ممرٌ ضيقٌ بطولٍ لا ينتهي/ رشا عمران
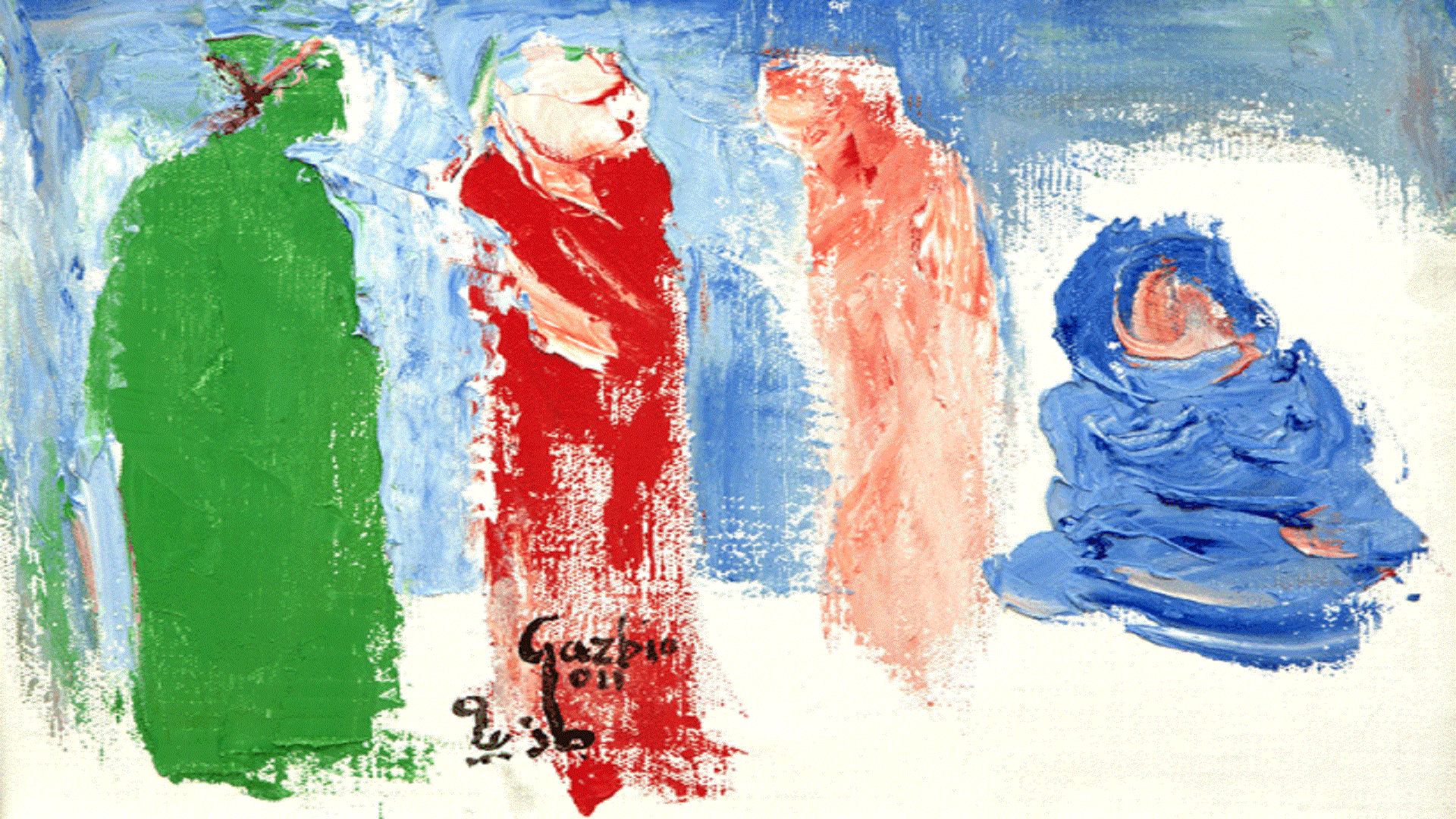
قرأت يوما أن الشاعرات المنتحرات غادرن الحياة لأنها كانت أضيق من أفكارهن، وأنهن ذهبن إلى الموت، ليتبعن الأثر الخفي لحفيف اللغة. قرأت يوما أنه في تلك اللحظة التي أخذن فيها قرار الانتحار، ولدت قصائد عظيمة، ولأول مرة امتلأن بالثقة أنهن شاعرات! أما أنا التي اعتدت قراءة سير الشاعرات المنتحرات، وبحثت طويلا عن سير الشعراء المنتحرين، وفكرت طويلا في سؤالٍ لم أعرف له جوابا: لماذا ينتحر الشعراء؟ هل يعتقدون، في لحظة ما، أنهم لم يعودوا قادرين على الكتابة، وأن حياتهم بلا كتابة الشعر لا معنى لها؟ هل يصل الشاعر يوما ما إلى إلى حد أن حياته مرهونة بكتابة الشعر، فيصبح توقفه عن الكتابة بمثابة حكم إعدام لا تراجع عنه؟ أفكّر كثيرا في ذلك، وأفكّر بنفسي شاعرةً، وأفكّر بسؤال الشعر، وبالسؤال عن أهمية أن يكون لي مشروع شعري أكرّس حياتي له. هل الشاعرات المنتحرات اعتبرن الموت إكمالا لمشاريعهن الشعرية؟ أم أن تجاربهن تكتمل بالموت، حيث يصبح الموت/ الانتحار هو الضوء الذي سيسلطه الزمن على تجاربهن، فتتوهج يوما وراء يوم؟ يا للمفارقة الغريبة إن كان ذلك حقا يخطر في بال الشاعرات اللواتي يقرّرن الانتحار.
“أيتها اللصة/ كيف زحفت فيه/ زحفت لوحدك نزولا إليه/ الموت الذي تمنيتُ كثيرا/ ولوقت طويل”.. تكتب آن ساكستون، الشاعرة التي انتحرت لاحقا، وهي تهدي قصيدتها هذه إلى سيلفيا بلاث، صديقتها الشاعرة التي سبقتها في النزول إلى الانتحار. لم يعد الشعر يكفيهن لمواصلة الحياة على ما يبدو، فنزلن الدرج الآخر، درج الموت علّهن يجدن المعنى المفقود في حياتهن. هل يمكننا أن نقول ذلك عنهن؟ حين قرأت يوميات سيلفيا بلاث، كنت مع كل فكرةٍ لها أشعر باضطراب فكرتها عن الحياة، ثمّة ما يجعلك تعتقد، وأنت تقرأ يومياتها، أنها سوف تنتحر، حتى لو كنت لا تعرف نهايتها مسبقا. هذا القلق في الكتابة وفي الأفكار، وفي البحث عن معنى الحب والشعر والزواج والأمومة والشهرة. يقال إن تيد هيوث، زوجها، قد تصرّف في اليوميات قبل نشرها بعد رحيلها، لتبدو سيلفيا على هذا الاضطراب، في محاولة إبعاد شبهة إيصالها إلى الاكتئاب المرضي عنه. من يدري الحقيقة؟
أحب المعنى في حياتي أكثر مما أحبه في الشعر. هذه أنا. ولكن يمكن لأحد أن يسأل، وربما يخطر لي السؤال نفسه: ومن أنت؟ وماذا قدّمت للشعر؟ سؤال أظن أن كل الشعراء يسألونه عن أنفسهم. كانت سيلفيا بلاث تسأله كثيرا في يومياتها. لا بأس، قد لا أكون قدّمت شيئا، وقد لا أقدّم شيئا، لكنني ربما أعرف قليلا ما أريده من حياتي. أعرف أنني أعيش لأجل حياتي، حيث أجد الشعر فيها، لا أعيش لأجل الشعر حيث أجد حياتي. لستُ مهووسةً بأن يخلّد الزمن إسمي. حين أختفي أنا كليا من الحياة لا معنى لبقاء اسمي، وحتما لا يغريني نور الموت مسلّطا على قصيدة لي، فأنا يغويني حفيف جناحي فراشة في حديقة صغيرة، حين أراقب ذبذبات الصوت الخافتة التي تصدر من الجناحين، فأغنّي لهذه النعمة التي اسمها الحياة. أحب الغناء كما أحب الشعر. أحب الرقص أيضا مثله، الغناء والرقص والموسيقا والمسرح والسينما ربما أكثر التصاقا بالبشر من الشعر. أفكّر وأنا أمشي في شارع مزدحم أن فكرة الشعر تلمع من الأجساد البشرية، لا من البرزخ الذي يطبق على الوحي كحارس مدرّب. أظن أحيانا أن فكرة الوحي القادم من مكانٍ غيبيٍّ ساذجة، يخترعها الشعراء حين يريدون القول إنهم أنبياء. لا أحب النبوءة. أحبها ربما في اللغة، حين نرى أنها ليست سوى ذلك التناغم الذي يخلفه تداخل الحضارة مع البدائية الأولى في برّية اللاوعي.
اللغة قصيدةٌ وشعر، حين نتمكّن من أسرارها. أفكر أن الشعر هو متابعة أخبار ابنتي الوحيدة التي تعيش في مكان بعيد، ورغبتي أن أكبر معها، وأن نكون عجوزيْن تختلفان بأثر التجربة علي. الشعر هو مراقبة خطوط التجربة على جسدي، عاما وراء عام. أن أتمكن من النجاة كلما يستفرد الموت بي، ويبدأ بعرضه المثير كممثل بورنو وسيم، أن ألاحق الزمن، وهو يتابع طريقه من دون أن يكترث بأفكارنا عنه. الزمن ممر ضيق، بطولٍ لا ينتهي. أما الشعر، يا صديقاتي المنتحرات، فهو مفتاح الباب الذي يتوسط الممر، كاشفا تلك القاعة الهائلة التي اسمُها الحياة.
العربي الجديد




