عسكرة العمران
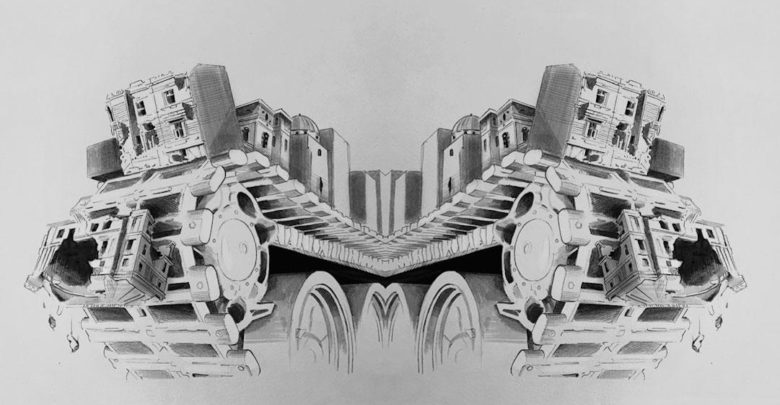
يتعسكر العمران حين يصير سلاحاً بيد السلطة، تتلاعب به وتفرض عليه ترتيبات عنيفة، موظفة إياه في خدمة مشاريع السيطرة وفرض الولاء. تقارب مواد هذا العدد موضوع عسكرة العمران في سوريا من ست زوايا مختلفة. تتحدث عن السلطة والخوف في صناعة المدن السورية؛ تناقش فرض التجانس العمراني كشكل من أشكال الإبادة فيها؛ تستعرض الحواجز كإحدى البنى التحتية للحرب التي وظفت هذه المدن؛ وتتناول البنية التشريعية التي سُنّت لشرعنة العنف العمراني الممارس ضدها؛ كما تناقش دور المنظمات الدولية والأمم المتحدة كشريك للنظام في ممارساته العمرانية الظالمة من خلال تعاميها عن الواقع السياسي السلطوي الذي يفرضه النظام من جهة، ورمنستها لمواضيع التراث العمراني بشكل يتجاوز واقع الناس على الأرض، من جهة أخرى.
كيف انتزع الأسد منّا سورياه المتجانسة/ سوسن أبو زين الدين
حصل بشار الأسد على سورياه المتجانسة. قالها منذ قرابة العامين، في العشرين من شهر آب لعام 2017. نعى بشكل متعجّل «خيرة» شباب البلد، وبنية تحتية كانت قد كلفت «الكثير من المال والعرق لأجيال»، لكنه طمأن جماهيره بأنه قد ربح سوريا «أكثر صحة وأكثر تجانساً بالمعنى الحقيقي، وليس بالمعنى الإنشائي أو بالمجاملات». وأكد أن «التوجهات المستقبلية للسياسة السورية تقوم على الاستمرار في مكافحة وسحق الإرهابيين في كل مكان، والمصالحات الوطنية التي أثبتت فاعليتها بأشكالها المختلفة»، إضافة إلى «زيادة التواصل الخارجي والتسويق للاقتصاد، الذي دخل في مرحلة التعافي».
بعد أشهر قليلة من خطابه هذا، سيُطبِق بشار الأسد الحصار على غوطة دمشق الشرقية، «سيسحقها» ويدمرها ويسوّيها بالأرض، سيضرب أهلها بالأسلحة الكيماوية، ويلاحقهم من حارة لأخرى. سيهاجم ملاجئهم، ويرسل جنوده لالتقاط الصور التذكارية مع وجوههم المرعوبة في هذه الملاجئ، ثم «سيصالحهم». سيخيّرهم بين أن يهجّرهم على متن باصاته الخضراء إلى الشمال السوري حيث تنتهي حدود سورياه المتجانسة؛ أو أن يصهرهم في أرضه، حيث سيُحملون إلى مراكز الإيواء، سيُعتقلون هناك، ويُعذبون، ويموتون تحت التعذيب، سيهتفون «بالروح والدم» لبشار الأسد، ثم سيُساقون إلى الحرب باسمه وتحت رايته… يحاربون لتوسيع حدود سورياه المتجانسة.
بشار الأسد كان قد «سحق» سابقاً حمص القديمة واليرموك وداريا والوعر والمعضمية والتل وخان الشيح وحلب الشرقية ووادي بردى والزبداني ومضايا والقابون وبرزة، و«سيسحق» لاحقاً ما تبقى من أحياء جنوب دمشق الثائرة وريف حمص الشمالي ودرعا. «سيصالح» أهلها عارضاً عليهم خياريه الاثنين، ثم ينتقل ليبدأ جولة جديدة من ترسيم الحدود على جبهات إدلب ماضياً في معركته لفرض التجانس.
يقول الباحثون العمرانيون أن فرض الـ«تجانس» هو شكل من أشكال الإبادة، يسمونه الأوربسايد (Urbicide)، في محاولة لمحاكاة مفهوم الإبادة الجماعية، الجينوسايد (Genocide)، من منطلق عمراني. الأوربسايد حرب من الحروب الجديدة التي تُخاض باسم سياسات الهوية. ليست حرباً تُعلن على المدن في محاولة للسيطرة عليها جيوسياسياً، بل حرب تخاض من خلال المدن، تتلاعب بها، وتتخذ من شوارعها وساحاتها ومساكنها وشبكات الكهرباء والماء فيها أدوات تطوّعها لتقضي على أحد جماعاتها المختلفة دينياً أو عرقياً أو قومياً أو سياسياً أو حتى اقتصادياً، وصولاً إلى مجتمع متجانس، لا مكان للآخر المختلف فيه.
ظهر مفهوم الأوربسايد أولاً في إشارة إلى مشاريع التطوير العمراني الضخمة التي مزّقت أحياء نيويورك منذ خمسينات القرن الماضي، تاركة خلفها مجموعات كبيرة من السكان المهجرين مسلوبي الذاكرة العمرانية. سكان عشوائيات أو مخالفات أو، بأبسط الأحوال، سكان مناطق مهمشة قبل أن تمسح عن وجه الأرض -كضرر جانبي- في سبيل تخديم مناطق أكثر أهمية. ورغم تداول المصطلح بكثرة في الستينات والسبعينات بعد أن كتبت عنه آدا هوكستابل في نيويورك تايمز عام 1968، إلا أنه ينسب لمارشال بيرمان1، الذي تحدث عن ضحايا مشاريع التطوير العمراني هذه عام 1987 قائلاً: «هؤلاء ضحايا جريمة ضخمة لا اسم لها. لنطلق عليها اسماً الآن. لنسمها الأوربسايد: مقتلة المدينة».
منذ حينها، شاع تطبيق المصطلح ضمن جغرافيات كثيرة وسياقات متعددة، أشهرها حرب البوسنة، وحرب لبنان، و في السياسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين. وقد تجلى المفهوم ضمن هذه السياقات عبر ممارسات مختلفة، منها ما هو قائم على البعد المادي للمدن بشقيه التدميري والإعماري؛ ومنها ما يعنى بتعطيل الحياة الدائرة في هذه المدن. ما يجمع هذه الممارسات أن المنطق السياسي فيها يهدف إلى فرض التجانس أو القضاء على الآخر المختلف الذي يجعل من التنوع خطراً مهدِّداً لهذه المدن.
من هنا، كان خطاب بشار الأسد عام 2017 اعترافاً مبطناً بأن حربه في سوريا هي وجه من أوجه الأوربسايد. هي مقتلة عمرانية، تمت فيها عسكرة العمران بشكل ممنهج منذ اليوم الأول للثورة – أو حتى قبل ذلك- لبدء الحرب وتصعيدها، ولتمهيد الأرض لسوريا المتجانسة ما بعد الحرب. سوريا التي استؤصل منها كل من تشي هوياتهم بانتماءات دينية أو جغرافية مشاغبة سياسياً، أو حتى من لم تسعفهم طبقاتهم الاجتماعية أو أحوالهم الاقتصادية بأن يفوزوا بمكان في البلد، التي ستُقدم إلى من بقي من محاسيب نخبتها السياسية والاجتماعية الاقتصادية أرضاً غضة للاستثمار.
تبدأ قصة الأوربسايد في سوريا من الحيطان التي غصت بـ«الأسد، أو نحرق البلد». «البلد» التي يريدها النظام هي بلد تُعرَّف بالأسد. المدن التي ستعرَّف بأي انتماءات أخرى ستُحرق، وتشهد المقتلة التي ستبدأ من بيوتها وشوارعها وساحاتها وشبكاتها وأراضيها، وتنتهي بها جزءاً من الكل المتجانس، حتى لو كانت مدن أشباح.
مقتلة المواقع: التدمير العشوائي الممنهج
لا يمكن القول أن الدمار الهائل في سوريا هو تحصيل حاصل للعمليات العسكرية وحسب، حيث أن حجم الدمار وتوزّعه الجغرافي بعيداً عن خطوط الجبهات وفي قلب الأحياء السكنية ومراكزها الخدمية، في معاقل الثورة حصراً، وفي المناطق ذات البعد الاستراتيجي سياسياً أو اقتصادياً؛ إلى جانب أنه بمعظمه قد نفذ بالبراميل المتفجرة عشوائية التدمير، لا بأسلحة قادرة على تصويب الهدف، يشي بأن هذا الدمار ليس اعتباطياً ولم يكن ضرراً جانبياً لعمليات عسكرية محددة، بل هو أداة من أدوات حرب التجانس.
حمص، التي دُمّر نصفها، مثال على ذلك. يُشاع أن الدمار فيها استهدف مناطق كانت قد شُملت بمشروع تخطيط عمراني إشكالي قديم تم طرحه عام 2007 من قبل محافظ حمص آنذاك، إياد غزال، تحت اسم حلم حمص. استهدف «حلم حمص» مناطق فقيرة، ومناطق عشوائيات ومخالفات جماعية، إضافة إلى مناطق من مركز المدينة. وأثار المشروع جدلاً واسعاً بين أهالي المدينة بسبب ما حمله من إمكانية مصادرة أراضيهم وهدم ممتلكاتهم وإبرام صفقات عقارية مشبوهة بحجة تطوير مركز المدينة وتوسيعه وتحديثه. رافق هذا احتجاجات شعبية واعتصامات منظمة ولافتات طالبت السلطات المحلية «ألا تجبل بساتين حمص بدماء ملاكها»، في إشارة إلى أن التصعيد يستوجب الدم. ورغم تأكيد السلطات المحلية للمواطنين أن المشروع لن يقوم على استملاك أراضيهم بشكل تعسفي في محاولة لاحتواء غضبهم، إلا أن الحكومة بدأت بمصادرة الأراضي عام 2009، واستمر العمل استعداداً لتنفيذ المشروع حتى بدء الثورة عام 2011، التي أدت إلى توقيف المشروع بشكل مؤقت وإقالة إياد غزال من منصبه في محاولة لامتصاص الغضب، حتى يستتب الأمن.
يرى الكثيرون من أهالي حمص أن الدمار الذي لحق بمدينتهم كان في صلبه محاولة لفرض ترتيبات عمرانية تعيد إحياء مشروع حلم حمص، ولكن ضمن السياق السياسي، وبشكل يستثمر ما فيه من انقسامات طائفية وطبقية ومناطقية مشحونة. يدعم فرضيتهم هذه حصار حمص وإفراغها الممنهج من أهلها بين عامي 2012 و2014 بفعل العمليات العسكرية العنيفة أو بفعل اتفاقات التهجير التي طالت أحياءً كانت، في غالبيتها، ضمن المخطط التنظيمي لـ «حلم حمص». خريطة التدمير الممنهج في حمص ترسم بوضوح منحنى يلتف من زاوية المدينة الشمالية الشرقية، عبر مركزها، نحو جنوبها الشرقي زاحفة في معظمها ضمن أحياء ذات غالبية سنية، محاذية للأحياء العلوية، التي بقيت إلى حد كبير «صاغ سليم».
باب السباع، القصور، بابا عمرو، والخالدية جميعها أحياء ذات غالبية سُنّية شهدت نفس سردية التدمير والتهجير. معركة بابا عمرو وحدها، والتي استمرت شهراً واحداً، هجّرت ما يزيد عن 50 ألفاً من أهل الحي وخلفت دماراً هائلاً في 600 من مبانيه، منها ما يفوق 200 مبنى مدمراً بشكل كامل. في الوقت الذي سَلِمت فيه أحياء الفردوس والغوطة والمحطة ذات الحضور الأكثف للأوساط الموالية للنظام ومراكزه الأمنية من التدمير إلا ما ندر. الخالدية، أحد أبرز أحياء «حلم حمص»، شهد دمار أكثر من 1250 مبنىً وجامعين، أحدهما جامع خالد بن الوليد، أحد رموز المدينة. أما باب الدريب، باب هود، وباب تدمر، قلب المدينة ومركزها التجاري و أهم أحياء مخطط حلم حمص بغالبيتها السنّية، شهدت مجتمعة دمار ما يفوق 1200 مبنى، بما في ذلك 15 موقعاً لأسواق محلية.
مما يزيد الوضع سوءاً أنه منذ استعادة النظام السيطرة على هذه الأحياء، لم يُسمح لسكانها بالعودة لما تبقى من منازلهم سوى لفترات محدودة جداً ليجمعوا بعض ممتلكاتهم وحسب. في عام 2014 سمح لأهالي الحميدية والقصور والقرابيص بالعودة لمنازلهم، إلا أن الأمم المتحدة، وتحت إشراف النظام، بدأت بإعادة تأهيل حي الحميدية ذو الغالبية المسيحية، فقط؛ في حين تم استثناء أحياء أخرى. في عام 2015 أعلن النظام عبر قنوات إعلامه الرسمية أن إعادة إعمار مناطق المخالفات في حمص ستتم وفقاً لمخططات حلم حمص، وبموجب المرسوم 66 (الإشكالي بحد ذاته، كما سنرى لاحقاً) والذي سيقدم الإطار القانوني لعملية الإعمار هذه، الأمر الذي عزز الفرضية الطائفية والمناطقية والطبقية في إعادة بناء حمص وحلمها.
مقتلة البيوت: التهديم الممنهج
بين عامي 2012 و2013، اقتحم الجيش العربي السوري بالبلدوزرات والمتفجرات، أحياء سكنية كانت قد شهدت حراكاً ثورياً في كل من حماة ودمشق، قبل أن يسيطر عليها النظام معلناً انتهاء القتال. 7 أحياء كاملة، يعادل مجموع مساحتها 200 ملعب كرة قدم سُويت بالأرض، وهُجّر أهلها دون إنذار أو حتى تعويض. مسؤولو النظام صرحوا أن هذه الجهود جاءت في سياق مشاريع تطوير عمراني لإزالة المخالفات في المنطقة، حسبما ورد في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، التي أجرت تحقيقاً حول عمليات التهديم الممنهج هذه، إلا أن قسماً كبيراً من سكان هذه المناطق كانوا يمتلكون كافة الأوراق الثبوتية اللازمة لعقاراتهم، الأمر الذي يترك دافعاً وحيداً لعمليات التهديم هذه، أكده محافظ ريف دمشق حسين مخلوف الذي قال في مقابلة إعلامية له في تشرين الأول عام 2012 أن هذه العمليات «ضرورية لطرد مقاتلي المعارضة».
حي القابون الدمشقي كان أحد هذه الأحياء. هُدم فيه ما يقارب 18 هكتاراً ضمن جولتين، الأولى وقعت عام 2012 على خلفية اشتباكات عنيفة بين النظام ومقاتلي المعارضة، وعقب هجمة شرسة شنتها قوات النظام على الحي واستعادت إثرها السيطرة عليه. استمرت عملية الهدم الأولى 50 يوماً، هُدم فيها 1250 متجراً و650 منزلاً كان يسكن كل واحد فيه عائلتين أو أكثر. أما الثانية فتمت عام 2013 دون أن توثق تفاصيلها.
منظمة هيومن رايتس ووتش خلصت إلى استحالة النظر في هذه العمليات على أنها هدف مشروع،ه حتى في سياق الحرب. فالبيوت التي هدمت بموجبها لم تكن أهدافاً عسكرية، لم تستخدم كمأوى للمقاتلين ولا للتخطيط للهجمات وشنّها ولا حتى لتخزين الذخائر والأسلحة. عمليات الهدم هذه لا يمكن أن تبرر إلا بأسباب استباقية أو عقابية لشريحة سكانية ينظر إليها النظام على أنها عنصر مهدد، شاذ عن النسيج الأوسع، لا بد من استئصاله لفرض التجانس. كل ما في الأمر أن المقتلة هنا كانت مقتلة للمنازل. حاربوا الناس في بيوتهم فاستأصلوهم.
وكما في حمص، أكّد فرضية الأورباسايد أن مجلس الوزراء والسلطات المحلية كانت قد حددت أجزاءً من القابون لإعادة الإعمار في نيسان عام 2018. هذه الأجزاء لم تشمل فقط مناطق تم تهديمها تعسفياً بين عامي 2012 و2013، بل شملت أيضاً مناطق أخرى استهدفها النظام في سلسلة جديدة من عمليات الهدم التي طالت ما يقارب 35 هكتاراً على طول الأوتوستراد الدولي بين عامي 2017 و2018، أي بعد اتفاق تهجير القابون الأخير في أيار عام 2017 حين تحول الحي إلى مدينة أشباح. ما يؤكد أن عمليات التهديم هذه لم تكن أداة عقاب في حرب فرض التجانس السياسي وحسب، بل جزءاً من مخطط أكبر لتسوية الأرض لمشاريع إعادة إعمار ستستثني أصحاب الأرض.
كان النظام قد أقفل الحيّ بشكل كامل عقب إفراغه من أهله. أبقى بعض أجزاءه محظورة تماماً عن الحركة، في حين سمح للسكان بالدخول المشروط لأجزاء أخرى شرط أن يتركوا هوياتهم الشخصية على الحواجز التي تحرسه، وأن يدفعوا رسوماً لدخولهم، وأن يخرجوا في نفس اليوم الذي يدخلون فيه. ويبدو أن «الكود» الذي يصنف الأحياء بين محظور ومشروط هو كود دوّار، تتبدل تصنيفات الأحياء ضمنه وفقاً لمعطيات لن يعرفها سوى مسؤولو النظام، فهم الوحيدون الذين يسمح لهم بالعمل في المنطقة.
إحدى اللواتي هُجّرن إلى إدلب ضمن اتفاق القابون روت أن أحد أقاربها استطاع الدخول إلى المنطقة (بفضل الرشوة) ليطمئن على منزلها -الذي كانت قد تركته سليماً واقفاً حين هُجّرت- بعد شهور من خروجها منه، وكان المنزل لا يزال على حاله. في العام الذي يليه، دخل قريبها مجدداً ليطمئن على المنزل ليجده ركاماً. لم تتلق صاحبة المنزل إشعاراً بالهدم، ولم تتلق تعويضاً رغم أن منزلها لم يكن ضمن مناطق المخالفات. على كل حال، لم يتذرع مسؤولو النظام هذه المرة بمشاريع التطوير العمراني لإزالة مناطق المخالفات كما فعلوا سابقاً. بل برروا عمليات الهدم الجديدة بضرورة تفجير الأنفاق التي خلفها «الإرهابيون» في المنطقة.
وبكل الأحوال، إن موضوع مناطق المخالفات بحدّ ذاته موضوع إشكالي في الحرب السورية، فقد تمت عسكرته واستخدامه سلطوياً هو الآخر. سياسات النظام تجاه مناطق المخالفات في بدايات الألفية كانت تتراوح بين «تسوية المخالفات وتحسينها»، و«تطويرها»، أي هدمها وإعادة بنائها. إلا أن الحرب، على ما يبدو، حسمت الأمر لصالح الخيار الثاني. لا تسويات في مناطق المخالفات أو تحديداً، لا تسويات في مناطق المخالفات ذات الغالبية السنية والتي احتضنت الثورة في إحدى مراحلها، وبالتالي احتضنت القسم الأكبر من التدمير والتهديم.
مقتلة البنى التحتية: حرمان المدينة
ليست حرب التجانس حرب تدمير وتهديم فقط، فهي أيضاً حرب تلاعب وإعادة ترتيب لشروط الحياة. حرب خبز وماء وكهرباء ودواء، وحرب شوارع وحواجز وحصار وفرض لأنماط الحركة، طوعت من خلالها شبكات البنى التحتية والمرافق والخدمات في معارك كرّ وفر قادها النظام، واستجابت لها الفصائل المسلحة.
حلب على سبيل المثال، المدينة التي قسّمتها خطوط التماس إلى قسمين منذ عام 2012، كانت قد أفرغت من ثلثي سكانها، الذين قارب عددهم الثلاثة ملايين قبل الحرب، بعد أن سيطر عليها النظام في النصف الثاني من عام 2016. دمر فيها ما يقارب نصف منازلها وأكثر من 80% من بنيتها التجارية وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة عام 2017. معظم هذا الدمار كان من نصيب ما صار يُعرف بحلب الشرقية، شطر المدينة الذي خرج عن سيطرة النظام، والذي تشكل بمعظمه من عشوائيات بناها مهاجرو الريف المهمشين الذين قصدوا المدينة بحثاً عن وضع اقتصادي أفضل، والذي قصده لاحقاً ناشطو المدينة هرباً من مناطق سيطرة النظام.
تفريغ حلب من سكانها لم يكن عشوائياً. إذ استهدف بدايةً جزء المدينة الذي ضم الشرائح الاقتصادية والسياسية غير المرغوب بها؛ وثانياً كان نتيجة عمل ممنهج لم يقتصر على التدمير العشوائي لمباني مناطقها الثائرة، بل استهدفها في مرافقها وخدماتها وبناها التحتية.
كانت حدود سيطرة مناطق النظام (أو ما يسمى حلب الغربية) لا تتجاوز 35% من أحياء المدينة مع بداية عام 2014. لكن المدينة كانت تغص بأكثر من 1450 حاجزاً، منها حوالي 1050 حاجزاً لقوات النظام، تتوزع على حدود خطوط الاشتباك وفي قلب مناطق سيطرته ضمن الأحياء السكنية. حواجز ثابتة وحواجز طيارة، لم تستخدم فقط كنقاط حماية لفرض حدود سيطرة النظام عسكرياً، بل استخدمت بشكل أساسي لفلترة الحركة ضمن مناطق سيطرته بحثاً عن الهويات ذات الانتماءات «المهدِّدة» أو «غير المتجانسة» ومن ثم استئصالها. على الطرف الآخر، كانت حواجز فصائل المعارضة الـ 400 تتركز بشكل رئيسي على خطوط الجبهات، وعلى طرق الإمداد الرئيسية، لا ضمن الحارات السكنية.
فصائل المعارضة طوعت شوارع حلب سلاحاً في حربها ضد النظام أيضاً. قد يكون المثال الأوضح على ذلك قطع خط الإمداد الرئيسي عن أحياء حلب الغربية بعد سيطرة الفصائل على خناصر بين شهري آب وتشرين أول عام 2013. وصل سعر ربطة الخبز في حلب الغربية إلى 150 ليرة سورية آنذاك، ثم عاد ليستقر على 15 ليرة، بعد الحملة العسكرية التي قادها النظام في تشرين الأول لفك ما سماه بالحصار، في وقت كان فيه سعر ربطة الخبز في حلب الشرقية يعادل تقريباً خمسة أضعاف هذا الرقم.
في المقابل، تعطلت نصف مخابز حلب الشرقية مع بداية عام 2014 معظمهم كان قد دُمّر بشكل ممنهج بفعل قصف النظام. في حين أن حلب الغربية لم يعطل فيها أي مخبز بفعل الحرب. حلب الشرقية شهدت مجازر طوابير الخبز التي وثقتها منظمة هيومن رايتس ووتش. أحد فرّاني باب الحديد شهد في تقرير المنظمة أنه في 21 آب عام 2012 كانت إحدى مروحيات النظام تحوم في المنطقة لساعات عند موعد فتح المخبز المسائي. كان أكثر من 200 شخص قد اصطفوا بانتظار دورهم في طابور الخبز عندما أسقطت المروحية قذيفتها قرب الفرن تاركة خلفها عشرات الجثث المغطاة بالطحين والغبار.
أيضاً، لم يصل حلب الشرقية، في ذاك الوقت، سوى ما يقارب 6 ساعات يومية من الكهرباء، سواء في الأحياء التي استهدفت فيها شبكات الكهرباء وبناها التحتية أو بقيت سليمة. وحلب الشرقية استُهدفت نقاطها الطبية بشكل ممنهج ومتكرر حتى لم يبق فيها سوى 24 مشفى أو مركزاً حسب إحصائيات الأمم المتحدة في آب 2016، كان منها عشر مراكز مغلقة ، لا يعمل فيها أي طبيب. مع نهاية عام 2016، كانت حلب الشرقية قد أفرغت من سكانها الذين حرموا سبل العيش فيها حتى لم يبق منهم سوى ما يقارب 325 ألفاً. هؤلاء هم من شهدوا الحصار الخانق، وواجهوا الحملة العسكرية الأعنف، قبل أن «يصالحهم» النظام ويهجرهم قسراً في طوابير طويلة من الباصات الخضراء التي راقبناها على مدى أيام، لتبقى حلب المدينة حكراً على من احتسبهم النظام جزءاً من سوريا المتجانسة.
عمليات إعادة التأهيل بدأت في حلب. حددت الأمم المتحدة قائمة المناطق التي تعد أولوية للبدء بالعمل من أجل تأمين عودة المهجرين، إلا أن النظام قاطعها مع قوائمه الخاصة لما حدده هو بمناطق الأولوية. تم بالنتيجة تحديد 8 مناطق باشرت الأمم المتحدة العمل في 3 منها ضمن مشروع تجريبي. تصريحات الأمم المتحدة حول سير العمل خلال عام 2017 تقول إن كافة أعمال صيانة المدارس والمراكز الطبية والخدمية استهدفت أحياءً تقع جميعها في حلب الغربية.
مقتلة الأرض والقانون: حرب الإعمار
جاءت تصريحات الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية واضحة بخصوص أن لا تمويل لإعادة إعمار سوريا حتى حصول «انتقال سياسي حقيقي» تحت رعاية الأمم المتحدة. ولكن لا يبدو أن النظام، حالياً على الأقل، يأبه بهذه التصريحات، فهو قد بدأ بالفعل إعادة الإعمار.
استخدم النظام هدفاً سهلاً للبدء: العشوائيات ومناطق المخالفات، حيث لا محاججات على مواضيع حقوق الملكية ضمن سياقات إعادة الاعمار. مشاريع تصاغ تحت عناوين التطوير العمراني، وتُسوّق كإعادة إعمار للبلد بوجه حداثي عالمي، فيه الكثير من الأبراج والمساحات الخضراء والمسطحات المائية وصور لأطفال مبتسمين محمولين على أكتاف أهاليهم، المبتسمين بدورهم والمطمئنين. وجوه لا تشبه بالضرورة تلك الوجوه المتعبة الحائرة المغبرة التي شهدت المقتلات جميعاً. وجوه لأناس ستعيش وأخيراً في «غيتوهات» عمرانية خضراء مشرقة لا تشبه ما خارج أسوارها من شوارع مزدحمة قاحلة، تغص بمباني متهالكة رمادية قبيحة.
ماروتا سيتي، أو «مدينة السيادة» بالسريانية، اسم ذكي اختاره النظام «حامي الأقليات» لمشروع إعادة الإعمار الأول الذي يعيد من خلاله فرض سيادته على «مناطق الشغب». وضع بشار الأسد شخصياً حجره الأساس، ووضع من خلاله حجر الأساس لما سيكون عليه الوجه العمراني لسورياه المتجانسة.
ماروتا سيتي، مشروع يقام في قلب دمشق على أراضي بساتين الرازي، منطقة المخالفات التي ثارت يوماً ضد النظام، رغم أنها لم تخرج عن سيطرته بشكل كامل. تجاور المنطقة سفارات دمشق ووزاراتها وجامعتها وأحياءها السكنية والتجارية «الراقية». بساتين الرازي كانت أحد موقعين حددهما المرسوم التشريعي 66 لعام 2012 الذي يقدم الأسس والنواظم القانونية والمالية لمصادرة مناطق المخالفات، ومن ثم إعادة تطويرها من خلال استثمارات عقارية خاصة. أخليت منازل بساتين الرازي قسراً ثم هدمت، فيما ترك أهلها مع وعود بمنازل مؤقتة وتعويضات زهيدة بالكاد تغطي نفقات إيجاراتهم لأشهر قليلة في سوق دمشق العقاري المتضخم، وشروط إجرائية معقدة وصارمة تجعل من فرصهم في العودة إلى أراضيهم (التي ستصبح ماروتا سيتي) خياراً أقرب إلى المستحيل، حيث لن يتحمل نفقات العودة إلى أبراج هذه الأراضي سوى «نخبة» البلد الاقتصادية وأصحاب رؤوس أموالها.
فالمرسوم 66 الذي بدأ بمنطقتين تنظيميتين -ثم عُدّل ليشمل كافة المحافظات السورية- يحوّل ملاّك العقارات إلى ملاّك أسهم على الشيوع للمقاسم التنظيمية في المشاريع الجديدة. تُقيّم عقارات الملاّك وفق وضعها الراهن على شكل أسهم دون أن يشمل التقييم ارتفاع قيمة العقارات بسبب المضاربات الناتجة عن مشاريع التطوير العمراني التي تشملها. ثم تُقيّم المقاسم التنظيمية في المشاريع الجديدة وتُوزّع بحصص سهمية على الشيوع بين أصحاب الحقوق في المنطقة التنظيمية. يتيح المرسوم لملاّك الأسهم أن يتداولوها فيما بينهم أو للغير، كلياً أو جزئياً، وفق 3 خيارات: أن يتخصصوا بالمقاسم، أو أن يساهموا في تأسيس شركة مساهمة وفق قانون الشركات النافذ أو قانون التطوير والاستثمار العقاري لبناء وبيع واستثمار المقاسم، أو أن يبيعوا أسهمهم بالمزاد العلني. يخضع للخيار الثالث كل من لم يسعفه حظه بالقبول في الخيارين الأول والثاني، وذلك وفق «قرارات قطعية» تتخذها «السلطات المسؤولة» بما يحقق «مصلحة مالكي الأسهم».
ولأن قيمة المقاسم التنظيمية الجديدة للمشروع الماروتي العظيم ستفوق بأضعاف قيمة عقارات الوضع الراهن لبيوت بساتين الرازي المهترئة، لن تكون حصص أصحاب الحقوق في هذا المشروع كافية لأن يعودوا إلى منزل كريم فيه. لن يعود إلى منازل «أرض السيادة» سوى من يستطيع أن يدفع ثمن هذه العودة ويتماهى مع هويتها النيوليبرالية الحداثية التي ستعرف بها سوريا المتجانسة.
باشر النظام إذاً إعادة الإعمار بالمرسوم 66 للتعامل مع مناطق المخالفات ريثما تصاغ القوانين التي ستنظم عمليات متابعة تهديم ما تبقى من مناطق اللا مخالفات، وإعادة إعمارها دون أن يكون لحقوق ملكية أصحابها حجم يذكر.
صحيح أنه ليس للقانون مؤسسات تحميه في سوريا، إلا أن النظام كان واضحاً، في معركته لإعادة إنتاج نفسه محلياً ودولياً، أنه سيعيد إنتاج سوريا المتجانسة «بالقانون». قانون تعسفي، ظالم، مجحف، مسيّس، موجه لخدمة مصالحه ومحاسيبه. لا يهم، طالما أنه القانون!
وهكذا، منذ عام 2012، حين كنا لا نزال إلى حد كبير مشغولين بالاندهاش من هول المجازر التي ترتكب بحقنا بالسكاكين والسواطير والمدفعيات والبراميل والبلدوزرات والديناميت، غاب عنا أن ننظر إلى المجازر التي سترتكب بحقنا بالقوانين التي صدرت واحداً تلو الآخر دون ضجيج. القوانين التي ستضمن أن لا مكان لنا – نحن الغاضبون الذين عصينا المنظومة السياسية العسكرية للنظام، أو الذين لم نمتلك وجوهاً مبتسمة مطمئنة يمكن لها أن تتصدر دعايات الترويج للغيتوهات العمرانية الحديثة، ولم نمتلك حسابات بنكية أو استثمارات يمكنها أن تدفع ثمن العيش في هذه الغيتوهات- لا مكان لنا في سوريا التي يُعاد إنتاجها لكي تكون سوريا متجانسة. غاب عنا الأوربسايد الذي يحاك ضدنا.
قبل المرسوم 66، صدر القانون 63 عام 2012 لمصادرة «أملاك الإرهابيين». هذا القانون الذي يتبنى مفهوم النظام للإرهاب، ويجرم بالتالي شريحة كبيرة من معارضيه السياسيين وذويهم ومعارفهم، ويسلبهم ممتلكاتهم العقارية.
بعدها، ظهر المرسوم التشريعي 19 لعام 2015 الذي يسمح لمجالس الإدارة المحلية بإنشاء شركات قابضة مساهمة مغفلة خاصة، تدير ممتلكات المجالس العقارية دون ضرائب. بموجب هذا القانون تم تأسيس شركة دمشق الشام القابضة عام 2016 بقيمة 60 مليار ليرة سورية وبإدارة محافظ دمشق عادل العلبي. دمشق الشام القابضة تدير اليوم مشروع ماروتا سيتي من خلال شراكات عديدة تم توقيعها مع مجموعة من الشركات الأخرى العائدة لأصحاب رؤوس الأموال السورية الأشهر، أمثال رامي مخلوف وسامر الفوز ومازن الترزي، بمجموع رأس مال وصل إلى 380 مليار ليرة سورية.
ثم ظهر المرسوم التشريعي 11 لعام 2016 والذي يوقف العمل في السجلات العقارية المغلقة بسبب الحرب، بما في ذلك تلك التي في المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام، محيلاً التعاملات العقارية في هذه المناطق خلال كل هذه السنوات إلى مشاريع مخالفات. تلاه المرسوم التشريعي 12 لعام 2016 القاضي بأتمتة السجلات العقارية وفق متطلبات إجرائية صارمة لإثبات حقوق الملكية التي ستتم أتمتتها، ما يحرم أولئك الذين فقدوا أوراق ملكية عقاراتهم تحت ركام منازلهم أو خلال نزوحاتهم المتكررة من حقهم في إثبات ملكيتهم، ويضيّق على شريحة كبيرة ممن لا يستطيعون الوصول إلى مؤسسات النظام لتسجيل ملكياتهم، حتى لو لم يفقدوا أوراق ثبوت ملكيتها.
ثم جاء المرسوم رقم 3 لعام 2018 الذي يقضي بإزالة أنقاض المنازل المدمرة، أو التي يقتضي هدمها وفق تصنيفات النظام، بما فيها من عفش وأثاث وذكريات وأشلاء وجثث، أيضاً وفق إجراءات صارمة تقيد حق الناس في إثبات ملكياتهم أولاً ومن ثم الاعتراض أو جمع ممتلكاتهم من بين الركام.
آخر هذه القوانين وأكثرها تعقيداً وإشكالية كان القانون رقم 10 لعام 2018 والذي تم تعديله لاحقاً بالقانون رقم 42 لعام 2018 والذي بدأ من خلاله إعلان منطقة تلو الأخرى من مناطق إعادة الإعمار التي ستتظافر فيها كل المراسيم والقوانين السابقة للبدء بمشاريع «ماروتية» جديدة. القانون رقم 10 يعتبر تصعيداً ممنهجاً للمرسوم 66 خارج مناطق المخالفات، فهو يتيح لوحدات الإدارة المحلية تخصيص المناطق التي تراها مناسبة للبدء بمشاريع إعادة الإعمار وفق شروط إجرائية صارمة، تطلب من ملاك هذه المناطق ومستأجيرها إثبات حقوقهم العقارية فيها وإلا ستعود هذه العقارات لملكية الوحدات الإدارية، التي يمكنها بالتالي التصرف بها دون تعويض.
قد لا تبدو جملة القوانين والتشريعات هذه بحجم الضجيج الذي نحاول إثارته حولها للوهلة الأولى. فهي لا تختلف كثيراً عن العديد من التشريعات التي تصاغ في معظم بلاد العالم النامية منها والمتقدمة لتنفيذ مشاريع ما يسمى بالجنتريفيكيشن (gentrification) الذي يتم من خلاله استبدال طبقة ما بطبقة «أعلى» منها من خلال مشاريع تطوير عمراني نيوليبرالي تقتضي تغيير هوية المنطقة العمرانية والثقافية.
ولكن ضمن الواقع السياسي والاجتماعي الاقتصادي والمكاني في سوريا، تصبح هذه التشريعات أكثر تعقيداً من كونها هيكلية عمل لمشاريع تطوير عمراني نبوليبرالي تفضي إلى الـ «جنتريفيكشن».
فالبنية التشريعية التي سُنّت لتنظم مشاريع إعادة الإعمار في سوريا تفرض إجراءات تنفيذية معقدة، تطلب -في أحسن الأحوال- الحضور الشخصي للمعنيين أو أحد أقاربهم أو الموكلين عنهم إلى مؤسسات النظام لإثبات ملكياتهم المهددة وفقاً لهذه المشاريع من خلال الأوراق الثبوتية القانونية المتعارف عليها، وذلك ضمن مهل زمنية محدودة جداً. في هذا الأمر إشكاليتين رئيسيتين:
أولاً، 11 مليون سوري هم اليوم لاجئون أو نازحون داخليون، لا يستطيعون بالضرورة التقدم لإثبات ملكياتهم وفقاً للشروط المطروحة لأسباب لوجستية بحتة، 9% منهم فقط يمتلكون الأوراق الثبوتية الرسمية التي تخوّلهم التقدم لتثبيت ملكياتهم. إضافة إلى هذا، معظم المهجرين من المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام (وبالتالي التي تعرضت للدمار الأكبر، والتي ستشمل بمشاريع إعادة الإعمار بشكل أوسع) لن يستطيعوا غالباً الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة لاستكمال إثبات ملكياتهم. هذا إضافة إلى مئات آلاف المعتقلين والمختطفين والمغيبين قسرياً في السجون، والذين لن يتمكنوا من التقدم لا شخصياً ولا من خلال أحد الأقارب أو الموكلين. وبالتالي فإن الواقع السياسي والأمني في البلد يجعل من جملة القوانين هذه وسيلة واضحة لتجريد ما يقارب نصف سكان سوريا من ممتلكاتهم بشكل «قانوني»، ولأسباب لوجستية بحتة.
الإشكالية الثانية هي أن جملة القوانين هذه تتعامل مع موضوع الحقوق في مشاريع إعادة الإعمار وفق ثنائية (مخالفات/ نظامي) أي أنها تنطلق أساساً من مفهوم تقليدي لا يقيم وزناً لنظم التملك العرفية المحلية في التعاطي مع موضوع حقوق الملكية. ما يعادل نصف الأراضي السورية فقط كان مسجلاً قبل الحرب، عدا عن أن إيقاف العمل في قسم كبير من السجلات العقارية فاقم هذا الأمر. إضافة إلى ذلك، مفهوم المخالفات مفهوم شائك في السياق السوري، وغالباً ما يتم قياسه وفقاً لضوابط البناء والأسس التخطيطية التي تفرضها نظم التخطيط الرسمية، إلى جانب موضوع أوراق الملكية. أي أن قسماً كبيراً ممن قد يعرَّفُون كسكان مخالفات يمتلكون في الحقيقة الأوراق الثبوتية لأراضيهم، لكن ليس بالضرورة لمنازلهم التي تم بناؤها بدون ترخيص أو بما يخالف ضابطة البناء واستعمالات الأراضي.
من هذا المنطلق، لا يمكن التعامل مع ظاهرة مناطق المخالفات والعشوائيات وفق السياسات العمرانية التقليدية لمؤسسات التخطيط الرسمية في سوريا، والتي كانت بحد ذاتها أحد أهم محفزات نشوء هذه الظاهرة من حيث كونها سياسات غير مرنة، تعمل وفق ضوابط وأسس غير قادرة على التجاوب مع حاجات الناس العمرانية واحتواء متغيرات الواقع من ضغط سكاني متزايد وعمليات تمدن سريعة. وبالتالي فإن النظر إلى مواضيع الحقوق ضمن عمليات إعادة الإعمار من المنظور الضيق لمفهوم المخالفات سيحرم شريحة واسعة من السكان من حقوقهم في أراضيهم ومنازلهم.
من هنا، يمكن القول أن البنية التشريعية التي سنّها النظام لضبط عمليات إعادة الإعمار هي بنية إقصائية تمييزية ظالمة، تحاول شرعنة الانتهاكات والممارسات العمرانية المجحفة التي قادها النظام في مقتلات عمرانية كثيرة. وهي الخطوة الأدق في استراتيجيته الممنهجة لهندسة سوريا المتجانسة، المبنية على مصالحه السياسية والاقتصادية. سوريا التي فاز بها رجال الأعمال المحاسيب، يتصافحون أمام مخططات المشاريع، فيما يُشطب الآلاف عن الخرائط ويعاد تدوير ركام بيوتهم وفق صفقات عقارية تؤسس لجغرافيا جديدة.
*****
1. فيلسوف أميركي ماركسي وأستاذ في العلوم السياسية في جامعة سيتي في نيويورك حيث درس الفلسفة السياسية والعمران.
سوسن أبو زين الدين: مهندسة معمارية سورية ممارسة في التنمية العمرانية. ماجستير في تخطيط التنمية العمرانية من «وحدة تخطيط التنمية» في كلية لندن الجامعية UCL، ودبلوم دراسات عليا من معهد دراسات الإسكان والتنمية الحضرية في جامعة إيراسموس روتردام، بكالوريوس في العمارة من جامعة حلب. عملت في مجالات التنمية المحلية والدولية والأبحاث مع مؤسسات أكاديمية ومراكز بحثية ومنظمات غير حكومية دولية وسورية. وهي مؤسِسة مشاركة لمبادرة «سكن للمجتمعات الإسكانية» واستديو «قباء»، اللذين تعمل من خلالهما على مواجهة التحديات العمرانية المتعلقة بالصراع في سوريا عن طريق ممارسات محلية بديلة.
التراث العمراني وإعادة الإعمار/ ي.ب
في الفترة بين 2015 و2016، قام تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) بعملية تدمير ممنهج لمعالم مدينة تدمر الأثرية. طال الدمار معبدَي بِل وبعل شمين والمقابر البرجية وقوس النصر، بالإضافة إلى الواجهة الداخلية للمسرح الروماني. باختصار، تم تدمير كل ما يرمز للمدينة ويميّزها. لم تكن حادثة تدمر هي الأولى من نوعها من حيث استهداف المواقع التاريخية والأثرية في سوريا، إلا أنها تركت الأثر الأكبر في ذاكرة السوريين.
صدر بيان عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) يصف عملية تدمير آثار تدمر بـ«التطهير الثقافي» (cultural cleansing)، الأمر الذي شكل نقلة نوعية في توصيف الجرائم ضد التراث العمراني، حيث لا يخفى على أحد الارتباط المعنوي بين هذا المصطلح ومصطلح التطهير العرقي (ethnic cleansing) الذي يستخدم للدلالة على جرائم الحرب التي تستهدف جماعة ذات خلفية عرقية معينة بغية تهجيرها من مكان ما أو إلغاء وجودها كلياً بحجة الحفاظ على التجانس العرقي لهذا المكان. كان وصف اليونسكو لعمليات داعش في تدمر على أنها تطهير ثقافي محاولة للضغط على المجتمع الدولي لإدراج الجرائم ضد التراث الثقافي تحت مظلة جرائم الإبادة الجماعية، الأمر الذي قد يؤدي إلى اتخاذ اجراءات عملية وأكثر جدية لحماية هذه الأماكن.
تبدو قراءة ما سبق طبيعية ومتوقعة، فالجميع يعلم أهمية مواقع التراث الثقافي ولا حاجة لسرد ذلك حالياً. إلا أن مجموعة من الإشكاليات تبدأ بالظهور عند قراءة ما سبق في سياق الحرب السورية. في هذا السياق، كان من الصعوبة بمكان تجنّب المقارنة بين تدمر والمدن السورية الأخرى. تقدم هذه المقارنة – مقصودة كانت أم غير مقصودة – تجسيداً أوضح لجدلية العلاقة ما بين الماضي والحاضر، التقليدي والحديث، والتاريخي وغير التاريخي. عند مناقشة هذه الثنائيات، غالباً ما نقوم بتعريف أنفسنا والعالم المحيط بنا من خلال الانتماء إلى أحد الطرفين دون الآخر، إلا أنه بالتدقيق في طبيعة هذه العلاقة نجد أن المسافة الفاصلة بين طرفي الثنائية غير موجودة، أو صعبة الإدراك في أحسن أحوالها.
ممارسة مجتمعية أم حركة نخبوية؟
تَظهر الإشكالية الأولى في إدانة منظمات العناية بالتراث الثقافي للدمار الحاصل في تدمر وعدد من المواقع التاريخية دوناً عن غيرها من المدن والبلدات السورية، الأمر الذي يؤكد على المسافة بين التاريخي، المهم؛ وغير التاريخي الأقل أهمية. إن هذه الإشكالية لم تقتصر فقط على توصيف الدمار بل تجاوزته لتشكل الأساس لأي عملية إعادة إعمار.
تعود هذه النظرة التفريقية – إن صح القول – في فهم النسيج العمراني في جذورها إلى أساس ونشأة حركة الحفاظ المعماري (Architectural Conservation) التي تشكل في وقتنا الحالي القاعدة النظرية الجامعة لجميع النشاطات المتعلقة، بالتراث، كالترميم والتأهيل والإصلاح وأيضا إعادة الإعمار.
ولدت حركة الحفاظ المعماري في أوروبا في بداية القرن الثامن عشر، وتشربت وعكست قيم المناخ الثقافي السائد حينها، فتأثرت بمبادئ عصر المنطق (age of reason) والثورة السياسية في فرنسا والصناعية في انكلترا. في ذلك الوقت، تم تعريف التراث من منظار مادي بحت يقوم على الوقائع الحسية فقط، وهو ما تأثر بأفكار جمعيات الآثاريين (antiquarian societies). وبالتالي فإن القيمة التاريخية والجمالية لأي مكان شكلت المحدِّد الأبرز لقيمته الثقافية وسيطرت على تعريفنا للتراث العمراني وفهمه حتى وقتنا الحالي.
عند الرجوع إلى المواثيق الخاصة بنظرية الحفاظ المعماري، دائماً ما نتوقف عند القاعدة الناظمة لهذه النظرية وهي حماية الأهمية الثقافية (statement of cultural significance) لمبنى أو موقع معين. فعلى سبيل المثال عرف ميثاق بورا (Burra Charter) لعام 1999 الحفاظ المعماري بأنه عملية الاعتناء بمكان معين بغرض حماية أهميته الثقافية والحفاظ عليها. يقترح هذا التعريف أنه، لكي نحمي مكاناً ما، لا بد أن تكون له أهمية ثقافية معينة تميزه عن غيره من الأماكن. لكن ما الذي يعرّف الأهمية الثقافية، وكيف يمكن قياسها؟ قادت هذه الأسئلة إلى تطوير نظام لتقييم الأماكن، الأمر الذي نقل حماية وحفظ مبنى أو موقع ما من فعل تقليدي واستجابة طبيعية لتدهور حالته الفيزيائية إلى فعل ممنهج وحركة ثقافية ذات بعد نخبوي تستند على أفكار روادها. أحد هؤلاء الرواد كان وليام موريس (William Morris)، والذي رأى أن قرار حماية مبنى معين لا بد أن يتخذه أناس ذوو خلفية ثقافية وفنية. شكلت هذه العقلية الانتقائية حجر الأساس لحركة الحفاظ المعماري، ناقلةً قرار حماية وترميم البيئة المبنية من مالكي المكان وقاطنيه إلى الجهات الرسمية.
إن اعتماد الانتقائية في حركة الحفاظ المعماري، واحتكار قرار الحفاظ بيد قلة نخبوية، أدى إلى تحييد السكان في عملية الترميم وإعادة البناء، وإلى سلب حقهم الطبيعي في إدارة بيئتهم العمرانية وصنع القرار الخاص بها. كما أدى إلى فصل الارتباط العضوي ما بين المبنى وساكنه، وإلى كسر عفوية وسلاسة النمو الطبيعي للمدن. ففي تدمر، نجد أن المدينة شهدت الكثير من التغيرات العمرانية والمعمارية التي عكست المناخ الاقتصادي والسياسي والاجتماعي السائد في كل فترة زمنية، فمعبد بِل تغير استخدامه إلى كنيسة خلال القرن الخامس، ثم تحول إلى جامع في القرن الثاني عشر، وأخيراً إلى قرية تؤوي المئات في القرنين الثامن والتاسع عشر، قبل أن يتحول إلى صرح تاريخي ومَعلَم سياحي. كما أن آثار المدينة وأحجارها أُعيد تدويرها واستخدامها بشكل عفوي حسبما دعت حاجة ساكنيها، فاكتسبت قيمتها من خلال توظيفها لخدمة الأهالي.
من جهة أخرى، هل يمكن اعتبار أية عملية تدمير للمواقع التاريخية كجريمة ضد الإنسانية وعملية تطهير ثقافي؟ ماذا عن التدمير المنفذ بأداة الحفاظ المعماري نفسه؟ بالعودة إلى حالة تدمر، وبالتركيز على معبد بِل وتتبّع تاريخه، نجد أن المعبد كان قد تعرض للعديد من عمليات التغيير في بنيته المعمارية والوظيفية. لعل أكبر هذه التغييرات وأكثرها قسوة كانت على يد الآثاريين الفرنسيين مطلع القرن العشرين، عندما احتضنت جدران المعبد آخر قرية تدمرية مبنية من الطوب الطيني على الطراز العثماني. في ذلك الوقت، سعى الآثاريون الفرنسيون إلى الحفاظ على ما اعتقدوا أنه يمثل وحدة الطراز المعماري (unity of style) متأثرين بأفكار المعماري فيوليه لو دوك (Viollet-le-Duc)، فاعتبروا أن القرية اعتداء على حرم المعبد. وهكذا قاموا بهدمها وتهجير أهلها إلى قرية مستحدثة خارج حدود المدينة الأثرية، الأمر الذي أدى لتحويل تدمر، وللمرة الأولى في تاريخها، من مدينة مأهولة يعيش قاطنوها داخل أبنيتها وبتناغم مع آثارها إلى متحف عمراني وأطلال خالية من الحياة. في هذا المثال نجد أن الحفاظ المعماري تحول من أداة حماية إلى أداة تدمير للمكان وتهجير لأهله.
هل التراث تاريخ فقط؟
تقودنا العلاقة الهرمية بين إعادة الإعمار وحركة الحفاظ العمراني من جهة، والطبيعة المادية والانتقائية التي تحكم نظرتنا للبيئة العمرانية من جهة أخرى، إلى الإشكالية الثانية.
فمنذ الأيام الأولى للحديث عن إعادة الإعمار، تم تصنيف النسيج العمراني المستهدف إلى نسيج تاريخي وآخر غير تاريخي. حظي الأول باهتمام المجتمع الدولي والمؤسسات والجهات الحكومية وأيضاً عامة الناس، فالجميع اتفق على ضرورة الاعتناء بالمواقع الأثرية في تدمر وحلب وحمص. وانهالت الدراسات والمقترحات من جميع المكاتب والهيئات المختصة، ودارت النقاشات واحتدّت حول الطريقة الأمثل لإعادة الإعمار، والتي يمكن تبسيطها بين مقترحين: ترك الآثار المدمرة شاهدة على ما حصل، أو إعادة بنائها كصورة عن حالتها قبل الدمار. لم يقدم المقترحان أي جديد في النظرة إلى المواقع التاريخية، حيث تمت مقاربتها من منظار طوباوي ومادي، وكأنها قطع أثرية تحتاج إلى الإصلاح. لست هنا بصدد مناقشة تعقيدات إعادة إعمار المناطق التاريخية، لكن لا بد من استخدامها للإضاءة على نوعية الاهتمام التي حظيت به تلك المناطق بالمقارنة مع المناطق غير التاريخية.
في الطرف الآخر، تم تسليم ملف المناطق غير التاريخية، وخاصة المناطق الفقيرة وغير المنظمة، إلى شركات التطوير العقاري المستحدثة على عجل من قبل البلديات وأصحاب النفوذ والمال. وتم استصدار عدد من المراسيم والقوانين لتوفير الخلفية القانونية لأية مشاريع مقترحة. تحمّست بعض المكاتب والشركات الهندسية المحلية والإقليمية لتقديم المقترحات العمرانية، وغصت مواقع التواصل الاجتماعي بتصورات مستقبلية لمناطق مثل تنظيم خلف الرازي غرب دمشق. تعاملت المقترحات المقدمة مع المناطق المتضررة كمساحات خالية من الأرض، يصول فيها المخططون ويجولون دون ضوابط أو حدود، ويمسحون المعالم المكانية لهذه المناطق كأنها لم توجد أصلاً. قدمت المقترحات الجديدة صوراً معمارية وعمرانية مستمدة من عمارة ما بعد الحداثة الخليجية (عمارة دول الخليج العربي في تسعينيات القرن العشرين وحتى وقتنا الحالي)، والتي ربما تخدع العين الغرّة وترسم سراباً لمدينة حديثة تنبثق من ركام الحرب. إلا أن تطبيق هذه المخططات، إن حدث، سيجعل من عودة الأهالي إلى أحيائهم بحكم المستحيل، بل إن مفهوم العودة هنا يصعب تخيله، فإلى أين تكون العودة، ولا منزل ولا حارة ولا دكان يُستدَل به؟ والعودة إن حصلت فستكون لمكان غريب بلا ذاكرة.
سواء كعملية تطوير عقاري أو كعملية حفاظ معماري، يتم النظر إلى إعادة الإعمار كعملية مادية بحتة، بلا أي بعد سياسي أو اجتماعي، وتتحول من وسيلة لتثبيت المصالحة والسلم الأهلي إلى جزء من الصراع نفسه.
إن الهدف من طرح الإشكالية السابقة هو الإضاءة على أهمية أي مكان، بغض النظر عن عمره أو قيمته المادية، فحتى في حال تصنيف الأماكن إلى مهم وغير مهم فإن هذه المفاضلة تقوم على طرفين لا يمكن إدراك أحدهما دون وجود الآخر. وبالتالي، حتى من وجهة نظر انتقائية تصبح كل الأماكن مهمة. هنا لا بد من التمييز بين المكان والفضاء، فالمكان بالتعريف هو فضاء ذو معنى، والمعنى يُكتسب من خلال التفاعل بين الناس والفراغ، وهو التفاعل الذي يحتاج إلى حيز زماني – بالإضافة إلى حيزه المكاني – كي يتحقق. بعض الأماكن لها أثر جمعي وتلمس حياة عدد كبير من الناس، كالمدارس والساحات العامة والأسواق؛ وبعض الأماكن لها أثر فردي كالمنازل، وبتفاعل هذه الأماكن مع بعضها البعض تتكون بيئتنا العمرانية وترتبط بها ذكرياتنا.
من جهة أخرى فإن إدراكنا للقيم غير الحسية، كالأثر الاجتماعي أو السياسي والقيمة الرمزية لمكان ما نتيجة ارتباطه بذكرى معينة، أدى إلى الدعوة إلى إدراج مجموعة من الأبنية والمواقع تحت مظلة التراث الثقافي رغم افتقارها للبعد التاريخي، الأمر الذي أدى لاحقاً لظهور مفهوم التراث الحديث. تظهر إشكالية الزمن لدى التمعن في معنى هذا التعبير، فعلى سبيل المثال، كيف يمكن أن نقيّم التراث الحديث؟ ومتى يمكن إطلاق تعبير «تراث» على عمل ما؟ فالإرث بالتعريف هو القيمة التي تُمرَّر من جيل مضى إلى جيل حاضر. لكن كيف يمكن أن نقيّم تراث جيل لم يمضِ، كعمل فنان لم يمت أو كتقاليد مجتمع ما زال قائماً؟ أين يمكن رسم الخط ما بين الماضي والحاضر، وما بين التقليدي والحديث، وهل يجب أن نرسمه في بادئ الامر؟ حاولَت كل من منظمة البيئة التاريخية في اسكتلندا وإنكلترا الإجابة على هذه الأسئلة من خلال تحديد إطار زمني يتم من خلاله تقييم عمل ما، أي في حال تجاوزه لعمر معين لا يقل عن الثلاثين عاماً، بينما حُدّد الإطار الزمني في كندا بأربعين عاماً.
أمام هذا المنطق المتضارب في فهم التراث الثقافي، يمكننا المجادلة بأن محاولات تقييم التراث العمراني وغير العمراني لم تستطع حتى الآن الوصول إلى صيغة منطقية محددة يمكن من خلالها البت بأهمية مكان ما. كل مكان – بغض النظر عن قيمته التاريخية أو الفنية – يحمل قيمة معنوية معينة. ولا يمكن إنتاج هذه القيمة بشكل مادي فقط، إنما تنمو وتتطور من خلال إشغال شخص أو جماعة لهذا المكان، كما أن إدراكنا لها يختلف باختلاف موقعنا من المكان كمستخدمين له أو كمراقبين. فالمكان كمفهوم يتوسط بين عالمين، فيزيائي، ملموس ومادي من جهة؛ ومجرّد، مُدرَك وروحي من جهة أخرى.
عن أية «إعادة» نتحدث؟
إن لمناقشة ما سبق أهمية بالغة، خاصة في ظل الحديث المتزايد عن إعادة الإعمار في سوريا، الأمر الذي يطرح الإشكالية الثالثة. فالجميع يعلم أنه عادةً ما يُعوَّل على إعادة الإعمار كأداة لترسيخ المصالحة والسلم بعد أي نزاع أو حرب. وإذا ما تغاضينا عن العيوب الكبيرة التي تشوب الرؤية الحالية لإعادة الإعمار في سوريا، أي افتقارها للبعد السياسي والاجتماعي المستند إلى مرحلة عدالة انتقالية وصلح اجتماعي، وحاولنا فقط التركيز على بعدها التقني، سنصطدم أيضاً بمجموعة من الجدران التي تمهد لمرحلة أعمق وأطول من النزاع والصراع والمظالم.
على سبيل المثال، بعد مرور أكثر من عشرين عاماً على نهاية حرب البلقان، لم تستطع إعادة الإعمار تحقيق أي مصالحة حقيقية. فباستثناء رمزية إعادة بناء وسط مدينة موستر، لم يتم إحراز أي إنجاز على مستوى التسوية الأهلية والاجتماعية هناك. في مثال آخر، والذي قد يكون الأقرب إلى الحالة السورية، نجد أن إعادة إعمار بيروت قامت بترسيخ الانقسام في المجتمع اللبناني، بل وعززتها مكانياً من خلال رسم حدود واضحة بين شرق المدينة المسيحي وغربها المسلم. فبعد توقيع اتفاق الطائف عام 1989، قامت الطبقة السياسية الحاكمة، والمشكَّلة بأغلبها من أمراء الحرب نفسهم، باستعجال إعادة الإعمار للالتفاف على عملية المصالحة الحقيقية. ففي ذلك الوقت لم تكن نهاية المعارك تعني نهاية الحرب. وقد عكست إعادة اعمار بيروت المناخ السياسي في لبنان القائم على المحاصصة، حيث تم تقسيم المدينة إلى ثلاثة قطاعات (القطاع الجنوبي، القطاع الشمالي، ووسط بيروت التجاري)، ليتولى القطاع الخاص الجزء الأكبر من عملية التخطيط والتنفيذ، وهو ما حيّد دور أهالي المدينة في المساهمة في إعادة بناءها. شكّل وسط بيروت التجاري المنطقة الأكثر حساسية نتيجة موقعه الجغرافي ودوره الأساسي كجامع لمختلف طبقات وأطياف المجتمع البيروتي واللبناني، وأيضاً لدوره الاقتصادي. عكست خطة إعمار وسط بيروت رؤية رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري في تحويل الوسط التجاري إلى مركز اقتصادي ومالي في الشرق الأوسط. وقد أدى تطبيق هذه الخطة إلى إعادة رسم حدود الملكية، في منافسة غير عادلة بين الملاك الصغار وشركات التطوير العقاري، كما أدى إلى تغيير واقع المكان ودوره في الذاكرة البيروتية وتحويله من ملتقى شعبي إلى كانتون مالي نخبوي. يمكن القول إن إعادة إعمار وسط بيروت قامت – بشكل متعمد أو غير متعمد – بإعادة إنتاج «صورة» المدينة وليس المدينة نفسها، وذلك بالتركيز على العامل البصري وباستخدام العمارة والتخطيط المديني كأداة لرسم الواقع المادي الجديد للمكان. إن التحول السريع في المشهد العمراني للمدينة حرم أهالي بيروت من فرصة تكوين أي ارتباط معنوي مع المنتج العمراني المستحدث، وما يزال البيارتة يتحدثون عن الوسط التجاري وأسواق بيروت الغائبة، والتي كانت هناك يوماً ما.
على الرغم من التطور الحاصل في فهم نظرية الحفاظ المعماري، والأهمية المتزايدة المعطاة للتراث غير المحسوس، إلا أن هذا التطور لمّا ينعكس على مفهوم إعادة الإعمار، والذي تعرّفه حركة الحفاظ المعماري على أنه عملية إعادة المكان إلى صورته الأصلية مع التمييز بين الأصل والإضافة. يتناول هذا التعريف الصورة المادية والمحسوسة للمكان دون أي إشارة إلى قيمته المعنوية أو الاجتماعية. فما الغرض من إعادة بناء صورة مكان ما دون بناء العلاقة التي تربطه مع قاطنيه؟ تسمى هذه الإشكالية مشكلة الفراغ (problem of space)، وهي تناقش كيفية الربط ما بين المكان كبعد فيزيائي وملموس وما بين المجتمع كبعد مجرد. تطرح مناقشة إعادة الإعمار من هذه الزاوية سؤالاً عن كيف يمكن لإعادة الإعمار أن تقوم بإعادة إنتاج القيمة المعنوية للمكان المدمّر.
*****
ي.ب: مهندس معماري سوري. باحث في مجال تاريخ العمارة.
تفييش، تفتيش، تعفيش/ تميم إمام
في تشرين الأول 2007، أعلنت الحكومة البريطانية عن تطبيق برمجية هي الأولى من نوعها، تقوم على التحقق من الأشخاص الداخلين إلى أراضيها بشكل أوتوماتيكي عبر ما يُسمى بـ«الحدود الإلكترونية». بُنيت هذه البرمجية على خوازرميات رياضية معقدة، تعتمد البحث العميق أو «التنجيم» في بيانات الأشخاص على الإنترنت بهدف البحث عن أية شبهة أو سبب للشك في الداخلين عبر هذه الحدود. هذه الاستراتيجية، التي اندفعت كثير من الدول بعد ذلك لاتباعها، وُصفت بأنها «اعتماد على أحداث الماضي لتفادي الأخطار المحتملة التي قد تأتي مع الوافدين إلى هذه الحدود في المستقبل». تعتمد هذه البرمجية بشكل أساسي على سلوك الأفراد وبصماتهم الإلكترونية المسجلة على الإنترنت، والمجالات التي نشطوا فيها، وما إذا كانت لهم سوابق إجرامية أم لا. فالداخل إلى هذه الحدود غير موجود على نظامها أو في سجلّاتها، وبالتالي يجب التأكد منه بالطريقة المذكورة.
وهكذا، ليس غريباً ما يحدث في سوريا منذ 2011، إذ يمكن القول إن الحدود والحواجز في سوريا تقوم بالعمل نفسه مع فارق بسيط: أن نظام البحث لا يكترث بمن هو جديد، بل يركز بحثه في بيانات السوريين الموجودين مسبقاً في سجلاته، ويفتش فيما إذا كانت تحوم حولهم شبهة الاضطلاع بنشاط سياسي. تعتمد السجلات الأمنية منذ عقود على استخباراتها في تحديث قوائمها وتوزيعها على نظامها الداخلي، الذي تتشاركه على كافة الحدود الخارجية، والتي ما لبثت أن تمدّدت إلى الداخل لتفصل بين المدن والبلدات بعد انطلاق الثورة السورية على هيئة حواجز عسكرية.
يعود تاريخ الدولة الأمنية في سوريا إلى الخمسينات. ابتدأه رئيس المخابرات آنذاك عبد الحميد السراج، عندما نظم جهازي الشرطة والأمن، اللذين أصبحا أساس الدولة البوليسية في سوريا. مع مرور الوقت، وصولاً إلى استلام الأسد للسلطة، تطورت الأجهزة الأمنية وتعدّدت، ومُنحت صلاحيات واسعة وأذرعاً متطاولة تتدخل في جميع جوانب الحياة للسيطرة عليها والتحكم بمفاتيحها. فقد تم تقسيم المدن مناطقياً بين الأفرع الأمنية، فيما سيطرت الفرق العسكرية على المناطق خارجها. فمثلاً، عند الحديث عن دمشق، يمكن القول أن الفرع المسمى «فرع الخطيب» سيطر على شارع بغداد والقصاع، وأصبح يتحكم في كل شاردة وواردة فيهما، وأضحت تلك المناطق تتبع لأوامره وتتحرك تحت عيونه المزروعة في الأكشاك ومخبريه الذين في الشوارع. وكذلك الأمر بالنسبة لما عُرف بـ«فرع فلسطين» لاحقاً، التابع لجهاز الأمن العسكري، عندما سيطر على المناطق الواصلة من دوار المطار إلى مخيم اليرموك، مروراً بالزاهرة والصناعة والطبالة.
أدى ذلك التقسيم إلى تفرّد وسيادة الأفرع الأمنية، كلٌّ في منطقته، على مبدأ «فرّق تسد»، ليتغلغل كل منها في الحياة اليومية للسوريين، ويشترط عليهم طلب الموافقات الأمنية لكل نشاط تجاري أو صناعي، حتى على صعيد استئجار منزل أو محل أو فتح بسطة لبيع الدخان. ذلك التقسيم المساحي للسلطة بين الأجهزة الامنية وفروعها، تجسّد بعد الثورة في الظهور العلني لحواجز أمنية يمتزج فيها العسكري بالمدني – كلٌّ على أرضه أيضاً – خلال الحياة اليومية، على الطرقات والطرق السريعة، وفي أبنية الدولة وعلى أبواب مؤسساتها.
مدينة دمشق، التي ستكون موضع تركيز هذا المقال، شهدت حضوراً عسكرياً كثيفاً، وتأثرت أنماط الحياة والسكن في أبنيتها والتنقل والحركة في شوارعها. من هنا يحاول هذا المقال فهم ما قد تتسبّب به الحواجز، المتمثلة ببعض السواتر الإسمنتية والجنود المسلحين، من تأثير على البيئة العمرانية والحياة المدينية. وسيستعرض أولاً تاريخ الحواجز وسبب نشوئها، بالتركيز على مدينة دمشق كونها «الأكثر أمناً»، وكوني عشت فيها طوال فترة دراستي الجامعية.
الحواجز كإعلان حرب
بعد الشهر السادس من الثورة، بدأ تشكيل وتنظيم كتائب الجيش الحر، والتي أدت شيئاً فشيئاً إلى خروج عدد من المناطق والمدن السورية عن سيطرة النظام. انتشرت المظاهرات في بعض أحياء العاصمة، واندفع النظام إلى حماية مناطق سيطرته عبر تعزيز حضوره الأمني والعسكري داخل المدينة وحولها. بدايةً، فرض النظام وجوده في شوارع المدينة بالدوريات الأمنية المؤقتة (الطيارة) التي كانت تعترض الطريق لساعات معينة باليوم، خصوصاً على الطرق المؤدّية إلى المدن والبلدات الثائرة، كالطريق الواصل إلى داريا بعد كفرسوسة، أو على طريق برزة، أو عند مداخل حي الميدان وأبو حبل. وكان ذلك الحضور أكثف بعد مظاهرات أيام الجمعة أو بعد تشييع الجثامين. ثم ما لبثت هذه الحواجز الطيارة أن استُبدلت بعد فترة بمتاريس ترابية أو إسمنتية وعدد من عناصر الأمن أو الجيش المتمركزين بقربها بصفة دائمة، وهو ما أصبح يسمى بالحاجز.
انطلقت كل تلك الحواجز، الطيارة منها والثابتة، من وظيفة رئيسية هي إيجاد المطلوبين للأفرع الأمنية عبر «تفييش» الهوية، أي مسح الباركود الموجود على بطاقة الهوية، والتي يُعاقب بشدة من يفقدها أو ينساها. ثم بعد تدخل الجيش في المعركة وبدء كثير من الشبان بالتهرب من الخدمة العسكرية الإلزامية امتدت عملية البحث لتشمل إيجاد المطلوبين لهذه الخدمة. ثم ما لبثت وظيفة الحواجز أن تطورت، لتضيف التفتيش الدقيق لكل ما يمر من خلالها عبر الأجهزة الكاشفة للأسلحة والمواد الكيميائية والأدوية؛ أو لتمنع الحركة بشكل كامل عن منطقة معينة، أو تسمح بالمرور المشروط لبعض الناس وبعض حاجيّاتهم وفقاً لجنسهم وعمرهم. وكل ذلك يعتمد بشكل أساسي على طبيعة المنطقة الأمنية ونشاطها الثوري، وما يستتبع ذلك من تعليمات أمنية.
إن التحرك بين المناطق السورية محكومٌ بالطبيعة الأمنية لهذه المناطق ونوع الحواجز الموجودة فيها، سواء كانت تلك المناطق تحت سيطرة النظام أم خارجها. أصبح كل وجود عسكري جديد بعد 2011، سواء كان حائطاً إسمنتياً أم مجموعة من الجنود، يسميه السوريون حاجزاً، فلا يسعهم التمييز بين هذا الحاجز أو ذاك سوى بتبعيته لفرع أمني ما أو لضابطٍ معروف بقيادته لهذه المنطقة. ولكن عند النظر لما تسببه هذه الحواجز من عرقلة للحركة في المدينة من الناحية العمرانية، ولعواقب تلك العرقلة على الحياة المدينية، يمكن تصنيف الحواجز العسكرية مجازياً ضمن ثلاثة أنواع: حواجز مفتوحة؛ حواجز مغلقة؛ وحواجز نصف مغلقة. يتغير تصنيف كلّ حاجز بتغير الزمن، ويتعلق بتطور الأوضاع الأمنية في المنطقة التي يقع فيها، وهو ما يمكن اعتباره بديهياً للسوريين المتابعين للواقع الأمني اليومي والمُعايِشين لنتائجه. ولكن هذا التصنيف سيساعد في تبسيط وفهم الحياة المدينية، وكيف كانت طبيعتها مشروطة بهذه الحواجز وأسباب إنشائها. ولهذا قد تكون الأمثلة تبسيطاً لحالات أكثر تعقيداً، أو قد تُغفِل بعضاً من جوانب الأثر الأكبر لهذه الحواجز.
لو بدأنا بالحواجز المغلقة، فهي بالتعريف جدران إسمنتية أو أهرام ترابية تُقام حول منطقة معينة بقصد فرض الحصار عليها، وتَمنعُ أي تفاعل بينها وبين محيطها، بما في ذلك خروج المدنيين المقيمين في فضائها منها أو دخول آخرين إليها. وعلى المدنيين داخلها أو خارجها أن يتجنبوا التّماس مع الحواجز المغلقة كلياً، لأنهم قد يتعرضون للقنص أو للاعتقال. ولذلك فإن أثر هذه الحواجز على البيئة العمرانية التي تحاصرها لا يمكن استيعابه بشكل كامل بمعاينتها من الخارج، فقد شكلت عازلاً يمنع مَن هم أمامَه أن يروا أو يعرفوا ما يجري وراءه أو يقدّروا ما يخلّفه على البيئة المدينية ككل كانت الفظائع المرتكبة بحق البيئة العمرانية في هذه المناطق سبباً إضافياً لتأزيم الوضع الإنساني، المتأزّم أصلاً جرّاء الحصار. فعلى سبيل المثال، كان قطع الخدمات والكهرباء عن مشافي المناطق المحاصرة من أبرز عوامل التأزيم الواردة في التقارير الإنسانية المأساوية من داخل تلك المناطق. أضف إلى ذلك أن التجمعات السكانية التي خلقتها تلك الحواجز، ناهيك عن الممارسات الإجرامية، أنشأت جدار عزل عنصري مبنيّ على أساس هوياتي، وهو ما أدى إلى حرمان السكان من حقهم في التنقل عبرها، فأصبحت مناطقهم أشبه بسجن يستعصي على زائريه أكثر من سجن عدرا. لقد أدت هذه الحواجز والسياسة المتّبعة عبرها بحق السكان إلى خنق المناطق التي تطوّقها، وإلى منع أي نشاط اقتصادي يساعد في تخفيف حدة الحصار على أهلها، ما دفعهم للاعتماد على ما توفره الأرض من حولهم، أو على ما يتمكن تجار الحرب من تزويدهم به بأسعار تفوق الخيال. ولا يمكن إهمال ما فعلته الحواجز بالأراضي والعقارات في محيط هذه المدن المحاصرة، والتي تناقصت قيمتها السوقية بسبب استحواذ الحواجز عليها أو قربها منها.
المدينة المقطّعة
لست بصدد التفصيل في أثر الحواجز المغلقة، لأنني لم أكن يوماً داخلها أو بقربها، ولا بقرب الحواجز نصف المغلقة؛ أي تلك التي، رغم قيامها بوظيفة حصار مدينة ما، تسمح ببعض الحركة المشروطة عبرها في حال وجود هدنة بين الطرفين. ففي بعض هذه الحالات، يسمح الحاجز للمدنيين بالدخول والخروج المشروط في ساعات معينة، وقد يفرض رسوماً على المواد الغذائية المدخَلة إلى هذه المنطقة. من هذه الحواجز حاجز مدخل مدينة التل حتى عام 2017، وحواجز مداخل مدن الغوطة عام 2012، والتي كان عناصرها يطالبون أيضاً بإبراز فواتير الكهرباء والمياه للسماح لأصحابها بالدخول والخروج.
ما سيتم تفصيله باستفاضة في هذا المقال هو الحواجز المفتوحة الموجودة في قلب مدينة دمشق وعلى أطرافها، والتي شكلت جزءاً أساسياً من الحياة اليومية للمارّين عبرها. وبالرغم عدم منطقية اسمها – فالحجز يفيد الإغلاق والمنع التام – كانت «الحواجز المفتوحة» تسمح بالحركة عبرها بعد التفتيش والتفييش. وهي موضع الحديث الأوسع باعتبارها الأكثر احتكاكاً مع عامة السكان، والأكثر شيوعاً وانتشاراً، حيث تتواجد في قلب كل المدن والبلدات الخاضعة لسيطرة النظام. في عام 2017 تم تقدير عدد الحواجز في مدينة دمشق لوحدها بنحو 287 حاجز، تتوزع في شوارعها وأزقتها أو على أبواب بعض مبانيها الحكومية، للقبض على المطلوبين أمنياً أو عسكرياً وللتحقق من المركبات والحقائب.
إن سبب هذا العدد الغفير هو السعي للتحكم بكل ما هو متحرك في المدينة، فكل حاجز يُنشأ، يقود بالضرورة لإنشاء حواجز أخرى لإجراء عمليات التحقق. بعبارة أخرى، يؤدي إغلاق طريق واحدة لزيادة كمية الحركة على الطرق الأخرى، وبالتالي يستلزم إنشاء حواجز جديدة عليها لإحكام مراقبة تلك الحركة المتزايدة، وهذا بدوره يدفع المركبات والمدنيين إلى شوارع جديدة لم تُغلق أو يُنشأ عليها حاجز بعد، وهكذا دواليك. وقد شلّ تكاثر الحواجز هذا انسيابية الحركة داخل العاصمة، فمن النادر جداً أن يخلو شارع ما من أية حواجز. كما أدى ذلك إلى ما يشبه كاميرات مراقبة بشرية ذات سلطة، تتحكم في حركة السكان ضمن نسق يضمن على الدوام مرورهم من طرق معينة، من خلال حواجز لا يمكن تجنبها، ما يضعهم تحت المراقبة على مدار الساعة، ومن دون الاكتراث لما قد يخلّفه ذلك من نتائج على حيواتهم.
على سبيل المثال، عندما تم إغلاق دوار كفرسوسة القريب من «فرع المنطقة» لمنع الاقتراب منه، تحوّلت خطوط المواصلات – كخط الدوار الجنوبي وخط مهاجرين-صناعة – لتمرّ من شارع الفحامة، الذي يستقبل المواصلات من جانب المجتهد ومن أوتوستراد درعا، ما أدى لنشوء طوابير طويلة في انتظار المرور عبر حاجز الفحامة. وهكذا أصبحت رحلة الذهاب إلى العمل أو الجامعة تستغرق وقتاً أطول من المعتاد، وزاد العبء المالي أيضاً على الذين يترجّلون من الباص ليأخذوا باصاً آخر بعد تجاوز الحاجز.
أدى ذلك التلاعب المفتعل في تيارات الحركة لأسباب أمنية إلى تشكيل ازدحام مروري شديد، كانت له آثار اقتصادية سلبية على وسائل المواصلات. فقد دفع ذلك الزحام أصحاب الباصات الصغيرة – «المكاري» – للتوقف عن العمل في ساعات الذروة، فالانتظار الطويل على طابور الحاجز يعني بالنسبة للسائق خسارة للمال. وبدلاً من 20 رحلة من أول الخط لآخره أضحت يوميته مقتصرة على 10 رحلات نتيجة أوقات الانتظار على الحواجز. وبهذا بررت الحكومة حلّها المقترح لمشكلة تناقص وسائط النقل، حيث فتحت المجال للشركات الخاصة لجلب باصاتها الكبيرة العاملة في كل الأوقات، والتي تستوعب أعداداً كبيرة مقارنة بالميكروباصات التي تستوعب 14 راكباً على الأكثر. أصبحت هذه الشركات تحصل أيضاً على امتيازات الوقود الرخيص من خلال عقودها مع الحكومة، في الوقت الذي كان يقضي فيه أصحاب الباصات الصغيرة 3 ساعات كل صباح على طوابير تعبئة الوقود.
صناعة الغرباء
تقوم العلاقة بين الحاجز العسكري والمدنيين أساساً على الشك المتبادل. فكل مدني يمرّ على الحاجز هو متّهم أو متهرّب من الخدمة حتى يثبت العكس. ولذلك يقوم الحاجز بالتدقيق في بيانات المارّين لإيجاد من «يشكلون خطراً على الأمن» حسب زعم السلطات. وبالنسبة لفاقدي بطاقة الهوية، التي تعد بمثابة جواز سفر داخلي، فيتم إيقافهم على ذمة التحقيق. وبالعكس، يغلب التوتر على المدنيين المارّين من الحاجز، فهو مكان عسكري معزول بسلطة مطلقة، وقد يقود أمر بسيط مثل تشابه الأسماء إلى الاعتقال، في الوقت الذي يتعذر فيه استعمال الهاتف أو طلب المساعدة. ولذلك فإن حالة الترقب وعدم اليقين تتملك الطرفين على مدار الساعة. غير أنه في حالة مدينة كدمشق، العاصمة التي تشكل بيئة عمرانية حاضنة لتنوع كبير جداً، يصعب تحديد ما هو الخطر الواضح، وقد تأخذ عملية تحديد الخطر وفلترته أبعاداً جديدة. إذ يمكن لعوامل بسيطة أن تكون مدعاة للشك والقلق لدى عسكريي الحاجز، ولذلك يبدأ الحاجز بالشك من اللحظة الأولى. ابتداءً من شكل السيارة القادمة من بعيد – شاحنة أم بيك آب أم سيارة فاخرة – وصولاً إلى بطاقة الهوية، والتي تعطي فكرة واضحة عن ماهية الشخص: إذ سيعرف الجندي من خلالها معلومات عن مكان ولادته ونشأته وطائفته والثقافة السائدة في منطقته، فلو كان رقم الخانة على الهوية أو نمرة السيارة من منطقة خارجة عن سيطرة النظام، ستزداد دقة التفتيش، وتالياً يزداد وقت الانتظار على الحاجز بالنسبة للشخص المعني، وكذلك بالنسبة لمن يقفون خلفه بانتظار دورهم. يضاف إلى ذلك الشكل والمظهر الخارجي، الذي قد يسبب انتظار المواطن لساعات للتحقيق معه بحجة أنه ليس من أهل المنطقة ولا شأن له يقضيه فيها. فليس باستطاعة كل من يمرّ من حاجز العباسيين إلى قلب المدينة، مثلاً، أن يمر من الحاجز الواصل بين ساحة الأمويين والمالكي – حاجز مشفى الشامي – حيث يقطن أهم مسؤولي النظام.
يحتاج الحديث عن النظرة الدونية الطبقية هذه أبحاثاً مطولةً لشرحها في المجتمع السوري. لكنني سأكتفي بالقول إنه لا يمكن لشخص بلباس قرويّ وبلهجة ريفية أن يمرّ من معظم الحواجز القريبة من المهاجرين أو المزة جبل أو المزة 86، لكونه ببساطة لا يتماهى مع سكان المناطق المارّين إليها بشكل يومي، وبالتالي لا مبرر لعبوره من تلك الحواجز. هذه المساءلة، المأخوذة بنظرة مسبقة لأبعاد مظاهرية ومناطقية ودينية، خلقت منظومة فلترة قائمة على سياسات هوية مجحفة، ومنعت كثيراً من المدنيين من التحرك بحرية في فضاءات المدينة العامّة، وحرمتهم من الوصول إلى مساحاتها وفرص العمل فيها، بل ووصل الأمر حدّ تجريمهم واعتبارهم خطراً على الموجودين وراء تلك الحواجز.
أدى كل ذلك إلى خلق ما يشبه مستعمرات سكانية معزولة داخل المدينة، تتّسم كل منها بهوية معينة وانتماء طبقي اجتماعي معين، تقوم عدة طبقات من البوابات (الحواجز) على حمايتها من بعضها البعض. لا تشبه أيّ من الطبقات تلك التي تليها أو تسبقها في هويتها السياسية أو في وضعها الاقتصادي والاجتماعي، بل إن الوصول من طرف العاصمة إلى قلبها أصبح يشبه الوصول من قشرة البصلة إلى لبّها، ويتطلّب المرور عبر كل تلك البوابات التي تُفَلتِر الهويات شيئاً فشيئاً وتمنع المشبوهين وغير المرغوب بهم من الدخول.
وبالمقابل، أدى ازدياد أعداد النازحين في أطراف المدينة، وهي المناطق التي يسهل الوصول إليها والعمل فيها، إلى اختلال الكثافات السكانية بين مناطق دمشق، مما سبب تضخماً مزدوجاً في أسعار سوق العقارات. وقد لا يكون هذا التضخم مفهوماً لكثيرين، فكيف يمكن لأسعار العقارات أن تتضخم في ظل الحرب والنزاع؟ ومن الذي يرغب أصلاً في أن يشتري أو ينافس على العقارات الموجودة في أخطر بلدان العالم؟
لكن من جهة أولى، كان احتكار قلب العاصمة من قبل شريحة معينة من المقتدرين مالياً والموثوقين أمنياً، بالإضافة لمكاتب السفارات والمنظمات الدولية، قد أدى إلى رفع السوية الطبقية لهذه المناطق بين تجار العقارات بأكثر مما كانت عليه سابقاً، وبالتالي رفع سعرها وأسعار الاستئجار فيها، خاصة وهي محمية بعدد كبير من البوابات العاملة يومياً على استبعاد الغرباء. فسعر الشقة في حي المالكي، مثلاً، ارتفع إلى أكثر من نصف مليار ليرة سورية (أكثر من مليون دولار) عام 2017. هذا بالإضافة إلى أن هذه المناطق لم تتأثر بالحرب فيزيائياً ولا خدمياً، وأن لها الأولوية في الحصول على أكبر حصص من الكهرباء والمياه، على عكس الجانب الآخر من المدينة. فبالإضافة لكونها مناطق ذات كثافة سكانية عالية وخدمات سيئة، كان البعض يتوقع انخفاض الأسعار فيها، خصوصاً أن معظمها عشوائيات بدون «طابو أخضر». غير أن الطلب المتزايد على السكن من قبل المدنيين النازحين أدى إلى رفع أسعار الاستئجار والشراء فيها، ليكون العرض والطلب هو المبدأ الرئيسي في تقييم العقارات والملكيات.
الهندسة السكانية
لم يتوقف دور الحاجز عند السماح أو عدم السماح لعامة السكان بالدخول إلى منطقة معينة، بل وصل إلى التحكم في مَن يستطيع العيش في تلك المناطق ومن لا يستطيع؛ حتى لو كان مستأجراً منذ ما قبل إنشاء الحاجز نفسه، فالمنطقة بكل الأحوال تحت سيطرة الفرع أو الجهة التي يتبع لها عسكريو الحاجز. مع بداية عام 2013، عندما ازدادت حركة النزوح الداخلي وازداد الطلب على السكن، بدأت الحواجز بتوسيع مجال عملها ليشمل بيوت المناطق المحيطة بها وأسماء الساكنين إلى جوارها، حيث صار الحاجز يطالب المستأجر بإبراز موافقة أمنية من الفرع المسيطر على المنطقة. تتمثل هذه الموافقة بطلب يتقدم به الشخص إلى أقرب مخفر شرطة، ليتم إرساله إلى الفرع والتحقق من معلوماته، وبعدها إما قبول إقامته في في هذا الحي أو رفضها. أصبحت الموافقة الأمنية لاحقاً جزءاً أساسياً من إبرام أي عقد إيجار في كافة أنحاء المدينة، سواء في مركزها أو في محيطها. ولكن مشكلة الموافقة الأمنية هذه أنها غامضة تماماً، فلا يمكن لأيّ شخص أن يعرف سبب الرفض أو سبب الموافقة، مما زاد من التلاعب بمصالح الأشخاص واستغلال حاجاتهم ودفعهم للرشاوى بقصد إتمامها خشية الطرد. وهكذا غدت الموافقة على يحق له السكن في تلك المناطق خاضعة لتفتيشات أدقّ وتحرّيات أوسع داخل الأفرع الأمنية، وأصبح بذلك الحاجز العسكري هو المتحكم في مَن يستطيع الحركة والتجول والعيش في فضائه وفي مناطق سيطرته.
يظهر تأثير الحاجز على المدينة خلال سنوات عديدة في تحويل بنيتها الديمغرافية. فالبحث الدائم عن مطلوبين للخدمة العسكرية دفع معظم شباب البلد إلى الهجرة خارجها تفادياً للتجنيد الإلزامي أو الاحتياطي، كما فرض ضغوطاً كبيرة على من بقي في داخلها؛ فالنقص الشديد في الموارد البشرية في الجيش أدى لطلب المزيد من الشباب الذكور للخدمة الإلزامية، وجعلهم أكثر الفئات استهدافاً من قبل الحواجز، بالإضافة لعدم تسريح من هم في الخدمة منذ سنين. تجلّى ذلك في تفادي وسائل النقل العامة، والتي فرَغت من الشباب في عمر التجنيد الإجباري والرجال في عمر التجنيد الاحتياطي، ليتّجه هؤلاء إلى قضاء رحلاتهم على الدراجات أو مشياً لتفادي التّماس مع أي حاجز. وهو ما دفع النظام للعودة إلى الحواجز الطيارة التي لا يمكن التنبؤ بمكانها، لاعتراض طريق المشاة وراكبي الدراجات وإيجاد من هو مطلوب للخدمة الإلزامية. وقد ترافق كل ذلك مع حضور أقوى للإناث في الشارع والمواصلات العامة ودوائر الدولة، حيث أصبحن أقل عرضة للخطر في ظل الاستهداف المباشر للذكور، وهو ما أدى إلى قلب كثير من الأدوار الجندرية في نمط الحياة المديني.
تتأتى حالة الشك وعدم اليقين نفسها أحياناً من المزاجية العسكرية، التي يقرر فيها الجندي أن يقبل أو يرفض أي مدني مارّ من هذا الحاجز حسب ما يُمليه عليه مزاجه، دون تحقق أي من الأسباب المناطقية أو الطبقية أو الأمنية المذكورة آنفاً. وهو ما كان يدفع الركاب في كثير من الأحيان، خصوصاً الشباب أو الذكور عموماً، إلى الترّجل من وسائل النقل العامة والعبور من طريق فرعي بعيد عن الحاجز تفادياً لأي مشادّة كلامية أو تعنيف لفظي. وفي حالة مستقلّي السيارات الخاصة فلا بد من اتخاذ الاحتياطات اللازمة لشراء رضا العسكري، كباكيت دخان أو علبة متّة، بما يسمح أحياناً بالتملّص من تفييش الهوية وتفتيش السيارة.
الرأسمالية العسكرية
دفعت تلك التصرفات المدنيين لإطلاق التسميات على الحواجز التي يطلب عناصرها عمولة (رشوة) لتمرير أي سيارة منها. فهناك مثلاً «حاجز المالبورو» على طريق دمشق-بيروت التابع للفرقة الرابعة، والذي يطلب باكيت مالبورو من كل سيارة متجهة من وإلى لبنان ليسمح لها بالمرور بسهولة، وإلا يتم ركنها رهن التفتيش لأكثر من ساعة. وهناك كذلك «حاجز المليون» على باب سوق الهال في الزبلطاني، والذي اشتُهر بأن إيراداته تصل إلى مليون ليرة سورية يومياً. والأمر نفسه يسري على الحواجز المغلقة وشبه المغلقة. فالحاجز عند مدخل مدينة التل، المدينة التي عقدت هدنة مع النظام لسنوات، استطاع باستغلال حاجة المدنيين فيها للمواد الغذائية أن يفرض رسوماً على كل كيلو من المواد الغذائية المدخلة طوال تلك السنين، وبلغت الإيرادات اليومية لهذا الحاجز لوحده ملايين الليرات. بل إن عسكريي هذا الحاجز أحضروا ميزاناً تقف عليه السيارات ليتم وزنها وهي فارغة وتسجيل بياناتها، ليتم التأكد لاحقاً ما إذا كان سائقها يخبّئ أي مواد في داخلها دون أن يدفع الرسوم.
أبرز هذه الحواجز تلك التي انشأتها ميليشيات «الدفاع الوطني»، والتي تشكلت خلال سنوات الحرب كقوات رديفة للجيش السوري، وعُرفت بتجنيدها المدنيين عبر إغرائهم بالنهب و«التعفيش» عند الاقتحامات. وبملاحظة العمليات العسكرية إلى جانب القوانين والتحويلات المرورية، يتضح كيف طوّعت السلطة القوانين لإحكام قبضتها، وكيف استغلت كل حالة نزاع لنهب المال العام وإقحام هذا النوع من الحواجز في طريق المارّة وفي حياة المدنيين. فعلى سبيل المثال لا الحصر، عندما استولى تنظيم جيش الإسلام على أوتوستراد حرستا الواصل بين دمشق وحمص، تم تحويل الطريق ليمر من المتحلق الشمالي المعروف بطريق التل، وهو أطول من أوتوستراد حرستا بنحو 45 دقيقة بسبب كثرة الحواجز فيه وطبيعة المنطقة الطبوغرافية، وبدورها فرضت الحواجز المنشأة عليه طريقاً إجبارياً للمواصلات العامة عبر ضاحية الأسد، ليتم إنشاء حاجزين إضافيين للدفاع الوطني قبل الضاحية وبعدها، لا يقومان بأي تفييش أو تفتيش أو تعفيش، بل فقط يأخذون عمولةً على كل سيارة تعبر منهما.
يحتاج استذكار حوادث وممارسات الحواجز في الفضاء العمراني في سوريا وقتاً وشهادات طويلة للشرح والتفسير، وما ورد في هذا النص كان مبنياً على مشاهداتي الشخصية واستماعي للأحاديث التي تدور حول الحواجز بشكل يومي. نستطيع أن نسمّي كل ما سبق بالنموذج السوري الدمشقي لعسكرة المدينة، فلعل المدن الأخرى اتبعت نهجاً مختلفاً في تعاملها مع الحواجز والعسكر. أزيلت الكثير من حواجز دمشق عام 2018 بعد انتهاء معارك ريف دمشق وانتهاء الخطر المزعوم المحدق بها، لكن بينما اختفى الحاجز ككيان تابع لفرع أمني أو جهة عسكرية معينة وعمله المنظّم، إلا أنه بقي على شكل مساحة تجمع أعداداً من العساكر المقيمين في خيمة أو في غرفة صغيرة، أو على شكل دوريات طيارة في البقعة ذاتها، ترافقها سيارات أمن على مدار ساعات اليوم. لقد خلّفت هذه الحواجز على مدى السنين السبع الماضية آثاراً يصعب تجاوزها عمرانياً وديموغرافياً واقتصادياً وبيئياً، حتى في حال إلغاء جميع المظاهر العسكرية في المدينة.
*****
تميم إمام: مهندس مدني سوري، حاصل على شهادة الماجستير في تنمية التخطيط العمراني من وحدة تخطيط التنمية في كلية لندن الجامعية UCL. يعمل في مجال التنمية مع منظمات دولية غير ربحية. مهتم بالخرائط الرقمية ويستخدمها من أجل توثيق حقوق الملكيات في مبادرته «خرائط من أجل سوريا».
العمران والسلطة والخوف/ هـ.ف
هذا النص مقتطفات من بحث أكاديمي أنجزته الكاتبة لنيل شهادة الماجستير في البناء والتصميم العمراني في التنمية.
المدن مرايا لأناسها، برغباتهم وبجوانبهم المضيئة والمظلمة. فهي تركيبات من هويّات متمايزة وكينونات حيّة لا تتوقّف عن التغيّر، تقصّ علينا حكايا أزمنة انكشف بعضها وما زال بعضها الآخر مستوراً؛ حكايات ذكريات وأنظمة منسية.
وحتى نتمكن من سبر المدينة – ذلك الكيان الذي يعيش فيه أكثر من 55% من سكان العالم – ونستطيع إدارتها بأفضل السبل، جاء تخطيط المدن كأداة تنظّم حياة النّاس وتروج لبيئة مبنيّة تشمل الجميع وتحقق حياة عادلة وآمنة. فكما تقول ساندركوك1:
«التخطيط المديني مشروع اجتماعي دائم لا يكتمل، مهمّته إدارة تعايشنا في الفراغات المشتركة للمدن وللأحياء بطريقة تدعم وتثري الحياة البشرية، وبهدف الوصول إلى عدالة اجتماعيّة وثقافيّة وبيئيّة».
بدأت بكتابة بحثي هذا بعدما لمست عن قرب أهميّة المشاعر والعواطف والعقائد في حياتنا، وكيف تتجسّد لتصبح حقيقة تنعكس على المكان نفسه، فيما تتجسّد السلطة في معان مختلفة لتصبح حقيقة نعيشها.
بدأ ذلك بأسطورة شعبيّة تناقلها السوريون عن حافظ الأسد، وكيف كان يراقب الجميع من شرفة قصره المطلّة على مدينة دمشق، وأنّ هناك مدافع جاهزة دائماً في حال قام السوريون بأيّ ثورة. أثارت هذه الأسطورة الشّعبيّة فزعي، وأظنّ أنّها تسربت إلى عقولنا وتشرّبناها بدون وعي فأصبحت حقيقة غير معلنة.
في مقالتي هذه أكتب عن مدينة دمشق، وعن تصوري لعملية التّخطيط فيها وكيف تجسّد الكثير من الأمور غير المحسوسة.
العمران والسلطة
في خضم صراعات القوى المختلفة، تأتي الحرب كأهم دافع لحركة المدن وقواها المتغايرة، جالبةً معها شؤون التحصين والمراقبة والأمن والسيطرة.
كانت الحرب جزءاً من حياة الناس تاريخياً، وكانت طريقتهم للدفاع عن مدنهم وحكامهم، فيما كان غزو المدن المجاورة يؤمن النمو المستمر لهذه المدن ونمو هيمنة قادتها.
وبحسب لويس مامفورد2 فإن كل مدينة هي في حالة حرب طبيعية مع المدن الأخرى، لكنها في الوقت نفسه في حالة دفاع عن النفس، تتمظهر في التحصينات والحماية من الأعداء، وفي استخدام آليات دفاع وتقنيات مراقبة تطور من خلالها أنظمتها العسكرية.
تهدف هذه الآليات لإدامة الأمن في المدينة، ولبث الطمأنينة الناجمة عن توفير حدود محمية. وقد كانت أسوار المدينة أولى دلالات حماية الحدود عبر التاريخ، بالإضافة للبوابات المحروسة ونوافذ المراقبة والغرف المطلة على تلك البوابات، والتي كانت تقرّر دخول وخروج الناس، وتفصل بين سكان المدينة والغرباء عنها.
لم تقتصر المدن على كونها ساحة للمعارك والحروب فقط في عصرنا الحالي، وإنما عملت كوكالة ووسيلة للحرب ونشاطاتها، فبتمدّن العالم وفراغاته تمدنت الحرب أيضاً. وبذلك تكون البيئة المعمورة مشهداً مدينياً للهيمنة، ومكاناً لممارسة القوة/السلطة، ولتجلّي الشعور بالخوف، ولوضع الجماعات غير المرغوبة أو العناصر المصنّفة «مهددة» أو «مخربة» تحت السيطرة.
نظم القوة والتأديب
تتواجد القوّة في كلّ مستويات التراكيب الاجتماعيّة، يحوزها البعض ويتخلى عنها البعض الآخر. والقوّة التي تمتلكها سلطة حاكمة هي نوع من التّحكّم الذّي تمارسه على النّاس، بعضها يستخدم لبناء القدرات والتّنظيمات، والبعض الآخر لهدمها، خاصّةً عندما تكون هذه القدرات والتنظيمات معارضة للسّلطة.
يشكّل مفهوم قوة السيادة (sovereignty power) بحسب الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو سلسلة لامتناهية من الممارسات التي تضمن إطاعة قوانين سلطة ما أو فرد من الأفراد. فالمجتمعات التي تقوم على السّيادة تهتم بحكمها على الموت أكثر من تنظيمها لحياة الناس، ولا تهدف ممارساتها في كل مكان فقط للمطالبة بالمزيد من السّيطرة على الأراضي، وإنما لتأمين إخلاص التّابعين لها أيضاً. ويعتمد تنظيمها المكاني المديني على العمارة الصّرحيّة، التّي تعمّق الإخلاص للقوّة السّياديّة.
بمرور الوقت، أنتج هذا النوع من القوى أنواعاً أخرى، كان مثالها في أوروبا القرن السادس عشر «البَيو-سلطة» أو السلطة على الأجساد (biopower)، والتي تسمى كذلك «القوة التأديبية» – ويفسرها فوكو بأنها طريقة للسيطرة على الجماهير من خلال مؤسسات تأديبية مجتمعية، تؤثر على التنظيم المكاني للمدن عبر تنظيم نشاطات الناس وأوقاتهم، وسلوكهم وعاداتهم، وهي بذلك تؤدّبهم وتضبطهم في مؤسسات مثل المشافي والمدارس وثكنات الجيش والسجون.
تفرض القوة التأديبية نفسها في أعمال وممارسات مثل المراقبة والحجر الاجتماعي، والتي تتعدد بين تنظيم الفراغات المغلقة و«البانوبتيكون» وصولاً لخلق المجتمعات التأديبية. ومن جهة أخرى يلعب جهاز الدولة البوليسي دوراً أساسياً في التأكّد من أن القواعد والآداب تسود المجتمع.
البانوبتيكون
ذكر فوكو «البانوبتيكون» في كتابه المراقبة والمعاقبة، وهو مبدأ تصميمي للمؤسسات الإصلاحية صيغ عام 1786 علي يد الفيلسوف الإنكليزي جيرمي بينثام، فوصفه بأنه مبنى دائري، «قفص» يقضي فيه المساجين حياتهم في زنازين متوضعة على المحيط تحت رقابة شديدة ودائمة من حرّاس يقبعون خلف ستائر في برج مركزي يمثل مصدر القوة الكلي الذي لا مفر منه.
البانوبتيكون أو السجن يتضمن الكثير من الثنائيات: المراقبة والمشاهدة؛ الأمن والمعرفة؛ الفردية والكلية؛ وأخيرا العزل والشفافية. المشاهدة والمعرفة أمران مهمان لتتبع تحركات السجين وتسجيل عاداته وحالاته النفسية، ومن ثم حفظها في تقارير ورقمنتها.
عبّر هذا المفهوم عن إدارة القوة عبر الفراغ، وأسّس لهندسة السيطرة المعمارية. فالبانوبتيكية هي تطبيق للقوة، وهي هنا مرئية لكن لا يمكن التحقق منها، ما يشكل نموذجاً لمؤسسة تأديبية فعالة لا تحدث في دائرتها أي جرائم أو فوضى (انظر الشكل 1).
تجسّدت عمارة السيطرة البانوبتيكونية في دمشق بالقصر الرئاسي المتربّع على قمة جبل قاسيون، وسطوته على سماء المدينة من وراء التحصينات المقامة حوله والممارسات الأمنية التي رافقت بناءه. كان كنزو تانغه3 قد صمّم القصر في ثمانينات القرن الماضي بشكل يجعل قائد البلاد الحاضر-الغائب يرمق مساجينه من برجه المطلّ على المدينة السجينة، يقبعون فيها مُدانين حتى تثبت براءتهم.
التخطيط العسكري للمدن
بتتبع التخطيط العسكري قديماً، لم تظهر الدول الأوروبية الحديثة إلا خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر. وحينها شرعت توسّع مدنها بفضل رأسماليتها الاستعمارية، ومن خلال العنف السياسي وممارسات التحكم والقمع، كالغزو واستغلال الأراضي والموارد للحفاظ على السلطة السياسية. لذلك فقد كانت الحرب الاستعمارية القاعدة الاقتصادية للرأسمالية الحاكمة. كما عملت المدن الأوروبية على شيطنة وقمع وتجريد الثائرين من إنسانيتهم، إما باستخدام العنف أو المحو المطلق، سواءً كانت تلك الثورات ريفية، أم ثورات استقلال، أم حركات مجتمعات أصلية أو أقليات مشيطَنة.
يخبرنا ستيفن غراهام4 أن هناك تأثيراً راجعاً أو مرتداً (boomerang) لمظاهر العسكرة والقوة التي طُبّقت في المدن النامية في المستعمرات على مدن الدول المستعمِرة. إذ تتشارك المدن المستعمَرة والمستعمِرة في الكثير من العناصر، كالحدود القاسية ونقاط التفتيش والسياج والمناطق المحمية والسجون، وفي وجود أحياء ذات طبيعة إثنية وطائفية، وانتشار قواعد عسكرية حول المناطق المالية.
كان «الجنوب العالمي» في القرن التاسع عشر ساحة اختبار لإجراءات الأمن وممارسات الاستهداف، والتي تضمنت تجريباً لتقنيات تحكم وتهدئة وعسكرة ومراقبة، وهو ما شكل صلب التخطيط العسكري القديم الذي طبقته الدول الأوروبية المستعمِرة. فهذه الأدوات اختُبرت أولاً هناك، ثم أعيد استخدامها في المدن المحلية ضمن الأحياء المتمردة، وهي تشمل تسجيل بصمات الناس، والسجون البانوبتيكية، وبناء الجادات العريضة الأوسمانية.5
بدت تلك الآليات واضحة في كل من الجزائر وسوريا، ففي الجزائر أعاد المارشال بوغود6 تنظيم أحياء كاملة في الجزائر العاصمة بعد هدم كامل ووحشي ضمن استراتيجيته لإيقاف انتصارات المقاومة. وأُعيد استخدام نفس المخطط في باريس لإضعاف ثائريها الفقراء من خلال تخطيط جادات عسكرية عريضة لإيقاف تقدم الثوار، وهي الجادات التي كان أوسمان قد تبناها في أفكاره.
أما في سوريا، تحديداً في دمشق، استقر الثوار في الغوطة كقاعدة انطلاق لمهاجمة مراكز الاحتلال الفرنسي ومباني قياداته في دمشق القديمة إثر اندلاع الثورة السورية الكبرى عام 1925. حاولت السلطات الفرنسية وقتها السيطرة على المدينة وتأمين استقرارها، وأحاطتها بالأسلاك الشائكة – سامحةً بعدد محدود فقط من المداخل – وردّت على هجمات الثوار بمحو جزء من منطقة العقيبة لشق شارعي بغداد والملك فيصل، وذلك بهدف قطع إمدادات ثوار الغوطة وعزل المدينة القديمة عنهم. وعندما لم تستطع قوات الاحتلال الفرنسي احتواء المقاومة، حدثت أول عملية إبادة عمرانية في تاريخ المدينة الحديث، حيث قصفت المدينة القديمة بالمدفعية المنصوبة على جبال المزة (التي لم تكن مأهولة في ذلك الوقت) وبالطائرات لمدة يومين، ما أدى إلى تدمير عدة أحياء خاصة في المدينة القديمة، مثل حي سيدي عمود الشهير والمسمى منذ ذلك الحين حي الحريقة، والشارع المستقيم في سوق مدحت باشا (انظر الشكل 3).
من ناحية أخرى، ساهم الفرنسيون في بناء الجزء الحديث من مدينة دمشق عبر تنفيذ بعض من أدوات أوسمان في تخطيط المدينة، كالساحات النجمية والشوارع العريضة في مخطط دمشق العام الذي وضعه دانجيه بمساعدة إيكوشار عام 1936. ولا بد من تذكر أن القصر الرئاسي القديم كان يتوسط مدينة دمشق في حيها الجديد «أبو رمانة» الذي شيده الفرنسيون.
أعيد إنتاج هذا التخطيط مجدداً في فرنسا، وتحديداً في باريس، التي غدت مثالاً واضحاً لتنظيم الحدود الاجتماعية على يد الحكومات الفرنسية. إذ أبعدت المهاجرين إلى أطراف المدينة، وخلقت بذلك أحياء خاصة بهم، وطوّقت مدينة باريس بعائق ضخم هو المتحلق الدائري الذي يفصلها عن تلك الأحياء. كانت أوضاع أحياء المهاجرين، اقتصادياً واجتماعياً وخدماتياً، أسوأ بكثير من الأوضاع في مركز المدينة. وقد قاد انعدام المساواة هذا لأحداث شغب متعددة، مثل شغب الضواحي الشهيرة عام 2005، وهو ما عاود الظهور مؤخراً عبر التعبئة الكاملة للقوات الأمنية وشيوع المظاهر الأمنية والعسكرية في المدينة.
خلال القرن العشرين، ازدادت الحاجة الماسّة لتحصين المدن، وتحوّل التفكير المديني في المجتمعات الغربية إلى تفكير أكثر عسكرية، محولاً الحياة اليومية في الفراغات العامة والخاصة والبنى التحتية وحتى السكان إلى ثنائية لا فكاك منها: فهم جميعاً إما أهداف أو تهديدات. وكان ذلك لبّ مفهوم التخطيط العسكري الجديد.
في كتابه مدن تحت الحصار، يشير ستيفن غراهام إلى أن التخطيط العسكري الحديث بدأ عند جلب الحرب إلى فراغات المدينة اليومية. وقد شكّل هذا التغيّر ذريعة وتحفيزاً لتوسيع أمور المراقبة وتحديد الهوية، لكن الأهم أنه استهدف وسيطر على الفراغ اليومي وشبكات الحياة اليومية، وبشكل خاص على أعضاء المجتمع «المتمردين أو الإرهابيين المحتملين أو الأشخاص ذوي النوازع الإجرامية». فالفارق أضحى واضحاً بعدما غدت الفراغات والشبكات والدوائر مجرد ساحات المعارك الرئيسية الجديدة.
تدور فكرة التخطيط العسكري الجديد حول تحصين المدينة وتكثيف المظاهر العسكرية للحياة فيها، بما يغير الثقافة المدينية بسياساتها ومشاهد مدنها ودوائر بناها التحتية عبر تطبيع العسكرة، ما يعني بدوره تطبيع الحرب نفسها. وقد سيطر هذا التطبيع، بحسب غراهام، على المدينة وفراغات الحياة اليومية من خلال إجراءات المتابعة والاستهداف العنيفة والعسكرية.
كي نفهم التخطيط العسكري علينا أن نفهم مقوماته الأساسية: العسكرة والأمن والخوف. وتصير حياتنا اليومية ساحة حرب دائمة بالتطبيع مع هذه المقوّمات الثلاثة.
عسكرة الحياة العامة
أول المقومات هو العسكرة، وهي عملية مكانية واجتماعية تولّد العنف ضمن المجتمعات المدنية من خلال تطبيع نقلة نوعية في أفكار الناس وأفعالهم وسياساتهم باتجاه الأمور العسكرية؛ إلى جانب ممارسة السلوكيات التأديبية العدائية بهدف تحديد ومراقبة الأجسام والأماكن والهويات؛ ونشر البروباغاندا لرمنَسة صورة العنف، فالأنظمة التي تعتمد التخطيط العسكري تنظّر للعنف هنا كوسيلة لتحقيق غاية الرب أو لاستيفاء ثأر محق.
عسكرة مجتمع ما عملية معقدة ومتنوعة ومتعددة الطبقات، تنسج بدقة تفاصيل الحياة بين مجالي الحياة المدينية العام والخاص، وثقافات كل منهما واقتصاداته السياسية وجغرافياته.
تجلى تطبيع العسكرة والجندية في الحياة المدينية في زيادة مصاريف الدولة على أمور تتعلق بتحديد وفصل العناصر المهدِّدة عن تلك التي تعتبر مفيدة، سواء في البلد نفسه أو خارج الحدود الوطنية عبر وحدات الجيش العاملة في الخارج، كما في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.
لم تأخذ «الجمهورية العربية السورية» شكلها الحالي إلا بعد انفصالها عن مصر عبد الناصر وتفكك مشروع «الجمهورية العربية المتحدة». شهدت البلاد خلال الحكم الناصري تحولاً نحو الدولة البوليسية والحزب الواحد والقائد الفرد، قبل أن يستولي حزب البعث على السلطة في انقلابه العسكري عام 1963 ويحل الدستور ويعلن حالة الطوارئ ويتسبب بنفي معظم الطبقة السياسية خارج البلاد.
سببت حالة الطوارئ خوفاً عاماً نتيجة القيود التي فرضتها على الحقوق والحريات الفردية والعامة، كحق الإقامة وحق الاجتماع وحق الحركة، وحتى حق المرور في أوقات معينة، ناهيك عن الرقابة على الإعلام. كان كل من يتحدى هذه القيود يقاد إلى المحاكم الميدانية أو العسكرية. وقد طبّعت هذه الحالة الحرب في عقول السوريين منذ أواخر الستينات.
أخذت القوة التأديبية في سوريا تنعكس في المؤسسات العقائدية التي تجنّد كافة فئات المجتمع وتلقّنهم الولاء لـ«الأب القائد»، فكانت منظمات طلائع البعث وشبيبة الثورة والنقابات المهنية وكلها تحت سيطرة حزب البعث. كانت منظمات «المجتمع المدني» المفترضة أحد أبرز مظاهر العسكرة، والتي اقترنت بالمؤسسات «الاستهلاكية العسكرية» التي شكلت أهم مصادر التموين للسوريين أثناء فترات العقوبات و«الإسكان العسكرية» التي سيطرت على بناء المساكن. ومن جهة أخرى تمثلت عسكرة التعليم في الزي العسكري الموحّد، وحصص التربية العسكرية الإجبارية، والتحية الصباحية للديكتاتور والحزب الحاكم، والتعهد بـ«التصدي للإمبريالية والصهيونية والرجعية».
الأمن لأمان السلطة
ثاني مقومات التخطيط العسكري هو الأمن. اقترن أمن المدن الغربية في القرن العشرين بالأنظمة العسكرية، وكان العذر الأمني يساق لتبرير كل عملية عسكرية. وبارتفاع معدلات الهجوم في مختلف مدن العالم، تم تطبيع مبدأ «الدفاع من أجل الأمن» وأصبح الإقصاء وجنون الشك جزءاً لا يتجزأ من إجراءات الأمن، أو على الأقل سمة لا يمكن التخلي عنها. تشعّبت رؤى الأمن وأنظمة الفكر العسكري وذابت الفروق بين السلم والحرب وبين البوليس والاستخبارات والجيش بمستوياتهم المحلية والوطنية والعالمية.
لا يهتم الأمن بالنظام القانوني أو بحقوق الإنسان، فهو قائم على ملاحقة وتحديد كل فرد أو مجموعة أو اتحاد وتقرير ما إذا كانوا مرتبطين بالعنف أو الإزعاج أو مقاومة الأنظمة الرأسمالية النيوليبرالية المهيمنة ومعاقبتهم تحت مسمى الأمن القومي أو الوطني.
لا يتشارك النظام الحاكم في سوريا مع الأنظمة الغربية في «رقميتها»، إذ لم يتبنَّ هذا النظام الأساليب الأمنية وإجراءات المراقبة الحديثة. بل، بالعكس، يعتمد على العين المجردة لتأمين الاستقرار.
أنشأ الأسد الأب هيكلية أمنية قوية سيطر من خلالها على سوريا بتعيين المقرّبين ونشر المخبرين، وتساوى أمامها المواطنون مع المسؤولين بكونهم أهدافاً للمراقبة. وبحسب هيومن رايتس ووتش فإن هناك ثمانية أجهزة أمنية رئيسية، لها فروعها وسجونها المنتشرة في كل أنحاء البلاد. والمذهل أن كلاً منها يعمل باستقلالية تامة عن الأجهزة الأخرى، ولكل منها غرف تحقيق وتقنيات استجواب خاصة بها، دون أي تنسيق أو حدود واضحة بين أشكال التحرك وجمع المعلومات. فالمخابرات العسكرية مثلاً مدربة على جمع معلومات لا تتعلق فقط بالقوات المسلحة بل بقضايا أمن الدولة؛ وأجهزة أمن الدولة مدربة على التعامل مع التمردات والسيطرة على حشود الناس. كذلك شكلت النقابات والمؤسسات العامة وأفرع حزب البعث الحاكم بانوبتيكوناتها الخاصة لمراقبة وتتبّع المواطنين فيها وحولها.
بينما تعني كلمتا «الأمن» و«الأمان» كلاهما حماية الممتلكات من المخاطر والتهديدات، يدور الأمن حول حماية المجتمع وتركيبته الاجتماعية، وحول فهم معنى القانون والنظام والأخلاق، وحول حماية القيم المجتمعية ضد أعمال الجريمة المخطط لها. أما الأمان فيدور حول الحماية ضد الحوادث الناجمة عن أعمال غير مخطط لها. ولأن الأمن يعتبر مسألة موضوعية، أي ليس حقاً فردياً بل هدف سياسي معقّد، فهو يشمل الأمان؛ الذي هو مسألة ذاتية ومطلب اجتماعي، ولا يرمز لخطر واقعي بل يتعلق بتفسيرنا ونظرتنا للحياة اليومية. كذلك يرتبط كل من الأمن والأمان بالثقافة، فهما منتجان لبيئتهما ويتأثران بالسياسات المطبقة فيها. ومن هنا فإن العلاقة المتبادلة بين ثقافة المجتمع وسياسات الأمان والأمن خلقت عنصراً محورياً لفهم المدينة هو الخوف المديني، والذي ستتم مناقشته بمزيد من التفصيل أدناه.
الاحتراس الدائم
ثالث مقومات التخطيط العسكري هو الخوف. فقد مرت الفراغات العامة في المدن خلال العقود الأخيرة بعمليات متواصلة من التحصين والفصل والإقصاء والسيطرة والخصخصة، كان بعضها متولداً من الحياة اليومية بما في ذلك مشاعر وتصورات السكان. لقد فشل تخطيط المدن الحديث في الاعتراف بدور المشاعر في تشكيل البيئة المعمورة، وفي الاعتراف بدور الخوف تحديداً في تشكيل عالم المدن. فغالباً ما نُظر إلى الخوف كمشكلة يجب حلها واختُزل في كونه نقيض الأمن.
كان الخوف عملة صالحة لتبرير أي مسألة، فالعسكرة الحديثة عملت مع سياسات الخوف، واستخدمتها في التخطيط المديني لتعزيز أشكال الإقصاء وإعادة تصنيع العلاقات الاجتماعية والاقتصادية، رغم أن الإقصاء كان ينتج أحياناً عن غير قصد. كذلك، يرتبط الخوف بممارسات البروباغاندا والتضليل الإعلامي، والتي تنطوي على عمليات وصْم وتهميش وتطويق تعيد تخطيط وإنتاج مساحات الإقصاء للآخرين.
يعرّف كوري روبين7 الخوف السياسي على أنه «شعور الناس بالتخوف من حصول أذى لرفاههم الجماعي، أو التخويف الذي تمارسه الحكومات أو بعض المجموعات على الرجال والنساء». وحسب ويندي بيرلمان8 هناك أربعة أنواع للخوف من السلطات متجذّرة في قلوب الناس: الخوف المُسكِت الناشئ عن القمع والقادر على الإخضاع؛ والخوف المذلَّل الذي يصاحب حالات التمرّد وكسر وضعية «القتال أو الفرار» لصالح التحدّي ورفع الصوت السياسي؛ والخوف شبه المطبّع، أي حين يفقد الخطر شكله المعتاد ولا يعود من الممكن فهمه أو التنبؤ به، وغالباً ما يكون مؤقتاً وينتهي إلى أحد أنماط الخوف الأخرى؛ والخوف الضبابي الذي يسود في أوقات اللايقين وتشوّش المستقبل والتعوّد على عدم الاستقرار في اتخاذ القرارات السياسية.
كان الخوف في سوريا سياسياً، بخلاف حاله في المجتمعات الغربية. وبحسب ويندي بيرلمان فإن الخوف الشائع فيها منذ سبعينات القرن الماضي حتى الآن هو الخوف المُسكِت الذي يشجع المواطنين على الخضوع لسلطة قسرية. كانت المراقبة والتهويل والاعتقال بانتظار كل من يفكر بالانتفاض. وكانت القوة الوحشية التي تعاملت مع أحداث الثمانينات تلاحق الناس وتملأ نفوسهم بالرعب والقلق. وفي ظل فرض الرقابة الصارمة على الإعلام والاختفاء التام للصحف والقنوات الحرة، لم يكن التعبير عن الآراء مسموحاً، وحتى إلقاء نكات قد يودي بفاعله في غياهب النسيان ومجاهل الاختفاء القسري والتعذيب وربما القتل. وقد ألقى هذا بثقله على علاقات الناس وغذّى الارتياب فيا بينهم، فعبارة مثل «وطّي صوتك، الحيطان إلها آذان» كانت عنوان المرحلة. لقد حوّل الخوف الناس إلى مواطنين مذعنين، لا يتحدّون النظام ويصدّقون عدم إمكانية أو عدم جدوى أي تغيير.
العمران والخوف
للتخطيط العسكري سمات وخصائص عدة، منها مكاني يتعلق بتجسيد مقوماته في الفراغ؛ ومنها ما يتعلق بفكره وعقيدته ودلالاته، كتعقب الأهداف باستخدام الأنظمة الإلكترونية أو ربط الأمن بالحكم النيوليبرالي واقتصاده السياسي الداعم؛ ومنها ما يتعلق بخلق فراغات عمرانية جديدة بعنف، إما بإنشاء أماكن فارغة تستتبع المضاربات العقارية وجني الأرباح، أو بتمثيل جغرافيات العنف غير المنتهي التي تحدّث عنها الفيلسوف أغامبين من خلال مفهومه الشهير حالة الاستثناء (دولة الإقصاء)، وهو ما يعرف باسم المجازر العمرانية أو urbicide؛ أو، أخيراً، بربط الجيش والبوليس ودمجهما معاً.
هنا سنتوقف عند خصائص التخطيط العسكري المكانية، حيث تتجسد العسكرة والأمن والخوف بشكل كبير في تنظيم الفراغات المدينية.
يعتمد التخطيط العسكري اعتماداً مباشراً على مقوِّم الخوف المديني، وهما يشكلان حلقة مفرغة، يتغذّيان على بعضهما البعض ويقوّي كل واحد منهما الآخر، فالخوف يتبع الشكل والشكل يتبع الخوف المعزّز بالسياسات المحلية. فمن خلال الخوف، تتكرّس صناعة الحدود الداخلية ضمن المدن، ويمتلئ النسيج المديني بالذعر نتيجة سياسات التخطيط الحديث التي يقودها التكنوقراطيون. وهكذا تصبح المدن مصممة بوظائف أحادية مجزأة لاستيعاب علاقات اجتماعية محددة باستعمال أدوات تعزز سياسات الإقصاء ضمن الأنظمة النيوليبرالية.
الخوف المديني، بحسب سيمون تولوميلو9، هو تركيب اجتماعي سياسي يُنتَج بطريقتين: إما بالتشتت المكاني، أو بإنتاج فراغات عامة مستمرة بمثالية. يحصل التشتت المكاني أو الفراغي كنتيجة مباشرة لعمليات إنتاج المدينة كآلة، والتي تعمّق الفردية والعزلة وتخلق مساحات مقسّمة أو «زونات» (zones) لتعزيز «الآخرية» (otherness) وما يستتبعها من تهويل الأخطار التي يمثلها الآخرون. أما الفراغات العامة المستمرة بمثالية فهي تشبه «المسقط الحر» الذي اقترحه لو كوربوزييه10، والذي يعزل البناء عن محيطه الخارجي ويمنع الفراغات العامة من تحقيق حيويتها المنشودة، ما يعني أن التخطيط المديني يخلق مشاكل أكثر من يحلها. من جهة أخرى فإن الخوف والأمن مرتبطان بشدة نظراً للدور القوي الذي تلعبه خطابات الخوف في تحديد الأشخاص المهدِّدين أو المهمَّشين أو «الآخرين».
ولشرح التنظيم المكاني للخوف وكيف يتجسد بشكل فعلي في الفراغات المدينية، حلل سيمون تولوميلو فراغات الخوف وصنفها ضمن عدة تصنيفات سماها مشاهد الخوف المدينية. تتعلق هذه المشاهد بخلق حدود ضمن المجتمعات لجهة احتوائها للآخرين وإقصائها لهم.
انكفاءات داخل المدينة
أول مشاهد الخوف هو المناطق المطوّقة (المغلقة) التي اشتُقت من مفهوم المجتمع التأديبي لفوكو وطريقة توزيعه للناس في الفراغ، والانتقال بين ممارسة الهيمنة أو الخضوع لها. يعرّف تولوميلو المناطق المطوّقة بأنها مكان غير متجانس لـ«الآخرين» ومنغلق على نفسه. ترمز المناطق المطوّقة إلى تجميع الأماكن المبعِدة اجتماعياً والمغلَقة مكانياً، وهي تظهر من خلال عمليتين:
أ) فراغات الإقصاء (الاستثناء) الإجباري من المساحات والحقوق الجماعية: وهي فراغات لها موقعان، الأول هو المخيمات المنصوبة في مناطق يصعب الوصول إليها، والثاني هو المناطق المهمشة التي تحدّها الأسوار والجدران أو الأجسام الطرقية (المكونة من طُرُق). يبرَّر الإقصاء بالحالة القانونية المعلقة، ويمارَس في منطقة الحرب أو في الفراغات الرمادية العشوائية التي تمثل علاقات القوة مكانياً والعزلة التي تسبّبها الدولة
ليس الاحتواء والإقصاء في دمشق واضحين كوضوحهما في بقية مدن العالم، لكنهما واضحان في المخيمات التي آوت الفلسطينيين الذين لاذوا لسوريا منذ 1948. فقد بُنيت في ضواحي دمشق، بعيداً عن المركز، وبخدمات بين السيئة والمتوسطة. وعند توسع دمشق وازدياد التمدن فيها، أصبحت هذه المخيمات جزءاً من المدينة، أحياءاً بمبانٍ إسمنية دائمة تسكنها طبقات وسطى من جميع فئات السوريين (كما في مخيم اليرموك). بعض هذه المخيمات يبعد عن وسط مدينة دمشق حوالي 7-14كم، لكن معظمها ما زال يعاني من أحوال سيئة ومن انفصال كبير عن مركز المدينة بأجسام طرقية ضخمة، كمخيم جرمانا ومخيم الست والسبينة (انظر الشكل 4).
تلقي فراغات العشوائيات الرمادية بظلالها على المدينة وتنتشر في مختلف أنحائها. وقد ظهرت أولاً بسبب الزيادة الكبيرة في أسعار العقارات ونمو الكثافة السكانية وهجرات السوريين الداخلية إلى العاصمة دمشق من الشمال السوري ومرتفعات الجولان. أصبحت العشوائيات بعدها سكناً لطبقات اجتماعية واقتصادية متنوعة (كما في نهر عيشة والتضامن والطبالة والدويلعة)، فكانت مخرجاً لمأزق السكن بالنسبة للبعض، والذين قاموا بحل مشاكلهم بأنفسهم، على الرغم من التهديد المحدق المتمثل بسياسات الهدم وتجميل المدينة على حساب سكانها.
ب) فراغات العزلة الطوعية (المنتجة ذاتياً)، حيث يريد أعضاء مجموعات متجانسة إنتاج مساحات آمنة لحماية أنفسهم من التهديدات الملموسة في المدن. مثال ذلك المجتمعات المسورة (في المناطق السكنية) التي يتم فيها تطويق المساحات المشتركة والتحكم في الدخول إليها بتحصينات وممارسات أمنية. تلك المجتمعات الخاصة تتمتع بأنظمة حكم ذاتي، وهي تشترك مع المخيمات بحوكمتها الذاتية، بالإضافة لاستخدامها نفس خطابات الخوف و«الآخرية» التي هي شكل من أشكال التطويق.
تَشكُّل هذه الفراغات في دمشق مثير للغاية. فهي لم تُبنَ للأغنياء كما هي حال العزلة الطوعية في دول العالم المتقدم، بل بُني بعضها ليستوعب جنود الجيش السوري وعائلاتهم، أو ليضم مجتمعات فقيرة متجانسة تتشارك الأصول الإثنية وترغب بالانغلاق على نفسها وتبادل الخوف مع العالم الخارجي (مثل جبل الرز الذي سكنه الأكراد، ومنطقتا عش الورور ومزة 86 اللتان يسكنها الجنود والأقلية العلوية).
أوصال المدينة المقطّعة
من مشاهد الخوف الأخرى العوائق (الحواجز) التي تتمثل بفراغات فيزيائية ناتجة عن استخدام شبكات البنية التحتية، بوعي أو بدون وعي، خاصةً تلك التي تقلل من حق الحركة بدل أن تزيده. فتركز معظم الاستثمارات في المدن وحول بُناها التحتية الضخمة من سكك وأجسام طرقية وأنفاق، ما يؤدي لازدياد المسافات بين الوظائف المدينية وبالتالي إلى شكل من أشكال الإقصاء داخل المدينة.
تنتج شبكات البنية التحتية مناطق جغرافية ونقاطاً تتمتع بنفاذ ميسّر إليها، لكنها قد تؤدي أيضاً إلى تشويه الفراغات المدينية وخلق سوء تناسق أو إطالة المسافات بدلاً من ضغطها وإيجاد نقاط وصل.
بالنسبة للبعض، تشكل فراغات التنقل شكلاً من أشكال الحواجز، فغالباً ما تفصل الطرق السريعة والسكك الحديدية بين المناطق التي كانت متلاصقة في السابق. فهي تؤثر على المساحات المدينية اليومية التي يقطعها مالكو وسائل النقل البطيئة. وعلاوة على ذلك، أثرت بنى النقل التحتية على المدن في جميع أنحاء العالم، فدمرت المنازل والمتاجر وأزالت الأحياء وتسبب بإجلاء السكان (وخاصة ذوي الخلفيات المهمشة والفقيرة)، ناهيك عن محوها الذكريات المعاشة في أماكن بنائها وقَسمها المجتمع إلى قِسمين.
ثمة تباينات أخرى في إنتاج السياسة المكانية. فقد تم توظيف الفصل عبر البنية التحتية أيضاً لفصل فقراء المدن والأقليات العرقية عن بقية سكان المدينة، كما هو الحال في المدن الأميركية وفي باريس على وجه الخصوص؛ ولا سيما الجادة التي تطوّق العاصمة الفرنسية فتسوّرها وتعمل كجدار تمييز بين المناطق الغنية والفقيرة. يساهم هذا النوع من الفراغات في ثقافة الخوف لأنها تحمي مستخدمي البنية التحتية من غزو «الآخرين»، وفي الوقت نفسه تعزل المناطق المدينية «الخطرة» من خلال التحكم والسيطرة على حقوق الحركة.
في دمشق، خلق مخطط إيكوشار11 شبكة من الطرق المتصلة التي سهلت حركة السيارات ووصلت بين الأحياء، لكنها مع ذلك مزقت نسيج المدينة والمناطق الخضراء فيها. حتى جبل قاسيون لم يسلم من ذلك، فقد خلق المخطط العام ذاك شقوقاً في النسيج المديني المتشابك أشبه بحواجز داخل المدينة (كشوارع الربوة وبيروت القديم والثورة وحلب والمتحلق الجنوبي وأوتوستراد درعا وأوتوستراد المزة).
وبسبب شبكة الطرق هذه، بعض هذه المناطق هُدمت وأعيد بناؤها وبيعت بأسعار مرتفعة، ما جعلها حواجز بين المناطق الغنية والمخدّمة والأحياء الشعبية القديمة والمهمشة. أُخرج الكثيرون من بيوتهم ومُحيت أراضٍ زراعية واسعة كي يتسنى لأصحاب السيارات وشاحني البضائع التنقّل من مكان لآخر. لقد أثّرت هذه الشبكة على الحياة اليومية لكثير من العائلات التي كانت تقطن هناك، فإما انفصلت عن بعضها أو اضطرت لتغيير أماكن عملها، فيما وجد كثيرون صعوبة في عبور الأجسام الطرقية الضخمة. حدث هذا في مناطق المزة أوتستراد ومزة بساتين، وكفرسوسة وكفرسوسة البلد، وداريا ونهر عيشة وغيرها.
عيون الأخ الأكبر
يتمثل المشهد الأخير من مشاهد الخوف المديني في ما يسمى مناطق التحكم. يظهر هذا النوع من الفراغات في التخطيط العسكري الحديث الذي يستخدم نسخة جديدة من البانوبتيكون. هذه المناطق توجه القوة من الأعلى إلى الأسفل بفضل الكاميرات وأجهزة الاستشعار، التي تشير لسلطة يمكن التحقق من وجودها ولكنها غير مرئية، فهي تراقب وتشاهد وتسجّل وتمحّص أنشطة الأفراد.
تغزو كاميرات المراقبة (CCTV) الفراغات المدينية، ولا سيما بعد تطور التقنيات التي تجعل التكنولوجيا أرخص وأصغر وأكفأ. وهي تبثّ الخوف من الإرهاب بدلاً من نشر الأمان.
تؤثر مشاهد التحكم على الخصوصية الشخصية في الأماكن العامة، كما أن نظم المراقبة عامةً (الإجراءات البيومترية، وبطاقات الهوية الشخصية، وكاميرات المراقبة، ونظام تحديد المواقع) وممارسات التحكم خاصةً (إغلاق الطرق، وإنشاء مناطق أمنية باستخدام الجدران ونقاط التفتيش والحواجز والمتاريس) تعتبر تهديداً للحريات السياسية الضرورية للمواطنة الفاعلة. يمكن للتحكم أن يتلاعب بعلاقة الفرد بالفراغ، كما يمكن للمظاهر الأمنية أن تضر بالمواطنة الفاعلة وأن تعزز الفردانية والانسحاب من الأماكن العامة، فهي «خطرة ولهذا تتم مراقبتها». وهكذا فإن عمليات المراقبة والتحصين تدفع نحو خصخصة الأماكن العامة وحصر الحياة الاجتماعية في مساحات خاصة مغلقة.
لا تكاد تتواجد الأنظمة التقنية ولا الكاميرات في مدينة دمشق بسبب نقص الكهرباء. وهي إن وجدت فغالباً ما تكون ذات ملكية خاصة. وهي بذلك تختلف عن مدن العالم المتقدم، لكنها تشبهها باحتوائها على بانوبتيكونات صغيرة في كل حي وكل شارع، فالناس يشعرون بأنهم مراقبون كل الوقت، حتى في بيوتهم، بسبب كثرة عيون السلطة ومخبريها وضلوع الجميع في التنصّت والوشاية.
يتجسد بانوبتيكون التحكم في سوريا في الأفرع الأمنية ومقرات حزب البعث المسيطرة على مدينة دمشق، بحيث تكاد تكون جميع أحيائها خاضعة لعيون الحرس. علاوة على ذلك، فإن الأكشاك المنصوبة في الطرقات وقرب الحدائق تراقب وتتنصّت على اجتماعات الناس وتجمع المعلومات عنهم كأفرع أمنية مصغرة. نلاحظ أيضاً أن معظم عمال النظافة وسائقي التاكسي مخبرون أو عناصر في الأجهزة الأمنية. أخيراً، لا يخفى على أحد أن الكثير من الأبنية والشوارع والساحات (المستشفيات، الأوبرا، المكتبة الوطنية، الملاعب، الجسور والطرق السريعة) أُطلق عليها اسم الأسد الأب أو الابن الراحل لتعزيز مزيد من السيطرة وتذكير للناس بسطوة حكم الأسد.
تطرّق هذا العرض للتخطيط العسكري في زمن السلم، ولم يستعرض المجازر المدينية التي تحدث في زمن الثورات والحروب، والتي تبرّر بها الأنظمة عملياتها العسكرية والأمنية وتحتوي تمرّدات مواطنيها. عايشت سوريا أشكالاً عديدة لهذه المجازر على مدى السنوات القليلة الماضية، ولعل المستقبل يحمل المزيد من تجلياتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي ما تزال حالياً قيد التشكل.
*****
1. ليوني ساندركوك (1949) أكاديمية ومخططة عمرانية أسترالية، تركز أبحاثها على التخطيط المجتمعي والتعددية الثقافية.
2. لويس مامفورد (1895-1990) مؤرخ وعالم اجتماع أميركي تناولت أعماله قضايا التكنولوجيا والحضارة المدينية الحديثة.
3. كنزو تانغه (1913-2005) مهندس معماري ياباني، حاصل على جائزة بريتزكر 1987 للعمارة ويعتبر من أهم المهندسين المعماريين في القرن العشرين.
ا4. ستيفن غراهام هو أكاديمي ومؤلف وباحث في المدن والحياة المدينية. وهو أستاذ في المدن والمجتمع ضمن وحدة البحوث المدينية العالمية بجامعة نيوكاسل.
5. نسبة إلى البارون جورج يوجين أوسمان (1809-1891)، والذي اختاره الإمبراطور نابليون الثالث لتنفيذ برنامج تجديد مديني هائل للشوارع والحدائق والأشغال العامة الجديدة في مدينة باريس، وهوا ما يشار إليه عادة باسم أعمال أوسمان لتجديد مدينة باريس.
6. المارشال توماس بوغود «نبيل لابيكونيري ودوق إيسلي» (1784-1849) كان الحاكم العام للجزائر بين 1842 و1847، وقد قاد أعمال المحو العمراني في الجزائر بعد التنكيل بالمقاومة.
7. كوري روبين هو منظّر وصحفي وأستاذ في العلوم السياسية في كلية بروكلين ومركز الدراسات العليا بجامعة مدينة نيويورك.
8. ويندي بيرلمان هي كاتبة وباحثة تركز على السياسات المقارنة في الشرق الأوسط والحركات الاجتماعية والتعبئة الشعورية، وهي حالياً أستاذة مشاركة للعلوم السياسية بجامعة نورث وسترن.
9. سيمون تولوميلو هو باحث في جامعة لشبونة، تشمل اهتماماته نظرية التخطيط والثقافات ودراسات الأمن النقدية والدراسات المستقبلية وجغرافية الأزمة.
10. لو كوربوزييه (1887-1965) هو مهندس معماري ومخطط عمراني وكاتب سويسري-فرنسي، يعتبر من رواد العمارة الحداثية والوظيفية. يعني المسقط الحر الذي اقترحه رفع المباني على أعمدة وترك الطابق الأرضي مفتوحاً بما يمدّ الفراغات العامة عبر المدينة ويخلق مساحات عامة حيوية.
11. مخطط إيكوشار هو المخطط التنظيمي الذي اقترحه ميشيل إيكوشار لتنظيم وتطوير مدينة دمشق عمرانياً عام 1968.
هـ.ف: مهندسة معمارية سورية. ماجستير في العلوم- اختصاص البناء والتصميم العمراني في التنمية من «وحدة تخطيط التنمية» في كلية لندن الجامعية UCL، بالإضافة إلى درجة الماجستير التأهيلي في هندسة المدن – تنمية المدن المستدامة من سوريا وفرنسا.
القانون الدولي وإعادة إعمار سوريا/ مهند شرباتي
منذ بدء عمليات القمع العسكري، ارتكب النظام السوري وحلفاؤه العديد من الجرائم الدولية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. شملت هذه الجرائم، حسب تقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا: القصف الجوي على مناطق خارجة عن سيطرة النظام، قتل المدنيين، تدمير ونهب الممتلكات، التهجير القسري، الاعتداءات الجنسية، الاعتقالات التعسفية، الإخفاء القسري، تدمير المنشآت المدنية والبنى التحتية، الحصار والتجويع، استخدام الأسلحة الكيماوية، وأخيراً اتفاقات «المصالحة» والإخلاء التي عقدها النظام مع بعض الفصائل المعارضة، والتي أدت إلى تشريد آلاف المدنيين.
اعتبرت العديد من التقارير أن ما يقوم به النظام السوري وحلفاؤه في بعض المناطق هو سياسة تغيير ديموغرافي، يتم تنفيذها عن طريق جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مرتكبة على أسس تمييزية، مثل الانتماء الجغرافي أو الديني أو السياسي، بقصد التلاعب بالتركيبة السكانية السورية وتعزيز سيطرة النظام السوري في هذه المناطق. وبالمجمل، أدت هذه السياسة وفقاً لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، إلى نزوح ما يقدر بنحو 5.6 مليون شخص من سوريا بحثاً عن الأمان، معظمهم لجأ إلى البلدان المجاورة كلبنان والأردن وتركيا، بالإضافة إلى حوالي 6.6 مليون نازح داخل سوريا.
بالإضافة إلى ذلك، قامت السلطة السورية خلال السنوات القليلة الماضية بإصدار قوانين عديدة، يُعتقد أن الغرض منها تعزيز سياسة التغيير الديموغرافي، وحرمان السكان المدنيين الذين ثاروا ضدها بشكل سلمي للمطالبة بحقوقهم المشروعة من ممتلكاتهم، وذلك عن طريق فرض قيود إدارية وإجرائية قد تؤدي إلى منع المهجرين من تسجيل ممتلكاتهم أو الاحتفاظ بها. وقد أشارت لجنة التحقيق الدولية في تقريرها الصادر في أيلول 2017 إلى أن هذه القوانين قد تؤدي في المستقبل إلى زيادة حرمان شرائح كبيرة من السوريين من حقوقهم، وأنها ستعقّد ما يُبذل من جهود من أجل الوصول إلى تسوية للنزاع وتحقيق المصالحة.
اليوم، ومع تغير الوضع العسكري على الأرض نتيجة سيطرة النظام السوري وحلفائه على معظم المناطق التي كانت تسيطر عليها الفصائل المعارضة، يزعم النظام وحليفته روسيا أن النزاع قد حُسم، وأن الأوضاع في سوريا أصبحت مواتية لعودة اللاجئين، وذلك في محاولة لحثّ المجتمع الدولي على المساعدة في دعم وإنعاش الاقتصاد السوري والمساهمة في عملية إعادة الإعمار، التي تقدر تكلفتها بما يتراوح بين 100 و400 مليار دولار حسب تقارير البنك الدولي. وهو ما يعني بالتالي تحويل تركيز المجتمع الدولي عن محاسبة مجرمي الحرب.
يتم الترويج لإعادة الإعمار كعملية تقنية، تشمل فقط إعادة إعمار الأبنية التي دمرتها الحرب، مع تجاهل جوانبها المتعددة التي تشمل أيضاً الإصلاح السياسي والاقتصادي والقانوني والاجتماعي، وجوب أن تبنى على أسس الديمقراطية والشفافية، بحيث تمنع استمرار الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان وارتكاب انتهاكات جديدة، وبحيث تؤدي بالنتيجة إلى خلق الظروف المواتية لعودة اللاجئين واستعادة أملاكهم وإعادة دمجهم في المجتمع.
لا بد من الإشارة هنا إلى أن الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي قد أعلنوا بشكل صريح عدم استعدادها للمشاركة في إعادة الإعمار ما لم يتحقق انتقال سياسي في سوريا. إلا أن ذلك لم يمنع دولاً أخرى من التعبير عن اهتمامها بالمشاركة، وهو ما ينطبق بشكل خاص على روسيا وإيران وبعض الدول المجاورة لسوريا، والتي تأمل تحقيق أرباح مالية طائلة جراء المساهمة في هذه العملية.
في ضوء ما سبق، تبرز تساؤلات عديدة حول دور القانون الدولي في عملية إعادة إعمار سوريا، خاصة في ظل سيطرة النظام وحلفائه على هذه العملية، واستمرار ارتكاب الجرائم الدولية وانتهاكات حقوق الإنسان؛ وستناقش هذه الورقة في قسمها الأول مدى توافق القوانين العقارية التي أصدرها النظام السوري في إطار عملية إعادة الإعمار مع القانون الدولي؛ فيما سيتناول القسم الثاني المخاطر القانونية التي قد تتعرض لها الدول والشركات الراغبة في المساهمة في عملية إعادة الإعمار في سوريا، بموجب القانون الدولي.
أولاً: توافق التشريعات العقارية مع القانون الدولي
أصدر النظام السوري خلال السنوات الماضية العديد من القوانين التي يمكن القول إنها تشكل الأساس القانوني لعملية إعادة الإعمار المزعومة في سوريا، كالمرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012 الخاص بإزالة مخالفات البناء؛ المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 القاضي بإحداث منطقتين تنظيميتين ضمن المصور العام لمدينة دمشق، المنطقة الأولى تضم جنوب شرق المزة من المنطقتين العقاريتين مزة وكفرسوسة، أما الثانية فتشمل جنوبي المتحلق الجنوبي من المناطق العقارية مزة وكفرسوسة وقنوات بساتين وداريا والقدم؛ المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2015 المتضمن إجازة إحداث شركات سورية قابضة مساهمة مغفلة خاصة بناءً على دراسات اجتماعية واقتصادية وتنظيمية، وذلك بهدف إدارة واستثمار أملاك الوحدات الإدارية أو جزء منها؛ المرسوم التشريعي رقم 23 لعام 2015 المتعلق بتنفيذ التخطيط وعمران المدن؛ المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2016 المتعلق بإعداد نسخة رقمية لوقوعات الحقوق العينية؛ القانون رقم 33 لعام 2017 المتعلق بتنظيم آلية العمل على تكوين الوثائق العقارية المتضررة كلياً أو جزئياً، أو التي ثبت فقدانها نتيجة الحوادث الطارئة، واعتبارها تتمتع بالقوة الثبوتية؛ المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2018 الخاص بإزالة أنقاض الأبنية المتضررة نتيجة أسباب طبيعية أو غير طبيعية، أو لخضوعها للقوانين التي قد تقضي بهدمها؛ وأخيراً القانون رقم 10 لعام 2018 الذي يسمح بإحداث مناطق تنظيمية جديدة في جميع أنحاء سوريا، مخصصة لمشاريع التطوير العقاري وإعادة الإعمار، وهو القانون الذي أثار جدلاً واسعاً دفع العديد من الدول إلى تقديم شكاوى إلى مجلس الأمن باعتباره يعيق عودة اللاجئين.
ومع بدء عملية إعادة الإعمار فعلياً في بعض المناطق، يبدو جلياً أن النظام السوري يستخدم إعادة الإعمار لتحقيق مصالحه السياسية والاقتصادية محلياً وإقليمياً، من خلال تطويع ومعاقبة المناطق التي ثارت ضده ومكافأة الدول الحليفة ونخب رجال الأعمال السوريين الذين قدموا له الدعم خلال السنوات الماضية. تتبدى هذه السياسة بشكل واضح من خلال الأحكام التمييزية التي تتضمنها بعض القوانين المذكورة أعلاه، وكذلك من خلال قيام السلطات السورية بمنح مشاريع إعادة الإعمار لحلفائها ولرجال أعمال سوريين معروفين بولائهم لها. بالإضافة إلى أنه يتم تنفيذ جميع هذه المشاريع في المناطق التي تعتبرها الحكومة مناطق معارضة، والتي تم تدميرها وقتل وتشريد غالبية سكانها المدنيين قسراً من قبل النظام والميليشيات الموالية له.
يتم حالياً تنفيذ أول مشروع تطوير عقاري، يُعرف باسم «ماروتا سيتي»، استناداً إلى القانون رقم 66 في منطقة بساتين الرازي (المزة) بدمشق، وهي من المناطق التي ثارت ضد نظام الحكم منذ 2011. وتشير التقارير إلى قيام عدد من رجال الأعمال والمستثمرين السوريين، الذين أسسوا مع الحكومة السورية شركة دمشق الشام القابضة، بتمويل هذا المشروع، إذ دخل رامي مخلوف، المشمول بقوائم العقوبات الأميركية والأوروبية، في المشروع عن طريق عدة شركات مملوكة جزئياً أو كلياً من قبله. وكذلك يساهم في المشروع رجل الأعمال السوري سامر فوز، الذي يعتبر أحد أبرز رجال الأعمال السوريين الذين ظهروا في سوريا بعد عام 2011، وهو معروف بارتباطه بالسلطة في دمشق. ولا بد من الإشارة إلى أن سامر فوز لم يكن مشمولاً بالعقوبات الغربية، وقد تمت إضافة اسمه مؤخراً إلى قائمة العقوبات الأوروبية. كما تم توثيق مشاركة عدد من رجال الأعمال السوريين بالاستثمار في هذا المشروع، مثل مازن ترزي وحيان قدور ومعن هيكل.
وفي السياق نفسه، يحضّر النظام للعديد من المشاريع استناداً للقانون رقم 10 لعام 2018، الذي يمكن اعتباره نسخة معدلة وموسعة من القانون رقم 66 لعام 2012، كونه يسمح بإنشاء مناطق تنظيمية في جميع أنحاء سوريا مخصصة لمشاريع التطوير العقاري. ويتطلب القانون رقم 10 أن يتمكن سكان المناطق التي يتم إعلانها مناطق تنظيمية جديدة من تقديم طلبات لإثبات ملكياتهم خلال مدة شهر من تاريخ الإعلان عن المنطقة التنظيمية، تحت طائلة فقدان الملكية في حال تعذر ذلك (المادة 2 فقرة 2-آ). وعندما يتعذر على المالكين إثبات ملكياتهم بشكل شخصي، فإنه يمكن للأقارب حتى الدرجة الرابعة أو للوكلاء القانونيين تقديم المطالبة نيابةً عنهم، ويحتاج الأقارب إلى إثبات علاقتهم بالمالك عن طريق الوثائق الثبوتية الرسمية، ويجب على الوكيل القانوني أن يستحصل موافقة أمنية من أجهزة الأمن السورية. وبالتالي فإن عدداً كبيراً من المالكين سيواجهون صعوبات كبيرة في إثبات ملكياتهم العقارية، سيما وأن عدداً كبيراً منهم قد نزح إما داخلياً أو خارجياً، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الكثير من المهجرين فقدوا وثائقهم الشخصية ومستندات الملكية الخاصة بعقاراتهم بسبب التهجير. علاوة على ذلك، فإن عدداً كبيراً من السكان قد قُتل أو اعتُقل أو فُقد. أضف إلى ذلك أن اشتراط الحصول على الموافقة الأمنية سيشكل عقبة أمام المالكين للمطالبة بممتلكاتهم، لأنه من غير المرجح أن يتقدم المقيمون في المناطق التي كانت تحت سيطرة المعارضة بطلبات للحصول على تصريح أمني، بسبب خوفهم من انتقام الأجهزة الأمنية.
ومن المناطق التي سوف تخضع لإعادة إعمار استناداً للقانون رقم 10، وفقاً لما صرحت به الحكومة السورية، حي بابا عمرو في حمص، المعروف بأنه من أولى المناطق التي ثارت ضد الحكومة السورية، وكان قد تعرض لحملة عسكرية شرسة وحصار دام عدة أشهر، ما أدى إلى تدمير معظم الحي وتشريد غالبية سكانه المدنيين بشكل قسري. وفي هذا السياق، باشرت السلطات السورية بالتحضير لإعادة إعمار منطقتي القابون وجوبر في دمشق استناداً للقانون نفسه، وهي أيضاً من المناطق التي تعرضت للقصف والحصار من قبل قوات النظام، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق مصالحة مع الفصائل المسلحة المعارضة التي كانت تسيطر عليهما، والذي نجم عنه تشريد آلاف المدنيين بشكل قسري. وبالتالي فإنه من المرجح أن سكان هذه المناطق لن يكونوا قادرين على إثبات ملكياتهم وفقاً للشروط المنصوص عليها في القانون، بسبب الظروف السالف ذكرها.
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن النظام أصدر في 6 تشرين الثاني 2018 القانون رقم 42، القاضي بتعديل مهلة التقدم بتصاريح الملكيّة وبادعاء الحقوق العينية، وجعلها سنة ميلادية كاملة بدءاً من تاريخ الإعلان عن المنطقة التنظيمية، إلا أن صعوبات إثبات الملكية المذكورة أعلاه تبقى موجودة رغم زيادة المدة، بالإضافة إلى أن القانون 42 لا يتضمن أي تعديل على أحكام القانون رقم 10، التي تسمح للوحدة الإدارية بالاقتطاع المجاني من الأراضي (المادة 2 الفقرة 11)، ولا على الآلية القسرية التي حددها القانون للتصرف بملكية الأسهم من قبل المالكين، وفق طرق ومدد محددة سلفاً تمنح المالكين ثلاث خيارات للتصرف بحصصهم؛ إما عن طريق تسجيل المقسم بأسمائهم والحصول على حصة من أرباح إعادة الإعمار، أو إنشاء شركة مساهمة مع مالكي حصص آخرين لبناء وبيع واستثمار المقاسم، أو بيع حصصهم بالمزاد العلني (المادة 2 الفقرة 17). وكذلك، لم يعالج التعديل القصور الموجود في الأحكام المتعلقة بالسكن البديل (المادة 2 الفقرة 24)، وهي أحكام تشكل انتهاكاً صارخاً لحق الملكية الذي يكفله الدستور (مادة 15) والقانون الدولي.
وأخيراً، قامت محافظة ريف دمشق بمنح العديد من العقود لشركة الإنشاءات العسكرية والشركة العامة للطرق والجسور استناداً للقانون رقم 3 لعام 2018 (المتعلق بإزالة الأنقاض)، وهي عقود تتجاوز قيمتها ثلاث مليارات ليرة سورية (6 مليون دولار)، لإزالة الأنقاض من شوارع المدن المدمرة في ريف دمشق. وكذلك تم منح عقود مشابهة من قبل محافظة حلب ومحافظة حمص تقدر بمئات ملايين الليرات. ومن المرجح أن يسهم هذا القانون بشكل كبير بنهب الأملاك والمقتنيات الخاصة، إذ لن يتمكن العديد من أصحاب العقارات المهدمة والمشمولة بهذا القانون من تقديم طلبات إثبات ملكيتهم خلال المدة القصيرة نسبياً التي حددها القانون (30 يوماً من تاريخ إعلان قرار المحافظ الذي يحدد المناطق العقارية والمباني المتضررة المشمولة بهذا القانون).
والواقع أن الشروط الإجرائية التي تتضمنها هذه القوانين للمطالبة بالملكية، مجتمعة مع التوقيت والسياق السياسي الذي صدرت فيه، ترجّح بشكل كبير أن الغاية الأساسية منها هي معاقبة المدنيين الذين يعتبرهم النظام معارضين له والاستيلاء على أملاكهم. إن جميع المناطق التي يشملها المرسوم 66 شهدت حراكاً مدنياً سلمياً ضد النظام الحاكم للمطالبة بالحقوق الأساسية التي تكفلها القوانين والمعاهدات الدولية، قبل أن تخضع لاحقاً لسيطرة الفصائل المعارضة، في حين لم تكن المناطق العشوائية الأخرى التي يسكنها موالون للنظام مشمولة بأحكام المرسوم. وكذلك فإن معظم المناطق التي يجري التحضير لإعادة إعمارها استناداً للقانون رقم 10 أيضاً شهدت حراكاً سلمياً منذ بداية الثورة، كما ذُكر أعلاه.
إضافة إلى ذلك، لو افترضنا أن الغاية من هذه القوانين هي التنظيم العمراني للمناطق العشوائية، فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا: لماذا لم يتم فعلاً تنظيم هذه المناطق من قبل، سيما وأن مشكلة العشوائيات في سوريا قديمة، وقد تم عقد العديد من المؤتمرات وإعداد كثير من الدراسات بشأنها قبل عام 2011؟ وبالتالي يبدو واضحاً أن هذه القوانين مدفوعة سياسياً، ومن المرجح أن تنتهك حق سكان المناطق المذكورة في الملكية وفي السكن اللائق المحمي بموجب القانون الدولي، وبالتالي قد تشكل عقبة حقيقية أمام عودة اللاجئين إلى ديارهم واستعادة أملاكهم.
وفقاً للقانون الدولي، يعتبر حق اللاجئين والمهجرين في العودة الطوعية إلى منازلهم قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي، تم النص عليها وتأكيدها في العديد من معاهدات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 12) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 13)، اللذين ينصان صراحة على حق كل فرد في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده والحق في العودة إلى بلده. إضافة إلى ذلك، فإن حق اللاجئين في العودة الطوعية إلى أوطانهم مكرّس أيضاً في المادة (5/د/2) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي تؤكد أيضاً على حق كل فرد في العودة إلى بلده دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو العرقي.
في السياق نفسه، يقر القانون الإنساني الدولي، الذي ينطبق على أوقات النزاعات المسلحة فقط، بحق اللاجئين والنازحين في العودة إلى منازلهم وأماكن إقامتهم المعتادة بمجرد انتهاء أسباب النزوح، ويُعدّ هذا الحق قاعدة من قواعد القانون الإنساني الدولي العرفي التي تطبق في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية على حد سواء (القاعدة 132، دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي العرفي). وتفرض هذه القاعدة التزاماً على الدول باتخاذ جميع التدابير الممكنة لتسهيل العودة الطوعية والآمنة للاجئين والنازحين، وإعادة إدماجهم وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم. وقد تم التأكيد على حق اللاجئين في العودة في العديد من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، على سبيل المثال القرارات التي تؤيد عودة اللاجئين إلى كرواتيا والبوسنة ورواندا. كما تم الاعتراف بحق العودة في العديد من اتفاقات السلام، كاتفاق دايتون الذي وضع نهاية للنزاع في البوسنة والهرسك.
مع ذلك فإن تنفيذ هذا الحق ليس سهلاً من الناحية العملية، إذ يرتبط حق العودة ارتباطاً وثيقاً بحق الملكية، بحيث لا يمكن العمل على إعادة اللاجئين دون ضمان حقهم في استعادة أملاكهم. وبالتالي، من أجل حماية حق اللاجئين والنازحين داخلياً في العودة بشكل فعال، فإنه يجب إيلاء قدر كبير من الاهتمام لحماية حقوقهم في استعادة أملاكهم خلال عملية إعادة الإعمار. فالدول ملزمة بموجب القانون الدولي بحماية حقوق الملكية لجميع اللاجئين والنازحين داخلياً. وتستند هذه الحماية إلى الحق في السكن الملائم المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المواد 17 و25) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 11). ويفرض هذا الحق التزاماً على الدول، ليس فقط بحماية الأفراد من التهجير القسري والتدمير التعسفي لممتلكاتهم، وإنما أيضاً ضمان حق اللاجئين والنازحين داخلياً في استرداد ممتلكاتهم أو الحصول على التعويض الملائم في حال كان الاسترداد مستحيلاً من الناحية العملية.
ولا بد من الإشارة في هذا الصدد إلى أن الصلة الوثيقة بين حق اللاجئين في العودة وحقهم في حماية واسترداد ممتلكاتهم، تظهر بشكل جلي وواضح في مبادئ الأمم المتحدة بشأن السكن واستعادة أملاك اللاجئين والنازحين (تعرف باسم مبادئ بينهيرو) التي اعتمدتها اللجنة الفرعية للأمم المتحدة المعنية بحماية حقوق الإنسان وتنميتها في عام 2005، حيث تعتبر هذه المبادئ الصيغة الأكثر شمولاً وصراحة ومنهجية لمفهوم حق اللاجئين في العودة الطوعية واستعادة أملاكهم في فترة ما بعد انتهاء النزاع كحق مستقل بذاته، وتقدم هذه المبادئ دليلاً قانونياً مفيداً لتقييم مدى توافق عملية إعادة الإعمار والقوانين العقارية التي صدرت في سوريا مع القانون الدولي. وعلى الرغم من أن مبادئ بينهيرو ليست معاهدة دولية ملزمة، إلا أنه قد تم اعتمادها والعمل بها من قبل العديد من الدول والهيئات والمحاكم الدولية، ما يعطيها قوة قانونية على الصعيد الدولي.
تنص مبادئ بينهيرو على حق جميع اللاجئين والنازحين في العودة طواعية إلى منازلهم أو أراضيهم أو أماكن إقامتهم السابقة (المبدأ 10)، كما تنص أيضاً على حق جميع اللاجئين والنازحين في استعادة أي مسكن أو أرض أو ممتلكات تم حرمانهم منها بصورة تعسفية أو غير قانونية، أو تعويضهم إذا قررت محكمة مستقلة ونزيهة أن الاستعادة مستحيلة في الواقع (المبدأ 2 الفقرة الأولى). وكذلك تؤكد المبادئ على التزام الدول باحترام حقوق المستأجرين وغيرهم من الشاغلين القانونيين للعقارات (المبدأ 16). بالإضافة إلى ذلك، فإن مبادئ بينهيرو تنصّ صراحة على عدم جواز اعتماد الدول لقوانين تؤثر على حق اللاجئين في استرداد أملاكهم، كإصدار قوانين تعسفية أو تمييزية أو غير عادلة (المبدأ 19)، كما هو حال القوانين العقارية التي صدرت في سوريا.
وأخيراً، لا بد من الإشارة أيضاً إلى أحد القواعد المستقرة في القانون الدولي، وهي أنه عندما تنتهك دولة ما التزاماتها بموجب القانون الدولي، تكون هذه الدولة ملزمة بجبر الأضرار عن طريق إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الضرر، أو التعويض عند استحالة ذلك. ويُعدُّ هذا الالتزام قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي (قاعدة 150 من دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر). وتتجلى هذه القاعدة صراحةً في المبدأ 13 من مبادئ بينهيرو. ويُنظر إلى الإعادة على أنها شكل من أشكال العدالة التصالحية، التي يتم من خلالها إعادة الأفراد أو مجموعات الأشخاص الذين يعانون من ضرر، نتيجة لإخلال الدولة بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، قدر الإمكان إلى الحال الذي كانوا عليه قبل حصول الضرر.
ولما كانت السلطة السورية قد أخلت ابتداءً بالتزامها المفروض عليها بموجب القانون الدولي، الذي يحرّم التشريد القسري والتدمير التعسّفي للممتلكات المدنية، فإنها تكون ملزمة بموجب القانون الدولي بتسهيل استرداد الأفراد لممتلكاتهم خلال فترة ما بعد انتهاء الحرب وأثناء إعادة الإعمار، وفي حال تعذر ذلك فإنها ملزمة بدفع تعويضات عادلة للمتضررين.
وبالتالي، فإن السلطات السورية ملزمة بموجب القانون الدولي باتخاذ جميع التدابير والإجراءات الممكنة لحماية حقوق الملكية لجميع اللاجئين والنازحين داخلياً خلال عملية إعادة الإعمار، وذلك من أجل تسهيل وتيسير عملية عودتهم بشكل آمن، ويشمل هذا الالتزام عدم إصدار قوانين تمييزية تنتهك هذه الحقوق. وهذا ما لم يفعله النظام حتى الآن، إذ أكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أكثر من مرة أن ظروف عودة اللاجئين والمهجّرين السوريين ليست مواتية بعد، لأن السلطات السورية لم تقم بتنفيذ التزاماتها الدولية المتمثلة بخلق الظروف اللازمة وتقديم الضمانات الحقيقية من أجل عودة آمنة وكريمة لهم.
بناءً على ما سبق، فإن إصدار قوانين عقارية كالقانون رقم 10 والقانون رقم 66 المذكورين أعلاه يشكل إخلالاً بالتزامات النظام السوري المنصوص عليها في القانون الدولي، ولا سيما لجهة احترام وحماية حق اللاجئين والنازحين في العودة إلى بلداتهم وقراهم، وحقهم في استرداد أملاكهم وعقاراتهم والحصول على التعويضات المناسبة في حال تعذر ذلك. بعبارة أخرى، فإن عملية إعادة الإعمار، يجب أن تتوافق مع ما تقتضيه القوانين والمواثيق الدولية، بشأن العودة الطوعية للاجئين واستعادة أملاكهم التي نُزعت منهم بشكل تعسفي أو غير قانوني، والتي تضمن حقهم في الحصول على التعويض المناسب في حال كانت استعادة العقارات مستحيلة من الناحية العملية. بحيث تؤدي عملية إعادة الإعمار بالنتيجة إلى إعادة إدماج اللاجئين والمهجرين وتفعيل دورهم في مجتمعاتهم، وليس مجرد إعادة إعمار للأبنية فقط.
ثانياً: المخاطر القانونية التي تواجه الدول والشركات المساهمة في إعادة إعمار سوريا
لا شكّ أن إعادة الإعمار في سوريا قبل انتهاء النزاع بشكل كامل، وفي ظل سيطرة النظام السوري وحلفائه ونخب رجال الأعمال السوريين الموالين له، سيعرّض الدول والشركات المشاركة فيه إلى مخاطر قانونية كثيرة. وبعبارة أخرى، فإن الجهات المساهمة في إعادة الإعمار ضمن هذه الظروف ستواجه خطر الاتهام بالمشاركة أو المساعدة في الجرائم المرتكبة من قبل النظام وحلفائه في سوريا، أو ستتعرض لخطر الاتهام بالمشاركة في تعزيز الجرائم الدولية التي ارتكبت سابقاً، عن طريق إعادة إعمار المناطق التي ارتُكبت فيها الجرائم من قبل الأطراف المذكورة، على سبيل المثال.
من الممكن تحميل الشركات التي تشارك في صفقات تجارية ذات صلة بإعادة الإعمار، مع النظام أو غيره من مرتكبي الجرائم الدولية، المسؤولية القانونية عن المساعدة في تمويل هذه الجرائم، حتى وإن كانت هذه الشركات لا تعلم كيف سيتم استخدام الأموال الناجمة عن هذه الصفقات، إذ يكفي فقط إثبات وجود هذه الأموال التي تسمح لمرتكبي الجرائم بالاستمرار في جرائمهم. وعلاوة على ذلك، قد يتعرض ممثلو الشركات المساهمة في عملية إعادة الإعمار للمساءلة بموجب القانون الجنائي الدولي إذا كانوا يعلمون أن أفعالهم سوف تسهّل أو تشجّع أو تقدّم دعماً مادياً أو معنوياً للنظام وحلفائه في ارتكاب الانتهاكات والجرائم الدولية.
في السياق السوري، يمكن لمجرد تقديم المساعدة المالية للحكومة السورية أو للأطراف المتهمين بارتكاب جرائم دولية وانتهاكات لحقوق إنسان أن يُعتبر سلفاً تمويلاً لانتهاكات قانونية وجرائم دولية، حيث أن حجم الجرائم المرتكبة في سوريا كبير ومعروف بشكلٍ كافٍ لدرجة أنه لا يمكن لأي دولة أو شركة أن تدعي عدم المعرفة بها. أي إن الدول والشركات المشاركة في إعادة الإعمار قد تغدو متورطة في جرائم دولية في حال قامت بتزويد مرتكبي هذه الجرائم الرئيسيين (الحكومة السورية، روسيا، إيران، نخب رجال الأعمال السوريين) بالوسائل التي تساعدهم على ارتكاب هذه الجرائم، ويشمل ذلك توفير البضائع، الخدمات، المعلومات، الأمور اللوجستية، الدعم المالي… وكلما كانت المساعدة التي تقدمها الشركة مباشرة كان إثبات مسؤوليتها عن الجرائم أسهل.
هنالك العديد من السوابق القضائية الدولية التي تؤكد على المسؤولية القانونية في هذا الصدد، فعلى سبيل المثال، خلال محاكمات نورمبيرغ في أعقاب الحرب العالمية الثانية، تمت إدانة شخص يدعى فريدريك فليك بتهمة مساعدة «فرق الحماية» (إس إس)، وهي منظمة نازية شبه عسكرية. وقد كان فليك رجل أعمال وعضواً في مجموعة «أصدقاء هملر»، التي كانت تضم رجال أعمال يجتمعون بعناصر القطع العسكرية النازية. وعلى الرغم من الأدلة التي تقول إن فليك وغيره لم يكونوا مدركين بشكل كامل لحجم جرائم هذه الفرق النازية خلال السنوات الأولى، إلا أن المحكمة رأت أن حجم الجرائم المُرتكبة كان معروفاً بشكل كافٍ لدرجة أنه كان على فليك وغيره أن يعلموا بها. وقد انتهت المحكمة في قرارها إلى أن المساعدات المالية الذي قدمها فليك ومدعىً عليه آخر (10% من حجم التبرعات التي قدمتها مجموعة أصدقاء هملر) تعتبر مبلغاً كبيراً بما يكفي لتحميله مسؤولية مساعدة الفِرق في جرائمها.
كذلك، أكدت الاجتهادات القضائية الصادرة عن المحاكم الجنائية الدولية أن المسؤولية القانونية قد تترتّب على المشاركة أو التواطؤ في الجرائم الدولية حتى بعد حدوث هذه الجرائم. ففي قضية بلاغويفيتش ويوكيتش، على سبيل المثال، انتهت المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا إلى اتهام المدعى عليهما في المساعدة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لتقديمهما الدعم اللوجستي بعد الهجمات على سيربينيتشا عام 1995، إذ قام كل من بلاغويفيتش ويوكيتش بتوفير الأدوات والأشخاص للمشاركة في حراسة وترحيل الضحايا، بالإضافة إلى المساعدة في دفن هؤلاء الضحايا أيضاً في أعقاب الهجمات.
تعطي هذه السوابق القضائية الدولية مثالاً عن الأنشطة التي يمكن أن يترتب عليها مسؤولية قانونية للجهات المهتمة بإعادة الإعمار في سوريا. فقد لا تكون الدول أو الشركات منخرطة بشكل مباشر في أنشطة جنائية، إلا أن توفير الدعم الذي قد يمكّن مجرمي الحرب من مواصلة أعمالهم الإجرامية أو تعزيز جرائمهم السابقة قد يرتّب مسؤولية قانونية.
وبناءً عليه، فإن الدول أو الشركات التي تشارك في إعادة إعمار المناطق التي تم تدميرها وتشريد سكانها قسرياً قد تتعرض لخطر المسؤولية القانونية عن جرائم التهجير القسري للمدنيين واستهداف المدنيين والأعيان المدنية التي ارتكبها النظام السوري وحلفاؤه في هذه المناطق. كذلك، قد تواجه الدول أو الشركات المساهمة في إعادة الإعمار خطر المشاركة والتواطؤ في جرائم الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب واستخدام الأسلحة الكيماوية ونهب الممتلكات الخاصة، في حال دخلت في شراكات تجارية مع مرتكبي هذه الجرائم، مع إدراك الجهات المساهمة في إعادة الإعمار لدور مرتكبي هذه الجرائم. فالدخول في شراكات تجارية مع مرتكبي الجرائم الدولية قد يُنظر له على أنه توفير الوسائل اللازمة للجناة لمواصلة جنايتهم، سواء عن طريق تزويدهم بالأموال أو أي وسيلة أخرى قد تساعدهم في ارتكاب الجريمة.
خاتمة
تجادل هذه الورقة في أن القوانين العقارية التي أصدرتها السلطات السورية في إطار عملية إعادة الإعمار المزعومة هي قوانين تمييزية ومدفوعة سياسياً، الهدف منها معاقبة المدنيين في المناطق التي انتفضت سلمياً ضد الحكومة السورية. وهي تتعارض مع الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي على الحكومة السورية، وخاصة لجهة احترام وضمان حق المهجّرين في العودة وحقهم في استعادة أملاكهم. وبالتالي فإن الاعتماد عليها كأساس قانوني لعملية إعادة الإعمار سيؤدي إلى استمرار وتعزيز الجرائم الدولية وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة، كما سيخلق بيئة ملائمة لارتكاب جرائم دولية وانتهاكات حقوقية جديدة من جانب الدول والشركات المحلية والأجنبية التي ستساهم في إعادة الإعمار. وهذا لا شك سيشكل عائقاً حقيقياً أمام عودة اللاجئين واستعادتهم لأملاكهم، وسيعرقل أي جهود لتحقيق سلام مستدام في سوريا.
لا تعني عملية إعادة الإعمار إعادة إعمار الأبنية المدمرة فحسب، بل هي عملية معقدة وشاملة ومتعددة الأبعاد، يجب أن تتم على أسس من الديمقراطية والعدالة والمساواة، وأن تشمل تحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي والقانوني والاجتماعي، وأن تمنع استمرار ارتكاب مزيد الجرائم الدولية وانتهاكات حقوق الإنسان، بحيث تؤدي بالنتيجة إلى تأمين عودة النازحين واستعادة أملاكهم، وإلى توفر الشروط الملائمة لإعادة إدماجهم في المجتمع، وفي النهاية إلى تحقيق السلام المستدام في سوريا، وكل ذلك مما لا يمكن تصوره في الوضع الحالي.
باختصار، إن المساهمة في عملية إعادة الإعمار من قبل الدول والشركات قبل انتهاء النزاع المسلح بشكل كامل، واستناداً إلى القوانين العقارية الحالية، وفي ظل سيطرة النظام وحلفائه ونخب رجال الأعمال السوريين المرتبطين به والمسيطرين على جميع مفاصل إعادة الإعمار، بالإضافة إلى أنها تشكل انتهاكاً لحقوق النازحين واللاجئين في العودة وفي الملكية، ستساهم أيضاً في دعم رواية الحكومة السورية بأن النزاع قد حُسم، وبأن الوضع أصبح جاهزاً من أجل عودة آمنة وكريمة للاجئين والمهجرين. وهو سيؤدي أيضاً إلى تقويض الجهود الرامية إلى محاسبة المتورطين في الجرائم الدولية وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في سوريا.
*****
مهند شراباتي: محامي سوري. حاصل على ماجستير في القانون الدولي لحقوق الإنسان من جامعة لوند ومعهد راؤول والينبرغ لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في السويد. ويعمل حالياً كباحث قانوني في وحدة حقوق الإنسان والأعمال التجارية التابعة للبرنامج السوري للتطوير القانوني، والتي تهدف أساساً لضمان احترام وصون حقوق الإنسان خلال عملية إعادة الإعمار في سوريا.
«النزاع» والعمران وخطايا الأمم المتحدة/ هاني فاكهاني
إن فشل الأمم المتحدة في التعاطي مع العمران في سياق سوريا «النزاع» – سوريا الولاء والعداء؛ سوريا المقاومة والإرهاب؛ سوريا الفوضى والحرية – وفشلها في فهم «النزاع» ضمن سياقه العمراني في سوريا المكان – سوريا الشوارع والعمران؛ سوريا الحواجز والحصار؛ سوريا التهديم والإعمار – جعل جهدها لإغاثة ضحايا الحرب جَرحاً، ودفعها نحو التعافي والسلام فتنة، وسعيها لبناء ما دمرته الحرب قهراً، فأضرّت بسوريا من حيث أرادت أن تنفع، وخاطرت بالهبوط بها من حيث أرادت أن ترفع. تسلط المقالة هذه الضوء على أخطاء منهجيات تدخل الأمم المتحدة في السياق السوري، لا توجيهاً لأصابع الاتهام بل محاولةً للوقوف على الأسباب بهدف تقييم المقاربة الدولية «للنزاع» والعمران في سوريا.
ظلم يتبعه ظلم، ونزاع يتبعه نزاع
ما حدث في سوريا في السنوات السابقة لم يولد من العدم. فسوريا كانت – كما يقال – بركاناً يغلي وانفجر. فالقمع السياسي، والاقتصاد المحتكَر، والتضخم السكاني، والتردّي الخدماتي، والقصور التنموي، والفساد المؤسساتي، والتخطيط الإقصائي، والظروف المهينة لمئات آلاف «سكان المخالفات»، والتأميم، والاستملاك، وتسلّط المحاسيب على الأرزاق والعقارات، شكّلت كلها مظلوميات عمرانية تراكمت على مرّ الأيام والسنين وجعلت من انطلاق الاحتجاجات قدَراً برسم الحالمين بمستقبل أفضل. هذا المستقبل استغله كثيرون، سوريين وغير سوريين، لإرضاء مطامع وتحقيق مكاسب على حساب آمال الشعب المكلوم.
يرى كثيرون أن حلم الناس لم يُثمر، وأن الحرب في سوريا لم تزد على مصائب الماضي إلا ظلماً ونزاعاً وإرهاباً. فالانقسام الحاد جعل من الحكومة الشرعية عند البعض نظاماً إجرامياً عند الآخر، ومن أصدقاء سوريا لدى الطرف الأول أعداء وشركاء في جرائم حرب عند الطرف الآخر، ومن المقاتل الشريف هنا إرهابياً مجرماً هناك، وهكذا في سلسلة غير منتهية من الانقسامات والتجاذبات والتحزّبات تحولت معها مواضع النزاع في سوريا إلى صراعات مدمّرة. هذه النزاعات جعلت من كل شيء في سوريا فضاءات لها وأدوات فيها؛ فصارت الأحياء والشوارع والحواجز والمزارع والمنازل والكهرباء والمياه والمشافي والجسور وحتى القبور مسارح للصراع تارةً، وسلاحاً تُستخدم فيه في تارة أخرى؛ تتلاعب بها أطراف النزاع أو تدمّرها أو تطوعّها بما يدفع مؤيدي الطرف الآخر إلى الحياد أو الاستسلام أو الموت. تعجّ التقارير بالأمثلة عن ذلك، فحصار الأحياء وتدمير ما فيها من خدمات ومقومات للحياة، أو تسويتها كلها بالأرض – بالقذائف أو بالجرّافات – لم يكن عرضاً من عوارض الحرب بل نهجاً مترصّداً، سواءً لتحقيق نصر عسكري أو لمعاقبة «المارقين» الذين ارتموا في كنف «أعداء الوطن» و«الإرهابيين» أو ببساطة لمجرد الانتقام. لم يزد هذا النهج من نزاعات الماضي إلا نزاعاً آخر، معارك متتالية تصبّ الزيت على النار وتأخذ بسوريا إلى دوامة بلا نهاية. وقد خلّفت هذه الدوامة آلافاً من السوريين بين لاجئ يحنّ لأهله وداره، ومهجّر يتحسّر على خرائب بيته، ومُبعَد لا حيلة له بالعودة إلى بلد تهدّم ثلثاه، ودمّرت نصف مدارسه ومشافيه واحترقت فيها جميع ذكرياته.12
قد يقول البعض إن أبشع صفحات حرب الأمس طُويت، وأن إعادة الإعمار انطلقت، متجاهلين أن لكل شيء في سوريا نزاعاً، وأن لكل نزاع معركة ولّادةً للمظالم وهدّامةً للحقوق والآمال. فما يُفترض أن يكون عملية إعادة إعمار واستعادة أمل يتكشف اليوم عن ممارسات إقصائية لا تراعي حقاً ولا تأبه بأي من شرائح المجتمع من المتضررين والمهجّرين، حاملةً في طياتها منافع للبعض القليل ومصائب ومظالم جمّة للكثيرين الآخرين، وحارمةً بذلك السوريين من أمل إعمار يجبُر المظالم ويكون خطوة نحو السلام.
في خضم هذا النزاع المعقد لما قبل الحرب وما في الحرب وما يُخطَّط له بعد الحرب، تعجز الأمم المتحدة و«أصدقاء سوريا» عن فهم النزاع في السياق العمراني وفهم العمران في سياق النزاع، جاعلين من أنفسهم شركاء في الظلم من حيث يعلمون أو لا يعملون، وجاعلين من تدخلاتهم وإنجازاتهم وانسحاباتهم ومساعداتهم ومفاوضاتهم ومنهجياتهم في الإعمار أخطاء متتالية في وادي المأساة السورية.
نهج خاطئ لمفاوضات السلام
فشل الأمم المتحدة في فهم النزاع في سوريا ضمن سياقها الجغرافي-السياسي، كمكان تتصارع فيه المصالح الإقليمية، قادها نحو طريق السلام الخطأ. فإعلان المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي مستورا نهاية عام 2017 أن فرصة ذهبية للمفاوضات المباشرة بين المعارضة والنظام السوري تلاشت، وإقراره بذلك بالانهيار الكامل للمفاوضات السورية في جنيف، وتأكيده عدم وجود أي حافز لدى نظام الأسد للجلوس على طاولة المفاوضات – في ظل ثبات المعطيات على الأرض وغياب أي ضغط روسي فعال – لم يكن إلا فشلاً جديداً في سلسلة طويلة امتدت لسنوات، فشلاً وراء فشل، لمحادثات السلام الأممية العقيمة.3 ما شهدته سوريا في السنوات اللاحقة، من مفاوضات سوتشي التي جمعت روسيا وإيران وتركيا، ومن دون وجود ذكر للسوريين، وما أفضت إليه في بعض الأحيان من تهدئة ما، ليس سوى دليل آخر على الدور المحوري الذي تلعبه حرب الوكالة الدائرة في سوريا.
يتفق الكثيرون أن سوريا ملك للسوريين، بأرضها وحضارتها ومستقبلها، ولكنهم يختلفون حول مستقبل الحرب في سوريا وما إذا كان فعلاً بيد السوريين وحدهم، في ضوء المكانة التي تحتلها سوريا على أجندات المتصارعين الاقليميين. فلا تخفى على أحد كثرةُ الأصابع الخارجية التي حرّكت وتحرّك الحرب في سوريا لخدمة مصالحها، ولا يخفى على أحد أن الكثير ممن يقاتلون في سوريا بيادق في لعبة حرب الوكالة التي تتخذ من تراب سوريا مسرحاً لها. فلروسيا في سوريا معركة إثبات وجود، وقاعدة عسكرية استراتيجية لا تعوّض بثمن، وخط يتم العمل عليه لتصدير الفوسفات؛ وللخليج المتهافت اليوم في الأرض السورية مضمار لكبح الطموح الإيراني؛ ولإسرائيل أيضاً مصلحة شبيهة ومصالح أخرى. هذا بغض النظر عما أحدثه الدمار من فرصة هائلة للاستثمار والانتفاع من الإعمار بالنسبة لكثير من تلك الأطراف. فمن البديهي إذاً ألا يكون حل الحرب السورية بيد السوريين فقط في ظل فشلهم وطمع الآخرين. فالتاريخ يعلمنا أنه لا شيء ينهي الحروب الأهلية المشتعلة أكثر من كبح جماح الحروب الباردة من ورائها والتعامل مع الأصابع التي تحرّكها من وراء الستار. ولنا في حروب أنغولا وغواتيمالا وفييتنام ولبنان وغيرها أمثلة.4
من هنا، ألا يمكن القول إن الأمم المتحدة، ولأعوام متتالية، فشلت في التعامل مع سوريا كمسرح حرب باردة بين لاعبين إقليميين يضيفون إلى الصراعات التي فيها صراعاتهم الخاصة؟ ألا يمكن القول إن المنظمة الدولية الكبرى أخفقت في لجم الأمم المتفرقة عن اتخاذ سوريا أرضاً لتصفية حساباتهم وتحقيق مصالحهم؟ ألا يمكن القول إنها رعت مفاوضات السلام الخاطئة أو القاصرة في جنيف؟ ألا يمكن القول إن منظمة الأمم المتحدة سارت في اتجاه السلام الخطأ؟
نهج خاطئ للمساعدات الإنسانية
رغم فشل المفاوضات، والتسويف الحالي للأمم المتحدة في الانخراط بعملية تمويل إعادة الإعمار انتظاراً لمرحلة «ما بعد الحرب»، قد يكون من الإجحاف القول إن نيتها كانت أو ما زالت إهمال الناس وتركهم لمصيرهم في الحرب. فالعُرف الدولي السائد يُلزم المجتمع الدولي بتركيز الجهد على المساعدات الإنسانية لإغاثة ضحايا الحرب ومساندتهم. غالباً ما تواجه هذه المساعدات تحديات جمّة في سياقات الحروب الأهلية، لما فيها من تعقيدات سياسية وحساسيات اجتماعية وطبقات متراكمة من المظلوميات والنزاعات والخلافات. وذلك فإن المؤسسات الإنسانية، تفادياً للانخراط في هذه التعقيدات وتركيزاً على دورها الإنساني، تتّبع جملة من المبادئ القديمة الراسخة للتدخل: كمبدأ الحياد ومساعدة كل المحتاجين بغض النظر عن خلفياتهم؛ ومبدأ عدم الانحياز إلى أي طرف من أطراف النزاع. لكن للأسف، وبسبب إهمال البعد المكاني والعمراني للنزاع في سوريا، آلت الجهود الإنسانية والإغاثية للوقوع في فخ التحديات التي حولتها إلى – وبعبارة متحفظة – حلقة جديدة من حلقات الضرر والظلم.
ففي أشد مراحل الحرب في سوريا استعاراً، قامت الجهات المتصارعة باستخدام العمران وسيلة من وسائل الحرب، ليقوم الجيش السوري ومساندوه باستخدام المدن كسلاح واستغلاله بكل الأساليب الممكنة لإلحاق الهزيمة العسكرية والسياسية والمعنوية بالمعارضة وبكل من أيّدها من أفراد وجماعات الشعب السوري. كان أحد أبرز هذه الأساليب فرض الحواجز والحصار على مدن أو أحياء برمتها، لتجويع مقاتلي المعارضة ومؤيديهم من السكان وتدمير معنوياتهم وإجبارهم على الانسحاب أو الاستسلام. ذلك كله في الوقت الذي يتم فيه التسويق للرواية الرسمية بأنه لا أحد يريد العيش تحت وصاية المعارضة «الإرهابية» أو في أماكن تواجدها، فالكل، يقول النظام، يفرّون من المعارضة والإرهابيين الذين يتخذونهم دروعاً بشرية ليعودوا إلى «حضن الوطن».
عملت الأمم المتحدة في هذا السياق لتنفيذ تدخلاتها الإنسانية وتوزيع مساعداتها الإغاثية عن طريق مكتبها لتنسيق المساعدات الإنسانية في فندق الفورسيزنز في قلب العاصمة دمشق، وذلك في سياق أحاط عملها بالكثير من الصعوبات والتحديات والتناقضات. وفي نهاية المطاف، وتحت مبررات ضرورات العمل من قلب دمشق، وبحجة أن وصول بعض المساعدات أفضل من عدم وصول أي مساعدات على الإطلاق، اختار مكتب المنظمة الرضوخ بشكل واضح لشروط وتوجيهات النظام السوري، والذي وضع كل ما طالته يده من عقبات في وجه إيصال المساعدات للمحاصرين في أنحاء سوريا، خاصة في أرياف دمشق. دفعت هذه الحيثيات كثيراً من فاعلي المجتمع المدني للاحتجاج. فقد وقعت أكثر من خمسين جمعية ومنظمة سورية تقريراً احتجاجياً مفصّلاً5 يتهم عمليات الأمم المتحدة بالانحياز للنظام وعدم التزام الحياد، وبالتالي مخالفة أهم أعمدة ومبادئ العمل الإنساني والإغاثي. أفاد التقرير أن ملايين الدولارات المخصصة لدعم المنظمات العاملة من دمشق وُزّعت بشكل شبه حصري في المناطق الخاضعة للنظام، وأن عمليات الأمم المتحدة لم تقدم المساعدات للمناطق المحاصرة بسبب قيود النظام لا بسبب الدافع الأمني لحماية عاملي الأمم المتحدة. استدل التقرير بأمثلة عديدة مثل عبور شاحنات المساعدات من خلال دوما، المحاصرة والشديدة العوز، للوصول إلى كفربطنا الخاضعة لسيطرة النظام في دمشق ومن دون تقديم أي مساعدات لأهل دوما أنفسهم. وفي الأشهر الثمانية الأولى من عام 2015 وصلت المساعدات الموزعة من خلال دمشق لما يقارب 4% فقط من المحاصرين. إن حيثيات الحصار العمراني المفروض على أحياء برمتها، والتدمير الممنهج للبنى التحتية والبنى الخدمية، والفشل الذي طال عمليات إيصال المساعدات للمحاصرين، كلها أجبرت الناس على الفرار من شبح الموت قصفاً أو جوعاً أو برداً أو مرضاً تحت الحصار. لم تجد هذه المأساة مكاناً حتى في تقارير مكتب تنسيق المساعدات، والذي دأب على استخدام مصطلحات بعيدة عن توصيف الواقع تجنباً لإغضاب النظام السوري، مفضّلاً الخضوع لممارسات غير شفافة وإعادة صياغة التقارير والمصطلحات المستخدمة ونفي وجود المنظمات الإنسانية غير التابعة للنظام.6
في ظل غياب الفهم العميق لأهمية السياق العمراني بما فيه من حدود وحصار وتدمير متعمد للبنى التحتية والعمار، شكّل توزيع مكتب الأمم المتحدة لمساعدات بقيمة مليارات الدولارات ضرراً من حيث أراد النفع، وتعمّق جراح الشعب المنكوب، وتجاوز المبادئ الراسخة في العمل الإغاثي والإنساني. فبدل الحيادية المطلوبة، أسهمت عمليات الأمم المتحدة بتعزيز رواية النظام الرسمية عن عدم رغبة الناس في العيش خارج سيطرة النظام، وعن اندفاعهم «بالآلاف» نحو «حضن الوطن» دوناً عن أي من الروايات الأخرى. وخلافاً لمبدأ عدم الانحياز، ساهمت عمليات الأمم المتحدة – ولو عن غير قصد – في تعزيز سطوة أحد أطراف النزاع على حساب الأطراف الأخرى. وبدل حماية وإغاثة الأكثر ضعفاً، رضخت لإجبارها على تهميش أولئك القابعين في أسوأ الظروف المعيشية في العالم، محاصرين بالقصف والبرد والجوع والمرض. ورغم أن وجهة نظر القائمين على مكتب التنسيق جاهزة (بعض المساعدة أفضل من لا مساعدة على الإطلاق) لا يبدو أن آلاف الأهالي الذين قضوا جوعاً أو مرضاً أو برداً تحت الحصار أو هُجّروا من ديارهم يتفقون مع وجهة النظر هذه بعدما شهدوا الدعم السياسي والمعنوي والعسكري الذي قدمته للنظام السوري.
نهج خاطئ لإعادة التأهيل
تشير تقارير إلى أن غالب مشاريع إعادة تأهيل المدارس والمراكز الطبية وبناء المراكز الاجتماعية في حلب حدثت حصراً في الأحياء التي حددتها الحكومة كأولويةفيما يبدو موقف الأمم المتحدة من تمويل إعادة الإعمار واضحاً، أي لا إعمار حتى انطلاق عملية سياسية فعالة في البلاد، إلا أنها في عدة حالات فشلت في النأي بنفسها تماماً عن كل ما يمتّ للعمران وإعادة الإعمار بصلة – ولو كان ذلك تحت مسمى إعادة التأهيل أو المساعدات الإنسانية لتيسير عودة المهجّرين إلى منازلهم. فعلى سبيل المثال، بعد معركة حلب في نهاية عام 2016، والتي أعقبت فترات من الحصار الشديد، وانتهت بسيطرة النظام السوري على المدينة وتهجير مئات الآلاف من سكانها وتدمير جزء هائل من منازلها وبُناها التحتية في قسمها الشرقي، انخرطت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة في مشروعات بناء في حلب بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية التابعة للنظام السوري. وقد ركزت المشاريع على ناحيتين، الأولى إنسانية هي تيسير عودة اللاجئين؛ والثانية إعمار حلب القديمة. ولكن ما تسرّب من آليات إعداد خطط التدخل، كما ورد في تقرير لشبكة فوكس نيوز7 يدلل مرة أخرى على قصور الأمم المتحدة في تعاملها مع البعد العمراني كبعد محوري لضمان عمليات إعادة تأهيل عادلة ومستدامة ومبنية على الحقوق. ويبدو أن ديناميات مشابهة لسوء توزيع المساعدات في ريف دمشق حدثت في حلب في عام 2017. فرغم إعداد المفوضية للائحتها الخاصة بأسماء الأحياء ذات أولوية المساعدة والتأهيل، فإن تلك اللائحة لم تُعتمد إلا بعد مقاطعتها مع لوائح من إعداد النظام، وهو الطرف في النزاع الذي لم يتوانَ عن تطويع العمران لكسب جولة جديدة في الصراع. وبحسب التقرير فإن غالب مشاريع إعادة تأهيل المدارس والمراكز الطبية وبناء المراكز الاجتماعية حدثت حصراً في الأحياء التي حددها النظام كأولوية، علماً أن بعض المشاريع خدمت أحياء لم تكن أساساً في حلب الشرقية، الأكثر تعرضاً للدمار. ومن جهة أخرى، فإن هذه العمليات لم تأخذ بعين الاعتبار، ولا حتى بالحدّ الأدنى، الاعتبارات المحورية المرتبطة بعشرات الآلاف من سكان حلب الشرقية الذين يعيشون خطر فقدان عقاراتهم بعد تلف وثائق ملكيتهم؛ ولم تأخذ بعين الاعتبار حقيقة أن تأهيل المنازل في حلب الشرقية لا يكفي بحال من الأحوال لعودة عشرات آلاف المهجّرين الذين يخشون العودة لأسباب أمنية. ومن دون ضمانات فعلية أمنية وقانونية لعودة سكان حلب الشرقية الأصليين، تنطوي عمليات إعادة التأهيل هذه على تثبيت تهجيرهم وتعزيز حرمانهم من حقوقهم، وهي تُسهم في خلق شبكات نفوذ وسيطرة جديدة في المدينة محل الشبكات الأهلية القديمة، ناهيك عما يحمله انعدام السيطرة على آليات تحديد أولويات النظام من تعزيز لسطوته على حساب حقوق الناس.
تشير تقارير إلى أن غالب مشاريع إعادة تأهيل المدارس والمراكز الطبية وبناء المراكز الاجتماعية في حلب حدثت حصراً في الأحياء التي حددتها الحكومة كأولويةيصف تقرير «لا عودة إلى حمص»8 حالة ثانية لقصور تعاطي الأمم المتحدة مع عمليات إعادة التأهيل المندرجة ضمن برامج المساعدات الإنسانية. فقد تعرضت حمص مع بداية 2012 لحملة عنيفة من التدمير والمجازر والاعتداءات الجنسية والسرقة و«التعفيش»، والتي أدت لنزوح الآلاف من سكان المدينة، خاصة من الأحياء ذات الغالبية السنية. وخلال عدة أشهر، استعاد النظام السوري بدعم من الميليشيات المساندة له السيطرة على أجزاء واسعة من أحياء بابا عمرو وكرم الزيتون وباب سباع وغيرها من الأحياء، المجاورة في غالبها للأحياء ذات الغالبية العلوية. ساهم الطابع الطائفي لهذه الحملات في توليد الكثير الشحن الطائفي في حمص، والذي صار أحد ملامح النزاع الرئيسية فيها. وفي منتصف العام نفسه، فرضت قوات النظام وحلفائه حصاراً خانقاً على باقي أحياء المعارضة ومع تدهور الأوضاع فيها، بدأت العوائل بالنزوح رغم الخطر الذي كان ينطوي عليه ذلك، ولم يتبقَّ في حمص إلا أقل القليل. تجددت الحملة العسكرية في نهاية العام 2013، وانطلقت على إثرها مفاوضات برقابة أممية لإنقاذ حياة من تبقى من السكان العالقين عن طريق «الإخلاء»، أو ما تصح تسميته أكثر بالتهجير القسري، الأمر الذي عرّض الأمم المتحدة للنقد الشديد، خاصة مع ما رافق «الإخلاء» من اعتقال للرجال وتعذيبهم وقتلهم. لم تخفّ حدة هذه الانتقادات في المراحل اللاحقة، فبعد ما تعرضت له حمص من دمار وحصار وتهجير قسري، سمح النظام بعودة بعض سكان حمص لأحيائهم، مثل حي الحميدية ذي الغالبية المسيحية. كان الحميدية أول الأحياء التي تم السماح بعودة سكانها إليها، ومن أولها إدراجاً في برامج إعادة التأهيل المدعوم من الأمم المتحدة، الأمر الذي أجّج الشحن الطائفي أكثر فأكثر، خاصة مع بقاء أحياء مثل بابا عمرو والخالدية خاوية. ورغم إعادة تأهيل الطرق للوصول لمناطق عدة وسط حمص، تم تجاهل حي باب هود الاستراتيجي والذي كان معقلاً للمعارضة، وذلك لأسباب مجهولة يراها كثيرون ذات دوافع سياسية. يصف التقرير أيضاً كيف أن الأعمال المدعومة لإزالة الركام من حي جورة الشياح وسط مدينة حمص، والذي تم «إخلاؤه» باتفاقية عام 2014، لم ترافقها أي محاولات تواصل مع أصحاب المنطقة الأصليين، الأمر الذي يراه كثيرون تهديداً لحقوق ملكيتهم. ومن جهة أخرى فإن التزامات الأمم المتحدة للعمل مع الحكومة من أجل إعادة إعمار مدينة حمص، في وقت كان لا يزال فيه الأهالي في حي الوعر المجاور تحت الهجوم والحصار، تطرح تساؤلات أخلاقية وسياسية لا يمكن إغفالها. إن منهجية عمل الأمم المتحدة في حمص، سواء في مرحلة احتدام القتال أو فيما تلاها من مراحل بداية عودة بعض النازحين، تثير تساؤلات حول إسهامها في تعزيز استراتيجيات التغيير الديموغرافي، أو بأقل تعبير حول جدواها في تخفيف حدة النزاع والانتقال بطريقة فعالة نحو السلام.
نهج خاطئ لإعادة الإعمار
يصطف اليوم الحلفاء على طرفي جبهة معركة الإعمار معلنين ولاءاتهم، فحلفاء النظام أوضحوا مراراً دعمهم واستعدادهم للاشتراك بتمويل إعادة الأعمار. فقد قال نائب الرئيس الإيراني بداية عام 2019 أن بلاده «ستكون إلى جانب سوريا في مرحلة الإعمار، كما كانت إلى جانبها في الحرب على الإرهاب»، قبل أن يعلن عن توقيع مجموعة من الاتفاقيات الثقافية والاقتصادية والاستثمارية وغيرها.9 أما الرئيس الروسي فعمل على إقناع الغرب بتمويل الإعمار بحجة دفع اللاجئين للعودة، ووقّع اتفاقيات مع النظام السوري للمساعدة في التنقيب عن الفوسفات سيسيطر الروس بموجبها على 70% من ناتج الفوسفات السوري – وهو ما يمكن النظر إليه كاسترداد لفاتورة دعم السنوات السابقة أكثر منه مساعدة فعلية لسوريا. بالطبع، إذا ما نظرنا من ناحية عملية، فالقدرة المادية لروسيا وإيران لا توحي بإمكانية دعمهما لأي إعادة إعمار حقيقية في سوريا.10 وعلى الطرف الآخر من الجبهة، يستمر الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة بفرض العقوبات الاقتصادية على دمشق، مثبّطَين بذلك شهية المستثمرين على الإقدام على مشاريع الإعمار. وفي الوقت نفسه يتحفظ كلا الطرفَين الغربيَّين على تمويل إعادة الإعمار ريثما تبدأ عملية سياسية حقيقية ذات مصداقية في سوريا تؤدي لحكومة تمثل مصالح السوريين على حد تعبيرهم، مكتفِيَين حالياً بالتخطيط أو الدعوة للتخطيط لمرحلة ما بعد «الاتفاق» ليتمكنا من الاستجابة السريعة لمتطلبات الإعمار في حينها.11 وبدورها تتبع الأمم المتحدة المقاربة الأوروبية والأميركية وتعارض تمويل الإعمار في الوقت الحالي، مستخدمةً معارضتها هذه كورقة ضغط سياسية على السلطة في سوريا. أما دول الخليج فتقف اليوم متذبذبة في مكان ما بين طرفي الجبهة، وهي تدرس احتمالية التطبيع مع نظام عادته سابقاً لإبعاده عن دائرة النفوذ الإيراني في المنطقة، الأمر الذي قد يترجَم – إن حصل – إلى مبالغ هائلة يعرضها الخليج على دمشق وفقاً للغة المتبادلة بينهما منذ عقود. وبالفعل قامت الإمارات والبحرين بإعادة افتتاح سفارتيهما في دمشق، في حين تبقى السعودية وباقي دول مجلس التعاون الخليجي أكثر حذراً.12
قد يقول البعض إن المعارك تراجعت، وأعداد الضحايا في أدنى مستوياتها، ومعركة «إسقاط» النظام انحسرت وانهزمت. ولكن للأسف فإن حرب سوريا أثبتت دوماً أنها أكثر تعقيداً مما تبدو عليه. فإن صحّت بالفعل فرضية أن معركة إسقاط النظام سقطت، فلا شكّ أن معركة بقائه تمدّدت واستعرت. وبعيداً عن التجاذبات الكلامية حول من سيدفع فاتورة الإعمار، تواصل أجهزة الحكومة السورية محاولتها إبقاء النظام، متخذةً من التعمير والتدمير أسلحةً لتعزيز سلطته وسيطرته «إلى الأبد». يسعى النظام من خلال هذه الأسلحة لخلق أمر واقعٍ، وترتيبات اجتماعية وديموغرافية وسياسية جديدة، وأطر إعادة إعمار قانونية وتشريعية وعمرانية، بحيث يستحيل معها إسقاط النظام أو التفكير في محاولة إسقاطه، ويعاد من خلالها توجيه أي عمليات إعمار قائمة أو مستقبلية بما يمهّد لانتصار غير متنازع عليه في معركة البقاء. فبعد أن توالت الأنباء والتوثيقات لما جلبه الدمار والحصار والتلاعب بالخدمات من تهجير وتغيير ديموغرافي على أساس طائفي وسياسي تمييزي، ومن تعزيز للسلطة على أساس إقصائي، وبعد ما تم توثيقه من تجريف لأحياء برمتها بغير وجه حق في دمشق وحماة،13 تتوالى اليوم أنباء ما يسبّبه أو سيسبّبه الإعمار من تعميق لهذا التمييز والإقصاء. يطوّع النظام اليوم المشاريع والمخططات التنظيمية في دمشق وحماة وحمص، ويفرض جملة من القوانين الإشكالية للإعمار – من المرسوم رقم 66 لعام 2012 إلى القانون رقم 10 لعام 2018 وصولاً للقانون رقم 5 لعام 2016 وغيرها من القوانين الذائعة الصيت.14 وقد تعرضت هذه القوانين والمشاريع المصاحبة التي يتم تنفيذها لانتقادات واسعة لما فيها من محاولات لحصر الضرر بالمعارضين، أو الموصومين بـ«بالإرهاب» أو «حاضني الإرهاب»، ولما تنطوي عليه من مخاطر كبيرة قد تحرم الآلاف من سكان «المخالفات» من حقوقهم، وتحرم آلاف المهجّرين من منازلهم بسبب الحصار والدمار من استعادة ملكياتهم والعودة إلى مدنهم وقراهم، ناهيك عن إتاحتها المجال بشكل حصري لشركات تدور في فلك المحاسيب للتشارك مع الحكومة بما يضمن لها النموّ والتمكن والاستئثار بالانتفاع المادي. كل هذه ترتيبات ومشاريع أقل ما يقال فيها أنها تُقصي أكثر من عشرة ملايين لاجئ ونازح وتكافئ أولياء وحلفاء الحكومة وتمهد لسيطرتهم بطريقة لا يمكن منازعتها.15
في هذه الأثناء، يبدو أن العالم شغل نفسه بالتجاذبات القائمة حول سؤال «من سيدفع فاتورة الإعمار في سوريا؟». من سيدفع 488 مليار بأصفارها التسعة وبالدولار؟ أهُم صدقاء سوريا من هذا الطرف أم من ذاك؛ هل هم الروس والإيرانيون وحلفاء النظام؛ أم المتذبذبون الخليجيون، أم هي الأمم المتحدة وأوروبا وأميركا، أم خليط من هؤلاء وأولئك؟ يسألون هذا السؤال وكأن كل شيء عبارة عن مال، وكل مظلمة تحدث اليوم يمكن جبرها بالمال، وكل حي يُجرَّف اليوم يمكن استعادته بالمال، وكل عائلة تُطرد من أرضها اليوم يمكن إعادتها بالمال، وكل حيتان السوق الذين يتم تمكينهم اليوم يمكن تجاوزهم غداً بالمال، وكل قواعد الإعمار التي تبنى اليوم يمكن مَحوُها بالمال، وكل الوقت يمكن إرجاعه للوراء بالمال.
خطوات في الاتجاه الصحيح؟
إسقاط الضوء على أخطاء الأمم المتحدة، سواء في المساعدات الإنسانية خلال الحرب أو في المفاوضات الرامية لإنهائها أو في العمل على إعادة إعمار ما «بعدها»، ليس الهدف منه وضعها في قفص واتهامها بالفشل مراراً وتكراراً، بل هي محاولة للوقوف على أسباب هذا الفشل وسعي لتصحيح النهج. وهو ما ينطلق من رؤية أن الإعمار والسلام الحقيقيَّين غير ممكنَين دون إعطاء الأولوية لجبر مظالم الناس ووقف توليد غيرها، وأن ذلك هو الطريق الوحيد للإعمار والسلام المستدام.
تتوالى الأمثلة على التلاعب بالتخطيط العمراني واستغلال التدمير واحتكار عمليات التعمير لتؤكد مجدداً أن العمران ليس مجرد فضاءات فيزيائية وجدران وبنى تحتية حيادية، بل هو فضاء ووسيلة في آن معاً؛ كانت وما زالت تُدار فيه ومنه وبه النزاعات. هذا يجعل من فهم الارتباط الوثيق بين العمران والنزاع شرطاً جوهرياً لتصميم وتنفيذ أي تدخلات، سواء تحت مسمى الإغاثة أو التأهيل أو الإعمار، بما يضمن عدم المخاطرة بالوقوع في فخ الضرر الذي يراد منه النفع.
لا يمكن النظر لعمليات التدخل في النزاع السوري بأبسط أشكالها، كإيصال للمساعدات الإنسانية، كمجرد نقل مواد بشكل حيادي بين نقطتين محايدتين سياسياً وموجودتين في مكان محايد أو في «اللامكان»، خاصة عندما تحوّل الحرب الأمكنة المترابطة والنُّسُج العمرانية المتصلة لمجموعة من الأمكنة المتشظية والمنفصلة بالحواجز والسواتر والجبهات. ولا تعني حيادية العمل الإنساني التي تعلنها الأمم المتحدة أو أي من منظمات العمل الإنساني ذاك التجريد، بل تعني حياد التخطيط للعمليات والتدخلات من خلال استيعاب صلتها بسياسات السياق العمراني المكاني وما تحمله هذه الصلة من إمكانيات ترسيخ ظلم أو تعزيز سلطة جائرة، وبالتالي تثبيت حصار ظالم وتهجير سكان متعبين وتهديم آمال حالمين، وإعلاء صوت البروباغندات وتخفيض أصوات الضعفاء. رأينا ذلك في حصار الغوطة وحمص وحلب وغيرها؛ رأيناه عندما أسهمت عمليات الإغاثة القاصرة في تثبيت سردية النظام السوري وإنفاذ سياساته. لا أحد يرغب بالبقاء في الغوطة، والكل يغادرها، لا لجوع ولا لخوف ولا لمرض ولكن «للعودة إلى حضن الوطن» كما يقولون. لا يجب النظر لإيصال المساعدات كمجرد إيصال لمواد من نقطة أولى إلى نقطة ثانية من خلال نقطة ثالثة، بل هي عمليات متجذرة في السياقات العمرانية للنزاع كأمكنة جغرافية ذات أهمية سياسية محددة، وكمناطق نفوذ لقوى عسكرية محددة ذات أهداف محددة، وكحيّزات محاصرة أو مفصولة بحواجز تابعة لقوات محددة، وكبيئات حاضنة لمجتمعات بانتماءات وهويات محددة، وكأسماء لأحياء ارتبطت بذكريات محددة. إن فهم العمليات ضمن سياقها في النزاع العمراني بهذا العمق يطرح أسئلة كثيرة عن إمكانية تطبيق مبادئ الحيادية وعدم الانحياز بفهمها التقليدي في الإعمال الإغاثية ويجعلها أكثر تعقيداً، الأمر الذي يجب أن يُعيد البُعد الأخلاقي والسياسي – تحت مبدأ لا ضرر ولا ضرار – إلى صدارة العمل الإنساني، إذ لا تشكل عبارة «بعض المساعدات أفضل من لا مساعدات على الإطلاق» دائماً جواباً كافياً.
لعمليات التأهيل والإعمار تعقيدات أخرى، فهي لا تدور فقط في فلك الأمكنة بل تُدار بها. فتصبح الجدران والحجارة والعمران وما يرتبط بها من تدمير أو إعمار سلاحاً ذو حدين، يعمِّر بحدّه الأول ليهدم بالآخر، ويبسُط بحده الأول ليرفع بالآخر، ويجيب عن سؤال بحدّه الأول ليطرح عاصفة من الأسئلة بالآخر. يتجلى ذلك واضحاً في ممارسات النظام للإعمار بعقلية مقاتل في معركة البقاء. فعمليات الإعمار الحالية – سواء سنّ القوانين الإشكالية التي تهدّد أملاك الناس وتؤبّد نزوحهم، أو تمكين الشبكات الاستثمارية الموالية لاحتكار الإعمار، أو إعمار المشاريع الفخمة الإقصائية لخدمة الأقلية الغنية على حساب أكثر الناس ضعفاً – ما هي إلا نماذج عما قد يجلبه سيف الإعمار من تهديم وإجحاف. فإذا تم أخذ هذه الحيثيات والمجريات بعين الاعتبار، وإذا كان السعي للإعمار في الحقيقة بغية الوصول إلى السلام، تصبح جدليات التمويل حديثاً عقيماً لا طائل منه. فلا خير في تمويل إعمار قائم على هدم حقوق الناس، ولا خير في تمويل إعمار يهدف إلى تثبيت حرمان الناس، ولا خير في تمويل إعمار يعزّز سلطة جائرة. الأولوية هنا هي لضمان أن تسهم عمليات الإعمار باسترداد حقوق الناس وجبر مظالمهم ونزع فتيل النزاع والحرب، سواء أحدث الإعمار اليوم أم غداً أم في المستقبل البعيد، أياً يكن من يموّل هذا الإعمار، أكانت الأمم المتحدة أم أوروبا أم أميركا أم السعودية أم إيران؛ وأياً يكن من يقوده، أكانت الحكومة الحالية أم حكومة مستقبلية منتخبة أم الأمم المتحدة بحد ذاتها. من هنا فإن على الأمم المتحدة إعطاء الأولوية لدورها كمراقب لعمليات الإعمار، قبل دورها كممول لها، وعليها أن تطرح سؤال «أي إعمار نريد أن نموّل؟» قبل سؤال «من سيمول الإعمار؟». فالأولوية هنا ينبغي أن تكون لتعزيز الإعمار المبني على الحقوق.
لا يمكن عزل تدخّلات الإعمار عن السياق العمراني، بما يشمله هذا السياق من وضع فيزيائي على الأرض، ووضع حقوق ملكية وأطر قانونية وتشريعية للإعمار، ووضع شبكات استثمارية في قطاع العقار وشبكات اجتماعية في التجمعات المعمورة. ليس هذا السياق العمراني نقطة ثابتة من الزمان، وليس حالاً ثابتة، بل هو حقائق متغيرة مع كل يوم. فالسياق العمراني عام 2011 لا يشابه السياق العمراني قبله ولا بعده، والسياق العمراني اليوم لا يشابه السياق العمراني الشهر الماضي ولن يشابه السياق العمراني في الشهر المقبل. وفي ظل ما تشهده سوريا اليوم من إعادة ترتيب وخلق للسياق العمراني، بتشريعاته وقوانينه وسندات ملكياته وشبكاته الاجتماعية والاستثمارية، لتحقيق مصالح سياسية واقتصادية إقصائية، فإن مجرد الانسحاب من عمليات الإعمار يعني التواطؤ في ترك الباب مفتوحاً على مصراعيه لنموّ هذه الترتيبات وترسّخها وسيطرتها على إعمار اليوم والمستقبل. من هنا فإن التصدي لهذا الإعمار الإقصائي لا يقل أهمية عن تمويل مشاريع إعمار مبنية على الحقوق، وهو التصدي الذي لا يجوز أن يقتصر على الانسحاب. إذ لا يمكن أن تجري مقاومة خلق هذه الترتيبات الجديدة للسياق العمراني من موقع المتفرج، ووقف التدخل في عمليات الإعمار اليوم لا يعني توقف الوقت وتجمد السياق العمراني فجأة. وعليه فإن دور الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وأصدقاء سوريا المقاوم والمقوّم لعمليات الإعمار وخلق سياقات وقنوات إعمار غير عادلة لا ينبغي نفض اليدين منه أو تأجيله.
في محاولة لدفع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي نحو تبني دورهما الرقابي والمقاوِم والمقوِّم، عمل عدد من الأكاديميين والباحثين والمؤسسات والمنظمات، بما في ذلك تلك التابعة للأمم المتحدة وللاتحاد الأوربي، على إيجاد مداخل يمكن الشغل عليها أو من خلالها لتقويم المنهج وتجنب تعزيز الاتجاه الخاطئ للتدخل. اشتغل البعض على سؤال الملكية وما قد ينتج عنه من مظالم في سياق الإعمار الحالي، وعلى الآليات التي يمكن العمل من خلالها على توثيق حقوق الناس وخلق أطر لاسترداد الملكيات.16 واقترح آخرون ضرورة مقاومة ممارسات الحكومة للسيطرة على الإعمار وفرض الأطر الإقصائية، مشيرين إلى إمكانية العمل من خلال آليات تتجاوز الحكومة وتعمل مع المجتمعات المحلية بما خلق توازن قوى بين المجتمع والنظام؛ أو من خلال العمل على نطاقات صغيرة مع مجتمعات محلية بما يعكس حاجاتها المباشرة، بدل العمل من خلال أهداف الحكومة العامة التي قد لا تنطلق من تلك الحاجات.17 كما أشار البعض إلى ضرورة العمل في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام بما يخلق بديلاً مبنياً على الحقوق، وبما يقلل من شعور النظام بالسيطرة المطلقة على آليات وأطر الإعمار، الأمر الذي يدفعه للتفكير مرات أخرى في السياسات التي يتبعها وجدوى الاستمرار فيها.
خاتمة
إن مظالم الماضي ومآسي الحاضر وما يُعدّ له في المستقبل تشكل كلها أسباب متراكمة للـ«النزاع» في سوريا. وفي سياق التلاعب بالتخطيط قبل الحرب، واستغلال التدمير خلال الحرب، ومحاولة احتكار إعمار ما بعد الحرب ووضعه في خدمة الأقوى، كان التحييد الظاهري للعمليات التي ترعاها الأمم المتحدة عن ارتباطاتها بالحيثيات العمرانية في «النزاع» السوري قد جعلها بيادق بيد الطرف الخطأ من «النزاع»، وجعل من مساعداتها الإنسانية وقوداً في حرب المعنويات والسياسة والتهجير، فكانت ضرراً أُريدَ به نفع، وحرفاً لمبادراتها للإعمار والتأهيل نحو تواطؤ مع الولاءات والمكافآت والتحيزات. وهكذا أصبح تقاعسها عن التدخل في مراقبة العمران تعامياً عن تمادي البيئة التي تجعل احتكار العمران والإعمار واقعاً غير قابل للتغير، يربح فيها رابحو معركة الحرب معركة السلام، ويكون فيها ضحايا الحرب ضحايا للسلام والإعمار. كل ذلك يجعل من الأمم المتحدة واقفة على الجانب الخطأ من «النزاع» والعمران في سوريا. وهو ما يفرض بالضرورة على الأمم المتحدة تقويم ذلك من خلال تعميق فهمها لما يربط عملياتها بالنزاع وبالسياق العمراني، ومن خلال تبنّيها لدور رقابي ومقاوِم ومقوِّم قبل دورها كممول.
*****
1. Human Rights Council, “Report of the independent international commission of inquiry on the Syrian Arab Republic (8th Report),” 2014.
2. D. Sharp, “Urbicide and the Arrangement of Violence in Syria,” in Beyond the Square: Urbanism and the Arab Uprisings, no. December, D. Sharp and P. Claire, Eds. Terreform, 2016, pp. 118–141.
3. P. Wintour, “‘Golden opportunity’ lost as Syrian peace talks collapse,” Guard., pp. 2017–2019, 2017.
4. The Economist, “How to stop the fighting, sometimes,” 2013.
5. The Syria Campaign, “Taking Sides: The United Nations ’ Loss Of Impartiality , Independence And Neutrality In Syria,” 2016.
6. A. Sparrow, “Aiding Disaster: How the United Nations’ OCHA Helped Assad and Hurt Syrians in Need,” Foreign Aff., no. February, 2016.
7. E. Beals, “UN allowing Assad government to take lead in rebuilding Aleppo,” Fox News, 2017.
8. PAX For Peace and The Syria Institute, “No Return to Homs – A case study on demographic engineering in Syria,” 2017.
9. حزب البعث، “سوريا وإيران توقعان 11 اتفاقية تعاون في المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية والاستثمار والإسكان”. كانون الثاني 2019.
10. J. Yazagi, “Opinion: No Reconstruction for Syria.” The Syrian Observer, 2017.
11. Council of the EU, “Supporting the future of Syria and the region: co-chairs declaration,” 2017.
12. بي بي سي، “الإمارات تعيد فتح سفارتها في العاصمة السورية دمشق”، 27 كانون الأول 2018.
13. Human Rights Watch, “Razed to the Ground, Syria’s Unlawful Neighborhood Demolitions In 2012-2013. ” 2013.
14. S. Abou Zainedin and H. Fakhani, “To reconstruct or not to reconstruct,” After the fall: Debating reconstruction in a broken Syria, no. 23, Syria Notes, pp. 6–11, 2018.
15. J. Daher, J. Yazigi, S. Said, and A. Shaar, Reconstructing Syria: Risks and side effects. 2019.
16. S. Aita et al., “Urban Housing And The Question Of Property Rights In Syria,” 2017.
17. S. Heydemann, “Rules for reconstruction in Syria,” Brookings, 24-Aug-2017.
هاني فاكهاني: مهندس معماري وممارس حضري سوري، يبحث ويحاضر ويصمم في مجال إعادة الإعمار والإسكان. مؤسس مشارك للمنظمة الناشئة ‘سكن للمجتمعات الإسكانية’ ولشركة خاصة بالخدمات المعمارية. حاصل على شهادة الماجستير في البناء والتصميم العمراني في التنمية من وحدة تخطيط التنمية في كلية لندن الجامعية UCL، حيث بحث العلاقات المتبادلة ما بين إعادة الإعمار والحوكمة والسلام في سوريا، وعلى بكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة دمشق.
أشرفت سوسن أبو زين الدين على إعداد الثيمة، والمواد البصرية المُرفقة للفنانة علياء أبو خضور (فيسبوك -إنستغرام)، والفنانة ياسمين فنري.
موقع الجمهورية




