كتاب “السلطة والمجتمع” تفكيك الذاكرة ورصد التاريخ السوري/ محمد عثمانلي
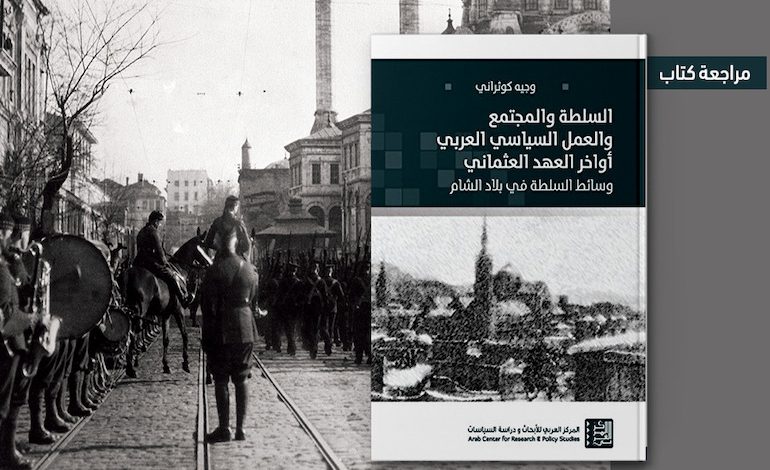
في الكتاب السابق “بلاد الشام في مطلع القرن العشرين”، كانت دراسة المؤرخ اللبناني وجيه كوثراني عبارة عن تحليل وثائقي للمشاريع الفرنسية في سوريا الطبيعية وما يتعلق بها من بنية المجتمع وأُسُس الاقتصاد، كما تطرق للمشروع الصهيوني كنتاج مواز لهذه الأحداث المهمّة، ولكن في كتابنا هذا يتوخّى منحى الفحص التاريخيّ الدرسَ الفكريَّ من ناحية، ومن أخرى يسلّطُ الضوءَ بشكل أكبر على عبارته الشهيرة الواردة في الكتاب السابق ويَفْصِلُ القول فيها: “كان النظامُ العثمانيُّ عبارةً عن رأسٍ منتفخٍ غيرَ منسجمٍ مع الجسمِ الاجتماعيِّ في الدّولة”.
يأتي كتاب “السلطة والمجتمع والعمل السياسي العربي أواخر العهد العثماني: وسائط السلطة في بلاد الشام” (المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2017، ط2) على تحليل البنية العمودية (السلطة – المجتمع) وتلك الأفقية (المجتمع – العمل السياسي) وبوادر “الإصلاح” في السلطة العثمانية العتيقة، و”أطماع” السلطة الانتدابية – الاستعمارية المستجدة، كذا ومقدمات وبذور الإصلاح المجتمعي السياسي والمتمثّل بالاستقلال وتكوين العروبة في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع العشرين.
فقه الكتاب
تقسم أفكار الكتاب الذي هو في أصله أطروحة الدكتوراه لكوثراني إلى قسمين في أربعة فصول، فالقسم الأول يتناول حركة الإصلاحات العثمانية في الفصلين الأولين بالحديث عن هيئة الدولة العثمانية قبل عملية الإصلاحات وبعدها، والقسم الثاني حول العمل السياسي النابز من المجتمع الشامي بمعناه الأعم، وثمّة مدخلٌ غاية في الأهمية هو تهيئة للقارئ لفلسفة هذه الجولة الفكرية التاريخية.
يحوي الكتاب العديد من المصادر والمراجع التاريخية الرئيسة والفرعية المتنوعة (196 عربي، 130 أجنبي) والتي يستعملها كوثراني لتكوين نظريته وإثباتها، وكذا هو غزير بأعلام بلاد الشام العثمانيين من كافّة التوجهات والطوائف الذين شاركوا في إبراز “إشكالية” العمل السياسي الشاميّ في تلك الحقبة، وتحاول نظرية الكتاب الإجابة عن كيفية بروز هذا العمل من خلال عدة مراحل تمخّضت عن تواجد المجتمع ونخبه ومثقّفيه في معمعة انتقال الإدارة القديمة للدولة من أصغر تقسيمة إدارية للقَضَاء وحتى سدّة الحكم المتنازع عليها من جهات وأحزاب داخلية وخارجية.
كما يفلسف كوثراني “مَوضُوعَتِهِ” بإمرار كافّة فصول الكتاب على مُسدّسٍ من الأفكار ابتدأ من 1) محاولة انتقال الدولة العثمانية من بنية الدولة السلطانية إلى الدولة الحديثة، ثم 2) التبرير الفقهي كهيئة فكرية، ثم 3) البنية المجتمعية الإسلامية الداخلية، ثم 4) البنية الطائفية بين المسلمين وغير المسلمين، ثم 5) الهيئة الثقافية المجتمعية لكل تلك البنى، وأخيرًا 6) السياق الدولي الذي أثّر بشكل فاعل في كل ما سبق.
لا يغفل كوثراني الحديث عن روح تلك المرحلة الحرجة الأكثر أهمية، ألا وهي المفاهيم المعقّدة المصاحبة لكافّة التيارات التي ابتغت العديد من المشاريع الإصلاحية، منها الاستقلال المشروط أو الانفصال أو بدايات الانفصال بشكل أدقّ، الدولة والأمة، الدولة – الأمة القومية، كذا والدولة – الولاية وشكلها المتخيّل في “الخطاب ثم العمل” السياسي العربي وتقاطع ذلك مع التوجهّات القومية – الإثنية، الإسلامية العثمانوية، والليبيرالية العلمانية؛ أو حتى الخليط الناتج عن أيّ منها، حيث يتّضح من تنظير المؤلف أن مثل هذه الفترة لم يكن فيها تلك الأفكار الصافية الواضحة البلجاء التي يَقْطَعُ بعضها مع بعض، بل وجود صيغ إسلامية وقومية مستلهمة من الغرب، كذا وصيغة الدمج التوفيقية بينهما.
بين إصلاح الدولة المركزي ومركَزَةِ الاستبداد
تناول الفصلان الأولان أثر معضلة الإصلاح العثمانية على المجتمع وبنية الدولة ووسائط السلطة فيها، تلك المعضلة المتمثلّة بالدرجة الأساسيّة بإعلان الحُكْمين السلطانيين الشهيرين “ذروة مبتدأ حركة الإصلاح العثماني”: الأول عام 1839 والمعروف بـ “گُلْ خَانِهء خطِّ شريف” (تنظيمات فرمانى)، والثاني عام 1856 حُكم الإصلاحات السلطاني (إصلاحات فرمانى)، ثم قانون الولايات 1864 (تشكيلِ ولايت نظام نامه سى) وغيرها من القوانين الوليدة بعد ذلك على طول القرن التاسع عشر.
تحدث كوثراني عن المرحلة التي حاولت الدولة العثمانية فيها الانتقال من الصيغة السلطانية نحو الدولة الحديثة، حيث كانت الدولة في شكلها القديم مبنية على دور التبرير الفقهي في إرساء نظام “السلطنة”، وأنّها كانت دولة عصبية أكثر من احتوائها على طبيعة الدعوة التي تدمج الأمة بالدولة، وكيف يتشكل “أهل الدولة” كعصبية “غالبة” مكوّنة من عصبيات موالية وعصبيات مستتبعة أنتجت شكل إمارة الاستيلاء والتغلب البديلة للشورى التي انتقلت فيما بعد بالوصول لصيغة القانون الأساسي 1876 حيث لم يكتمل وجوده وتم تعليقه بعدها.
هذا على صعيد قمّة الهرم، ولكن في قاعدة الهرم ثمّ سُلط متشكّلة من الأزل تقاوم أثر التغيّر في الإدارة الذي يمسّ شرفها السيادي يقابلها أعيان المدن والتجار الذين فهموا إصلاح الدولة المركزي على أنّه قابل للاستثمار والتجارة لصالحهم، وهذا أنتج نزاع الريف – المدينة بدرجة أولى، ثم طغى على ذلك وجود طائفيات مغلقة الاقتصاد مختلفة المذهب كالعلويين، وكذا قبلية الطرز كانت تقاوم مثل هذا التغيير كالدروز، وأخرى مشتتة في الأرجاء يصعب ترويضها كالبدو، وثالثة الأثافي لما يقوم السلطان بحرف مسار الإصلاح لصالحه نحو تركيز الاستبداد.
كانت عمليات التنظيمات بمفهومها العام الإصلاحي قد أثرّت بشكل كبير على هيكلية الدولة بحيث انتقلت وظيفتها في النواحي الطرفية من مجرّد الحفاظ على الأمن وجمع الضريبة إلى استتباع مركزي شديد، يوازي هذا الأمر التغير الذي طرأ على المؤسسة الدينية “المبرِّرة” بعد عملية الإصلاح وكيف أخذت قوّتها بالتلاشي تدريجيًّا وتفتيت سلط القضاة الحاكمين في الأقضية المحلية وتقزّم مكانة شيخ الإسلام، أيضًا وانحسار قدرة الإقطاع العسكري في الأطراف الذي يجبي “الالتزام”، لصالح وظائف إدارية معقّدة أكثر تشابكًا وانتقاله من وسيط حصري للسلطة بين المجتمع والدولة إلى عملية استقطاب تتولى تغيير الطبيعة التي اعتاد الأهالي والأعيان عليها منذ قرون وبالأخص على سبيل المثال تطور مؤسسة كالحسبة الكلاسيكية إلى نظام أوروبيّ جديد؛ البلديات والتي تعطي معادلات جديدة غزيرة أنتجت تنظيمًا جديدًا لـ “الإدارة والمال والسلطة”.
كذلك على مستوى النواة الاقتصادية في الأطراف نرى التغيّر قد مسّ التنظيم الحرفي وطرق التصوف التي تلعب دورًا فيه، واستثمار الدولة الذي بات ينتقل لشكل جديد يؤثر بدرجة أساسية على مجموعات أسمتها الاقتصاديات الغربية بال “تدينات الصغيرة”، وهنا يأخذ كوثراني تمثيلًا لكلٍ منها: العلوية بتتبيع الجبل والسهل للمدينة، والدروز بين مترددين من استقبال إصلاحات الدولة وآخرين يحاولون استغلال “التنظيمات” لصالحهم.
هذا هو هدف التنظيمات والإدارة الجديدة التي أرادت ابتلاع وَلَيّ سلطات محلية أصغر منها واختراق المناطق البعيدة الطرفية ونقل المجتمع من اقطاع العسكر القديم إلى بيروقراطية حديثة بحيث لم تساعدها في ذلك العديد من الظروف العائدة للدولة والمجتمع، مما أنتج ذلك الجسم غير المتفاعل مع رأسه.
من عصبية الدولة السلطانية إلى سلطات العمل السياسي الحديث
في الفصلين الأخيرين كشف كوثراني عن ولادة العمل السياسي بعد سِنِي تصنيع الخطاب السياسي في مجتمع بلاد الشام من حلب ونواحيها وليس انتهاءً بفلسطين وضواحيها مرورًا بعقدة الثقافة الحرّة التي شكّلت أهم المعضلات في التاريخ العثماني الحديث، إقليم لبنان وما فيه.
إحدى مشاكل البحث كانت بأطروحات مثل التي قدمّها “جاك وولريس” حول أن معضلة الشرق العربي تتمثل في عدم قابليته لأن يتشكّل قوميًا على الطراز الأوروبي، ولعلها إحدى مقدّمات كوثراني اللافتة في تبيان النقطة الرئيسة التي اختلفت عليها التوجهات العربية، إما في معارضتها أو السير في ركبها.
شكّل الحديث عن العمل السياسي العديد من المطبّات والخلافات والاختلافات فيه بين الشك الموجب والريبة السالبة من الانتماء للوطن العثماني المدموغ بالاستبداد السلطاني، والمتردد في استكمال مسيرة الإصلاح من جهة، وتحقيق أشكال مختلفة من حركة الاستقلال التي ابتدأت بمشروع “اللامركزية” ومرّت بعدها بمقدّمات لحركات استقلال تامّة متنوعّة الأشكال عن النظام العثماني الذي حكم المنطقة العربية نحو أربعة قرون.
لم تكن مسيرة العمل السياسي العربي منحصرة في مطلع القرن العشرين فقط، ولكنها تتوغّل إلى بُعيد منتصف القرن التاسع عشر واستمرت بالتنامي بأشكال مختلفة حتى وصلت للثوران، كما لم تكن منحصرة على الجانب العربي فقط ولكنها انطلقت من الجانب التركي أساسًا، وهنا الحديث عن معارضة خارج حدود الإمبراطورية العثمانية.
أسست النظرة الخلدونية الدولة على قاعدتي التجاذب العصبي والدعوي، والدولة العثمانية كما يرى كوثراني لمّا دخلت في دوّامة الانتقال من العصبية السلطانية نحو المركزية الحديثة، كانت تفتقر لصيغة الدعوة التي تدمج الأمة بالدولة حيث احتوت على “عصبويات تتنافر وتتقارب”، وهذا سبّب على مراحل ومدد تفتق العمل السياسي العربي الحديث في الحالة السورية (ومن قبلها وقبل العمل السياسي التركي الحزبي ذاك البلقاني بحسب إلبير أورطايلي) وكانت بعدها قد ظهرت بذور السلطة الحديثة.
يمكن القول إن سوريا لم تعد قادرة على الصمود كولاية طرفية، وأنها باتت تتجه نحو تكوين مركزيتها الخاصّة، كترجمة نهائية للعمل السياسي برزت من الاستبداد الذي ولّد معارضة خارجية أنتجت حركة تركيا الفتاة في البداية ثم انهمرت بعدها أمطار الجمعيات والمجامع والمحافل السرية والعلنيّة العربية.
وهنا كان حديثه عن ظاهرتي “المناشير” 1876 و”مؤتمر دمشق” 1878 بوصفهما من مظاهر المؤسسة للعمل العربي والمتماهية مع مؤتمر برلين الدولي بُعيد تولّي السلطان عبد الحميد الثاني، حيث خشيت الاتجاهات العربية انهدام الدولة وتلاشي مصير أقاليمها ليد القوى الاستعمارية كما قد لاحظوا هذا على البلقان.
عند ذلك ظهر الكثير من الأعلام والجمعيات المنافحة عن أهداف كثيرة من القائمين عليها أمثال عبد القادر القباني وعبد الحميد الزهراوي، شاهين مكاريوس، فارس نمر، يعقوب صرّوف، وكذا طاهر الجزائري وعائلة الشهابي ومحب الدين الخطيب، واللافت محاكمة المحدّث جمال الدين القاسمي بتهمة “الاجتهاد”، وبروز مناهضة لعمليات “الاستلاب الشعبي” الذي تعمل عليه السلطة باستثمار التصوّف حيث واجهها كلّ من رشيد رضا والكواكبي.
هنا على سبيل التمثيل قام كوثراني بالتوغل في أطروحتيّ عبد الرحمن الكواكبي ونجيب العازوري فالأول طرح “الخلافة العربية”، والثاني “الدولة العربية” المبنيّة على أساس الأمم بتقسيم الدولة العثمانية. كما استحضر المؤلف آراء عربية في مثل تلك المشاريع فاعتبر جورج أنطونيوس أن “ظاهرة المناشير” كانت تدلّ على وجود قومية عربية وجدانية، وزين نور الدين زين الذي اعتبرها حركة مارونية لبنانية ضيقة الأفق، ولكن كوثراني نظر إليها على أنّها قضية تستحق البحث وأنها تدل على تحوّل بارز في الثقافة العربية.
وقبل كل ذلك يشير كوثراني إلى أن إجهاض تجربة إصلاحيّة نامية لمدحت باشا كوالي لسوريا في العقد الثامن من القرن التاسع عشر، يضاف لها وجود دعاية فرنسية ضدّه بتهمة كونه إنجليزيًا، ساهم في الإيذان بخراب العمران وكان قلق النخب العربية من الولوج في مغبّة مصير مشابه للبلقان والوقوع بأيدي الاستعمار فظهرت بذور العمل السياسي العربي بالحديث عن مشاريع من قبيل “الوطن السوري”، كذا وحصل استجلاب الأصوات العربية الداخلية للخارج الغربي بعدها.
نحو ذوبان مشاريع السلطة العثمانية والإصلاح العربي في الاستعمار
بالتأكيد لا يغفل الحديث عن الضلع السادس “السياق الدولي” الأخطر، حيث يسلّط كوثراني الضوء عليه بشكل ملحوظ، وفيه توهان وضيعان وفوقان؛ تيه السلطة العثمانية بين شكلها السلطاني (ما قبل الانقلاب الناعم 1908) وشكلها الاتحاديّ (ما بعد الانقلاب الخشن 1909) في الانتماء الألماني، وضياع سلطات المجتمع العربي لحساب المشاريع الأوروبية الثقافية الإرسالية والاقتصادية السياسية في الانتماءات الفرنسية والبريطانية، وأخيرًا تفوق الإنجليز الأقوياء أصحاب مشروع أوروبا – الهند، والفرنسيين الضعفاء الذين حصلوا على ما يريدون من بريطانيا في ولوجهم “سوريا الطبيعية”.
هنا يركّز كوثراني حديثه عن المشروع الفرنسي ويتّخذه خزعة من أجل تكشيف نظريته والوصول إلى طبائع العمل السياسي العربي الشاميّ ومصارع اتّجاهات التطيّف والانقسام الذاتي، ولكن -على ضفّة أخرى- الأكثر نضوجًا فكريًا من أيام ستتلو هذه الحرب الشعواء كما نراه في تنظير الدبلوماسي والمؤرخ اللبناني خالد زيادة، حيث يدعو للعودة إلى “عروبة ونهضوية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين”.
لا غرو كذلك من وجود عملية “استتباع الاقتصاد العثماني” بالتدريج لأوروبا وأثر التنظيمات والقوانين على التجارة وإنتاج ما أسمته التوجّهات العربية الناقمة بـ “الشركات الانحصارية” نتاج احتكار أعيان المدينة لموارد الاقتصاد، وما أثّر به تحول نظام الملل لامتيازات فحماية للطوائف فمشروع سياسي فرأسمالية كولونيالية فدول مفتتة.
يضاف إلى ذلك الانفجار القومي الذي أشعل شرارته عمليات التتريك الاتحادية الشوفينية، ومع أن التوجهات العربية في كثير من جمعياتها ومؤيّديها كانت قبل إعلان الدستور 1908 مؤيّدة للمواطنة العثمانية وعدم الانفصال كذا ومنهم من أيّد اللامركزية، أو أنّهم متردون من القول بالانفصال علنًا، رغم ذلك فإنّه وبعد محاولات كثيرة للحوار مع حكومة الاتحاديين لنيل الحقوق والإصلاح كان أحد الوسطاء فيها أشهرهم عبد الكريم خليل، فإنّه سبّب ما يمكن أن نسمّيه بالنكسة العربية بطرح الوعود الشكلية للمثقفين العرب، ونتاج خوف الاتحاديين من اعتبار العرب كأمة منفصلة عن الجسم العثماني وهلعوا من تأسيسهم دولة قومية اتّباعًا للتقليد الغربي واعتبارهم مواطنين أتراك.
هنا رأت الاتجاهات العربية المعارِضة للاستبداد الحميدي، والتي وقفت إلى جانب تركيا الفتاة وحركتها “الاتحاد العثماني” وقتذاك، رأت طريقها الخاص رغم أنّها كانت مفتتة الأهواء، بعد ذلك تأسست جمعية “العربية الفتاة” عام 1911 وهي الفترة ذاتها التي تحوّل رشيد رضا فيها إلى مناهضة الاتحاديين.
مثل ذلك نشأت حركة الإصلاح في بيروت 1912 من القائمين عليها اسكندر عازر وسليم الطيارة، (وبرأيي كانت سنة 1913 هي سنة توحّش الاتحاديين التي فيها يتم دمج الدولة بالحزب بشكل ضيّق خطير) كذا وفي ذاك العام يُعقد المؤتمر العربي الأول من قبل المثقفين المسلمين التي رُفضت كل طلباتهم اللامركزية، يُعقد في باريس كحالة يائسة من الحوار مع رأس هرم الدولة التركية القومية المتشكّلة.
هكذا انفجرت جميع التناقضات الإسلامية القومية الإقليمية الطائفية، ودخلت أجواء الحرب المقلقة، وبرزت أنياب القوى العظمى واستعدّت لنشل البلاد ونيل ثمرات العديد من الامتيازات التي اشتغلت عليها منذ عقود طويلة، وأثمرت جهود دولية عديدة مثل المعاهدة الفرنسية الإنجليزية 1899 حول السويس والبحر الأبيض المتوسّط وحواليه، كذا واستعرت الدعايات الكولونيالية المتضاربة ولعبت “سوسيولوجيا الحرب الأهلية” دورها في بلاد الشام.
يمكن اعتبار هذا الكتاب ليس فقط تاريخًا للأفكار، بل يشير كوثراني في العديد من جنباته إلى أن تلك الفترة كانت خصبة بالمصادر والوثائق التي تؤدّي إلى الكتابة التاريخية الشعبوية والمؤدلجة على كافّة الصُعد وبالخصوص تلك الإسلامية والقومية، لذلك فهو “مقال في المنهج” أيضا.
وددت إضافة ملاحظة أخيرة وهي استخدام المذكرات المنسوبة للسلطان عبد الحميد الثاني في الكتاب، حيث ثمّ تأكيد ملحوظ في الأكاديميا التركية على أنّها ليست مكتوبة من قبله، ومع ذلك فإن منهج المؤرخ القلق الخبير وجيه كوثراني في بناء نظريته في التأريخ ليس عشوائيًا، بل يمرّ في مرحلة اختيار المصدر الرئيس والفرعي، وكذلك يضع مجموعة من الفرضيات لدعم ورفد تلك النظرية، حيث إن احتُمل فقدان إحدى هذه الفرضيات تبقى النظرية في مأمن من الدحض، واستخدام تلك المذكرات في هذا الكتاب لم يأتِ في منزلة استدلال رئيس كما أنّه متوافق مع السياق العام للأحداث آنذاك، وهي إحدى مناهج كوثراني التي يسلّط الضوء عليها في مقام آخر.
في الخاتمة أقول إنّ عاصفة الحداثة التي اقتحمتها السلطة العثمانية كانت قد كسرت ظهرها على مُدد، وأنتجت فيها “المسألة العربية” ليس فقط في الحرب العالمية الأولى بل منذ أكثر من أربعين عامًا، حيث مرّت الدولة كما يقول كوثراني بـ”تفكك المجتمعات العثمانية عن بعضها وعن الدولة، وكانت مرحلة انفكاك وتفكيك السلطنة وانفتاح ولاياتها على مشاريع تاريخية عديدة”، فليست هي مسألة مؤامرة متعلقة باتفاقية جاءت من الخارج بقدر ما هي قضية داخلية تخصّ سائر المنطقة.
الترا صوت




