ترجمات أدبيّة بتاء تأنيث سوريّة.. الواقع والتحدّيات
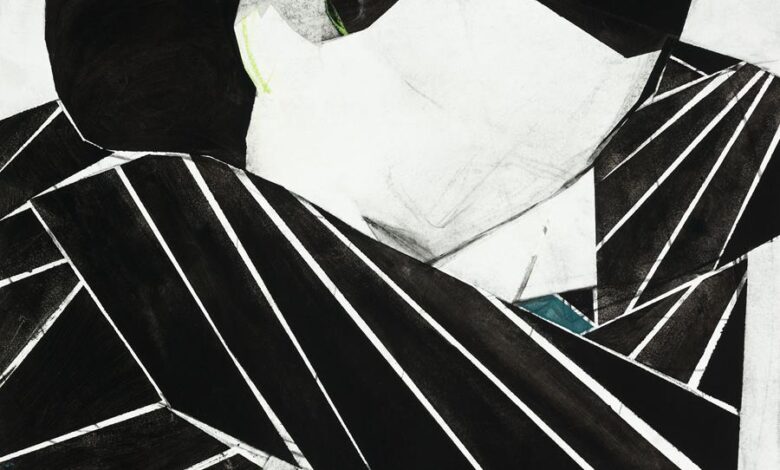
يُجمع أهل الاختصاص من كتّاب ونقّاد وناشرين وقرّاء على أنّ نقل الأعمال الأدبيّة العالميّة إلى اللغة العربيّة، سواء القديم منها أو المعاصر، يُعدُّ من أصعب أنواع الفعل الأدبيّ.
المتأمّل في مدونة ترجمات الأعمال الأدبيّة العالميّة في العقد الأخير يلاحظ وجود عدد من المترجمات السوريّات اللاتي اخترنّ نقل روائع من هذه الأعمال وغيرها من الكتابات الفكريّة والفلسفيّة، الأمر الذي دعانا إلى التواصل مع عدد من هؤلاء المترجمات اللاتي يبدعنّ في ترك بصمات أنثويّة بحرفيّة عالية في عالم بقي لسنوات طويلة حكرًا على المترجمين من الرجال، لسؤالهنّ عن بدايات اشتغالهنّ في حقل الترجمة، وما هي المعايير التي تدفع بهنّ لاختيار الأعمال الأدبيّة التي يشتغلنّ على ترجمتها؟ وما هي المشكلات التي يواجهنّها، وكيف تغلبنّ عليها، وأوجدنّ لأنفسهنّ موطئ قدم في حقل الترجمة؟ وما هي شروط نجاح ترجماتهنّ لما يخترنه من نصوص؟ أخيرًا؛ ما هي آخر الأعمال الأدبيّة التي نقلنّها من لغات العالم إلى لغة الضاد؟ فكان هذا التحقيق.
(أوس يعقوب)
المترجمة والكاتبة أمل فارس كانت أوّل من أجابت عن أسئلتنا قائلة: بدايتي في حقل الترجمة كانت كمترجمة متطوّعة في موقع “الأصوات العالميّة” في عام 2015، ثمّ قادتني رحلة استكشاف الذات والرغبة الملحّة لسدّ جوع المعرفة وعطش القراءة الذي لا يُروى إلى تتبّع أعمال كتّاب أميركا اللاتينيّة حيث كنت ما زلت أقيم، وصادفتُ من النصوص ما أُغرمت به بكلّ معنى الكلمة ومقابلاتٍ نادرة فيها من العمق والفردانيّة ما يستحقّ أن يعرفه القارئ العربيّ ورحت أضيفها تباعًا إلى قائمتي التي لا تنتهي – كما هي حال قوائم المترجمين كافة- كمشاريع يجب إنجازها.
وبدأتُ بنشرها تباعًا في المواقع الإلكترونية لتظهر لاحقًا في كتابي الأوّل «دردشة معلنة»، الصادر عن “دار ممدوح عدوان للنشر” 2018. الترجمة كانت وما زالت بالنسبة لي حبًّا خالصًا وهوايةً ممتعة تقوم على نقل المعرفة وبالتّالي تدخل تحت باب التّنوير، وتلك متعة لا تضاهيها متعة.
أمل فارس اقتراب من الكتابة الإبداعيّة
تضيف فارس: بالنسبة للأعمال التي تعرض عليّ للترجمة من قبل دور النشر فإنّني أعتبرها بمثابة تحدٍّ جديد وفرصةٍ لتوسيع معارفي وتنمية قدراتي التّقنية، هذا بالطبع في حال وقع العمل ضمن اهتماماتي. وفيما يخصُّ معاييري في اختيار الأعمال التي أتوق إلى ترجمتها وأقترحها على الناشرين، فأكثر ما يشدّني منها هي تلك القادرة على فتح أبواب الوعي لديّ إلى الأقصى، كما تلك التي تقترب مني كتجربةٍ إنسانيّة مهمّة كنصوص الكاتب والموسيقيّ الأرجنتينيّ فاكوندو كابرال، على سبيل المثال، أو الكاتب والمخرج والمعالج النفسيّ التشيليّ أليخاندرو خودوروفسكي، صاحب التّجربة الفريدة في مجال العلاج الروحي بالفن. وكذلك أعمال خوليو كورتاثار وأشعاره وقصصه وكائناته المُتَخَيّلة (لاس اسبيرانساس) و(لاس فاماس)las esperanzas y las famas والتي تُصنّف، بما في ذلك من قبل القرّاء النّاطقين بالإسبانيّة، بأنّها تمتاز بغرائبيّة وتحتاج الكثير من الحُبّ لتذوقها.
هذه العوالم التي تفتحها أمامي أعمال هؤلاء كمثال وآخرين لا مجال لذكرهم كلّهم، تستحوذ على اهتمامي وتشدّني لترجمتها، رغم عوائق عدّة تعترض مثل هذه الخيارات في العالم العربيّ لاعتبارات تتعلق ربّما بسياسة النشر.
تتابع فارس: المشكلة الرئيسيّة التي صادفتني في بداياتي تكمن في غموض الخطوات التي تسير وفقها عملية الترجمة، وعدم توفّر دليل واضحٍ للمترجمين الجدد يساعدهم على البدء بالشكل الصحيح، وبالتالي تجنيبهم رحلة المراسلات والمعلومات المنقوصة أو المغلوطة والإحباط النّاجم عن الرّدود التي لا تصل. باعتقادي سيكون من الجيّد توفر تقرير مختصر تُوَضّح خلاله النّقاط الأساسيّة لعمليّة الترجمة مع معلومات وعناوين واضحة لدور النشر، ما يفتح المجال أمام المترجمين الجدد الأكفاء كي ينخرطوا في هذا المجال مع إمكانيّة توفير جهد ووقت الطرفين المترجم والناشر.
شروط نجاح الترجمة بالدرجة الأولى، بحسب أمل فارس، تخضع للعمل بحدِّ ذاته ومدى انجذاب المترجم إليه كما وتطابقه الفكري مع ما يقرأه. بالنسبة لي لا أجد نفسي قادرةً على ترجمة عمل يمتدح الشيوعية مثلًا، أو يهلل لحاكم بعينه أو فيه مغالطات تاريخية، فالترجمة هنا تقترب إلى حدٍّ كبير من الكتابة الإبداعيّة، شخصيًّا إمّا أن أكون على قناعة تامّة بما تطرحه من أفكار تترتب عليها أيديولوجيّات معينة، وإمّا تفقد جماليّتها، وبالتالي اهتمامي بنقلها والإضاءة عليها. ثمّ التواصل المباشر مع الكاتب إن أمكن لإزالة الشكوك والتأكّد من توضيح الأفكار المبهمة في النصّ. ثمّ بالطبع تأتي الشروط التّقنية للترجمة من حيث التمكّن اللغويّ لدى المترجم والدقّة والأمانة في النقل وهذا لا يختلف عليه أحد.
أخيرًا، جوابًا عن سؤالكم حول آخر ترجماتي، أشير إلى أنّ عملي القادم سيصدر قريبًا عن “منشورات تكوين” بعنوان «الطفرات» لكاتبها المكسيكيّ خورخيه كومنسال. يتناول العمل مرض السرطان كثيمة روائيّة قلّما يتّم التطرّق إليها. هناك أيضًا كتاب منجز بعنوان «رسالة إلى ستالين» للكاتب فرناندو أرابال، من المفترض أن يصدر عن “دار ممدوح عدوان للنشر”. أمّا في مجال الترجمة من العربيّة إلى الإسبانيّة أنجزت هذا العام ترجمة «الوصايا» للكاتب السوريّ فادي عزّام.
وعلى صعيد المبادرات الشخصيّة كنت بدأت مشروع ترجمة رسائل خوليو كورتاثار من كتاب «رسائل 1977-1982»، ربّما يتوسّع ليشمل رسائله من أعمال أخرى. كما باشرت بترجمة أحد أعمال الكاتب أليخاندرو خودوروفسكي، وأتمنى أن أوصل العملين للقارئ العربيّ قريبًا.
فيروز نيوف: تجربتي في الترجمة أقرب إلى الهواية
تحدّثنا المترجمة فيروز نيوف عن بداياتها في حقل الترجمة قائلة: نشأت في أسرةٍ مثقفة، مزدوجة اللغة (عربيّ – روسيّ) تحبّ المطالعة، ويعتبر الكتاب جزءًا من حياتها. ومنذ طفولتي الباكرة وإلى اليوم أقرأ باللغة الروسيّة، مع أنّي تعلمت في المدارس العربيّة من الصف الأوّل الابتدائيّ وحتى تخرجي من الجامعة في بلدي سورية كطبيبة أسنان عام 1995.
في الثالثة عشرة من عمري ترجمت قصّة للأطفال نشرتها في مجلة “أسامة”، التي تصدر عن وزارة الثقافة في دمشق. وقبيل إنهاء المدرسة الثانوية نشرت في الصفحة الثقافية بجريدة “الثورة” السوريّة اليوميّة، عشر قصص صغيرة من قصص الكاتب الروسي الساخر ميخائيل زوشنكو. إنّ لغة زوشنكو وتعابيره الشعبيّة تحتاج إلى معرفة عميقة باللغة الروسيّة، وإلى كثير من الحذر في ترجمتها. كانت تجربة مبكرة وأوّليّة، طبعًا. كنت أختار ما أحبّه وأعتبره ممتعًا ومفيدًا.
يعود الفضل في اهتمامي بالترجمة إلى تشجيع من والدي الدكتور نوفل نيوف. فهو متشدّد في قواعد اللغة العربيّة وأسلوبها، كما في قواعد الترجمة وأصولها. وهكذا باتت الترجمة تحدّيًا مشوِّقًا وعادة في حياتي اليوميّة.
وعن المعايير التي تدفعها لاختيار الأعمال الأدبيّة التي تشتغل على ترجمتها؟ تجيب نيوف: بما أنّ اللغتين العربيّة والروسيّة لغتان أمّ بالنسبة لي، أدرك جيدًا أنّ الترجمة تتطلب الفهم قبل كلّ شيء. وهذا أوّل تنبيه إلى أنّ الترجمة الحرفيّة تقتل المعنى والأسلوب أيضًا. كنت أتساءل دومًا كيف نترجم هذا التعبير من الروسيّة إلى العربيّة، أو بالعكس، كيف ننقل هذه الفكرة من العربيّة إلى الروسيّة بطريقة توصل المعنى إلى القارئ بيسر، وبأمانة أيضًا.
أعتقد أنّ من أصعب الأمور في الترجمة هو نقل الفكرة بشكلٍ دقيق وأنت تحافظ على أسلوب المؤلف من دون ترجمة حرفيّة. وفي نفس الوقت من دون زيادة أو نقصان، أو تلخيص، كما يحدث عند بعض المترجمين أحيانًا. يجب أن نأخذ بعين الاعتبار خصوصية كلّ من اللغتين في بناء الجملة، وفي النحو والتعابير والأمثال … إلخ.
بالطبع، أنا لا أستطيع أن أُنَظِّر للترجمة، أو أن أخوض بعمق في مشكلاتها، لأني لست مترجمة محترفة، بمعنى الاحتراف. فأنا طبيبة أسنان، وقد شغلني عملي في اختصاصي عن السير في هذا الطريق، وحدّ من عدد الأعمال التي ترجمتها.
أمّا عن المشاكل التي تواجهها في حقل الترجمة، فتقول: تواجهني أحيانًا مشكلة إيجاد الترجمة المناسبة لبعض التعابير الشعبيّة والأمثال. فهنا لا يكفي الفهم فقط، وأشعر بأنّ ثقافتي التراثيّة بالعربيّة ليست كافية. لذلك أقول إنّ تجربتي في الترجمة أقرب إلى الهواية ممّا هي إلى الاحتراف. لكني في الحقيقة أحبّ الترجمة وأراها جزءًا من شخصيتي. وأردفت: ترجمت ونشرت في بعض المجلات قصصًا، منها قصتان لأحد أعلام الرواية التاريخية في المرحلة السوفيتية هو فالنتين بيكول. طبعًا، أعماله الأدبيّة مختلفة كلّ الاختلاف، باللغة والمفردات والأسلوب، عن قصص زوشنكو. وكذلك ترجمت عدّة قصص أرمنيّة عن اللغة الروسيّة. بعدها نشرت في (الهيئة السوريّة العامّة للكتاب، وزارة الثقافة في دمشق) “سلسلة لليافعين” ترجمة لرواية ألكساندر غرين «الأشرعة الحمراء». وكذلك في الهيئة نفسها ترجمت جزأين من رباعيّة ألكساندر فولكوف الشهيرة «ساحر مدينة الزمرد».
وفي عام 2007 ترجمت رواية مكسيم غوركي «اعتراف. أين الله؟»، ونشرتها في “دار التكوين” في دمشق.
تتابع نيوف حديثها: كُلّفت بترجمة عدّة سيناريوهات سوريّة إلى الروسيّة لصالح “المؤسّسة العامّة للسينما” في دمشق. ومرّة أخرى كانت تجربة مختلفة ومميزة مع ترجمة اللغة اليوميّة باللهجة العامّيّة وما فيها من عبارات ودلالات ومعان تتطلب كثيرًا من الدقّة والمعرفة. كما كنت تعاقدت مع شركة أدوية في دمشق ترجمت لصالحها نشرات طبية من الروسيّة والإنكليزيّة والفرنسيّة إلى العربيّة. وهذا مجال آخر، مليء بالمصطلحات العلميّة الأقرب إلى عملي في مجال الطب.
طبيعيّ أنّ من أهمّ مقوّمات النجاح في مجال الترجمة هو الإلمام الجيد باللغتين عبر القراءة والمتابعة، وقراءة الكتاب بلغته الأصليّة قبل الشروع بترجمته.
الترجمة عملية معقدة، وهي في نفس الوقت ممتعة تدفع نحو البحث والتأمل في أشياء ومواضيع قد لا تخطر على البال، وأنت تقرأ مجرّد قراءة لا تحتاج إلى التفكير بلغة أخرى.
ختامًا، في نظري على المترجم أن يوسع دائرة قراءته باللغتين، وأن يعمل دائمًا على إغناء قاموس مفرداته، والبحث عن المصطلحات الجديدة، والمرادفات لكثير من المفردات الجديدة التي تظهر كلّ يوم في حياتنا المعاصرة، حياة عصر السرعة والتطورات التقنية المذهلة.
وبسؤالنا عن جديدها من الترجمات التي تعمل عليها الآن؟ أجابتنا: اشتغلت مؤخرًا على ترجمة الجزء الأوّل من رباعيّة روائيّة، وذلك بتكليف من دار نشر عربيّة مرموقة. أنتظر أن يصدر العام القادم، وأتمنى أن يكون عملًا ناجحًا ويلاقي أصداء جيدة، كما لاقت ترجمتي لرواية مكسيم غوركي «اعتراف. أين الله؟» التي أعيدت طباعتها عدّة مرّات.
يارا شعاع: الترجمة فنّ
المترجمة يارا شعاع تحدثت عن بداياتها في حقل الترجمة الأدبيّة قائلة: درست الأدب الفرنسيّ في “جامعة دمشق” وبعد أن تخرجت من الجامعة كنت قد بدأت دراسة الترجمة في “المعهد الفرنسيّ” فأحبّبتها كثيرًا، وقررت التخصّص في هذا المجال. ثمّ درست الماجستير في “معهد الترجمة” في دمشق، وتخصّصت بالترجمة الفورية. ما دفعني للتخصّص في هذا المجال هو حبّي وشغفي لقراءة الكتب بأنواعها.
بالنسبة لي الترجمة هي إحدى أهمّ وسائل التواصل لنقل المعلومات وتكمن أهمّيّتها في ارتباطها بشتّى أركان العلم والمعرفة. وعلى المترجم أن يكون واسع الصدر وأن يكون قابلًا لترجمة شتّى أنواع الكتب والموضوعات. مهما تنوّعت فهذا غنى للإنسان ولثقافة البلد بحد ذاتها.
أمّا عن معايير اختيارها للكتب التي تعمل على ترجمتها، تؤكّد شعاع أنّ المهم بالنسبة لها هو النوع وليس الكم. مبيّنة: تتنوّع الموضوعات التي تطرحها الروايات، لكن الحكم على جودة الرواية وفق موضوعها قد يكون خطأ.
تضيف شعاع: بنظري الترجمة الأدبيّة من أصعب أنواع الترجمة وأمتعها. يمكن اعتبارها السهل الممتنع، حيث تتطلب من المترجم/ة العيش داخل تفاصيل الرواية وفهمها والتمكّن من عيش أحداثها، للتمكّن من ترجمتها بصدق وإيصال أفكارها، وكأن الرواية مكتوبة باللغة الأم. ما يجعل القارئ يتعايش مع الترجمة مثلما يتعايش معها أصحاب اللغة الأصليّة. في النهاية، يتميّز كلّ نصّ أدبي بصور جماليّة وتعبيريّة واستعارات وكنايات مخصّصة لنقل المعنى المُراد من النصّ.
ما أسعى إليه هو نقل أعمال متميزة من كافة اتّجاهات الأدبين الفرنسيّ والإنكليزيّ إلى العربيّة.شخصيًا أترجم محاولة أن يجد نصّي فضاءً جديدًا يخلق سماءه لينتشر أكثر فأكثر.
من أهمّ قواعد الترجمة الأدبيّة الناجحة هو إتقان المترجم للقواعد النحوية الخاصّة باللغتين المترجم منها وإليها. فلكلّ لغة قواعد خاصّة بها، لذا ينبغي على المترجم أن يكون حاذقًا بقواعد اللغتين.
من الطبيعيّ أنّه في البداية واجهت العديد من المشاكل كصعوبة إيجاد الكلمات أو التعابير المناسبة حقًا لإعطاء النصّ الأصليّ حقّه ولإيصال الفكرة بأسلوب جيد. للابتعاد عن الوقوع في فخ الترجمة الحرفيّة والتمكن من التخلص من جميع العقبات التي يمكن للمترجم أن يقع بها لجأت إلى قراءة العديد من الكتب والصحف والنصوص الأدبيّة بشغف وحبّ كي أتعلم من أسلوب وسلاسة كبار الأدباء.
أمّا عن شروط نجاح الترجمة فترى محدّثتنا أنّ أوّل الشروط هو حبّ النصّ الذي تقوم بترجمته واستيعابه جيدًا. كما يُطلب من المترجم أن يسعى جاهدًا لإيصال
النصّ المطلوب ترجمته بصدق وأمانة. الترجمة ليست وسيلة وإنّما هي فنّ.
إنّ كلّ جُملة، بل كلّ كلمة في الترجمة الأدبيّة، تحتاج إلى تركيز شديد، والأمر محفوف بكثير من المخاطر في حالة إغفال ذلك الأمر.
لدي الآن أكثر من 15 كتابًا ترجمتها لصالح العديد من دور النشر العربيّة.
وعن جديدها، تكشف لنا شعاع، في نهاية حديثها معنا، أنّها تقوم حاليًا بترجمة كتاب «بانكو» للكاتب الفرنسيّ هنري تشاريير، بالإضافة إلى مشروع إعادة ترجمة كتب ألبير كامو.
سيزار كبيبو: شحّ مصادر البحث العربيّة
سيزار كبيبو مترجمة رواية «حياة غرانغ كوبلاند الثالثة» للأميركيّة آليس ووكر، تجيب عن سؤالنا “كيف كانت البدايات في حقل الترجمة”، قائلة: أعتقد أنّ اختياري للترجمة جاء، بالدرجة الأولى، من عشقي للغتين العربيّة والإنكليزيّة بالقدر ذاته، ورغبتي بالتعرّف أكثر على هاتين اللغتين، ومعرفة المزيد عن الثقافات المختلفة وعن “الآخر” بمعنى ما. مضيفة: منذ تعلمت الإنكليزيّة، وأنا أجدُ نفسي أترجم الكلمات والتعابير في ذهنيّ بشكلٍ آلي، وتلفتني الكلمات الجديدة المُعَبِّرة بدقة عن المعاني والدلالات، وأتلقفها مثلَ من وقع على كنز. ربّما لأنّني بدأت قراءة الأدب في سنٍ مبكرة، ولعب الأدب جزءًا أساسيًّا في تكويني، فأجدني أميلُ بشكلٍ عامّ للترجمة الأدبيّة، وأختارُ ما أترجمه، بناءً على ما قد تضيفه الأعمال الأدبيّة التي أختارها، لتجربتي في الترجمة أوّلًا، وللمكتبة العربيّة ثانيًا. أفضّل بصورة عامّة الأعمال التي تهتمّ بتقنيّات الكتابة بقدر اهتمامها بالمحتوى.
كبيبو تواجه – مثل الكثير من المترجمين والمترجمات- تحدّيات عديدة، يتعلق معظمها -كما تذكر- بشحِّ مصادر البحث العربيّة، سواء المحتوى الرقميّ أو الورقيّ، فالقواميس والمعاجم لا تكفي أبدًا، وهناك ضرورة لقراءة صفحات وصفحات وربّما كتب، لإيجاد مرادف دقيق، وقد لا نجد، فنلجأ لاجتراح كلمات جديدة أو الاكتفاء بالشرح. ويجد المترجم إلى العربيّة نفسه أمام تحدٍّ آخر، يتمثّل في المحرّمات أو الخطوط الحمراء أو “التابوهات” العديدة التي تحكم العالم العربيّ؛ فكيف لنا أن نختار كلماتٍ “لا تخدش الحياء” ونسمّي الأشياء بأسمائها في الوقت ذاته، من غير أن نحيد عن شرط أمانة الترجمة ومصداقيتها؟ نجاح الترجمة إذًا مرهون، إضافة إلى صحتها ودقتها، بهوامش تضيق وتتّسع على نحوٍ كبير، ومرهون أيضًا بعوامل اجتماعيّة وسياسيّة ونفسيّة ودينيّة وثقافيّة، قد تعدم عملًا ما بصرف النظر عن قيمته الأدبيّة أو الفكريّة أو الإبداعيّة. أنا شخصيًّا أترجم عملًا ما لأنّني أجده يستحقّ الترجمة، ولا أهتمّ كثيرًا لأيّ شأنٍ آخر.
وعن ترجماتها التي سترى النور قريبًا، قالت مترجمة «رسائل فريدا كالو»: أعكف هذه الأيّام، على ترجمة «أبشالوم.. أبشالوم!» للكاتب الأميركيّ وليم فوكنر، وسيصدر في العام القادم عن “دار المدى”. وهناك مشروع لترجمة عمل آخر مع “دار نينوى” الدمشقيّة.
نور حريري: أقرب إلى عالم الفلسفة
المهندسة والمترجمة نور حريري، التي تواصل دراستها في مجال اللغات والدراسات الجندريّة في ألمانيا، تحدّثنا عن بداية علاقتها بحقل الترجمة، قائلة: درستُ الهندسة في الجامعة وليس الأدب الإنكليزيّ، لكن اهتمامي باللغة كان كبيرًا. عملت في بادئ الأمر في مجال تدقيق الترجمات المعتمدة لسنوات قبل أن أتوجّه إلى ما يسمّى بالترجمة الأدبيّة. شرعتُ حينها في ترجمة مقالات فلسفيّة وسياسيّة ونشرتها في عدد من الصحف ثمّ انكببت على ترجمة كتب الفلسفة بصورة خاصّة.
وعن معايير اختيارها للأعمال التي تشتغل على ترجمتها، تقول مترجمة كتاب «مفترق الطرق: اليهوديّة ونقد الصهيونيّة»، للفيلسوفة الأميركيّة جوديث بتلر: تختلف المعايير باختلاف مشروع المترجم وموقفه من الترجمة. لذا، للإجابة على هذا السؤال، عليّ التطرّق إلى موقفي الشخصيّ من الترجمة. بصورة عامّة، لا يمكنني التحدّث عن الترجمة بشكلٍ منفصل أو مجرّد، على الرغم من كونها فنًّا وعلمًا مستقلًا بذاته له نظريّاته الخاصّة والمختلفة. إلّا أنّها لم تشكّل بالنسبة لي مشروعًا في حدِّ ذاتها. الترجمة أداة معرفة تأتي في سياق معرفيّ، وربّما في سياق مشروع معرفيّ شخصيّ، فتكون ممارسةً دائمةً مرافقةً لهذا المشروع تتطوّر بتطوّره وقد تتوقف بتوقفه. لذا أختار من الترجمات ما أجده دافعًا هذا المشروع إلى الأمام، المشروع الذي وإن كان شخصيًّا في جوهره فإنّ موضوعاته تمسّ المجال العامّ وتبلغ عمق قضاياه. لذا أجد نفسي أقرب إلى عالم الفلسفة منه إلى عالم الأدب وأميل إلى اختيار أعمال الفلسفة القاريّة لانشغالها بقضايا الإنسان والمجتمع والمعرفة والوجود. إلّا أنّني سأسعى في الترجمات القادمة إلى اختيار الأعمال الجامعة بين مجالات الفلسفة المختلفة كالتحليليّة والقاريّة وتفرعاتها كالعلوم الإدراكيّة وعلم النفس. بكلمات أخرى، سأختار من الأعمال ما يحاول الإجابة على أسئلتنا الجديدة وليدة العصر ويجمع شتات أفكارنا المتفككة.
حريري، الحائزة على المركزَ الأوّل في مسابقة “المعهد الأوروبيّ للبحر الأبيض المتوسّط” و”مؤسّسة آنا ليند للقصّة القصيرة” لعام 2016، ترى أنّ مشكلات الترجمة كثيرة، وأنّها لا تعتقد أنّه من الممكن التغلب عليها تمامًا. واحدة من أهم هذه المشكلات، على سبيل المثال لا الحصر، هي صعوبة ضبط المصطلح – وليس نقل المصطلح- واعتماده وتفادي تعدّد دلالاته.
تضيف مترجمة «سُبُل النّعيم.. المثيولوجيا والتحوّل الشخصيّ» للأميركيّ جوزيف كامبيل: أعتقد أنّه لا يمكن التصدّي لمشكلة من هذا النوع بواسطة الجهود الفرديّة. ففي ظلّ تطوّر العلوم وتسارع ظهور النظريّات، يحتاج هذا النوع من المشكلات إلى تضافر مؤسّساتي من أجل مواكبة دفق النظريّات الهائل وضبط المصطلحات وتنظيمها. أمّا بالنسبة للنشر، فتكمن المشكلة الأساس في ميل معظم دور النشر إلى ترجمة الأدب والرواية وإعراضها عن ترجمة ما دون ذلك.
شخصيًّا، وجدت شيئًا ما لست متيقّنة من أنّه موطئ لقدمي فعلًا. ما سبق ذكره قد يفيد في شرح العوامل التي تُحدّد موطئ القدم، بل وتُحدّد القدم المسموح لها بإيجاد موطئ لها. اعتبارات النشر والسوق والعلاقات الشخصيّة بين المتنفّذين في المراكز والدور الكبيرة ثمّ ذائقة الجمهور الحقيقيّة أو المصنوعة، هذه كلّها ترسم الحدود التي لا مجال لموطئ قدم خارجها وإلّا وجد المترجم نفسه أمام “دعسة ناقصة”.
وعن نجاح الأعمال المترجمة، من وجهة نظرها، تقول حريري: تختلف الشروط باختلاف الجنس الأدبيّ أو التخصّص. بالنسبة للفلسفة والعلوم الإنسانيّة، أعتقد أنّ الدقّة هي الشرط الأوّل والأساس لنجاح أيّ ترجمة بالإضافة إلى الإلمام بالموضوع وعدم المبالغة في توطين اللغة الأصل وصهرها في اللغة الهدف.
في الختام تحدّثنا نور حريري عن جديدها، قائلة: أعمل حاليًا على ترجمة كتابين لجوديث بتلر، هما: «الحياة النفسيّة للسلطة: نظريّات في الإخضاع»، و«ذوات الرغبة: تأمّلات هيجليّة في فرنسا القرن العشرين».
ضفة ثالثة
حرب غير ملهمة: ما المنتج الثقافي السوري بعد سنوات الثورة واللجوء؟/ محمد سامي الكيال
خلّفت الحروب الأهلية في العصر الحديث، رغم كل مآسيها، نتائج إيجابية عموماً على المستوى الثقافي، فمن الحروب الأهلية الأمريكية والروسية والإسبانية، مروراً بالحروب التي شهدتها دول العالم الثالث في عصر التحرر الوطني، مثل الثورة الصينية، وصولاً لبعض الحروب الأهلية العربية، وعلى رأسها الحرب اللبنانية، كان لمثقفي وأيديولوجي الحرب، دور كبير في صياغة خطاب ثقافي وفكري، لعب دوراً عضوياً في تطوير الإطار الثقافي عموماً. وصيغت كثير من الأعمال الأدبية والفنية، والنظريات السياسية والاقتصادية، ضمن سياقات الحروب، لدعم الموقف الأيديولوجي والسياسي للأطراف المتنازعة.
وفق هذا المنظور فإن كثيراً من كتابات لينين بعد الثورة الروسية، وقصائد لوركا، وأعمال مهدي عامل، كانت، بشكل من الأشكال، جانباً من «المجهود الحربي». ثقافة الحروب لم تقتصر على فترات المواجهة المسلحة وحدها، فبعد انتهاء الحرب وانتصار أحد أطرافها، قد يستطيع مثقفو الطرف المهزوم تحقيق انتصار ثقافي، عن طريق تحويل مبادئهم إلى قيم مهيمنة، تلقى قبولاً اجتماعياً واسعاً، وتصبح جانباً من «الحس السليم» السائد، وأفضل مثال عن هذا ما حققه المثقفون اليساريون والجمهوريون الإسبان، الذين أصبحت أعمالهم تراثاً إنسانياً عالمياً، ساهم في صياغة الجو الثقافي للقرن العشرين بأكمله، ولعب دوراً مهماً في السقوط التدريجي لنظام فرانكو في ما بعد. من جهة أخرى يسعى مثقفو الطرف المنتصر إلى صياغة هيمنة أيديولوجية وثقافية متينة للأنظمة الناتجة عن الحروب، الأدب والسينما السوفييتية، عن فترة الحرب الأهلية، مثال جيد على ذلك.
لا تبدو الحرب الأهلية السورية ملهمة لهذه الدرجة، فسواء بحثنا في معسكر النظام أو الثورة، لن نجد منتجاً ثقافياً أو أيديولوجياً، قادراً على إضافة قيم وأفكار جديدة أو مبتكرة، وغالباً ما يلعب مثقفو الطرفين في مناطق مريحة ومألوفة، فالحديث المجرد عن الحرية، الديمقراطية، مواجهة العداون الأجنبي والتطرف، العالم الذي خذلنا والمأساة السورية، ليس، في معظم الأحيان، إلا تكراراً لعبارات تهدف إلى مخاطبة ما يُظن أنه متفق عليه عالمياً، بدون محاولة لتقديم مفاهيم أو معالجات جديدة. من الصعب بالفعل الحديث عن إضافة سوريا للثقافة العربية بالحد الأدنى، فما بالك بتوقع إحداث تأثير عالمي مقارب لأبعاد القضية السورية، التي أدت لصراعات إقليمية ودولية واسعة، ومشكلة لاجئين عالمية.
لا يمكن تفسير ضعف المنتج الثقافي السوري بمشاكل لدى السوريين، بوصفهم أفراداً، ربما كان الأجدى النظر إلى الشروط الثقافية البنيوية التي ينشطون ضمنها، والتي يبدو أنها لا تتيح مجالاً كبيراً لإبداع مرتبط بالأبعاد الاجتماعية والسياسية لتجربتهم، وتجعل التميّز الثقافي مجرد حالات فردية محدودة. فما المشكلة البنيوية في التجربة الثقافية السورية المعاصرة؟ ولماذا فشلت سنوات الحرب واللجوء، بكل غناها الحياتي، في إنتاج خطاب ثقافي سوري مُجدّد؟
مشكلة اللغة
يمكن ملاحظة ميل أساسي في اللغة الثقافية السورية السائدة، وهي الانفصال بين لغة الخطاب السياسي والمنتج الثقافي «الرفيع» من جهة، واللغة اليومية والعادية من جهة أخرى. اللغة الأخيرة تبدو أكثر مباشرة ووضوحاً، وغير صوابية على الإطلاق، مليئة بإشارات عن الأحقاد الطائفية والمناطقية، التمييز الجندري وفساد الأفراد والمؤسسات، في حين تبدو اللغة «الرفيعة» غير قادرة على استيعاب هذه الإشارات، أو إعادة إنتاجها في سياق جديد أكثر متانة، فيتم تمويهها على الأغلب، وتُدفع إلى حيز المسكوت عنه، الذي يعرفه الجميع في الوقت نفسه، فتصبح اللغة العادية أشبه بلاوعي اللغة «الرفيعة» الذي قد يظهر على شكل زلات لسان أو قلم مستنكرة.
تعبير «اللغة العادية» يوضع عادةً مقابل «اللغة الاختصاصية» ويعوّل كثير من الفلاسفة وعلماء الاجتماع على الإمكانيات التواصلية للغة العادية، باعتبارها لغة عمومية، يمكن للأفراد من خلالها التواصل في الحيز العام، ومناقشة مختلف المسائل في إطار عقلاني، مُتضمَّن في اللغة نفسها، في حين لا يمكن للغة الاختصاصية، رغم أنها شديدة العقلانية غالباً، أن تحقق عمومية اللغة العادية. هذا التصنيف لا يمكن تطبيقه على الحالة السورية، فاللغة العادية مقصيّة بشكل مضاعف، فهي تعتبر لغة دونية أولاً، ومقابلها ليس لغة اختصاصية، بل لغة مُعقّمة و«رفيعة» هي لغة الخطاب الثقافي والسياسي المقبول به؛ ولا يوجد ثانياً حيّز عام يمكن التواصل به أصلاً، ما أفقد اللغة العادية كثيراً من إمكانياتها.
معظم الأمور متفق عليها في إطار لغة الإطار الثقافي السائد، فأكثر المتحدثين وطنيون، مع ميل قومي ويساري، يرفضون الطائفية والتطرف. وعلى الرغم من أن نزع الأشكلة من طبيعة أي ثقافة سائدة، إلا أن الشرط الثقافي السوري المغلق والمعزول عن العالم لعقود، وغياب الحيز العام، والتيارات الثقافية والسياسية المتنازعة، جعل لغة الخطاب السائد أقرب لقوالب ليس باستطاعتها القيام بوظيفتين أساسيتين لأي لغة: التعبير والتفسير. من الصعب فعلاً توقع مناقشة مسائل شديدة التعقيد والتركيب، وصراعات شديدة الوحشية، وتفكك اجتماعي شامل ودموي، بلغة محكية، غير قادرة على إنتاج مفاهيم جديدة، مثل اللغة العادية، أو بلغة متخشّبة ومنغلقة، مثل اللغة «الرفيعة». باختصار يمكن القول إن السوريين لا يملكون لغة صالحة للتعبير عن تجربتهم أو تفسيرها.
لا يتعلق الأمر هنا بانفصال بين فصحى وعامية، بل بتعبيرات لغوية خسرت قدراتها، سواء تم التلفّظ بها باللهجات السورية، أو بالعربية الكلاسيكية، لأنها لم تقم بوظائفها التواصلية في إطار عمومي يتسم بحد أدنى من الانفتاح، فصارت أشبه بلغة مجالس مغلقة، عائلية، قروية، مناطقية. وليست لغة صالحة لحياة مدينية. وبالمقارنة مع بقية العالم العربي تبدو حالة اللغة السورية الأشد انغلاقاً، والأضعف قدرة على التعبير والتفسير.
البحث عن رعاة
إلا أنه لا يمكن اختصار المسألة بالمشكلة اللغوية، فمن الممكن نظرياً تثوير اللغة، ومنحها إمكانيات جديدة، مع تغيّر الظروف الاجتماعية والسياسية، وهذا لم يحصل في الحالة السورية، رغم كل التحولات الدراماتيكية التي عرفتها البلاد وسكانها.
يمكن البحث في هياكل المؤسسات الثقافية المعنية بالقضية السورية، خاصة في دول اللجوء الأساسية، لمحاولة إيجاد بعض تفسيرات استمرار الجمود: تعاملت هذه المؤسسات مع المثقفين السوريين بوصفهم «شهوداً» على مأساة إنسانية، وأفراداً في حاجة لـ«التمكين» وليس بوصفهم صانعين لمنتج ثقافي فعلي. معايير الجودة والأهمية لم تكن سؤال تلك المؤسسات بقدر «التمثيل»: هل يملأ المثقفون، الذين يتم دعمهم، خانات التصنيفات الواردة في البرامج التمويلية للمؤسسات (أقليات، معتقلو رأي، نساء، أبناء مناطق ساخنة، إلخ)؟
هذا النمط من التفاعل مألوف للغاية في المؤسسات الممولة من دول غربية، وقد يخفي كثيراً من الفوقية في التعامل، فضلاً عن نظرة أيديولوجية مغلقة، تميّز نمط عمل «المنظمات غير الحكومية» والنتيجة هي أن كثيراً من المتعاملين مع هذه المؤسسات يعملون على تعريف الآخر- المموِّل بمأساتهم، بطريقة تناسب توقعاته، بدلاً من إعادة إنتاجها ضمن منظور ثقافي جديد، قد يكون صادماً أو غير مألوف.
أعاق هذا الإطار المؤسساتي نشوء ثقافة سورية فاعلة في المنافي، وعوّد كثيراً من منتجي الثقافة على البحث عن نمط معيّن من الرعاة، من السهل معرفة مطالبهم وشروطهم. وبدلاً من صراع التيارات الفكرية والسياسية والثقافية، صار الصراع الأبرز غالباً هو التنافس على الوصول إلى الممولين، واستعراض موقع طالب التمويل، ضمن هرم الضحايا. بهذا المعنى فإن مشكلة الإنتاج الثقافي السوري جزء من مشكلة عالمية في الدعم والتمويل الثقافي.
أجيال غير سورية
وإذا كانت أزمتا اللغة والبنية التحتية لإنتاج الثقافة ملازمتين للجيل الحالي من المثقفين السوريين، فلا يمكن توقع ظهور كثير من الأعمال الفكرية أو الفنية، التي تعبّر بشكل مركب عن تعقيد الحدث السوري، أو تسعى جدّياً لتفسيره. بعبارة أخرى يمكن القول إنه من الصعب نشوء أو تطور ثقافة سورية فعلية، ضمن الشرط الحالي. الأجدى التفكير بثقافة «بعد سورية» قد تظهر مع أجيال جديدة، لم تعاصر سوريا التي نعرفها، بل عاشت في شرط تفكك البلاد، بكل منظوماتها الاجتماعية والثقافية. هذه الأجيال، التي لا يمكن اعتبارها سورية تماماً، تملك إمكانية لتجاوز المشكلة البنيوية للوضع الثقافي السوري، فهي لن تعيش في شرط يخضعها لأحادية وانغلاق اللغة الثقافية السائدة، مع انحلال بنى السلطة والمؤسسات الثقافية السورية التقليدية، ويمكن أن تنتج، في البلد والمنافي، نمطاً من الثقافة المستقلة، بعيدة عن برامج المؤسسات الغربية، الساعية لـ«التمكين».
وعلى الرغـــــم من أن الثقافة المستقلة على الصعيد العالمي باتت مُستوعَبة من المؤسسات الثقافية الكبرى، وســـرعان ما تصبح جزءاً من التيار السائد، إلا أن بإمكانها في الحالة السورية أن تُحسّن شروط الدعم الثقافي، وتجعل النظرة للمُنتَج الثقافي السوري أكثر جدّية، وربما يمكن حينها الاستفادة من المادة الغنية التي خلّفتها الحرب السورية.
٭ كاتب من سوريا
القدس العربي




