أنيا مولينبيلت: ما معنى أن يكون الشخصيّ سياسة؟
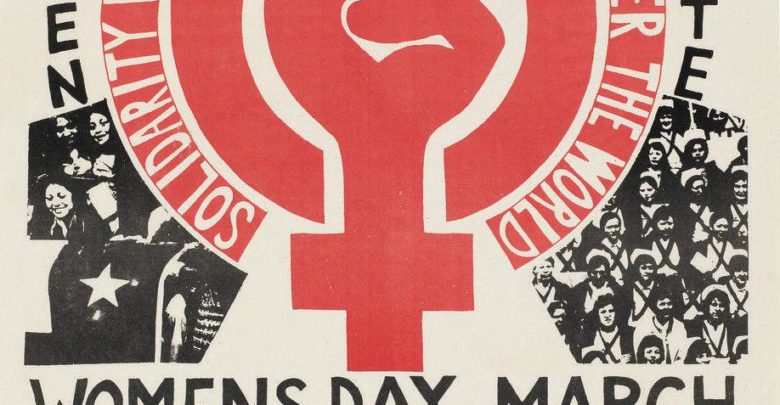
رحاب شاكر
أنيا مولينبيلت (1945)، كاتبة وسياسية هولندية، وإحدى رائدات الموجة النسوية الثانية في ستينات وسبعينات القرن العشرين. صدر كتابها الأهم من غير خجل عام 1976، الذي كتبت فيه عن حياتها الشخصية. كانت أنيا عضوة في مجلس الشيوخ نيابة عن الحزب الاشتراكي (2003 حتى 2011). ناصرت القضية الفلسطينية. وقد سبق أن نشرت الجمهورية خمس مقالات لها: ماذا تعرف النِسويات عن الحب؟ والرجولة كمشكلة والنقطة العمياء عند ماركس ولا تضرب وأنا ربة بيت. أجرت رحاب شاكر هذا الحوار معها في بيتها في أمستردام، تمت ترجمته عن الهولندية، ونتوقع أن يصدر لها في 2020 كتابٌ عن دار الرحبة، ستتولى رحاب شاكر ترجمته أيضاً.
أنتِ من أبرز الأسماء النِسوية الهولندية، بل إحدى رموز الموجة النِسوية الثانية على مستوى العالم. يهمني أن أعرف ما الذي نبهكِ إلى ضرورة النِسوية والعمل مع النساء في ذلك السن المبكر؟
لم أكن أدري أني أحتاج النِسوية إلى أن جاءت. أنا من عائلة ثرية نوعاً ما، كان والدي مدير شركة ووالدتي ربة منزل كما هو متعارف عليه. حتى قبل الحركة النِسوية كنت أرى حياتها مملة وقاتلة للروح، فأفكر أني لن أعيش مثلها ما حييت. أنا أكثر ميلاً للمغامرة من أمي، فحبِلتُ في سن السادسة عشرة من صديق تعرفت عليه أثناء الإجازة. طُرِدتُ بعدها من المدرسة وتم الضغط عليّ كي أتزوج. أروي أحياناً هذه القصة لأني أسمع الناس يتذمرون كثيراً من الزيجات الإجبارية والمدبَّرة في العوائل المسلمة التقليدية، ولكن الضغط عليَّ في تلك الأيام كان عادياً جداً أيضاً. لم يسألني أحد فيما إذا كنتُ أرغب بالزواج فعلاً، ولكن بما أني حبلى، توجب الزواج من الرجل الذي حملتُ منه. من العار أن تكوني أماً عزباء، وستُجبرين غالباً على التخلي عن طفلكِ. تزوجتُ إذن في سن السادسة عشرة من شخص لم أتعرف عليه إلا منذ وقت قصير. وسرعان ما اكتشفت كم هو عنيف، وقد استغرقني الأمر ثلاث سنوات قبل أن أتمكن من التخلص منه. لم يكن الطلاق من طرفٍ واحد ممكناً حينها، مع العلم أنه لم يمض على ذلك الزمان سوى جيل واحد. لم يكن هناك ملاجئ للسيدات المعنفات أهرب إليها. وفي آخر المطاف تأبطتُ ابني وعدتُ إلى منزل والديَّ اللذين كنتُ على علاقة سيئة معهما.
عندما بلغتُ العشرين، لم تكن حياتي قد بدأت بعد. سجلتُ للدراسة في الأكاديمية الاجتماعية، لأني لم أكن حاصلة على شهادة بعد. وفي تلك الأثناء انتسبتُ إلى لجنة مكافحة العنصرية التابعة لحزب الفهود السود، وشاركتُ في حلقات تعليمية ماركسية. آزرتُ الجميع، ولكن لم تكن هناك حركة نِسوية تناصرني. لم يخطر على بالي أن هذا ممكن أصلاً، حيث كانت حلقاتنا اليسارية تُعنى بالعمال الذين يتلقون أجراً، في حين كنتُ طالبةً ترعى طفلاً. الأمومة، برأيهم، أمرٌ شخصيٌ لا يتدخلون فيه.
ولم تتفتح عيوني إلا بعد قراءة مقال بعنوان الفصل الثالث سوف يغير حياتك للكاتبة الأمريكية شلومايث فايرستون. يدور المقال حول النِسوية والحب، وعن تواجد فروق السلطة في البيت أيضاً بين الرجل والمرأة. كما قرأتُ في المنشور نفسه مقالاً عن حلقات التوعية التي أطلقنا عليها لاحقاً اسم «حلقات الكلام». فكرتُ حينها: أنا أريد أيضاً! وهكذا تواصلتُ مع صديقاتي وبدأنا الكلام عن تجاربنا الشخصية.
بدأتِ شهرتكِ مع صدور سيرتكِ الذاتية من دون خجل عام 1976. تتفق معظم النِسويات على أهمية شعار «الشخصيّ سياسة»، بل يعتبرنه من أهم ما جاء به الفكر النِسوي. ما معنى أن يكون الشخصيُّ سياسةً بالضبط؟ وهل كنتِ واعية لنهجك؟ وما التأثير الذي تركه عليكِ وعلى محيطكِ؟
من الأهمية بمكان أننا بدأنا نتكلم عن تجاربنا الشخصية ضمن حلقات الكلام: ما الذي كان يزعجنا، وكيف نريد أن نعيش، وأي نوع من النساء نتمنى أن نكون؟ وطبعاً كل ما كنا نتكلم عنه كان يُعتبر شخصياً، أو شيء يخصكِ أنتِ فقط. هذا يعني أن النساء كنَّ معزولات عن بعضهن بعضاً، وأن كل امرأة تفكر أنها الوحيدة التي لديها زوج عنيف، أو الوحيدة التي لا تستمتع بالجنس، أو التي تعبت من زوجها الذي لا يساعدها بأعمال المنزل والأطفال. كل هذه الأمور التي نعتبرها اليوم قضايا نِسوية، كانت في ذلك الوقت جديدة جداً. عُنيت الموجة النِسوية الأولى بحق العمل والتصويت والمساواة أمام القانون، أي بالقضايا العامة، ولكنها لم تتدخل أبداً بتقسيم العمل والمسؤوليات المنزلية. اعتبرت نِسويات الموجة الأولى أن النساء قادرات على القيام بأعمال الرجال، ولكن لم يخطر على بالهنَّ أن الرجال قادرون أيضاً على القيام بعمل النساء. وهذا هو جوهر المسألة: ما زالت مشكلة التوفيق بين العمل ومسؤوليات المنزل مطروحة على النساء حصراً. المشكلة لا تخص الرجال، لأن ثمة نساء يحلونها لهم.
كما كان مهماً بالنسبة لنا أن ندرك أن الفصل بين ما نعتبره سياسة وبين الشخصي ليس فصلاً طبيعياً. اكتشفنا أن الفجوة بين العمل في المنزل وخارجه ليست طبيعية. من زمان كانت الأمور تتداخل فيما بينها، إذ كنا نعيش سوية في المزرعة. الرجال كانوا يعملون، والنساء كذلك. ربما كانوا لا يقومون بالعمل نفسه، ولكن كلاهما كانا يعملان من أجل الأسرة وفي السوق على حد سواء. أما حين أتى التصنيع ومعه الرأسمالية، غادر العمل المأجور المنزل، وبقيت الأعمال المنزلية والعناية بالأطفال فقط. وهكذا حصل الفصل بين العمل من جهة والميدان الخصوصي من جهة أخرى، فازدادت عزلة النساء المحبوسات داخل أسرهنّ وازدادت تعاستهنّ. مما أدى إلى ثورتهنّ، ولكن ليس إلّا بعد أن تكلمنَ مع بعضهنّ وتأكدنَ أن سبب تعاستهنّ ليس شخصياً.
وقد صدر في ذلك الوقت كتابٌ لبيتي فريدان حول حياة ربة البيت. كان برأيها أنه من الغباء أن تترك النساء المتعلمات دراستهنّ ليكرّسن أنفسهن لخياطة الستائر وجمع وصفات الطعام. من قال إن المنزل هو قدر المرأة؟ ألم تعمل النساء، والأمهات، عبر التاريخ؟ هذه كانت نقطة انطلاق الموجة النِسوية الثانية، حيث ركزنا على كون تقسيم العمل مسألة سياسية: العمل غير المأجور للنساء، والمأجور للرجال، مما يجعل كفة الميزان تميل لصالح الرجال وتمنحهم سلطة القرار. على سبيل المثال، كانت والدتي زوجة المدير الثرية، غير أنها مجبرة على طلب مصروف المنزل الذي يُمنح لها كما الصدقة.
لقد طرحتُ هذا السؤال نظراً لكتابكِ من دون خجل. اعتبرتُ أنكِ كنتِ تمارسين السياسة من خلال الكتابة.
نعم، هذا صحيح. ولكنه كان غريباً بالنسبة للناس في ذلك الزمان.
أين يكمن السياسي في كتابة السيرة الذاتية؟
لم أفكر بذلك عن وعي، ولكني أدركت مدى أهمية التفاتنا إلى حياتنا. لأننا نطمح أيضاً إلى حياة تزدهر فيها مواهبنا، ونتخذ فيها قراراتنا بأنفسنا. غير أنه ليس لدينا الأمثلة الكافية التي تعلمنا كيف «نتحرر». كنت أبحث في تلك الفترة عن كتب تروي حكايتي، ووجدتها في أميركا وإنكلترا، ولكن عددها كان ضئيلاً جداً. كما كنتُ أكتب في جريدة نسائية صنعناها بأنفسنا دون الاعتماد على ناشر رسمي. كنا نحكي فيها عن تجاربنا. وقد اشتهرت هذه الجريدة جداً، ففكرتُ: إذا كانت كل هؤلاء النساء محتاجات إلى قصصٍ تروي حياتهنّ، فلِمَ لا أكتب كتاباً كاملاً؟ لم أنوِ كتابة رواية أو قصة متخيلة، بل استقيتُ من حياتي الشخصية. وطبعاً لم أتوقع أبداً أن قصتي ستحظى بكل ذلك الاهتمام، لا بل إن ذلك أخافني فعلاً. فالكتاب صار الأكثر مبيعاً قبل أن تصدر مقالة نقدية واحدة حوله. لم يصبح الأكثر مبيعاً لأنه مميز، بل لأنه مميز في ذلك العصر، فمن التي كانت تكتب هكذا؟ أذكر أن الروائية هيلا هاسه استغربت أني استخدمت مادة تصلح لثلاث روايات في كتاب واحد. فقلتُ لنفسي: ولكني لا أكتب الأدب، ولا حتى «سيرة ذاتية»، فهذا ما يفعله الأشخاص الذين يعتقدون أنهم مهمون. أنا كتبت كتاباً كما أحب أن أقرأه. حاولنا أن نغير حياتنا كنِسويات، وأن نستقلّ، ولكنه اتضح أننا لا ندري كيف. كل ما كنت أريد قوله هو أنه بوسعنا التغزل بالحرية، ولكن في الواقع الأمور لا تجري بتلك البساطة. فهل ستستمر علاقتك ِالعاطفية مثلاً؟ أمّا السياسي في الكتاب فيكمنُ في كشفي عن قصص النساء، عن العنف ضدهنّ مثلاً، وجعلي من الحكاية الفردية مشكلة اجتماعية.
كيف أثّرت كتابة هذا الكتاب على حياتك؟
اشتهرتُ فجأة، رغم أني لم أطمح لذلك. كنت أرى نفسي كنِسوية واحدة ضمن حركة واسعة جداً. لا فرق عندي بين كتابة كتاب ووضع اليد على بيت مهجور وتحويله إلى دار لمساعدة النساء المعنفات. لم يعجبني أبداً أني بتُّ مشهورة. أحببتُ طبعاً أني كسبتُ مالاً، إذ لم يسبق أن دخلتْ هذه المبالغ إلى حسابي المصرفي، ولكن لم يعجبني أن الناس باتوا ينظرون إلي كرمز للنِسوية. كما أن البعض بدأ يلومني من داخل الحركة كما لو أني تقصدتُ الترفع على الأُخريات. كنت أقول لنفسي: النِسوية هي جميعنا معاً. لم أقدّم أبداً على وظيفة كـ«رمز» أو «ممثلة للنِسوية».
أعني الكتابة نفسها، ألم تحرركِ الكتابة؟
نعم، ولكني كنتُ أكتبُ من قبل. كتبتُ عدة مقالات حول تجربتي، من بينها مثلاً مقالة حول الأمومة. ما زلتُ أذكر الجملة الأولى: «كان بإمكاني أن أكون أباً رائعاً ولكني أم سيئة». وأقصد أن الرجل إذا قام بما أقوم به (أي العمل وتربية طفل) لقال الجميع عنه أنه أب رائع، ولكنهم يجدونني أماً سيئة. ما زلنا حتى الآن نتوقع من المرأة أن تعمل كما لو أنها لا تربي أطفالاً، وأن تربيهم كما لو أنها لا تعمل.
ثمة نِسويات ركزّنَ تماماً على القضية النِسوية ومنحنها الأولوية المطلقة، وثمة أخريات تنازلن عنها انتظاراً للثورة الاشتراكية الكبرى. أما أنت فحاولت طيلة حياتكِ التوفيق بين الاشتراكية والنِسوية. سؤالي: ألم يحصل أن وقفت الاشتراكية في طريق النِسوية، أو العكس؟ وألم تضطري للتضحية ببعض نِسويتك من أجل إرضاء التيار الذي يعتقد أنه يعمل من أجل الإنسانية جمعاء، وأن النِسوية ليست سوى خروجاً عنها؟
لم أحاول أن أرضي أحداً قط. كنت أرى الاشتراكيين مقصّرين لأنهم يتكلمون عن العمال فقط. قلتُ بوضوح: على الاشتراكيين أن يدركوا مساهمة المرأة العظيمة التي تقدمها من غير أجر. أخذتُ الاشتراكية كما تعلمتها وأضفت إليها شيئاً مهماً، قلتُ إننا كنِسويات اشتراكيات نمثّل «الإنسانية جمعاء» أكثر من هؤلاء الذين لا يرون المرأة إلا في حال كانت عاملة.
كان يهمني أن أوضح للاشتراكيين أنهم غير قادرين على الالتفاف على النساء، وللنِسويات أن التغاضي عن الفروق الطبقية غير ممكن. دعينا نعود إلى بيتي فريدان: الخطأ الذي ارتكبَته هو أنها اعتقدت أن جميع النساء يرغبن بمزاولة العمل، غير أن جزءاً كبيراً من الفقيرات يعملن فعلاً، وبالأخص السوداوات. بل إنهنّ يقمن بأعمال شاقة وبأجر تعيس، حيث لا خيار آخر لديهنّ. هؤلاء النساء يعتبرن الجلوس في المنزل من أجل رعاية الأطفال ضرباً من الدلال. علينا إذن أن نعترف بالفروقات بين النساء. ثمة فرق شاسع عندما تتمتع المرأة بتعليم عالِ أم لا. أسمعهم اليوم يتكلمون عن النِسوية كما لو أنها تُعنى فقط بالنساء اللواتي وصلن إلى القمة، وبتحطيم السقف الزجاجي، ويحصون الأستاذات الجامعيات والسياسيات. ولكن هؤلاء لسنَ سوى طبقة صغيرة جداً ونخبوية إلى حدٍ كبير. معظم النساء غير قادرات على الاقتراب من «السقوف الزجاجية»، بل يجلسن طوال الوقت خلف الحاسبة في السوبر ماركت، أو ينظفن المكاتب، أو يخدمن في بيوت النساء الأخريات. عندما نحاول تعريف النِسوية، نقول غالباً أنها السعي من أجل المساواة بين الرجل والمرأة. ولكن ماذا نريد بالضبط؟ بمن نريد أن نتساوى عندما نتكلم عن المساواة والتساوي بالأجور، هل تريد السيدة الوزيرة أن تتساوى مع سائقها؟ بالطبع لا.
حين نأخذ النِسوية على محمل الجد، لا يمكننا التماهي فقط مع النساء الحاصلات على تعليم عالِ. لا مهرب من النظر إلى الخلفية الطبقية والإدراك أن نصف الهولنديات ما زلن غير قادرات على العيش من رواتبهنّ. مع أن كثيرات يعملن فعلاً، ولكنهن يقمن بأعمال لا تردّ عنهنَّ الفاقة، أو يعملن نصف دوام لأنهن مسؤولات عن أطفال صغار. وقتها ستلاحظين أن التي تتسلق سلم العمل هي القادرة على دفع أجرٍ لامرأة أخرى تكسب أقل منها وتستلم عنها جزءاً من أعمال البيت. بتنا نعلم الآن أنه رغم كل هذا التحرر ما زال الرجل الوسطي يرفض حمل نصف الواجبات المنزلية على عاتقه، بل يفضل تلقي العناية فقط. الرجل الذي يتسلق سلم العمل، ينجح بذلك لأن لديه امرأة تسانده، أما العكس فنادراً ما يحصل.
كنتُ ولا زلت استصعب العمل مع الاشتراكيين الذين لا يعترفون أن جزءاً عظيماً من حياة المرأة يتحدد من خلال كونها الشخص الذي يقوم بالعمل غير المأجور، أي العمل الذي لا نسميه عملاً، بل حباً. نعتني بالرجل وبالأطفال من غير مقابل، ولكننا لا نفكر بالإضراب. إن لم نقم نحن بهذه الأمور، فمن الذي سيفعل؟ وهذه هي بالضبط النقطة التي طالما سببت الشجار بيننا وبين الاشتراكيين. هم يقولون: العمال أولاً، ربات البيوت لسن عمالاً. ما زلتُ أقابل ماركسيين بغاية اللطافة لم يستوعبوا حتى الآن أن الرأسمالية سوف تنهار في حال توقفت النساء عن القيام بكل هذا العمل غير المأجور. فمن الذي سيعتني بغذاء العمال وراحة نومهم ونظافة ثيابهم قبل أن ينطلقوا إلى العمل؟ هذه الأمور لا تُنجز من تلقاء نفسها. هذا ما أسميه النقطة العمياء عند الماركسيين التقليديين.
ولكن أليس هذا هو جوهر الاشتراكية، أن تهتم بالعمال فقط وتنسى ربات البيوت؟
ولكن من يحدد ما هي الاشتراكية؟ أنا أيضاً موجودة. لستُ أقل اشتراكية، بل أكثر اشتراكية منهم، لأني أقبل ما يقولون، وآتيهم بآخر الأخبار وهو أن الإنسانية منقسمة إلى جنسين، وعلينا أن ننظر إلى دور الجنس الآخر. هذا ليس أقلَّ اشتراكيةً، بل تعديلٌ لها وإضافة. لا أقول إن عليهم ألا يتكلموا عن العمل المأجور، كل ما أقوله أن هذا لا يكفي.
عندما نتكلم عن حقوق المرأة، يتساءل البعض أحياناً لماذا لا نتكلم عن حقوق الإنسان والإنسانية جمعاء، لماذا حقوق المرأة فقط؟ برأيهم ليس بإمكاننا الكلام عن حقوق المرأة. ما رأيك؟
حياة الإنسان الذي يعتني بالأطفال تختلف عن حياة الإنسان الذي يتبرع بنطافه، أليس كذلك؟ نسمي أحدهما الرجل، والآخر امرأة. فإذا أردنا أن نصل إلى اللحظة التي نتساوى فيها جميعاً كبشر، يجب أن نعمل على تساوي الظروف والفرص أولاً. هي الآن ليست متساوية. لا يهمني أن أتكلم عن الرجال والنساء إلا في حالة الظلم. أما إذا قضينا على الظلم، فلا يهمني إن كان الإنسان رجلاً أم امرأة. ينبغي ألا يكون ذلك مهماً في غالب الحالات.
اكتشفت النِسويات أن تبادل التجارب والمقارنة فيما بينها من أنجع الوسائل التي تساعد على تطوير الوعي النِسوي. ولقد ازدهرت حلقات الكلام النسائية في سبعينات وثمانينات القرن العشرين. ماذا تحكين لنا عن هذه الحلقات، من كان يديرها، وكيف انتشرت بهذه السرعة الهائلة وكيف اندثرت؟ وكيف كانت تجربتك الشخصية ضمنها؟
كانت طريقتنا في غاية البساطة. اجمعي ست إلى عشر سيدات والتقي بهنّ أمسية واحدة أسبوعياً. كنا نختار موضوعاً وتبدأ إحدانا بالكلام لتنضم إليها الأخريات واحدة تلو الأخرى. وتستلم إحدى المشاركات إدارة الحديث كي تضمن دوراً للجميع. ولكن الاتفاق كان كالتالي: لا توجد رئيسة بيننا، والأهم هو ألا نحكم على أحد، وأن نصغي ونمنح بعضنا حرية الكلام. أهم شيء في تلك اللحظات هو ألا نقول: «هذا ليس نِسوياً» أو «ينبغي ألا تتصرفي هكذا» أو «أنا لأ أوافقكِ»، لأن النساء محقات دوماً حين يروين تجاربهنّ الشخصية. لا يهمنا أن تتشابه تجاربنا، بل أن ندرك أن ثمة قضايا تتحكم بحياتنا وأننا كنا نحسب أنفسنا الوحيدات اللواتي يعانين منها. لم نمرّ جميعنا بتجربة تعنيف، ولكن أكثر من واحدة أو اثنتين فعلت، هذا يعني أن ثمة الكثير من المعنفات في العالم. وقد كانت بيننا امرأة متزوجة تشتكي من علاقة زوجها بامرأة غيرها، كما كانت بيننا امرأة أخرى على علاقة مع رجل متزوج. كانت المواجهة بينهما مؤلمة، فكل واحدة راحت تلوم الأخرى. غير أنه كان مفيداً أن نرى مدى تعاسة الاثنتين. المتزوجة تشعر بالخيانة، والأخرى تعلم أنه سوف يختار زوجته عند الضرورة ولن يختارها. أذكر كيف شرعت الاثنتان تنظران إلى بعضهما بعضاً وتفكران: لماذا نفعل هذا؟ هل هذه هي الحياة التي نريد أن نحياها، أن يكون الرجل مهماً لنا إلى درجة تصبح كل واحدة منا أتعس من الأخرى بسبب أفعاله؟ هذا مجرد مثال عمّا سوف يحدث لو تمكنا من الكلام مع بعضنا بصدق.
لاحقاً صرنا نستخدم هذه التجارب في كتاباتنا ومؤتمراتنا. رحنا نتساءل كم امرأة تشعر بالغباء لأنها تمكث في المنزل ولا تطور نفسها؟ كم امرأة تشعر بالقباحة جراء وابل الوصفات التي تشرح للمرأة كيف ينبغي أن يكون شكلها؟ جميعنا سمينات وأشياؤنا ليست في مكانها الصحيح. عندما اكتشفنا عدد النساء غير الراضيات عن أجسادهنّ، جاءت الخطوة التالية: يا إلهي، كل هؤلاء النساء! من الذي يقنعنا أننا لسنا على ما يرام؟ من يقرر عنا ذلك؟ من أين نَبَعت كل هذه الدعايات؟ من يقرر كيف يجب أن يكون مظهرنا وأن علينا اتباع الحمية؟ هكذا ظهرت النظرية النِسوية.
وبعدها باشرنا العمل. فكرنا: إذا كان لدينا هذا العدد الهائل من النساء المُعنَّفات، لا بد إذن من مكان تتوجه إليه المرأة التي تواجه الضرب. ينبغي أن تشعر أنها ليست وحيدة، وأن ثمة مساعدة تنتظرها في حال اختارت الهرب. هذه إحدى نتائج حلقات الكلام. كانت النساء تشارك في الحلقة قرابة السنة، مرة واحدة في الأسبوع، ويتوقفنَ عندما تُستنفذ جميع المواضيع تقريباً. قد يعجبنا أن نلتقي لاحقاً لنسأل عن الأحوال، بيد أننا كنا لا نسعى إلى فهمٍ أفضل فحسب، بل نريد أن نكون فاعلات أيضاً. لذلك قمنا بتدوين قصصنا وجمعها في جريدة صنعناها بأنفسنا وفي كتيبات لاحقاً. كما أسسنا «بيت السيدات» المفتوح دوماً للمرأة.
ونظمنا مهرجانات: في يوم من الأيام جمعنا جميع حلقات الكلام المتواجدة في تلك الفترة في صالة واحدة. قلتُ يومها لنفسي: ياللروعة! إذ لم يسبق لي أن شاهدتُ هذا العدد من النساء مجتمعات، فضلاً عن كوني تربيتُ على فكرة أن النساء لسن مهمات، وأن لا معنى للحياة إلا حين يدخلها رجل. ولكني بتُّ أرى فجأة أن هؤلاء النساء جميلات فعلاً. وكم استمتعنا! طرحنا مثلاً السؤال التالي على الحضور: كم واحدة منكن تصنّعت أثناء ممارسة الجنس وصولها للذروة؟ ثلاثة أرباع النساء أجبن: أجل أنا فعلت! أما المثليات فقلن أنهنّ لا يتصنعنَ شيئاً. وبضعة نساء ممّن لم يجربن ذلك قبلاً قلن: يا لها من فكرة رائعة، لماذا لم أفكر بها من قبل؟ ضحكنا حتى شبعنا!
كنا نقول أن الطريقة التي تلقينا فيها تعليمنا الجنسي لم تكن مشبعة للمرأة، وأن تصورنا عن ممارسة الجنس ذكورية، مما جعلنا نعتقد جميعاً أن الخلل فينا. تبادل هذه التجارب حرضنا على التفكير بها. من ناحية اكتشفنا أننا لسنا مجنونات، ولسنا وحيدات ولا مضطرات إلى عزل أنفسنا، مما منحنا إحساساً عميقاً بالوعي بالذات والثقة بالنفس وهذا بالضبط ما كنا نحتاجه. ومن ناحية أخرى خلق لدينا أفكاراً جديدة، حيث كنا نطمح إلى التغيير. على سبيل المثال، شاركتُ بتأسيس دار نشر نِسوية، وبتنظيم دورات احترافية لمساندة النساء. ولأول مرة شرعنا بالقيام ببحوث حول العنف والتحرش الجنسي. كما أسسنا ما يسمى بـ «تعليم الفرصة الثانية» للسيدات اللواتي لم يتممن تعليمهنّ الابتدائي.
ولكن لماذا انتشرت حلقات الكلام في تلك الفترة واختفت الآن تماماً؟
حازت حلقات الكلام على شعبية واسعة بسبب الحاجة الماسة إليها. أعتقد أن الحاجة ما زالت موجودة، ولكن كل تلك المواضيع التي كنا نتداولها (من الجنس إلى المظهر) باتت مطروحة الآن في جميع المجلات النسائية. لم يكن الأمر كذلك في تلك الأيام. لم يكن هناك كتاب واحد حول الجنس من منظور المرأة. أنا التي كتبتُ أول كتاب في هولندا، وكان عنوانه: لنا فقط. حالياً تمّ تبني اكتشافات تلك الحقبة، لذلك تجدين قصصاً حول الجنس والعلاقات والحب الفاشل في كل مكان. المعلومات حول كيفية الطلاق وصعوبة التعامل مع الرجال باتت في متناول اليد. لم تعد هذه المواضيع حكراً على النِسوية، لذا يمكنكِ القول أن النِسوية اختفت بسبب نجاحها. مرت فترة اعتقدنا فيها أنه لم يعد ثمة حاجة إلى تنظيمنا كنساء، ولكن الأمور ستتغير برأيي، لأنه لا توجد مساواة حقيقية وما زال العنف والتحرش الجنسي منتشران. انظري إلى حركة أنا أيضاً.
بعض مثقفينا الرجال يشعرون بالإقصاء عندما يسمعون عن لقاءات نسائية أو نشاطات للنساء فقط. لا أدري ما الذي يغيظهم بالضبط، فيتّهمون النساء المبادِرات بالانطواء على الذات، وفي أحسن الحالات بممارسة سياسة الهوية؟ كيف تردّين عليهم؟ وهل هناك فائدة فعلية من المبادَرات النسائية حصراً؟ وما هي شروط مشاركة الرجل فيها؟
لو لم تنظم النساء حلقات الكلام، لمَا كان هناك نِسوية، ولمَا تكلمنا عن المواضيع التي تعنينا. سبب عدم مشاركة الرجال هو أن النساء لن يتحدثن بصدق أمام الرجال حول ما يقاسينه منهم. إذ أنهنّ سيضطررن إلى تمسيد لحية الرجل والقول: لا، لا، نحن لا نقصدكَ أنت! وهذا مُرهِق للغاية. قابلتُ في الماضي رجالاً كانوا يقولون: لا مانع عندي أن تتحرر النساء على شرط ألا يؤثر هذا على حياتي. هذا يدل على أنهم لم يفهموا بعد أن النساء لسن الوحيدات المطالبَات بالتغيير، وأن عليهم أن يتغيروا معنا. وطبعاً نحن نرفض أن يملي الرجال علينا ماذا ينبغي القيام به، مع أن هذا كان يحصل كثيراً، وبالأخص من قبل أولئك الرجال اليساريين.
برأيي لا بد أن تأتي اللحظة التي سنتعاون فيها مع الرجال. يتعين حينها أن يكون مشروعنا المشترك واضحاً، وإلا لن يكونوا مستعدين مثلنا للنظر إلى أنفسهم، والتفكير بدورهم في الحفاظ على عدم المساواة. إن رفضوا ذلك، فهم غير جديرين بالشغل مع النِسويات. حتى ولو كانوا اشتراكيين حتى النخاع، لا يمكننا العمل معهم إن لم يدركوا مغزى التعاون وما هي مساهمتهم الشخصية. يا لها من تجربة إيجابية وتعليمية حين يشعر الرجل بالإقصاء، لأنَّ هذا ما يحصل مع المرأة دائماً. وحين يتساءل الرجل: «مممم، لماذا لم أعد مركز حياة النساء؟»، سيضطر إلى التفكير ببداهة تلقيه للعناية، وأخذ رغباته بالحسبان، وسينتبه أنه دائماً أول من يحق له فتح فمه بالحديث، وأن ثمة من يصغي إليه.
حاجة الرجال إلى النساء في كل شيء نابعة عن عدم معرفتهم ماذا سيفعلون من دون النساء. دعيهم يفكرون إذن. ما هو الشيء الذي يجعلهم متعلقين بالنساء بحيث لا يتحملون قيامنا بأشياء من دون السماح لهم بالحضور؟ هذا مهم جداً برأيي. أعرف رجالاً يتفهمون ذلك، كما أتفهم أنا كامرأة بيضاء أنه غير مرحب بي في بعض النشاطات التي ينظمها السود ليتحدثوا عن العنصرية. كنتُ عضوة في لجنة مكافحة العنصرية التابعة لحزب الفهود السود عندما واجهتُ هذا الموضوع لأول مرة. استهجنتُ كثيراً أني مُنعت من المشاركة، مع أني ضد العنصرية وأعتبر نفسي بيضاء جيدة. غير أني بتُ أفهم الآن أن ثمة قضايا لا يمكنني السيطرة فيها وعليَّ التسليم بها والاقتياد بالآخر. من الأهمية بمكان أن يتعلم الرجال تقبل قيادة المرأة وتنفيذ المطلوب. هذه ليست تجربة سيئة على الإطلاق. حاولتُ مثلاً أن أكتشف ما هي الميزات التي أتمتع بها كإنسانة بيضاء. فحين أذهب إلى غزة، يعاملونني على الحدود كما لو أني فلسطينية، أي مجرمة محتملة أو عدوة. لم أعتد هذا من قبل، أنا متعودة أن يُحسب حسابي دائماً. كان معي رجلٌ أسود قال لي: «تجربتي تختلف عن تجربتكِ، أنا لا أغضب، فأنا أفكر أن هذا ما يحصل معنا دائماً، أما أنتِ فلا تحتملين، لأن البدهي عندكِ أن تُؤخذي على محمل الجد». والشيء نفسه ينطبق على الرجال. دعي هؤلاء المتذمرين من الإقصاء يتساءلون لماذا لم يبدؤوا بالشغل على أنفسهم حتى الآن، لماذا لا يفكرون بسلوكهم، ولماذا يظنون أن النساء غير قادرات على الابتعاد عنهم؟ دعيهم يدركون مدى تعلقهم بالنساء واعتمادهم عليهنّ.
سؤال عن دور الرجل في القضية النِسوية. بعد أن خطّت سيمون دي بوفوار كتاباً ضخماً عن المرأة، الجنس الآخر، نراها تختم كتابها بالجملة التالية «يعود للرجل ضمن عالمٍ معطى أن يجعل الحرية تسود». هذا يعني أنها تقول إن المرأة لن تتحرر إذا كان الرجل لا يريد ذلك، أي أن التحرر يبدأ من عنده. ألا ترين هذا محبطاً للغاية؟ هل توافقينها؟ وإذا أجبت بالإيجاب، كيف ينبغي على النِسويات أن يتعاملن مع هذا المعطى؟
لا أتذكر هذه المقولة. ولا أوافق عليها، فقد اتضح تماماً أن الرجل لا يمثل لنا مملكة الحرية – مع بعض الاستثناءات طبعاً. كما أن الرجال أنفسهم مقيدون بسلاسل الرجولة المفروضة، بيد أن هذه الرجولة تضمن لهم كسب مال أكثر وتمنحهم سلطة أكبر. حرية الرجال كانت ولا زالت أوسع من حريتنا، ولكن هذا لا يجعلهم مثالاً نقتدي به. كم أنا سعيدة بظهور مجموعات من الرجال تسعى فعلاً إلى المساواة الجندرية، فقد أدركوا أنهم سوف يستفيدون أيضاً.
كتبت سيمون دي بوفوار كتابها قبل صعود النِسوية، فلا عجب أن تميل إلى تقليد نموذج الرجال التقدميين: بدون زواج، ولا أطفال، ولا حتى مساكنة، مع عدم الارتباط بشخص واحد. حاول سارتر أن يحتفظ بحقه بالارتباط بعدة علاقات، ففعلت مثله، ولكننا نعلم من مذكراتها أنها لم تكن سعيدة. لم يكن لديها نموذج نِسوي بديل للحياة التقليدية وخدمة الزوج والأطفال. في الحقيقة لا أجد فائدة من استنساخ النموذج الذكوري والزعم أن الزواج وإنجاب الأطفال مؤسسة قمعية. جميل أننا بتنا نملك الحق في اتخاذ القرار بخصوص الإنجاب أو عدمه، ولكن تخيلي الآن أن تُضرِبَ جميع النساء عن الإنجاب! عندها سنكون وجدنا حلاً لمشكلة البيئة، فكل شيء سيتوقف. أنا مع رد الاعتبار للأمومة. أليست الأمومة، مثلها مثل العمل المأجور، مساهمة هامة في سبيل استمرار الحياة؟
لم تعتبر دي بوفوار نفسها نِسوية إلا في مرحلة متقدمة من عمرها، أي بعد انطلاق الموجة الثانية في فرنسا. من يدري كيف كانت ستفكر لو عاشت في حقبة لاحقة، أي بعد نشوء نماذج جديدة تستثمرها النساء في تنظيم حياتهنّ.
هناك جدل يجري حالياً في هولندا حول كيفية التعامل مع المنقبات في الشارع والدوائر الحكومية. التركيز على هؤلاء المنقبات ليس بريئاً أبداً، وألمس تماماً البعد العنصري تجاه الإسلام في محاولات منعه. وأراك محقة بمهاجمتك لخطط منع النقاب. ولكن الشيء الذي يثير انتباهي وحزني، هو أنك لا تقولين شيئاً عن النقاب كرمز لحجب المرأة عن المجال العام، أي أن البعد العنصري الآخر يغيب عنكِ أو بالأحرى تتجاهلينه. لم أسمع كلمة «ولكن» منك. كأن تقولين: أنا لست مع الضغط على المسلمين بهذه الطريقة، ولكن هذا لا يعني أن النقاب ليس رمزاً وتطبيقاً عنصرياً تجاه المرأة. لماذا لم أسمع منكِ هذه الـ«ولكن»؟
لم تسمعي مني ما تريدين، لأنه رأيكِ وليس رأيي. أفهم تماماً أن السياق يحدد الموقف من الحجاب والنقاب. أنتِ سورية، وتاريخكِ يختلف عن تاريخي. مبدئي الأساسي هو أن تختار المرأة لباسها وأسلوب تعبيرها عن إيمانها أو عدمه. في البلدان التي تُجبر فيها النساء على لبس الحجاب أو النقاب، أقفُ في صف المدافعات عن حرية رفض ذلك. أما في بلدي فالأمر معكوس، لدينا حملة يمينية ضد المسلمين. ثمة محاولات لحظر كافة التعبيرات الدينية العلنية، مع أن هولندا ما زالت مكتظة بالكنائس. أقفُ هنا في صف النساء اللواتي يدافعن عن حقهنّ في لبس الحجاب أو النقاب. انضممتُ منذ فترة إلى مجموعة من المسلمات الناقدات للعنصرية العرقية والجنسية وعدم المساواة المتواجدة بين جاليات المهاجرين. بعض المشاركات سافِرات، ولكننا جميعاً متفقات على أن الحكومة والسياسة لا يملكان حق التدخل بلباس النساء. عبر صِلاتي الواسعة مع المسلمات، وبعضهنّ منقبات فعلاً، بدأتُ أفهم الدوافع الكثيرة وراء التحجّب أو عدمه، مع أنها لا تعنيني حقاً. هناك قضايا كثيرة على المسلمات أن يناقشنها فيما بينهنّ، وليس معي أنا. تماماً مثلنا حين قررنا أن ثمة قضايا نفضّل تداولها فيما بيننا، فلا نترك القرار فيها للرجال. لا أجد سلوكي نِسوياً حين أشرع بتعليم هؤلاء النساء ما هو النقاب، وبودي أن أقول للنِسويات الهولنديات اللواتي يعارضن الحجاب: لا يمكنكنّ البت بالموضوع بمعزل عن المسلمات! يتعين علينا أن نعي أن النِسوية البيضاء غالباً ما تتعامى عن العنصرية واضطهاد المهاجرين واللاجئين، يجب أن نتواضع في حكمنا على آراء نساء الأديان والثقافات الأخرى. تعلمتُ الكثير من النِسويات المسلمات، إذ أن مبدئي الأساسي الثاني هو أنه حان أن نتوقف عن تحديد ما هو الأنسب لهم. في حزبي (معاً 1)1 نتعاون مع عاملات الجنس وعابري الجنس وذوي الإعاقات واللاجئين والمهاجرين والأمهات العازبات. نحاول أن نتكلم بأنفسنا، وهذا ينسحب على المسلمات أيضاً. أهم شيء هو أن يتعلم الهولنديون البيض أن المسلمين بشر ويملكون صوتهم الخاص.
أتعجب كيف يتغير الزمان. منذ قرنٍ ونيف كنا نعتبر تغطية الجسد أمراً حضارياً، حتى أن النساء كن يسبحن بثيابهنّ. أما الشعوب التي تمشي نصف عارية فكانوا «برابرة» في نظرنا. حالياً انقلبت الآية: صار ينبغي عليكِ أن تلبسي المايوه وتستلقي على الشاطئ كي تثبتي أنكِ «متحررة»، أما إذا فضلتِ تغطية جسدكِ فأنتِ بدائية. أرجو ألا يكون ميلنا لتعريف ثقافتـ«نا» على أنها متفوقة على الشعوب الأخرى سوى آخر رفات الاستعمار.
العلاقة بين الأنوثة والكتابة علاقة إشكالية نوعاً ما. لا نعلم كم من الإبداعات ضاعت في صراع المرأة مع شروط الحب غير المتكافئة وواجبات الزواج غير المتوازنة وقدسية الأمومة. هذا فضلاً عن صعوبة الكتابة جراء قيود تحدّ حرية المرأة الداخلية وضعف الدعم الاجتماعي الذي تتمتع به المبدعة. ومع ذلك تمكنتِ من كتابة ما يزيد على 45 كتاباً إلى جانب كونك أماً وحبيبة وزوجة لمرتين. كيف فعلتِ ذلك؟ كيف طوّعتِ نفسكِ ومحيطكِ لتحقيق ذلك؟
تطرحين سؤالكِ كما لو أني نجحتُ في ذلك. كتبتَ الكتب فعلاً، ولكن السؤال الأصعب هو كيف فعلتُ ذلك، وكيف كانت علاقاتي العاطفية، وبالأخص بعد أن بدأتُ أشتهر. كان الرجال يعجبون بي، ولكن الأغلبية يستصعبون أني امرأة مهمة. حين كنتُ أُدعى لإلقاء ندوة، ينتهي سروري بمجرد اصطحاب صديقي. فالناس ينظرون إليه كتابع، كما يحصل عادة مع النساء، ولكنه لا يحتمل ذلك. معظم الرجال غير قادرين على مساندة النساء كما نفعل نحن من أجلهم. كان هذا سبباً للصدامات واضطرني لإخبار صديقي أني لا أرغب باصطحابه، لأني سأنشغل طوال الوقت بالحرص على مشاعره فقط. أول علاقة لم أواجه فيها صعوبات كامرأة مستقلة وشخصية عامة كانت مع زوجي العربي. لا أفهم كيف حصل هذا، ولكنه الوحيد الذي لم أتشاجر معه عندما كنت عضوة في مجلس الشيوخ. لا أقول أنه ساندني، فنحن لم نقطن في بيت واحد. انظري، الحب جميل طالما أنتما لا تعيشان سوية. وأنا لم أساكن أحداً بشكل دائم بعد انتهاء زواجي الأول. وحين شرعتُ بالكتابة كنتُ في بداية الثلاثينات، وابني في سن المراهقة وبإمكاني أن أقول له: اسمعني جيداً، أنا لا أكتب فقط حين أكون منكبة على الآلة الكاتبة، أنا أكتب أيضاً حين تراني سرحانة أمام النافذة. كان يفهمني، ويمتنع عن إزعاجي.
أفهم أن يصعب على غالبية النساء خلق الحرية لأنفسهنّ. فالأطفال يحتاجون للتركيز، وبالأخص عندما تداومين أيضاً على عملٍ لا يترك مجالاً لأي شيء. كنتُ أعمل كمدرّسة، أقفُ أمام الصف أسبوعاً، وأعطّل الأسبوع الأخر. كان هذا مناسباً جداً، فالكتابة تحتاج إلى أكثر من سويعة مسائية أكون فيها مرهقة في غالب الأحيان. كما أني تعلمتُ أن أكون غير اجتماعية، وأن أقول آسفة، أنا لست متاحة، لأني منشغلة بالكتابة. لا أجيب أحياناً على الهاتف، مع أن هذا يزعج الكثيرين من حولي.
الحركة النِسوية هي التي زودتني بالثقة التي أحتاجها لتوفير الوقت للكتابة، حيث أخذنا حريتنا لنكتب ما نشاء. كنا نكتب من دون ذكر أسمائنا في بادئ الأمر. لم نهتم لذلك لأننا نكتب من دون أجر أصلاً. اكتشفتُ وقتها كم أحب الكتابة، وأن أقدم شيئاً للآخرين من خلالها. لا يوجد أحد يراجع كتاباتي ويقول: هذا ليس أدباً، أو لا تشتغلي هكذا. الحرية الداخلية أمر يختلف عن إيجاد الوقت الكافي، أعني حريتكِ التي تمنحكِ صوتكِ الخاص. برأيي بمقدور النساء مدّ يد المساعدة لبعضهنّ في هذا المجال. بوسعهنّ مثلاً إعادة تجربة حلقات الكلام، ولكن على شكل مجموعات كتابة، من دون رقابة، ومن دون البحث عن ناشر في اليوم التالي. وقد نفّذنا ذلك: رحّبنا بكل التجارب، وطلبنا من الجميع أن يكتبنَ. لا نقول هذه المادة أفضل من تلك، بل نستمتع بقراءة كتاباتنا وقد نصنع منشوراً منها. إذ أن لدينا مشكلة إضافية: معظم كتّابنا وقرائنا من النساء، ولكن الناشرين لا يمنحوننا أي تسهيلات، وبالأخص في الآونة الأخيرة. لذا أسسنا دار نشر خاصة بنا، وصار لدينا إعلامنا الخاص ومدوناتنا. على سبيل المثال، قلما نجحتُ بنشر مادة في الجرائد، ولكن عدد «الأصدقاء» على فيسبوك وصل حده الأقصى.
هل تشعرين أنكِ حصلت على ما تستحقينه من الاهتمام كمثقفة في عالم يسيطر عليه المثقف الرجل؟
لا، ولكني لا أهتم. لقد قمتُ بواجبي وما زلتُ أفعل. في الحقيقة أنا أنظر لنفسي كناشطة أكثر من كوني مثقفة. ربما يجب ألا أتشكّى من كمية التقدير التي أحصل عليها فعلاً، ليس من الإعلام الرسمي، وليس من العالم الأكاديمي، ولكن من طلابي وقرائي وأولئك الذين يحضرون ندواتي. والذين أتعاون معهم بكل تأكيد.
من أين جئتِ بكل هذه الطاقة؟
من النساء الأخريات، من النِسوية، من فكرة أننا نقول أشياء مهمة. شاركتُ في الشهر الماضي [آذار 2019] في ثلاث تظاهرات كبيرة: مسيرة النساء ومسيرة من أجل البيئة ومظاهرة مكافحة العنصرية. آلاف الناس شاركوا معنا. وفي الأول من أيار احتفلنا بعيد العمال طبعاً. أتعاون حالياً مع مجموعة من الأمهات العازبات ومع مجموعة أخرى من المسلمات. كما أن الحزب الذي انتسبت إليه مؤخراً، حزب (معاً 1)، هو أول حزبٍ أسسته امرأةٌ سوداء. نعمل معها من أجل المساواة الجذرية والعدالة الاقتصادية. وسوف أخطبُ قريباً في مهرجان الماركسية. أنا جزء في حركة كبيرة وفي غاية الأهمية وهذا يمنحني طاقة.
هل نواصل إذن؟
نعم، أنا متأكدة أننا نقوم بعمل في غاية الأهمية. والتاريخ في صفنا.
1. حزب سياسي تم تأسيسه عام 2016، ترأسه الهولندية السورينامية سيلفانا سيمونس. كان الاسم الأصلي للحزب هو (بند رقم 1)، في إشارة إلى البند الأول من الدستور الذي يضمن المساواة لجميع المواطنين بغض النظر عن الدين أو العرق أو الجنس أو الميول الجنسية أو أسلوب الحياة. اضطر الحزب لتغيير اسمه بسبب تشابه الأسماء مع مؤسسة اخرى، فصار اسمه: معاً 1، وحصل الحزب في انتخابات 2018 على مقعد واحد في مجلس بلدية أمستردام، ولم يصل حتى الآن إلى البرلمان.
موقع الجمهورية




