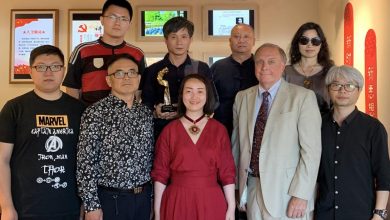ليلة في ليما/ فرناندو بيسوا

ترجمة ميشرافي عبد الودود
ألاّ تُبقي هنا في دُرْج،
ألاّ تُبقي هنا في جراب،
مختوما، متبلورا، مكتملا،
هذا المشهد كله.
ألاّ تنتزع عنوةً
من الفضاء، الزمن، الحياة،
مُحتَجِزا
في مكان ما
من الروح حيث ستبقى مدخرة
للأبد
حيةً، ساخنةً،
هذه الصالة، هذه الساعة،
العائلة بأسرها، السكينة والموسيقى بالداخل
لكن حقيقية على صورتها هناك
الآن، مرة أخرى
عندما كنتِ ماما، ماما، تعزفين
ذات ليلة في ليما.
أين توجد الساعة، البيت، الحب؟
عندما كنت تعزفين ماما
ذات ليلة في ليما؟
وفي زاوية من الأريكة
أختي،
صغيرة وملمومة،
لا أعرف إن كانت نائمة أم لا.
وبرغم الدموع، لا تخطئ
الذاكرة التي أحملها
خط الميدالية الرفيع
لهذه الجانبية الأكثر من رفيعة
قلبي، فيما يتذكرك، وديعة ورمادية قبل الآن؛
يبكي، قلبي الذي لك دائما، والذي دائما طفلا
أرى أناملك على لوح البيانو
فيما ضوء القمر بالخارج للأبد بداخلي،
أنت تعزفين على قلبي، بلا نهاية،
ذات ليلة في ليما.
لكن حبّكِ كان يرشح فوق كل شيء.
الصمت الفادح للأشياء المنتهية
يداك الصغيرتان والجميلتان جدا
في رهافة مغتبطة ومألوفة
في ابتسامة لا تسع
سوى سرمدية الإنسان
كنتِ تسحبين السكينة من البيانو
ذات ليلة في ليما.
لم أكن أعرف وقتها أنني كنت سعيدا.
الآن فيما لم أعد الذي أنا، أعرف جيدا أنني كنته.
“هل نام الصغار على الفور؟
– لكن أجل، لقد ناموا على الفور.
– هذه تقريبا نائمة”.
فيما أنتَ مبتسما ومتجاوبا تكمل
ما كنت تلعب –
كنتِ تعزفين متأنية
ذات ليلة في ليما.
كل ما كنتُ عندما لم أكن شيئا
كل ما أحببتُ وما لا أعرف حقا
أنني أحببته إلا من انسداد الطريق اليوم
إلى أدنى تحقق
من فراغ يدي إلا من لوعة الصُوداد –
كل هذا يجِيش بداخلي
عبر الأضواء، الموسيقى، ورؤيا
لا تتناهى
من هذه الساعة الأبدية في قلبي،
التي كنت تقلبين فيها
الصفحة الخيالية للموسيقى الملعوبة
بينما أنا أنصت إليك، وأراك
تتابعين
اللحن الأبدي
الغريق
في القاع الأبدي لهذه النوستالجيا
عندما كنت أمي، تعزفين
ذات ليلة في ليما.
“هذه أيضا مستغرقة في النوم…
– لا إنها ليست نائمة”.
ثم أخذنا جميعا نبتسم
وبشرود تابعت
الاستماع في ضوء القمر
الذي يشعّ في الخارج عنيفاً ومفرداً،
ما جعلني أحلم بلا انتباه،
ما أحلم به اليوم من أسفي على نفسي،
هاته الترنيمة الصامتة، مختومة وهادئة
التي كانت أمي تعزفها –
ذات ليلة في ليما
ذات ليلة في ليما.
أنا كنتُ كثيرا من الأشياء الوضيعة
خنتُ كثيرا ما أنا
الروح الظمآنة
لهذا الجدلي المثالي الذي أنا
لطالما تمادت في التوهان
لطالما أجمعت المشاعر جميعها
على خداعي –
لأنني بلا مأوى
دعيني أسكن
رؤيا
هذا المنزل العتيق،
دعيني أتابع الاستماع بلا انقطاع –
أنا في النافذة
من المكان الذي لا نكفّ فيه عن الشعور،
في الصالون، صالوننا، الدافئ
من أفريقيا المترامية حيث يكون ضوء القمر
في الخارج فسيحا ولامباليا،
ليس ثمة صواب ولا خطأ
وأين إذن، في قلبي
ماما، ماما،
تعزفين بشكل مرئي
تعزفين إلى الأبد
ذات ليلة في ليما.
أمي كانت تجلس على البيانو
وتعزف…
بتفانٍ.
ذات ليلة في ليما.
إلهي، إنه بعيد جدا، جدا بائد كل هذا!
ماذا عن طلعتها المهيبة؟
ماذا عن صوتها الحفيّ باستمرار؟
ماذا عن ابتسامتها المتماسكة الدافئة؟
ما يحدث اليوم
وينْمنح للذكرى؛ أنني أستمع الآن
“ذات ليلة في ليما”
التي تذاع على الراديو
هذا اللحن، الذي لنا، ملكنا،
ليس سوى.. ذات ليلة في ليما
خصلات شعرها الرمادي كانت جدا جميلة
تحت الأضواء
وأنا الذي لم يكن يفكر يوما أني سأفقدها
وتتركني فريسة لِما أنا
ها قد رحلتْ، غير أني دائما طفلها.
لا أحد رجلا في عين أمه.
ينبعث الصوت من الراديو
متلكئا بلا داع في إعطاء الخبر:
“والآن
ذات ليلة في ليما”…
أتوقف عن الابتسام…
يتوقف قلبي…
وفجأة
الأغنية المعشوقة والملعونة ذاتها
تتدفق من الآلة الجامدة…
في ذاكرة فجائية وفورية
تاهت روحي
ضوء قمر أفريقيا الفسيح يُغرق
تلالا تكسوها الأشجار في بياض نقي
كان صالون منزلنا فسيحا، يتطلع
من حيثما يتجه، حتى البحر، مُطلا
على العتمة الشفافة للقمر العملاق…
لكن أنا فقط، في النافذة.
وفي هذا الدفئ،
في هذه السعادة،
حيث كان ثمة روح
(إلهي، ما أقسى هاته الصوداد!)
حيث تحت الضوء الذهبي،
(أين مضى اليوم كل ذلك؟)
بعيدا عن المكان الذي كان فيه القمر فضيا،
كانت أمي تعزف،
ميداليةً متأنية وإنسانية على البيانو،
ذات ليلة في ليما.
منذ ذاك الوقت
عبرتُ
كثيرا من الحيوات،
في معظم الأوقات متاهاتٍ.
قلبي
ينوء بالأشياء المتروكة.
كم مضى من الوقت،
في عذوبة رغد منزلنا القديم، وأنا
في النافذة، أنصت، حالما متسمرّا،
منفردا، خفيّاً،
ماذا تحوي
كل هاته الموسيقى الحسية والفطرية،
كل ما تركته يتلاشى
في قلب من أردتُ أن أكون،
كل ما تركت ورائي،
من مجرد التفكير فيه،
كل ما كان، كل ما كان
بالنسبة لي مجرد حلم،
الافتتان
المنتشي بحزن
لأني حلمته،
من يدري ما إذا كانت هاته الصوداد
التي استحالت إلى حلم نصف إنساني
من بين كل ما تنطوي عليه هذه الليلة،
تقيم في البعيد، حيث كنتِ ماما الصغيرة، على البيانو
تعزفين، تحت فيضان ضوء القمر
ذات ليلة في ليما.
زوج أمي
(أيّ إنسان، أيّ روح، أي قلب!)
يتكئ بجسده الممتلئ كرياضي معافى يستريح،
على الأريكة الأكثر اتساعا
فيما يستمع، مدخِّنا وحالما،
وعيونه الزرقاء انمحى أزرقها
وأمي، طفلةً،
في زاوية مقعدها المريح،
ملمومة، تستمع نائمة،
ومبتسمة…
كان ثمة عزف في مكان ما
ربما كانت رقصة…
فيما أنا، واقف، أمام النافذة،
رأيت كلّ ضوءِ قمر أفريقيا كلها
يُغرق مشهد حلمي.
أين مضى كل هذا؟
ذات ليلة في ليما.
فلتنفطر يا قلبي.
إنها محطة إذاعة لامبالية
من خلال آلة جامدة
في الموسيقى، في الموسيقى فقط، منحتني
القلق العميق الذي يراودني
عند رؤيتك، لأنني أتذكر
ماماي، ماماي،
الهادئة جدا، تعزف
ذات ليلة في ليما.
بيد أني أشعر بغيبوبة
لا أعرف إذا ما كنت أرى، أم أنني أنام،
لا أعرف ما إذا كنت أتذكر، أم أنني أنسى،
ثمة ما يشبه الغموض، يتدفق،
بين الذي أنا والذي كنتُ،
مثلما نهر، أو ريح، أو حلم،
شيء ما فجائي أجهله تماما
يتعطل بغتة
ثمّ، في القاع حيث يتلاشى؛
ينبعث، أكثر وضوحا دائما،
في هالة من الصفاء
والحنين،
حيث لا يزال قلبي معلقا
البيانو، صورة العازفة، الصوداد،
أنام متوسدا هاته المعزوفة –
وأسمع أمي، تعزف،
أسمع؛ ملحُ الدموع في الفم يسبقني،
ذات ليلة في ليما.
غلالة الدمع لا تعمي عيوني.
أنا أرى، فيما أبكي،
ما تعيده لي الموسيقى –
الأم التي كانت لي، المنزل القديم،
الطفل الذي كنتُ،
رعبُ الزمن، لأنه يمضي،
رعب الحياة، لأنها ليست سوى قتل،
أنا أرى وأتلاشى،
في إغماءة حيث أنسى؛
أنني ما زلت موجودا في هذا العالم…
أشاهد أمي تعزف.
وتلك الأيادي البيضاء، الصغيرة،
التي لن تداعبني أبدا لمستها،
تعزف على البيانو، متفانية وهادئة،
ذات ليلة في ليما.
آآآه، أنا أرى كل شيء بوضوح
أنا مرة أخرى هناك.
أشيح بعيوني التي رأت
عن ضوء القمر الشحيح في الخارج.
لكن ماذا؟ أنا أهذي فيما توقفت الموسيقى…
أهذي كما كنت هاذيا دائما
من دون التحقق ممّا أنا في أعماق روحي
من دون إيمان حقيقي أو قانون ثابت.
أهذي، أخلق أبديات تخصني وحدي،
في أفيون من الذاكرة والهجر،
أنصّبُ ملكات رائعة،
لا قدرة لي على تتويجهن.
أحلم لأنني أستحم
في النهر المتخيل للموسيقى المتوقفة،
روحي طفلة ترتدي خرقا
وتنام في زاوية مظلمة.
لا أملك مني
في قساوة الواقع الفعلي
سوى رثاثة روحي المهجورة،
ورأسي الذي لا يزال يحلم مقابل الحائط
أمي، أليس بالإمكان وجود
إله يحُول دون بطلان كل شيء،
عالم آخر حيث يستمر كل هذا في الوجود؟
ما زلت أهذي: وهمٌ كل شيء…
ذات ليلة في ليما.
انفطر يا قلبي…
في السنوات من 1930 إلى 1935، وهي السنوات التي تدهورت فيها صحة فرناندو بيسوا بوتيرة متسارعة أدت إلى القصور الكبدي الذي تسبب في موته 30 نوفمبر 1935، شكّل استرجاع الطفولة المفقودة الغنائية المستحوذة التي رشحت على سطح قصائده العاطفية. وتمنح هذه النصوص المتأخرة فرصة نادرة للتعرف على بعض ملامح شاعر اللاطمأنينة الذي “لم يكن أبدا”، ومارس لعبة الاستخفاء تحت أسماء مستعارة كثيرة طوال حياته.
شهران قبل رحيله، كتب الشاعر أحد أصدق وأعمق النصوص على الإطلاق: “ليلة في ليما”، حيث يستدعي صورة الأم التي تعزف على البيانو أغنيةً بنفس العنوان تتكرر هنا كلازمة للفقدان، السكينة في البيت العائلي بجنوب أفريقيا، ضوء القمر، الأخت الصغيرة النائمة، بيسوا طفلا وشاعرا يمزقه الندم، وزوج الأم المثالي المستريح على الأريكة…
للمرة الأولى والأخيرة يقبل فرناندو بيسوا الميلودرامي المتعدد المتخفي بالظهور العلني من وراء الستارة السوداء بوجهه المكشوف الذي مزقته الأقنعة المطاطية اللاصقة موقعا “صورة الفنان في شرخ الشباب”؛ صورة حية نابضة بالألم الذي نفض يديه من كل أمل مستحيل؛ كأنما يعتذر متحسرا بعد فوات الأوان من نفسه ومن الجمهور من إطالة أمد لعبة التخفي والتعذيب. القصيدة صوداد (مفردة برتغالية لا يوجد لها مقابل في اللغات الأوروبية)، وهي مزيج شعوري يختلط فيه الحزن والحنين والأمل. وبحسب بيسوا “الصوداد هو شعر الفادو” القريب نوعا ما من الفلامنكو الأندلسي، وهما يشتركان في وحدة الفاجعة: نكبة العرب في الأندلس سنة 1492، ونكبة البرتغال بانهيار أحلام الامبراطورية في معركة القصر الكبير سنة 1578.