جُلّ التاريخ المروي يعدُّ خاطئاً.. لماذا؟/ أليكس روزنبرغ
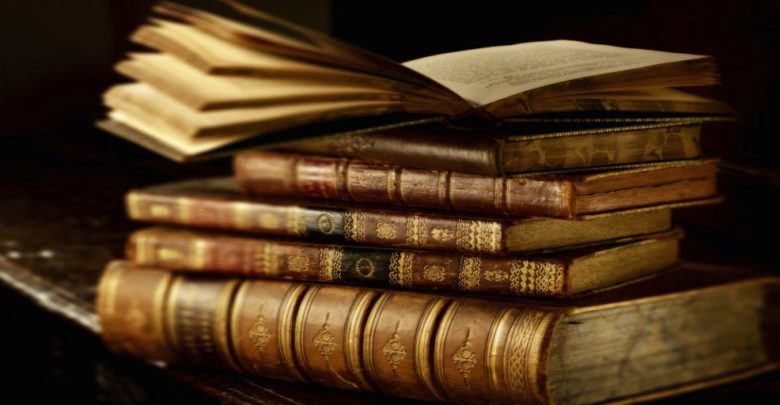
ترجمة – Salon
يكاد يكون من المسلم به عالمياً أن معرفة تاريخ أمر ما، أسلوب ناجع لفهمه. ويقال أيضاً إن معرفة تاريخ شأنٍ ما، هي أفضل الطرق لفهمه. بل في الكثير من الحالات يُعتقد بأن الطريقة الوحيدة لفهم شيء ما، هي معرفة تاريخه.
إلا أن هذه الافتراضات الثلاثة خاطئة.
تسير علوم الإدراك والأنثروبولوجيا التطورية وفي مقدمها علم الأعصاب، بخطى ثابتة لتعليمنا ثلاثة أشياء عن التاريخ: الأول هو أن ارتباطنا بالتاريخ باعتباره طريقاً للفهم له جذور تطورية ومغروس في أساس جيناتنا؛ ثانياً ما هو تحديداً الأمر المتعلق بالدماغ البشري الذي يجعل كل التفسيرات التي قدمها التاريخ يوماً خاطئة؛ ثالثاً كيف حوّل تطورنا أداة مفيدة للنجاة إلى نظرية معيبة عن الطبيعة البشرية.
قد يجد الكثير من القراء سهولة في تصديق أول هذه الافتراضات. قد يكون لجوءنا إلى التاريخ بقصصه الحقيقية، باعتباره وسيلة للفهم هي طبيعة ثانية فينا على حد تعبير المثل الشائع. لكن إذا كان للعلم أن يثبت أنه طبيعة أولى فينا، مغروس فينا وهو جزء مما يسيرنا ومحفور بطريقة ما في جيناتنا، قد يساعدنا هذا في فهم خصيصة من خصائص الحياة والثقافة الإنسانية، عتيقة وأزلية وصامدة في وجه أي تغيير. لكن الافتراضان الآخران سيصيبان معظم القراء بالذهول. كيف تكون كل التفسيرات التي يقدمها التاريخ خاطئة، وكيف يمكن للتطور نفسه أن يحملنا بنظرية معينة، بعيداً عن أن تكون نظرية عن الطبيعة الإنسانية، تكون خاطئة تماماً؟
لا تأتي هذه التأكيدات الثلاثة التي تقضي بأن ثقتنا في التاريخ وميلنا وحاجتنا له بل وحتى حبنا له، شيء مادي ماثل فينا، وأن كل التاريخ خاطئ وهذا الخطأ ناتج عن تطور لاحق لما هو مغروس فينا ابتداءً، إلا متلازمة لا يمكن فصل أحدها عن الآخر. يُبنى الافتراضان الثاني والثالث اللذان يصعب تصديقهما، على الفرضية الأولى، ويفعلان ذلك بطريقة تجعل من الصعب علينا أن نرفضهما. إذا كان علم النفس الإدراكي والأنثروبولوجيا التطورية والأهم منهما علم الأعصاب، قادرين على تفسير سبب ارتباطنا بالتاريخ باعتباره وسيلة للفهم، فبإمكانهما دحض ادعاء التاريخ بأنه يقدم فهماً حقيقياً للماضي والحاضر والمستقبل.
ليس التاريخ الأكاديمي التاريخ الذي نلجأ إليه لتفسير الأفعال البشرية الفردية والحيوات التي تؤسسها، أو لفهم الإنجازات الإبداعية والسياسية والعلمية والعامة الشهيرة والقرارات المصيرية ونتائجها التي تكون كارثية في كثير من الأحيان. هذا لأن التاريخ الأكاديمي اليوم نادراً ما يكون تاريخاً سردياً (تاريخاً محكياً). تأثر التاريخ الذي يكتبه أساتذة الجامعات اليوم، بعمق، بالعلوم الاجتماعية والسلوكية وحتى الطبيعية، ونادراً ما يسعى إلى تفسير الإنجازات وقصص الحياة الفردية والجماعية. كثيراً ما يلجأ التاريخ الأكاديمي إلى القصص والتسجيلات والرسائل والمذكرات واليوميات التي كتبها الناس كأدلة لتفسيراته التي يقدمها. لكن سرد هذه القصص (الحقيقية) لا يضيف كثيراً لعملية التأويل.
التاريخ الذي يشغل اهتمامنا هنا، هو التاريخ الذي يفسر الماضي والحاض عبر سرد الحكايات الحقيقية بالطبع، وهو ما يجعلها تاريخية وليست محض خيال.
يعتقد الجميع تقريباً أن التاريخ من أساليب المعرفة، في بعض الأحيان يكون واحداً من بين طرائق كثيرة، وفي أحيان أخرى يكون الطريقة الأفضل، وأحياناً يكون هو الطريقة الوحيدة المؤدي إليها. وما إن يعتقد الناس أنهم يعرفون شيئاً ما، حتى يبدأوا بالتصرف وفقاً لهذه المعرفة. إذا كانوا مخطئين بشأن ما يعرفونه، قد تكون النتيجة هي الإحباط أو خيبة الأمل أو حتى أسوأ. ويختلف هذا الأسوء ابتداء من الإقدام على الإضرار بأنفسهم وصولاً لإحداث كوارث للبشرية.
يُقام الادعاء بأن السردية التاريخية لا تنفصل عن الفهم بشكل عرضي ويومي. اختر عدداً من مجلة New York Times Book Review أو من London أو New York Review of Books، أو حتى من الملحق الأدبي لمجلة التايمز، ستجد مراجعة تشيد بالتاريخ أو السير الذاتية باعتبارها وسيلة لا غنى عنها لفهم بعض المواضيع اللاتاريخية بامتياز.
هل أنت مهتم بالأمور التي صنعت ستيف جوبز وجعلته ناجحاً؟ إذن عليك بالتأكيد قراءة السيرة التي كتبها والتر إيزاكسون. أو ربما عليك أن تقرأ كتاب “أن تصبح ستيف جوبز Becoming Steve Jobs” لبرنت شليندر وريك تيتزيلي. لابد وأن حقيقة ما كان يفكر فيه جوبز في شهوره وأيامه الأخيرة تكمن في موضعٍ ما بين هاتين الروايتين لسيرة هذا الرجل الواحد.
حتى حين لا تبدو الرواية التاريخية ضرورية لفهم شيء ما، كثيراً ما يعتقد أنها الطريق الأمثل لهذا الفهم. لا شيء يلقي الضوء على هذا الاعتقاد مثل ميل كتاب العلوم لاستخدام السرد التاريخي. العلم ليس مجموعة قصص، بل نظريات وقوانين ونماذج ومكتشفات ومشاهدات وتجارب. مع ذلك تبدو الطريقة الوحيدة التي يُوصِلُ بها الكتاب العلم إلى الجمهور العام هي عبر سرد تاريخ المنجزات العلمية أو سير العلماء الذين حققوها.
فيزياء الزمان؟ إذن الكتاب المناسب لك هو كتاب ستيفن هوكينج “تاريخ مختصر للزمان A Brief History of Time”، والذي يشرح علم الفلك عبر سرد مختصر لتاريخ الفيزياء منذ أرسطوطاليس. هناك سبب وجيه يدفع الكتاب لتوصيل العلوم عبر الحكايا والقصص. ليس فقط لأن معظم الناس يفضلون القصص. بل وأيضاً لأن معظم الأشخاص العاديين من غير العلماء يجدون صعوبة شديدة تصل إلى درجة الاستحالة في تحصيل المعلومات العلمية بأي طريقة أخرى. تكمن المشكلة في أن الناس بعد قراءة هذه الكتب العلمية، يتذكرون القصص الواردة فيها وينسون العلم.
أجد من غير الملائم قليلاً في الإنكليزية (ولغات أخرى) أن يكتنف مصطلح “التاريخ” بعض الغموض: تستخدم الكلمة لوصف ما حدث في الماضي، والدراسة المختلفة تماماً لما حدث في الماضي، كلاهما. في كل حال، علينا أن نتعايش مع هذا الغموض. يبدو من الواضح أن الطريقة الوحيدة لدراسة أحداث التاريخ، الماضي، هي عبر التاريخ أي ثمرة دراسة الماضي، وأن كل ما تحتاجه لفهم الماضي هو التاريخ الصحيح له.
إذا كان التاريخ المروي يصل إلى نتائج خاطئة دائماً، لماذا يعد مهماً؟ لأن السرديات التي قدمها مجال التاريخ كانت وما زالت مضرة بالصحة والسلامة وبحياة معظم الناس الذين عاشوا هذه الأحداث التاريخية. تورطت القصص التي يرويها المؤرخون في المآسي والموت أكثر من أي جانب آخر من مجالات الثقافة الإنسانية. وكما سنرى، تتحمل طبيعة هذه القصص الأكثر إقناعاً التي يروونها مسؤولية أنهار الدموع والألم والمعاناة والمجازر وأحياناً الإبادة الجماعية، والتي تمثل أغلب التاريخ البشري.
لماذا أقول إن معظم السرديات التاريخية خطيرة ومضرة بالناس، بدلاً من القول إن بعضها أيضاً ملهم ومثير للحماس؟ هل قمت بالعد، حاسباً الأرقام ووازناً التأثيرات المؤذية لبعضها في مقابل التأثيرات الحسنة للبعض الآخر؟ هذا ليس ضرورياً. يعرف علماء الأنثروبولوجيا التطورية ما يكفي عن تطور الثقافة البشرية ليحكموا عن ثقة بأن معظم السرديات التاريخية دفعت وتستمر في دفع الناس والشعوب للأخذ من الآخرين ورفض مشاركتهم وإعطائهم. كان رهاب الأجانب والعنصرية والأبوية التي حكمت العالم قبل وقت طويل من نشوء الدول القومية، مشبعة بالكامل بالسرديات التاريخية عمن فعل ماذا لمن.
حين وصلت الدولة القومية إلى مسرح التاريخ، كانت بمثابة وسائل أكثر كفاءة لرفع أعداد قتلى هذه الروايات التاريخية. العهد القديم هو أحد أكثر هذه السرديات شهرة والتي تحث على الترابط الداخلي والعدائية نحو الخارج. وظهرت القصص والحكايا في عصر ما قبل التاريخ كممارسة مكنت البشر من الانتقال من قعر السلسلة الغذائية في غابات السافانا الأفريقية إلى القمة لآلاف القرون أو ما يقاربها. اختيرت هذه الممارسات الثقافية لفاعليتها أولاً في قتل الحيوانات الكبيرة، وثانياً قتل البشر الآخرين واستعبادهم في أسوأ الأحوال.
في المقابل، نحن مكيفون مسبقاً لنحب التاريخ. نحن نرتشف حب التاريخ مع لبن أمهاتنا. هذا الحب الذي هو أشبه بالهيرويين منه باللبن، هو إدمان التاريخ وليس مجرد ميل عرضي نحوه. حتى حين ندرك أثاره المضرة، نستمر في التوق لهذا الشعور الذي يولده.
في هذه الأثناء، هناك أشياء يجب أن نأخذها في حسباننا، هي التي تبعث فينا الشك تجاه التاريخ المروي باعتباره طريقة للفهم. أولاً عندما يتعلق الأمر بالفيزياء والجيولوجيا والعلوم الطبيعية الأخرى، لا يهتم المتخصصون في هذه المجالات بالتاريخ على الإطلاق. اقرأ كتب المراجع، والدوريات العلمية، واحضر بعض الندوات والمؤتمرات التي يعرضون فيها نتائج أعمالهم لبعضهم البعض. لا تجد فيها ذكراً لتاريخ فروعهم العلمية وكيف وصلت إلى ما هي عليه اليوم. تكتسب الحقائق والبيانات والأدلة والمشاهدات الأهمية الأكبر، وعلى رغم أن الكثير منها يتعلق بأحداث ماضية قريبة أو بعيدة، فإن كل ما تفعله هو تقديم الأدلة على نتائج علمية، ومكتشفات ونماذج ونظريات. لا يخلط العلماء أبداً بين العلم والسرديات التاريخية للعلم، ولا يخلطونها مطلقاً بالسير الذاتية للعلماء.
الأمر الثاني الذي يجب أن نفكر فيه، هو الخلاف الأزلي بين المؤرخين حول الأحداث ذاتها.
يعيد المؤرخون السرديون كتابة التاريخ دائماً وينفون ادعاءات بعضهم بعضاً السببية. وليس هناك سبب للاعتقاد بأنهم سيتوقفون عن فعل ذلك يوماً، حتى بالنسبة إلى أحداث بعيدة في الماضي كحدث سقوط الإمبراطورية الرومانية.
علمُ السير عرضة للتعديل والمراجعة مثله مثل التاريخ. هناك أسباب كثيرة تدفع المرء إلى قراءة سيرة ستيف جوبز الذي كتبها والتر أيساكسون. تعد هذه السيرة كتاباً مسلياً ومثيراً وحتى ملهماً. لكن في غضون أسابيع من نشرها، ظهر كتاب آخر ينافي فهم أيساكسون لجوبز. ستستمر مثل هذا الخلافات حتى لا يعود الجمهور مهتماً بمواضيعها أو أشخاصها.
قد تقدم التعديلية التاريخية أدلة لدعم ادعاء التاريخ المروي بأنه يقدم تفسيراً حقيقياً، لكن هذا يحدث فقط في حال تلاقت التفسيرات التاريخية كما تفعل نظيرتها العلمية.
على خلاف ذلك، لا تظهر التفسيرات المتعاقبة للمؤرخين للأحداث الزمنية ذاتها (التعديلية التاريخية) نمط الالتقاء ذاته. بل بالعكس، تختلف تفسيرات الأحداث ذاتها جذرياً، سواء أكانت ممتدة مثل حركة الإصلاح الديني أو قصيرة مثل اندلاع الحرب العالمية الأولى. بل حتى نمط تتابعها كثيراً ما يكون في دوائر تعيد نفسها قبل أن تنحرف إلى اتجاه جديد تماماً.
خذ في الاعتبار الصراع الحالي في الشرق الأوسط. كل ما نحن في حاجة إليه لفهم هذا الصراع هو ما يؤمن به المشاركون فيه ويريدونه الآن، ليس ما آمن به والديهم وأسلافهم وآبائهم وأرادوه. لكن المؤرخين الشعبيين والحس العام يخبروننا بأننا لن نتمكن من فهم دوافع الناس الآن إلا عبر التاريخ.
لكن هذا المنطق في دراسة التاريخ والسِيَر مثير للقلق، لا لشيء سوى أنه لا يخبرنا بما حدث فعلاً في الماضي، بل ما يعتقد الناس أنه قد حدث. معتقدات الناس بشأن التاريخ هي التي تحركهم وليست الأحداث التاريخية الفعلية.
لا تنافح العلوم الاجتماعية والسلوكية الحديثة قطعاً عن الفكرة القائلة بأن معتقدات الناس بشأن التاريخ، سواء كانت مصيبة أم مخطئة، ضرورية لفهم شؤونهم. خذ الاقتصاد على سبيل المثال. تكاد معظم النماذج الاقتصادية البارزة عن السلوك الإنساني تخلو من السرد التاريخي.
سير الأبطال
لدينا نحن البشر شهية نهمة تجاه القصص التي تحكي سير أبطال محددين، تروي لنا صعوبة المسعى والصعاب التي يجب التغلب عليها، ومن ثم النهاية السعيدة (أو على الأقل المرضية شعورياً). يعلم كُتّاب العلوم أنهم إذا تمكنوا من إيجاد خصائص مثل هذه في ما يكتبونه، فسيحافظون على اهتمام الناس حتى لو لم يدركوا الكثير عن العلم نفسه. في أفضل الأحوال، فإن مثل هذه السرديات التاريخية المدبَّرة التي تحكي قصص الانجازات العلمية قد تنقل بعضاً من العلم بطريقة يفهمها الجميع أكثر مما قد يُحصّلونه من الدوريات والمراجع العلمية، أو حتى من الحوارات مع العلماء أنفسهم. بالطبع هذه ليست طريقة يلجأ إليها كُتّاب العلوم لاستثارة اهتمام القراء فقط. فالعلماء حتى حائزو جائزة نوبل منهم ينساقون للرضا، واللذة والراحة، وحتى التنفيس في بعض الأحيان، الذي تمنحه لهم القصص التي تبين جاذبية التاريخ لكل الأشخاص الآخرين. بعضهم كتب كتباً تدخل في قائمة الأكثر مبيعاً مثل سيرة جيمس واتسون الذاتية “الملف المزدوج” والجميع يقرأها ومن بينهم العلماء، من أجل القصة الواردة فيها. هذا هو نمط الفهم المفضل عند الجميع.
وبرأيي، المشكلة الحقيقية التي يسببها لنا حبنا للقصة، هي أن تأويلات التاريخ المروي تصل بنا غالباً إلى نتائج خاطئة، وكثيراً ما تكون العواقب بالغة الضرر. يُجانِب التاريخ المروي الصواب في معظم الأحيان بطريقة تَمَكّن العلم من تفادي الوقوع بها. تخطئ هذه السرديات حتى عندما تحوي حقائق دقيقة لما حدث، من دون إضافة ما لم يحدث أو إغفال أشياء حاسمة قد حدثت.
لتوصيل فهم حقيقي، على التأويلات التاريخية ضبط التواريخ. ثم عليها إيجاد الروابط السببية بين الأحداث بالترتيب الزمني الصحيح. لكن ضبط هذه الأخيرة، تقريباً لا يحدث مطلقاً في التاريخ المروي أو السِيَر.
هناك شواهد على أننا لا نربط النقاط بطريقة صحيحة في كل مرة نحيي فيها ذكرى حدث تاريخي عظيم. فبعد مئة عام من اندلاع الحرب العالمية الأولى نظن أننا ندرك جيداً الأحداث التي قادت إليها. لكن لفيف الكتب التي نُشِرت بمناسبة مرور مئة عام على هذه الحرب الضروس، ما زالت تختلف في ما بينها بشكل جذري حول الرواية الصحيحة للحرب وأسبابها.
تنبش القصص التي يرويها المؤرخون الشعبيون نزعة الفضول فينا، وتلبّي حاجاتنا النفسية لمعرفة سبب حدوث شيء ما، ودائماً ما تفعل القصص ذلك حتى عندما تكون خاطئة تماماً، طالما لا نعرف أنها خاطئة.
يبدو الرأي القائل بأن كل تأويل يقدمه التاريخ المروي خاطئ بالضرورة، مُغرِضاً في تطرفه إلى درجة تمنع أي أحد من أخذه على محمل الجد. بالفعل، متطرف إلى درجة تُغري القراء الجادين، وخصوصاً محبي التاريخ، لمعاملة الفكرة بمجموعها باعتبارها هزلاً غير معقول. وبطريقة ما، فهم مُحقون؛ فنحن لا نستطيع زعزعة ارتباطنا بالرواية التاريخية. لكن ما يخبرنا به علم النفس السلوكي والأنثروبولوجيا التطورية وعلم الأعصاب، حول سبب حبنا للقصص إلى هذه الدرجة، كافٍ ليدفعنا لبناء إدراك جديد عن السبب الذي يجب لأجله أن نتخلى عن هذه القصص باعتبارها مصدراً للمعرفة.
هذا الموضوع مترجم عن موقع salon.com ولقراءة الموضوع الأصلي زوروا الرابط التالي.
https://www.salon.com/2018/10/07/why-most-narrative-history-is-wrong/
درج




