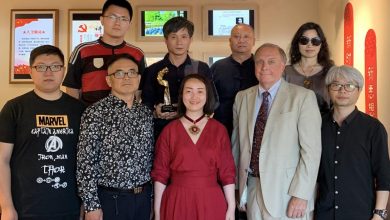نورج للريح/ أمجد ناصر

دسكرة
دسكرته ليست معروفةًً بالرّمان ولا بشيءٍ آخرَ سوى انها نورجٌ للقيظ والغبار ولكن عابثاً إلهُ الرّيح والمطر فَرَكَ كعبه هناك فطلعت شجرةُ رمانٍ كُتِبَ على حبَّاتها ألاَّ تكبر أو تصغر
قطف لي منها حَبَّةً قبل أن يصعد السلّم الحجريَّ درجتين درجتين إلى القصر المهجور، لم يعلم أنني أنا سليلة إله الزراعة ذات الزندين المتموجين بحرائق الحصاد علَّقتُ رمانته الشقراء تذكاراً من اليد التي تلمَّست صدري العاري على الجدار جاهلةً بما ستنفخُ فيه من صورها الأحلام.
طوحنا يا هوى
مِنْ بين كلِّ الوجوه التي أحببتَها أو كرهتَها، يطلُّ وجهُه كلما سمعتَ هذه الأغنية. تحاولُ أحياناً تَذَكّرَ اسم التي لها غمازتان وذيل فرسٍ فتفشلُ، وتحاول تَذَكُّر وجهَ الولدِ البدويِّ الذي سكب تنكة كازٍ على ثيابه وأشعل النار بنفسه لأنهم لم يزوجوه حبيبة قلبه فتفشل، وتحاول تذكّر يديّ والدك يقرصُ بواحدةٍ أذنك ويكتمُ بالثانية صوت المغني المصريّ في راديو ذي هيكلٍ عظميٍّ كبيرٍ فتفشل. وحده وجه ذلك المهلهل خلقةً وثياباً، يطلُّ عليك في لقطةٍ ثابتةٍ، عندما سمعتما هذه الأغنية من راديو ترانزستور يتخطرُ به شابٌ يلمعُ شَعره بـ “البرل كريم” في بلدةٍ تعلِّق الغبار على مشاجب العمالقة.
المغني المصريُّ الذي كنتما تتطوحان مع أغانيه متخيلين حبيباتٍ بالبكيني على شواطىء الاسكندرية مات بالبلهارسيا، صاحبك المهلل خلقةً وثياباً سقط من سقالةٍ مضحكةٍ في الصحراء ومات، وأنت هجرتَ بيتَ العائلة باكراً، لتثني على الحديد الثقيل في مصانعَ للصُلب لم ترها، وظلت الأغنيةُ تتقافزُ بأربع أقدامٍ حافيةٍ على لظى سكةِ حديدٍ هجرتها القطارات:
طوحنا
يا هوى
طوحنا..
رفيق الطفولة
يراك مرةً كلَّ خمسِ، ستِ سنين، أنت الذي ما إن يعود إلى البيت الأول حتى يحزم حقائبه من جديد. تكون تروسُ الأيام ومُسَنَّناتُها (التي لا تصدأُ أبداً) قد طحنتْ عظاماً، هرستْ لحماً، تجشأتْ أحلاماً حامضةً في وجه أعتى المتفائلين. حروبٌ اندلعت وخبت، بلادٌ تفتَّتْ، بورصاتٌ وعملاتٌ صعبةٌ طلعت ونزلت، وتكون قد أحببتَ كذا مرة واكتشفتَ أنه لم يكن حبَّاً بل رغبةً بنت كلب تعرف طريقها جيداً في أكثر ممرات نفسك وعورةً، ويكون الشيبُ قد اشتد عزمه لزحزحتك عن العشرينات التي تتشبثُ بها على نحو أخرق، وهو كما هو بضحكته البلهاء الطيبة وريالته التي تسيل ما إن ينطق جملتين وراء بعضهما بعضاً، يبادرك كأن شيئاً لم يحصل، زمناً لم يمرّ، بنفس الكليشيه التي لا بد أنه التقطها من فيلمٍ هنديٍّ أو مصريٍّ أيام الفرار من المدرسة: يا رفيق الطفولة المعذبة! ويذكرك بحادثةٍ واحدةٍ لا تتذكرها البتة ولا تعلم مدى صحتها، ولكنها نابضةٌ في ذهنه كسمكةٍ انتشلت من الماء تواً، أمرته فيها (بصفتك زعيم شارع لا يعرفُ الرحمة!) بقطع أذن قطٍ سائبٍ كطلب انتسابٍ عاجلٍ لمملكة الأقوياء التي كنتَ (في رأيه) متوَّجاً على عرشها الشرير. المدهش في الأمر أنه، حسب روايته، قد فعل ذلك.
كان رفيق طفولتك فعلاً، الحافية حرفياً، لكن ليس المعذبة، إلاَّ إذا اعتبرت ألف صفعة من يد أبيك الكبيرة، ألف ركلة من بسطاره العسكري كذلك. انتهت، فجأة، طفولتكما، ككومبارس في عرضٍ مسرحيٍّ مرتجلٍ لتجدا أمامكما أدواراً لم تُحسنا أداءها: هو صار جندياً لم يطلق رصاصةً واحدةً، وأنت رحتَ تطلقُ رصاصاً فارغاً ( كما بدا لاحقاً) على معاقل العالم القديم وترقصُ مع الكلمات في ظلمةٍ دامسة.
لا يكفي الظنُ أن للموت عملاً أكثر تعقيداً من اصطياد ضحكة طيبة كي يبقى “رفيق الطفولة المعذبة” يروي بعدك، بلا زيادة أو نقصان، حادثة القط السائب مقطوع الأذن، فقد تركها لك لترويها وربما لتصدقها أيضاً. فالذين ماتوا، حتى الآن، وكنتَ مقتنعاً أن دورك قبلهم يتكدسون في رأسك حتى إنك صرت تتخلص منهم بمادةٍ أقوى من النسيان.
ضفة ثالثة