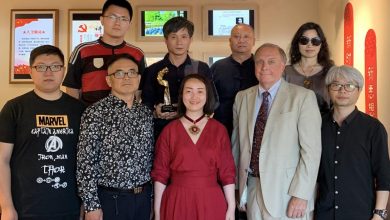مساحاتٌ بيضاء/ بول أوستر

ترجمة محمد عيد إبراهيم
بعدما كتب الروائي الأميركي بول أوستر (1947) أربعة دواوين شعرية لافتة، وجد نفسه في الرواية، وما هي إلا سنوات حتى صار ممن يُعدّ على الأصابع ضمن الروائيين الأميركيين. يكتب أوستر بنمط من الواقعية الوحشية: وضوح في التفاصيل، أناقة أسلوبية، عناصر رمزية أسلوبية مع سوريالية ذات اهتمامات معرفية وميتافيزيقية، حساسية ما بعد حداثية، مصادفات سينمائية واختراعات مخيالية. من دواوينه: «اختفاءات»، «عملٌ أرضيّ»، و«القصائد الكاملة». كما نشر ترجمات للشاعر الفرنسي مالارميه، والفيلسوف الفرنسيّ سارتر. ومن كتبه النقدية والسيرة: «اختراع العزلة»، «فنّ الجوع»، «الدفتر الأحمر»، «من اليد للفم». حين ننظر إلى شِعر هذا الروائيّ الذي أدار دفّة إبداعه كلياً للرواية، لا نجد غضاضة في تحرّي مفاصل هذا الشِعر. فالقصائد التي يضمها ديوانه «قصائد مختارة» غنائية، متوترة، مفعمة بموسيقى قوية حاذقة بالغة الرهافة. يعمل أوستر في قصائده تحت هيمنة عناصر واعية، حيث يدفع اللغة إلى حافة الانهيار، مما يجعله يضع المنطوق بثوب الحقيقيّ المتغير، كاشفاً عن صوتٍ شعريّ يُخلص دائماً لنبضات رؤاه وأماني أحلامه الواعدة. لكن عالم بول أوستر الشعريّ، والروائيّ من بعده، يتميّز بالبحث في التفاصيل: المصادفة، الوصف المتكرّر لحياة متقشّفة، الإحساس بكارثة وشيكة، السارد المحوريّ لشخوصه، فقدان قدرة الفهم، فقدان قدرة اللغة، وصف الحياة اليومية، الفشل، غياب الأب، التناصّ، التاريخ الأميركيّ. النصّ أدناه من ديوانه: «قصائد مختارة» (لندن ــ 1998)
شيءٌ يحدثُ، ومن لحظةِ أن يبدأ يحدثُ، لا يعودُ شيءٌ كما كانَ من قبل ثانيةً.
شيءٌ يحدثُ. أو آخر، شيءٌ لا يحدثُ. جسمُ يسعى. أو آخر، إنهُ لا يسعى. وإن راحَ يسعى، فثمةَ شيءٌ يبدأ يحدثُ. وحتى إن لم يسع، فثمةَ شيءٌ يبدأ يحدثُ.
يأتي هذا من صوتي. لكنهُ لا يقصدُ أن هذه الكلماتِ قد تكونُ هي ما يحدثُ. فهي تأتي وتروحُ. ولو حدثَ وتكلّمتُ في هذه اللحظةِ، فذلكَ فقط لأني آملُ أن أجدَ طريقةً لأن أذهبَ، أركضَ متوازياً مع كلّ شيءٍ آخرَ يذهب معي، وهكذا أبدأ أجدُ وسيلةً لملء هذا الصمتِ من دونِ أن أحطّمَه.
أسألُ أياً كانَ مَن ينصتُ إلى هذا الصوتِ أن ينسى الكلماتِ التي قيلَت. ومِن المهمّ أنه لا أحدَ ينصتُ بعنايةٍ. أريدُ لهذه الكلماتِ أن تتلاشَى، حتى أتكلّمَ، في الصمتِ الذي جاؤوا منهُ، ولقاءَ لا شيءَ قد يبقى غيرَ ذكرى حضورهم، رمزاً لحقيقةِ أنهم كانوا هنا يوماً ولم يعودوا هنا من بعد وأنهُ أثناءَ حياتهم القصيرةِ لا يبدو أنهم قالوا شيئاً على وجهٍ خاصّ قد يكونُ هو الشيء الذي حدثَ في الوقتِ نفسهِ بينما كان جسمٌ معيّنٌ يسعى في مكانٍ معيّنٍ، كانوا يسعون فيهِ معَ كلّ شيءٍ آخرَ كانَ يسعى.
شيءٌ يبدأ، ولم تعد فعلياً هي البدايةَ، بل شيءٌ آخرُ، يدفعنا في قلبِ الشيءِ الذي يحدثُ. وإن كانَ علينا أن نقفَ بغتةً لنسألَ أنفسنا «إلى أينَ نذهب؟»، أو «أينَ نحنُ الآنَ؟»، فربما ضِعنا، لأن كلّ لحظةٍ نحنُ فيها لم نعد نعرفُ أينَ، لكننا نشعرُ بأنفسنا وراءنا، بما لا رجعةَ فيهِ، في ماضٍ لا ذكرى لهُ، ماضٍ تمحوهُ بلا نهايةٍ حركةٌ تحملنا إلى الحاضرِ.
لن يُجدي، إذن، أن نسألَ أسئلةً. فهذا مشهدُ نبضٍ عشوائيٍّ، بمعرفةٍ لصالحها ــــــ كأننا نقولُ، هي معرفةُ أن توجَد، تأتي للوجودِ ما وراءَ أيّ احتمالٍ لصَوغها في كلماتٍ. ولو حدثَ مرةً أن خلّينا أنفسنا إلى لا مبالاةٍ ساميةٍ من وجودٍ بسيطٍ حيثما يحدثُ أن نكونَ، لربما عندئذٍ لن نخدعَ أنفسنا بالتفكيرِ في أننا، أيضاً، قد نصبحُ أخيراً جزءاً مما يصيرُ على الكلّ.
نفكّر في الحركةِ لا كوظيفةٍ فحسب للجسمِ بل امتدادٌ للعقلِ. وبالطريقةِ ذاتها، نفكّرَ في الكلامِ لا كامتدادٍ للعقلِ بل كوظيفةٍ للجسمِ. تنبعثُ الأصواتُ من الصوتِ حينَ يدخلُ الهواءُ يحيطنا طافراً ثم يدخلُ الجسمَ الذي يحتلّ ذاكَ الهواءَ، ومع أن الأصواتِ لا تُرى، إلا أنها ليسَت أقلّ من إيماءة يدٍ حين نمدّها في الهواءِ نحو يدٍ أخرى، وبهذه الإيماءةِ قد نقرأُ ألفباءَ الرغبةِ كلّها، حاجةُ الجسمِ أن يؤخَذ فيما وراء نفسهِ، حتى إن استوطن كوناً من حركتهِ الخاصة.
على السطحِ، تبدو هذه الحركةُ عشوائيةً. لكن هذه العشوائيةَ، في حدّ ذاتها، لا تستبعدُ معنى. وإن كان معنى فهو ليسَ بالضبطِ الكلمةَ الموافقةَ، إذن قُل المغزَى، أو الحسّ المثابرَ بما يحدثُ، حتى إن تغيّرَ، لحظةً بعدَ لحظةٍ. وأن نصفَ ذلكَ تفصيلاً فربما ليسَ مستحيلاً. لكننا سنحتاجُ إلى كلماتٍ كثيرةٍ، إلى أنهارٍ كثيرةٍ من المقاطعِ، الجُملِ، والفقراتِ التابعة، لأن الكلماتِ دائماً تتخلّفُ عما قد حدثَ، وبعدَ وقتٍ طويلٍ من كلّ حركةٍ توقفَت وكلّ شهودها قد تبعثروا، يصفُ الصوتُ الحركةَ وهي لا تزالُ تتكلّمُ، وحدَها، لا يسمعها أحدٌ، بعمقِ الصمتِ والعتمةِ من خلفِ حيطانٍ أربعة. وإن حدثَ شيءٌ، ومع أني بنفسي أريدُ أن أكونَ حاضراً داخلَ مكانِ هذه اللحظةِ، بل هذه اللحظاتِ، وأن أقولَ شيئاً، معَ أنه قد يُنسى، لكنهُ سيشكّلُ جزءاً سيصمدُ من هذه الرحلةِ لفترةٍ طويلةٍ من الزمنِ.
في عالمِ العينِ المجرّدةِ، لا شيءَ يحدثُ لن تكونَ له بدايةٌ ونهاية. معَ أنهُ لا مكانَ قد نجدُ فيهِ المكانَ أو اللحظةَ التي نقولُ فيها، ما وراءَ ظلٍّ من الشكّ، هنالك حيث يبدأ، أو حيث ينتهي. لأن بعضاً منا، قد بدأ قبلَ البدايةِ، وآخرين منا سيواصلون ما يحدثُ بعدَ النهايةِ. أين نجدها؟ لا تنظر. إما أنها هنا أو ليسَت هنا. ومن يجرّبُ أن يجدَ ملاذاً بأيّ مكانٍ، وفي أيّ لحظةٍ، فلن يكونَ حيث يظنّ أن يكونَ. وبمعنى آخر، قُل وداعاتِكَ. فالوقتُ لا يتأخّرُ أبداً. وهو يتأخّرُ دائماً.
فلنقل إن أبسطَ شيءٍ ممكنٌ. لكيلا نمضي أبعدَ مما كانَ يحدثُ وأجده أمامي. لكي نبدأ بهذا المشهد، مثلاً. أو حتى لنلحظَ الأشياءَ الأقربَ غالباً، كما هو في العالمِ الصغيرِ أمامَ عينَيّ، فقد أجدُ صورةً للحياةِ التي توجَد ورائي، كما بوسيلةٍ لا أفهمُ منها تماماً أن كلّ شيءٍ في حياتي كان متّصلاً بكلّ شيءٍ آخرَ، وهو بدورهِ يوصلُني بالعالمِ على اتّساعهِ، العالمِ اللامتناهي الذي يرتسمُ في العقلِ، كشيءٍ مميتٍ ومجهولٍ كالرغبةِ ذاتها.
فلنضع الأمرَ بوسيلةٍ أخرى. فمن الضروريّ أحياناً أن لا نُسمّي الشيءَ الذي نتكلّمُ عنه. فالربّ غيرُ المنظورِ عندَ العبرانيين، مثلاً، لهُ اسمٌ غيرُ منطوقٍ، وكلّ اسمٍ من ناموسِ التسعِ والتسعين يُعزَى إلى هذا الربّ لم يكن في الحقيقةِ أكثرَ من وسيلةٍ لمعرفةٍ لا يمكن النطقُ بها، فهو لا يمكنُ رؤيته، وبالتالي فلا يمكنُ إدراكهُ. وحتى إن كانَ على منبَسطٍ أقلّ سمواً، في عالم المرئيّ نفسهِ، فنحنُ غالباً ما نُكبَح عن إفشاءِ سرّ الشيء الذي نتكلّمُ عنه. فلننظر إلى كلمة it. نقول «إنها» تمطرُ، وأنّى لــــ «it» أن تذهبَ؟ نحسّ أننا نعرفُ ما نقولهُ، وما نقصدُ أن نقولَه هو أن «it»، كلمة «it»، تشيرُ إلى شيءٍ لسنا في حاجةٍ لأن نقوله، أو شيءٍ لا يمكنُ أن يُقال. وإن كانَ الشيءُ الذي نقولهُ يروغُ منا، فثمةَ شيءٌ لا ندركهُ، كيفَ نلحّ في قولِ إننا ندركُ ما نقولُ؟ وإن كان يمضي دون أن نقولَ إننا ندركهُ. كلمةُ «it»، مثلاً، في الجملةِ السابقةِ، «يمضي دون أن نقول»، هي في الحقيقةِ لا شيءَ عدا أنها تدفعنا إلى فعلِ الحديثِ نفسهِ. وإن كانَ، فكلمةُ «it»، هي ما يتواترُ دائماً في أيّ جهدٍ لتعريفها، فهي مقبولةٌ كالعطيةِ، كشرطٍ مسبقٍ لما نقولُ. قيلَ، مثلاً، إن الكلماتِ تدحضُ الشيءَ الذي يحاولون قولَه، لكن حتى أن نقولَ «تدحضُ» فمعناهُ أن نعترفَ بأن «تدحضَ» صحيحة، أي أنها تخونُ الحقيقةَ الضمنيةَ في قوةِ كلماتٍ تقولُ ماذا يُقصَدُ أن يُقالَ. معَ ذلك، حينَ نتحدّثُ، فنحنُ غالباً لا نقصدُ أن نقولَ أيّ شيءٍ، كما في الحالةِ الحاليةِ، التي أجدُ فيها هذه الكلماتِ تتساقطُ من فمي لتتلاشَى في الصمتِ الذي جاءت منهُ. بمعنى آخرَ، إنها تقولُ نفسَها، وأفمامنا هي فحسبُ مجردُ آلاتٍ لما نقولُ. كيفَ يحدثُ هذا؟ لكننا لا نسألُ عما يمكن أن تُحدثهُ «it». نعرفُ، حتى لو لم نصغها في كلماتٍ. ويبقى الشعورُ داخلنا، أننا نقدّرُ معرفةً مفعمةً بالتناغمِ مع العالمِ، وليسَت في حاجةٍ أياً كانت لأن تسقطَ من أفمامنا. تعرفُ قلوبنا ما فيها، حتى لو ظلّت أفمامنا صامتةً. وسيعرفُ العالمُ كنهَها، حتى لو لم يبق شيءٌ في قلوبنا.
يشرعُ رجلٌ في رحلةٍ إلى مكانٍ لم يزرهُ من قبلُ. يعودُ رجلٌ آخرُ. يأتي رجلٌ إلى مكانٍ لا اسمَ لهُ، لا معالمَ لتخبرَه أين هو. يقرّرُ رجلٌ آخرُ أن يعودَ. رجلٌ يكتبُ رسائلَ من لا مكانٍ، من مساحةٍ بيضاءَ قد افتتحَها في عقلهِ. الرسائلُ لم يتسلمها أحدٌ. الرسائلُ لم تُرسَل قطّ. يشرعُ رجلٌ آخرُ في رحلةٍ بحثاً عن الرجلِ الأول. يصبحُ هذا الرجلُ الثاني أكثرَ وأكثرَ شبهاً بالرجلِ الأول، حتى أنهُ، أيضاً، يبتلعهُ البياضُ. يشرعُ رجلٌ ثالثٌ في رحلةٍ من غيرِ أملٍ في أن يصلَ إلى أيّ مكانٍ. فهو يجولُ. يواصلُ التجوالَ. طالما أنه يبقى في عالمِ العينِ المجردةِ، يواصلُ التجوالَ.
ألبثُ في الحجرةِ التي أكتبُ فيها هذا. أضعُ قدماً أمامَ الأخرى. أضعُ كلمةً أمامَ الأخرى، وفي كلّ خطوةٍ أتّخذُها أضيفُ كلمةً أخرى، كأن كلّ كلمةٍ كي تُقالَ فثمةَ مساحةٌ أخرى عليّ أن أعبرها، مسافةٌ عليّ أن أملأها بجسمي وهو يسعى عبرَ هذه المساحة. إنها رحلةٌ عبرَ مساحةٍ، حتى إن لم أجد أيّ مكانٍ، حتى لو انتهيتُ إلى المكانِ نفسهِ الذي بدأتُ منهُ. هي رحلةٌ عبرَ مساحةٍ، كأنها إلى مدنٍ عدّة، وللخروجِ منها، كأنها عبرَ فلواتٍ، كأنها إلى حافةِ بحرٍ تخَيليّ، حيث تغرقُ كلّ فكرةٍ في أمواجٍ صارمةٍ من الحقيقيّ.
أضعُ قدماً أمامَ الأخرى، ثم أضعُ القدمَ الأخرى أمامَ الأولى، حيث تصبحُ الأخرى من جديدٍ هي الأولى. أسيرُ في غضونِ هذه الحوائطِ الأربعِ، وطالما كنتُ هنا فبإمكاني أن أمضي لأيّ مكانٍ أحبّ. قد أذهبُ من طرفٍ بالحجرةِ إلى الآخر وألمسُ أياً من الحوائطِ الأربعِ، أو حتى الحوائطَ أجمعَها، واحداً إثرَ آخرَ، كما أحبّ بالضبطِ. وإن حرّكتني الروحُ، فقد أقفُ بمنتصفِ الحجرةِ. إن حرّكتني الروحُ في متّجهٍ آخرَ، لاستطعتُ أن أقفَ في أيٍّ من الزوايا الأربعِ. ألمسُ أحياناً إحدى هذه الزوايا الأربعِ وبهذه الطريقةِ أستجلبُ نفسي إلى اتّصالٍ مع حائطَين في الوقتِ نفسهِ. بينَ حينٍ وآخر أدعُ عينَيّ تطوفان إلى السَقفِ، وحينما أُستنفَد على نحوٍ خاصّ من جهودي هناك، فثمةَ أرضيةٌ دائماً لترحّبَ بجسمي. النورُ، يتقاطرُ عبرَ النوافذ، لا يوزّعُ الظلّ نفسَه أبداً مرتين، وفي أيّ لحظةٍ معطاةٍ أشعرُ بنفسي على شفا ما أكتشفهُ من حقيقةٍ مفزعةٍ لا يمكن تصوّرها. وهي لحظاتٌ تمثّلُ عندي سعادةً قصوى.
في مكانٍ ما، كأنهُ غيرُ مرئيٍّ، وأقربُ إلينا مما ندركهُ (عبرَ الشارعِ، مثلاً، أو في حيٍّ مجاورٍ)، فثمةَ شخصٌ يولَد. في مكانٍ آخرَ، تسرعُ سيارةٌ على طولِ طريقٍ دائريٍّ شاغرٍ بمنتصفِ الليلِ. في تلكَ الليلةِ ذاتها، رجلٌ يدقّ مِسماراً في طاولةٍ. لا نعرفُ شيئاً عن أيٍّ من هذا. تشطَأ بذرةٌ غيرُ مرئيةٍ في الأرضِ، ولا نعرفُ شيئاً عنها. أزهارٌ تذوي، بناياتٌ تصعدُ، أطفالٌ تبكي. ومن هذا كلهِ، لا نعرفُ شيئاً.
هذا يحدث، وبينما يواصلُ حدوثَه، ننسى أينَ كنا حين بدأنا. وفيما بعدُ، حينَ نسافرُ من هذه اللحظةِ أبعدَ مما سافرنا من البدايةِ، سننسى أينَ نحن الآنَ. وأخيراً، سنرجعُ كلّنا للبيتِ، وإن كانَ هناكَ بيننا مَن لا بيتَ لديهِ، فمن المؤكّدِ، على رغمِ ذلك، أنهم سيتركون هذا المكانَ إلى أيّ مكانٍ عليهم أن يذهبوا إليهِ. وإن لم يكن شيءٌ آخرُ، فالحياةُ قد علّمتنا بهذا شيئاً واحداً: أياً كانَ مَن هنا الآنَ فلن يكونَ هنا في ما بعدُ.
أكرّسُ هذه الكلماتِ لأشياءٍ في حياةٍ لا أفهمها، لكلّ شيءٍ عابرٍ بعيداً أمامَ عينَيّ. أكرّسُ هذه الكلماتِ لاستحالةِ أن أجدَ كلمةً توازي الصمتَ في داخلي.
في البدايةِ، أردتُ أن أتحدّثَ عن الأذرعِ والسيقانِ، عن القفزِ والهبوطِ، عن أجسامٍ تتعثرُ وتدورُ، عن رحلاتٍ مهولةٍ عبر المكانِ، عن مدنٍ، عن فلواتٍ، عن سلاسلَ جبليةٍ تمتدّ أبعدَ مما تراهُ العين. ورويداً رويداً، على أيّ حالٍ، كما بدأت هذه الكلماتُ تفرضُ نفسَها عليّ، بدَت الأشياءُ التي أريدُ أخيراً غيرَ ذاتِ أهميةٍ. فهجرتُ، مُكرَهاً، قَصصي الرائعةَ إجمالاً، مغامراتي كلّها عن أماكنَ متباعدةٍ، وبدأتُ، ببطءٍ، وبألمٍ، أستفرغُ بالي. الفراغُ الآنَ هو كلّ ما يتبقّى: مكانٌ، لا يهمّ إن كانَ صغيراً، لأنهُ مهما حدثَ فهو المسموحُ لهُ بأن يحدثَ.
ولا يهمّ إن كانَ صغيراً، فكلّ احتمالٍ يلبثُ. حتى الحركةُ تتقلّصُ إلى غيابٍ ظاهرٍ للحركةِ. فالحركةُ، مثلاً، منَمنَمةٌ كالتنفّسِ ذاتهِ، كالحركةِ التي يُحدثها الجسمُ عندَ الشهيقِ والزفيرِ. في كتابٍ قرأتهُ يوماً، للمستكشفِ القُطبيّ الشهيرِ، بيتر فروتشين (1)، يصفُ كيفَ احتجزتهُ عاصفةٌ ثلجيةٌ شماليّ جرين لاند. وكانَ وحدَهُ، تناقصَت مؤنهُ، فصمّمَ أن يبني كوخاً مقَبّباً حتى تغورَ العاصفةُ. ومرت أيامٌ عدة. كانَ خائفاً، فوقَ هذا كلهِ، أن تهاجمَه الذئابُ ـــــــ فقد سمعَها تجوسُ على سطحِ كوخهِ ــــــ وعليهِ أن يخطو خارجاً على نحوٍ دَوريّ وهو يغنّي بملء رئتَيهِ ليخيفَها كي تبتعدَ. لكن الريحَ كانت تهبّ بعنفٍ بالغٍ، ومهما كان غناؤهُ عصياً، إلا أنه لم يكن يسمعُ غيرَ الريحِ. وإن كانت هذه مشكلةً خطيرةً، عموماً، إلا أن مشكلةَ كوخهِ نفسه كانت أفدحَ. فقد بدأ فروتشين يلاحظُ أن حوائطَ مأواهُ الصغيرِ راحَت تنغلقُ
عليهِ تدريجياً. بسببِ الأحوال الطقسيةَ بالخارجِ على نحوٍ خاصّ، كان تنفّسهُ يتجمّدُ حرفياً على الحوائطِ، ومعَ كلّ نفَسٍ تصبحُ الحوائطُ كثيفةً أكثرَ، وصار الكوخُ أصغرَ كثيراً، حتى لم يعد ثمةَ فراغٌ تقريباً لجسمهِ. وهو شيءٌ مرعبٌ بالتأكيدِ، أن تتصوّرَ أنفاسكَ وهي تُحيلكَ كَفناً من ثلجٍ، وخطرَ ببالي أنها تُخضعه أكثرَ وأكثرَ، لنقُل، إنها مثلَ قصةِ بو (2) «الحفرةُ وبندولُ الساعة». في هذه الحالةِ فالرجلُ نفسهُ هو مُعامِلُ هلاكهِ، بل أبعدُ، فأداةُ هذا الهلاكِ أقربُ شيءٍ هو في حاجةٍ إليهِ ليحفظَ نفسَه حياً. فالإنسانُ قطعاً لا يستطيعُ الحياةَ إن لم يتنفّس. لكنه في الوقتِ نفسهِ، لن يعيشَ إن تنفّسَ. ومن فضولي الشديدِ، لا أتذكّرُ كيفَ توصّلَ فروتشين أن ينجو من وَرطتهِ. لكن لا حاجةَ بنا للقولِ: إنه نجا. وعنوان الكتاب، كما أتذكّرُ، كانَ «مغامرةٌ قُطبية». وقد نفدَت طبعتهُ من سنواتٍ عدة.
لا شيءَ يحدثُ. مع ذلكَ، فهو ليس لا شيءَ. كي ننشُدَ الأشياءَ التي لم تحدُث، أمرٌ نبيلٌ، لكن كَم هو فاتنٌ أن نلبثَ في عالمِ العينِ المجردةِ.
علينا أن نستنجَ هذا: أن كلّ شيءٍ محسوبٌ، أن كلّ شيءٍ هو جزءٌ من كلّ شيءٍ، حتى الأشياءُ التي لا أدركُ أو لا أستطيعُ أن أدركَ. كالرغبةِ، مثلاً، في تدميرِ كلّ ما كتبتهُ حتى الآنَ. ليسَ من أيّ نفورٍ لعدمِ مواءمةِ هذه الكلماتِ (مع أنها تبقَى احتمالاً بارزاً)، بل بالحَرِيّ من حاجتي لتذكيرِ نفسي، في كلّ لحظةٍ، أن الأشياء لا يجبُ أن تحدثَ بهذه الطريقةِ، أنه ثمةَ دائماً طريقةٌ أخرى، سواءً أفضلُ أو أسوأ، في ما قد تتشكّلُ به الأشياءُ. أدركُ في النهايةِ أني قد صرتُ خائرَ القوى في التأثيرِ على الناتجِ حتى بأدنى شيءٍ يحدثُ، لكن، مع ذلك، وعلى الرغمِ من نفسي، فهو فعلٌ من حقيقةٍ عمياءَ، كما أريدُ أن أفترضَ بمسؤوليةٍ كاملةٍ. وتتولّدُ عندي هذه الرغبةُ، هذه الحاجةُ الغامرةُ، أن آخذَ هذه الأوراقَ وأبعثرَها عبر الحجرةِ. أو أمرٌ آخر، أن أواصلَ. أو أمرٌ آخر، أن أبدأ من جديدٍ. أو أمرٌ آخر، أن أواصلَ، كأن كلّ لحظةٍ كانت البدايةَ، كأن كلّ كلمةٍ كانت بدايةَ صمتٍ آخرَ، وكلّ كلمةٍ أخرى كانت أكثر صمتاً من الأخيرةِ.
حفنةُ قصاصاتٍ من ورقٍ. السيجارةُ الأخيرةُ قبلَ أن آوي للفِراشِ. الثلجُ يهمي بلا انقطاعٍ في هذا الليلِ الشتويّ. عليّ أن ألبثَ في عالمِ العينِ المجردةِ، سعيداً كما أنا الآنَ في هذه اللحظةِ. وإن كانَ ثمةَ الكثيرُ لأسأله، فهو يستحقّ ذكراهُ، كوسيلةٍ للعودةِ إليهِ في عتمةِ هذا الليلِ الذي سيغمُرني قطعاً من جديدٍ. فلن أكونَ بأيّ مكانٍ سِوى هنا. ولسوف تستمرّ الرحلةُ المهولةُ عبرَ المكانِ. بأيّ مكانٍ، كأن أيّ مكانٍ كانَ هنا. والثلجُ يهمي بلا انقطاعٍ في هذا الليلِ الشتويّ.
1- فروتشين: (1886/ 1957)، رحالة دانمركيّ وكاتب سيرة، لاستكشاف القطبين. (م)
2- ألن بو: (1809/ 1849)، كاتب وشاعر وقاص، يتميز فنه بالغموض والألغاز. (م)
ملحق كلمات