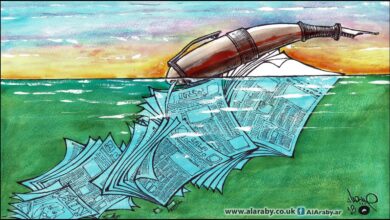لماذا لا يمكننا الحديث عن حقيقة الشيخوخة؟

بالطبع لديك فرصة لأن تصبح أكثر سعادة في الثمانين عما كنت عليه في العشرين أو الأربعين، لكنك سوف تشعر أنك أسوأ حالاً!
في قديم الأيام، حين كان معظم الناس لا يتمتعون بطول العمر، كان هناك قليل من الأعمال الأدبية المرموقة حول الشيخوخة، وقد كتب هذه الأعمال كُتّاب لم يصلوا إلى مرحلة الشيخوخة. إذ كان سن تشوسر حوالي خمسين عاماً عندما ألّف “قصة التاجر” The Merchant’s Tale، وكان سن ويليام شكسبير ما بين 41 إلى 42 عاماً عندما كتب مسرحيته الشهيرة “الملك لير” King Lear، أما الكاتب جوناثان سويفت فقد كان سنه حوالي 55 عاماً عندما تحدث في كتابه “رحلات غوليفر” Gulliver’s Travels عن مجموعة من البشر الخالدين الذين أصابهم الإعياء، وقد أطلق عليهم اسم’سترالدبرجز‘، وكان سن الشاعر ألفريد تينيسون 24 عاماً عندما بدأ في كتابة قصيدته “تيثونوس” وحين تغنَّى بشيخوخة ’قلب عطش‘ في قصيدته “عوليس”.
قد يعتقد البعض أن سن الأربعين لم يكن سناً صغيراً في زمن شكسبير؛ ولكن وقتها إذا كنت قد نجوت من مخاطر الولادة والعدوى والحروب والأوبئة فلدَيك فرصة جيدة في الوصول إلى سن متقدم أيّاً كان موعد ميلادك. كان متوسط العمر وقتها رقماً متواضعاً بالتأكيد وظل على هذه الحال لمدد طويلة من التاريخ (بالنسبة للأمريكيين الذين ولدوا سنة 1900، لم يكن متوسط العمر قد وصل حتى إلى الخمسين)، وقد يكون هذا أحد أسباب أن أحداً لم يؤلّف كتباً عن الشيخوخة؛ إذ لم يكن هناك الكثير من كبار السن للكتابة عنهم واتخاذهم نموذجاً تدور الأحداث حوله. ولكن الآن بوجود عدد من الناس فوق سن 65 عاماً يفوق عدد الأطفال تحت سن الخامسة، أصبح القرّاء يهتمون بمعرفة ما ينتظرهم في سن الشيخوخة.
من خلال قراءة عدد كبير من الكتب الحديثة حول الشيخوخة، قد ينسى المرء أن الشيخوخةَ قبل نصف قرن كانت -على حد قول فيكتور بريتشيت في مقدمته لرواية موريل سبارك “تذكّر أنك ستموت” Memento Mori، وهي المقدمة التي كتبها عام 1964- “موضوعٌ مهمّ ظل المجتمع المعاصر لا يتحدّث عنه أو يتمعّن فيه، وحتى لا يلقى له بالاً”. أما اليوم فلا يقتصر الأمر على كوننا نواجهه، بل إننا صرنا أيضاً نضعه في بؤرة الاهتمام؛ فمن الواضح أن سنوات الشيخوخة فرصة للاحتفاء بأنفسنا وبروعةِ ما ينتظرنا من أسفار وأعمال تطوعية وراحة واكتساب مهارات جديدة وغير ذلك. ولذا لا يبدو أن أحداً يرغب في الاستخفاف بنقاش قضايا الشيخوخة. حاولت نورا إفرون مناقشته في كتابها I Feel Bad About My Neck لكنها تحدثت ببراعة عن الكآبة ودون أن تتطرق إلى حقيقة القلق في هذا السن. وعلى العكس من ذلك، نجد عدداً من الأعمال المتفائلة؛ مثل كتاب ماري بيفر Women Rowing North: Navigating Life’s Currents and Flourishing as We Age، وكتاب مارك أغرونين The End of Old Age: Living a Longer, More Purposeful Life، وكتاب ألان كاسل Better with Age: The Psychology of Successful Aging، وكتاب أشتون أبل-وايت This Chair Rocks: A Manifesto Against Ageism، وكتاب كارل أونوريه Bolder: Making the Most of Our Longer Lives. هذه الكتب الخمسة تعمل على طمأنتنا بأن التقدم في العمر لا يعني سوى أن علينا أن نبذل جهداً أكبر للبقاء شباباً.
تعمل بيفر طبيبةً نفسية وتركز في عملها على النساء فوق سن الستين اللواتي تصف حالتهن العقلية والجسدية بالتدهور المستمر؛ لكنها تقع أحياناً في فخ الابتذال حين تحثّ النساء على أن “يتعاملْن مع كل التجارب التي تمرُرْن بها على نحو إيجابي”، إلّا أن الكاتبة دائمًا ما كانت تتسم بتعاطفها مع أولئك النساء. يعتقد أغرونين -الذي يُوصَف بصورة مشوّشة بأنه “طبيب نفسي مختص بأمور الشيخوخة” (وهو في منتصف الخمسينات من عمره) أن الكبر في السن لا “يجلب القوة” فقط، ولكنه أيضاً “أكثر ما ننجزه قيمة في حياتنا”. ويرى كاسل -أستاذ علم النفس بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجيليس UCLA- أن هناك “شيخوخة ناجحة”، ويسعى إلى أن يبيّن لنا كيفية الوصول إليها. أما أبل-وايت -التي تصف نفسها بـ”المؤلفة والناشطة”- فلا تندد فقط بالأفكار النمطية عن كبار السن، وإنما تريد القضاء عليها، حتى أنها تبدِّل ألفاظاً مثل “كبار السن” و”العجزة” وتستخدم بدلاً منها ألفاظاً أخرى مثل “الحكماء” الذي تعتقد أنه يركز على أفضل ما لديهم. وتصف أبل-وايت دورَ رعاية المسنين أنها “أَسِرّة مثيرة للشهوة والرومانسية”، وتكتب أيضاً “الجنس والإثارة يتغيّران مع العمر، لكن غالباً إلى الأفضل”. ربّما كان هذا صحيحاً، مع أني لم أسمع أحداً قبل ذلك يُثبِت ذلك الأمر. وربما صاغها بشكلٍ معبِّر فيلسوف اللذة رودني دانجرفيلد -الذي توفي قبل شهر من عيد ميلاده الثالث والثمانين- بعد أن درس العلاقة بين الجنسانية وطول العمر، إذ يقول “أنا في سنٍّ حلَّ فيه الطعام محلَّ الجنس في حياتي. في الحقيقة لقد وضعت مرآة أعلى مائدة المطبخ”.
يأتي ذِكرُ أبل-وايت في كتاب أونوريه، الصحفي الكندي الذي يبلغ من العمر 51 عاماً؛ إذ تخبره أن التقدم في العمر “مثل الوقوع في الحب أو الأمومة”. ويذكرنا أونوريه أن “التاريخ حافلٌ بأناس كانوا يلمعون في أواخر عمرهم” من بينهم سوفوكليس ومايكل أنجلو ورامبرانت وباخ، إضافة إلى إديسون الذي قدم براءات اختراع وهو في سن الثمانين. ربما لأن أونوريه ليس أميركياً فقد أغفل ذِكرَ ستاتشيل بايج، لاعب البيسبول الذي ظل يشارك في البطولات الكبيرة حتى سنّ الـ59. ومثل أبل-وايت التي تزعم أن العقل يعمل “بشكل متناغم أكثر مع ما حوله” كلما تقدَّم في العمر، يؤكد أونوريه أيضاً أن الشيخوخة قد “تغيّر بنية الدماغ بطرق تعزز الإبداع”.
هؤلاء المؤلفون لا يجهلون مخاطر الشيخوخة، لكنهم يفضلون أن ينظروا إلى الجانب الإيجابي. فجميعهم يؤكدون أن كبار السن يشعرون براحة أكبر، ويقل لديهم الشعور “بالقلق الاجتماعي والرهاب الاجتماعي”، وفقاً لما قالته أبل-وايت. تدعم بعض الأدلة هذه الفكرة. فقد أصبحت الصلة بين السعادة والشيخوخة فكرة مقبولة على نطاق واسع، خاصة بعد نجاح كتاب جوناثان روش، “منحنى السعادة: لماذا تتحسن الحياة بعد سن الخمسين”، وكتاب جون ليلاند، “السعادة اختيار: دروس من عام أمضيته مع المسنين”، واللذين نشرا العام الماضي. وفقاً لاستبيان أجرته مؤسسة غالوب عام 2011، تتبع السعادة منحنى على شكل حرف U، وهي فكرة قدمها لأول مرة عالما الاقتصاد ديفيد بلانشفلاور وأندرو أوزوالد في دراسة أجريت عام 2008. لقد اكتشفا أن شعور الناس بالسعادة يكون في أعلى حالاته في مرحلة الطفولة وفي سن الشيخوخة، بينما ينخفض بشكل ملحوظ في مرحلة منتصف العمر.
لكن مؤخراً، تشكك البعض في هذه الفكرة. إذ يبدو أن السعادة قد تتخذ هذا المنحنى في الدول التي يكون فيها متوسط الدخل مرتفعاً ومتوسط الأعمار أيضاً، أو حيث يشعر الفقراء بالاستياء أكثر في مرحلة منتصف العمر ولا يترددون في التعبير عن ذلك. لكن ربما يكون هناك تفسير أبسط. ربما يكون المشاركون في مثل هذه الاستبيانات هم الأشخاص الذين تتبع حيواتهم المنحنى، بينما لا يهتم الأشخاص الذين يشعرون بالبؤس في سن السبعين أو الثمانين، حيث يزيد شعورهم بالضجر بسبب التوقعات التي لم تتحقق، بالمشاركة في مثل تلك الاستبيانات.
تتمثل إحدى استراتيجيات تلك الكتب في التأكيد على أن التقدم في العمر هو عملية طبيعية، لذلك فهي جيدة، وهي فكرة ترجع إلى عهد أفلاطون، الذي عاش ليصل عمره إلى الثمانين وكان يرى أن الفلسفة تناسب الرجال في مرحلة النضج، أما النساء فكان يرى أنهن مهما بلغن من العمر، فهن غير مؤهلات للتفكير الفلسفي في جوهر الأشياء. في حين كان لتلميذه الأشهر أرسطو رأي آخر. فقد احتوى كتابه “فن البلاغة” على فقرات طويلة في ذم كبار السن ونعتهم بالبخل والجبن والتشاؤم والثرثرة وبرود المزاج. كان أرسطو يرى أن الجسد يفقد حرارته مع التقدم في العمر. تكونت تلك الآراء في النصف الأول من حياة أرسطو ولا نعلم إن كان قد غير نظرته قبل وفاته في سن الثانية والستين. كان شيشرون من أشد المدافعين عن فكرة أن الطبيعة دائماً على حق، حيث كتب وهو في سن الثانية والستين: كتاب “كيف تكبر في العمر”، وهو عمل أثنى عليه كل من جون آدامز (الذي مات عن عمر يناهز التسعين) و بنجامين فرانكلين (الذي مات في الرابعة والثمانين).
كان لمونتين نظرة أكثر واقعية. فقد كتب عام 1580 واصفاً نهاية العمر الطويل بأنها “أمر نادر، وغير عادي، ومتفرد، وهو نوع من الموت الاستثنائي: وكلما طالت الرحلة كلما كانت غير مرغوبة. ربما كان مونتين، الذي لم يعش ليبلغ الستين، ليغير رأيه لو أنه عرف أن الكثير من الناس في القرن الحادي والعشرين يعيشون ليبلغوا السبعين والثمانين من أعمارهم. لكني أشك في أنه كان سيقول في تلك الحالة: “من الذي بلغ الشيخوخة ولم يحن إلى الماضي ويتأفف من الحاضر؟”، لا يبدو أن حياته يُمكن وصفها بمنحنى السعادة.
بالطبع لديك فرصة لأن تصبح أكثر سعادة في الثمانين عما كنت عليه في العشرين أو الأربعين، لكنك سوف تشعر أنك أسوأ حالاً. أعرف هذا لأن كتابين نشرا مؤخراً يوضحان ما الذي يحدث لجسم الإنسان مع التقدم في العمر. كتاب “تأثير التيلومير (القُسَيم الطَرَفي): كيف تحيا بصحة أفضل ولمدة أطول”، من قبل إليزابيث بلاكبيرن وإليسا إيبيل، وكتاب المؤلفة سو آرمسترونغ،”الوقت المستعار: ما يقوله العلم عن كيفية وسبب تقدمنا في العمر”، كلاهما يصفان ما يحدث للإنسان مع بلوغه أرذل العمر.
تُقدم آرمسترونغ، وهي كاتبة بريطانية متخصصة في العلوم والصحة، بأسلوب مايكل لويس، أفضل ما توصلت إليه أبحاث الشيخوخة مع السير الذاتية المختصرة لأبرز الشخصيات، بينما تركز بلاكبيرن، وهي واحدة من الثلاثة أشخاص الذين حازوا على جائزة نوبل في الطب أو علم وظائف الأعضاء عام 2009، على نقص طول التيلوميرات (القسيمات الطرفية)، وهي عصيات متناهية الصغر متصلة بكروموسوماتنا، والتي يعد طولها مؤشر على صحة الخلايا. في الأساس، تنقسم معظم الخلايا نحو خمسين مرة قبل أن تصاب بالشيخوخة. تساهم تلك الخلايا في حدوث الالتهابات وتتعارض مع الكولاجين الواقي. وفي نفس الوقت، تتناقص أطوال التيلوميرات مع كل انقسام خلوي، بل إن نوعية الحياة تؤثر على درجة انكماشها، فقد أظهرت البيانات أن المتزوجين أو الأشخاص الذين يعيشون مع شريك حياة لديهم تيلوميرات أطول”.
بيد أن شخصية مثل والت ويتمان، الذي لم يتزوج، وصل إلى سن الثانية والسبعين وكان يمثل حالة فريدة من الشيخوخة. وكتب قائلاً، “إلى الشباب، الممتلئ بالرغبة والحب، الشباب المتميز بالرشاقة والقوة والروعة. هل تعلم أن الشيخوخة قد تأتيك بنفس الرشاقة والقوة والروعة؟” من الجميل أن تفكر بهذه الطريقة، لكن لعلم الأحياء رأي آخر. توضح ما تسمى بالساعة الفوق جينية أن الحمض النووي الخاص بالإنسان يصاب بتغيرات مع التقدم في العمر، وأن طفرات الميتوكوندريا المرتبطة بالتقدم في العمر تقلل من قدرة الخلايا على توليد الطاقة، وأن جهازنا المناعي يصبح أقل كفاءة مع الزمن. وتتوهن العظام، ويضعف البصر، وتخور قوى القلوب. يزداد معدل التبول، بينما يتناقص معدل التبرز، وتتراكم البروتينات السامة في المخ لتكون الرواسب والكتل المتشابكة التي تسبب مرض الزهايمر. ليس من المفاجئ أن يكون لدى 68% من المستفيدين من نظام ميديكير اليوم عدة أمراض مزمنة. ليس هناك الكثير من الرشاقة، والقوة، والروعة في ذلك.
باختصار، لا يتماشى السرد المتفائل الذي يُقدمه الكُتاب المدافعين عن الشيخوخة مع القصة الحزينة التي يرويها الجسم البشري. لكن ربما هذا ليس هو مقصدهم. في دراستها الموسعة التي أجريت عام 1970 بعنوان “قدوم العمر”، كتبت سيمون دو بوفوار في مقال لها: “هناك حل واحد لكي لا تصبح الشيخوخة محاكاة سخيفة لحياتنا السابقة، وهو الاستمرار في السعي نحو غايات تعطي لوجودنا معنى، مثل التفاني للأشخاص، أو المجموعات، أو القضايا، سواء كانت اجتماعية أو سياسية أو فكرية أو إبداعية”. بيد أن مثل هذا المعنى لا يصل إليه الإنسان بسهولة. في عام 1975، نشر روبرت نيل باتلر، الذي صاغ مصطلح “التمييز ضد كبار السن” دراسة بعنوان: “لماذا نعيش؟ أن تكون مسناً في أميركا”. فازت الدراسة، التي تناولت تقصير المجتمع تجاه شريحة المسنين الآخذة في الاتساع، بجائزة بوليتزر. ويختتم باتلر بحثه قائلاً، “بالنسبة للعديد من المسنين الأميركيين، تُعتبر الشيخوخة مأساة، ومرحلة يشوبها اليأس، والحرمان، والبؤس والغضب المكتوم”.
بعد أربع سنوات، كان لدى الصحفي البريطاني رونالد بليث، الذي لا بد أنه أحد الأحياء القلائل من الكتّاب الذين تحدثوا مع أناس من العصر الفيكتوري (فهو الآن يرنو إلى السابعة والتسعين من العمر)، رؤية أكثر تفاؤلاً. فقد كان كتابه “المشهد شتاءً” The View in Winter، الذي يحوي تاريخاً شفهياً لرجالٍ ونساء في أواخر عمرهم، هو شهادة جميلة، أحياناً شخصية وأحياناً علمية، “لا تصل إلى نتيجة واحدة. … فالعصر القديم مكتظ بالموت وبالحياة. إنه إنجاز مقبول، ولكنه في نفس الوقت كارثة. إنه يتجاوز الرغبة ويسخر منها في آنٍ. لقد كان طويلاً بما يكفي، وكان أبعد ما يكون عن هذا”. بعد ذلك ببضع سنوات، صاغ مذيع شيكاغو العظيم ستادز تيركل، الذي توفي في سن السادسة والتسعين، نسخة أميركية من المشهد الشتوي الذي رسمه بليث. في كتابه الصادر عام 1995 بعنوان “قصة البلوغ” Coming of Age، يستجوب تيركل 74 “عجوزاً” (رجال ونساء فوق سن السبعين) حول أفكارهم عن الشيخوخة والسياسة وأسلوب الحياة الأميركي.
ولأننا اليوم نحيا أطول، فلدينا الوقت الكافي لكتابة الكتب حول العيش الطويل. في الواقع هناك الكثير من هذا النوع من الكتب لدرجة أن الناقدة الكندية كونستانس روك، صاغت عام 1992 مصطلحَ ’رواية الختام‘ Vollendungs -وهو تتمّة غريبة بعض الشيء لمصطلح ’رواية التشكيل‘ Bildungsroman- لتصف الروايات التي تتناول نهاية العمر؛ مثل رواية باربارا بيم “رباعية الخريف” Quartet in Autumn، ورواية كينغسلي أميس “الشياطين القدامى” The Old Devils، ورواية والاس ستغنر “الطائر الرائي” The Spectator Bird. منذ ذلك الحين، ظهر كثيرٌ من الأبطال المسنين في روايات كتبها لويس بيغلي (“عن شميدت” About Schmidt)، وسو ميلر (“الضيف المُميَّز” The Distinguished Guest)، وساول بيللو (“Ravelstein“)، وفيليب روث (“الجميع” Everyman)، ومارغريت درابل (“صعود الطوفان المظلم” The Dark Flood Rises). أما عالَم الكتب غير الأدبية فقد واكَب السياق أيضاً. هناك اليوم موقع إلكتروني يسرد أفضل خمسين كتاباً حول الشيخوخة، ولكنه مع الأسف يتجاهَل كتابَ ويليام إيان ميللر الفريدَ Losing It: In Which an Aging Professor Laments His Shrinking Brain، الصادرَ عام 2011؛ وكتابَ لين سيغال الحكيمَ والرصينَ Out of Time: The Pleasures and the Perils of Ageing، الصادرَ عام 2013؛ وكتابَ مارثا نوسباوم وساول ليفمور الذكيَّ والمثيرَ Aging Thoughtfully: Conversations About Retirement, Romance, Wrinkles, & Regret، الصادرَ عام 2017، وفيه تتناول الفيلسوفة (مارثا) وأستاذ القانون (ساول) كل شيء يتعلق بالأمر، بدءاً من “الملك لير” إلى نقل ملكية الأصول. وكما كان لا بدَّ كائناً، اجتمع علم الشيخوخة بالإنترنت في كتاب Aging and the Digital Life Course، وهو مجموعة من المقالات التي حرّرها ديفيد برينديرغاست وشيارا غاراتيني ونُشِر عام 2017. تنامت مكتبة الشيخوخة بصورة ضخمة، لدرجة أن الخمسين مليون أميركي فوق سن الخامسة والستين يمكنهم قضاء بقية حياتهم يقرأون تلك الكتب، حتى مع استمرار المتقاعدين الحيويين وأولئك الذين هم في العقد الثامن من العمر في كتابة المزيد من ذلك النوع من الكتب.
آخر الإصدارات الفلسفية الكبرى حول الشيخوخة كتبتها امرأة أيضاً؛ ويُعَدّ إلقاء الضوء على كتاب هيلين سمول “الحياة الطويلة” The Long Life، الصادر عام 2007، بمثابة الولوج إلى “جامعة الشيخوخة” بعد التسجيل في كلية جيدة. تريد سمول، الأستاذة في جامعة أوكسفورد (وكان سنها 42 فقط حين صدر الكتاب)، أن تدمج فكرة الشيخوخة في نظرتنا إلى الحياة. وبالتأمل في معنى كون الإنسان قد أتم دورة الحياة، التي لا يراها مونتين طبيعيةً، ترى سمول أن الشيخوخة “مرتبطة باعتبارات فلسفية أكبر وأوسع نطاقاً”، يقود وصفها والتعبير عنها -سواء أدبياً أو علمياً- إلى تحفيز التوجهات العاطفية والأخلاقية وهو في نفس الوقت انعكاسٌ لها. وفي نبرةٍ تعكس أقوال الفيلسوف بيرنارد ويليامز، تشير إلى أن حَيَواتنا تكتسب معناها عبر الزمن، ومن ثَمّ فإن قصة المرء لا تتم حتى يصل إلى سن الشيخوخة؛ وهي مرحلة من العمر تساعدنا على فهم كينونتنا ومعنى حياتنا.
قد لا يرغب جميع الناس في معرفة ما إذا كانت تسوية سمول الشيخوخةَ بإدارك الذات ما زالت صامدةً أم لا. ففي عام 2014، نشرت مجلة ذي أتلانتيك مقالةً لطبيب الأورام والمتخصص في الأخلاقيات الحيوية حزقيال إيمانويل، وكان سنُّه حينها 57، وتسبب عنوانها فقط “لماذا أتمنى أن أموت في سن الخامسة والسبعين” في ارتباك وعدم ارتياح بين أولئك الذي هم في السبعينات من أعمارهم. يعتقد إيمانويل أنه حين يصل إلى ذلك السن سيكون قد عاش حياة تامة مكتملة، ويُحاجِج أنه حين يصل المرء إلى ذلك السن (75) “يكون الإبداع والأصالة والإنتاج قد تلاشوا إلى حد بعيد بالنسبة للغالبية العظمى منا”. وعلى العكس من أونوريه وأبل-وايت، يرى إمانويل أن “من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، خلق أفكار إبداعية جديدة، لأننا لا نكتسب تشكيلة جديدة من الروابط العصبية التي يمكنها أن تحل محل الشبكة العصبية الموجودة بالفعل”. ومع أنه لا يفكر في الانتحار، فهو لا يسعي إلى إطالة حياته؛ فلن يقوم بعمل فحوصات الكشف عن السرطان (فحص القولون بالمنظار وما شابهه من فحوص)، ولا شيء من أجهزة تنظيم ضربات القلب أو الدعامات. إنه يرغب في الرحيل حين يكون ذلك مناسباً وجيداً.
إنها رؤية غير أنانية، لكنها قد لا تبدو ذات مصداقية عند مَن لم يتدرَّجوا في سلم التطور من أمثالي. بعد اجتيازي سن السبعين، لا أهتم كثير بأنني قد لا يكون لدي المزيد لأقدِّمه حين أصل إلى سن الخامسة والسبعين؛ بل لستُ على ثقة أنه سيكون لدي الكثير لأقدمه ’قبل‘ أن أصل إلى ذلك السن. إضافةً إلى هذا، يبدو إيمانويل وكأنه يتحدث عن الفنانين والمفكرين والعلماء، الذين سيُؤلِمهم أن قواهم العقلية وإبداعهم قد ينحسِرا في خريف العمر، وليس عن الأشخاص العاديين من العمال الذين بعد سنوات الكدح والكفاح في المصانع أو المكاتب قد يرغبون في قضاء بعض الوقت في ممارسة الرياضة أو قراءة الكتب. يؤدي الإعجاب الحسود بالطبيب الجيد إلى الإحباط وخيبة الأمل في النهاية، حين يحتفظ لنفسه بالحق في تغيير رأيه؛ وهو الأمر الذي يؤكد، من ثَمّ، توقعات مونتين الكئيبة بأن “رغباتنا تجدِّد شبابها باستمرار؛ فنحن دائماً ما نستأنف العيش من جديد”.
دعونا نؤكد أن طرق الولوج إلى سن الشيخوخة هي بعدد كبار السن، وخاصة أن عدداً متزايداً منا ما زالوا يُحدِثون جلبة وضجيجاً على الرغم من كل آلامنا وأمراضنا. لقد تحسَّر يوماً لاعب كرة السلة مايكي مانتل (أو ربما الممثلة مَاي ويست أو الفنان يوبي بلاك) قائلاً “لو كنت أعلم أني سأعيش كل هذا العمر، لَكنت اعتنيت بنفسي بصورة أفضل”. توفي مانتل في سن الثالثة والستين فقط، لكن الحقيقة هي أن كثيرين منا سيكونون حين يصلوا الثمانين في وضع صحي وبدني أفضل مما تخيَّل جاك في مسرحية “كما تشاء” لشكسبير، الذي ظن أن من يصلون إلى هذا السن سيكونوا قد زرعوا أسناناً جديدة بعد تساقط أسنانهم، ويستعملون النظارات الطبية وأجهزة تساعد على السمع. إن الحياة الطويلة نعمة؛ لكني لست على ثقة إن كنا سنشعر تجاهها بالامتنان.
لعل التقدم في العمر بصورة طبيعية يحمل كثيراً من المساوئ، بيد أن الأمر يصبح أكثر تعقيداً إذا ما أُصيب الإنسان بالخَرَف، الذي تتضاعف احتمالات الإصابة به كلَّ خمسة أعوام بعد سن الخامسة والستين. ومع ذلك، تعتقد أبل-وايت، مستشهدةً بأحد الأبحاث الحديثة، أن الإصابة بالخَرَف عند هذا السن لم تعد أمراً “حتمياً أو حتى محتمَلاً”. ومع أننا نتمنى لها أن تعيش حياة مديدة ومزدهرة، فبالنسبة لأمثالنا ممن أخذوا على عاتقهم مهمة تقديم الرعاية للأزواج أو الآباء المصابين بالخَرَف، ليس من السهل دوماً أن نعرف على كاهل مَن يقع العبء الأكبر (واحدٌ من بين كل ثلاثة من مقدمي الرعاية يبلغ من العمر خمسة وستين عاماً أو أكثر).
وغني عن البيان أنني لست مُرشحاً للانضمام إلى رواق المشاهير من كبار السن. بل في الواقع، أخطط أن أكون مجرَّدَ معطفٍ رثٍّ مُعلّقٍ على عصا، في انتظار أن أغرق في غياهب عالم النسيان الثاني بقلق شديد، مع أنني على يقين إلى حد ما أنه لن يَؤول إلى نفس نتيجة العالم الأول. ومع ذلك، أود الاعتقاد أنني أتمتع ببعض الموضوعية إزاء الشعور بالتقدم في العمر. فقد عاش والدي قرابة 103 عاماً، ومعظم أصدقائي الآن في السبعين من عمرهم. قد يكون من قَبيل المجازفة أن نطعن في قيمة التقدم في العمر، لكنني سأرفع عصاتي في وجه كل من يحاول إيقافي. ففي الوقت الراهن، يبدو أننا نعوِّض أنفسنا عن التجاوزات التي اقترفناها في الماضي: فبدلاً عن التقليل من قيمة الشيخوخة، فإننا نمنحها قيمةً قد لا تكون لها. بالتأكيد يتعين علينا أن نعيش أطول فترة ممكنة، ما لم نُصَب بالمرض أو العجز؛ ولكن عندما يتعلق الأمر بالتردّي في العمر، فلا ينبغي لنا أن نفقد صراحتنا تجاه الوهن الذي يصيب أجسادنا. بل يُمكنك القول إن الهدف يتلخص في الحياة مدةً كافية تجعلك تُفكر في أنك قد عشت حياة مديدة بالفعل.
لا شك أن المرء قد يرغب في أن يتقدم به العمر بينما ما يزال ينعم بالجمال والجَلَد، ولكن الشيخوخة تجعل الأمر صعباً. أما أولئك الذين يعتقدون أن التقدم في العمر هو استراحة محمودة من المشاعر والهموم والمتاعب التي واجهوها خلال مرحلتي الشباب أو منتصف العمر، فإما أنهم محظوظون للغاية أو عقلاء إلى حد مذهل. لماذا التصدي لأمرٍ لا مفر منه؟ ما الفائدة من ذلك؟ لا شيء على الإطلاق. ولذا، يبدو أن الشكوى لا طائل منها وغير لائقة. فضلاً عن أن الوجود في حد ذاته قد يكون لا معنى له وغير لائق؛ ولا عجب أننا نتساءل عن معنى كل ذلك. فقد كتبت الشاعرة لويز بوجان قائلةً “في البداية نريد أن تكون الحياة رومانسية؛ وبعد ذلك نريدها أن تكون مُحتملة؛ وأخيراً نريدها أن تكون مفهومة”. قد تتفق الأستاذة هيلين سمول مع ذلك، ومع أنني من المعجبين بكتابها، فقد انتابني الشك في أنّ تراكُمَ الأعباء على مر السنين يَزيدُ فهمَنا للحياة حقاً. ألم تقُل ريغان عن والدها الملك الثائر: “أليس ذلك بسبب العجز والوهن الذي أصابه مع تقدمه في العمر: إلّا أنه دائماً عَرَف نفسه وإن بشكل محدود”. ربما تُسهِم السنوات في زيادة الخبرة، وتضفي تميُّزاً خاصاً على منظورنا للحياة، لكن هل من المؤكد أن الحكمة أو الرضا ستظهران بالضرورة نتيجة لذلك؟
ربما نعتمد عندما نبلغ من الكبر عِتيّاً على نفس الأشياء التي كنا نعتمد عليها قبل أن يتقدم بنا العمر. ومن المحتمل أن يجد الأشخاصُ الذين اتسموا بالغرور والأنانية أنّ التقدمَ في العمر أقل احتمالاً وقبولاً من أولئك الذين يبحثون عن معنى الحياة من خلال مساعدة الآخرين. وأولئك الذين حالفهم الحظ في أن يعيشوا حياة كاملة ومُثمرة، قد يغادرون هذه الحياة دون ندمٍ غيرِ مُبرَّر. ولكن -على سبيل الجدل- إذا كنت شخصاً تستغرب باستياء عندما يفسح لك الناس في الأربعين أو الخمسين من عمرهم مقعداً في الحافلة، أو أن أطبّاءك أصغر منك سناً بأربعين عاماً، فربما يكون ذلك بسبب ما تشعر به من سخط إزاء نبض الزمن المتواصل.
لا شك أن ثمة حياة ما تزال تدب في هذا الطفل الطاعن في السن حتى الآن، ولكن ثمة أيضاً بعض القيود التي تُفرَض عليه. فقد صار هذا الجسد المُتعَب المُتألِّم المُتقلِّص يُسبِّب لنا الآن الإحراج في أحيانٍ كثيرة. إذ يشعر العديد من الرجال كبار السن أن عليهم التبول مباشرةً بعد أن انتهوا من التبول لتوهم، كما قد تعاني العديد من النساء المُتقدمات في العمر من سلس البول كلما عطَسْن. قد تقول ماري بيفر ومَن على شاكلتها ببساطة “رحمك الله” ويحثوننا على الاستمرار. فهم يصِرُّون على أن الحياة قد لا تتفاقم بالضرورة بعد بلوغ السبعين أو الثمانين من العمر؛ ولكنها تزداد سوءاً بالفعل. لا يهمني كم عدد كبار السن الذين يُمارسون الجنس كل ليلة؛ فما يزال هناك شيء ما مفقود.
لا ينحصر الأمر في الطاقة أو البراعة الجنسية فحسب، وإنما يشمل أيضاً لذة التطلع والأمل. حتى لو كنتَ أعزباً، هل يمكنك أن تستعيد ذلك الشعور بالإثارة عند أول قبلة وعند اللحظات الأولى لممارسة للجنس؟ هل هناك أحد يرغب حقاً في ممارسة الجنس عند سن الخامسة والسبعين؟ فقد أصبحنا الآن، نُخفض الإضاءة ونطوي ملابسنا، ثم نتمنّى ألّا نبدوَ على قدرٍ كبير من الهشاشة وألّا تظهرَ تجاعيدُنا واضحة فنبدوَ كباراً جدّاً. بالطبع يدَع الحب الناضج مجالاً لقبول العيوب الجسدية، لكن ألَا نسعى إلى أن نكون مرغوبين لجمالنا عِوَض أن تغفَر لنا عيوبنا وقصورنا؟ قد تبدو هذه أسباباً تافهة ليأسَف المرء بشأنها؛ غير أن فقدان المرءِ المتعةَ من خلال جسده، وفقدانه متعةَ الشعور بأن ذلك الجسد من أسباب سعادة شخص آخر، هو سبب حقيقي للأسف.
يمكنني التنبؤ باعتراض البعض قائلين: إنْ كان أبنائي قد كبروا ويعيشون سعداء، وإن كان أحفادي يبتهجون عند رؤيتي، وإن كنت أحظى بصحة جيّدة وأشعر بالأمان من الناحية المالية، وإن كنت راضياً بما أنجزته، وإن كنت أشعر بالراحة اليوم لأني لم أعد بحاجة إلى إثبات ذاتي؛ فلماذا إذن يُعَدّ انقضاء عمر الشباب مقايضة عادِلة. الكثير من ’إنْ كان كذا‘، ولكن لا عليك. علينا جميعاً التسامح مع التقدم في العمر. ولذا أسدى خالص التحايا إلى د. أوليفر ساكس، الذي اختار أن يعتبر الشيخوخة ”وقتاً للراحة والحرية من الإلحاحات المختلَقة التي تكون عبئاً على المرء في باكر أيامه، والتفرّغ لاستكشاف ما يرغب المرء في اكتشافه، ووقتاً لدمج الأفكار والمشاعر التي شكّلت عمر الإنسان“. في سن الثانية والثمانين، أعاد ساكس اكتشاف متعة طبق الأسماك المحشوّة، الذي -كما أشار- كان ليستلّه من الحياة كما كان قد أدخله فيها.
يؤكد سويفت أنه ”ما من إنسانٍ حكيم يتمنى أن يعود به العمر إلى الوراء، ليصبح صغيراً في السن من جديد“، ولكنه يقول هذا لأنه لم يلتقِ بي من قبل. بيد أن هذا لا يعني أن علينا أن نرى الشيخوخةَ على خلاف ما هي عليه حقّاً. فربّما كانت تساعدنا على النضج وبلوغ مرحلة أرقى من الكمال، لكنها تقهرنا في سبيل هذا. ”إن الحياة موتٌ بطيء“، هكذا كتب فيليب لاركين قبل أن يتوقف عن ذلك الموت عن عمرٍ ناهز 63 عاماً. هذه حقيقة يتجاهلها بعجرفة الشباب المشغولون كثيراً بالعيش. ولو توقفوا لحظة من الزمن، لَاكتشفوا أن كل الكتب تقريباً حول الشيخوخة تروِّج لاتخاذ موقف ”إيجابي“ منها، إنما هو في سبيل الحفاظ على شعور بالرضا ولتحقيق قدرٍ ما مِن الحكمة. غير أنه يبدو لي أن المرء يمكن أن يكون حكيماً وتعيساً، ويمكن أن يكون حكيماً ونادماً، بل حتى يمكن أن يكون حكيماً ومرتاباً في الحكمة من الشيخوخة.
حين أعلن سقراط أن الفلسفة هي ممارسة الموت، كان يقصد أن يقول أن الفكر نفسه يصوغه الموت؛ ونظراً إلى أن وجودنا محدود فبإمكاننا التفكير فيما وراء تلك الحدود. فالزمان يحيط بنا من كل جانب، ولذا نختلق القصص حول حياة أخروية لا يكون فيها وجودنا مصفَّداً بالأيام والسنين، وما يمثّلانه من تآكل وتهدُّم. ولكن إلى أين يقودنا هذا، بعيداً عن الارتياب الغامض في أن الخلود ليس ضماناً للحكمة؟ وأعني بالخلود هنا على الأقل صورته المتمثّلة في الإله يهوه المُنتقم، والآلهة اليونانية والرومانية القديمة الحاقدة. إذن مُجدداً، لو كنتَ ذلك النوع من الناس الذين يرون ثُمن الكوب الممتلئ، لا الأثمان السبعة الأخرى الفارغة، فلن تشعر بالقلق حِيال ذلك؛ بل ستستقبل كل يوم جديد بحفاوة وامتنان، بغضّ النظر عن ذلك السعال والبلغم وعشرات الأقراص من الأدوية.
ولكن ما عساي أن أعرف؟ فلست سوى شخص واحد لا يشعر وهو في الحادية والسبعين من العمر بنفس المشاعر الجيدة التي كانت لديه وهو في الحادية والستين، وهو على أتم اليقين من أن مشاعره ستزداد سوءاً حين يكون في الحادية والثمانين. ببساطة أعرف ما كان الناس دائماً يعرفونه: ”دَورٌ يَمضِي ودَورٌ يَجِيءُ، والأرضُ قائِمَةٌ إلى الأبَد“. آهٍ لو توقف كاتب هذه الكلمات عند هذا القدر! لكنه للأسف أضاف ”في كَثرَةِ الحِكمَةِ كَثرَةُ الغَمّ، والذي يَزِيدُ عِلماً يَزِيدُ حُزناً … فقلتُ في قَلبِي: كما يَحدُثُ للجاهِلِ كذلِكَ يَحدثُ أيضاً لي. وإذ ذاكَ، فلِماذا أنا أَوفَرُ حِكمةً؟ فقلتُ في قلبِي: هذا أيضاً باطِلٌ“. ما كان لشابٍّ أبداً أن يكتب مثل هذه الكلمات.
هذا المقال مترجم عن موقع Newyorker ولقراءة المادة الأصلية زوروا الرابط التالي.
درج