تعبير: الكلمات والعنف والدموع/ ياسين الحاج صالح
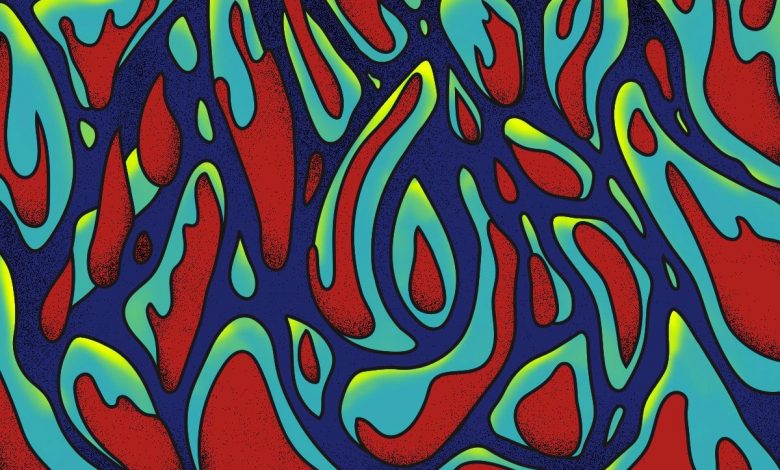
ماذا يحدث حين تفشل الكلمات؟ وهي تفشل كثيراً. هذا واقع لا يحجبه واقع آخر: أننا لا نكف عن الكلام. إذ يمكن للفشل أن يكون دافعاً جزئياً للاستمرار في الكلام، في مسعى منا للاقتراب من النجاح في قول ما نريد قوله. دافع جزئي لأن النجاح يبقى غير مضمون، ولأن التجارب البشرية، ومنها ما هي شديدة القسوة، لا تبدو مصممة أو موجودة على نحو خاص بحيث تنجح الكلمات في تمثيلها، وأن الكلمات من وجه آخر لا تبدو مصممة على أفضل نحو كي تحيط بكل الأوضاع والتجارب الممكنة للكائن البشري. ثم لأننا نتكلم ما دمنا أحياء، وقد لا يكون استسلامنا للصمت غير نفضة يد نهائية من الحياة ذاتها.
ماذا نفعل حين تفشل الكلمات؟ نمارس العنف، نبكي مقهورين، أو نموت بحسرة بعد حين يطول أو يقصر. أو هذا ما تُقدره هذه المقالة وتحاول النظر فيه.
فشل الكلمات
لكن ما معنى فشل الكلمات؟ في أي شيء تفشل الكلمات؟ في التعبير، في نقل ما نشعر به إلى غيرنا، ترجمته إلى كلام مفهوم يشاركنا فيه آخرون. الكلام يُحوِّلُ تجاربنا الذاتية إلى شأن مشترك مع غيرنا، يُخرجها من داخل الذات إلى ما بين ذوات متعددة فيقيم رابطة اجتماعية. ومن هذه الرابطة قد نتلقّى صوراً من الدعم والمساندة والمواساة حين تكون تجاربنا قاسية أو ساحقة.
وبقدر ما إننا في الكلام نتبادل الكلمات والإصغاء مع مُكلِّمينا، فإننا نأخذ في اعتبارنا ما يقول المُكلمون، وهم يفعلون الشيء نفسه، فلا نبقى كما نحن، ولا يبقون، نتغير معاً. ونتعدد. إذ نأخذ ما نسمع معنا ونقلبه في أذهاننا أو نتداول في شأنه مع أنفسنا. فكأننا نأخذ شركاءنا في الكلام معنا. يصيرون هم داخلنا ونصير داخلهم، حتى إذا حاورنا أنفسنا حاورناهم. هذه وظيفة فكرية للكلام الداخلي، بقدر ما إن التفكير «حوار مع النفس» بحسب حنة آرنت تأسيساً على أفلاطون (سأناقش تصور التفكير عند آرنت في تناول مستقل). فشل الفكر قد يتولد عن فشل الكلام المتاح، إما لفقره أو لفيض التجربة عنه. من يشرع في التعبير هو شخص بتصرفه مخزون كلامي قد لا يلائم ما خَبِرَ من تجارب. ولا أعني بالمخزون الكلامي معجمنا من الكلمات المفردة، بل الطرق الكلامية لتمثيل التجربة من مفردات وتعابير وأمثال وشروح وقصص مختلفة باختلاف السياقات، تُستحضَر عند الحاجة.
الكلام بهذا المعنى يقيم علاقة لنا بغيرنا كما يقيم علاقة لنا بأنفسنا. وهذا بقدر ما إنه لا تفكير بلا كلمات، ولا كلمات دون مُكلمين، جماعة. يقيم الكلام على هذا النحو استمرارية بين التفكير والاجتماع، بحيث يكون التفكير اجتماعنا بأنفسنا وتآمرنا مع أنفسنا، والاجتماع تفكيرنا وتآمرنا مع غيرنا. وفي هذا ما يقيم استمراراً بين وظيفة الكلام الفكرية ووظيفته الإقناعية، فما يمكن أن يقنع الغير هو كلام جرى تَدبُّره في النفس، وما نتدبره في أنفسنا نبنيه من تفاعلاتنا مع غيرنا.
العنف والبكاء
في الكلام نحن في وضع حواري، قد لا يخلو من انفعال، لكن لا يستمر الكلام إلا بقدر ما يبقى الانفعال منضبطاً. حين يفلت من السيطرة، إن نحو العنف أو البكاء، ينحل الكلام نفسه فيهما وقد يزول تماماً.
في العنف نحن في وضع متشنج، نطرد التعدد من داخلنا، ولا نحاور أنفسنا أو نفكر. التفكير والعنف لا يجتمعان معاً. الجلّاد لا «يأخذ صفنة» وهو يعذب ضحيته. في جوهره، التعذيب وضع مضاد للتفكير ومضاد للنقاش. وهو ليس جزاءاً على نقاش فشل، فمن يُعذِّب يفعل لأنه يملك القوة ولا يخشى العواقب، ولا يحتاج إلى إقناع غيره. بالعكس، نعلم من تجربتنا السورية أن هناك تعذيباً لأنه ليس هناك نقاش أو إقناع. من يعذبون لا يفكرون بأنفسهم كمجتمع مع من يجري تعذيبهم، يتبادلون معهم النظرات والابتسامات والخدمات والأشياء، وقبل كل شيء الكلمات. لقد ترقت سورية إلى دولة تعذيب في ارتباط مباشر وقوي مع منع وامتناع النقاش العام، وما يقتضيه ذلك من تعبير الناس عن أفكارهم ومشاعرهم ونياتهم، وكذلك مع تراجع وزن الإقناع والاقتناع في السياسة. ويبدو الأمر أقرب إلى قاعدة عامة، فحيث هناك نقاش عام علني، يطور عدد أكبر من الأفراد تفكيراَ شخصياً، ويتشكل مجتمع نشط، وينمو البعد الإقناعي في السياسة، وتنحسر ممارسة التعذيب. وبالعكس، كان التعذيب مزدهراً في مجتمعات انحسرت فيها ساحات النقاش والكلام الحر.
وغير التعذيب، من هو في وضعية قتال لا يتوقف للتفكير بينما هو يقاتل. كأنما في القتال يجري طرد الفجوات في داخل المقاتل، يتصلب نفساً وجسداً، ويتوقف حواره الداخلي. وكأن توقف الكلام مع الغير في الحرب يثمر توقفه مع النفس، توقف التفكير ذاته. وهذا باب للشر وفقاً لحنة آرنت التي تُرجِع الشر إلى انعدام التفكير، وتآكل الضمير الذي هو نتاج للتفكير بحسب المنظِّرة المرموقة.
أما في البكاء فنحن، بالعكس، في وضع شبه سيّال، ونفقد كل صلابة ونسيل إلى خارجنا من الموقع الذي نطل فيه على الخارج، عيوننا. يحصل أن نفقد السيطرة على أنفسنا فكأن أحداً آخر يتحكم بنا. كأننا غيرنا.
والواقع أنه في العنف الفردي كذلك قد يفقد المرء السيطرة على نفسه، يسلم نفسه لنوبة من الغضب والتحطيم، تطال الأشياء وربما الأشخاص. فكأن الكلمات هي أدوات التحكم بالنفس، فيما البكاء والعنف مَجلَيان لفقد التحكم. وهو ما يسوغ منذ الآن تزكية استثمار أكبر في الكلمات التي هي أدوات «العقل». والعقل هو ما يفترض أنه موقع التحكم بأفعالنا وأنفسنا.
وحين نصمت ونموت في عزلة، فربما لأننا نجف من الداخل ونكف عن السيلان إلى الخارج، أي لأن الدموع تفشل كذلك وليس الكلمات وحدها. وربما كذلك لأننا نفشل في توجيه العنف نحو الخارج أو لا نحوز نفاذاً نحو وسائله المؤثرة. ولعل هذا المصير أشيع مما يبدو، بخاصة في عوالمنا الجريحة، المستترة والمحرومة من الكلام.
وبينما قد نبكي في عزلة، أو نميل لأن لا نُرى ونحن نبكي، فإن البكاء فعل اجتماعي من حيث البواعث، متصل بتفاعلات اجتماعية قاهرة، وليس بحال من شؤون النفس الفردية. نبكي تعبيراً عن القهر أو الحزن أو الألم. وتشير كلمة العَبْرة والعَبَرات العربية إلى صفة عابرة للدموع، صفة معبرة واجتماعية، وإن بطريقة مختلفة عن العبارات. الدموع تخفف اختناقنا، تغسل همومنا، فتصلح علاقتنا بأنفسنا. فكأنها ضرب من التفكير، وهذا بقدر ما إننا في التفكير نحاور أنفسنا وقد نتفاهم معها.
ولعلّه تبكى النساء أكثر من الرجال في مجتمعاتنا لأنهنَّ محرومات من الكلام أكثر من الرجال، إن على مستوى الأسرة أو على المستوى العام. ثم إن العنف الجسدي وما بُني عليه من فنون حربية ورياضات طورها الرجال ليس مما تحوز النساء فيه أفضلية. ولا ريب أنهنَّ يبكينَ أقل في مجتمعات يتكلمن فيها أكثر. ثم إنه يبدو أننا، الرجال الذين تدربنا على كبح انفعالاتنا، ومنها بخاصة البكاء، أسخى دموعاً اليوم. وهذا في ارتباط مرجح في تصوري مع فشل كلماتنا أمام تجاربنا، وتطور صور للرجولة أقل عضلية.
… والمجتمع
من فشل الكلمات، إذن، قد ننتقل إلى العنف أو إلى البكاء. الشرط الذي يؤدي إلى واحد منهما يؤدي إلى الآخر. في العنف تنقطع الرابطة الاجتماعية، وفي البكاء يجري الانسحاب منها والانكفاء على النفس. لكن هذا لا ينفي عن العنف صفة اجتماعية مثلما لا ينفيها عن البكاء. قد نتكلم على مجتمع أو متَّحَد سياسي (polity) حزين، حين يكون البكاء، التعبير بالدموع، ممارسة منتشرة، شرطاً اجتماعياً بالمعنى الواسع للكلمة الذي يشمل السياسي. وربما نتكلم على مجتمع أو متَّحَد عنيف، حين يكون العنف، بما فيه التعذيب، شرطاً اجتماعياً سياسياً.
فشل الكلمات خطير العواقب على ما هو ظاهر. المجتمعات التي تتكلم أقل يمكن أن ينفجر فيها العنف أكثر، وتكون أكثر حزناً وبكاءاً. وفي زمننا يغلب أن يكون شرط المجتمع الذي لا يتكلم هو الوجه الآخر لشرط الدولة التي تتكلم وحدها، أو التي تحتكر الكلام «الشرعي» فوق احتكارها للعنف. جمع الدولة بين احتكار الكلام واحتكار العنف يلغي الشرعية عن العنف المحتكر، بأثر تعطيل الصفة الإقناعية للكلام، التي هي مدار الشرعية.
في كل حال، البكاء والعنف، كما الكلام، أفعال اجتماعية وسياسية، لا تُفهَم خارج هذا الشرط الأساسي.
على أنه لا يتعين التفكير في الصفة الاجتماعية للدموع والعنف، وللكلمات بطبيعة الحال، في تقابل مع أجسادنا وتكوينها واستعداداتها، من صنف التقابل بين الثقافة والطبيعة. الواقع أن الصفة الاجتماعية لكل من الكلام والعنف والبكاء مؤسسة على تكوين الجسم البشري. فالكلام يميزنا تطورياً عن غيرنا من الكائنات الحية. لدينا نظام إشاري مجرد، ننفرد به عن غيرنا من الأحياء، هو اللغة. «العقل» هو نتاج هذا النظام الإشاري. ويبدو أننا ننفرد بالدموع كتعبير عن الانفعالات أيضاً، وهو ما يشجع من وجه آخر على التقريب بين الدموع والأفكار، وعلى تصور أن الدموع ضرب من الرؤية. على أننا نشارك أحياء أخرى العضلات التي نتوسلها في العنف وفي الهرب من العنف.
نحن في المجتمع بأجسادنا التي تفكر، وتبكي، وتضرب وتهرب، ونحن مع أنفسنا بأجسادنا. لا يبدو أن لنا أنفساً مستقلة عن أجسادنا واجتماعيتنا. صحيح أننا لا نوجد مع أنفسنا إلا بفعل وجودنا في مجتمع، أو أن الفرد مكون من مجتمع/مجتمعات، أكثر مما يتكون المجتمع من أفراد سابقين في وجودهم عليه، لكننا لا نكون أفراداً بغير شعور أجسادنا أو تجربتها.
ويمكن أن نبنى على ما تقدم أننا حين نخسر ما يميزنا من كلمات عن شركائنا من الحيوانات، ومن دموع، نستقر على ما يجمعنا بها من فعل العضلات.
كيف تفشل الكلمات؟
يفترض المرء أن كلماتنا، وإن لم تكن مصممة في أحسن صورة للتعبير عن العالم حولنا، وأن تجاربنا وإن لم تكن مصممة لتنحل في كلماتنا دون باق، فإن تشكلهما معاً، الكلمات والتجارب، كوجهين لوجودنا في العالم، يؤسس لعالم من التجارب/ الكلمات، لا توجد فيه التجارب دون كلمات تخزنها، وتسهل عبر الذاكرة التعامل مع تجارب لاحقة، ولا توجد
نعم. لكن التطابق بين الكلمات والتجارب ينكسر حين نُمنع من الكلام، أو حين تكون التجارب مهولة وغير مسبوقة، تتحدى مخزوننا الكلامي فلا يستجيب لها بكفاءة، أي حين يحدث ما لا يقبل التعبير. إذ قد تبلغ التجارب من الشدة بحيث تكسر الكلمات فيما تكسر. وهذه من خبراتنا المتكررة في سنوات الثورة السورية: نشعر أن كلماتنا تقف عاجزة أمام ما يحدث، فإما نصمت لأن «الكلام لا يفيد»، أو نثابر على الكلام فتقل طاقة الكلمات على حمل معنى أو توليد معنى للتجارب المهولة الجديدة. ثم إنه ينكسر التطابق بين الكلمات والتجارب حين تَتَندّب نفوسنا بفعل تكرر جراح التجربة ورضوضها، فننعكف على أنفسنا ونفقد القدرة على امتلاك كلمات جديدة والاستجابة الفاعلة لتجارب جديدة. مثل الندوب الجسدية التي تغلق مكان الجرح، الندوب النفسية تحمي من جرح أو رضة جديدة، لكنها في الوقت نفسها تقلل حساسيتنا حيال ما يجري حولنا. فكأن مساحة تفاعلنا مع العالم، مساحة لقاء التجارب والكلمات، تتقلص، لأنه سبق أن وردتنا الآلام من هذه المساحة. أو كأننا ننسحب من العالم لأنه جارح ومؤذٍ.
النفس المتندبة هي نفس جريحة أو مرضوضة، قد تموت بحسرتها، أي دون علاج لجروحها. وهذا أكثر من شائع في تصوري، بل لعله القاعدة. وهو يعطي وجاهة كبيرة لقول المتنبي إن «الموت نوع من القتل». كلنا ميتون، لكن لا يبدو أن أحداً منا يموت إلا وهو جريح. ولا يبدو أن أحداً يموت بسلام.
هذا غير أن من شأن تواتر ندوبنا النفسية وتصلبها أن يحولها إلى دروع، تغلق النفس ولها أثر خانق. وقد تنقلب النفس المتندبة، المدرعة، إلى مدرعة مفخخة، مهيئة لأن تنفجر بعنف. على الخريطة النفسية، إن جاز التعبير، ربما تقع النفس الجريحة المقهورة التي فقدت الكلام والدموع والعنف كأداة، والنفس المفخخة التي تنفجر لأنها محرومة من الكلام ومن وسائل عنف مؤثرة في موقعين متجاورين، فلا يمتنع التحول من واحدة منهما إلى الأخرى.
إن صحت هذه التقديرات فإن الأفراد والجماعات والمجتمعات في أشد الحاجة إلى العناية بالكلمات والاستثمار في الكلام. المجتمعات العنيفة والمجتمعات الحزينة، هي مجتمعات تعطَّلَ الكلام فيها، سواء بمنعه أو بتجمده على أحوال تُعطل قدرته على التعبير، بفعل هول التجارب. فبما أن الكلمات أدواتنا في التعبير، وفي التفاهم مع غيرنا، أي في السياسة كذلك، فإن من شأن العناية بالكلمات وتطويرها، وإدخال كلمات جديدة، وصنع روابط مغايرة بين الكلمات، أن يكون نهجاً حيوياً لتجنب العنف والحزن. قد يمكن التفكير في المجتمعات الغربية المعاصرة بأنه اعتني فيها بالكلام عناية مميزة، بوظائفه الفكرية والإقناعية معاً، ما أتاح التقليل من مستوى العنف فيها، وأن تكون مجتمعات أقل حزناً من غيرها.
قوالب وقواقع وأزمة
تَعطُّلُ التعبير يتولد عن المنع، لكن يمكن أن ينجم كذلك عن اختناق التعبير بأثر قوالب كلامية تُفرَض على التجربة فتثلم حدها وتترك تحديها دون استجابة، فتغني عن خلق التعبير أو الإبداع. على هذا النحو شرح عبدالله العروي آلية التسنين أو صنع التقليد في كتابه السنة والإصلاح. أُذكر بتحليل العروي ليس لتماثل بنيوي بين «التسنين» وبين إخماد الفاعلية التجديدية للتجارب المغايرة بقوالب كلامية غير نوعية، ولكن كذلك للإشارة إلى المصدر الديني لغير قليل من القوالب الكلامية في تداولنا. حيال تجارب الفقد، وحتى الفظيع منه، نتوسل عبارات من نوع: لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل، إنا لله وإنا إليه راجعون… ما لدينا هنا هو تمثيلات غير تجريبية تُضاف إلى ما تقدم ذكره من تجارب غير ممثلة. ولاستجاباتنا المحددة إيديولوجياً للكثير من تجاربنا أثر مشابه، غير نوعي لهذه التجارب. ما يجمع بين المعتقدات المختلفة هو إضعافها الوظيفية التعبيرية للكلام، من حيث أن التعبير هو العلاقة بين التجارب والكلمات. فمن يتكلم هنا ليس نحن الجرحى المذهولون، بل العقيدة، الدين أو المذهب أو المنهج، السابقة للتجارب. ما يُدخِل عقائدنا اليوم في أزمة هو قوة التجارب وقسوتها، وشدة الشعور بفشل تعبيراتنا المألوفة.
ولعل القوالب الكلامية والفكرية، الدينية منها وغير الدينية، وليدة اختناق ونفس جمعية متندبة، تحتمي مما لا يُعبَّر عنه من هول بتعابير/ قواقع، تساعد على التحمل، لكن لا تحمي من التجارب. العروي نفسه يلمح في تفسيره للتسنين اللاغي للحدث إلى تجربة قاسية أو مذلة، إلى جرح عميق. يُفهم التسنين ضمن هذا النطاق كاستتار أو كتقوقع في مواجهة واقع جارح، كعيش داخل نفس بلغ من صلابة ندوبها أن صارت قوقعة صلبة.
هذا شكل من الإنسانية نجد أنفسنا، في السياق السوري، في موقع متناقض حياله اليوم. فهو من جهة أولى يمنع من الاشتباك مع التجربة، أو الحدث بلغة العروي، ومن العمل على توليد معان حية منها، أي بناء فكرنا وثقافتنا على تجاربنا المعاشة، بما يُحسِّنُ فُرصنا في بقاء نشط؛ لكن من جهة ثانية تبدو حاجة الاحتماء بالغة القوة اليوم، ويبدو نازع التقوقع أقوى من النازع المعاكس، فكأننا نعرض أنفسنا لمزيد من الأذى إن خرجنا إلى العالم بدون حمايات مجربة.
بيد أن هذه الحمايات لا تحمي في واقع الأمر. وأزمة الانكشاف تحرض بالأحرى على كسر القواقع وشق دروب مغايرة للتعبير.
التعبير والتشكيل
في مقالة سابقة، الكلوم والكلمات: في تمثيل الأزمات وأزمة التمثيل، عملت على إظهار أن التمثيل هو مساحة تقاطع التعبير الذي يربط بين التجارب والأفكار (أو بين المعاناة والمعاني، أو في هذا السياق المخصوص بين العَبَرات والعِبارات)، وبين التشكيل الذي يوفره لنا التراث، كل المتاح الإنساني من أشكال لإخراج تعبيرنا اجتماعياً. لدينا اليوم أزمة تمثيل بفعل تلاقي أزمة في التعبير متصلة بهول التجارب وبتندّب النفوس، معززين بالمنع أو قمع حرية التعبير، بأزمة في التشكيل. تَعطُّلُ الكلام بفضل فقر أو جمود قوالب كلام وتفكير موروثة هو من نوع تَعطُّلِ التشكيل، أي تراجع ملاءمة الموروث المتاح للتجارب المعاشة. أما الحظر النشط للكلام فهو يمس التعبير أساساً، الربط بين التجارب والأفكار، وهذا بفعل الصفة السياسية جداً للتجارب، والمنبت السياسي لأشد صور المعاناة قسوة وعموماً. ولما كانت أشد تجاربنا هولاً هي تجارب سياسية كذلك، فإنها تتحدى التعبير أولاً، وليس التشكيل.
ولا تبدو العلاقة بين أشكال الإخماد الديني والإيديولوجي للتعبير وحظره السياسي علاقة برانية بين ظاهرتين منفصلتين. يمكن التساؤل عمّا إذا كانت القوالب الموروثة تستمر بفعل غريزة بقاء تخصها رغم عدم ملاءمتها أو لا تجريبيتها، أم أن تلاقي هول التجارب مع حظر التعبير يضائل إلى أقصى حد فُرَصَ تولد كلام أكثر تجريبية وملاءمة، ودلالة، فيزكي الموروث المعروف للعموم من كلام غير شخصي. بعبارة أخرى، نتوسل الكليشيهات في تعبيرنا ليس لأنها غير تجريبية ولا تدل، بل بالضبط لأنها غير تجريبية، حين تكون التجارب ساحقة ولا تطاق. أي لا يمكن أن يمثلها شيء، لا تقبل التمثيل. المهول الذي يتحدى الكلمات ويهزمها يناسب قوالب الكلام وعاداته المألوفة.
وقد يمكن التفكير في حالنا السوريّة من هذا المدخل. فتجاربنا طوال نحو عقد هي تجارب قاسية، قصوى، تحدت طوال السنوات الماضية مُتاحنا اللغوي والتعبيري، ووقف هذا أمامها عاجزاً بقدر كبير. وهذا على خلفية حظر كلامي وفقر تعبيري أطول أمداً. لا كلام هنا يمكن أن يكون ملائماً أو معبراً. وهذا يلعب لصالح الصيغ المقولبة مثل الحوقلة والحسبلة، ومثل نظريات المؤامرة. فإن كان لنا أن نقاوم أن «نطقَّ» ونتحلل، وليسا بالمستبعدين في كيان سياسي حزين ومعنف، فلا بد من ثورة تعبيرية إن جاز التعبير، تتيح لنا التعبير عما لا يمكن التعبير عنه اليوم.
أو بالأصح ثورة في التمثيل، في إنتاج المعاني وترجمة التجارب إلى أفكار، كما في تطور الأشكال وتنوعها. فإذا كانت تلتقي في شرطنا اليوم تجارب غير ممثلة (هول، فظاعة، جروح عميقة) بتمثيلات غير مجربة (قوالب كلام، كليشيهات)، أي مشكلات التعبير والتشكيل، فإن مضمون الثورة التمثيلية هو تجاوز هذا الشرط، والتقريب بين تجاربنا وتعبيراتنا، والاشتباك مع فرادتها وممانعتها الجوهرية للتمثيل. وفي الوقت نفسه ثورة في التشكيل، وإنشاء طرق جديدة للكلام.
والواقع أنه ليس هناك تجارب تمنح نفسها للتعبير والتشكيل طائعة، وأن الأصل في التجارب هو امتناعها على التمثيل، أو أنه في البدء ثمة فشل الكلمات، وأن كلامنا وتفكيرنا وثقافتنا هو اشتباك مع ما لا يُعبَّر عنه ولا يقبل التشكيل، مع ما لا يمكن تمثيله، وهو اعتناء بالكلمات كي تعني، أي كي لا تفشل. فنجاح الكلمات هو أن تعني.
وامتناع تمثيل التجارب يعني أننا لا نمثلها إلا بأن نخلقها هي ذاتها، نعطيها حياة. تموت التجارب التي لا تُمثَّلُ عبر الصراع مع امتناعها على التمثيل، التي لا نمثلها إلا بأن نخلقها فتمثلنا.
في كل حال التمثيل ليس شيئاً كمالياً. فبما هو اشتباك مع العالم وترميز له، فإنه إنتاج لـ «علم» يعين على الرسوخ في العالم، ويجعل من جراح الاشتباك ذاتها منابع للمعنى. تمس الحاجة إلى ثورة في المعاني بفعل ما حدث من «ثورة» في المعاناة، كماً ونوعاً وشدة. الملايين تعرضوا لتجارب جارحة، مختلفة عن مألوف أكثرهم، وخلال زمن قصير نسبياً لم تتح لهم فرص للاستعداد والتكيف. نخسر إن تغلّب لدينا مرة أخرى نازع الاحتماء والتقوقع على واجب الخروج، وإن مع معاناة لسعات الوجود المنكشف. أول ما يلزمنا اليوم هو الشجاعة في التعبير.
وتبدو العوائق دون ثورة تمثيلية أقل صعوبة في الشتات بفعل زوال القيود العامة أمام التعبير وعدم الاضطرار لممارسة رقابة ذاتية، وتوفر المسافة التي تتيح إعادة خلق التجربة أو إنشاءها، ثم بفعل ما يتاح من احتكاك بلغات وأدوات وأساليب تعبير مغايرة في مجتمعات اللجوء السوري. أي توسع التراث المتاح.
ولادة التعبير وحريته
في ما تقدم ما يتيح مقاربة مسألة حرية التعبير من مدخل مغاير. حين نتكلم على حرية التعبير ينصرف تركيزنا عادة إلى كلمة حرية، وإلى العوائق العامة، السياسية والدينية والاجتماعية، التي تحول دون أن يعبر الناس عن أفكارهم وآرائهم ومعتقداتهم بحرية. نفترض أن لدينا أفكاراً وآراء ومعتقدات تحول دون التعبير عنها عوائق خارجية، قمع سلطة ما، فلا نتكلم على فشل الكلمات أو فشل التعبير الذي يتولد عن هول التجربة، أو عن تندب النفوس الذي تسببه الجروح والرضات النفسية الفردية والجماعية، ولا عن العيش في عزلة بسبب التندب. فشل الكلمات لا يأخذ حتماً شكل الصمت عن الكلام، لكن ربما شكل الصمت عن المعنى إن جاز التعبير. وهذا هو المقصود بالكلمات القوالب، أو الكليشيهات.
فإذا كان الجرح هو النافذة التي يدخل منها النور إلى نفوسنا، بحسب صيغة بديعة لجلال الدين الرومي، فإن جراحاً تندّبت تحول دون دخول النور. يمكن أن نفكر بالجرح كفقد مؤلم، كمعاناة قاسية، وبالنور بوصفه الفكرة التي نستولدها من التجربة/ الجرح، أو المعنى الذي نستخرجه من المعاناة. ولعلهم ليسوا قلة من يدخل إليهم النور من جراحهم، لا يقتصر الأمر بحال على كتاب وفنانين مكرسين. الثقافة الشعبية، وربما في «مناسينا» المكبوتة أكثر من غيرها، هي نور دخل من جراح عموم الناس.
والمسألة على ما يظهر أوثق صلة هنا بولادة التعبير وموته منها بحريته وقمعه، بامتناعه منها بمنعه. فإذا تعزز الامتناع المتولد عن هول التجارب وتندب النفوس بالمنع والقمع، حصلنا على أزمة تعبيرية، على ضرب من العِيِّ الاجتماعي، أعتقد أننا عرفنا طوراً متقدماً منه بين أواسط ثمانينات القرن العشرين ونهايته، وهذا مع بقائنا طوال الوقت حتى الثورة في عِيٍّ نسبي. في العقد السابق للثورة أخذت تتوفر شهادات عن الهول، ضمن «أدب السجون» بخاصة، لكن لم يجر التفكير في الأزمة التعبيرية، والتمثيلية، في عِيِّنا العام. ولا نزال في تصوري نجد أنفسنا في افتقار متفاوت إلى اللغة، إلى الكلمات والتعابير غير الممضوغة، التي تسعف في تعبير تجارب الهول وتمثيلها.
ومن أوجه امتناع الكلام في ما يتصل بإشاعة سوء استخدام الكلمات، مما كان ولا يزال جهاز حكم في سورية. أعني احتكار الكلام الصحيح عبر وسائل إعلام مسيطر عليها، وإحلال الكليشيهات والصيغ المقولبة محل النقاش والتعبير عن التجارب الفعلية، ونشر مناخ من التشكك في كل ما يقال من كلام مستقل. هذا فضلاً عن تعميم السباب والبذاءة اللفظية في الحياة اليومية من قبل وكلاء النظام والموالين له كشكل بطريركي من أشكال التعبير عن الفحولة والسؤدد. يرتد الكلام هنا إلى فعل عضلي، تقوم به عضلة خاصة هي اللسان. وحين لا يكون هذا الفعل اللساني عنفاً لفظياً، ملحقاً بالعنف الجسدي كما في وضعيات التعذيب، فإن التعسف وفقدان المعنى أو اللامفهومية هو خاصيته. يتعدى الأمر سوء استخدام الكلمات إلى سوء معاملتها، تعذيبها في الواقع مثلما يجري تعذيب الناس، وانهيارها مثلما يحدث أن يجري لمن يتعرضون للتعذيب من الناس. لا يكاد يكون ثمة كلمات لم تُعذَّب وتنهر في سورية الأسد: الوطن، الحرية، الاشتراكية، الدولة، الديمقراطية، الوحدة الوطنية، الأمن، الإعلام… وهذا من أوجه التدمير الاجتماعي خلال خمسين عاماً التي لم تنل الاهتمام المستحق. تنهار الكلمات بأن تفقد معناها. المعنى لا يربط الكلمات بالتجارب فقط، ولكن المتكلمين ببعضهم، أي هو مرفق اجتماعي. نعتني بالكلمات كي تعني، فتعتني بنا. كي نصير مجتمعاً.
تبقى ولادة التعبير وموته مشروطة سياسياً مثلها مثل حرية التعبير وقمعه في تجربتنا المعاصرة. فليس بالمنع المباشر فقط يتحكم الطغيان بالتعبير، وإنما كذلك بتحطيم القدرة على الكلام، يإحداث تجارب لا توصف ولا يعبر عنها. بل لعل النجاح في إنتاج من لا يستطيعون الكلام أو لا يقولون غير كلام ركيك هو المثل الأعلى للطغيان الحديث. ولذلك فإن خلق الكلام وتوليده، والعمل على تمثيل ما لا يُمثَّل، أي «الإبداع»، هو فعل مقاومة سياسية.
من شأن ثورة في التعبير، أي نقلة نوعية في تمثيل تجاربنا، أن تضعنا في موقع أفضل بكثير من أجل حرية التعبير. نحتاج إلى تحرر قدرتنا على التعبير كي نقاوم بكفاءة أكبر القيود الخارجية على التعبير. وأن نوسع الكلام المتاح لنكون في وضع أفضل لتوسيع المباح. من شأن زوال هذه العوائق الخارجية، بالمقابل، أن يساعد كثيراً في فتح طرق سالكة بين التجارب والأفكار، لكنه لا يضمن بحد ذاته تشكيلاً لأفكارنا في صور تخاطب المزيد من الناس. الثورة هي ثورة على المستويين: التعبير والتشكيل، الاشتباك مع التجارب الجديدة، الهائلة، وغير المسبوقة، ثم توسع الأشكال المتاحة مع توسع التراث ليشمل المتاح في ثقافات أخرى وبِلغات أخرى.
مجتمع كلام؟
هل يمكن تصور أوضاع تحل فيها مشكلات التعبير والتشكيل، وتعاصر فيه ثقافتنا مشكلاتنا، وتستجيب لما يعانيه اجتماعنا من توترات وصراعات؟ هل يمكن للاجتماع البشري أن يكون ناطقاً، يدير شؤونه ويعالج مشكلاته بالكلام، فيستبعد كلياً أو بقدر كبير شرط المجتمع الباكي و/أو العنيف؟ لا يبدو أن التاريخ المعروف يوفر أمثلة على ذلك، وإن تكن المجتمعات متفاوتة في عنفها وحزنها، بما يعني أن حزناً أقل وعنفاً أقل ممكنان. وكما سبقت الإشارة، فإنه يبدو أن الثقة بالكلام أو الاعتماد الواسع على الكلام في تشخيص المشكلات ومعالجتها يتوافق مع آلام سياسية أقل. هناك آلام وجودية، تتصل بخاصة بخبرة الموت، موت القريب والحبيب، لا سبيل إلى تجنبها، لكن عدا أنها لا تقع ضمن هذا التناول، فإنه يمكن للكلام أن يساعد حتى في تحمل هذه الآلام الوجودية.
هذه المادة جزء من «جريدة سميرة»، القسم الذي تحضر سميرة الخليل في نصوصه حافزاً أو موضوعاً ورمزاً.
موقع الجمهورية




