في الذكرى التاسعة للثورة السورية، وأزمة المعارضة السورية -مقالات مختارة-
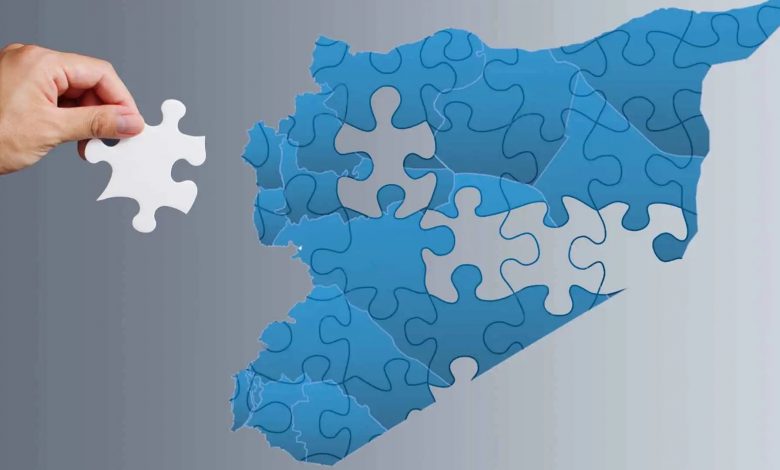
تحديث يومي في نهاية الملف
ورود على قبر الثورة/ عمر قدور
ما كان ينقص سوى كورونا لتمر ذكرى الثورة السورية بوصفها حدثاً ينتمي إلى زمن آخر. استذكار الثورة بين الأوفياء لها يشبه التقليب في ألبوم عائلي مشترك، تحضر فيه صور الأحبة من الموتى وذكريات زمنهم الجميل، الزمن الذي استشهدوا فيه بنبل، بينما تمكن الباقون من النجاة لأنهم سعوا إليها أو لأنهم حظوا بها اعتباطاً. يحضرون كأبطال في زمن عزّت فيه البطولة، أو صارت خارج سياق طاغٍ من الخيبة والهزائم والارتزاق.
يحضر كورونا هذه السنة ليضع السوريين أمام استحقاق آخر مؤلم، فهم من دون اختيار جزءٌ من بشرية مهددة بفناء قسم منها، بينما لم تُظهر البشرية ذاتها التعاطف المأمول مع إبادتهم. هم مهددون بالوباء أسوة بالبشرية، بعد أن كانت الإبادة من نصيبهم الخاص. ويلزم الإفراط في الأمل من أجل الظن أن البشرية الناجية من الوباء ستكون أعلى حساسية إزاء مقتلة بعيدة عن أسوارها الجديدة، إذ من المرجح أن يكون الناجون أشد أنانية وأقل اكتراثاً بغيرهم، ولو إلى حين.
وإذا لم يقع حدث دراماتيكي في الأمد القريب، لعلها تكون الفرصة الأمثل لآلة الإبادة الأسدية وحلفائها بانشغال العالم بالوباء الجديد. في ظروف أفضل، قبل أسابيع قليلة، رأينا المنسوب المرتفع لتجاهل مأساة الواقعين تحت القصف في إدلب، ثم رأينا كيف تُركوا لتفاهم روسي-تركي لا يلحظ مأساتهم. قد يوقف الوباء عجلة السياسة والحرب في دول تحترم مواطنيها، وتسخّر إمكانياتها كلها من أجل مواجهته، أما مع الأسدية وحلفائها فلا يمكن توقع هذا السيناريو، بل من التعقل توقع أن يفكر القتلة في مثل هذه اللحظات الحرجة باقتناص ما يرونهم أفضل فرصهم.
قد تكون أخبار كورونا أيضاً ذريعة مناسبة للتخفف من عبء ذكرى الثورة، ومن عبء أسئلة عن المآلات. الأسئلة ذاتها كانت واجبة في سنوات ماضية، إلا أن التملص العام منها كان أسهل لأن نتائج الهزيمة العسكرية لم تكن على هذه الدرجة من الوضوح. كان ثمة متسع لمن لا يفصل بين الثورة والحرب، ويرى الثورة في كل ما هو مضاد للأسدية، أو يعمل تحت هذا الادعاء. يصادف اليوم أن تُستهلك تلك الذرائع، وأن تغيب معها المطالب بوقفة تأمل.
كنا خلال سنوات في أتون الحرب، وكان ينبغي التذكير دائماً بأن السوريين أعلنوا الثورة وأن الأسد والأسديين أعلنوا الحرب؛ هكذا كان الأمر منذ المظاهرات الأولى. فرضت الحرب الإلزامية قوانينها، وراحت المفاضلة تنحصر مؤقتاً بين الشر المطلق وما هو أدنى منه. لم يتهاون الأسد وشبيحته للحظة في إظهار الأسدية كآلة إبادة وشر مطلقين، فوظيفة الحرب لم تكن تحقيق الانتصار كي تُحسب منافعها التقليدية، وفي مقدمها كسب أهالي المناطق المستهدفة؛ كانت منذ لحظة إعلانها حربَ وجود. على هذا الأساس، تتوجب قراءة انحيازات الحرب من قبل الذين لم يكونوا يوماً “هم أو أحبة لهم” سوى مهددين بالإبادة، فالحرب الإلزامية تولّد انحيازاتها الإلزامية، ومن الخطأ الخلط بينها والانحياز إلى مثُل الثورة الأولى، باستثناء أولئك الذين يتطابق مفهومهم الأيديولوجي الخاص بالثورة مع حربهم الخاصة.
الذين اتخذوا موقفاً مناوئاً للحرب لم يقدّموا إجابات أو اقتراحات للتعاطي مع الأسدية التي أعلنت الحرب، ولم تكن لتتوقف عنها حتى لو توقفت الثورة. النسبة الغالبة منهم لم تنجُ من الانحيازات التي فرضتها الحرب، وهذه النسبة امتلكت ترف اعتبار الأسدية أهون الشرور، وصولاً إلى الاصطفاف معها مباشرة أو مواربة بخلاف اعتزال الحرب المعلن من قبلها. إذا نحينا ما يمكن استنتاجه حول رياء هذه النسبة، يمكن القول أن حرباً “جذرية” من هذا القبيل يصعب أن تمنح للمعنيين بها إمكانية الحياد.
في الحرب التي أعلنها الأسد منذ تسع سنوات، كانت آلة الإبادة تقول للسوريين أن الخسارة ممنوعة عليهم لأنها تعني الفناء، وكان النظام الدولي يقول لهم أن النصر ممنوع عليهم تحت ذريعة عدم وجود حل عسكري في سوريا. لا نعلم ما هو مخفي في دهاليز السياسات الدولية، المؤكد أن التدخل الإيراني المبكر جداً جداً “والذي لولاه ربما سقط الأسد بأقل التكاليف” أتى برضا دولي، وعندما فشلت الميليشيات الشيعية ظهر الرضا الدولي ذاته عن التدخل الروسي، أي أن التعويل على حرب استنزاف تدفع الأسد إلى تقديم تنازلات لم يعد له وجود، فضلاً عن تهافته في الأصل.
طوال سنوات الحرب كان التعبير عن الانتماء إلى الثورة لا يعدو كونه التزاماً بهدفها، أي حرية السوريين والانتقال إلى الديموقراطية، وهذا يختلف بالتأكيد عن وجود ثورة فعلية في سوريا. كان هناك متلهفون لإعلان نهاية الثورة وحصر زمنها بأقصر مدة، وكثر منهم قدّموا رواية عن ثورة لأيام أو أسابيع قليلة سرعان ما انحرفت عن غايتها، وهي سردية تتشابه إلى حد مستغرب مع دعاية الأسد عن مطالب مشروعة في الأيام الأولى سرعان ما تم تجييرها لأجندات خارجية. في المقابل من أولئك، كان هناك كثر ممن يعزّ عليهم الاعتراف بأن الثورة انتهت موضوعياً، وبأن القتال ضد الأسد غير محكوم بمعايير الثورة وأهدافها. كانت لهفة الأولين لطي صفحة الثورة سنداً للإنكار الذي مارسه القسم الآخر، إذ فُهم منها “عن حق غالباً” وجود رغبة في دفن أحلام التغيير.
قلائل الذين انتبهوا ونبّهوا إلى إنكار نهاية الثورة بوصفه تعلّقاً عاطفياً بما لم يعد له سند، وإلى أن إعلان وفاتها لا يحتم دفن تطلعات السوريين معها على النحو الذي يتمناه البعض. من وجهة النظر هذه، لإعلان الوفاة وظيفة العبور بالقضية السورية إلى عتبة مختلفة، وبأدوات جديدة عوضاً عن التي ثبت فشلها، وبخطاب أعمق من الخطاب المختزل الذي تم استهلاكه. في ذكراها التاسعة، قد يكون قاسياً وصادماً بالنسبة للبعض القول أن دفن جثة الثورة ووضع ورود على قبرها هو أفضل تكريم، أقلّه بدلاً من الاستمرار في خوض نقاشات غايتها عزل ذلك الجثمان عن كل من يريد رمي قاذوراته فوقه، سواء كان من أعدائها أو ممن يزعم الانتساب إليها.
المدن
—————————————-
السنة العاشرة للثورة أو البحث عن السلام في سورية/ برهان غليون
من الصحيح، ولا يستطيع أحد أن ينكر ذلك، أن استمرار الشعب السوري، ممثلا بفصائل المعارضة المسلحة والسياسية والمثقفة، في خوض معركةٍ غير متوازنة أكثر من تسع سنوات، يشكل وحده عبرة لمن يعتقد أن المسألة حسمت، وإنجازا بطوليا في مواجهة نظام غدر بشعبه عندما وضع مصيره في يد قوى كبرى، تنتظر الفرصة منذ عقود، وبعضها منذ قرون، للحصول على موطئ قدم على الضفة الشرقية للمتوسط، ووضع اليد على الفريسة السورية. ولعل هذا الإنجاز يزداد قيمةً عندما نضعه في سياقه التاريخي، من الافتقار للتضامن الدولي والتشتت والانقسام الفكري والسياسي لأحزاب المعارضة، والظروف القاسية التي واجهت السوريين في سعيهم إلى الخروج من نفق العبودية الذي أراد نظام الأسد أن يدفنهم أحياء فيه إلى الأبد.
ولكن من الصحيح أيضا أن ثمن هذه المقاومة البطولية للهمجية والانتصار على الضعف والخوف الإنسانيين معا، كان باهظا جدا، دفعه السوريون من أرواح مئات الألوف من أبنائهم وبناتهم، واقتلاع الملايين منهم من منازلهم وأحيائهم وقراهم ومدنهم ورميهم في المجهول، مع حرمان ملايين الأطفال من الحد الأدنى من التعليم والتأهيل في مواجهة تحدّيات مستقبل غامض، وإلحاق الدمار بالعمران البشري، الاقتصادي والسياسي والمدني معا. ومما لا شك فيه أن أخطر ما فقده السوريون، في هذه المحنة الطويلة، وحدة إرادتهم وضياع قرارهم المستقل، واضطرارهم إلى تسليم أمورهم إلى حلفائهم أو/ وأكثر فأكثر إلى مستخدميهم. وارتهان معارضاتهم، بمسمياتها المختلفة، ومؤسساتها، وأشخاصها، إلى أجندات وأولويات القوى التي تتنازع على الحلول محلهم في حكم بلادهم واقتسام مصالحهم الوطنية.
ينطبق هذا الوضع على ما يسمى النظام والمعارضة معا، فلا يوجد أي شك في أن النظام المافيوي قد نجح في أن ينفذ تهديده: الأسد أو نحرق البلد. بل ذهب، في ذلك، إلى أبعد مما كان من الممكن لأكبر المتشائمين تخيّله، فدمّر مؤسساته ووزّع موارده على حماته من الدول التي جاءت لنجدته، حتى تحوّلت أراضيه إلى حقل منذور للحروب الإقليمية والمواجهات الدولية، مزروع بمئات القواعد العسكرية ونقاط المراقبة الأجنبية، وإلى ميدان تدريب واختبار للجنود وللأسلحة الجديدة الروسية والإيرانية والإسرائيلية والأميركية. لكنه خسر مقابل ذلك ملكه وتحوّل، بأشخاصه ومؤسساته، إلى قناة لسلطة احتلال متعدّد الأطراف، ودليل مليشياتها، وتغطية قانونية لانتهاكاتها الشاملة حقوق السوريين وسيادتهم.
ولكن النتيجة الأبرز لهذا النصر الملتبس كانت أسوأ من هزيمة، بمقدار ما عنى استمرار الحرب ومآسيها في كل مكان، تحت سيطرة النظام وفصائل المعارضة سواء، بالإضافة إلى تحوّلها إلى حرب بالوكالة، وقودها السوريون ومستقبل أجيالهم ووطنهم، ومخرجاتها تعميق الشرخ فيما بين جماعاتهم حتى أصبح من المشروع التساؤل، كما يفعل كثيرون، فيما إذا كان لا
يزال لدى السوريين ما يكفي من الثقة للعودة إلى العيش المشترك، بل والحديث عن وطن واحد قادر على احتضان جميع أبنائه، بينما لا تكفّ معالم الانقسام والتقسيم عن الانغماس عميقا في القلوب والمشاعر والتطلعات قبل أن تتجسد في الواقع وتفصل بين مناطق وعوالم تنكر بعضها بعضاً، وترفض أن ترى الواقع والحاضر والمستقبل إلا من خلال ما تعيشه من مخاوف وتتغذى به من أوهام.
ومع ذلك، لم يفقد السوريون الأمل أبدا، حتى في مخيمات التشرّد والمنافي والعراء، لا يزالون مؤمنين بأنهم لم يقولوا كلمتهم الأخيرة، وإنهم على الرغم من التدخلات الأجنبية المستمرة هم وحدهم الذين سيصنعون في النهاية قدرهم. وبدل أن ينتظروا التشجيع من قادتهم، يبادرون هم أنفسهم إلى تشجيع من شبّه لهم أو من ظهرت عليه في هذا الوقت أو ذاك علامات القيادة والشجاعة، ويدعونهم إلى أخذ المبادرة. بينما يكاد الشعور بالعجز لا يترك لعناصر النخب السياسية سوى اليأس والإحباط.
وفي النهاية، يمكن القول، باختصار، بعد تسع سنوات من الثورة التي أريد لها أن تتحول، وقد تحوّلت بالفعل، إلى حربٍ دولية وأهلية معا، يدفع ثمنها السوريون من مختلف الاتجاهات، لكن على أرضية الصراعات والأجندات الدولية، أن كلينا ربح رهانه وانتصر على أخوانه، لكننا خسرنا جميعا وطنا وسلاما وأمنا وربما مستقبلا. والتحدّي الذي نواجهه الآن هو امتلاك الشجاعة لوضع حد لهدر الأرواح والموارد، والبحث عن الحلول الناجعة لتجاوز أسباب الانزلاق نحو الحرب، والرهان على وعي جميع السوريين وقدرتهم على التسامي على آلامهم والتضحية من أجل مستقبل أبنائهم، لإرساء أسس التفاهم والمبادئ التي ستقوم عليها سورية الجديدة، بعيدا عن التمييز والظلم والاستبداد والاستقواء بالأجنبي، فلم يعد من الممكن اليوم تحقيق الديمقراطية، ولا القضاء على الديكتاتورية وإزالة الظلم الواقع على الجماعات الدينية أو القومية أو القبلية، من دون استرجاع السوريين حقهم الأول في ملكية وطنهم الذي يكاد يسرق منهم، إن لم يحصل بعد. فقد أصبح من الواضح، في نظري، أن ما يجري في سورية منذ تسع سنوات هو عملية سطو مسلح لعصابة من الدول على شعبٍ ممزق، لطرده من وطنه وانتزاع أرضه، وإحلال شعب أو شعوب وجماعات غريبة مكانه، واستخدامه، موقعا وطوائف وبشرا، أدوات في خدمة المشاريع الجيوستراتيجية لهذه الدول، وكل ذلك بموافقة السلطة العائلية القائمة وتعاونها، سواء كان هذا التعاون عن جهل وحمق أو بسبب رغبة بدائية لا ترتوي في الانتقام. لذلك لا أحد يشكّ اليوم في أن هذا التدخل والتوطن العسكري والبشري المتوسع في الأرض السورية لا يحصل إرضاءً لسلطة شاذّة، يعترف الجميع بسفاهتها وفسادها ومحدودية تفكيرها. إنه يعني بالعكس، إنهاء الوكالة الحصرية التي تمتعت بها عائلة الأسد لإدارة أحد أهم المواقع الجيوستراتيجية شرق المتوسط، بسلطاتٍ استثنائية، ولخمسة عقود، لقاء ضمانها إخضاع الشعب السوري وتحييده في معادلة القوة الإقليمية. كما يعني وضع سورية منذ الآن تحت الإدارة المباشرة للدول التي شاركت في استعادته من بين أيدي الشعب الثائر، تتقاسم ريعه فيما بينها، وتتنازع عليه في الوقت نفسه.
والسؤال: هل لا يزال هناك أمل في رأب الصدع، والتغلب على مشاعر الحقد والضغينة والكراهية التي أنتجتها سنوات، بل عقود طويلة من العنف والاستئثار بالحكم وسوء استخدام السلطة؟ وما هي احتمالات وفرص عودة السوريين، من مختلف المشارب الفكرية والسياسية والدينية، إلى منطق التعاون والتكاتف في سبيل الهدف الأسمى المتمثل باسترجاع حقوقهم الجماعية، كما فعلوا في مواجهة الاحتلال الأجنبي في النصف الأول من القرن الماضي؟ وقبل ذلك هل تستطيع نخبهم العاملة في السياسة، والطامحة إلى قيادة المرحلة المقبلة، بما تضمه من جيل المعارضة القديم وجيل الناشطين الجديد الذي ولد من رحم الثورة، وفي معاركها وأهوالها، أن تتجاوز خلافاتها وتوحد إرادتها وجهودها للسير بالشعب والبلاد إلى بر الخلاص، بعيدا عن الانشغالات والمعارك الصغيرة التي تشتت وعيها وتفتت جهودها وتهدر طاقاتها؟ كيف أو ما هو الطريق إلى ذلك؟
هذه هي الأسئلة الرئيسية المطروحة اليوم على السوريين من كل المواقع والانتماءات والتطلعات، والتي تشكل الإجابة الناجعة عنها مفتاح المستقبل السوري، وأوراق الاعتماد في يد الطامحين إلى تبوّؤ مركز القيادة الوطنية التي يتطلع لولادتها أكثر السوريين، على جميع مستوياتها الفكرية أو السياسية أو العسكرية. كما تشكل المدخل إلى حل أو مواجهة مشكلة الاحتلالات الأجنبية، ومن ثم تحقيق التغيير السياسي والانتقال من نظام التعسف وسلطة الأمر الواقع إلى نظام سياسي يعكس إرادة السوريين، ويستجيب لتطلعاتهم، التي لا تختلف عن تطلعات شعوب العالم كافة اليوم.
2
بالتأكيد، لن يكون من السهل على جمهور فقد أو كاد لغة التواصل بين جماعاته، الطائفية والقومية والثقافية، أن يحرّر ذاكرته من صور الغدر والخيانة التي رافقت مسيرة الحرب الطويلة الماضية، ويفتح صفحةً جديدة في تاريخ مشترك لا توجد بعد إشارات قوية على إمكان كتابته. هذا على الأقل ما تشير إليه تعليقات وردود وحوارات كثيرة يتداولها السوريون على وسائل التواصل الاجتماعي، كما تؤكد معظم التحليلات والنقاشات التي تدور بين أوساط النخبة السورية، والتي تكاد تجمع على أنه لم يعد لسورية، بعد المقتلة الكبرى التي عرفتها في السنوات الماضية، أي مستقبل مشترك على الأغلب، وربما انتهت إلى الأبد.
ومع ذلك، لا ينبغي أن نخلط بين خطاب الحرب ومنطقها، ونحن اليوم في أسفل مراحل الحرب وأكثرها مشقّة وشقاء، مع خطاب حالة السلام ومنطقه. ولا يشك أحد بأن الميل إلى السعادة والتعلق بالحياة يظل الأقوى عند المجتمعات، وبشكل خاص تلك التي تعرّضت لمعاناة قاسية واستثنائية، بما في ذلك حرب الإبادة الجماعية.
وهذا الميل الطبيعي هو الذي يفسّر همود مشاعر النقمة والانتقام سريعا بعد وقف الأعمال العدوانية، والنزوع إلى التحرّر من العواطف السلبية والتقاليد المحافظة، وذلك ببساطةٍ لأن قيمة الحياة تظهر على حقيقتها، وبشكل أقوى بعد انتهاء الحروب التي تزهق فيها أرواح كثيرة، ويصل فيها الشقاء إلى مستوياتٍ غير محتملة. وليس هناك سوى الأمل في حياة جديدة ما يحرّر الأفراد الذين سكن القلق والرعب والجوع قلوبهم سنوات، ما يعيدهم إلى الواقع، ويشعرهم بوجودهم وقيمتهم. ولهذا غالبا ما يظهر الضحايا أكثر استعدادا لأن يغفروا لجلاديهم بعد نهاية الحروب من أولئك الذين لم يشاركوا فيها، فكثيرا ما يحول هؤلاء، لسبب أو آخر، معاناة الضحايا إلى رأسمالٍ يوظفونه في خدمة مآربهم السياسية، وأحيانا الاقتصادية، عندما يطالبون بتعويضاتٍ أو منافع أو امتيازات يستفيدون منها خاصة.
والأمثلة على تفوّق روح التسامح لدى الضحايا على مشاعر الحقد ونداءات الانتقام، من دون أن يعني ذلك الانتصار دائما عليها، كثيرة. وأقواها وأكثرها مغزى نهاية النظام العنصري الذي سيطر على جنوب أفريقيا قرونا عديدة، فالأفارقة الذين مارست عليهم الأقلية البيضاء شتى أنواع العنف لتقضي على مقاومتهم وتحويلهم إلى عبيد يخدمونها لم يتردّدوا في إظهار تسامحهم مع جلاديهم، حالما قبل العنصريون البيض تفكيك نظامهم العنصري والعيش بسلام في دولة جنوب أفريقية ديمقراطية تساوي بين جميع أبنائها. لم يقل أحدٌ عن هؤلاء السود أنهم نسوا عذابات أجدادهم وآبائهم وإخوانهم الذين حرموا مئات السنين من المعاملة الإنسانية، ولا أنهم فقدوا كبرياءهم وكرامتهم، وقبلوا بالتخلي عن حقهم في الانتقام، بل بالعكس من ذلك تماما. لقد نظرت الشعوب جميعا، بما فيهم جلادوهم العنصريون، إلى تغاضيهم عن حقارات خصومهم التاريخية على أنه تجسيدٌ لسموهم الأخلاقي، ونضج وعيهم السياسي، وتفوق حسهم الإنساني. وكتب اسم مانديلا الذي أصبح رمزا لهذا السمو والتفوق السياسي والأخلاقي لشعب أفريقيا الجنوبية في سجل الخالدين من صانعي تاريخ الإنسانية.
والمثال الثاني من رواندا، البلد الذي شهد بين 1990 و1994 حربا أهلية دموية بين قبيلتي الهوتو والتوتسي، راح ضحيتها مليون ضحية، وحطمت بنياتها ومؤسساتها، وأصابت اقتصادها بالخراب. ونزح عنها أصحاب الكفاءات والرساميل جميعا، حتى وصل متوسط الدخل السنوي للفرد إلى أقل من 30 دولارا. ولكن كانت تكفي خمس سنوات لنظام الحكم الجديد الذي حقق السلام، حتى نسي الناس أحقادهم وثاراتهم، وحولوا بتعاونهم رواندا من أرض خراب وموطن حروب قبلية همجية إلى القُطر الذي يتمتع بأعلى معدل نمو على المستويين الأفريقي والعالمي. وكان الفضل في ذلك للحكومة التي وظفت الثقة التي أولاها لها الشعب المُدمى في تطبيق سياسات تنموية جريئة، راهنت فيها على حشد الطاقات المبدعة لشعبها من كل المناطق والإثنيات، وشكلت المجلس الاستشاري للاستثمار والتطوير الذي ضم ذوي الكفاءات العليا من الروانديين المنتشرين في العالم، وعاملتهم من دون تمييز، فصارت رواندا مثالا للانتقال الناجح من بلد الحروب والنزاعات القبلية إلى أرض السلام والأمن والاستقرار، ومن بلد النزوح الجماعي إلى أحد أهم المقاصد السياحية في أفريقيا، ومن الفقر والبؤس والبطالة إلى أحد أكثر عشرة بلدان أفريقية استقطابا للاستثمارات، ومن أكثرها تقدما وانفتاحا على العالم. ومن النادر أن يذكر اسم رواندا اليوم في التقارير الدولية من دون إضافة صفة المعجزة إليه، بمقدار ما أصبحت مثالا حيا لقدرة الشعوب، عندما تتوفر لها القيادة المخلصة، على تجاوز مصاعبها وانقساماتها.
ما سهّل هذا الانتقال من الحرب إلى السلام في الحالتين هو تحقيق العدالة، وفي مركزها الاحترام المتبادل والمساواة في الحقوق والواجبات، والاعتراف بمعاناة الضحايا وتعويضهم ومحاسبة الجناة على جرائمهم، في إطار ما تسمى اليوم العدالة الانتقالية التي تعنى بتطبيق قوانين استثنائية للعدالة، تأخذ بالاعتبار ظروف الحرب وطبيعة النزاعات الأهلية. فتحقيق العدالة هو الشرط الأول لتحقيق السلام، ليس لأنها تساعد على تحرير أهالي الضحايا والذين عانوا من ويلات الحرب من كوابيس ذاكرتهم، وتمكنهم من إنجاز الحداد على ضحاياهم وماضيهم القريب فحسب، ولكن لأنها تعفيهم أيضا من واجب الثأر والانتقام، وتحول دون أن تصبح الجريمة أمرا عاديا، لا يمكن أن تقوم معها حياة اجتماعية طبيعية.
لا أذكر هذا على سبيل الدعوة الأخلاقية، وإنما وصفا لواقع حي وعبرة تستحق التأمل. لكنني ذكرته أيضا لأشير إلى أن الاستمرار في القتال ليس الخيار الوحيد، بل ليس خيارا منطقيا على الإطلاق، وأن الشعوب قادرة، إذا وجدت من يأخذ بيدها من أصحاب الثقة والمسؤولية، ويحول بينها والجماعات المتطرّفة التي لا تعتقد أن هناك حلاً ممكناً لنزاعها أقل من الإبادة الجماعية للطرف الآخر، على السمو بمشاعرها وأفكارها، والبحث عن فرص التفاهم من حول أهداف وغايات نبيلة ومشتركة، والتعاون في إعادة البناء السياسي والعمراني لوطنها ومجتمعها.
فبعكس ما تسعى إلى تأكيده تحليلاتٌ تبسيطية أو مغرضة، تروّج نظريات خطيرة وخاطئة، ليس للتنوع القبلي والطائفي والقومي، بحد ذاته، أي دور في اندلاع الحروب الأهلية التي عرفتها مجتمعات عديدة. بالعكس، يشكل التنوع أحد مصادر ثروة الأمم وقوة ابتكارها وعظمة مدنيتها، ويكفي للبرهنة على ذلك النظر إلى تاريخ الإمبراطوريات التي كانت الحاضنة الأساسية للحضارات الكبرى وموطن إخصابها، من إمبراطوريات سورية القديمة وما بين النهرين إلى الصين والهند، فالتنوع هو خاصية الأمم الأعظم اليوم، وفي مقدمها الولايات المتحدة الأميركية، التي تكاد تكون دولة التعدد القومي والديني والمذهبي والإثني بامتياز. وهذا لا يعني أن التنوع لا يقود حتما إلى الحروب الأهلية فحسب، وإنما يعني أكثر من ذلك أن هذه الحروب ليست نابعة من تعدّد الثقافات، ولا هي حتمية في أي مجتمع، وإنما هي صناعة سياسية، تلجأ إليها عادة نخب “مزنوقة” أو مأزومة تحاول فك عزلتها، وفتح طريق للنجاة من مصير محتوم، قادها إليه فسادها وظلمها وإفلاس سياساتها، لكن على حساب دماء شعوبها وحقوقهم ومستقبلهم، فهي لا تهدف من زجّ الشعوب في حروب داخلية إلا إلى حرف أنظارها عن مسؤوليتها هي في خلق المشكلات المستعصية على الحل، ودفعها إلى تفريغ شحنة غضبها في قتال بعضها بعضا، وفي خلط الأوراق السياسية والاجتماعية للبقاء في الحكم، واستعادة شرعية مصطنعة باسم الحفاظ على الأمن، تمكّنها من العودة إلى استخدام العنف على نطاق أوسع، وتحويله إلى أسلوب حكم.
باختصار، قليلة هي الشعوب التي لم تعرف الحروب الأهلية وغير الأهلية في تاريخها. وعلى طريقة إنهائها والخروج منها توقف، في أغلب الأحيان، مستقبلها، إما العودة إلى التفاهم والتعاون والاتحاد والتقدم إلى الأمام كما حصل في رواندا، وقبلها جنوب أفريقيا أو السقوط في الفوضى والانقسام والعنف المعمم، كما هو حال أفغانستان والصومال وأقطار كثيرة أخرى.
3
هل يمكن أن يأمل السوريون بمخرج “مشرّف” من الحرب الراهنة يوفّر المزيد من المعاناة والخسائر البشرية والمادية، وينقذ سورية من المصير المشؤوم لميدان حروب داخلية وخارجية لا نهاية لها؟ الجواب ببساطة أنه لا توجد نزاعات مستعصية على الحل. إنما توجد عقبات ومصاعب ينبغي تذليلها لشق طريق السلام. وهنا أود التركيز على عقبتين كأداءين بالفعل، الأولى الانخراط الدولي الواسع النطاق في هذه الحرب، حتى لم يعد للسوريين مكان فيها سوى الالتحاق بالاستراتيجيات الدولية المتصارعة، وصعوبة توصل السوريين إلى تفاهمٍ معها، وربما صعوبة توصل هذه الدول الأجنبية فيما بينها إلى تفاهم يوفر الحد الأدنى من شروط العودة بسورية إلى السلام. والثانية نزوع أغلب السوريين إلى تجاهل وجود مشكلات وقضايا تثير النزاع الداخلي، أو الاستهانة بكثير مما برز منها خلال الحرب، وبسببها أيضا، على منوال هؤلاء الذين يردّدون دائما إننا كنا عايشين ولم يكن هناك ما يعكر صفو حياتنا، أو أولئك الذين يصرّون على أن الخلافات الدينية والقومية والمناطقية التي تجلت بشكل واضح خلال الثورة لم تكن سوى خلافات مصطنعة أو ناجمة عن التدخلات الأجنبية. وهذا ما يمنع الاعتراف بها، ولا يشجع على التفكير فيها بموضوعية ومواجهتها بشجاعة في سبيل بلورة وعي مشترك بها والتداول في إيجاد الحلول الناجعة لها. وربما تطلب هذا بداية الفصل بين أسباب النزاع الخارجي والداخلي وعدم الخلط بين رهاناتها المختلفة أو التغطية على واحدها بالآخر.
ولأنني لا أعتقد أن في مصلحة الدول المنخرطة في الحرب السورية التوصل إلى تفاهم بينها، ولا إلى حلولٍ للقضايا المثيرة للنزاع بين السوريين، بل إنها تسعى، بالعكس، إلى تعقيدها وصب مزيد من الزيت عليها، لاستخدامها في تنفيذ خططها الخاصة، فلا أرى مدخلا لمواجهة مسألة الخروج من الحرب المستعصية على الحل، حيث تحوّلت سورية إلى ساحةٍ لاستعراض عضلات القوى الإقليمية والدولية، سوى في يقظة السوريين أنفسهم، وسعيهم الجدي إلى التوصل فيما بينهم لمثل هذه التفاهمات المشتركة. وليس هناك طريق آخر لذلك سوى مواجهة القضايا المثيرة للنزاع، والتعرف الصحيح عليها، وتقديم التنازلات المتبادلة التي تساعد على حلها، من دون تلكؤ أو انتظار أن تقوم الدول الأجنبية/ المحتلة بهذه المهمة، لأنها كما ذكرت لا تملك الرغبة ولا المصلحة في ذلك، وربما ليست قادرة عليه. وهذا يعني أن النظر في خلافاتهم هي مسؤولية السوريين وحدهم، وحلها أو وضع الأسس الواضحة لحلها، وعدم انتظار الوسطاء الدوليين، هو الشرط الذي لا غنى عنه لمواجهة التحدّيين الأكبرين: تحدّي الاحتلالات الأجنبية واستعادة السيادة على الأرض، وتحدّي بناء النظام الديمقراطي الذي يجسّد هذا التفاهم، ويضمن تعميقه وولادة الوطنية السورية التي يشكو كثيرون من غيابها.
وسوف أكتفي هنا في التذكير بهذه القضايا الرئيسية، على أمل العودة إليها بالتفصيل في مقالات لاحقة. وأهم هذه القضايا التي تحتاج إلى حوار موسع بين السوريين، جمهورا ونخبا، هي: العقدة الطائفية وعلاقة الأديان والمذاهب بنظام الحكم، ومكانة الطائفية في الصراع السياسي الراهن، والعقدة الإسلاموية ودور الحركات الإسلامية المتطرّفة والمعتدلة في إثارة المخاوف من الثورة الشعبية وعليها، ومن التحول الديمقراطي أيضا، والتمييز بين الإسلام والحركات الإسلامية، والمسألة الكردية السورية التي تفتح على مسألة الهوية والمسألة القومية وعلاقتها بالدولة الحديثة وبالديمقراطية، ومسألة العلاقات الإقليمية والدولية ومكانتها وموقعها في إعادة بناء السياسة السورية، والمسألة السياسية بما تمثله من تحديد الخيارات والتوجهات الفكرية والعقدية والاجتماعية والاقتصادية للدولة الديمقراطية المنتظرة، وأخيرا الأخلاقيات المدنية التي من دونها لا توجد ضوابط للعلاقة بين الأفراد أو بالأحرى حوافز لاتحادهم وراء هدف أو قضية.
تنشأ النزاعات والحروب، والثورات هي نوع من الحروب السياسية التي قد تصبح مسلحّة أيضا، من حول مصالح تعبر عن نفسها عادة ضمن قضايا أو مسائل، يصوغها أصحابها حسب معطياتهم الفكرية والسياسية والظرفية، ويضيفون إليها أحلامهم وأمنياتهم، وربما جزء من معاناتهم التاريخية، وهي تنير طريقهم، وتوجه سلوكهم تجاه الجماعات الأخرى. وصياغتها تنطوي بالضرورة على قسط كبير من الذاتية والحسابات الأنانية التي تنعكس، في تعدّد السرديات التي ينطوي عليها أي نزاع اجتماعي. وتعكس لذلك أشكالا مختلفة من التجاهل أو إساءة التقدير لمصالح منافسة أو المبالغة في عرض مصالح أصحابها وحقوقهم. ولا يمكن التوصل إلى تفاهم بين الأطراف المتنازعة إلا بإخضاع هذه السرديات لمناقشة مفتوحة وتقييم متبادل، تعيد أصحابها إلى الواقع، وتحدّ من الشطط في الأحلام والتمنيات على حساب مصالح الآخرين وحقوقهم، وتساعد على التوصل إلى حلولٍ عادلة، تقوم على توازن المصالح وتجنب طغيان واحدتها على الأخرى. هذه هي الخطوة الأولى التي لا مهرب منها للتقدّم على طريق السلام وضمان نهاية غير كارثية للحرب.
العربي الجديد
————————————
المعارضة السورية .. ضرورة تصحيح البوصلة/ علي العبدالله
مع حلول الذكرى التاسعة لانطلاق ثورة الحرية والكرامة، تثور أسئلة سوداوية عن المصير والمستقبل، في ضوء المعطيات القائمة أمنيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا؛ وأسئلة عن سبل الخروج من تحت الأعباء الثقيلة والكثيفة التي ترتبت على سياسات النظام الحاكم والقوى الإقليمية والدولية التي دعمته في خياره المدمر للدولة والمجتمع، وعما يستدعيه ذلك من المعارضة السورية، بقادتها وكوادرها ومثقفيها، كي تستطيع لعب دور إيجابي في معركة الخروج من هذا الحال، ووضع البلد على طريق الحرية والكرامة والعدل والمساواة وسيادة القانون والحريات العامة والخاصة، والفصل بين السلطات والمواطنة، في دولةٍ حديثة ونظام ديمقراطي، هدفها المعلن منذ سنين.
لم يكن المسار الذي اتخذته الثورة السورية المجيدة قدرا محتوما، بل نتيجة منطقية وموضوعية لطبيعة القوى الشعبية التي فجرتها، ببنيتها السياسية والثقافية والنضالية الهشّة، من جهة، وللدور الهامشي الذي لعبته المعارضة الحزبية وعجزها عن الالتحام بالثورة وقواها الشعبية، ولعب دور مباشر في فعالياتها الميدانية والمساهمة في التخطيط والتنظيم والحشد السياسي والإعلامي المحلي والإقليمي والدولي، من جهة ثانية، وقوة التدخل الخارجي ونقله الصراع من صراع في سورية بين معارضة سلطة مستبدة وفاسدة إلى صراع على سورية بين قوى إقليمية ودولية، من جهة ثالثة. فالمعارضة الحزبية؛ موضوع هذه المساهمة، بمنطلقاتها العقائدية وبرامجها السياسية وممارساتها العملية التي تبنتها، وقد حوّلتها إلى بقرة مقدسة طوال عقود سابقة على انفجار ثورة الحرية والكرامة، لم تكن جاهزة لدور كبير ووازن في الثورة، في ضوء نظرتها السياسية إلى المشهد السياسي المحلي والإقليمي والدولي، وانطلاقها في التعاطي مع الموقف السياسي المحلي من مسلّمات مرحلة النضال الوطني التي لم تنجح في تجاوزها، حيث بقيت في تحليلها وتقديرها للموقف محكومةً بأولوية التحرّر من الاستعمار والإمبريالية والصهيونية، وتحقيق السيادة الوطنية وإقامة نظام وطني مستقل؛ والنظر إلى النظام الحاكم باعتباره جزءا أصيلا من قوى التحرّر الوطني، السوري والعربي؛ واعتبار التناقض معه ثانويا، يمكن تجاوزه عبر الانخراط في حوار وتعاون وتحالف معه، لتحقيق الهدف الأكبر: التحرّر الوطني وتحقيق السيادة الوطنية. فالأحزاب ذات الخلفية الماركسية اعتبرته نظاما تقدّميا ومناهضا للإمبريالية، والأحزاب ذات الخلفية القومية اعتبرته نظاما عروبيا، واقتصر تحفظها، الأحزاب، عليه في جزئية الانفراد في السلطة وعدم
إشراكها في إدارة الحكم. تجلى ذلك بوضوح في البرامج التي صدرت في بدايات الألفية الثالثة، “البرنامج السياسي للتجمع الوطني الديمقراطي في سوريا”(2001)، و”البرنامج السياسي العام” لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي (2003)، و”موضوعات المؤتمر السادس للحزب الشيوعي السوري- المكتب السياسي” (2004)، غيّر اسمه بعد المؤتمر فأصبح حزب الشعب الديمقراطي، حيث جاءت على شكل خطوط عريضة وتصورات عامة وعدم القطع مع النظام وممارساته وتجاوزاته، فقد بقيت تعتبره في الصف التقدمي والعربي؛ قدم كاتب هذه السطور قراءات نقدية لهذه البرامج ولـ “الميثاق الوطني في سوريا”، وثيقة جماعة الإخوان المسلمين في سورية (2002)، في حينه. كان نائب رئيس الجمهورية، عبد الحليم خدام، قد أضاء لها الضوء الأحمر في محاضرته في جامعة دمشق فبراير/ شباط 2001 باتهامها بدفع سورية نحو الجزأرة والصوملة، لكن ذلك لم يستفزّها ويدفعها إلى الخروج من طمأنينتها، ورهان بعضها على وعود الرئيس الجديد، بشار الأسد، وتجاهلها الطريقة التي وصل فيها إلى السلطة، وأثرها على النظام الجمهوري، ومستدعياته الأولية التي تتعارض مع التوريث؛ حيث لم تصدر عنها بعد ذلك وثائق أو برامج تغطّي المتغيرات التي حصلت في الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية، أو دراسات تقوّم التوجهات الجديدة للنظام ومآلاتها، في ضوء انقلابه على وعوده العامة، وعودة التشدّد والقبضة الأمنية والاعتقالات، وتنشيط محكمة أمن الدولة سيئة الصيت، وأحكامها الجائرة، وتكريس السلطة الأسرية والمحسوبية والفساد ونهب المال العام تحت راية “اقتصاد السوق الاجتماعي”، في تجويفٍ كامل للدولة، بالقضاء على عموميتها وحياديتها، حتى إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي؛ الذي ضّم، عند قيامه عام 2005، أوسع تحالف معارض، لم ينجح في تلافي عيوب التشكيلات السياسية السابقة ونواقصها بوضع تصور سياسي وبرنامج عملي للوصول إلى هدفه: نظام ديمقراطي.
لم تنجح أحزاب المعارضة في التعاطي مع المتغيرات المحلية، في ضوء هشاشة بنيتها الفكرية والتنظيمية. ولعب الضغط الأمني دورا وازنا في تكريس هذه الهشاشة، حيث بقي حجمها صغيرا، بالقياس لعدد السكان، وانتشارها محدودا، اقتصر على تجمعاتٍ في عدد من المدن الرئيسة. لم تحاول التعمّق في فهم بنية الوعي السياسي ومحدّداته في التجمعات الشعبية، والعمل على اقتحامها، فافتقرت لمعرفتها ولتقدير حدة احتقانها وتوترها الداخلي، وردود أفعالها المحتملة على سياسات النظام، وانعكاساتها على حياتها وإحساسها بعدم الأمان. وقد برزت سلبية ذلك في الأيام الأولى للثورة، حيث ظهرت غربة الأحزاب عن الجماعات والتجمعات التي خرجت في التظاهرات؛ وتعمّقت الغربة بعد عجزها عن مد جسور التواصل معها، والالتحام بها، والانخراط في الثورة ومعاركها السياسية والإعلامية، ما أفقد الثورة فرصة الاعتماد على أطر للتنسيق والتشبيك، وغرف عمليات وإدارة جاهزة، ما اضطرّها لإقامة هذه الأطر بجهد ذاتي، عبر تشكيل تنسيقياتٍ بقيت هشّة، نتيجة حداثة التجربة وعدم وجود سوابق عملية ومعرفة وثيقة بين المساهمين في إقامتها، وهذا تجلى في أهم عيبين ظهرا في مسيرة الثورة:
الأول، غياب تنسيق عميق وقرار جماعي لفعاليات الثورة وخططها المستقبلية، ما حوّل الحراك الشعبي إلى حراك مناطقي محكوم بقوى محلية وقدرات سياسية وتنظيمية ضعيفة، وتحوّل المناطقية إلى مقياس معتمد في العلاقات بين القوى والمناطق، وقاعدة لمطالب وأدوار في مؤسسات المعارضة التي نشأت لاحقا، وفي تقاسم الدعم الخارجي.
ثانيا، غض النظر عن عيوب الثوار وأخطائهم، وتأييد ما يحصل فيها، أو السكوت عنه، ليس من باب الاقتناع بصحته وسلامة منطلقاته ومآلاته، أو القبول بما يحصل؛ بل تأييدا انتهازيا على أمل تحصيل مقعد في الثورة، والمشاركة في صياغة سورية الجديدة التي ستقوم بانتصار الثورة الحتمي. وهذا قاد إلى تراكم الأخطاء والتخبط والعجز عن الاستدراك ومراجعة مسيرة الثورة وترشيد خطواتها اللاحقة.
تحتاج أحزاب المعارضة لإعادة نظر في توجهاتها العامة وتصوراتها السياسية وإقامة رؤية جديدة، في ضوء دراسة المجتمع السوري ببناه الاجتماعية والدينية والمذهبية وسياسات النظام في رده على الثورة ومطالبها، وانعكاس ذلك على المجتمع والدولة ومستقبلهما، وتحديد أرضية معلوماتية ومفاهيمية للتحرّك واستدراك الأخطاء ومواجهة العقبات، وإعطاء مساحة أكبر للجانب العملي، والتخفف من آليات عملٍ أساسها الاجتماع خلف أبوب مغلقة، على أمل تعديل المسار، والانطلاق نحو إعادة مطالب الثورة إلى الطاولة، لأخذها بعين الاعتبار من القوى الإقليمية والدولية المنخرطة في الصراع على سورية.
وهنا يرى كاتب هذه السطور أن أول القضايا التي تحتاج إلى إعادة نظر الموقف من الأديان بعامة، والإسلام بخاصة، لما له من موقع مركزي ودور في تكوين شخصية السوري، وانطوائه على طاقة ثورية عظيمة، ودفع قوي للتضحية في سبيل العقيدة والقيم الأخلاقية، ولموقعه في وعي المواطنين وخياراتهم وتفضيلاتهم؛ وعدم تركه لحركات الإسلام السياسي، توظفه في الحشد خلف رؤاها السياسية والاجتماعية، ما يستدعي تليين النظرة العلمانية المنطلقة من اعتبار الدين أساس اغتراب الإنسان، وتحطيم ذاته وتمزيق شخصيته، واعتبار نبذ الدين وإخراجه من الحياة ونظمها وقوانينها مهمة أولى ورئيسة على طريق التحديث والديمقراطية، بتجاهل تام للدور الذي لعبه الدين وما زال في حياة الإنسان، الفرد والجماعة، وتجاهل ظاهرة تعدّد أنماط العلمانية في التجربة الغربية؛ فهناك النمط الفرنسي المتصلّب، يوصف باللاديني، أو اللاييكي بالفرنسية، الأثير على قلوب علمانيي بلاد المسلمين، والنمط البريطاني الذي قضى بإعطاء الدين دوراً، وإن كان محدوداً، عبر الاعتراف به في حياة المواطنين ومنح الكنيسة استقلالية وحرية عمل اجتماعياً وسياسياً وثقافياً وإعلامياً، وتعيين 25 رجل دينٍ مسيحيٍ في مجلس العموم البريطاني، والنمط الأميركي المتصالح مع الدين، والمنطلق من نظرة تقول: “إن ثمة إمكاناً لتنظيم العلاقة بينهما وجسر الهوة عبر التنسيق بين فرضياتهما وقيمهما بما يخدم هدفهما المشترك: الإنسان”، ما جعله لا يرى تناقضا بين علمانية الدولة وفرض الصلوات في المدارس الرسمية، وعدم الانطلاق من نظرةٍ أحاديةٍ تقفز على حقائق التاريخ والضرورة الاجتماعية، وتتجاهل مستدعيات التصور العملي والخطة الصائبة بجناحيها: المعقولية والعملية، فالاعتبارات التاريخية والثقافية تفرض احترام العامل الديني، باعتباره عاملا مكونا في شخصية المسلمين وثقافتهم وسلوكهم العام والخاص، والضرورة الاجتماعية تستدعي أخذ التطور المفاهيمي والقيمي والتقني والمؤسسي الحديث في صياغة نظمنا السياسية وعلاقاتنا الاجتماعية خدمة للإنسان في حقوقه وواجباته، بحيث تصبح حياته أكثر أمناً واستقراراً وحرية، ما يستدعي عدم اعتماد مواقف نمطية جامدة واستبعاد هذا العامل أو ذاك، والعمل على جسر الهوة مع الرؤى والقناعات الشعبية ذات الجذر الديني، بالبحث عن تقاطعاتٍ، وطرح تأويلات وحلول وسط تجعل الرؤى والخيارات الحديثة قريبةً من المزاج العام، تمهيدا للدخول في تفاهمات وعقود اجتماعية مناسبة.
العربي الجديد،
—————————————–
سوريا: البلد الذي تتحاشاه النظرات!/ موفق نيربية
منتصف مارس/آذار الحالي، تدخل سوريا عامها العاشر منذ اندلاع ثورة شبابها عام 2011، حين خرجوا إلى الشوارع يهتفون من أجل الحرية والكرامة، ويعلنون كفايتهم من الذل والاستبداد لنصف قرنٍ من الزمان، على يد قادة متوحشين لا يتورعون عن عمل شيء أبداً، ويعتمدون علناً على سمعتهم هذه.
يغرق أطفال سوريا في المرض وسوء التغذية، ويخضعون لظروف التشغيل والتجنيد العسكري، وتزويجهم أطفالاً واستغلالهم جنسياً، ولانعدام فرص التعليم وانقطاع سلسلته لسنوات، بعد أن توقف ثلث المدارس عن استقبال التلاميذ، وبسبب التدمير أو الانشغال بالقوى المسلحة أو النازحين، من مناطق أخرى.
ولا شيء بعدُ في الأفق ينبئ ببصيص أمل لهذا الشعب المسكين، الذي لم يعلن توبته عمّا فعله أبناؤه الثوار الأوائل، رغم كلّ ما حدث له، ورغم تمزيق البلاد إرباً على مرأى من العالم كله. فقد استبدّ الحلم بانتصار حاسم على النظام في عامي 2012- 2013، بالكثير من المعارضين السياسيين، والعسكريين أو من في حكمهم خصوصاً. ولم تستطع تلك الموجة الدولية العارمة التي أخرجت بيان جنيف1 إلى النور في منتصف عام 2012، ولا تلك الموجة العربية التابعة آنذاك، التي كانت حصيلتها إنجازات مؤتمر القاهرة، بعد بيان جنيف بأسابيع قليلة، أن تتغلب على ميول بعض المعارضين إلى استكمال الحسم على الأرض، مدعومين بدول إقليمية لها برامجها أيضاً، ثم بدعم الولايات المتحدة أيضاً، أو بقيادتها لغرفة العمليات المعارضة.
واستطاع ذلك التيار بالفعل أن يتطور ويتقدم إلى أمام، من خلال توظيف الدعم الإقليمي المتعدد في اتجاهات متعددة، تورّمت القوى الإسلامية من خلالها، وتلك الأكثر تشدداً منها بالضرورة، وبتأثير مستلزمات المنافسة والصراع على سوريا والسوريين. وحدث ذلك في العامين التاليين 2014 – 2015، ما جعل دمشق تبدو دانية القطوف في صيف العام الثاني، ولكن للأيدي الأطول والأكثر ميلاً للمغامرة خصوصاً.
فكان أن ظهر التدخل العسكري الروسي المباشر في سبتمبر/أيلول من ذلك العام طبيعياً وعادياً، وربما في مكانه، ليس لأهل النظام وحدهم، بل للعديدين غيرهم من المراقبين، والمتورطين من دون رغبة بمشاهدة حالة متطرفة في دراميتها واحتمالاتها. ولم يكن لذلك إلا أن يؤكد لشباب ربيع 2011- عدداً ونوعاً- صحة انعزالهم النسبي، وللبقية العامة ضرورة اجتياح الحدود المجاورة، ثم حدود أوروبا لاحقاً. في حين أنعش ذلك التدخل والاحتدام حمّى التطرف، وتعاظم حجم وتأثير “داعش” و”النصرة” إلى حدود حاسمة تفرض مجاراتها كلياً أو جزئياً على غيرهما أحياناً.
ولم تخلُ المعارضة هنا أو هناك، والأوساط الدولية الصديقة أيضاً، من بعض تفاؤل بأن يحمل التدخل الروسي بعض الإنعاش لعوامل الحل السياسي، بعد أن كانت القيادة الروسية، قد عكست بعض الحكمة منذ مؤتمر جنيف الأول، وأوحت بأنها لا تتمسك بنظام فاشل إلى حدٍ كبير، وتوافق من ثم على استبداله بهيئة انتقالية كاملة الصلاحيات، ستحاول أن تجعلها لطيفة على النظام وأهله، قدر الإمكان. ازداد ثقل وظلّ الدور الروسي بعد ظهور نتائج التدخل العسكرى السريعة، من خلال موافقة مجلس الأمن على القرار 2254 بعد خمسين يوماً من بدء العمليات. وربما كانت تلك الموافقة الروسية تهدف إلى امتصاص ردود الفعل على المشهد العسكري الفظ آنذاك، فذلك القرار، رغم كل ما أدخله الروس عليه من الغموض، حدّد من جديد مخطط الانتقال السياسي في سوريا، بتشكيل حكومة لاطائفية خلال ستة أشهر، ثم صياغة دستور جديد، فإجراء انتخابات خلال ثمانية عشر شهراً، تحت إشرافٍ أممي، إضافة إلى ضمان إجراءات مكافحة الإرهاب.
ولكن نجاحات التدخل الروسي المتلاحقة، استطاعت تعزيز صلابة الرؤوس الحامية في موسكو، خصوصاً من خلال ظهور ميول الإدارة الأمريكية للابتعاد عسكرياً وسياسية عن القضية المتشابكة. وأصابت تلك الأجواء المتشددة بعدواها رأس النظام وقيادته، التي كانت مراراً على أعتاب اليأس والاستسلام قبل ذلك، فازدادت رفضاً للعملية السياسية، وبناء الخطط على أساس الانتصار النهائي المقبل. فاستحقت المعارضة السورية ما لحق بها، بعد استكبارها في العامين أو الثلاثة التالية، بتحفظ بعضها على العملية السياسية، لتصبح في وضع تتنازل فيه يوما بعد يوم، من دون مردودٍ ولا مقابل.
ولا نظلم المعارضة المتصدرة للمشهد هنا، مع تزايد ضعف تمثيل الشعب السوري في الواقع إلى حدود فاقعة، وازدياد غياب اللون الديمقراطي المدني المعتدل؛ في حين ارتمت أطراف المعارضة الإسلاموية بسعادة وانسجام في أحضان أطراف إقليمية، وابتدأ يظهر عليها ابتعادها عن تأييد طموحات السوريين في التغيير، وبرزت مكانه تكشيرة شامتة بفشل مشاريع تحديث ودمقرطة المنطقة. لم تستطع الأمم المتحدة، رغم تحديث طرائقها بمرونة وتكيّفٍ مرات عدة، أن تجمع طرفي المعادلة السوريين معاً أبداً حتى الآن. كانت ذروة نجاحات ديمستورا في جنيف4، رغم التشاؤم الذي فرضه موقف الإدارة الأمريكية الانسحابي آنذاك، حين استطاع التقاط صورة للوفدين على خشبة مسرح واحدة. وتم الاتفاق في تلك الدورة على بعض إجراءات تتلامس وتتوازى مع خطوط القرار الأممي 2254.
كان طبيعياً ومفهوماً بعد ذلك أن تبدأ علامات الرفض والتعطيل الخرقاء بالظهور في سلوك النظام ووفده، الذي اضطر للذهاب إلى جنيف بعد اللتي واللتيا عدة مراتٍ بعد ذلك، في أجواء تزداد احتفالاً بالانتصارات المتوالية على الأرض، بإسهام رئيسٍ من قبل الجيش الروسي، وطيرانه الحرّ المتطور الحاسم الدور. ولكن الأمر المفاجئ، أو غير المفاجئ أيضاً، هو تزايد الضغوط الداخلية في جهة المعارضة، رفضاً وتشهيراً، مع شبهة تشجيع من أطراف إقليمية لا تجد فرصة لمصالحها في هذه اللحظة، ضمن دائرة العملية السياسية، ولأسباب لا تتعلق بالقضية السورية أبداً، بل بتطورات أخرى، أهمها احتدام الخلاف الخليجي، وبين القطبين اللذين كانا الداعمين الأكبر للمعارضة في الأساس، إضافة إلى بدء تحوّل العدسات إلى ساحاتٍ أخرى، ازدادت أهميتها شيئاً فشيئاً، في ظلّ عطالة المسألة السورية، التي ملّت أطرافها من استثارة الاهتمام الأمريكي بلا جدوى فعلية أو حاسمة.
يُسجّل للأمم المتحدة أيضاً، قدرتها على الالتفاف على تلك الأوضاع، وتطويع مسار أستانة الموازي منذ مطلع عام 2017، باتجاه تطوير أي بنية تجمع السوريين معاً، وتؤسس للمراحل اللاحقة، باعتمادها من قبل الأمم المتحدة. كانت اللجنة الدستورية تلك البنية، بعيوبها الكثيرة، التي لم تستطع مناقشات ومناورات ماراثونية أن تخفف منها كثيراً. ولكن تركيبة تلك اللجنة من الناحية النظرية، وربما من وجهة نظر القانون الدولي، ستسمح لها بأن تكون حقلاً للتفاعل، يمكنه بناء شيء سوري – سوري في المستقبل، ومن أجل المستقبل. وهذا أمل يرى فيه بعض السوريين معادلاً لأمل إبليس بالفردوس، ولكنه الموجود. تحولت معارك قوات لنظام التي ما عادت هي النظام، وقوات المعارضة التي ما عادت هي المعارضة، إلى عبث وموت مجاني، لا يمكن بوجوده تلمّس أي بارقة لوقف شاملٍ لإطلاق النار، والتماس لحظة التقاط الأنفاس منها.. لأن الدولة السورية تهتكت، والبلاد تمزقت، والشعب تفرق في أركان المعمورة.
ولا تنفع نداءات الظفر والنصر هنا وهناك، ولا البكاء على الأطلال أو الزمن الغابر.. ما ينفع – ربما- هو تنشيط الاهتمام الدولي من جديد، وهو الأكثر فعلاً وإمكانياتٍ حالياً، بانتظار أن تثمر محاولات السوريين لتنظيم أنفسهم من جديد، على أسس جديدة، وأرضٍ جديدة، فالنظام تناهى، والمعارضة القديمة تناهت.. ولا بأس بكل ما يوحد ويجمع ويعيد الاجتماع السوري والأمل السوري. ولا يعني ما قيل أعلاه، إننا لا نرفع الصوت عالياً تحيةً لثورة آلسوريين في ذكراها التاسعة.
كاتب سوري
القدس العربي
———————————-
عن المعارضة التي تحولت إلى عبء يثقل كاهل السوريين/ رشيد الحاج صالح
عندما اندلعت الثورة السورية في آذار 2011، لم يخطر ببال السوريين يومًا أن المعارضة السياسية التي تشكلت، ممثلة بالائتلاف الوطني والمؤسسات والمنظمات والوزارات التابعة له، ستتحول إلى كيان ليس له علاقة بتطلعات السوريين وأحلامهم حول دولة الحريات والقانون، التي كانت تراودهم وهم يُقتلون في شوارع المدن السورية، بالمفرق والجملة. لم يخطر في بالهم أن يتحول هذا الكيان إلى مجرد موظفين تعنيهم رواتبهم الشهرية أكثر من أي شيء آخر. ولكن لماذا وصلت درجة استهتار هذه المعارضة بقضايا السيادة الوطنية ووحدة الأراضي السورية وكرامة السوريين إلى مستوًى يشبه المستوى الذي وصل إليه النظام الأسدي؟
لقد فهمت المعارضة السياسية السورية، بعد تشكيل الائتلاف الوطني في نوفمبر 2012، أن فعل المعارضة للنظام الأسدي يقوم على تبني خطاب ضد هذا النظام يفضح جرائمه وسياساته القمعية، وتكوين كيان سياسي مهمته الأساسية هي أن يحلّ محل النظام ويستلم تركته. تقديرات المعارضة انطلقت من أن النظام الأسدي لم يعد مقبولًا دوليًا، وأن المهمة الأساسية هي أن تُقنع المعارضة الأطراف الدولية بأن تحلّ محله. ولذلك يمكن القول إن أول أخطاء معارضتنا أن تفكيرها لم يكن منصبًا على كيفية إسقاط النظام الأسدي والاعتماد على السوريين لتحقيق هذا المسعى، بقدر ما انصب على تجهيز نفسها للحلول محل النظام واستلام السلطة منه، وكأن سقوط النظام سياسيًا أو عسكريًا مسألة محسومة سلفًا، وهو خطأ يشبه من الناحية الاستراتيجية الخطأ المعروف الذي ارتكبه الصحابة في معركة أُحد المشهورة.
قناعة هذه المعارضة بأن ساعة استلام السلطة من النظام مسألة وقت لا أكثر، وأن عليهم الاستعداد لها، وأن الأطراف الخارجية الداعمة لهم، أو ما كان يعرف بأصدقاء الشعب السوري، هي من سيسقط النظام، دفعتهم إلى تفصيل أنفسهم على مقاس تلك الأطراف، لا على مقاس السوريين. بمعنى أنها معارضة تمثل الأطراف الداعمة ولا تمثل الشعب السوري بالدرجة الأولى. تتفاعل مع الأطراف الداعمة، ولا تتفاعل مع الداخل السوري بالدرجة الأولى. تتصرف وفق متطلبات الأطراف الداعمة، لا وفق متطلبات الوضع السوري. تحاول أن تبدد مخاوف الأطراف الداعمة لا مخاوف السوريين بالدرجة الأولى.
هكذا تحول الصراع بين هذه المعارضة والنظام الأسدي إلى صراع على الحصول على الدعم الدولي، وعلى إصدار القرارات الدولية، وعلى التركيز على الإشارات والرسائل والنصائح والتصريحات التي تصدر من القمم والاجتماعات والمؤتمرات التي تتعلق بسورية. بلغ إهمال الوضع الداخلي أن محافظة الرقة التي “تحررت” من النظام عام 2013 لم يفتتح فيها الائتلاف أي مؤسسة تُذكر، وبقيت مهملة إلى أن افترستها (داعش) بشكل كامل عام 2014، حيث سيطر التنظيم على كامل المحافظة بعد تصفية كل الفصائل المقاتلة هناك، ومنها “جبهة النصرة”.
المهمة الأساسية التي تعانيها المعارضات الوطنية عادة هي الحفاظ على استقلال قرارها بدرجة معقولة، وجعل القضية الوطنية ملكًا لها ولمن تمثلهم بالدرجة الأولى، دون أن يعني ذلك عدم أخذ الأطراف الدولية بعين الاعتبار. وهذا يعني أن المعارضة الوطنية عليها أن تستخدم “السياسة” لجلب دعم دولي لمطالب من تمثلهم وليس العكس. المعارضة التي نتحدث عنها قلبت المعادلات، ولم تجد أي مشكلة في التضحية باستقلال قرارها والجري وراء الداعمين والقوى الخارجية، حتى وصلنا إلى وضع تريد فيه هذا المعارضة أن يتكيف السوريون مع كل التفاهمات الدولية، ومقررات المؤتمرات الدولية حول سورية.
بعد ردة الفعل الدولية على استخدام نظام الأسد للسلاح الكيمياوي في غوطة دمشق، في آب/ أغسطس 2013؛ أدرك النظام الأسدي أن الملعب الدولي لم يعد منطقة خطرة. وأن لعبة المؤتمرات التي تعقدها الأطراف الإقليمية والدولية حول سورية ستفضي، بكل بساطة، إلى لا شيء. طبعًا هذا اللاشيء له ثمن يمكن أن يقدمه النظام لداعميه، وهو مستعد لأن يقدم كل ما تطلبه روسيا مثلًا، وأن يسكت عن كل ما تقوم به أميركا داخل الأراضي السورية. ولكن ماذا عن المعارضة؟ في الحقيقة هي، بكل بساطة، لا تعرف إلى أين تسير الأمور. هي فقط تتلقى أوامر، وصلاحياتها تتمثل في تنفيذ ما يطلب منها.
هذه الوضعية الكارثية بالنسبة إلى المعارضة تعود إلى أنها تبنت مفهوم السياسة، من حيث هي “العمل من أجل امتلاك السلطة”، وليس من حيث هي أيضًا عمل سياسي واجتماعي يشرك أكبر قدر ممكن من الناس، بوصفهم موضوعًا للسياسة وشريكًا في المجال السياسي، وأن مصالحهم وتطلعاتهم تشكل، في النهاية، الهدف الأساس من العمل في السياسة. فالمعارضة تبنت مفهومًا أسديًا للسياسة يجعل منها مجرد وسيلة للمساومات وتقديم التنازلات والمحاصصة، لأن السلطة هي موضوع السياسة الوحيد بالنسبة إلى هذه المعارضة.
ولذلك فقد خسرت المعارضة السوريين، قبل أن تخسر أي شيء آخر. حيث توزعت خارطة السيطرة في النهاية بين النظام الأسدي من جهة، والفصائل الإسلامية المسلحة من جهة ثانية. المعارضة خسرت السوريين لأنها، بكل بساطة، لم تسعَ إليهم، فهم موضوع سلطة وليسوا شركاء.
بعد مؤتمر سوتشي في بداية 2018، وضعت المعارضة كل بيضها في سلة اللجنة الدستورية التي يبدو أنها ستحدد مستقبل سورية. النظام الأسدي أما أن يقبل بالدستور الجديد الذي ستكتبه تلك اللجنة، إذا كان سيضمن بقاء بشار الأسد في السلطة، أو يقوم بتعطيل عمل اللجنة، إذا شعر بأنها ستُقِر مواد تشكل خطرًا على بقائه. طبعًا الائتلاف، والقوى المتحالفة معه، والمنصات، لا تملك أوراقًا تذكر، بغية إحداث تغيير حقيقي للوضع في سورية عبر اللجنة الدستورية.
الوضع الذي حشرت فيه المعارضة نفسها، ومن تمثلهم، دفع بكثير من السوريين إلى الحديث عن «الفراغ» الذي عجزت المعارضة السياسية عن ملئه. فالمعارضة هي معارضة، ولكنها في حقيقة الأمر ليست معارضة، حيث إنها لم تعد تمثل من يفترض أنها تمثلهم، وعلى الرغم من ذلك تستمر في التمثيل، على طريقة بشار الأسد الذي يفترض أنه يمثل السوريين، في حين أنه لا يقوم بغير قتلهم وتهجيرهم. هي ليست معارضة، حيث إنها لا تشعر بأنها مسؤولة أمام من تمثلهم، بنفس الطريقة التي لا يشعر فيها النظام الأسدي بأنه مسؤول أمام السوريين، والسبب يعود في الحالتين إلى أن كلًا من المعارضة التي تحدث عنها والنظام الأسدي يشعر بأنه لا يستمد سلطته ممن يمثلهم. السوريون في ذهن الطرفين هم موضوع للسلطة لا أكثر. هم رعايا أكثر منهم مواطنون.
المعارضة هذه لا تعرف، في الوقت الحالي، كيف ستؤول الأمور في إدلب وريفها، وريف حلب، ومنطقة تل أبيض ورأس العين في الجزيرة السورية، وما هي حدود التفاهمات الروسية التركية، وما هي حدود الوجود الأميركي في ريف دير الزور. أما النقطة الأكثر إحراجًا فتتمثل في أن المعارضة ليس لها أي دور يذكر في هذه القضايا، حتى فصائلها تتقدم وتتراجع بحسب توجيهات محددة.
هذه الأوضاع الصعبة التي يعيشها السوريون هذه الأيام دفعت بكثير منهم إلى التفكير في صيغ من حوارات/ نقاشات، بغية تكوين كيانات بديلة للمعارضة الموجودة، كيانات تعمل على مساعدة السوريين في امتلاك قرارهم المستقل، وتخليصهم من النزعة التسلطية الموجودة في مؤسسات المعارضة المهترئة، والعودة للاهتمام بالسوريين، بوصفهم أفرادًا لهم حقوق ومصالح، مثلما تساعدهم في استرجاع أهداف ثورتهم التي لم تعد تعني للمعارضة الحالية أيّ شيء يُذكر. نقاشات تعيد التفكير في مفاهيم السياسة والهويات والطائفية والوطنية والأكثرية والأقلية والقومية، ومختلف المفاهيم السياسية التي تبيّن أنها بحاجة إلى إعادة النظر فيها من جديد، وذلك كله تمهيد للتفكير في عقد مؤتمر سوري عام، نعتقد أنه أصبح أمرًا مطلوبًا اليوم أكثر من أي وقت مضى.
جيرون
—————————————
حان الوقت لتجاوز طفولتنا السياسية/ برهان غليون
(1)
أعادت مأساة إدلب ومعاناة أبنائها إلى الواجهة المشكلة التي نعيشها منذ بداية الثورة السورية، من دون أن نجد جوابا شافيا لها، وهي إيجاد مركز قرار يوجه خطانا، ويثمر جهودنا ويعزّز من صدقية قوتنا السياسية، ويراكم الخبرة الضرورية لانتزاع حقنا في أن نقرّر مصيرنا بأنفسنا، أو على الأقل أن نشارك في القرارات التي تتعلق برسم مصيرنا الوطني، كسوريين. وقد فشلت جميع جهودنا لإيجاد مثل هذا المركز، وبقينا أشتاتا متفرقة، ومجموعات تعمل كل واحدة منها حسب رأيها وظروفها واعتقاداتها، وشيئا فشيئا حسب ما تطلبه منها القوى التي تضمن بقاءها، او حسب ما تعتقد هي أنه مفيدٌ للتقرّب من هذه القوى الخارجية، للحفاظ على موقعها ووجودها.
لا يوجد أي شك في أنه كان للتدخلات الأجنبية الدور الأكبر في تمكين الأسد من خوض الحرب التي فرضها على الثورة، والاستمرار فيها، بفضل ما قدّمه له شركاؤه الإيرانيون والروس من دعم متعدّد الأشكال، لوجستي وعسكري ومالي وإعلامي ودبلوماسي، لا يمكن مقارنته بما توفر لقوى الثورة والمعارضة. ولا يوجد أي شكّ كذلك في أن الغرب الديمقراطي الذي كان الحليف المنتظر للديمقراطيات الوليدة في العالم أجمع، والذي راهن على تدخله قسمٌ كبير من الجمهور السوري الملوّع بعنف النظام، تردّد في الوقوف إلى جانب السوريين، وعمل على تشتيت قواهم بدل مساعدتهم على تنظيم أنفسهم ومواجهة أعدائهم، على الرغم مما كان قد أغراهم به من وعود وآمال، منذ تبنّيه شعار تنحي الأسد. وهذا ما تجلى في افتقار من أطلقوا على أنفسهم اسم “أصدقاء الشعب السوري”، والذين تجاوز عددهم في أول مؤتمراتهم 70 عضوا، للإرادة والاستراتيجية والوسائل اللازمة لردع الأسد عن الاستمرار في حرب الإبادة وانتهاك قرارات مجلس الأمن وتجنيب السوريين الكارثة الإنسانية التي يشكل التملص من عواقبها اليوم سببا جديدا لاستمرار الحرب. ولا يوجد شك أيضا في أثر الإرث السلبي لنصف قرن مما ينبغي أن نسميه حرب الاستنزاف التي خاضها نظام الأسد لتحطيم المجتمع، وقتل روحه وقيمه الإنسانية، في تعميم انعدام الثقة والافتقار إلى الخبرة السياسية والتجارب التنظيمية، ولا في أثر وفعالية الألغام التي زرعتها السلطة المخابراتية بين جنبات المجتمع، والتي احتفظت وحدها بمفتاح تفجيرها في اللحظة المناسبة، لفرط عقده، وتوجيه طوائفه بعضها ضد بعض، وزعزعة إرادة السوريين وإرهابهم.
ولا يوجد شكٌّ أخيرا في الأثر السياسي المدمر لنزوع النخب السلفية إلى تصدّر الخطاب وواجهة الكفاح المسلح، ومحاولة الإسلام السياسي عموما ابتلاع الثورة وتجييرها لحسابه السياسي الخاص، بصرف النظر عن الدوافع والنوايا والتدخلات الخارجية، أقول لا يوجد شكٌّ في أثر ذلك كله على تراجع صدقيتنا السياسية وانقلاب الرأي العام العالمي علينا. وما كان للصعود المدوي لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وإعلانه عن تأسيس “دولة الخلافة”، بعد تمكّنه من الوصول إلى الوسائل العسكرية التي جعلته قوةً يحسب حسابها، ليعيد قلب الصورة تماما، فيحلّ مصطلحات الجهاد والكفر والطائفية والإرهاب محل مصطلحات ثورة الحرية والكرامة والمواطنة والدولة المدنية التعدّدية، ويقضي على أي أمل لنا باستعادة تأييد الرأي العام العالمي، بل العربي، وتعاطفه مع الثورة السورية وشعاراتها التحرّرية.
كل ذلك أصبح من البديهيات المعترف بها من الجميع، لكن البقاء على هذا المستوى من التحليل لا يقدّمنا كثيرا ولا يفسّر، في ما وراء ذلك، التراجع المستمر الذي تشهده قضيتنا، بالرغم من استمرار الشعب في تقديم التضحيات الباهظة. إنه يدفعنا، كما هو ظاهر منذ سنوات، ببساطة، إلى اليأس من قدرتنا على العمل كشعب مستقل، وإلى الاستقالة السياسية والرهان، في خلاصنا على تقاطع المصالح الدولية، أو انتظار المعجزات والتحولات الاستثنائية التي لا نملك أي إمكانية لإحداثها أو التسريع بحصولها.
(2)
ما زلت أعتقد أن مشكلتنا الرئيسية، قبل أن تكون خارجية، تكمن في انقساماتنا الداخلية أولا، وغياب أي استراتيجية مستقلة وفعالة، للعمل على تحقيق الأهداف التي لا نزال متمسّكين بها بعد تسع سنين من التضحيات والمعاناة القاسية ثانيا. ومن يتأمل في ممارستنا السياسية يدرك بسهولة أننا عقدنا العزم على التعايش مع هذه الانقسامات، داخل المعارضة نفسها، والاستغناء عن أي محاولة لبناء استراتيجية مستقلة، تراعي أوضاعنا، وتعتمد على تطوير قوانا الذاتية، وترتبط بحساباتنا الوطنية. وتتلخص استراتيجيتنا الراهنة عمليًا بالرهان على انتظار ما يحتمل أن تنتجه الضغوط الدولية، وعلى ما يمكن أن يصيبنا من مكاسب جانبية، في حال نجحت القوى الدولية التي تؤيدنا في تحقيق أهدافها الوطنية. وعلى احتمال تفاهم دولي يصبّ في مصلحتنا ولو جزئيا. وأخيرا على نتائج العقوبات الاقتصادية على النظام وحلفائه. وبينما يتفاءل بعضنا باحتمال تفاهم روسي أميركي يفتح الطريق المغلق نحو تسوية سياسية ولو بحدها الأدنى، يغذي بعضنا الآخر الوهم في أن تؤتي العقوبات الاقتصادية والسياسية التي وضعها المجتمع الدولي على النظم الثلاث: السورية والإيرانية والروسية، أكلها، وتجبر هؤلاء على الصّدع للإرادة الدولية، ممثلة بقرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى انتقال سياسي، يقوم به السوريون أنفسهم، في وقتٍ أصبح من الصعب فيه تحديد هوية “السوريين”، بل هوية المعارضة السورية ذاتها. ويذهب بعضنا، أبعد من ذلك، إلى أنه لم يعد لنا أملٌ في الخروج بحلٍّ ينقذ آخر ما تبقى لنا من مصالح وطنية سوى الالتحاق بخطط واستراتيجيات الدول التي نعتقد أن بإمكانها أن ترعى بشكل أفضل من غيرها مصالحنا، أو تلك التي تتقاطع مصالحها الوطنية مع إعادة السلام والاستقرار الإقليمي، مع الأمل في أن يرافق وقف الحرب إدخال الحد الأدنى من الإصلاحات السياسية إلى نظامٍ يصوغه الروس على شاكلة نظامهم شبه القيصري.
وإلى حد كبير، تفسر هذه المواقف والرهانات الاستراتيجية الضعيفة انعدام أي نقاش جدّي داخل صفوف المعارضة حول الخط السياسي والاستراتيجية والخيارات الاجتماعية، باستثناء التناحر بين إسلاميين وعلمانيين، والذي يشكل هو نفسه انعكاسًا للاصطفافات الإقليمية، حتى لم يعد من المبالغة القول إن الولاء الخارجي أصبح المحدّد الرئيس لاختلاف المواقف السياسية أو الخط السياسي لمجموعات المعارضة المتعدّدة، كما أظهرت ذلك بجلاء بدعة المنصّات السياسية التي لا تحدد هويتها سوى أسماء العواصم والمدن التي عقدت فيها اجتماعاتها التأسيسية، فلا يتميز “سياسيو” المعارضة اليوم بنوعية توجهاتهم الفكرية والاجتماعية والاقتصادية أو السياسية، وإنما بخياراتهم الاستراتيجية أو تحالفاتهم الإقليمية والدولية.
يعتقد الموالون للتحالف مع تركيا أن أنقرة هي الحليف الأهم لما تمثله من قوة إقليمية، وتملكه من أوراق النفوذ، وفي مقدمها السيطرة على أجزاء استراتيجية من الجغرافيا السورية، وعلاقتها القوية والمباشرة مع القسم الأعظم من القوى العسكرية المنظمة التي نشأت خلال الثورة، ولا تزال قادرة على الفعل. في المقابل، يعتقد خصومهم ومنافسوهم أن “المخلص” الوحيد الذي يملك أوراق التغيير في سورية هو موسكو لما تتمتع به من روح المبادرة، وما تمثله اليوم من سلطة وصاية فعلية على دمشق، ومن سيطرة على الأرض، ومن نفوذٍ داخل أجهزة الدولة والنظام، وما تحظى به من مكانةٍ وإمكانات قوة عظمى عسكرية، تؤهلها للعمل من الداخل السوري، وبحرية أكبر من أي دولة أخرى. أما الفريق الآخر فهو لا يرى أملا في أي تقدم ممكن من دون العمل مع الولايات المتحدة التي تشكل القطب الوحيد القادر على الوقوف في وجه التحالف الروسي الإيراني الذي يقبض على رقابنا، والتي كان لها الدور الأكبر في إضعاف النظام وحلفائه من خلال ما فرضته عليه من عقوبات اقتصادية ودبلوماسية، وما يمكن أن تفرضه عليه من عقوبات جديدة وملاحقات قانونية لمجرمي الحرب السورية، بعد تصويت الكونغرس على قانون قيصر لحماية المدنيين في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2019.
(3)
ليس لهذه “الاستراتيجية” التي تراهن على حسن نية الدول المتنازعة على اقتسام الإرث الأسدي في سورية أي مضمون سوى اعتراف المعارضة، بمختلف منصاتها ومؤسساتها، بالهزيمة السياسية والتسليم بها. وهذا هو الوصف الحقيقي لوضعنا اليوم، معارضين راديكاليين ومعتدلين، بعد أن سلمنا بانعدام قدرتنا على العمل الجماعي، والفعل المتسق والمنسق، وانقسمنا بين موالين لهذه الدولة أو تلك، وقبلنا بترك المستقبل رهين ما يجود به الموقف الدولي ونتائج الصراع الدائر من حولنا وعلينا. وكما هي العاقبة لأي هزيمة، ما كان لنا أن نبلع الموسى، من دون أن يدب الإحباط في نفوسنا، وفي أثره الشك بالذات، وانعدام الثقة واختلاق المثالب الذاتية والنقص الولادي أو التكويني. هكذا بينما يعمل الروس، بكل الوسائل، لإعادة تأهيل النظام الفاجر، المسؤول عن قتل الألوف وخراب البلاد، حتى يستعيدوا من خلاله السيطرة على كامل الجغرافيا السورية، ويفرضوا الحل الذي يناسبهم، ينشغل نشطاؤنا وكثيرون من أفراد المعارضة وسياسييها ومفكريها بنشر غسيل بعضهم، والتشكيك بنواياهم، وفي خلق الخصوم والعداوات والمظلوميات على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي. ويسود الاعتقاد، على طريقة ما كان يحدث في القرون الوسطى من ملاحقة الساحرات وحرقهن، بأن ملاحقة هؤلاء ومحاسبتهم وشل فاعليتهم، إن لم يكن إخراجهم من الحياة وإجبارهم على الاختفاء، هو السبيل الوحيد لتطهير الثورة من أخطائها وأسباب فشلها وإعادة إطلاقها ناصعةً وبيضاء كالثلج.
والواقع أن الحرب التي كنا نخوضها ضد النظام وحلفائه قد انتقلت، من دون أن ندري، إلى داخل صفوفنا، بذريعة الكشف عن المندسّين والخونة والمتآمرين والفاسدين. وحل محل الحوار والنقاش المطلوبين من أجل بلورة رؤية وخط سياسيين أكثر نجاعةً وفاعلية، يمكّنان المعارضة من استعادة صدقيتها وتفاعلها مع جمهورها، والمساهمة في رصّ صفوفه، وتنظيم مقاوماته المتنامية، التسابق على تأسيس الكيانات والمؤسسات والتجمعات المتنافسة على شرعية تمثيل الثورة، أو الداعية إلى عقد مؤتمرات وطنية بحجم أعضائها، وعدد المجموعات والمنصّات المتنازعة على ملء الفراغ، ووراثة موقع لم يعد له وجود. وبهذا، يستطيع كل فريق أن يبرئ نفسه، ويحمل مسؤولية فشل المعارضة على الآخرين، ويتطهر من الخطيئة المحتملة بالتشهير بالنخب السياسية المنافسة. ومن البديهي ألّا ينجم عن هذا المسعى أي تحليلٍ موضوعي، يساعد على تجلية الموقف وتقدم النقاش، ولا من باب أولى تدشين مرحلة جديدة وشق طريقٍ يقود إلى إعادة تأسيس سياسي جديد، أو يساعد على بناء أي مقاومةٍ فعلية وفعالة لقلب موازين القوى وفرض التغيير. إنه يمثل بالأحرى نوعا من الانتحار السياسي الجماعي، ونهاية حزينة لملحمة كبرى، لا بداية لأي حل.
من السذاجة الاعتقاد أن من الممكن خلاص سورية اليوم من دون تعزيز الضغوط الدولية، وحدّ أدنى من تفاهم الدول الكبرى المتنازعة على النفوذ في سورية والمنطقة الشرق أوسطية، ومن خلالها على السيطرة الإقليمية والعالمية، وذلك بمقدار ما أصبحت الحرب السورية إقليمية ودولية معا. ولكن من السذاجة أيضا الاعتقاد أن نهاية هذه الحرب يمكن أن تضمن الحد الأدنى من المصالح الأساسية لسورية والسوريين معا، من دون وجود فاعل جمعي ومؤسّسي سوري يجسّد هذه المصالح، ويمثل السوريين فيها، ومن ثم من دون وجود استراتيجية وخطة عمل سورية للدفاع عنها. وغياب مثل هذا الفاعل يعني أن الدول، في أحسن الأحوال، سوف تنظر إلى المصالح السورية من منظار مصالح تلك القوى السورية التي تواليها، إن لم نقل تعمل كأدوات في خدمة أهدافها. وهذا يعني مضاعفة خريطة تقاسم النفوذ الدولي في سورية بخريطة تقاسم نفوذ سورية سورية، لا تجعل من سورية دولةً فاشلةً فحسب، ولكنها تحول دون قيامها دولة مدنية تعدّدية، تضمن كرامة أبنائها وحقوقهم المتساوية في المواطنة المتساوية والحرّة التي تبرّر وحدها تضحيات الملايين منهم بأشكالها المختلفة.
(4)
في المقابل، لا أعتقد أننا، على الرغم من كل ما أصابنا ولا يزال يصيبنا، قد أسقط نهائيا في يدنا ولم يعد أمامنا خيار سوى الاستسلام للقدر، والقبول بالالتحاق بالقوى الأجنبية، والتفرّغ خلال “الوقت الضائع” لتصفية حساباتنا الداخلية، على أمل قطف بعض ثمار التسوية الدولية. وعلى الرغم من المحن والمآسي التي يعيشها السوريون، في كل المناطق والمواقع، والتي تنذر بتدهور الأوضاع لوقت طويل قادم، ولهذا السبب بالذات، ينبغي أن نوقن أن هناك خيارات أخرى أمامنا، وأن الحل لا يكمن، مهما كان الحال، في الارتماء في أحضان القوى الدولية أو المراهنة على هذا المحتل أو ذاك، ولا من باب أوْلى في التخلي عن مسؤولياتنا والخلود لليأس والانتحار السياسي، فالنظام، على الرغم من احتفاظه بوجوده الشكلي، قد انهار تماما أمام الضربات القوية والمستمرة منذ سنوات، لجمهور رمى بنفسه على الموت للتخلص من الطاغية، ولولا هزيمته لما اضطر إلى الاستعانة بالمليشيات والجيوش الأجنبية. وهو لم يعد يعني شيئا لأي طرفٍ، بما في ذلك رجالاته الذين يبحثون عن حماتهم الخارجيين.
كما أن الصراع بين القوى المحتلة أصبح أكثر فأكثر احتداما، بعد أن أدركت جميعها أنها وصلت إلى طريق مسدود، وأن من الصعب، إن لم يكن المستحيل، التوفيق بين مصالحها، بمقدار ما تغلب البعد الجيوسياسي لهذه المصالح على أبعادها الأخرى، وصار الأمر يتعلق مباشرة بالنسبة لجميعها بالدفاع عن موقعها ودورها وهيبتها في التوازنات الإقليمية والدولية. بالإضافة إلى أن المنطقة تعيش اليوم بأكملها في غليانٍ شعبي لا يهدأ، من الجزائر إلى العراق، بما في ذلك داخل إيران الخامنئية ذاتها التي لعبت الدور الأكبر في تأجيج صراعاتها، وزرع الخراب والفوضى في حياة مجتمعاتها.
وتكاد جميع نخب المنطقة السياسية تكون اليوم فاقدة للشرعية، وعاجزة عن استعادة الحد الأدنى من الصدقية التي تمكّنها من تهدئة الجمهور المهدّد في حياته ومستقبله. وينذر ذلك كله بحقبة من زعزعة الاستقرار الشامل واستمرار القلاقل والاضطرابات التي لا يمكن أن تنتهي من دون تغيير عميق في أسلوب ممارسة السلطة والحكم في هذه المناطق، ومن دون معالجة شمولية للأزمة الإقليمية المستمرة منذ نهاية الحقبة العثمانية، والتي افتتحتها الاتفاقية الفرنسية الإنكليزية التي كرّست الانقسام الدائم والعداء والتنافس بين الدول الجديدة، الهشّة والفاقدة للسيادة والثقة والقوة، والتي زادها تفجرا واشتعالا المشروع الاستيطاني الإسرائيلي الذي لا يزال يصب الزيت على نارها، ويحرم المنطقة من أي أمل في السلام والاستقرار. وهذا يعني أن شيئا لم يحسم ولن يحسم قريبا في الصراع الدائر في منطقتنا، وأن حسم النزاع والتوصل إلى حالةٍ من الأمن والاستقرار الاقليمي والوطني لن يتحقق في هذه المنطقة، من دون تعافي شعوبها وتمكنها من استعادة المبادرة، وأخذ مصيرها بيدها، والتخلي عن انتظار مبادرات القوى الخارجية لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار والرخاء والازدهار. فلا تنبع المشكلة التي نواجهها من الإرث الثقيل الذي خلفه الاستعمار، والذي تجسّد في التشكيل الجيوسياسي البنيوي الملغوم للمنطقة، وفي إدارته صراعاتها بما يضمن استمرار تبعيتها واختلال توازناتها وبؤس نموها فحسب، وإنما ينجم أيضا عن عجزنا عن تطوير أنماط من التفكير والسلوك الفردي والجماعي التي لا بد منها لتجاوز تفتتنا وتخبطنا الاستراتيجي، واستعادة المبادرة السياسية.
يكمن قسط كبير من المشكلة في نمط تفكيرنا وممارستنا، فنحن نعيش تناقضاتٍ نرفض الاعتراف بها. نفكر بطريقة ونعمل عكسها. نقول إن العالم يقف ضدنا، لكننا لا نكفّ عن مطالبته بالتدخل لصالحنا. ونقول إنه هو أصل مشكلاتنا وسبب ضعفنا، وننتظر منه أن ياتي ليحل مشكلاتنا أو يساعدنا على حلها. ونعترف بضعفنا وتقصيرنا في تنمية قدراتنا، ولا نعمل أي شيء لتجاوز انقساماتنا وتطوير قدراتنا الذاتية، وتعزيز التواصل والتفاهم والتعاون فيما بيننا، والسعي الجدي إلى تحسين أنماط التنظيم والإدارة لجهودنا. نقول دولة الأسد انتهت وزالت، وهي زالت بالفعل، لكننا لا نقوم بأي عملٍ من أجل بناء البديل السياسي، أي البذرة الحاملة لدولة الشعب أو دولة المواطنة التي تملأ الفراغ، وتحل محل الدولة البائدة أو على الأقل تعد لذلك. نتحدّث عن وطنية وقيم ديمقراطية، وكل جهدنا مكرس لتحطيم بعضنا بعضا، وإقصاء واحدنا الآخر، وتشويه وجهة نظره وتسويد صفحته واسمه.
والحال لن نستطيع أن نقنع المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانبنا، ونستفيد جدّيا من فرص التضامن من مؤسسات قانونية وحقوقية، ونحن نكاد نسلم بعجزنا عن حل خلافاتنا وتحقيق الاتفاق والتفاهم فيما بيننا. ولن نتمكّن من بناء الديمقراطية التي هي هدفنا الأول، من دون أن نعمل على تكوين قوى ديمقراطية منظمة. ولن تفيدنا المراهنة على تدخل تركيا أو روسيا أو أميركا أو أوروبا لصالح مشروع الديمقراطية السورية، إذا لم تتجلّ ملامح هذا المشروع، ولم تظهر في ممارساتنا وعملنا وتفكيرنا. ولا يمكن أن نطمح إلى أن تضحّي الدول من أجلنا إذا لم نظهر، نحن أنفسنا، استعدادنا للتضحية في سبيل قضيتنا، والاستثمار في مشروع تحرّرنا. كما سيكون من المستحيل أن نشجع الآخرين على الوفاء بالتزاماتهم السياسية والأخلاقية تجاهنا، إذا تخلينا نحن أنفسنا عن التزاماتنا السياسية والأخلاقية تجاه قضيتنا وشعبنا.
بمعنى آخر، لا يمكن لشعبٍ أن ينال من الحقوق أكثر مما يستطيع أن ينتزعه، بقوته وإرادته وتصميمه وتنظيمه أيضا. وأن من يخسر معركته في التحول إلى شعبٍ منظم القوى، وموحد الإرادة، يخسر معركة التضامن الدولي، ويعامل بوصفه ضحية، وتتحول قضيته إلى قضية إنسانية لا تثير التعاطف إلا بمقدار ما تنتفي صفتها السياسية. ومن دون “محوّل وطني” يجمع الجهود ويثمرها، يخشى أن تتحول تضحياتنا جميعا إلى جهود مجانية، تصبّ في مصلحة الآخرين الذين يملكون وحدهم القدرة على تثميرها، وتحويلها إلى مكاسب وإنجازات سياسية أو استراتيجية، وتحقيق أهدافهم الخاصة على أكتافنا.
——————————————–
المعارضة السورية وطفولتها السياسية.. تعقيب على برهان غليون/ علي العبدالله
لم يوفق الأكاديمي وأول رئيس للمجلس الوطني السوري برهان غليون، في الإمساك بالعلة التي قادت إلى حالة السلب التي تعيشها قوى المعارضة السورية وجعلتها تنخرط في سجالات ومهاترات بينية، وتبتعد عن المهمة التي يرى أنه “حان” وقت التصدّي لها، والتي حدّدها في مقالته “حان الوقت لتجاوز طفولتنا السياسية” (العربي الجديد: 14/2/2020)، بـ”إيجاد مركز قرار يوجّه خطانا، ويثمّر جهودنا، ويعزّز من صدقية قوتنا السياسية، ويراكم الخبرة الضرورية لانتزاع حقنا في أن نقرّر مصيرنا بأنفسنا، أو على الأقل أن نشارك في القرارات التي تتعلق برسم مصيرنا الوطني، كسوريين”. مهمة على قدر كبير من الأهمية، لا ريب في ذلك، لكنه، وبدل التركيز على سبل تحقيق هذا الهدف الهام والنبيل، أهدر وقته وجهده في حديث مكرور عن حالة المعارضة وأمراضها الذاتية، وارتهانها لقرارات الدول الراعية، ومراهناتها على الآخرين لتحقيق بعض أهداف الثورة السورية، ودعوتها إلى العمل من أجل هذا الهدف، وفي توجيه نقد إلى الأطراف العربية والإقليمية والدولية التي اجتمعت تحت اسم “أصدقاء الشعب السوري”، والتي لم تقم بالدور المطلوب منها، “لافتقارها للإرادة والاستراتيجية والوسائل اللازمة لردع الأسد عن الاستمرار في حرب الإبادة وانتهاك قرارات مجلس الأمن”، وتخصيصه “الغرب الديمقراطي” بتهمة كبيرة “تردّد في الوقوف إلى جانب السوريين… وعمل على تشتيت قواهم بدل مساعدتهم على تنظيم أنفسهم ومواجهة أعدائهم”، في تناقضٍ واضح مع استهجانه مراهنة قوى معارضة على هذه القوة أو تلك لتحقيق أهداف الثورة السورية، خصوصا وكلنا يعلم أن “الغرب الديمقراطي” نفعي لا يقدّم خدماتٍ مجانية، ينتظر فوائد من أي فعل يقوم به، لا يتحرك من دون فوائد، لم يجد ثمارا مجزية لانخراط مباشر وقوي في قضية السوريين.
بداية، يمكن فهم حالة المعارضة الديمقراطية، وما تعانيه من ضياع وانعدام وزن في ضوء جملة أسباب بنيوية وتاريخية، غير انهماكها بالسجالات والمهاترات البينية والشللية والعصبوية، والارتهان للدول الراعية، فهذه كلها أعراض للحالة، وليست سببا لها، أولها هشاشة تكوينها السياسي والتنظيمي، ليس بسبب ضغط النظام، الذريعة التي تحرص على إبرازها والتستر خلفها، بل بسبب بنيتها الفكرية والسياسية، وفشلها في التعاطي مع المتغيرات المحلية والدولية، حيث كانت في معظمها يسارية، ماركسية وناصرية، اختلّ توازن أولاها، الماركسية، بانهيار المعسكر الشيوعي، وتشكل سحب من الشك حول الماركسية فكرا والاشتراكية نظاما، فتشتتت وتمزقت بين متمسّك بالموقف التقليدي ومراهن على توليفة جديدة، تحتفظ بجزء مهم من الموقف التقليدي بتأسيس تشكيلاتٍ هجينةٍ، تمزج بين فكرها القديم والنظام الديمقراطي الغربي، من دون بذل جهد لتأصيل هذا الخليط، فغدا التوجه الديمقراطي قشرا يغطي توجها ماركسيا مستترا، فما زال الثلاثي اليساري: إلياس مرقص وياسين الحافظ وجمال أتاسي، بوصلتها الفكرية ومرشدها الروحي، في حالة سلفية حديثة، لم تكشف عن عدم صلاحية الخليط الذي وضعته على كاهلها، كسلاح فكري وسياسي لمواجهة الواقع والنظام المستبد والفاسد، وتبحث عن مخرج بتركيبة منسجمة ومتسقة لمواجهة واقع جديد. ليس في اجتهادات مرشديها ما يلبي حاجتها للتعاطي معه ومواجهته. أصبحت كحالة الغراب الذي قلد الطاووس، فعلق بين الوضعين، لا أصبح طاووسا ولا عاد غرابا.
أما ثانيتها، الناصرية، فمأزقها أعمق ومأساتها أكبر، حيث بقيت في جلباب رمزها جمال عبد الناصر، من دون إعادة نظر ولو محدودة في تجربته وتراثه، رغم ما كُشف من سلبيات في هذه التجربة، خصوصا لجهة شخصنة السلطة والقضاء على الحياة السياسية بإخراج المجتمع من السياسة، عبر دمج الوظيفة السياسية في الأجهزة الإدارية، ودمج الوظيفة السياسية في الوظيفة الأمنية؛ بحيث أصبحت الأجهزة الأمنية عرّاب العمل السياسي والتنظيمي، وتقوم بالدور المفترض أن تقوم به الأحزاب السياسية، وتعميم مفهومٍ للسياسة قائم على اعتبارها مجموعة من المشكلات الإدارية يدور العمل حول حلها، وحول رفع الأداء، لا حول الخيارات والأولويات، ما يعني إلغاء الصراع الفكري والتنافس السياسي، وإلغاء العمل السياسي المستقل. نظامٌ تحكمه أجهزة بيروقراطية وأمنية لإدارة السلطة سياسيا واقتصاديا، بدلا من القوى السياسية والاجتماعية، وعلى حساب دورها وحريتها ومشاركتها في القرار الوطني، وارتباطها (القوى الناصرية) بآلية تفكير وعمل متمحورة حول التبعية للقائد، وعجزها، على الرغم من تبنّيها الخيار الديمقراطي، عن تجاوز قديمها الذي ثبت عدم جدواه في ضوء التغيرات العاصفة التي ضربت البلاد. وأما ثاني العوامل، فما ترتب على الهشاشة السياسية والتنظيمية: افتقارها رؤية وبرامج عملية لمواجهة الواقع السياسي وتحولاته المتسارعة، حيث بقيت عند الشعارات الفضفاضة والعموميات الساذجة، من دون تصور واضح وبرنامج محدّد للأهداف والغايات وطرق الوصول إليها. وثالثها حالة الانهيار التي أصابتها بعد تراجع الثورة، وفشل مراهنتها على تحقيق نصر سريع، والتي قادتها إلى الانخراط في المهاترات والسجالات الفارغة، لحفظ ماء الوجه والبقاء في حالة توازن نفسي شخصي، عبر تحميل الآخر مسؤولية الهزيمة، فالهزيمة يتيمة والنصر له ألف أب، كما يقول المثل الشعبي، ارتكاس نفسي لاإرادي للهروب من مواجهة الواقع والإقرار بالفشل ناجم عن الإفلاس والعجز. حالة شائعة عرفتها تجارب سياسية كثيرة، خاصة مع اقترانها بحياة المنفى.
لم تستطع المعارضة الديمقراطية لعب دور وازن في الثورة، لهشاشة تكوينها، من جهة، ولافتقارها للعمق الشعبي من جهة ثانية. لقد هرولت إلى إشغال موقع شاغر في الثورة، موقع القيادة، عبر الالتقاء مع بعض مسؤولي النظام، وطرح تصورات وحلول، أساسها التفاوض مع النظام من دون أن تكون جزءا من الفعل اليومي للثورة، ومن دون التفاهم والاتفاق مع الثوار، ومن دون التوقف عند مؤشرات صريحة وصادمة، تقول برفض النظام مبدأ المساومة، كما عكسته ممارساته واستخدامه العنف الصريح والمباشر، منذ اللحظة الأولى لانطلاق التظاهرات، فخسرت المحاولة، وبدل إعادة النظر في خطئها هذا، ورسم خط بديل قائم على الانخراط في الثورة، ولعب دور فعلي فيها، وتحمل قسط من تضحيات المواطنين، ارتكب رموزها غلطتهم القاتلة، بمغادرة البلد إلى المنافي، فخسروا صدقيتهم، وفرص لعب دور في الثورة، مهما كان حجمه أو مداه، على خلفية خسارة ثقة الثوار. وهذا وسّع الهوة بينهم وبين الثوار، وأعطى صورة سلبية عن استعدادهم للبذل والتضحية من أجل المبادئ والحقوق، إذ غدا واضحا أن القوى الديمقراطية أقل القوى استعدادا للتضحية، فما أن بدأ النظام بالقتل المباشر والاعتقالات، حتى بدأوا بمغادرة البلد زرافات ووحدانا. وهذا قطع حبل التواصل بينهم وبين الثوار والحاضنة الشعبية، وجعل كل محاولاتهم للتواصل واستعادة الثقة ضربا من المستحيل. هل لهذا علاقة بطبيعة الإيمان، وأن أصحاب الإيمان الديني أكثر استعدادا للتضحية والعطاء لقناعتهم بجزاء الآخرة؟
كرر الكاتب موقفا تبنّته المعارضة اليسارية والديمقراطية، يحمّل حركات الإسلام السياسي مسؤولية الخسائر السياسية بقوله: “الأثر السياسي المدمر لنزوع النخب السلفية إلى تصدّر الخطاب وواجهة الكفاح المسلح، ومحاولة الإسلام السياسي عموما ابتلاع الثورة وتجييرها لحسابه السياسي الخاص، بصرف النظر عن الدوافع والنوايا والتدخلات الخارجية، أقول لا يوجد شكٌّ في أثر ذلك كله على تراجع صدقيتنا السياسية وانقلاب الرأي العام العالمي علينا”…، وضياع فرصة استعادة “تأييد الرأي العام العالمي، بل العربي، وتعاطفه مع الثورة السورية وشعاراتها التحرّرية” بسبب ظهور تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) “قلب الصورة تماما، فيحلّ مصطلحات الجهاد والكفر والطائفية والإرهاب محل مصطلحات ثورة الحرية والكرامة والمواطنة والدولة المدنية التعدّدية”. بتجاهل تام لحق كل جهة سياسية في العمل على فرض رؤيتها وخيارها في إطار صراع الأفكار والبرامج، وارتباط ما حصل (تصدّر حركات الإسلام السياسي المشهد)، بأسباب كثيرة من قدرات سياسية وتنظيمية واستعدادات فردية ودعم خارجي كبير من قوى إسلامية، قريبة أو مماثلة، ومن دول لا تريد نجاح تجربة سياسية بإرادة شعبية. صحيح أنها ارتكبت كبائر سياسية وتنظيمية ومالية، خصوصا “داعش” وسلوكه المتوحش وجرائمه بحق المدنيين العزّل والتوجس الغربي من كل تنظيم وعمل إسلامي، على خلفية “غزوة واشنطن” وتبعاتها والأعمال الإرهابية الأخرى، لكن السبب الرئيس لخسارة المعارضة الديمقراطية، برأيي، وجود هوة واسعة بين حواضن الثورة ورؤية المعارضة الديمقراطية السياسية والاجتماعية، وفشل الأخيرة في جسر هذه الهوة، هذا إذا كانت تقرّ بوجود هذه الهوة وخطورتها وتدرك ضرورة العمل على جسرها، فشعارات “المواطنة” و”الدولة المدنية التعدّدية” شعارات نخبوية تتبنّاها قوى سياسية واجتماعية صغيرة، مدينية في الغالب، وذات تأثير محدود، غريبة على مسامع القوى الشعبية، خصوصا في البلدات الصغيرة والأرياف، والتي شكلت حاضنة قوية لقوى الإسلام السياسي التي تتمتع شعاراتها بجاذبية وحضور راسخ في المخيال السياسي والاجتماعي لهذه القوى الشعبية، ما جعل تشكيل ألوية جهادية ومكاتب شرعية وحسبة وبيت مال ورفع شعارات تنادي بالخلافة أو الإمارة التقليدية تحصيل حاصل، في حين أن كل المحدّدات والتصورات الحديثة بقيت برّانية بالنسبة للجسم الرئيس في المجتمع السوري، لم تدخل كل القيم والتصورات والمحدّدات الحديثة في صميم قناعة القوى الشعبية العريضة، ولم تلامس وعيها، وتغير من طبيعة مخيالها السياسي والاجتماعي، حيث ما زالت الخلافة نموذجها لنظام الحكم الصالح، وما زال أبو بكر نموذجها للحاكم الرحوم، وعمر بن الخطاب نموذجها للحاكم العادل، وعلي بن أبي طالب نموذجها للحاكم الشعبي، ومعاوية بن أبي سفيان نموذجها للحاكم الحاذق.
منح هذا حركات الإسلام السياسي أسبقية وأفضلية على أصحاب التوجهات الديمقراطية والحديثة، وقاد إلى تأييدها ودعمها والانخراط في صفوفها ومؤسساتها، والتغاضي عن كثير من ممارساتها وتعدّياتها وتجاوزاتها على حقوق المواطنين، على خلفية الإحساس بالقرابة والحميمية. ما زال مجتمعنا، في العمق، يراوح عند مرحلة الانتقال من النظام السلطاني، بتجسّده الأخير: السلطنة العثمانية، إلى نظام الدولة – الأمة، الدولة الوطنية أو القومية الحديثة، ولم يتجاوزها، وما زال التوجه الحديث نخبويا لم يخترق التشكيلات الاجتماعية الشعبية، ويقنعها بصلاحيته لحل مشكلاتها المادية والروحية، ما كان يستدعي مواجهة القضية والعمل على جسر الهوة مع الرؤى والقناعات الشعبية، بالبحث عن تقاطعات، وطرح تأويلات وحلول وسط تجعل الرؤى والخيارات الحديثة قريبةً من المزاج العام. لقد أخطأت المعارضة الديمقراطية بتجاهل هذا الاستحقاق مع ما للإسلام من موقع مركزي ودور في تكوين شخصية السوري، وانطوائه على طاقة ثورية عظيمة، ودفع قوي للتضحية في سبيل العقيدة والقيم الأخلاقية، فـ”الحقيقة المحورية الوحيدة أن الإسلام هو المحرّك الطبيعي للسياسة عبر العالم الإسلامي، ففي العالم الإسلامي يعتبر الإسلام مقياسا للعدالة والإنسانية والحكم الصالح ومحاربة الفساد، ويمثل مرجعية عقائدية للصراعات الداخلية ضد الحكومات الاستبدادية العلمانية، ولصراعات الأقليات المسلمة من أجل التحرّر من السلطات غير الإسلامية القاسية في كثير من الأحيان”، وفق غراهام فولر، (لوس أنجليس تايمز، الشرق الأوسط: 24/9/2001)، وتركها (المعارضة الديمقراطية) الإسلام لحركات الإسلام السياسي توظفه في معاركها الفكرية والسياسية، فتفوز بالشعبية، وبتحشيد القوى الاجتماعية حول شعاراتها وأهدافها. الأنظمة المستبدة والفاسدة هي الأخرى أدركت أهمية الموضوع وخطورته، وتعاطت معه بخبث وانتهازية، عبر حرص قادتها على تلبس مظهر التدين وحضور صلوات الجُمع والعيدين، واحتفال عيد مولد النبي والحج إلى بيت الله الحرام ورفع شعار حماية الدين والدفاع عنه.
ومع الاتفاق مع قول برهان غليون “فلا تنبع المشكلة التي نواجهها من الإرث الثقيل الذي خلفه الاستعمار، والذي تجسّد في التشكيل الجيوسياسي البنيوي الملغوم للمنطقة، وفي إدارته صراعاتها بما يضمن استمرار تبعيتها واختلال توازناتها وبؤس نموها فحسب، وإنما ينجم أيضا عن عجزنا عن تطوير أنماط من التفكير والسلوك الفردي والجماعي التي لا بد منها لتجاوز تفتتنا وتخبطنا الاستراتيجي، واستعادة المبادرة السياسية”. .. “ولن نتمكّن من بناء الديمقراطية التي هي هدفنا الأول، من دون أن نعمل على تكوين قوى ديمقراطية منظمة”، مع الاتفاق في ذلك، إلا أن ثمّة واقعا جديدا يحتاج إلى مواجهة ومعالجة، نجاح النظام في دفع أغلبية الشعب السوري إلى الانغماس في همومه الخاصة والتفكير في ظروفه المباشرة، ما جعل ويجعل محاولات الثورة والتغيير حرثا في بحر.
العربي الجديد
—————————————-
في نقد “نقد طفولتنا السياسية”/ عمار ديوب
كتب الأكاديمي والمفكر السوري، برهان غليون، مقالاً، سماه “في نقد طفولتنا السياسية” في “العربي الجديد” (12 فبراير/ شباط 2020)، وردّ عليه الباحث، علي العبدالله، في تعقيب في الصحيفة ذاتها، في 21 من الشهر نفسه. يتناول محور النصين غياب مركز للقرار في المعارضة السورية ونقد مشكلاتها، وأسباب فشلها ودورها في هزيمة الثورة وسواه. وإذ ركز برهان على تلك المشكلات، كما انتقده العبدالله، وأنّه يكرّرها في مقالاته، ومن دون جديدٍ فيها، فإن العبدالله حاول نقل الحوار من الأسباب السياسيّة لفشل المعارضة إلى الأسباب الفكريّة، وتناول “هشاشة تكوينها السياسي والتنظيمي” المستند إلى “بنيتها الفكرية والسياسية”، وردَّ ذلك إلى ماركسيّةٍ مستترة/ حالة سلفية حديثة، وهذا بخصوص اليساريّة منها. وأمّا الناصريّة، فتتمحور حول “الديكتاتور” جمال عبد الناصر، وبهذا يكمن فشلها، وبالتالي، برأيه مشكلة المعارضة “الديمقراطية/ اليسارية” هنا، الأمر الذي منعها من جَسر الهوّة، بين رؤاها والوعي الشعبي، وبالتالي لم تمثل الثورة، وإنما صادرتها وتسلقت عليها. وبرأيه أن “للإسلام.. موقع مركزي ودور في تكوين شخصية السوري، وانطوائه على طاقة ثورية عظيمة، ودفع قوي للتضحية في سبيل العقيدة والقيم الأخلاقية”، وأن هذه الفكرة لم تهتم بها المعارضة الديمقراطيّة، بينما أولتها الإسلاميّة والنظام دوراً كبيراً، وبالتالي سيطرا على الثورة، وسورية.
حاولت أن أفهم ماذا يريد برهان غليون من فكرة فشل المعارضة في “إيجاد مركز قرار يوجه خطانا”. المعارضة السورية شكلت عدّة مراكز، وبدءاً من عام 2011 “المجلس الوطني، وهيئة التنسيق، والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، والهيئة العليا للمفاوضات، ومؤسسات أخرى”، فهل كان يجب تشكيل مركز من كل هذه المؤسسات؟ أم كان يجب تشكيل مركز قرارٍ من المنظرين والمفكرين السوريين والفلسطينيين، يصيغون الاستراتيجيات والسياسات وبرامج العمل الأساسية؟ ثم لماذا يجب تشكيل مركز واحد؟ وأيضاً، هل مشكلة المعارضة في تعدّد المراكز؟ يوجّه غليون نقده لمؤسسات المعارضة، وإن لم يُسمِها، وحين يفعل، ينتقد “النخب السلفية” متجاهلاً نقد الإخوان المسلمين بالتحديد، وقد كان لهم دور مركزي في المؤسسات المذكورة هنا، ولاحقاً يتخطى الإخوان المسلمين والنخب السلفية، ويوجه نقده إلى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وكأنّ للأخير علاقة بالثورة من أصله!.. هناك ضرورة للنقد، وللنقاش وللحوار الذي يطالب به برهان، ولكن ما لا يجوز بأي حالٍ تجاهل القوى التي لعبت دوراً مركزياً في إفشال الثورة، وهي محدّدة، ولها سياسات واستراتيجيات ورؤى وعلاقات إقليمية متينة، وهي سبب ذلك الفشل.
ضرورة النقاش
ضرورة النقاش، برأي برهان غليون، بسبب كارثيةٍ الحالة السوريّة، وأن الخارج لن يفعل شيئاً للسوريين، وإن رغب بذلك فهذا يتطلب مركزاً سوريّاً جامعاً. فكرته هذه تتجاهل واقعاً أصبح معقّداً للغاية، ومعارضةً جُرّبت، تسع سنواتٍ ولم تتحسّس حتى لحظته كارثيّة الواقع المعقد هذا. وبالتالي، هناك واقع سوري مفكّك، وواقع المعارضة يشبهه، وهو ما يمنع التفكير والنقاش الجدّي بذلك المركز وضرورته. برهان هنا لا يقدر جيّداً التفكك والتشظي اللذين وصلت إليهما الحالة السوريّة، وفكرته أن النظام انتهى، أيضاً ليست عاملاً تحفيزياً للنقاش أو لضرورته. الحالة هذه، وتعقيداتها واستنقاعها تتطلب وقتاً إضافياً “واقعاً موضوعيّاً جديداً” لإعادة النظر، ولتشكيل قوى سياسية وفكرية جديدة. الأخيرات حتى لحظته لم تتشكل، والتجارب السياسية الجديدة ما زالت شلليّة ونخبويّة وهامشيّة بامتياز، ومنها فشِل في استقطاب عدّة أفرادٍ ليعلن عن نشاطاته. هنا، يُطرح سؤال: من سيمثل المعارضة والثورة إذاً؟ وهو سؤالٌ دقيقٌ للغاية، وهناك عدّة أجوبة، أسوأها ما يتمسك بالمعارضة الفاشلة حالياً، وأفضلها ربما، يقول بضرورة تفكيك مؤسسات المعارضة، وتسليم الأمر للأمم المتحدة، واعتبار سورية دولةً ونظاماً ومعارضة فاشلة، مع رفضٍ قطعيٍّ للوصايات الدولية، وضرورة أن تلعب مؤسسات الأمم المتحدة، هي بالذات، دوراً في إخراج سورية مما هي فيه من تفككٍ واحتلالاتٍ ومشكلاتٍ متعدّدة الأوجه.
ما أوضحته لا يعني رفض النقاش، ولا ضرورة تشكيل مركز جديد، ولكنني أريد التحديد الدقيق لتلك النشاطات والمؤسسات، ووفق الممكن في لحظتنا الراهنة، وأعتقد أن تنظيم وعقد ندواتٍ فكرية للحوار هو أفضل الممكنات وأدقها، وتُناقَش فيها كل المشكلات التي طرحتها هذه المقالات وسواها، وكل المفاصل الأساسية للوضع السوري ومنذ 2011. يرفض برهان غليون أن “يستسلم”، للواقع، وهذا شكل من أشكال “الطفولة السياسية”، حيث ليس هناك من واقعٍ متماسك من أصله. وأمّا العبدالله، فيعلن موقفاً يائساً، فيكتب في نهاية مقاله “ثمّة واقع جديد يحتاج إلى مواجهة ومعالجة، نجاح النظام في دفع أغلبية الشعب السوري إلى الانغماس في همومه الخاصة والتفكير في ظروفه المباشرة، ما جعل ويجعل محاولات الثورة والتغيير حرثاً في بحر”.
حاول العبدالله، وقد انتقد تكرار غليون التطرق لمشكلات المعارضة، وبعكس غليون الذي ظلَّ حديثه عن المعارضة السورية بكليتها، التمييز بين المعارضتين، الديمقراطية والإسلامية، ووجه نقده للديمقراطيّة بصورة أساسيّة، وأنّها تعاني من: مشكلاتٍ فكريّة من ناحية، وتنظيميّة من ناحية أخرى، وهذا أبعدها عن عقلية الشعب ووعيه الديني، ولم تستطع إخراجه منها. ويتفق العبدالله مع غليون في أن لمشكلاتنا الحالية جذراً قديماً، وإن كان كل منهما يفسّر ذلك بطريقة مختلفة، حيث أساس مشكلاتنا ينطلق من “نهاية الحقبة العثمانية” لدى غليون، ولدى العبدالله “ما زال مجتمعنا، في العمق – لاحظ العمق التاريخي الذي لا يطرأ عليه أي تغييرٍ! – يراوح عند مرحلة الانتقال من النظام السلطاني بتجسده الأخير في السلطنة العثمانية، وإلى نظام الدولة – الأمة”. لا يوضح العبدالله فكرته هذه، فماذا يعني أننا ما زلنا في تلك المرحلة، وأين الخطأ في إظهار مشكلة غياب “الدولة الأمة” مشكلةً حقيقيّة لدى العرب؟ أليست هذه هي القضية، وغياب تحققها الواقعي، والتحكم الأوروبي في تشكيل مجتمعاتنا، وقبله العثماني شكّلَ الأرضية للاحتلالات وللاستبداد لاحقاً، وطبعاً للقضية جوانب أخرى، ولكنها ليست موضوع نقاشنا الآن. والسؤال: هل شكلت الدولة القُطرية بديلاً عن الدولة الأمة، أو الدولة الإسلامية حتى “السودان مثلاً”. في كل الأحوال، تظلُّ قضية تحقق الأمة الدولة مركزيةً للنهوض العربي، وأن الخيار الديمقراطي فقط هو الطريق الوحيد للوصول إليها.
الوعي أم السياسة؟
يركز علي العبدالله على شكل الوعي السوري، ويراه “في العمق” شكلاً دينياً، وأن الدين ما زال “المحرّك الطبيعي للسياسة” في مواجهة “الحكومات الاستبدادية العلمانية”. لن أجادل بأن ذلك ليس صحيحاً من أصله؛ فهناك بيئاتٌ اجتماعيةٌ وعيها ديني. ولكن، وعكس ذلك، الثورات العربية، وإن كان الوعي الديني منطلقاً لبعض قطاعاتها المجتمعية، فهو لم يكن سبباً في حدوث الثورة، بل أوضحت الثورات، في موجاتها الثانية، طبيعة الموجة الأولى، وهي ضد الأسلمة بالكامل، وضد حكوماتٍ كانت تدّعي الأسلمة “العراق، السودان، لبنان، ولديك إيران”. علينا التمييز بين شكل الوعي، وهو بصورته الكبيرة، ما زال دينياً، ولا شك، ويرتبط سبب هذه الصورة بأيديولوجيات الأنظمة، وليس بالدين ذاته، وبين أن يكون دافعاً للثورات الجديدة. الأخيرات حدثت بسبب قضايا مجتمعية ومطلبية وسياسية بالدرجة الأولى، وتسعى نحو نظامٍ ديمقراطيٍّ في الدول العربية كافة، وحتى الدول التي برز فيها الإخوان المسلمون قوة وازنة لم تستطع التفرد بالنظام السياسي، وظلّت القضية المحورية هي كيفية الوصول إلى الديمقراطية، وكيف نجد سياساتٍ اقتصاديةً لتجاوز الأزمات، بل مشكلة الإخوان هي بالضبط هنا، كيف يوفقون بين ميلهم الطائفي والديمقراطية وتأمين فرص عمل لملايين العاطلين، وهذا محال، حيث تستند الديمقراطية إلى المواطنة، بينما تستند الطائفية إلى الدين. وبخصوص الاقتصاد، ليس لديهم إلّا الاستدانة من البنوك الدولية أو الدول الخليجية! المقصد من هذا الجدال ضرورة التمييز بين الوعي الشعبي والطائفية السياسية، وبين الثورات وشكل وعيها الخاص. أيضاً، ليس صحيحاً أن الوعي المدني (دولة مدنية) يخص جماعاتٍ صغيرة، كما يقول العبدالله، بل هي مطالب عامة، ولا يغيّر من ذلك وجود جماعاتٍ تطالب بدولةٍ دينية، أو لا تتبنى الدولة العلمانية الديمقراطية بشكل دقيق، ولكنها ليست الأساس.
أتفق مع العبدالله على أن شكل الوعي لم يتغيّر كثيراً، ولكن هذا لا يتعلق بالماضي، ولا بالدين، ولا بأن الدين ما زال يشكل مخيال المسلمين، منذ وجد الإسلام. ويتعلق الأمر بالقوى التي تخوض الصراع السياسي والاجتماعي، وقبل الثورة بالنظام وبعده بالنظام والمعارضة وبالفاعلين الثقافيين بكل تنويعاتهم. لا يمكن إعطاء أهمية كبيرة للوعي التقليدي، وأنّه ما زال يتمحور حول هذا الصحابي أو ذاك، أو حول هذا الزعيم الديني أو ذاك، ولو كان فعلاً يتمحور حولهم، فإن ذلك لا يتعلق بهم. لا، فهذه الاستعادة تتعلق بالفاعلين في الحاضر، أنظمة وقوى إسلامية وتيارات فكرية، وهي تستثمر في التديّن والتطييف. يرفض العبدالله حكاية المعارضة المستهلكة وحجتها أن الفشل سببه النظام وحده، وهذا صحيح، ولكن ما هو غير دقيق ردّ الفشل، ولنقل مشكلات الثورة وتعقيدات مآلاتها ومآلات سورية إلى عدم تبصّر المعارضة الديمقراطية لروح الشعب (الإسلام)، وأن مشكلة المعارضة تكمن هنا! وقد أوضحت أن ثورات الموجة الثانية كانت بالضد من الإسلاميين، ولم يكن لديها مشكلة مع الإسلام، وأن أهدافها تمحورت حول الديمقراطية والمدنية والعلمانية، والخروج من الأزمة الاقتصادية، وتأمين فرص عمل وهكذا.
يتناول النقاش أعلاه تارّةً مشكلات القوى السياسية، كما في حالة برهان غليون، وتارّةً المشكلات الفكرية وأشكال الوعي، كما فعلَ علي العبدالله، ولهذا تباعدا في النقاش. وعلى الرغم من ذلك، يعود العبدالله ليتفق مع غليون على ضرورة الديمقراطية وتشكيل قوى ديمقراطية منظّمة، ولكن اختلاف الرؤية للسياسة بينهما يدفع إلى التساؤل: هل “الديمقراطية” المنشودة، و”القوى الديمقراطية” المرغوب تشكيلها هي ذاتها عند الإسلاميين وسواهم؟ وهذا يفتح نقاشاً بشأن هذه القضية، وهي إشكاليّة في كل الأنظمة التي تشكلت بعد الثورات، حيث هناك خلافات كبيرة بشأن شكل النظام الديمقراطي وبنود الدستور، وعلاقة الشريعة بها، وكيفية تطبيق علمانية الدولة، وحياديتها إزاء الأديان والطوائف، وكيفية شرعنة الأحزاب الدينية.
يؤكد العبدالله، في رّده على غليون، حق الإسلاميين في الاختلاف بالمنظور السياسي، وهذا ما لا يرفضه غليون، وإن انتقد السلفية بصورة خاصة. وبالتالي، لماذا يدافع العبدالله عن قضية خاطئة، وقد انتقد الإسلاميين، ورؤيتهم الطائفية والفئوية في الثورة السورية في مقالاتٍ كثيرة؟ هل يتعلق الأمر برفض كلِّ نقدٍ من خارج الإسلاميين لهم، والدفاع عنهم، وقد أصبح نقدهم يتكرّر كثيراً؟ يخطئ العبدالله بهذا، فهناك ما يشبه الإجماع بين السوريين على حقهم في المشاركة السياسية بكل فعاليات الحياة السياسية. أمّا النقد، فيتمحور جلّه حول طائفيتهم واحتكارهم للثورة ودورهم الكارثي في تفشيلها وإلحاقها بالخارج، وفي هذا أخطأت المعارضة الليبرالية كذلك، والتي يسميها العبدالله خطأ يساريّة.
عن طفولتنا السياسية
يحصر عنوان مقال برهان غليون، “طفولتنا السياسية”، أخطاء المعارضة السورية بالخيارات الفكرية والسياسية. ولهذا رفض التركيز على إظهار الفساد والخلافات بين كتل المعارضة وأفرادها “الحرب انتقلت إلى داخلنا”. تناول نصه أكثر من مرة تبعية الكتل وأفراد كثيرين للدول، ولكنه لا يدقّق في خطورة ذلك، أي في المصالح التي أصبحت لتلك القوى وللأفراد في المعارضة، وهم بذلك يشبهون النظام بتبعيته لإيران أو لروسيا. المقصد هنا أن مصالح كتل من المعارضة هي التي تدفعها إلى التمسّك بمؤسساتها وأن تظل موجودة، على الرغم من كل التعقيد الذي تطرقت عليه. إذاً، هناك مشكلات تتعلق بالخيارات الفكرية والمصالح الاقتصادية والتبعية لتلك الكتل.
فكرة النقاش أعلاه هي الأساس، بغض النظر عن الأولويات فيها “المركز، أو سبل تحقيق هذا الهدف النبيل”، ولكن أيضاً هناك ضرورة لتشكيل ذلك المركز “الفكري”، والبدء بنقاشٍ موضوعيٍّ وعميقٍ عن الوضع السوري برمته، وألّا يكون المركز والنقاشات لغاياتٍ ضيّقة ومحدودة، كأن يكون هدفها تشكيل قوّة سياسيّة جديدة، أو منصة سياسية، أو دور ما في تسوية سياسية قادمة، وسواه، كما جرى ويجري. الأهم كذلك الإقلاع عن الأكاذيب، وتأجيل ذلك بحجة استفادة النظام منها أو عدم سقوطه.
تكمن ضرورة النقاش في الوضع الكارثي الذي أصبحت سورية عليه، فهناك عدّة احتلالات، ودمار لأكثرية المدن، وتهجيرٍ لملايين السوريين، وبروز هوياتٍ سوريّة متعدّدة ومتقاتلة على أسسٍ قومية وطائفية وعشائرية ومناطقية. وهناك انهيار اقتصادي كبير. الأسوأ في ذلك كله الهيمنة المطلقة للخارج، خصوصاً روسيا وإيران وتركيا، على الوضع السوري برمته، نظاماً ومعارضةً. هذا هو الواقع الجديد، وهو يتجاوز ما تطرق إليه غليون، وما حاول العبدالله التركيز عليه.
العربي الجديد
————————————————
أسئلة البدايات في الثورة السورية/ بسام يوسف
في أشهر الثورة السورية الأولى، بعد أن زج نظام الطغيان جيشه السوري في حرب ضد شعبه السوري، قد بدا واضحاً لجميع السوريين: أن ما يقوم به جيشهم السوري وأجهزة السلطة الأمنية، أو مجموعات “الشبيحة” المرافقة والداعمة والمعززة له ولها، لا ينسجم مع هدف إخماد الثورة في المناطق الثائرة فقط. وكان السؤال الذي بدأ السوريون يسألون بعضهم بعضاً عنه بعد معرفة تفاصيل اقتحام الجيش وحواشيه لـ”درعا البلد”، ولـ “حي الرمل الجنوبي” في اللاذقية، هو: لماذا كانت قوات الجيش السوري، وقوات أجهزته الأمنية، تتعمد تخريب البيوت في الأحياء والقرى والبلدات التي تدخلها، وتجعلها غير قابلة للسكن؟
كان هذا النهج واضحاً ومتعمداً منذ الأشهر الأولى، ولم يكن التبرير بالفوضى التي ترافق الحرب عادة، أو بالضرورات العسكرية، تبريراً مقنعاً لأي أحد؛ لقد كان تخريب البيوت، ونهب محتوياتها، حتى تصبح العودة إليها والعيش فيها مستحيلاً من بين المستحيلات، يؤكد أن لابد أنه عمل منهجي متعمد، قد باشروا تطبيقه منذ الأشهر الأولى من عمر الثورة السورية.
إذاً، منذ البداية لم يكن تهجير السوريين من بيوتهم ومدنهم أمراً اضطرارياً، فرضته ضرورات المعارك ووقائع الحرب؛ لأن التهجير قد كان هدفاً، مخططاً له ومرغوباً فيه، هدف قد تتالت تهيئة مقدماته اللازمة، وجرى تمكين عوامل استدامته لجعله دائماً.
وعلى هذا يمكن القول: إن عمليات التهجير من بابا عمرو في حمص، قد كانت الأكثر وضوحاً، والمشغول عليها بتركيز أكبر وبتخطيط أدق، وأنها كانت البداية التي ستتوالى لاحقاً في أحياء المدينة كلها، وفي كل المناطق التي حوصرت ثم تم اقتحامها لاحقاً، في مناطق أخرى. ومع ذلك، في البداية لم يكن تحديد الجهة التي سينتقل المهجرون إليها مهماً؛ لقد كانت الخطة تتطلب- حينها- أن تفرغ المناطق تباعاً.
لقد أفرغت حمص من سكانها “السنّة” بخطة منهجية، كان قد خططها، وأشرف عليها، وقادها قاسم سليماني الذي كان يدير معركة “نظام الحكم السوري” ضد الشعب السوري، ومنذ البداية كان قد خطط سليماني لتهجير دائم، ومنذ البداية كان قد تقصد الفظائع، وتعمد ارتكاب المجازر من دون أي حاجة عسكرية أو أمنية لها؛ كي يستحيل الرعب نفسه إلى قوة تهجير؛ تدفع الناس دفعاً إلى مغادرة بيوتهم وأراضيهم وبلدهم. وأيضاً منذ البداية، قد خطط، وكرس، وأراد تأسيس بنية عسكرية خاصة؛ لتكون أداة تنفيذ مشروعه الطائفي الإجرامي؛ فكانت كتائب الدفاع الوطني، كما شاء أن يسميها، لأنه قد كان يعرف جيداً: أن هذه المجازر البشعة التي تحمل تصنيفاً طائفياً، لابد تحتاج إلى بنية فاشية خاصة؛ كي تقدم على ارتكابها وإنجازها وحراستها.
وفي المراحل التالية، وبعد أن ازدادت الأحياء والبلدات والقرى التي أرغم أهلها على مغادرتها، كان لابد من إعادة صياغة خطط التهجير وإستراتيجياتها؛ كي لا تترك بلا ضوابط، خصوصاً وأن القيادة الإيرانية -والسورية- التي تنسق المعركة ضد الشعب السوري، ظلت تريد، وترغب، من السوريين المهجرين مغادرة سوريا إلى أبعد ما يمكن وإلى أبد الآبدين، أو لجوئهم- إذا كان لابد من ذلك لحسابات واقعية- إلى مناطق حدودية مع دول مجاورة. لكن المهجرين السوريين الذين راحوا ينتقلون من تهجير إلى آخر داخل المدن السورية، ألزموا الوحش بتغيير خطته؛ ولهذا اختيرت محافظة إدلب؛ لتكون المنطقة التي يدفع إليها السوريون الذين لا يريدون مغادرة سوريا.
لم تكن مقولة المجتمع المتجانس التي أطلقها بشار الأسد محض مقولة عابرة. نعم، لقد كانت الخطة التي وضعها سليماني وبقية طاقمه الذي أدار الصراع بين الطغمة الحاكمة والشعب السوري، تقتضي التخلص من أكبر عدد ممكن من الشعب السوري الرافض لاستمرار حكم عائلة الأسد؛ أي الشعب الذي يوصم بتصنيف طائفي واحد، والذي ينبغي التخلص منه، سواء أكان بالقتل أم بالتهجير، حتى إن تطلبت عملية التخلص خسارة مناطق جغرافية من سوريا.
بناء على هذا، يمكننا أن نفسر، أو نفهم، لماذا تعمد النظام تخريب البيوت وجعلها غير قابلة للعيش، ولماذا كان يرتكب المجازر البشعة، ويتعمد توسيع انتشار تفاصيلها؛ كي لا يفكر أحد من المهجرين بالعودة إلى المناطق التي انتزع منها.
نعم، لقد فضل السوريون البقاء في مخيم الركبان بالغ السوء، الذي تكاد تكون الحياة فيه حكماً بالإعدام، على العودة إلى تحت سيطرة النظام، ونعم لقد بقي مئات آلاف السوريين في العراء تحت أشجار الزيتون، رغم البرودة الشديدة، وفي خيام رقيقة لا تحمي من برد ولا من حر ولا من خطر، ولم يفكروا أن يتجهوا إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام.
ولم يكن اعتباطاً من جوقة النظام نشرهم صور جثة “أحمد جفال”، الرجل الفقير المسن الذي يعمل في جمع النفايات البلاستيكية من شوارع معرة النعمان، والذي رفض بشدة الخروج من معرته عندما اقتربت قوات النظام منها، ولكن قوات الأسد قتلته، واحتلت جثته بعد أن احتلت المدينة، ومثلت بها.
إذاً، لماذا يحارب النظام بكل هذه الشراسة لاستعادة إدلب، كأنه لم يوافق مسبقاً بألّا تكون له، هل استفاقت فيه نخوته الوطنية، أم هل فكر أن بإمكانه تهجير جميع أهلها إلى تركيا، أو حصرهم بشريط حدودي ضيق، وبالتالي عودة المدن الفارغة إلى سيادته بعد أن هجّر أهلها، ومثّل بهم.
ألهذا يزج بشار الأسد- بمنتهى الحماقة- بما تبقى لديه من قوات في معركة لا تعنيه يافطتها الوطنية أبداً؛ لأن الوطن بالنسبة إليه: كرسي، ومكب نفايات أولاً وآخراً. وبالتالي: لا يعنيه عدد من سيقتل من قواته في هذه المعركة التي أسس هو لهزيمته بها؛ فهؤلاء الذين يتواصل تدفق نعوشهم من جبهات القتال إلى المناطق السورية، ليسوا أكثر من عبيد لا يستحقون أكثر من منحهم رتبة من سلم رتب يمنحها من خان وطنه وشعبه.
كل ما يريده بشار الأسد، ومن أمامه ومن خلفه الروس، بعد أن أزاحوا الإيرانيين من قيادة المعركة، هو أن يوسعوا مساحة سوريا التابعة لهم ما استطاعوا. أما السيادة والوطن والكرامة والشعب فهي ليست أكثر من مفردات يرشها بشار الأسد وعصابته فوق الدم المهدور؛ كي يتمكن الحمقى من مواصلة وهمهم.
تلفزيون سوريا
————————————————-
ثوار أم مرتزقة؟/ حسام الدين درويش
قصة «ثائرٍ/نازحٍ سوريّ»: كيف (لا) يتحوَّل الثائر إلى مرتزِق؟
مَنْ يكتُبْ حكايته يَرِثْ
أَرضَ الكلام، ويمْلُكِ المعنى تمامًا
محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيدًا.
لكلمة «مرتزِق» معانٍ سلبيةٌ معياريًّا. ووفقًا لمعناها الأولي، تحيل الكلمة على كسبٍ للرزقٍ، كسبًا غير مقبولٍ، لسببٍ ما. فالعسكري المرتزِق هو الذي يقاتل من أجل المال، بالدرجة الأولى، لا من أجل قضيةٍ أو قيمةٍ يؤمن بها. وفي السياق السوري الراهن، كثيرًا ما استُخدم هذا المفهوم، أو ما يشابهه (مفهوم العميل، مثلًا)، للنيل من هذا الطرف أو ذاك. فالنظام الأسدي أنكر وجود من يتظاهر من أجل الحرية والديمقراطية والكرامة، وقال بأن من يرفعون هذه الشعارات إنما يفعلون ذلك، لقاء «سندويشات شاورما»، ومبالغ ماليةٍ، من أطرافٍ أجنبيةٍ. وفي السنوات القليلة الماضية، ازداد وصف كثيرٍ من «المعارضين السوريين» بالمرتزقة، نتيجة لتحولهم إلى «صبيانٍ» أو «أُجراء» لهذه الدولة أو تلك، وإلى ناطقين باسمها، وخدمٍ لمصالحها، ومنفذين طائعين وصاغرين ومُستصغَرين لإيديولوجيتها وسياساتها وأوامرها وتعليماتها وتوجيهاتها، بطريقةٍ مهينة، ليس لسوريتهم وللثورة التي يمثلونها فحسب، بل ومهينةٍ أيضًا لإنسانيتهم، بالدرجة الأولى.
وقد تكثَّف استخدام مصطلح «مرتزقة»، في الفترة الأخيرة، للحديث عن السوريين المنخرطين في الفصائل والميليشيات التي شاركت الحملات العسكرية التركية في سوريا: «درع الفرات»، «غصن الزيتون»، «نبع السلام». واكتسب وصف هؤلاء السوريين ﺑ «المرتزقة» زخمًا أكبر، ومصداقيةً أقوى، مع الأنباء التي تحدثت عن إرسال تركيا لمقاتلين سوريين إلى ليبيا. ويبدو وصف «مرتزقة» دقيقًا جدًّا، لغويًّا، عند الحديث عن هؤلاء الأشخاص. فوفقًا لمعجم اللغة العربية المعاصرة، المرتزقة هم «من يحاربون في الجيش طمعًا في المكافأة المادية، وغالبًا ما يكونون من الغرباء» (ص 884). وينطبق هذا التعريف على المقاتلين السوريين المرسلين إلى ليبيا، على الأرجح، لكن، إلى أي حدٍّ، ينطبق هذا التعريف على السوريين المنتمين إلى الفصائل والميليشيات الخاضعة لتركيا، و/أو المشاركة في حملاتها العسكرية؟ وإلى أي حدٍّ، يستحق هؤلاء المشاركون الحمولة المعيارية/ الأخلاقية السلبية المرتبطة عادةً بهذا الوصف؟
لا بد من الإشارة إلى أن معظم الموصوفين ﺑ «المرتزقة» هم من بيئةٍ ثائرةٍ/نازحة. فهي بيئةٌ ثائرةٌ ضد النظام الأسدي، بمعنى أن معظم أفرادها أعلنوا، صراحةً، تأييدهم للثورة السورية ضد هذا النظام؛ وهي بيئةٌ نازحةٌ، بمعنى أن قسمًا كبيرًا من هؤلاء «المرتزقة» نازحون من بيوتهم، وكانوا و/أو ما زالوا يقيمون في مخيماتٍ في المناطق السورية الخاضعة للنفوذ التركي. فهل تحوَّل بعض «أبناء الثورة السورية» من «ثوارٍ» أو «مشاريع ثوِّارٍ» إلى «مرتزقةٍ»؟ وكيف؟ وما هي سمات الواقع الموضوعي الذي حصل، أو رُفض، فيه هذا التحوُّل؟ للإجابة عن هذه الأسئلة وما يماثلها، وسرد قصة هذا التحول وذاك الرفض، تواصلت مع أحد القاطنين في أحد مخيمات النازحين في الشمال السوري، «محمد»، وسأحاول، فيما يلي أن أسرد جزءًا من قصته، وقصة كثيرين من أمثاله.
كان محمد من أوائل المتظاهرين في مدينة حلب، قبل أن يضطر إلى النزوح إلى بيت أهله في ريفها. في شباط 2016، اضطر محمد إلى النزوح مجدّدًا، بسبب القصف الروسي ـ الأسدي، والهجوم البري المتزامن لقوات النظام وقوات «بي كي كي/ الأكراد»، التي استولت لاحقًا على قريته وعلى المناطق المحيطة بها. ومنذ ذلك الوقت يقيم محمد في أحد المخيمات المقامة قرب مدينة إعزاز. إن معاناة سكان المخيمات من العيش في خيمةٍ هي «أشبه بقبرٍ»، وفقًا لتعبير محمد، ومن شروط الحياة بالغة الصعوبة، والمتعلقة باهتراء خيمهم، وترابية/ طينية أراضي المخيمات، وصعوبة الحصول على ما يحتاجونه من غذاء ومياه ودواءٍ ووقود للتدفئة، بالإضافة إلى سوء أوضاع المجال التعليمي، و«عيشة الشحادين» التي يعيشها عمومًا، واعتمادهم الدائم على «رزق الطير» وعلى مساعدات أو إغاثة منظماتٍ وأفرادٍ لا يمكن التعويل أو الاعتماد عليهم وحدهم، ولا الثقة في استمرار دعمهم، وعجز معظم الثائرين/ النازحين عن تأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة لهم ولأسرهم وأهلهم، هي أمورٌ ينبغي أخذها في الحسبان، عند التفكير في كيفية تحوُّل بعض الثائرين/ النازحين إلى «مرتزقةٍ».
إذا وضعنا مجالات العمل الخاصة بعدد قليلٍ من الناس، نجد أن العمل لدى إحدى الفصائل «المرابطة» قرب المخيمات، وعلى الحدود مع قوات النظام الأسدي أو قوات «بي كي كي/ الأكراد»، هو مصدر الرزق الوحيد المتاح لكثيرٍ من الثائرين/ النازحين. ويزداد إغراء العمل، لدى هذه الفصائل، وتحت الإمرة التركية، عندما يقبل الشخص المشاركة في الحملات العسكرية التي تقودها تركيا في الأراضي السورية، والتي تمثلت حتى الآن في عمليات «درع الفرات»، و«غصن الزيتون»، و«نبع السلام». فالمشاركون في هذه الحملات يتلقون رواتب أكبر بضعفٍ، أو أكثر، من الرواتب التي يتلقاها أفراد الفصائل عادةً.
في الفترة الأولى التي تلت عملية النزوح، انضم محمد إلى إحدى الفصائل العسكرية العاملة في المنطقة، واقتصر عمل ذلك الفصيل، حينها، على حراسة المخيمات وحراسة المناطق الحدودية مع النظام السوري وقوات «بي كي كي/ الأكراد». وقد كان ﻟ «الراتب الشهري» الذي يدفعه الفصيل لأفراده دورٌ في هذا الانضمام؛ لكن محمد شدَّد على أن غايته الأساسية والأهم، من هذا الانضمام، كانت المشاركة في «تحرير سوريا»، عمومًا، وتحرير قريته والمناطق المحيطة بها، خصوصًا. الراتب الشهري الذي كان يتلقاه محمد هو «100 دولار أميركي». وبعد إنشاء «الجيش الوطني»، وسيطرة تركيا سيطرةً كاملةً على كل الفصائل، أصبح أفراد هذا الجيش يتلقون راتبهم بالليرة التركية (400 ليرة تركية). كانت هناك استثناءاتٌ قليلةٌ؛ فمن كان يتلقى تمويلًا من «الموك» – المنضمون إلى «لواء المعتصم»، على سبيل المثال – كان يقبض 300 دولار شهريًّا.
بقي محمد يعمل مع فصيلٍ عسكريٍّ لمدة سنتين ونصف تقريبًا، واقتصر عمله، خلال تلك الفترة، على «المرابطة» الدورية في إحدى نقاط الحراسة القريبة من المخيم؛ لكن الشعور بعدم الارتياح من هذا العمل، والرغبة في تركه، ازدادا تدريجيًّا، لدى محمد، إلى أن حسم أمره، وترك العمل مع الفصائل المسلحة، نهائيًّا. وفي تفسيره لسبب تركه ذلك «العمل»، يذكر محمد مجموعةً من الأسباب أو العوامل الأساسية. السبب الأول هو ازدياد قناعته بأن الأمر، في المجال العسكري على الأقل، قد خرج من يد السوريين. فتركيا أصبحت، أكثر فأكثر، هي الآمرة الناهية: فهي التي تتحكم بتمويل الفصائل، وتعيين قادتها والمسؤولين عنها، وهي التي تفرض خطة عملها، والمعارك التي ينبغي لها خوضها، والمعارك التي ينبغي لها الامتناع عن خوضها. وقد بلغ تحكم الأتراك بتلك الفصائل ذروته، خلال تشكيل «الجيش الوطني»، وبعد هذا التشكيل؛ حيث أصبح لزامًا على كل أفراد هذا «الجيش» أن «يبصموا»، لدى الجانب التركي، وأن يتلقوا «رواتبهم» بالعملة التركية، بعد انقطاع كل أقنية الدعم المادي الأخرى، أو تنظيمها بحيث تمر عبر الجانب التركي، حصرًا.
شعر محمد أن العمل مع الفصائل قد أصبح أشبه بعمل المتطوعين أو المحترفين، وتوقف عن كونه «عملًا ثوريًّا»، أو من أجل الثورة. فلم يعد هناك دلائل، أو حتى مؤشرات وقرائن، على أن عمل هذه الفصائل يستهدف مواجهة النظام السوري وتحرير الأراضي التي ما زالت بحوزته. كما تبددت آماله في أن تعمل الفصائل على تحرير قريته، وبقية المناطق التي «تحتلها» قوات «بي كي كي/ الأكراد»، والتي لا تبعد عن مخيمه إلا كيلومتراتٍ قليلةٍ.
القيادة الأجنبية للفصائل المقاتلة، والتحكم الكامل بنشاطاتها وتحركاتها وتمويلها وأهدافها، كانا السبب الأكبر الذي جعل محمد ينسحب من العمل العسكري مع الفصائل. كان محمد راغبًا بشدةٍ في وجود فصائل وطنيةٍ بأجندةٍ سوريةٍ/ وطنيةٍ، وبقيادة سوريةٍ/ وطنيةٍ من «أهل الثورة»، من أمثال عبد القادر الصالح، ويوسف الجادر (أبو الفرات) وعبد الباسط ساروت. وقد عبَّر محمد عن إحباطه وأسفه الشديدين، لأن ذلك لم يعد موجودًا، غالبًا أو عمومًا، وهذا ما دفعه إلى الانسحاب والانطواء، بعد محاولاتٍ عديدةٍ فاشلةٍ قام بها، لتنظيم الناس المحيطين به، في إطار تنظيمٍ محليٍّ وطنيّ.
بعد انسحاب محمد من العمل العسكري (مع الفصائل)، حاول أن يكسب رزقه، من خلال بسطةٍ صغيرةٍ، لبيع القهوة والشاي. ونظرًا لضعف المدخول، تعلَّم محمد كيفية صنع بعض أنواع الحلويات، وأصبح يصنعها بنفسه، في خيمته (أيضًا)، ويعرضها للبيع. لكن العائد المادي بقي ضعيفًا، لأسبابٍ عديدةٍ، يأتي في مقدمتها ضعف الإمكانات المادية لدى الغالبية الساحقة/ المسحوقة من سكان المخيم. فقلةٌ منهم فقط يسمح لهم وضعهم المادي برفاهيات شراء الحلويات، أو حتى فنجانٍ أو كأسٍ من الشاي أو القهوة.
وعلى الرغم من الضائقة المالية الكبيرة التي يعيشها باستمرارٍ، وعجزه، مع كثيرين، عن تأمين أبسط متطلبات الحياة الكريمة، له ولبقية أفراد أسرته، لم يبدِ محمد أي إشارة على كونه نادمًا على ترك العمل العسكري مع الفصائل. وقد ازدادت قناعته بصحة قراره، بعد عمليتي «غصن الزيتون» و«نبع السلام» التركيتين. لكن موقفه الشخصي من الفصائل والقيادة الأجنبية/ التركية لها، لا يجعله في موقف رافضٍ بالكامل للمنتمين إلى هذه الفصائل والعاملين معها، من جهةٍ، وللدور التركي في سوريا، عمومًا من جهةٍ أخرى. وسأفصِّل فيما يلي وجهة نظره، في خصوص هاتين المسألتين.
يميِّز محمد بين ثلاثة أسباب رئيسةٍ تدفع الناس إلى الاستمرار في الانتساب إلى فصائل «الجيش الحر/ الجيش الوطني»، والانخراط في صفوفه، والقتال معه.
من جهةٍ أولى، هناك أشخاصٌ ما زالوا يرون أن هذه الفصائل تمارس دورًا إيجابيًّا في تحرير مزيدٍ من المناطق الخاضعة لاحتلال النظام الأسدي أو قوات «بي كي كي/ الأكراد» أو الدواعش (سابقًا)، أو حماية «المناطق المحررة»، من القوى المذكورة أو من غيرها من القوى. ويعتقد هؤلاء الأشخاص أن خضوع مزيدٍ من المناطق لسيطرة «الجيش الحر/ الجيش الوطني» كان و/أو سيكون له آثار إيجابية على سكان المناطق المحررة، سابقًا ولاحقًا، كما سيكون له وزنٌ وأهميةٌ كبيرةٌ، في أي مفاوضاتٍ سياسيةٍ مستقبليةٍ، مع النظام الأسدي أو غيره، في خصوص مستقبل سوريا. ولا ينكر معظم هؤلاء الأشخاص وجود سلبياتٍ كثيرةٍ وكبيرةٍ في «عمليات التحرير»، لكنهم يرون أن وجود الفصائل المسلحة، والانتساب إليها، والمشاركة معها في «عمليات التحرير»، و/ أو عمليات الدفاع و«حماية الأراضي المحررة» من هجمات «الأعداء»، يمثل الخيار الأفضل، أو بالأحرى، الخيار الأقل سوءًا، بين الخيارات المتاحة. فالبدائل المتاحة كلها أسوأ بامتيازٍ.
من جهةٍ ثانيةٍ، هناك أشخاصٌ ينضمون إلى هذه الفصائل المسلحة، ويقاتلون معها، تحت ضغط الحاجة المادية، بالدرجة الأولى. فغايتهم الأساسية هي الحصول على «الراتب الشهري» و«المكافآت المالية»، ليستطيعوا أن يؤمنوا لأنفسهم، ولأفراد أسرهم، حاجاتهم الأولية من طعامٍ وماءٍ ولباسٍ وعنايةٍ طبيةٍ وما شابه. وهم يجدون أن الانضمام إلى إحدى الفصائل هو السبيل الوحيد لتحقيق هذه الغاية. وبسبب ضآلة المبالغ المالية التي يتلقاها أفراد الفصائل عمومًا، والتخفيض المتكرر للرواتب، أو توقف معظم الفصائل المتكرر عن دفع «الرواتب المالية»، مراتٍ عديدةٍ، يجد هؤلاء الأفراد أنفسهم في حالاتٍ متكررةٍ من العوز المادي، وبسبب ذلك، تكون أمامهم أحد الخيارات الثلاث التالية: إما الاستمرار في العمل لدى الفصائل، بوصفه أفضل الخيارات الممكنة، أو أقلها سوءًا، وتحمل «ضنك العيش»، عند انقطاع الرواتب المالية خصوصًا، مع محاولة إيجاد عملٍ أو موردٍ ماليٍّ إضافيّ؛ أو ترك العمل لدى هذه الفصائل والبحث عن فرص عملٍ أخرى (فتح بسطة، مثلًا وخصوصًا، كما فعل محمد)، أو الاشتراك/ التطوع في الحملات العسكرية التركية، نظرًا إلى أن الأتراك يضاعفون رواتب من يشارك في مثل هذه الحملات عادةً.
من جهةٍ ثالثةٍ، هناك أشخاصٌ ينضمون إلى الفصائل/ «الجيش الوطني»، بهدف الاستفادة من موقعهم، في ممارسة عمليات التعفيش، التي تحدث خصوصًا أثناء الحملات العسكرية على مناطق جديدةٍ. وقد لا يحتاج مثل هؤلاء الأشخاص إلى محاولة تبرير أو تسويغ لصوصيتهم وممارساتهم التعفيشية، لكن ليس نادرًا أن يبرروا أفعالهم بسوء أوضاعهم المالية و/ أو بأنهم كانوا ضحايا سابقين لعمليات تعفيشِ من هذه الجهة أو تلك، وأن ما يفعلونه هو مجرد استردادٍ لحقوقهم والثأر من الجهة التي مارست ذلك التعفيش بحقهم، و/ أو بأنهم يمارسون حقهم الطبيعي في الحصول على «الغنائم»، وفقًا لما كان يفعله المسلمون الأوائل، و/ أو بأنه من الأفضل أن يحصلوا، هم، على هذه الغنائم، بدلًا من تركها للصوصٍ آخرين غير مستحقين لها، أو بدلًا من تركها مشاعًا وغير مستخدمةٍ بسبب هروب أهلها أو نزوحهم. من الواضح تهافت الحجج المقدمة لتسويغ ما يبدو، لوهلةٍ أو أكثر، أنه غير قابلٍ للتسويغ. لكن الفوضى السائدة في «المناطق المحررة» عمومًا، وفي المخيمات، وخلال الحملات العسكرية خصوصًا، تترك آثارًا عميقةً وكبيرةً على الأخلاقيات السائدة عمومًا. وسأعود لاحقًا إلى هذه النقطة.
الأسباب الثلاثة المذكورة لا توجد منفردةً وبمعزلٍ عن بعضها بعضًا، بل غالبًا ما يكون اثنان منها، على الأقل، حاضرين، لدى الشخص نفسه. وليس هناك تعارضٌ ضروريٌّ بين الانضمام إلى أحد الفصائل، على أساس وجود قناعةٍ بإمكانية إسهام هذه الفصائل، وذاك الشخص، في عمليات «تحرير الأراضي المحتلة»، من هذا الطرف أو ذاك، والتصدي للتهديدات المحيقة ﺑ «الأراضي المحررة»، من جهةٍ، والانضمام إلى هذه الفصائل، بسبب العوز المادي، و«طمعًا» في الرواتب والمكافآت المادية، من جهةٍ أخرى، فيمكن للسببين أن يكونا حاضرين معًا، عند كثيرٍ من الأشخاص، وفي كثيرٍ من الحالات. كما لا يوجد تناقضٌ ضروريٌّ بين الانضمام، بسبب الحاجة المادية، والانضمام، طمعًا في الغنائم، وسعيًا إلى ممارسة عمليات التعفيش، عند وجود الفرصة لذلك.
السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: إلى أي مدى يمكن أن ينسجم السببان الأول والثالث معًا: الرغبة في نصرة الثورة والثائرين، وتحرير الأرض والناس، من جهةٍ، وتقبُّل، أو حتى مجرد قبول، عمليات النهب والتعفيش، وفق ذهنية الغنائم، التي جرت في العمليات التركية الثلاث، من جهةٍ أخرى؟ من الواضح أن عمليات التعفيش المذكورة تحاكي، ليس ما قام به جنود النظام الأسدي، مرارًا وتكرارًا، في مناطق سوريةٍ مختلفةٍ، فحسب، بل وتحاكي أيضًا ممارسات نخبه السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، القائمة على الفساد واللصوصية والإفساد. وبذلك فإن ممارسي عمليات التعفيش إنما يعيدون إنتاج النظام الأسدي، أكثر مما يعملون على إسقاطه وتغييره، وفقًا لمزاعمهم. لا شك أن هؤلاء «المعفشين الصغار» يعيشون في ظروفٍ مختلفةٍ، اختلافًا كبيرًا، عن ظروف «المعفِّشين الأسديين الكبار»، فأوضاعهم وأوضاع أهاليهم وأطفالهم مزريةٌ غالبًا، وليس أمامهم كثيرٌ من الخيارات الجيدة، لكن إلى أي حدٍّ يمكن أن يفضي هذا الاختلاف إلى اختلافٍ في تقييمهم، بوصفهم مرتزقةً ومعفِّشين؟
يمكن استخدام هذا التمييز/ التمايز بين أنواعٍ أو أنماطٍ مختلفةٍ من الأسباب والأشخاص، في إقامة التمييز، أو إظهار التمايز، بين الفصائل العسكرية العاملة في تلك المنطقة. صحيحٌ أن جميع هذه الفصائل خاضعةٌ لتركيا، لدرجةٍ أو لأخرى، إلا أن هذا لا يعني أنه لم يعد هناك قضية سورية بالنسبة إليها جميعًا. فمن ناحيةٍ أولى، معظم الفصائل والأشخاص المنتمين إلى «الجيش الحر/ الجيش الوطني» لم تشارك في الحملات التركية الثلاث المذكورة. والمشاركة طوعيةٌ دائمًا، بمعنى أنه ليس هناك ضغطٌ على أي فصيلٍ أو شخصٍ، للمشاركة في أي معركةٍ أو حملةٍ عسكريةٍ. وقد امتنع عددٌ كبيرٌ من الفصائل والأفراد المنتمين إليها، عن المشاركة في الحملات التركية الثلاث. صحيحٌ أن فصائل «الجيش الحر» انضوت كلها في التنظيم الجديد، لكن هذا لا يعني أن هذه الفصائل، أو أعضاءها، قد فعلوا من أجل المال (فقط). الخضوع للإشراف التركي في التنظيم، وعدم فتح معركة إلا بإذنه، وعدم اجتياز الحدود الحالية ﻟ «المناطق المحررة» إلا بإذنٍ تركيٍّ، لم يكن، كل ذلك، خيارًا، بالمعنى الكامل للكلمة. فكل البدائل هي خياراتٌ ميتةٌ، لأنها أسوأ بكثيرٍ، ولا يمكن قبولها أو تحمل كلفتها، بحالٍ من الأحوال. فالبدائل تتمثل في الاستسلام للنظام الأسدي، على سبيل المثال، أو التخلي عن حماية تركيا ومساندتها المادية والمعنوية الضرورية جدًّا؛ أو حتى استعدائها والدخول في معركةٍ خاسرةٍ معها، أو مع النظام الأسدي وحليفه الروسي.
خضوع الفصائل وأفرادها، للإشراف التركي، بحد ذاته، وللحدود العامة التي يضعها، لا يعني التحول بالضرورة إلى مرتزقةٍ. فبغض النظر عن عدم انطباق التعريف الاصطلاحي ﻟ «الارتزاق» على هذه الفصائل وهؤلاء الأفراد، لكونهم يقاتلون في أرضهم وليس في أرضٍ اجنبيةٍ، ثمة شكوكٌ كبيرةٌ في انطباق التعريف الشعبي المعياري على بعض هذه الفصائل، على الأقل، وعلى الكثيرين من أفرادها.
هناك من فقد ثقته بكل «الفصائل المعارضة» وبكل أفرادها، ولم يعد يرى أي معنى للحديث عن «الجيش الحر»، لا من حيث الوجود، ولا من حيث القيمة الإيجابية. ومع الإقرار بوجود مسوغاتٍ، كثيرةٍ وكبيرةٍ، لهذه النظرة السوداوية العدمية، هناك ضرورةٌ عمليةٌ، بل ونظريةٌ، معرفيةٌ ومعياريةٌ، للتمييز بين ما يسميه محمد، مع كثيرين في المخيمات وتلك المناطق عمومًا، «فصائل الجيش الحر»، والفصائل التي أوجدتها تركيا وصنعتها، لتنفيذ مآربها الخاصة. فهذه الفصائل الأخيرة تختلف، اختلافًا جذريًّا، عن الفصائل المنسوبة ﻟ «الجيش الحر/ الجيش الوطني». ويتمثل الاختلاف في أن فصائل التي شكَّلتها تركيا لا علاقة لها، من حيث المبدأ، بالثورة السورية ضد النظام الأسدي، ولا تُعتبر جزءًا منها، ولا تعتبر هي نفسها ذاتها جزءًا منها. فهذه الفصائل أنشأتها تركيا منذ سنواتٍ قليلةٍ، لتنفذ بها بعض مآربها/ سياساتها. ومعظم أفراد هذه الفصائل هم محترفون أو مرتزقة، بالمعنى الشعبي الدقيق للكلمة. فهم لا يقاتلون من أجل قضيةٍ ما، يؤمنون بها وبقيمها، وإنما يقاتلون، حصرًا وأساسًا، من أجل الحصول على المال (الرواتب والمكافآت والغنائم)، وربما الجنسية ومنافع أخرى. وهؤلاء، تحديدًا أو خصوصًا، هم من يصفهم محمد، وكثيرون غيره، ﺑ المرتزقة. وقد أصر محمد على وجوب الابتعاد عن لغة التعميم، عند الحديث عن أفراد هذه الفصائل، فليس مستبعدًا، من وجهة نظره وجود عناصر غير مرتزقةٍ بينهم، من حيث أنهم انتسبوا إليها، بناءً على اعتقادهم بأنها تخدم أهداف «القضية العادلة» التي يقاتلون من أجلها. وعندما سألت محمد عن معلوماته عن «المقاتلين السوريين» الذين قيل إن تركيا قد أرسلتهم إلى ليبيا، قال لي إنه لا يعلم عن الأمر شيئًا، وإنه، على حد علمه، لم يكن هناك أي عرضٍ على أفراد الفصائل المنتمية إلى «الجيش الحر/ الجيش الوطني»، للذهاب إلى ليبيا. وبعد أن سأل أحد قادة فصائل «الجيش الحر/ الجيش الوطني»، أخبرني بأنهما اتفقا على أنه لم يذهب أحد من أفراد هذه الفصائل إلى هناك، وعلى أن الفصيل الذي يفعل ذلك هو مرتزقةٌ، وهو، على الأرجح، من الفصائل التي شكَّلتها تركيا؛ «وكل واحد بدو يروح هاد باع دينو وأرضو»، من وجهة نظرهما.
تبدو نظرة محمد، وكثيرين غيره، إلى الدور التركي في سوريا، خلال السنوات الأخيرة، بالغة التركيب والتعقيد، ومتعددة الأبعاد المعيارية. فبالنسبة إليهم، تركيا ليست عدوًّا لهم، فهي من ساعدتهم على أن يجدوا، في الأراضي السورية، مكانًا آمنًا من خطر القصف الأسدي أو الروسي أو الأميركي، ومن خطر قوات النظام الأسدي وقوات داعش و«قوات بي كي كي/ الأكراد». ويشعر محمد، مع كثيرين، بامتنانٍ بالغٍ، بسبب قدرتهم على البقاء، حتى الآن، في أرضهم، في سوريا. فهذا البقاء يعطيهم شعورًا بإمكانية العودة إلى بيوتهم وقراهم مستقبلًا، ولو بعد حينٍ؛ كما أن هذا البقاء يجنبهم شعور اللاجئ بأنه مقيمٌ في أراضي الآخرين. وقد وصف محمد تركيا بأنها كالقشة التي يتمسك بها الغريق. فمع اعتقاد السوريين في تلك المنطقة أن العالم كله قد تخلى عنهم، فإنهم يشعرون بالامتنان للوجود التركي الذي جنَّبهم العودة إلى ويلات النظام الأسدي. فالأتراك أصدقاءٌ، فقط، مقارنةً بالقوى والدول الأخرى.
وليس لدى أمثال محمد أوهامٌ، في خصوص دوافع تدخل الاتراك، فهو يعرف، حقَّ المعرفة، بديهية أن ما يفعله الأتراك إنما تحركه مصالحهم الخاصة، وقد أظهرت عمليات «درع الفرات» و«غصن الزيتون» و«نبع السلام» ذلك بوضوحٍ شديدٍ، لكنه يأمل أن تتقاطع مصالح الأتراك مع مصالح السوريين النازحين/ الثائرين على النظام. ويسود الاعتقاد و/أو الأمل، لدى كثيرين، في أنه يمكن لتركيا أن تساعد هؤلاء السوريين على تحقيق بعض تطلعاتهم، وأنها ستفعل ذلك على الأرجح، حين لا يتعارض ذلك مع مصالحها الخاصة، وحين تسمح لها الظروف الدولية بذلك.
لكن مقابل هذا التقاطع المنشود، هناك التناقض المؤسف أو حتى الكارثي أحيانًا، بين مصالح تركيا ومصالح السوريين الثائرين/ النازحين. وقد ظهر هذا التناقض، ظهورًا فاقعًا، في عملية «غصن الزيتون» فبدلًا من أن تساعد تركيا الناس الراغبين في تحرير قراهم ومناطقهم من احتلال «قوات بي كي كي/ الأكراد» لها، وهي القرى والمناطق التي لا تبعد عن مخيماتهم إلا كيلومتراتٍ قليلةٍ، جنَّدت بعض سكان هذه القرى والمناطق المحتلة، واستغلت حالة الاحتقان والتوتر بينهم وبين «قوات بي كي كي/ الأكراد»، كما استغلت حاجتهم و/ أو مطامع بعضهم المادية، وزجتهم في حملتها على عفرين السورية، وما تضمنته هذه الحملة، أو أفضت إليه، من جرائم ومآسٍ وكوارث.
يتعامل الأتراك مع السوريين في تلك المناطق عمومًا، من موقع الأقوى والوصي، ويستفيدون من حالة تفاوت القوى بينهم وبين هؤلاء السوريين، وحاجة السوريين إلى من يعينهم على نوائب النظام الأسدي وحلفائه وأوضاعهم الكارثية. ولهذا لا يتهاون الأتراك، ولا يتسامحون، مع من يتجرأ على انتقادهم او مخالفة تعليماتهم وتوجيهاتهم. فلقد «صار لهم على الثائرين/ النازحين الضربة اللازمة»، على حد تعبير محمد. ولا يستسيغ محمد هذا التعامل الفوقي، وهو يحاول تجنب التعرض له، قدر المُستطاع. وهذا هو أحد أسباب تركه العمل مع الفصائل المسلحة، كما سبق وأن أشرنا. لكن، كل ذلك وغيره، لا يجعل تركيا عدوًّا، في نظر معظم الثائرين/ النازحين، المقيمين في تلك المخيمات والمناطق. فهم ليسوا في وضعٍ يسمح لهم باستسهال معاداة تركيا أو استعدائها. وحتى إذا سلَّمنا بأن تركيا هي عدوةٌ للسوريين الثائرين/ النازحين، أو ينبغي أن تكون عدوةً لهم في عيونهم، ينبغي حينها تفكيك ثنائية عدو-صديق، لتصبح تركيا العدو الصديق، أو العدو والصديق، في الوقت نفسه؛ فهي العدو الأقل سوءًا، لدرجةٍ تجعلها، مقارنةً مع الأعداء الآخرين، صديقًا لا يمكن الاستغناء عنه، في السياق الراهن، على الأقل.
خرج مصير السوريين من أيديهم، منذ فترةٍ طويلةٍ، خروجًا جزئيًّا ونسبيًّا، على الأقل. وما زال هناك أملٌ وإمكانيةٌ بألا تقتصر خيارات السوريين، على أن يكونوا إما مرتزقةً لا قضيةً لهم إلا مصالحهم الخاصة، أو يائسين منسحبين من العمل في مجال الهم العام و«القضية/ الثورة السورية». لا ينبغي، أو بالأحرى، لا يمكن للسوريين أن يتحولوا إلى مجرد «مرتزقةٍ»، بقدر ما يكون لديهم قضيةٌ يتبنونها، ويدافعون عنها، ويعملون على إنجاحها وتحقيق غاياتها، لما في ذلك من تحقيقٍ لمصالحهم وتطلعاتهم وقيمهم، في الوقت نفسه.
ربما أصبح واضحًا أن الارتزاق نتيجةٌ، أكثر من كونه سببًا، وأن معظم ضحاياه ورافضيه، والمهتمين أو المنهمين به، «على الأرض»، هم أكثر المتهمين، بل و«المهتوتين»، به. وفي وضعٍ لا ترى فيه القوى والدول صاحبة النفوذ والهيمنة و«القول الفصل»، في السوريين، إلا أدواتٍ لأجندتها، ووسائل لتحقيق أغراضها وغاياتها. لكن على الرغم من أنَّ «كل شيءٍ» قد يدفع للارتزاق ويسوِّغه، فإن معظم الناس المتهمين بالارتزاق، أو بدعمه، أو بكونهم «بيئته الحاضنة»، رافضون له، فعليًّا، من حيث المبدأ، وهم ضحاياه وضحايا ظروفٍ خارجةٍ عن إرادتهم، أكثر من كونهم مرتزقةً مسؤولين عن هذه الظروف وعن سوئها المتزايد.
تفاديًا لأي سوء فهمٍ محتملٍ، من الضروري التشديد على أن هذا النص لا يهدف، لا إلى متابعة (استسهال) إطلاق أحكام الإدانة المعتادة، في خصوص المرتزقة وارتزاقهم، ولا إلى الدفاع عنهم وتسويغ هذا الارتزاق، الفعلي أو المزعوم. فما يهدف إليه النص، تحديدًا أو خصوصًا، هو امتلاك فهمٍ أكبر لهذه الظاهرة، ومناقشة بعض الخطابات الرائجة في خصوصها، وتوضيح وجهة نظر كثيرين من المتَّهمين بها، بحقٍّ أو بدونه، واستنطاق معاناتهم، وإبراز أصواتهم المغيَّبة، أو مهمَّشة الحضور، وضعيفة التأثير، في مسألةٍ تخصُّهم، بالدرجة الأولى. إن الإنصات إلى هذه الأصوات، وأخذ منظورها في الحسبان، يحتَّم علينا التوقف عن استسهال إطلاق الأحكام والتعميمات، الفارغة معرفيًّا، والمسيئة أخلاقيًّا وسياسيًّا، في خصوص هذه المسألة. وفي مثل هذا السياق، لا بد للمعاش أن يكون حاضرًا، في التنظيرات والتقييمات، ومؤسِّسًا لها، جزئيًّا ونسبيًّا، على الأقل.
في سردي للظروف التي برزت فيها ظاهرة الارتزاق، حاولت أن أبين بعض الظروف التي حصل فيها تحول بعض الثائرين إلى مرتزقة، والتي شهدت في الوقت نفسه، رفض كثيرين لهذا التحول. ونظرًا إلى السمة الأخلاقوية السائدة أو الطاغية، في خطاب من يقتصر على إدانة الارتزاق و«المرتزقة السوريين»، بدون إقامة التمييزات، وضبط المصطلحات، وفهم أسس الظاهرة وأبعادها وحدودها، ينبغي لهم، ولنا جميعًا، الابتعاد عن استسهال التعميمات الجائرة، والحذر الشديد من إطلاق تلك التسمية على ضحايا الارتزاق، والمكتوين بناره ونار القوى التي تفرضه. فمن الضروري التشديد، في هذا الخصوص، على أن القسم الأكبر من الثائرين/ النازحين قد قاوم ظاهرة الارتزاق ورفضها، حتى حين بدا أن الارتزاق هو الخيار الأفضل، إن لم يكن الخيار الوحيد، المتاح أمامهم. ورفضهم للارتزاق نابعٌ من كونهم ضحايا له، وناتجٌ عن تبني معظمهم لقضيةٍ سياسيةٍ وأخلاقيةٍ هي قضيةٌ وجوديةٌ، قضيةُ وجودهم، أيضًا؛ لكونها تمس صميم هذا الوجود، وقيمته، في الوقت نفسه.
موقع الجمهورية
———————————–
الاجتماع الوطني السوري بين الخراب واحتمالات الترميم/ بكر صدقي
بصورة متوازية مع خراب العمران، تفكك المجتمع السوري أيضاً وباتت إعادة تجميعه من نوع “المهمة المستحيلة”. ومع ذلك لا تنفك تظهر محاولات جديدة كل حين وحين في شكل أحزاب وتيارات ومؤتمرات وتجمعات سياسية تعلن مبادئ الاجتماع السوري (المحتمل) فتكرر بعضها بعضاً، بغير فاعلية يمكن المراهنة عليها. يقال، في تبرير غياب الفاعلية هذا، إن مصير سوريا والسوريين قد خرج من أيديهم وبات رهن توافقات (أو تنافرات) القوى العظمى والإقليمية المنخرطة في الصراع والممسكة بأوراق التسوية السياسية التي، بدورها، لا تني تبتعد كالسراب.
على صحة هذا التقرير، فهو لا يفسر لماذا تنبت أطر سياسية جديدة، كل يوم، قبل أن تشيخ سابقاتها، مع أنها تكرر المبادئ ذاتها، وأحياناً يكون القائمون على إطلاق المبادرة الجديدة، هم أنفسهم، جزئياً أو كلياً، من أطلقوا مبادرات سابقة فشلت ولم يعلنوا عن دفنها.
لماذا لا يتم التمعن في الأوراق السياسية (بيانات تأسيس أو برامج سياسية أو إعلانات مبادئ… إلخ) بعين نقدية ترى الخلل في المبادئ المكرورة، بدلاً من البحث عنه خارجها؟ لماذا لا تتم مراجعة مبادئ لطالما بدت كبديهيات لا تقبل المناقشة؟ سأضرب مثالين ملحين: وحدة الأراضي السورية، وعلمانية الدولة.
غالباً ما نقرأ في الأوراق السياسية لأطر جديدة بنداً أساسياً يتحدث عن التمسك بالجغرافيا السورية “وطناً نهائياً لجميع السوريين”. إن كلمة “نهائياً” هذه تثير الذعر لدى مكونات لديها أحلام استقلالية كالكرد، كما لدى مكونات مذهبية لا يناسبها أن تحكم “إلى الأبد” من قبل “المكون الأكثري” (أي العربي السني). إن الموافقة على هذا المبدأ تبدو كالزواج الكاثوليكي الذي لا فكاك منه إلا بالموت.
ولكن هل الحل هو انفصال من يريد الانفصال، وتقطيع أوصال الأراضي السورية التي لا قبل لها بذلك بسبب مساحتها الصغيرة نسبياً؟ هل يمكن حقاً قيام عدة دويلات على أشلاء هذه المساحة المحدودة، وأن تكون قابلة للحياة؟
الجواب المرجح على هذين السؤالين هو النفي، بصرف النظر عن موقع من يعطي الجواب. مع ذلك يبقى تعبير “وطناً نهائياً” مثيراً للنفور، ليس فقط لدى مكونات عرقية أو ثقافية أو مذهبية لديها أحلام مختلفة، بل حتى لدى الأكثرية التي من حقها أن تحلم بوطن يتجاوز الحدود السورية الضيقة إلى مناطق مجاورة ينتمي سكانها إلى الهوية ذاتها (العربية السنية) مثلاً في بعض العراق وبعض لبنان والأردن.. إلخ. هذه ليست افتراضات مجردة أو متخيلة، على أي حال، بل سبق وتحققت بأشكال مختلفة في تاريخ سوريا الحديث، أو هناك قابلية لتحقق بعضها الآخر. فقد نشأت دولة واحدة، في نهاية الخمسينات، بجمع مصر وسوريا معاً تحت قيادة نظام سياسي واحد. كذلك، قامت، أيام الانتداب الفرنسي، عدة دويلات على أسس مذهبية وجهوية، وهناك حركة سياسية كردية نشطة، منذ الخمسينات، لا تخفي حلمها الاستقلالي، وإن كانت تستبعد ذلك على المدى القريب، وتدعو، بدلاً من ذلك، إلى نظام فيدرالي يأخذ بنظر الاعتبار التنوع العرقي – الثقافي في سوريا.
الخلاصة هي أن مبدأ “وطناً نهائياً” الذي نقرأه في معظم إعلانات التأسيس لحركات سياسية جديدة، يثير الكثير من التحفظات التي يحسن الإصغاء إليها، والبحث عن مبدأ بديل أو صياغة بديلة لا تنفر قسماً من المجتمع أو بعض مكوناته.
المبدأ الثاني المثير للجدل هو مبدأ علمانية الدولة. ومع أن الدولة الحديثة لا بد أن تكون علمانية لتكون دولة جميع السكان، لا دولة تمثل قسماً منهم وحسب، يثير التركيز عليه بصيغ “جافة” إذا جاز التعبير، تحفظ قطاعات اجتماعية تفهم من العلمانية عداءً للدين أو للإسلام بصورة خاصة. بصرف النظر عن خطأ هذا المفهوم، يبقى أن العلمانية تفرض فرضاً من فوق، أي بنوع من القسر.
يكاد قارئ مبادئ الأحزاب والتيارات التي تظهر كل حين يتخيل رجلاً فظاً في يده عصا غليظة ينهر السوريين صارخاً في وجوههم: “علمانية ولاك! سوريا وطن نهائي ولاك!” فيحني السوري المسكين رأسه بخنوع قائلاً: “أمرك سيدي! علمانية علمانية! نهائي نهائي!”.
في حين أن الأحزاب والتيارات السياسية التي تتبنى هذين المبدأين قائمة أساساً على مبدأ أول وأكثر تركيزاً هو مبدأ الديموقراطية والنظام الديموقراطي. كيف تتسق الديموقراطية مع عصا غليظة تفرض مبدأي العلمانية ونهائية الدولة؟
والحال أن فكرة العنف أو القسر مضمرة في البيانات موضوع حديثنا، ليس فقط ضد من يحتمل أن يرفضوا المبدأين المذكورين، بل كذلك جميع المبادئ التي من المفترض أن تكون موضوعاً لـ”عقد اجتماعي” جديد وفقاً للنوايا المعلنة لدى مختلف التيارات السياسية.
كيف يمكن، إذن، إعادة ترميم ما دمره النظام من الاجتماع السوري، سواء قبل الثورة والحرب أو بعدهما؟ كيف يمكن أن يتعاقد السوريون، أفراداً ومكونات، على عقد اجتماعي جديد يتوافقون عليه بغير قسر؟ وهل هو ممكن؟
هذه هي الأسئلة الصحيحة. وعلى المرء أن يختار بين بديلين: إما الإعلان صراحةً عن أن فرض بعض المبادئ “فوق الدستورية” كما تسمى أحياناً، يحتاج إلى قوة قسر وعنف. أو الإعلان صراحة عن احترام خيارات السوريين، أفراداً ومكونات، مهما كانت، أي بلا أي شروط مسبقة، وما ينطوي عليه هذا الخيار من احتمالات لا تستبعد حتى تفكيك الكيان السوري ذاته. يبقى أن المدخل الصحيح للتوافق على عقد اجتماعي جديد هو البحث عن المصالح المشتركة، بدلاً من التركيز على المبادئ المجردة التي تحتاج إلى قوة قسر لفرضها. على الناس أن يدركوا أن لهم مصلحة في “الوطن النهائي” وفي علمانية الدولة، لكي يمكن إعادة لملمة التفكك الاجتماعي السوري.
أما بشأن قوة القسر التي ورد ذكرها في الخيار الأول، فهي، في شروطنا الراهنة، قوى عظمى أو وكلاء إقليميين تم التوافق فيما بينهم على فرض نظام سياسي معين، بصرف النظر عن إرادة (أو إرادات) السوريين. أي نوعاً من قوة انتداب جديدة، لا تبدو القوى الاستعمارية التقليدية متحمسة لاستعادتها، باستثناء روسيا. لكن روسيا، بالمقابل، لا تملك تفويضاً أممياً لا بد منه للقيام بدور الانتداب.
تلفزيون سوريا
—————————————————
القوى الكردية في سوريا أمام تحديات حاسمة/ عروة خليفة
مرّت يوم أمس الذكرى السنوية السادسة عشرة للانتفاضة الكردية في سوريا، التي بدأت من مدينة القامشلي يوم الثاني عشر من آذار (مارس) 2004. وقد جاءت هذه الذكرى في وقت تعيش فيه القضية الكردية في سوريا تعقيدات بالغة الخطورة، إذ تسيطر تركيا وفصائل سورية تابعة لها على عدد من المناطق ذات الغالبية الكردية في سوريا اليوم، بعد عمليات عسكرية أدّت إلى تهجير مئات الآلاف، فيما يستمرّ تجاهل العملية السياسية في سوريا للحضور الكردي بشكل شبه تام، وتتفاعل التعقيدات التي خلقتها سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على مناطق ذات غالبية عربية في محافظتي دير الزور والرقة، وذلك في أجواء شديدة الاحتقان، يُفاقم منها رفض تركيا وحلفائها السوريين، وكذلك النظام السوري، للاعتراف رسمياً بأي قضية كردية في البلاد، الأمر الذي يعني أن الانتظار قد يطول جداً قبل أن نصل إلى القبول بنقاش القضية الكردية رسمياً في سوريا، سواءَ ضمن المسار السياسي السوري العام، أو ضمن مسار خاص يعترف بهذه القضية، ويبني على ذلك الاعتراف مساراً تفاوضياً مستقلاً.
قد يكون المقطع السابق شديد التبسيط لقضية معقدة عمرها من عمر الدولة السورية الحديثة، إلا أنّ نظرة عامة إلى أوضاع الأكراد السوريين السياسية اليوم، قد تتطلب بعض هذا التعميم لبناء تحليلات تبدو غائبة في سياق صراعات سياسية وهجمات وخطابات فاشية متبادلة في سياق المسألة الكردية، بنت جدراناً حول التعرّف على أوضاع القوى السياسية الكردية في سوريا ومواقعها.
خلال الشهر الماضي، واستجابةً لمبادرة أطلقها مظلوم عبدي، القائد العسكري لقوات سوريا الديمقراطية، أعلن المجلس الوطني الكردي السوري عن افتتاح مكاتب رسمية له في مناطق سيطرة قسد. ويضم المجلس، الذي تأسس عام 2011 برعاية رئيس إقليم كردستان السابق مسعود بارزاني، عدداً من الأحزاب والمنظمات النسائية والشبابية، التي تميل في معظمها إلى تأييد التيار الذي يقوده بارزاني ضمن الحركة الكردية في سوريا، وهو ما وضعها في تنافس سياسي أوسع بين تيار مسعود بارزاني وتيار حزب العمال الكردستاني، الذي أسسه عبد الله أوجلان في تركيا. وقد بدت تلك المبادرة تحريكاً للمياه الراكدة في الحياة السياسية الكردية، التي سيطر عليها في سوريا حزب الاتحاد الديموقراطي مدعوماً من جناحه العسكري، وحدات حماية الشعب، ومن ثم من قوات سوريا الديمقراطية التي تشكل الوحدات أهم مكوناتها، وهو ما جعل من هذا الحزب الممثّلَ السياسي بحكم الأمر الواقع لمناطق سيطرة قسد. وعلى الرغم من تشكيل مجلس سوريا الديمقراطي ليكون ممثلاً سياسياً عن تلك المناطق، إلا أن هيمنة حزب الاتحاد الديمقراطي، ومن خلفه حزب العمال الكردستاني، على الفضاء العام في مناطق قسد بشكل شبه تام تبدو أوضح من أن تخطئها عين، وهو ما منع حتى الأحزاب الكردية الأخرى، التي يتمثّل عدد من أهمها في المجلس الوطني الكردي، من العمل في مناطق الجزيرة، وفي منطقة عفرين قبل السيطرة التركية عليها عام 2018.
وقد كانت الرغبة الأميركية في إنجاز هذا التقارب بالغة الوضوح، عبّرت عنها تصريحات المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، ولقاءاته مع ممثلين عن المجلس الوطني الكردي، ولكن لا يبدو حتى اللحظة أنّ هذه الخطوة بدايةٌ فعليةٌ لتحركات أوسع، إذ يحافظ الطرفان، حزب الاتحاد الديمقراطي والمجلس الوطني الكردي، على الخط العام لسياستيهما المتباعدتين من ناحية العلاقات الإقليمية أو من ناحية التوجهات الداخلية. كما أن المؤشرات لا تعطي أي تفاؤل حول نية قسد تقاسم السلطة في مناطق سيطرتها مع أي قوى أخرى، سواء كانت قوى كردية أو غيرها، وهو ما يعني عملياً احتفاظ قسد بنفوذها وسلطتها المطلقة، ما يجعل ميزان القوى على الأرض مختلاً للغاية على نحو لا يسمح بأي حوار متوازن بين الأطراف.
بالمقابل، فإنه لا يبدو أن هناك أي محفزات جدية قد تدفع قُدُماً بمشروع الحوار الكردي الكردي المدعوم أميركياً، إذ لا توجد كوتا كردية ثابتة مثلاً ضمن أي مسار سياسي خاص بسوريا، وليس ثمة ما يضمن الاعتراف رسمياً ودولياً بالقضية الكردية في سوريا، ولا بأحقية الأكراد في تقرير مصيرهم، لا في سوريا ولا خارجها.
يحتاج فتح الباب أمام تغيير حقيقي في علاقات القوى السياسية الكردية في سوريا إلى عوامل أكثر تأثيراً، وأكثر بكثير من مجرّد السماح لأحزاب في المجلس الوطني الكردي بفتح مكاتب لها في مناطق سيطرة قسد. التحديات الآتية من خارج سوريا ليست بالهينة على الأطلاق، وتهجير أكراد سوريين من بيوتهم ومدنهم في الجزيرة وعفرين ليس هامشياً، لكن انتظار حل شامل لكل هذه القضايا قد يفضي إلى تحجر سلطة مشوهة أصلاً لقوات سوريا الديمقراطية، يمكن أن تقبل بحلول أقل من الوسط مع النظام السوري، الذي يرفض أصلاً الاعتراف بوجود قضية كردية في سوريا، وهو ما قد يفضي إلى كوارث جديدة لن تكون أقل من تلك التي حصلت في عفرين.
في الوقت الذي لم تسمح فيه الدول الإقليمية حتى اللحظة بالاعتراف بأكراد سوريا بشكل رسمي وقانوني، فإن هذا الاعتراف، حتى في حال حدوثه، لن يقدم حلّاً سحرياً لمشاكل القوى الكردية السياسية ذاتها، وهي المشاكل التي قد يكون التوجه إلى حلها فوراً هو الطريقة الأفضل لتجاوز جنين حرب أهلية سورية، أنتجته العمليات العسكرية التركية في الجزيرة وعفرين، وممارسات حزب الاتحاد الديمقراطي في مناطق سيطرته.
موقع الجمهورية
—————————–
الشمال السوري يُحيي ذكرى الثورة رغم كل شيء/ مصطفى أبو شمس
ترافقت ذكرى الثورة السورية التاسعة لهذا العام مع ثلاثة أحداث رئيسية، طغت على الفعاليات والمظاهرات التي شهدتها مناطق الشمال السوري الخارجة عن سيطرة النظام، والتي بدت أقل زخماً مما كانت عليه في السنوات السابقة. الحدث الأول هو الاعتصام المفتوح الذي دعا له ناشطون على طريق حلب اللاذقية الدولي، والذي جاء يوم الخامس عشر من آذار، اليوم المحدد لبدء مرور الدوريات الروسية التركية المشتركة على الطريق. والحدث الثاني هو نزوح أعداد كبيرة من الأهالي والمهجرين، وذلك بعد خسارة معاقل مهمة للثورة في أرياف إدلب وحماة وحلب. أما الحدث الثالث فهو تنامي حالة الإحباط واليأس التي سبقت ذكرى الثورة بأيام قليلة، وذلك جرّاء الاتفاق الروسي التركي الذي جاء مخيباً للآمال، إذ لم تُتًح الفرصة لمراجعة ما حدث واستعادة التوازن من جديد.
وقد شهدت مناطق مختلفة مظاهرات وفعاليات مختلفة في ذكرى الثورة، دعت إليها المكاتب الثورية والنشطاء في مناطق من إدلب وريف حلب الغربي، منها أريحا وأطمة وإدلب المدينة وباتبو، بينما شهدت مناطق عفرين وإعزاز والباب وأخترين ومارع في ريفي حلب الشمالي والشرقي حضوراً أوسع للمظاهرات والاحتفالات بإحياء عيد الثورة، تضمنت رفع لافتات وشعارات تطالب بإسقاط النظام ومحاسبة رموزه وقادته والإفراج عن المعتقلين.
مظاهرة مركزية حاشدة في مدينة الباب بمناسبة الذكرى التاسعة لانطلاق الثورة السورية
على وسائل التواصل الاجتماعي، تركَّزَ الحديث في ذكرى الثورة على استعادة ذكريات وأحداث أيامها الأولى، وبالمقارنة مع ما كان عليه الحال في السنوات السابقة، يمكن بسهولة ملاحظة التراجع في التغطيات الميدانية التي تجريها المواقع والصفحات الإلكترونية للفعاليات الاحتفالية والاحتجاجية على الأرض، وكذلك الأمر في المواد الإعلامية التي تذكّر بأحداث الثورة ورموزها ومحطاتها.
وفيما يتعلّق بالاعتصام الذي تم على الطريق الدولي، انقسمت الآراء في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام بين مؤيد له ومعارض. وقد رأى فيه بعض من تحدثنا إليهم عودةً بالذاكرة إلى أيام السلمية الأولى التي رافقت المنتفضين ضد حكم الأسد لأشهر طويلة قبل بدء العمل المسلح، وتذكيراً بنجاعة هذا الأمر في هزّ أركان النظام، وتأكيداً على استمرار الثورة كما بدأت، خاصة أن الاعتصام جاء بالتزامن مع ذكرى الثورة. في حين رأى آخرون أنه، وبعد سنوات من القتل الممنهج والاعتقالات، لا فائدة من العودة للاعتصامات والتظاهر، خاصة في ظل نطام قمعي دموي لا يمكن التعويل على ردود أفعاله، وفي ظلّ خذلان المجتمع الدولي للقضية السورية، متسائلين عن جدوى الاعتصامات في مثل هذه الظروف.
ترافق هذا الاعتصام مع فيديو لمقاتلين يتبعون لهيئة تحرير الشام، ظهروا في الطريق مهددين الدوريات المشتركة في حال مرورها بالتصدي لها عسكرياً، وهو ما دفع عدداً من الناشطين لتحميل مسلحيّ الهيئة مسؤولية ما سيحدث، معتبرين أنهم يكررون سلوكهم نفسه في كل مرة، وهو سرقة أي نشاط سلمي وتخريبه. وقد طالب بعض النشطاء بفض الاعتصام إن لم يكن بالإمكان مواجهة حملة عسكرية جديدة، ستؤدي إلى خسارة مناطق في حال عودتها، مستندين في كلامهم إلى الخسارة الكبيرة التي تكبدتها فصائل المعارضة خلال الأشهر الماضية.
فجر الدين عرابي هو صحفي وناشط من حلب، وقد شارك في إحدى مظاهرات إحياء ذكرى الثورة في ريف حلب، وهو يقول إنه من الواجب «العودة إلى العبارات الثورية البكر الأولى ونشرها مجدداً، وعدم السماح لأحد بالمساس بها، كونها تمثل ذاكرتنا واستمرارنا»، وإنه جاهز ومن معه لدفع الثمن الذي خبروه مراراً، مركّزاً على ضرورة «الابتعاد عن الاستسلام للعاطفة وحدها في التعاطي مع ما يحدث»، والتزام منهج تعزيز القوة في الخطاب والتمسك بالمطالب، التي يلخّصها بـ «الحرية والكرامة، وإلغاء الفكر المتشدد وعدم السماح لإصحابه بالاستمرار في حرف مسار الثورة».
درغام حمادي ناشط وصحفي في ريف حلب، وهو يعزو تراجع فعاليات ذكرى الثورة في محافظة إدلب ومحيطها إلى «خسارة قلاعها» كما وصفها، وأهمها معرة النعمان وسراقب وكفرنبل، وقبلها خان شيخون واللطامنة، بالإضافة إلى خلو جبل الزاوية والأتارب من سكانهما، وهي مناطق دائماً ما كانت تشكل ثقلاً ثورياً منذ الأيام الأولى في العام 2011، وهو الثقل الذي استمر حتى لحظة خسارتها.
يروي حمادي أن كثيراً من الناشطين تفرقوا عن أماكن وجودهم، بعضهم اتجه نحو مناطق في ريف حلب الشرقي وبعضهم الآخر إلى المخيمات، وهو «ما زاد من صعوبة وصولهم للمشاركة، أو انخراطهم في الفعاليات الثورية في المناطق التي لجؤوا إليها»، الأمر الذي يفسّر من وجهة نظره تنظيم مظاهرات كبرى في عفرين وإعزاز والباب، نتيجة الأعداد الكبيرة التي وفدت إلى هذه المناطق خلال الشهرين الماضيين.
المحامي والناشط عثمان خضر قال إن ذكرى الثورة تمرّ في ظروف بالغة القسوة، وذلك نتيجة تقدم قوات النظام، وتحوّل المنطقة إلى ساحة للصراع الدولي، دون إشراك السوريين أصحاب القضية في تحديد مجريات ما يحدث، الأمر الذي تسبّب بإحباط كبير، مترافق مع نزوحٍ هو الأكبر خلال السنوات الماضية. رغم ذلك، يؤكد خضر على أهمية المظاهرات والمعارض والاعتصامات وغيرها من الفعاليات، التي تحافظ على ذكرى الثورة.
من جهته، يقلل المحامي زياد المحمد من أهمية الخسارة الأخيرة في الحد من استمرارية الثورة، فهو يرى أن «الانتكاسات والتراجعات أمر طبيعي»، وأن «الثورة ليست رقعة جغرافية تنتهي المسألة بخسارتها». وزياد هو واحد من أبناء مدينة حلب، تم تهجيره منها قسرياً في الباصات الخضراء أواخر العام 2016، وهو يرى أنه ينبغي مواصلة الثورة رغم كل ما جرى، مع التركيز على ذاكرتها السلمية التي كانت الأصل في انطلاقتها.
يتندر بعض من التقيناهم قائلين إن انتشار فيروس كورونا حال دون اشتراك أعداد كبيرة من السكان في المظاهرات، وهو أمر غير مستبعد حتى لو أن الحديث عنه جاء مُغلّفاً برداء من السخرية، وذلك بعد التحذيرات من التجمعات واحتمال تحوّل الأمر إلى كارثة إنسانية في حال حدوثه. لم يغب ذكر كورونا عن اللافتات ووسائل التواصل الاجتماعي، وذلك عبر المقارنة بين الفيروس وبشار الأسد، وأيهما أكثر خطورة على الشعب السوري، وكذلك في الأغاني الساخرة من النظام ورأسه، والمبنية بكلماتها على مثل هذه المقارنات، في استعادة لذاكرة الأغاني والهتافات الأولى في الثورة.
يمر عيد الثورة التاسع وسط تغيرات كبيرة تشهدها مناطق سيطرة فصائل المعارضة وحياة سكانها، لكن الثورة «لم تهبط من الفضاء» كما يقول الطبيب عبد المنعم الأحمد، ولذلك فإنه «من الطبيعي أن تصبغ الظروف الحالية شكلها وفعالياتها واحتضان الشارع لها، ومن المستحيل مقارنة اليوم بما حدث منذ تسع سنوات، فالزمن لا يعود للوراء، خاصة مع فقدان كثير من مناضلي الثورة الأوائل، الذين كان لهم أكبر الأثر في تفعيل المظاهرات وكتابة اللافتات والأغاني الثورية التي تعبر عن المواقف السياسية».
الطبيب عبد المنعم الأحمد من أبناء ريف إدلب، يعيش اليوم في مدينة الباب بريف حلب الشرقي بعد نزوحه. وهو يقول أن «النزق الثوري بدأ بالتراجع منذ سنوات، مع التحول إلى العسكرة والفصائلية التي قضت على معظم أشكال المظاهرات والفعاليات، خاصة في المناطق التي خضعت مباشرة للتنظيمات الإسلامية المتطرفة مثل داعش والنصرة وغيرها، والتي عملت على قمع فعاليات الحراك الثوري المدني. ومع طول المدة، تأصلت فكرة عدم الجدوى من هذا النوع من الحراك، وساهم في ذلك شعور المتظاهرين بصمم المجتمع الدولي تجاه ما يحدث». ويضرب مثالاً عشرات الوقفات التي نُظمت بخصوص المعتقلين، وجميعها لم تستطع الإفراج عن معتقل واحد، وهو ما زاد من حالة الإحباط، دون أن ننسى ركون عدد كبير من النشطاء للابتعاد عن أي نشاط سياسي خوفاً من الاعتقال من قبل هذه الجهة أو تلك، أو تجسيداً للشعور بالخذلان، بالإضافة إلى هجرة أعداد كبيرة منهم إلى تركيا أو أوروبا، وهو ما يعتبر السبب الأهم في تراجع الفعاليات الثورية السلمية، على حد قول الطبيب عبد المنعم.
يسود جو عام من التأثر بالخسارة، إلى جانب الفقر الذي يمسك بخناق الملايين في مناطق سيطرة فصائل المعارضة، ويضاف إلى ذلك سعي كثيرين لإيجاد مكان آمن بعيداً عن الموت والقصف الذي ساكنهم لتسع سنوات. في ظل هذه الظروف، مضافاً إليها الظروف السياسية العالمية والإقليمية التي تتحكم بمصير الثورة وأبنائها، يبدو مفهوماً أن تتراجع جذوة إحياء ذكرى الثورة عمّا كانت عليه خلال السنوات القليلة الماضية، ويحتاج الأمر فعلياً إلى تغيرات جذرية أو حدث مفصلي كبير يغيّر من هذه الأوضاع، حتى تستعيد ذكرى الثورة بعضاً من روحها التي دُفنت تحت أطنان من القهر والموت وركام المنازل والمصير المجهول.
موقع الجمهورية
—————————————
تركيا..ذاكرة الثورة السورية/ عائشة كربات
تدخل الحرب الأهلية الدموية في سوريا عامها العاشر بينما يبدو أن النظام يعزز قبضته على السلطة، لكنه لن يتمكن أبداً من تحقيق السلام. تستمر المعارضة في فقدان مكانتها، وفي نظر بعض الغربيين، شرعيتها. إنها ليست الثورة نفسها التي بدأتها قبل تسع سنوات، ولكنها صراع متعدد المستويات؛ المحلي والإقليمي والدولي.
ومع ذلك، هناك العديد من الأسئلة التي يجب الإجابة عليها، أحدها لم يتغير منذ البداية: ماذا تريد أنقرة، وما هي الأهداف السياسية لتركيا؟
في بداية الربيع العربي، أعلنت تركيا أنها ستعتمد خمسة مبادئ للعملية برمتها، بما في ذلك في سوريا. كان المبدأ الأول، تقديم الدعم الكامل، بغض النظر عن البلد، لحركات الشعوب العربية، ليس فقط لأسباب رومانسية، بل آملة أن تكون شعبية تركيا في ذلك الوقت في أعين الشعب العربي كنموذج يحتذى به، قابلة لأن تترجم إلى وضع مربح للجانبين. المبدأ الثاني كان ببذل قصارى جهدها لضمان فترة انتقال غير دموية. المبدأ الثالث هو الامتناع عن إشراك الجهات الفاعلة غير الإقليمية. والرابع هو الحفاظ على التعاطف مع الناس وأن يكونوا في قلب التطورات.
في ذلك الوقت كان حزب العدالة والتنمية الحاكم يعتقد أن هذه المبادئ ضرورية لعدم تكرار ما اعتبروه خطأ الجمهورية منذ تأسيسها في عام 1923؛ أي أن يبذلوا قصارى جهدهم للحفاظ على مسافة والابتعاد عن الشرق الأوسط والعالم العربي.
المبدأ الخامس كان الدفاع عن وحدة أراضي الدول.
بالنسبة للمعارضة التركية، كانت هذه المبادئ مغامرة. أما بالنسبة للمنافسين الإقليميين لتركيا، فكانت انعكاساً للعثمانية الجديدة. ولكن في ما خص الحكومة، وعندما تحولت هذه المبادئ إلى أسئلة عملية واستراتيجية، تغيرت الحقائق على الأرض، وكما نرى تحولت الثورة السورية إلى حرب دموية. كان على أنقرة أن تتوسل إلى الولايات المتحدة للتدخل، وأخيراً عندما فعلت ذلك، أزعجت تركيا فقط. لا يوجد وضع مربح للجانبين، ولكن الجميع يعانون.
ما الخطأ الذي حصل؟
أشياء كثيرة. أنقرة لم تكن قادرة على حساب نطاق قوتها، ولا ردود فعل الآخرين. على سبيل المثال، لم تعتقد أبداً أن الروس سيتدخلون وأن هذا التدخل سيكون دائماً. ولكن بصرف النظر عن هذه الحسابات الخاطئة، كانت هناك قضية هيكلية حقيقية يجب معالجتها: الهوس الكردي لأنقرة.
بالطبع، يدعي المسؤولون في أنقرة أنهم ليسوا ضد الأكراد وليس لديهم أي مشاكل مع حقوقهم الثقافية والسياسية، إنهم يقاتلون فقط ضد ما يسمونه منظمة إرهابية، وهي وحدات حماية الشعب الكردية.
ولكن عندما ننظر إلى الممارسات على أرض الواقع والتطبيق في تركيا، هناك تناقضات مع التصريحات الرسمية هذه. الكثير من التفاصيل يمكن أن نتحدث عنها، يمكن التساؤل ماذا لو لم تعالج أنقرة هذا الهوس، هل كان تدفق التاريخ في سوريا بأكملها سيكون مختلفاً؟. على سبيل المثال، لو كانت أنقرة تشجع أكثر المعارضة السورية في البداية على التعاون مع الأحزاب الكردية الأخرى غير تلك المرتبطة بحزب العمال الكردستاني؟ ماذا لو تمكنت أنقرة من التصرف في الوقت المحدد عندما هاجم داعش سنجار؟ لو لم يكن لدى أنقرة هذه القضية، فهل كانت ستتبع سياسة الموازنة بين روسيا والولايات المتحدة؟
حسناً، بعد عشر سنوات، لا يزال المستقبل وسياسة أنقرة يعتمدان على القضية الكردية. بعد هذه النقطة، إذا دخل النظام في اشتباكات مع المناطق الكردية، فماذا ستفعل تركيا مثلاً؟ بعد كل هذه المعارك بين النظام والمعارضة، كيف يمكن في المستقبل حماية المعارضة من النظام؟ هل ستتم حماية حقوقهم في إدارة مركزية أو لامركزية؟ إذا كانت تركيا ستطالب بالحكم الذاتي للمعارضة، فبماذا ستطالب للأكراد؟
بجانب كل ذلك، هناك مبدأ مهم مفقود، ماذا ستفعل مع اللاجئين؟ قللت أنقرة من شأن التحركات البشرية وسيكولوجيا اللجوء، وقد فات الأوان لتنفيذ سياسات الاندماج، ولا تزال تقوم بهذا الخطأ وتأمل في إنشاء نوع من المناطق الآمنة لهم.
لقد حان الوقت للتفكير مرة أخرى ووضع استراتيجية كبرى لسوريا، حتى لو أنها أصبحت متأخرة كثيراً.
————————————
اليوم الأول من السنة العاشرة/ باسل العودات
أنتجت الحرب السورية، التي أوقد سعيرَها النظام السوري، أكبر كارثة على مستوى الإنسانية منذ عقود، وخلّفت مئات آلاف الضحايا، وملايين اليتامى والثكالى والأرامل، وأدّت إلى أكبر أزمة لجوء ونزوح شهدتها المنطقة، على مدى تاريخها القديم والحديث، وتسببت في تغييرات ديموغرافية وسكانية في الشرق الأوسط كله، وأدّت إلى أن تصبح سورية ميدانًا تتصارع فيه القوى الإقليمية والدولية.
هرب ملايين البشر من سورية، من جحيم الحرب، ومن إجرام النظام الشمولي، وخوفًا من أقبية السجون، ومن عسف وقمع الأجهزة الأمنية، ومن ميليشيات وكتائب ومرتزقة وقطّاع طرق، كما هربوا من عنف النظام الروسي الذي يعمل على تحقيق أهدافه الاستراتيجية، ولو على حساب تشريد أو موت ملايين الأبرياء، كما هربوا أيضًا من انتقام إيران التي باتت “مارقة”، في كثير من المقاييس.
من قام بالثورة في سورية، قبل تسع سنوات، هم أناسٌ أحبّوا الحياة، وأحبّوا الوطن، وكانوا يفتخرون بكرامتهم وعنفوانهم، وأرادوا تغيير النظام السياسي الأمني التمييزي إلى نظام ديمقراطي تعددي تداولي، يحفظ حقوق البشر وكراماتهم، ويساوي بين الجميع، ويرفع المواطنة إلى المستوى الأهم، ويُسوّد القانون، ويحقق العدل.
عمل النظام السوري، خلال السنوات التسع الأخيرة، على تدمير القيم والأخلاق والمُثل، فخرّب التعليم وشوّه الفكر، ونشر التخلّف والنزعات والنعرات والتمييز وشجّع الشعبوية.
في المقابل، لم تسعَ المعارضة السورية، السياسية والحقوقية والأهلية، لتشكيل الوعي الشعبي، وعي ما زال السوريون بعد تسع سنوات في أمس الحاجة إليه أكثر من أي شيء آخر، وعي بأهمية التخلص من العقائد والأفكار والأيديولوجيات البالية، ووعي بأن أي سوري هو مواطن وفقط، بغض النظر عن قوميته ودينه وإثنيته ومنطقته، ووعي بأن أحدًا لا يمكن أن يملك الحقيقة وحده، ووعي بأن الثورة تنجح حين يتمسك البشر بالقيم والمبادئ.
لم تُفلح المعارضة السورية في أن تشرح للسوريين أن الدكتاتور واحد، مهما كانت قوميته أو دينه، سواء أكان رئيس دولة أو رئيس حزب أو رئيس ميليشيا، وأن عبادة الزعيم أمرٌ شعبوي متخلّف.
بعد تسع سنوات عجاف، ما زال يمكن التعويل على النخب السورية بأن تأخذ دورها التوعوي، لتعيد تشكيل الوعي والمعرفة والفكر والأخلاق، عبر ريادتها في إنتاجها الفكري والبحثي والعلمي والثقافي، وسيكون دورها وطنيًا للغاية في ما تقوم به، بل وثوريًا أيضًا.
——————————
الثورة والطرف الثالث/ معبد الحسون
في التغيرات الكلية الكبرى التي تقتحم المجتمعات، هناك ظواهر طبيعية رسوبية، تبدأ في التشكل منذ اليوم الأول. لا تكون ملحوظة عادة، ويتم التعاطي معها بوصفها شوارد طيفية خفيفة، لا يقوى بنيانُها الهش على حمل أي معنى ذي مدلول خاص وحاسم. في الثورة السورية برزت ظاهرتان جليتان لدى عموم الثوار. الأصح لدى الغالبية الساحقة من السوريين، سواء كانوا ثواراً أو خلاف ذلك. ولم تُعطَ الظاهرتان من العناية والانتباه، ما يكفي لإيلائهما الأهمية المستحقة. أو ما يمكن أن ينتج عنهما من نتائج، من خلال التطور المطّرد للأحداث لاحقاً.
الظاهرة الأولى تتمركز حول تصور أولي سابق، أو لنقل (مخيال عام)، قائم على فكرة أن الثورة، بكل عرامها وزخم مدلولاتها في تاريخ سوريا الأخير، ما انفجرت، وما كان لها أن تحدث، إلا لصالح خلاصة أو نتيجة أساسية، هي الإطاحة بنظام الأسد ونظامه وآله وعائلته والفئة المحيطة به. وبعد التخلص من هذا الشر الكبير الذي تسببت به هذه العائلة، سوف تتغير الأمور تلقائياً، وتتطور نحو التحسن التدريجي، وصولاً إلى حال من السلام الاجتماعي، والاستقرار الوطني الشامل الذي يلبي حاجة جميع السوريين، ويكون ضمانة اقتصادية واجتماعية لمستقبل سوف يترقى بالتدرج، وبتلقائية مضمونة.
الظاهرة الثانية تركزت على أن كل مأساة سوريا، ومشاكلها المتراكمة منذ عقود، مرجوعة إلى حزمة قانونية ودستورية وواقع إداري فاسد. أو هي تعاني من مشاكل كثيرة لا حصر لها، في أسلوب وطرائق إدارة دولة أمنية بوليسية خانقة للشعب، وطاردة لأي خيار سياسي مستقبلي. وأن مقتضى الثورة كله يتمحور في إصلاح الدستور والقوانين والإدارة السورية عامة، توصلاً إلى القضاء على كل هذا الفساد العميم الخانق، والذي تأثرت به غالبية ساحقة من عموم الشعب السوري. ثم الخروج بتصور شامل عن العدالة بشقيها؛ الفردي والجمعي. ما يلبي حاجة كل طرف من الأطراف، وينفي ذلك الشعور بالعجز والغبن والاضطهاد والتمييز. سواء كانت تلك الأطراف طوائف أو إثنيات قومية، أو سكان مدن وأرياف أو عشائر أو نساء أو أطفال أو غير ذلك.
أما قضية وجود الأسد وعائلته، ودولته الأمنية الفاسدة والمتوحشة، فإن ذوبان هذا الجبل الجليدي الضخم، من التأصيلات والتشريعات والممارسة الفاسدة، التي صارت عرفاً متأبداً، سواء تقونت، أم بقيت متلبثة في حدود التعاطي معها كعرف عام مسلم به، فالأمر مرتبط بكونه تحصيل حاصل، سوف يجد حلولاً له بمرور الوقت. وليس ثمة من أمل باستمرار وجود مثل هذه السلطة الطغيانية الإبادية، فيما لو سارت سوريا على درب التغير الشامل، الدستوري والقانوني والإداري، بل ولا يمكن تصور ذلك إلى حد الاستحالة.
هذه مخيلة عامة لامست مشاعر الثوار السوريين وتصوراتهم منذ اليوم الأول. وواقع الأمر أن الفكرتين (المتصوَرتين) صحيحتان، بالمعنى التجزيئي والتبعيضي لفكرة الثورة. ولم تكن الفكرتان المتصورتان دخيلتين أو غريبتين عن شعارات الثورة وأدبها وخطابها العام. بيد أن الخطورة ظلت كامنة في أن القوى، والدول الخارجية التي كانت تتابع وتراقب المشهد عن كثب ـ الدول المؤيدة للنظام مطلقاً، والمؤيدة أو المتحمسة ولو ظاهرياً لصداقة الثورة ـ قرأت هذا المخيال قراءة أخرى مختلفة. ووجدت في التصورين اللذين قسما السوريين إلى دائرتين، فرصة أولية للاشتغال عليهما. وتطوير وتمديد مضامينهما بحيث يتم تحولهما تدريجيا إلى كتلتين معزولتين.
وإلى طرفين نقيضين. فالتصوران عند فحصهما، سوف يُلحَظ في بنيتهما أمران أساسيان:
ـ الأول أن كل مبدأ فيهما يتعارض مع الآخر، من حيث السيرورة التاريخية العامة. ولو وضعنا سهماً يحدد سير التصور الأول، لكان عكس اتجاه السهم الذي يحدد اتجاه التصور الآخر.
ـ الثاني هو أن الفكرتين “تبعيضيتان” في مجمل اللوحة السورية الكبرى. بمعنى أنهما صحيحتان فيما لو كانت سوريا لوحة كبرى مؤلفة من منمنمة بانورامية فسيفسائية. ففي اللوحة الفسيفسائية، كل جزء فيها صحيح وضروري، وليس من جزء فيها هو اللوحة ذاتها. أو هو موضوعياً، قادر على أن يستبعد اللوحة ويحل محلها.
هذه القراءة الأولية هي افتراض استقرائي، لتصور مسبق للسياسات الدولية التي كانت تستهدف الجواب على الأسئلة التالية:
ـ كيف يمكن تحبيط ثورة شعبية في مثل عرام وقوة الثورة السورية، دون المساس بقدسية رمزياتها التي رسخت في ضمائر ملايين السوريين؟
ـ كيف يمكن تحويل ثورة شعبية محقة الهدف والشعارات إلى “ثورة إصلاحية”، تستهدف إصلاح نظام متوافق عليه دولياً، دون المساس بجوهره المحض؟
ـ كيف يمكن تحويل ثورة شعبية محقة الهدف والشعارات، إلى فوضى شاملة وحرب أهلية؟
ـ كيف يمكن سحب الثورة كاملة من الثوار السوريين، وجعلها مرهونة القرار السياسي للقوى الإقليمية والدولية؟
في الحق ـ لو أنني أحللتُ نفسي، افتراضياً، محل القوى التي كانت تفكر وتجاذب مثل هذه الأسئلة ـ لأجبت نفسي على الفور، ودون تردد:
ـ بإحالة الثورة والثوار والحواضن البشرية والشعبية المحيطة والمتقوية بها، إلى طرف ثالث مستقل ومحايد. يُكفل ضمانُ صورة سوريا المستقبلية من خلاله، بمعزل عما كان طموحاً للثورة السورية والثوار السوريين يوماً ما.
ـ ثمَّ بالإبقاء على كل رمزيات الثورة، ذات التوقير والتبجيل في نفوس الملايين من السوريين؛ كالعلم والأناشيد ورموز شهداء الثورة السورية وغير ذلك؛ مما استوجب التوقير والتقديس، وإسلام هذه الرمزيات كاملة إلى الطرف الثالث، بكل حمولتها المعنوية والرمزية، وبكل زهوها وفخارها، وناتجها الرمزي والشعائري الذي وقر له تبجيلٌ في القلوب، واحترامٌ شامل لدى عموم السوريين.
ـ إدخال بعض الثوار، أو من سوف يتبقى منهم، بعد سلاسل متعاقبة، ومراحل من القتل والاعتقال والتشرد والعزل الكيدي المتعمد، إلى هذه الدائرة، دائرة الطرف الثالث، وذلك لغاية شرعنتها ووضعها موضع القَدَرية التي لا مندوحة عنها.
بذلك فقط يمكن إحلال الطرف الثالث ـ البديل ـ محل الثورة والثوار. لإكساب الطرف الثالث مصداقية وشرعية، من المتعذر أو المشكوك فيه أن يحوزها دون تطعيمه بثوار، أو “رشة ملح بوجود بعض الثوار”، على مسطحات كل المؤسسات والمنظمات التي سوف تحمل عبء تمثيل الثورة، أو تمثيل كل حقوقها السياسية الاقتضائية. أو إسباغ الاعتبارية على الطرف الثالث بحيث يبدو وريثاً شرعياً للثورة والثوار.
وحتى لا يُحمل مضمون الوصف السابق، على أي محمل خاطئ أو ملتبس، من أن الثوار هم مجموعات من الأفراد “الجيدين”، بينما الطرف الثالث هو مجاميع من الأفراد “السيئين”، لا بد من أن أسارع إلى القول معترفاً، بأن الثورة السورية هي ثورة شعب؛ شعب يشتملُ على أفراد جيدين وأفراد سيئين. وفيه نبيهون أذكياء، وفيه ضعاف عقول ومحدودو الفطنة والذكاء. وفيه مؤمنون من ذوي الصرامة المبدئية، كما أن فيه الكثير من السفلة والانتهازيين، ومقتنصي فرص الفوضى والخراب، ومستغلي ضعف مركزية الدولة، والمشتغلين المتربحين من الخراب العام.
فالمقايسة بين فئتين بشريتين، لا تقاس بخصائص كيميائية وفيزيائية تفاضلية ثابتة، وقطعية النتائج. وكما يتفاضل الحديد مع النحاس في الخصائص، ليعطيا في النهاية نفس الخاصيات، مهما تبدلت الظروف والأزمنة والأمكنة. ويكفي أن نتخيل مشهداً يجتمع فيه الفقر المدقع مع الجهل الفاحش، وضعاف العقول مع معدومي الضمير، والشخصية السيكوباتية مع الشخصية الهذيانية، والسفلة مع القتلة. ثم يشكلون حلفاً واحداً متضامناً متكافلاً فيما بينهم، (تحت اسم الثورة ورايتها)، حتى ليبدو المشهد وكأنه أشبه بمجانين خطرين، هاربين من مشفى الأمراض العقلية، تحالفوا بحكم المصادفة والمصلحة الجامعة، مع مجاميع مجرمين وسفاحين هاربين من السجن، وقتئذٍ يغدو هؤلاء أشبه بقنبلة ذرية مؤجلة الانفجار، سوف تنفجر يوماً ما، في موجة تسونامي عاتية يصعب السيطرة عليها، ضمن كل الاحتمالات، لتدمر الثورة والثورة المضادة معاً، وتحيل المجتمع كله إلى رميم وأشلاء.
كانت الثورة إيماناً بحالة ما (هو أقرب شبهاً بالإيمان الديني). إيماناً مؤطراً بشعارات وأفكار عامة. أما الطرف الثالث، الذي عُمِل على تشكله وصناعته دولياً، فقد كان موضوعياً أقرب إلى عكس واقع الثورة والثوار؛ كان أفكاراً عامة مؤطرة بإيمان بحالة ما. بمعنى أن الذين رفضوا الثورة، ووقفوا في وجهها، قد لا يكونون بالضرورة رافضين لشعاراتها أو مبادئها، وإنما الرفض مناطه الإيمان بها عينياً. وقد بدأ الاشتغال على تكوين الطرف الثالث، من مجاميع كبيرة من خارج الثورة. مجاميع متكونة ومتجمعة أساساً من:
ــ بعض منشقين عن مؤسسات النظام، أو موظفين سابقين عاملين في مؤسساته منذ عقود طويلة.
ــ معارضين سابقين، متجولين في بلاد المهجر، بلا عمل ولا وظيفة محددة، ولا دور لهم يلعبونه.
ــ مثقفين مناكفين، وفلاسفة مشترطين على الشعب شروطهم الاستباقية. ومن سياسيين تقنيين، ذوي باع وخبرة لا تقاس بأمية الثوار السياسية، وخبراتهم الأقرب إلى الصفرية، حنكةً وتجربةً.
ــ باحثين متعطشين عن مكانة وشهرة وامتيازات خاصة. ومن باحثين عن مكاسب مادية من عوائد الثورة، ومن المال المضخوخ من الخارج.
ــ جواسيس ومخبرين لصالح النظام، أو لصالح الأنظمة الدولية والإقليمية المتدخلة في الشأن السوري والماسكة لملفاته.
ــ ممثلي طوائف، وطائفيين جدد متغطين بشعارات الثورة، ومجاهرين ـ على سبيل التقية السياسية ـ بخطابها العام، وبالعلمانية
والديمقراطية والمواطنة. ولديهم من الهواجس العصبوية والعُصابية المسبقة، والقلق الخاص ـ الشخصي أو الجمعي ـ من المسلمين السوريين (السُنة على وجه التحديد) الذين يشكلون قريباً أكثر من70% من مجموع الشعب السوري.
ــ عصبويين قوميين، وأقلويين مستفيدين من العطف الشامل الذي رعته الدول الإقليمية والكبرى، المتدخلة في الشأن السوري، واللعب الدولي على أوتار التفضيلات والتمييزات الفئوية، بناء على هويات ضيقة ما قبل دولتية. عصبويين قوميين متسترين بشعارات الديمقراطية والمواطنة والعدالة والمساواة والحقوق، وأيضا كتقية سياسية لتكتيكات مرحلية مؤقتة.
ــ إسلاميين وإيديولوجيين، أصحاب مشاريع سابقة للثورة. وجدوا فرصة متاحة بتوسعة الشارع الشعبوي، من خلال التلاعب بعواطف الناس الدينية والتأثير عليهم بخطاب طائفي مضاد، لا علاقة له بالثورة وهدفها العام المعلن. مما يجعل من التجييش الشعبوي في هذه الفوضى الشاملة، أمراً في منتهى السهولة واليسر.
الثورة كانت، من حيث هي فكرة وإيمان جديد، يماثل الإيمان الديني من بعض جوانبه. وقد تمثلت في الطرف الثالث تمثيلاً مشبعاً إلى حد الكفاية. وإضافة إلى كل ما سبق، كان متاحاً بمنتهى اليسر والسهولة، إدخال كثير من الانتهازيين والشخصيات السطحية، والهامشية التافهة من معدومي الكفاءة والخبرة والموهبة، لتوسعة حاضنة الطرف الثالث. بل وحتى إن اقتضت الضرورة، إدخال مجانين ومعصوبين هذائيين، إن وُجد بأنهم مفيدون في بعض اللحظات والمفاصل التاريخية الضرورية.
أصحاب نظرية المؤامرة في هذا العالم يعتقدون بأن تاريخ الإنسانية كله، إنما انبثق من حزمة مؤامرات، فكان التاريخُ بعض تجلياتها. أما أصحاب نظرية (اللا مؤامرة) الذين يرفضون المؤامرة مطلقاً، فيعتقدون بأن التاريخ، إنما هو ابن الظروف والمصادفات، وموازين صراع منكسرة تارة ومنتصرة تارة أخرى. وهو لا يبعدُ أن يكون عصارة مصالح البشر وشهواتهم، وبَدَوَات عقولهم وجنونهم. أما الحقيقة فلسوف تظل تجلس القرفصاء زمناً لا تُعرف نهايته، حتى ينتهي هذا الجدل بينهما، وحتى يئن لها أن تنهض من جديد.
وبعيداً عن كل تصور أو خيال مؤامراتي، يجب الإقرار سلفاً ومسبقاً، بأنه قد جرى استعمال مصطلح “الرمادية” بإفراط شديد، وصل إلى حدود الإسراف الذي أهدر فحوى المصطلح ذاته؛ وذلك في وصف الطرف الثالث، مع أن التوصيف دقيق كـ (تموضع دور ومكان)، وغير دقيق تماماً كـ (وصف شكلي).
وحتى أتقدم في بسط الفكرة مزيداً، وأنتشلها من تجريديتها، ومن كونها مجرد رأي، إلى علامة تاريخية محددة، يؤرخ بما قبلها وما بعدها، أجد لزاماً عليّ مضطراً، بأن أحدد تاريخين مفصليين من عمر الثورة، كحادثة مضت في تاريخ سوريا الحديث. حادثين محوريين لم تُستكشف دلالتهما إلا بعد مضي سنوات بما حملت من أحداث لاحقة:
التاريخ الأول: هو نهاية عام 2012. وهي اللحظة التي أعلِن فيها عن تشكيل ما سمي بـ (الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة). وذلك في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني / في الربع الأخير من عام 2012.
التاريخ الثاني: هو 27/ يناير/ كانون الثاني من عام 2015. وهو اللحظة التاريخية الفاصلة، التي حُسِم فيها نهاية الحصار الذي ضربه تنظيم داعش على مدينة عين العرب (كوباني). وذلك بانتصار قوات التحالف الدولي على داعش وهزيمة التنظيم. ودخول التحالف الدولي إلى مدينة عين العرب (كوباني) دخول الفاتحين المنتصرين. وكما دخلت قوات الحلفاء مدينة برلين في نهاية الحرب العالمية الثانية، معلنة نهاية الحرب وانتصار الحلفاء على النازية، وبالتالي الشروع في فرض شروط المنتصر على الطرف المهزوم في الحرب.
التاريخ الأول توج مرحلة، بُدِئ بها منذ الأشهر الأولى لقيام الثورة السورية، وهي مرحلة الاشتغال والتأسيس للطرف الثالث (البديل عن الثورة والثوار). فكان الإعلان عن تأسيس الائتلاف الدولي، والذي هو ـ رمزياً وفعلياً ـ بمثابة تسليم قياد الثورة لطرف ثالث. التاريخ الثاني هو واقعياً، تاريخياً وفعلياً ـ من حيث الرصد التاريخي الموضوعي والمحايد ـ تاريخاً فاصلاً، يمكن تحديده كنقطة ارتكازية للإعلان عن نهاية الثورة السورية من على مسرح التاريخ. (بصورة دائمة أو مؤقتة، فهذا ما لا يمكن الجزم به في اللحظة الحاضرة).
التاريخ الأول (تاريخ الإعلان عن تشكيل ما يسمى بالائتلاف)، كان محصلة وثمرة الجهد السياسي لتتويج الطرف الثالث، والإمساك بالشق السياسي المتعلق بالثورة. التاريخ الثاني (تاريخ الانتصار العسكري والتدخل العسكري للولايات المتحدة والتحالف)، كان محصلة وثمرة الجهد العسكري في تتويج الطرف الثالث، في إمساكه ومتابعته المباشرة لسير وقائع الأعمال القتالية على الأرض.
هذه اللحظة، لحظة تشكيل الائتلاف من قبل الفاعلين الدوليين، كانت لحظة المصالحة الضمنية، والمصارحة الصامتة بين الثورة والطرف الثالث. تنازلت فيه الثورة عن جانبها الإيماني القدسي بالثورة، وتنازل لها الائتلاف في المقابل، عن الإيمان بالنظام والقطيعة السياسية معه. على الأقل ذلك ما حصل من حيث الظاهر.
قد يغيظ البعض هذا التصور، لأسباب عاطفية تتصل بنوستولوجيا الحنين إلى ذلك الزهو الذي يصعب مفارقته، ويحزن القلب الاعتراف به. فقولنا بأن (الثورة ما زالت مستمرة)، ينسحب على نفس المبدأ العاطفي، الذي ظل عشاق الزعيم المصري الراحل جمال عبد الناصر، يرددونه لسنوات لاحقة بعد رحيله: (عبد الناصر لسه ما متش)، ويُدرج معه. كما أنه من الصحيح القول بأن مفاعيل الثورة السورية وارتداداتها وتشظياتها، قد استمرت حتى يومنا هذا. بل وقد تظل مستمرة لعشرات السنين القادمة. وكما يصح القول بأن الحرب العالمية الثانية قد انتهت فعلياً (تاريخياً) في عام 1945، لكن تأثيرات الحرب استمرت لأكثر من ستين عاماً بعد نهايتها. بل وحتى يومنا هذا.
ولكن بعيداً عن العاطفة وما تشتهي وتميل إليه القلوب، فإن الواقع يؤكد لنا بأنه قبل تاريخ 27 يناير/ كانون الثاني عام 2015، لم يكن موجوداً على كامل الأرض السورية سوى نظام الأسد، والثورة والثوار. وإلى جوارهما الثورة المضادة وقواها المختلفة. أما بعد هذا التاريخ، وبعد أن فرض المنتصرون على تنظيم داعش (الذي كان من أوجب أسباب تصنيعه هو لعب هذا الدور)، وعلى السوريين عموماً، شروط الطرف المنتصر، لم يعد ثمة شيء يتحرك على الأرض السورية إلا بإرادة دولية، وبأوامر وتعليمات خارجية. هذه النتيجة باتت تنسحب على النظام، من حيث هو الطرف الأول في المعادلة على الأرض. مثلما باتت تنسحب على الثورة من حيث هي الطرف الثاني في المعادلة.
بُدئ العمل على تجفيف الثورة والثوار السوريين، ابتداءاً من نهاية عام 2012. وبالوصول إلى مطلع عام 2015، كانت إجراءات عزل الثوار وإهمالهم، بل وقتلهم واعتقالهم وتهجيرهم خارج البلاد، وبعثرتهم بشتى السبل، فيما يشبه الاستئصال المخطط مسبقاً. كما تم تأميم كتائب الجيش الحر ومصادرتها، وتوزيعها كالهدايا على التشكيلات العسكرية التي تعمل تحت إمرة الطرف الثالث وتتمول منه. ومن غرف متابعة عمليات تابعة لدول طرفية خارجية. وبذلك أصبحت الثورة، بشقيها السياسي والعسكري، تدار عبر توجيهات صادرة من تلفونات عبر العالم، ومن سفارات وخارجيات واتصالات سكايب من الخارج. كما تم تأميم الإعلام والصحافة الثورية، (رغم ضعفها المهني وقلة خبرتها ويفاعة عمرها وهشاشة خبراتها الإعلامية)، تأميماً شاملاً لصالح الطرف الثالث.
أما السياسة، فيستحسن أن لا أكرر نفسي كثيراً وإعادة القول مرات، بأنها كانت أول ما صودر من الثورة السورية لصالح الطرف الثالث. وبذلك لم يعد موجوداً وفاعلاً حقيقياً ـ على أي وجه من وجوه الحقيقة ـ إلا الطرف الثالث الذي تربى بتغذية من دول الخارج المتدخلة في الشأن السوري.
عملياً، ودون خطة مبيتة مسبقة، الثورة والطرف الثالث تساعدوا بطريقة مبطنة مضمرة، الثورة احتاجت الطرف الثالث لانتشالها من التكبيل والاختناق والشلل. والطرف الثالث نال شرعيته واستحقها وحقق وجوده من خلال الثورة. كلا الطرفين اعتمد على الآخر. وعملياً كذلك، فإن الثورة والطرف الثالث هما الطرفان الحيويان الحاسمان في معادلة بقاء سوريا أو فنائها؛ طرفان أولهما قدم، حتى اليوم، مليون شهيد. الثاني لم يقدم شهيداً واحداً إلا على سبيل المصادفة غير المتوقعة وغير المقصودة. الأول قدم من المخطوفين والمعتقلين والمغيبين في غياهب سجون النظام أكثر من نصف مليون، حتى اليوم. الثاني لم يعتقل منه أقل القليل من سجناء الصدفة. الأول أعطى الثورة نفسه وماله وأهله ومستقبله وهباً وأجراً للثورة. الثاني تعامل مع الثورة وكأنها أجرته واستحقاقه وراتبه و”بدل تعبه”.
فتح الأبواب مشرعة بين الثورة والطرف الثالث، أفاد الطرف الثالث في معظم التفاصيل الجوهرية، وساعد على نقل الملف من الساحات إلى قاعات المؤتمرات. ومن خنادق الجيش الحر، إلى بنادق الكتائب الممولة والمتحركة بشروط ذلك التمويل. ومن ثورة شعب على الأرض السورية وداخل الحدود السورية، إلى ثورة الكترونية تدور رحاها عبر الانترنيت. وحتى اقرب الفكرة أكثر، أود الإشارة بان الغالبية الساحقة ممن “مثلوا الثورة” منذ وقت مبكر، لم يشاركوا فيها لا من قريب ولا من بعيد. ولم يسهموا بأية فعالية ثورية على أي مستوى كان، إلا في أدنى المستويات وأضيق الحدود.
في فذلكة النتائج وتلخيص ما سبق، يمكن القول:
ــ تم تدمير الثورة السورية، وكل تمثيل لها بالتدرج المطلوب، وبالتقسيط الذي لا يبدو باهظاً أو ملفتاً للانتباه، من قبل الخارج الدولي لصالح الطرف الثالث. ففي عامها الأول (2011)، لم يكن تمثيل الثورة في المجلس الوطني، الذي كان أولى المبادرات لتحصينها بمرجعية سياسية ذات اعتبار؛ لم يكن تمثيل الثورة الحقيقي فيه، يتجاوز النسبة التي تتراوح بين 30 ـ 40 %. أما في العام التالي، عام (2012)، وبعد حل المجلس الوطني وتشكيل الائتلاف، فقد نزلت نسبة تمثيل الثورة فيه إلى قريب من 5 %. فيما بعد، في الأعوام التي تلت ذلك، وبعد تشكيل ما سمي بـ (هيئة المفاوضات العليا)، في صيغها المتعددة والكثيرة، فقد كان جلياً أن تمثيل الثورة قد هبط إلى الصفر التام.
ــ الطرف الثالث هو الموجود الوحيد اليوم، في مقابل النظام. وسواءٌ أقرَّ السوريون بهذه الحقيقة أم أنكروها، فإن عليهم التشكل والعمل لدعمه وتقويته. وتنقيته من شوائبه الكثيرة التي شابته. وبناء الخلاص من خلال تواصل وبلورة الرؤى المشتركة فيما بينهم. بغض النظر عن الشعارات والمسميات، ورفع علم الثورة وتبني رموزها المختلفة.خاصة إذا ما علمنا بأن الطرف الثالث قد ولد واستمر وهو رهين تجاذبات بين أقصى اليمين الثوري إلى أقصى اليسار الثوري. ومن أقصى الإخلاص والصدقية إلى أقصى الانتهازية والوصولية.
أخيراً، لابد من التنويه أيضاً، بأن طريقة اصطفاء الطرف الثالث، كما جرت عليه الأمور في سوريا، هي نفسها، ما يتمُّ، أو تمَّ الاشتغال عليها في وقت، واحد في مصر وليبيا واليمن. ويُتوقع أيضاً أن تسري بنفس الآليات على السودان والجزائر ولبنان والعراق مستقبلاً.
*هذا البحث هو فصل مزيد ومضاف إلى كتابي (الرقة والثورة)، لم يسبق نشره فيما سبق.
بروكار برس
—————————–
الأزمة السورية… بين واقعية المجتمع الدولي وأخطاء المعارضة الاستراتيجية/ حسن فحص
عسكرة الانتفاضة لم تمنح المتظاهرين الحماية المطلوبة وأعطت النظام ذريعة شيطنة الحراك
لم يكن تقدير الموقف الذي عرضه الموظف في الخارجية الأميركية بداية الانتفاضة السورية في أبريل (نيسان) عام 2011 بعيداً عن الواقع، عندما أكد أن الإدارة الأميركية تواجه أزمة على الساحة السورية.
فهي من ناحية ترغب وتريد إحداث تغيير في سلوك النظام السوري، وإبعاده عن التأثير الإيراني ومحوره بالمنطقة، وعليه فهي تدعم الحراك السوري “السلمي” الذي بدأت تشهده بعض المدن.
أزمة الإدارة الأميركية
ومن ناحية أخرى، تدرك صعوبة التعامل مع هذه الساحة، خصوصاً أنّ واشنطن لا تملك أوراقاً بيدها لتكوّن أو تشكّل بديلاً للرئيس السوري، فضلاً عن شكوك في قدرة المعارضة المتصدية لأمور الثورة في توفير انتقال سلمي ديمقراطي، وإحداث تحوّل جذري في النظام القائم وقيادته في المرحلة التالية.
وأضاف الموظف أنّ الساحة السورية تختلف في تعقيداتها وصعوبتها عن الساحات العربية الأخرى التي شهدت انتفاضات شعبية، مثل ليبيا على سبيل المثال، إذ سمح الإجماع الدولي والتراجع الروسي بفعل القرارات التي اتخذها الرئيس الروسي آنذاك دميتري ميدفيديف، وتمرير قرار مجلس الأمن الدولي حول الأزمة الليبية في توفير الأرضية لتدخّل دولي تحت غطاء حلف الناتو، وحسم الأمور بسرعة، وإخراج الرئيس الليبي معمر القذافي ونظامه من المشهد السياسي.
في المقابل، وفي حوار وصل إلى حد الجدل مع بعض الأصدقاء المتصدين الحراك السوري منذ بدايته، واستمروا لاحقاً قيادات ومؤثرين في توجهات هذا الحراك خلال العامين الأولين، حول التأثيرات السلبية التي ربما تترتب نتيجة التوجّه الذي يسود الحراك السلمي للانتقال إلى العمل العسكري تحت شعار حماية التظاهرات السلمية من خلال التركيز على إنشاء ما بات تشكيلات عسكرية مسلّحة تحوّلت لاحقاً إلى مُسمّى “الجيش السوري الحر”.
خيار الجيش الحر وعسكرة الحراك
المعارضة السورية ذهبت إلى تبني خيار “الجيش الحر” بناءً على التجربة الليبية، حيث حظيّ التشكيل العسكري الذي أنشأته المعارضة الليبية حينها “جيش ليبيا الحرة” بدعم دولي ومساندة واضحة من الدول المؤثرة في هذه الأزمة، فضلاً عن موقف مجلس الأمن الدولي الواضح في هذا الاتجاه، الذي استطاع الحصول على الموافقة الروسية لإصدار قرار يوفّر الغطاء الأممي للتدخل العسكري، من دون أن تقرأ هذه المعارضة الظروف الموضوعية والأبعاد السياسية والاستراتيجية التي دفعت هذه الدول لدعم هذا التشكيل ووجود قرار دولي بإنهاء نظام القذافي.
وذهبت إلى الدفع باتجاه “عسكرة” الحراك السلمي تحت ذريعة الحماية في البداية، وحاولت جرّ المجتمع الدولي إلى تبني هذا الخيار ودعمه، من دون الالتفاف إلى الفارق بين الحيثيات الليبية والحالة السورية، هو موقف كشف عن مستوى من القصور في قراءة المتحوّلات والمواقف الدولية من الأزمات، خصوصاً في الشرق الأوسط.
عسكرة الانتفاضة السلمية للشعب السوري لم تنجح في منح المتظاهرين الحماية المطلوبة والمستهدفة من هذه الخطوة التي كانت متعجّلة، وفي المقابل منحت النظام الذريعة التي كان يبحث عنها، ويعمل على الوصول إليها، من خلال شيطنة الحراك المُطالب بالحرية والديمقراطية، وتحويله إلى المستويين الأمني والعسكري، لتسهيل عملية القمع الدموي، التي سرعان مع حوّلها النظام إلى فرصة لممارسة أعلى مستويات القمع من أجل إعادة فرض سيطرته، والقضاء على كل مظاهر الحراك السلمي، الذي يشكّل له تهديداً حقيقياً ووجودياً.
اللاعب الروسي والحليف الصيني
وعلى الرغم من رغبة المعارضة وبعض الدول في تسريع عملية التغيير والانتهاء من النظام وإقصاء رئيسه بشار الأسد عن المشهد السوري، فإنّ هذه الرغبة اصطدمت، فضلاً عن تردد غربي، بإرادة مستجدة وجديدة من اللاعب الروسي، ومعه الحليف الصيني برفض هذا المسار الذي يشكل تهديداً استراتيجياً لمصالحهما في الشرق الأوسط والساحة الدولية.
وتزامن هذا التغير مع عودة فلاديمير بوتين إلى سُدة الرئاسة، الذي عمل على تصحيح ما عدَّه خطأ استراتيجياً قام به سلفه ميدفيديف بتمرير قرار مجلس الأمن الدولي حول لبيبا، الذي أضعف الموقف الروسي في منطقة غرب آسيا، فعمد بمؤازرة الصين إلى عرقلة كل المساعي الدولية والمجموعة العربية لإصدار قرارات تدين الأفعال القمعية والدموية التي يمارسها النظام ضد الشعب السوري، فضلاً عن تعطيل أي تحرك عسكري يؤدي إلى تغيير جذري في المشهد السوري، خصوصاً ما حدث في تعطيل خيار الرئيس الأميركي باراك أوباما بتوجيه ضربة عسكرية للنظام بعد إدانته باستخدام السلاح الكيماوي ضد المدنيين والمعارضة في أكثر من منطقة سورية.
النظام الإيراني واستهداف مصالحه
وإلى جانب الحلفاء الدوليين للنظام السوري على قاعدة المصالح الاستراتيجية، روسيا والصين، وجد النظام الإيراني بما هو الحليف الإقليمي للنظام السوري، وأيضاً على قاعدة المصالح الاستراتيجية، في الأحداث التي تشهدها سوريا ومساعي بعض الأطراف لإطاحة الأسد ونظامه استهدافاً مباشراً لمصالحه الاستراتيجية ومحاولة لمحاصرته وإخراجه من جغرافيا الشرق الأوسط، وإبعاده عن الحدود مع إسرائيل، وإنهاء التهديد الذي يشكّله لاستقرار المنطقة.
من هنا، لم يكن أمام قيادة النظام الإيراني سوى الذهاب إلى آخر الخيارات الممكنة والدخول العسكري المباشر على خط دعم النظام الذي بات في دائرة الخطر والسقوط، ولم يكن المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي بعيداً عن القلق الحقيقي للنظام عندما اعتبر الدفاع عن دمشق هو دفاع عن طهران، وأن سقوط الأهواز في خوزستان ربما يكون أقل تكلفة على النظام من سقوط سوريا.
الدخول الإيراني العسكري جاء تحت عنوان “مستشارون عسكريون” من قوات فيلق القدس التابع إلى حرس الثورة الإسلامية، وشكّلت تشكيلات حزب الله اللبناني الذراع القتالية لهم، وكانت المهمة الأولى حماية العاصمة دمشق، واستعادة السيطرة على محيطها وريفها، الأمر الذي سمح بإبعاد شبح السقوط عن قصر تشرين الذي كان يُسمع في أرجائه أزيز الرصاص ودوي الانفجارات.
معركة القصير والتحول إلى الهجوم
ولعل التطور الأهم الذي حدث في هذا السياق، الذي نقل النظام السوري من مرحلة الدفاع إلى الهجوم، كان في معركة “القصير” التي شكّلت تحولاً استراتيجياً في الأزمة السورية، ونقلت المعركة من مواجهة بين النظام وقوى مدنية، وتطالب بتغيير النظام الشمولي، إلى مواجهة بين قوى المحور الإيراني وجماعات متطرفة في مقدمتها تنظيم النصرة الفرع السوري لتنظيم القاعدة، ولاحقاً مع تنظيم داعش الذي تمدد من العراق إلى سوريا قبل أن يعلن دولته في حركة ارتداديه في الجغرافيا، انطلاقاً من عاصمته في الرقة باتجاه الموصل.
الحراك المصري والتراجع التركي
وتزامنت “معركة القصير” مع الحراك الشعبي المصري، الذي أدّى إلى إسقاط حكومة الرئيس محمد مرسي، وانتهاء مرحلة حكم تنظيم الإخوان المسلمين، الأمر الذي انعكس في نتائجه، إضافة إلى نتائج “معركة القصير” على وضع النفوذ التركي بالمنطقة العربية، خصوصاً على الساحة السورية، الأمر الذي وضع السلطة التركية ورئيسها رجب طيب أردوغان على سكة تراجع الدور وتقديم التنازلات، التي تزايدت حدتها وفاتورتها لاحقاً بعد الدخول الروسي العسكري المباشر، لدعم الأعمال الحربية للنظام الإيراني وحلفائه ضد المعارضة السورية، وعجزه عن حسم المعركة، وارتفاع فاتورة الخسائر البشرية في صفوفه، الأمر الذي أسس لمرحلة جديدة من تقاسم النفوذ والسيطرة بين الجانبين الروسي والإيراني على الساحة السورية، في حين اكتفى وما زال النظام التركي بالمراقبة وحساب خطوات التراجع، إن لم تكن الخسائر، التي تلحق به، بينما حافظت واشنطن على حدود دورها من خلال رسم حدود النفوذَين الروسي والإيراني في مناطق شرق الفرات، بانتظار بلورة الحل السياسي.
——————————–
في الذكرى التاسعة للثورة السورية/ راتب شعبو
العلامة الأبرز في المرحلة الأولى من الثورة السورية كانت الابتكار والتجريب. خرج الناس على القديم، على مسارات حياتهم اليومية، وعلى القنوات المعتادة التي يغذّيها الاستبداد، ويتغذّى عليها، إلى مساراتٍ جديدة غير مألوفة، فوجدوا أنفسهم مرغمين على الابتكار والتجريب. وهو إلى هذا ابتكارٌ محفوفٌ بالرعب. كيف يمكن تنظيم مظاهرة في بلدٍ لم تشهد شوارعه منذ عقود أي تجمعات احتجاجية، ولم تعرف سوى مسيرات التأييد والولاء؟ ثم كيف يمكن إيصال الصوت إلى الخارج، للاستفادة من ثقل الإعلام، ومن قوة الرأي العام العالمي، ومن خشية النظام من الفضيحة بأمل لجمه عن “التفظيع” بالمحتجين؟ وكيف يمكن توثيق الانتهاكات التي يتعرّض لها المحتجّون؟ وبعد ذلك، كيف تمكن إدارة مناطق تخلى عنها نظام الأسد طوعاً أو كرهاً؟ وعلى طول الخط، كيف تمكن إدارة هذه العلاقة السياسية الطارئة بين السوريين الرافضين استمرار دورة الاستبداد السياسي المتمثلة في نظام الأسد؟
كانت العلاقة التضامنية التي طرأت فجأة بين السوريين الثائرين تحتاج إدارة تنظيمية، ابتكر لها السوريون شكل التنسيقيات. وكانت تحتاج أيضاً إلى إدارة سياسية: تحديد الشعارات، تحديد الملامح الأساسية للثورة ضد محاولات التشويه الداخلية (من داخل الثورة) والخارجية (من النظام)، أو بكلمة واحدة، إبراز خط سياسي عام للثورة، هو الخط الوطني والديمقراطي والعلماني، بوصفه النقيض المباشر لنظامٍ استبداديٍّ، يستثمر في خطوط الانقسام الطائفية والقومية في سورية، ويستعمر الدولة ويفخخها، بحيث يكون موقع الرئيس فيها هو مركز ثقلها وصمام أمانها، حتى أصبحنا أمام دولة الرئيس، بدلاً من رئيس الدولة.
لم تتوفر للثورة السورية إدارة سياسية من جنس مطالبها وبواعثها الأساسية، الأمر الذي جعلها تحت تأثير القوة الإسلامية التي تستمد “جاذبيتها” من عامل ذاتي، هو حضور الإسلاميين الذين كانوا في الغالب أكثر جرأةً وثقة بالنفس، وإخلاصاً لمبادئهم من غير الإسلاميين، حتى أصبح كثيرون من هؤلاء ينظرون إلى الإسلاميين أنهم أصحاب الشأن، ويسلمون بأنهم “أم الصبي”، مرتضين لأنفسهم دوراً هامشياً في القضية. هذا فضلاً عن عنصرين موضوعيين داعمين للقوة الإسلامية، هما قوتا التقليد الديني والدعم الخارجي، ليس فقط التركي والخليجي، بل والغربي أيضاً.
لم يقصّر الإسلاميون (بمختلف تلاوينهم) في تولي القضية، وكان هذا، في الحق، يدل على إقدام ومثابرة وانخراط يحسب لهم، بصرف النظر عن روحهم الإقصائية، وعن مدى الاختلاف معهم فكرياً وسياسياً وعمقه. وعليه، كان من طبيعة الأمور أن تصاغ مسيرة الثورة وفق نظرتهم وتصوراتهم، فارضين على الآخرين من غير الإسلاميين الانصياع لهم أو الخروج من “الثورة”. خلال مرحلة من عمر الثورة السورية، أصبح نقد الإسلاميين يعادل نقد الثورة. وإذا كان هذا التطور قد رفع من عتبة تماهي نسبةٍ كبيرة من السوريين مع الثورة، فإن نسبة كبيرة أيضاً من السوريين غير الإسلاميين تقبلت هذا التحول وتماهت معه، ومنهم من راح يجتهد في “اكتشاف” المعنى الثوري في كل ما يصدر عن الإسلاميين الذين صاروا بالفعل قوة “التغيير” الفعلية الوحيدة.
من طبيعة الاستجابات القصوى أن تولد استجابات قصوى مضادّة. وعلى هذا، حين سار نظام الأسد إلى نهاية الطريق في استخدام كل وسائل البطش والتركيع الممكنة، بما في ذلك استخدام وسائل محرّمة دولياً، مثل أسلحة الدمار الشامل وحصار المدن، سار الإسلاميون إلى نهاية الطريق في “إسلاميتهم”، وصولاً إلى إعلان الخلافة والإمارات والمحاكم الشرعية… إلخ. على هذا، لم يعد ممكناً لغير الإسلاميين أن يجاروا الإسلاميين في مواصيلهم تلك.
عانت النخبة المعارضة الديمقراطية السورية، أو غير الإسلامية، من التمادي الإسلامي، ووجدت نفسها في النتيجة مقطوعة، لا هي قادرة على المضي أكثر في “مسايرة” الإسلاميين في ذهابهم البعيد، ولا هي راكمت القدرة الذاتية على الفعل المستقل. كما عانى جمهور الثورة أيضاً من هذا التمادي، بمن في ذلك الجمهور التاريخي للإسلاميين. النخبة السورية التي أيدت نظام الأسد وجدت نفسها في المأزق نفسه، حين ذهب النظام في سياساته إلى حدود الإبادة والارتهان للدول المساندة، فقط كي لا يرى في معارضيه سوى “طرف آخر” أو “إرهابيين”.
قام السكوت الشعبي الذي أحاط بسياسة البطش الأسدي، في البداية، على أرضية التخوف من
التحول الإسلامي، ثم على أرضية الرفض المطلق للتمادي الإسلامي (على خلفية طائفية وعلى خلفية سياسية). وبالمثل، قام السكوت الشعبي عن “التطرف الإسلامي” في مناطق سيطرته، على أرضية الرفض المطلق لنظام الأسد (على خلفية طائفية أو سياسية). رفضان مطلقان امتلكا القدرة على حرق كامل الطيف الذي بينهما، وأنتجا صراعاً دمّر السياسة والمجتمع والبلاد. ولكن لم يعد هذا السكوت خاوياً بعد هذه السنوات، فقد بات، كما نعتقد، مشحوناً بالشعور بمحدودية الفكر القصووي، هنا وهناك، وبتبعاته المدمّرة، ولا نظن أن هذا الشعور العميق يوفر النخبة المؤثرة في كلا الطرفين.
أدّت الاستجابات المتطرّفة المتبادلة إلى حرمان السوريين من اختبار ما ابتكروه في السياسة والتنظيم خلال الثورة، وكان هذا من أسوأ النتائج التي فرضها البطش الأعمى الذي واجه به نظام الأسد البشائر الأولى ليقظة السوريين.
اليوم، وبعد تسع سنوات من صراعٍ كان يسير باضطراد على درب الاختزال والفقر السياسي كلما تمادى أكثر في الدم والدمار، يبدأ الجمهور، كما النخب، في كل سورية، يتلمسّون حدود أفكارهم السياسية وطفوليتها. يرى “الجمهور الموالي” بالعين المجرّدة أن نظام الأسد يقترب من هزيمته أكثر كلما اقترب من “انتصاره” أكثر، ويرى “الجمهور المعارض” أيضاً أن الإسلاميين الذين شكلوا القوة المعارضة الأساسية لنظام الأسد، لا يقلّون بطشاً وفساداً عن هذا النظام، وهم، بعد كل شيء، تتقلص إمارتهم، ويتحولون، مع الوقت، إلى فضلة صراع مهملة مرشّحة للتحول إلى أتباع وخدم عند النظام الذي ثار السوريون لإسقاطه، أو عند أنظمةٍ خارجيةٍ أخرى، وفي خدمة سياساتها ومطامعها الخاصة.
في اللوحة السورية المريعة، يمكن لنا، مع ذلك، أن نلمح ضوءاً باهتاً، يمكن أن يدعم الأمل في أن يكون السوريون (الجمهور والنخبة معاً) قد اكتشفوا حدود أفكارهم، وقد لمسوا وأحسوا وأدركوا أن التطرّف في إلغاء الآخر السياسي، لا يفضي سوى إلى صراع عقيم، أو قل يفضي إلى إلغاء الذات، في الوقت نفسه الذي تخال فيها الذات أنها تقترب من إلغاء الآخر.
العربي الجديد
—————————
في مفهومي “الحرب الأهلية” و”الثورة” في سوريا/ د: حسام الدين درويش
الذكرى التاسعة للثورة: أخلاقيات الوسم والتسمية
يرفض معظم مؤيدي النظام ومعارضيه أو الثائرين عليه، معًا، وسم “الحرب الأهلية”، لكن في حين يتحدث معظم المؤيدين عن “المؤامرة الكونية على سوريا” و”الحرب على الإرهاب”، يصر معظم المعارضين على الحديث عن “ثورةٍ (شعبيةٍ)”، لكن ثمة “معارضون” يرون أن “الواقعية” تقتضي الإقرار بأن الصراع في سوريا هو حرب أهليةٌ (طائفيةٌ) بامتيازٍ، فأين هي الحقيقة؟
اختلفت الوسوم labels المطلَقة على ما حصل في سوريا منذ عام 2011. ولعل وسما “الثورة” و”الحرب الأهلية” هما الأشهر أو الأبرز والأكثر شيوعًا، في هذا الخصوص. وفي اتفاقٍ نادرٍ، يرفض معظم مؤيدي النظام ومعارضيه أو الثائرين عليه، معًا، وسم “الحرب الأهلية”، لكن في حين يتحدث معظم المؤيدين عن “المؤامرة الكونية على سوريا” و”الحرب على الإرهاب”، يصر معظم المعارضين على الحديث عن “ثورةٍ (شعبيةٍ)”، لكن ثمة “معارضون” يرون أن “الواقعية” تقتضي الإقرار بأن الصراع في سوريا هو حرب أهليةٌ (طائفيةٌ) بامتيازٍ([1])، وبأنه لا فائدةً ولا معنىً ولا قيمةً لإنكار ذلك. فإلى أي حدّ، وبأي معنىً، يمكن وصف “الأزمة السورية” بأنها “ثورةٌ” و/ أو حرب أهليةٌ”؟
وفقًا ﻟ “دراسات الحرب”، ينص التعريف التقليدي للحرب الأهلية على أنها “صدامٌ عسكريٌّ مستمرٌّ، داخليٌّ، بالدرجة الأولى، يفضي إلى مقتل ما لا يقل عن 1000 شخصٍ، في ميدان المعركة، سنويًّا، وتتواجه فيه قوات الحكومة المركزية مع قوةٍ متمردةٍ قادرةٍ على إيقاع خسائر في صفوف القوات الحكومية، تعادل 5%، على الأقل، من عدد القتلى في صفوفها”([2]). وانطلاقًا من هذا التعريف، يُشار إلى وجود ثلاثة معايير تميِّز الحرب الأهلية عن الأنواع الأخرى من المواجهات العنيفة داخل الدولة: داخلية المواجهة، نوعية المشاركين في المواجهة، وجود مقاومة فعَّالة. وسأشرح فيما يلي هذه المعايير الثلاثة، وأناقش مدى انطباقها على الوضع السوري.
ثلاثة معايير
ينص المعيار الأوَّل على أن المواجهة العسكرية ينبغي أن تكون في داخل دولةٍ ما، بالدرجة الأولى، ليكون بالإمكان تصنيفها بأنها حربٌ أهليةٌ. ومن الواضح انطباق هذا المعيار على الوضع في سوريا، إلى درجةٍ كبيرةٍ. صحيحٌ أن المواجهات قد امتدت إلى لبنان، في فترةٍ ما، من خلال المواجهة بين ميليشيا حزب الله وبعض “القوى المسلحة المعارضة المتمردة”، لكن الصراع عمومًا كان موجودًا في النطاق الجغرافي السوري بالدرجة الأولى. ما ينبغي أخذه في الحسبان أن المواجهات التي حصلت مع داعش والنصرة/ تحرير الشام هي امتدادٌ لمواجهةٍ عسكريةٍ بدأت في أفغانستان والعراق بين القاعدة والقوى الغربية خصوصًا، وهذا ما يُفقد تلك المواجهة الطابع المحلي الخالص.
ينصُّ المعيار الثاني على ضرورة أن تكون قوات الحكومة المركزية طرفًا في المواجهة العسكرية الداخلية. وهذا المعيار ضروريٌّ وغائبٌ، في الوقت نفسه، عن الفهم الشائع لمفهوم “الحرب الأهلية”. فوفقًا لهذا الفهم الشائع، تكون الحرب أهليةً، عندما يتقاتل الأهالي فيما بينهم وتكون السلطة/ الحكومة المركزية غائبةً. وفي عام 2016، نفى صادق جلال العظم أن يكون ما يجري في سوريا “حربً أهليةً معممةً”، واستند، في نفيه، إلى مقارنةٍ مع “الحرب الأهلية اللبنانية الجارة” و”الحرب الأهلية العراقية القريبة”، حيث رأى أن كلا الحربين كانت بين الطوائف، مع غيابٍ (شبه) كاملٍ للسلطة/ الدولة.([3]) لكن، وفقًا لهذا المعيار الثاني، وعلى النقيض من الفهم الشائع الذي يتبناه العظم، لا تكون المواجهة العسكرية الداخلية “حربًا أهليةً”، إلا عندما تكون السلطة/ الدولة طرفًا من أطراف هذه المواجهة.
للوهلة الأولى، يبدو أن هذا المعيار ينطبق، إلى حدٍّ كبيرٍ، على الوضع في سوريا، من ناحية مشاركة قوات السلطة المركزية، في جزءٍ كبيرٍ من المواجهة المسلحة، في سوريا. لكن ينبغي الانتباه إلى غياب مشاركة هذه السلطة، غيابًا كاملًا، تقريبًا، عن جزءٍ مهمٍّ من هذه المواجهة: الحرب على داعش التي شنها التحالف الدولي المكوَّن من أكثر من 73 دولةً، والمواجهة بين القوات التركية و”ميليشيات الجيش الوطني” من جهةٍ و”ميليشيات قسد” من جهةٍ أخرى. وتستدعي هذه المشاركة الأجنبية/ غير المحلية، وغياب أو تغييب السلطة المركزية، الإشارة إلى أنَّ هذا المعيار يهدف، تحديدًا أو خصوصًا، إلى تمييز هذه الحرب عن بقية أشكال الصراعات المسلحة الداخلية، مثل “العنف الطائفي أو الجماعاتي communal violence”، و”الحرب الداخلية الجهوية أو المناطقية regional internal war”. ويمكن لمشاركة قواتٍ أجنبيةٍ، في الحرب الأهلية، وانخراطها أو تدخلها فيها، أن تفضي إلى تغيير طبيعة/ ماهية هذه المواجهة المسلحة الداخلية، وتصنيفها. فالتدخل الخارجي يمكن أن يحوِّل الحرب الأهلية إلى “حربٍ أهليةٍ مدوَّلةٍ internationalized civil war”، أو “حربٍ بالوكالة proxy war”، أو “حربٍ بين الدول interstates war” أو “حربٍ دوليةٍ أو عالميةٍ an international, or a world war”.
فالحرب الأهلية تصبح “حربًا أهليةً مدوَّلةً” عندما تتدخل قوةٌ أجنبيةٌ، تدخُّلًا مؤثِّرًا، في تلك الحرب، لصالح قوات السلطة المركزية؛ ومن الواضح أنَّ جانبًا من “الحرب في سوريا” هو “حربٌ أهليةٌ مدوَّلةٌ”، منذ 2014، على الأقل، أي منذ التدخل الروسي الكبير والمؤثِّر. وربما كان بالإمكان الحديث عن تدويلٍ أكبر لهذه الحرب، إذا أخذنا في الحسبان المشاركة الإيرانية الفاعلة فيها.
ويصبح الصراع المسلح الداخلي “حربًا بين الدول”، عندما تتدخل دولةٌ أجنبيةٌ، تدخلًا عسكريًّا مباشرًا، في ذلك الصراع، لصالح القوى المتمردة على السلطة المركزية أو المعارضة لها. وربما تكفي الإشارة إلى تدخل الولايات المتحدة وخلقها أو مساندتها الكبيرة ﻟ “قوات سورية الديمقراطية”، وتدخُّل تركيا، وخلقها أو مساندتها الكبيرة لقوىً أو ميليشياتٍ عسكريةٍ سوريةٍ “معارضةٍ”، للتدليل على أن جانبًا من “الحرب في سوريا” هو “حربٌ بين الدول”.
وتصبح المواجهة الداخلية المسلحة “حربًا بالوكالة”، عندما تقوم قوىً إقليميةٌ أو دوليةٌ بدعم القوى المحلية المتقاتلة ورعايتها والسيطرة عليها إلى درجةٍ ما. ومن الواضح أن جانبًا من “الحرب في سوريا” هو “حربٌ بالوكالة”، إذا أخذنا، في الحسبان، مثلًا وخصوصًا، دور تركيا والولايات المتحدة الأميركية وقطر والسعودية، بالإضافة إلى دور روسيا وإيران، والقوات المحلية الخاضعة لها، خضوعًا كليًّا أو جزئيًّا.
ويمكن القول إن جانبًا من “الحرب في سوريا” هو “حربٌ دوليةٌ أو عالميةٌ”، انطلاقًا من مشاركة من 73 دولةً، على الأقل، في “التحالف الدولي” الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية، ومشاركة مقاتلين يحملون جنسيات أكثر من 80 دولةً في ميليشيات داعش، ومشاركة أكثر من 30 ألف مقاتلٍ أجنبيٍّ من سبعين بلدًا، وفقًا لكريستوفر فيليبس، في كتابه “المعركة من أجل سوريا: التنافس الدولي في الشرق الأوسط الجديد”، الصادر عام 2016.([4])
يهدف المعيار الثالث/ معيار “المقاومة الفعّالة” إلى تمييز الحرب (الأهلية) عن “المذبحة massacre” عمومًا، و”المذبحة المنظمة pogrom”، و”التطهير purge”، و”المجزرة slaughter” التي تقوم بها حكومةٌ بحقِّ كائناتٍ “لا حول لها ولا قوة”، أي لا قدرةً لها على التصدي للعنف الممارس ضدها، وعلى مجابهته. وينص هذا المعيار على أنَّ الطرف الأضعف، من الأطراف المتصارعة، لديه إمكانيات لأن يقاوم، مقاومةً فعَّالةً، الطرف الأقوى، ويوقع به خسائر لا تقل عن 5% من الخسائر التي يتكبدها. وعلى الرغم من أن معيار “المقاومة الفعَّالة” لا يتضمن القول بوجود تكافؤٍ أو تماثلٍ، في القوى، بين طرفي الصراع، فمن الصعب الحديث عن وجود مقاومةٍ فعَّالةٍ لدى “قوى المعارضة المسلحة”، عندما تكون قوات السلطة المركزية، وحدها، من تملك وتستخدم الطائرات والصواريخ البالستية والأسلحة الكيميائية. وهذا الخلل أو الانعدام في توازن القوى العسكرية، بين قوات السلطة المركزية و”قوات المعارضة المسلحة”، جعل المواجهة بين الطرفين تكون، أحيانًا أو غالبًا، مجازر ومذابح، أكثر من كونها “حربًا أهليةً”.
استنادًا إلى المعايير السابقة، يبدو مشروعًا التشكيك في مشروعية الحديث عن الأوضاع في سوريا، خلال السنوات الثمانية الأخيرة، على أنها، بالدرجة الأولى، (مجرد) حرب أهلية. وعلى العكس من مزاعم القائلين بضرورة “التحلي بالواقعية”، وبضرورة الإقرار بأن ما حصل ويحصل في سوريا، منذ عام 2011، هو حربٌ أهليةٌ، لا يبدو أن التشكيك في هذه التسمية يجسَّد حالة إنكارٍ نفسيٍّ/ نفسانيٍّ، بالمفهوم الفرويدي، فلهذا التشكيك أسسٌ معرفية ومنهجيةٌ أكثر قوةً مما يظن كثيرون. فبغض النظر عن مدى كونها “حربًا أهلية”، من الضروري التشديد على أنها ليست مجرد حربٍ أهليةٍ، فهي أيضًا، أحيانًا، وجزئيًّا ونسبيًّا، “حربٌ بالوكالة” و”حربٌ دوليةٌ أو عالميةٌ” و”مجزرةٌ (منظمةٌ)” و”مذبحةٌ”.
أين المشكلة؟
المشكلة/ الإشكالية في كل التسميات السابقة لا تتعلق بجانبها الوصفي فقط، بل تمتد إلى جانبها المعياري/ التقييمي أيضًا. فكل هذه المفاهيم هي مفاهيم “معياريةٌ كثيفةٌ thick ethical concepts”، فهي لا تقتصر على الوصف فحسب، بل تتضمن تقييماتٍ أيضًا، بالضرورة. ونظرًا إلى أن الاسمين/ الوسمين الأكثر شيوعًا، في هذا الخصوص، هما “الحرب الأهلية” والثورة”، فسأقوم بمقارنة البعد المعياري المحايث لهذين المفهومين، لأبيِّن أهمية الانتباه إلى هذا البعد في عمليات الوسم والتسمية. فعند استخدام المفاهيم المعيارية الكثيفة، تتضمن الوسوم والأسماء التي نستخدمها قيمًا وأحكامًا معياريةً عما يجب أن يكون، إلى جانب تضمنها لأحكامٍ واصفةٍ لما هو كائنٌ.
لمفهوم “الحرب الأهلية” دلالاتٌ معياريةٌ سلبيةٌ عمومًا، ﻓ “الحرب الأهلية” تحيل على ما ينبغي لنا تجنبه، “مهما كان الثمن”، على الأرجح. في المقابل، يحظى مفهوم “الثورة” بسمعةٍ جيدةٍ عمومًا، كونه يعني تغييرًا/ تغيرًا جذريًّا إيجابيًّا، و/ أو سعيًا حقيقيًّا وفاعلًا لإحداث هذا التغيير. وفي سوريا (ما قبل الثورة، على الأقل)، كان يكفي وصف فعلٍ أو حدثٍ ما بأنه ثورةٌ، لإظهار تقييمنا الإيجابي له. ولهذا حرص معظم الانقلابيين في تاريخ سوريا المعاصر على وصف “انقلاباتهم” ﺑ “الثورات” لإسباغ قيمةٍ إيجابيةٍ عليها. و”ثورة آذار 1963″ هي مثالٌ بارزٌ لذلك. ولهذا السبب تحديدًا أو خصوصًا، رفض النظام وإعلامه، رفضًا مطلقًا، تسمية ما حصل في سوريا منذ 2011 بأنه “ثورةٌ”.
تهمل “دراسات الحرب” الهدف من المواجهات المسلحة، عمومًا، ومن تلك التي تسميها ﺑ “الحرب الأهلية” خصوصًا، ولا تُفاضل بين طرفي الصراع، من حيث المشروعية مثلًا، وتقتصر على الحديث عن “الاستيلاء على السلطة” وما شابه. أما مصطلحات مثل الحرية، والكرامة، والديمقراطية، والتحرر من الاستبداد، فلا مكان لها في مثل هذه الدراسات التي لا تأبه (كثيرًا) إن كان النظام السياسي ديمقراطيًّا أو غير ديمقراطيٍّ. في المقابل، يتضمن المفهوم السياسي للثورة عمومًا، وفي السياق السوري/ الاستبدادي خصوصًا، تمييزًا بين طرفين، أحدهما محقٌّ و”مظلومٌ”، من حيث المبدأ، والآخر ظالمٌ ويفتقد للمشروعية (الديمقراطية). باختصارٍ، قد يتضمن الحديث عن “حربٍ أهليةٍ” مساواةً أو مماثلةً معياريةً بين طرفين ليسا متساويين أو متماثلين، أو لا ينبغي المساواة أو المماثلة بينهما. وفي بحثٍ مهمٍّ عن “الحروب الأهلية”، يشير ستاتيس كاليفات إلى أن الحرب الأهلية هي […] ظاهرة عرضة لالتباسٍ، أو حتى جدالٍ/ احتجاجٍ، دلاليٍّ جديٍّ. ويحمل وصف نزاعٍ ما، بأنه حربٌ أهليةٌ، ثقلًا رمزيًّا وسياسيًّا؛ لأن المصطلح يمكن أن يمنح أو ينكر الشرعية لأحد الأطراف المتحاربة”([5]).
عندما نتحدث عن “حربٍ أهليةٍ”، فهذا يعني أن المفاوضات بين الأطراف المتقاتلة ينبغي أن تهدف، بالدرجة الأولى، إلى تحقيق السلام والاتفاق بين الأطراف، في هذا الخصوص؛ ولا يهم كثيرًا، في مثل هذا السياق، مسائل الديمقراطية، والحرية، والكرامة، ومعاقبة الجناة، وإنجاز العدالة بالنسبة إلى الضحايا. في المقابل، إن الحديث عن ثورةٍ ضد نظام استبداديٍّ يتضمن ضرورة تغيير ذلك النظام، وتحقيق، ليس السلام فقط، بل والعدل، أيضًا، ليس لأنه غايةٌ في حد ذاته فقط، بل بوصفه شرطًا ضروريًّا من شروط إنجاز هذا السلام، أيضًا.
إن وصف ما حدث في سوريا منذ عام 2011 بأنه “حربٌ” أو “حربٌ أهليةٌ”، يتجاهل، بقصدٍ أو بدونه، المظاهرات والنشاطات المدنية/ السلمية التي قام بها السوريون المعارضون للنظام الأسدي، قبل، وأثناء، وبعد انطلاق المواجهة المسلحة مع هذا النظام. وقد ظلت هذه النشاطات هي المهيمنة في سوريا، حتى منتصف 2012، على الأقل، وبقيت موجودةً، وجودًا متفاوت القوة، لفترةٍ طويلةٍ، بعد ذلك.
الانتباه إلى مضامين المفاهيم التي يستخدمها المرء، في توصيفاته/ تقييماته، والسعي، قدر المستطاع، إلى أن يكون موضوعيًّا ومنصفًا، في توصيفاته/ تقييماته، هو جزءٌ أساسيٌّ من مراعاة مسؤولية الكلمة. فالقول فعلٌ، في مثل هذه السياقات على الأقل، كما بيَّن الفيلسوف الإنكليزي أوستين في عمله الأبرز “كيف تفعل الأشياء بالكلمات”، الذي جرت ترجمته إلى الفرنسية تحت عنوان “عندما تقول أنت تفعل”([6]). وعندما يكون هناك ضحايا وقتلةٌ وجرائم ومعاناةٌ وعذاباتٌ بشريةٌ هائلةٌ، تزداد الحاجة إلى الالتزام بمسؤولية الكلمة وبموضوعيتها وإنصافها. وبدون ذلك الالتزام، ستكون كلماتنا بمنزلة “إضافة الإهانة إلى الجرح”.
المراجع:
([1]) ليس نادرًا، في „الدراسات الغربية“، التركيز على البعد الطائفي من الصراع وتضخيمه واعتباره أحيانًا الجذر والمحور الأساسي للصراع، من خلال الحديث عن صراع سنيٍّ شيعيٍّ/ علويٍّ. انظر:
Samer N, Abboud, Syria, Cambridge: Polity Press, 2016), p. 1.
([2]) Melvin Small, and Joel David Singer, Resort to Arms: International and Civil War,1816–1980, Beverly Hills, CA: Sage, 1982: 205-206.
([3]) في الحوار الذي أجرته ديمة ونوس مع العظم، يقول العظم: “ما يجري في سورية اليوم هو بالتأكيد ليس حرباً أهلية معمّمة، خاصة عندما نقيس ما يحصل على الحرب الأهلية اللبنانية الجارة والحرب الأهلية العراقية القريبة. في لبنان، عبّأت الطوائف المكوّنة للمجتمع اللبناني نفسها ودخلت في حرب شرسة في ما بينها (خاصة الدروز والموارنة) وكانت السلطة غائبة عن ذلك كلّه والدولة على الهامش تماماً. في العراق، لم يكن هناك دولة أو سلطة بعد أن حلّهما الاحتلال الأمريكي فقام كل من المكوّن الشيعي والسنّي للشعب العراقي بدخول حرب أهلية حقيقية في ما بينهما”. “صادق جلال العظم لـ’المدن’: الحل بسقوط العلوية السياسية”، المدن، 15 تموز/ يوليو 2016.
([4]) Christopher Phillips, The Battle for Syria: International Rivalry in the New Middle East, (New York & London: Yale University Press, 2016), p. 142.
([5]) Stathis N. Kalyvas, “Civil Wars,” in The Oxford Handbook of Comparative Politics, eds. Carles Boix and Susan Stokes (Oxford: Oxford University Press, 2007), p. 416.
([6]) بالنسبة إلى الترجمة العربية، انظر: جون أوستين، نظرية أفعال الكلام العامة: كيف ننجز الأشياء بالكلام، ترجمة: عبد القادر قنيني، (الدار البيضاء: أفريقيا الشرق، 1991).
حكاية ما انحكت
——————————–
حتى الموت/ خضر الآغا
منذ بدء الاحتلال الروسي لسوريا في أيلول/سبتمبر 2015، بدا واضحًا أن ميزان القوى رجح كثيرًا ونهائيًا باتجاه روسيا نظرًا للتفوق النوعي في الأسلحة وبخاصة الطيران، وبدا أن كل أشكال المقاومة لن تغير شيئًا على الأرض، لا مقاومة الفصائل ولا مقاومة أهالي المدن والبلدات التي شن عليها الاحتلال هجمات متلاحقة وعنيفة متخذًا في ذلك سياسة الأرض المحروقة. وحيث ذلك فقد أدركت الفصائل والمقاومون من الأهالي والناشطون والمراقبون أن مزيدًا من المقاومة تعني مزيدًا من قتلهم دون تحقيق أي تقدم فعلي على الأرض. وقد ارتفعت أصوات هنا وهناك تطلب من المقاتلين التوقف عن القتال، ومن الأهالي مغادرة البلدان والمدن التي تتعرض للهجوم. ومع ذلك لم يتوقف المقاتلون عن القتال، ولم يترك الناس بلداتهم ومدنهم بالرغم من معرفتهم النتيجة التي هي غالبًا الموت.
عندما كان يسيطر الروس بشكل تام على سير المعارك وعلى الأرض كان يجري تهجير المقاتلين والأهالي إلى مناطق أخرى، وغالبًا إلى إدلب على الرغم من أنه كان بإمكانهم البقاء تحت مسمى “المصالحة” بينهم وبين النظام بـ “ضمانة” روسية! لكنهم مع ذلك كانوا يرفضون “المصالحة”، ويهاجرون تاركين بلداتهم وملكياتهم وذواكرهم وتاريخهم.
فلماذا يفضلون القتال حتى الموت، ويفضلون التهجير بكل طرقاته الكارثية والخطيرة ونتائجه المدمرة على أن يبقوا تحت سيطرة النظام؟ لا يقود البحث عن أسباب ذلك إلا إلى سبب واحد لا ثاني له وهو أن لا حياة مع نظام البراميل ونبش القبور. أسّس هذا النظام الهمجي علاقته بمعارضيه على حد واحد: إما قاتل أو مقتول. وذلك منذ أن سجن حافظ الأسد رفاقه في الحزب والدولة والجيش وقتل بعضهم ليستولي على السلطة، ومنذ أن سجن معارضيه لمجرد رأي يخالف رأيه أو لمجرد انتساب لحزب سياسي معارض سنوات بلغت كحد متوسط 15 عامًا بقرارات أمنية عرفية، ومنذ أن دمّر مدينة حماه… وقد اعتبر معارضيه منذ مجيئه إلى السلطة أعداء له وليسوا خصومه السياسيين. وأكمل ابنه المسيرة من بعده وأضاف إليها قتل الناس وتهجيرهم وتهديم منازلهم ودور عبادتهم وكافة التفاصيل المرعبة التي لم نزل نعيشها يوميًا وعلى مدار الساعة… ناهيك عن تدمير المجتمع السوري وتفخيخه وإفقاره وغير ذلك من الأمور التي لا يفعلها حتى الأعداء بشعوبهم، ولا يفعلها حتى الهمج… الحقيقة لا يفعلها إلا هذا النظام حرفيًا وحصريًا، إنها من طبيعته.
قام نظام الجريمة على مدار سنوات الثورة والحرب باعتقال الكثير ممن تم إرغامهم على المصالحة أو ممن فضّلها على التهجير وعواقبه، وقد قضى بعضهم تحت التعذيب في سجونه، كما أرغم المقاتلين من الفصائل ومن أهالي البلدات والمدن الذي رضخوا للمصالحة على القتال في صفوف جيشه، وكان يضعهم في الخطوط الأمامية من المواجهات ليقاتلوا أهلهم وأهالي بلداتهم ومدنهم المهجرين من جهة، وليموتوا من جهة أخرى، وقد حصل ذلك في كافة المناطق، في الغوطة وفي درعا وغيرهما.
في هجوم الإبادة التي تشنها روسيا وميليشياتها، بما فيها ميليشيا النظام، على إدلب لم يتم تسجيل ولا حالة من هروب الناس إلى مناطق سيطرة النظام على الرغم من المصير المجهول الذي يلقاه الهاربون، وعلى الرغم من انعدام المكان الذي يمكن أن يهربوا إليه أصلًا بعد أن صارت إدلب هي مكانهم الأخير. لا تفسير لذلك أيضًا إلا أن الناس يفضلون الموت فعليًا على أن يعيشوا مع هذا النظام، فالحياة منعدمة بوجوده.
ربما لن نعثر في التاريخ الحديث على حالة من الشر المطلق يمكن الاستناد إليها لتفسير طبيعة النظام السوري، لا النازية تسعفنا ولا الفاشية، ولا حتى العصابات المنظمة، فالجرائم التي ارتكبتها مع خطورتها وكبر حجمها لم تكن في مثل طبيعة وحجم جرائم هذا النظام. لا يمكن تفسير طبيعته إلا بمقارنتها مع نفسها، لذلك لن نلجأ إلى البحث في التاريخ عن تفسير، فالتفسير يكمن في طبيعة النظام ذاتها، ولا عن تسمية إلا باسمها نفسها: الأسدية إذًا.
بـ”الأسدية” نفسر قتال السوريين حتى الموت دون أن يسلّموا أو يستسلموا، وبـ”الأسدية” نفسر هروب الناس إلى البراري والوحول والغابات والسيول والأمطار دون مناطق سيطرة النظام، نفسر هروبهم إلى/ وتفضيلهم الموت على ألا يعيشوا في ظل النظام.
أسّس الأسد الأب الأسدية عبر ثلاثين عامًا من قمع الشعب السوري وإذلاله، عبر اعتباره، ليس فقط معارضيه السياسيين أعداء له فحسب، بل الشعب السوري برمته، ورأينا مرارًا تجلياتها مكثفة بمجزرة حماة، وقد أكمل الابن المهزوز تفسير الأسدية على نحو غير مسبوق منذ أن ثار عليه السوريون 2011 فظهرت دفعة واحدة المقولة الأسدية الوحيدة التي حكمت سوريا منذ العام 1970 وهي: أنا أو لا أحد، وقد أظهرها الشعار الذي يعبر عن جوهرها باختصار محكم: الأسد أو نحرق البلد.
الأسدية هي ذلك الشر المطلق في عصرنا.
السوريون يعيشون الآن صراعًا وجوديًا: نكون أو لا نكون. هذه هي الأسدية.
الترا صوت
———————————-
من انتصر في سوريا؟!/ ريما فليحان
مع كل تغيير بخارطة المعارك وإعادة لرسم مناطق النفوذ في سوريا، يُعلن الانتصار بوقاحة لا مثيل لها، وأقول إعادة توزيع لمناطق النفوذ لأن الجغرافية السورية بكاملها ليس فيها مناطق محررة، لا المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام ولا المناطق الواقعة تحت سيطرة أي فصيل مسلح بغض النظر عن تبعيته وعلمه الذي يرفعه وأيدولوجيته التي يتبناها. لقد انتهت مرحلة السذاجة السياسية عند الكثير من السوريين بعد أن أصبحت للحرب في سوريا صورة واضحة المعالم، وهي عبارة عن اقتتال وتنازع يجري على الأرض السورية ويدار بإرادات دولية ونزاعات إقليمية ومصالح ذاتية ضيقة، يدفع فيها المدنيون الأبرياء الأثمان الباهظة من دمهم واستقراراهم ومصير أبنائهم. انتهت تلك المرحلة التي كان يمكن فيها للطرفين أن يقولا بثقة أو “بصدق على الأقل” عن المناطق التي تقع تحت سيطرة النظام “مناطق محررة” أو المناطق الخارجة عن سيطرة النظام “مناطق محررة”، بغض النظر عن الجهات التي تسيطر على تلك المناطق، لأن فكرة التحرير الحقيقية تلك تسقط على فوهات البنادق والانتهاكات بحقوق المدنيين والتي وقعت في كل شبر في سوريا، سقطت حين كان النظام يدك بيوت المدنيين ويستهدف المشافي والأسواق في المناطق التي تظاهرت ضده ويقتلهم يكل أنواع الأسلحة ويعتقل ويعذّب النشطاء ويصفي ويلاحق الأبرياء في مناطقه أو حين يعيد السيطرة على مناطق كانت خارجة عن نفوذه لينتقم من الأهالي وكل من كان له موقفاُ معارضاً له.
سقطت فكرة التحرير أيضاً حين استهدفت الفصائل المدنيين بالهاون في المناطق الأخرى، وحين وضع المدنيون في أقفاص وحين اعتقل وعذّب الناس في مناطقهم بسجون تشابه سجون النظام، وحين خطفوا النشطاء وغيبوهم في سراديب مظلمة، وحين تحكموا برقاب الناس وظلموهم وهم يفترض في مناطق “محررة”، والحقيقة أن المدنيون في سوريا كانوا ومازالوا طوال السنوات الماضية للحرب رهائن ينشدون النجاة فقط بأي وسيلة ممكنة مع كل تغيير وإعادة رسم لمناطق النفوذ عسكرياً على الخارطة السورية.
اذاً لا تحرير في سوريا، في سوريا فقط مقتلة يقوم بها من جهة نظام فاشي ضمن سلسلة من جرائم الحرب التي تقتلع المدنيين من بيوتهم وتقتلهم حتى في المخيمات بل وتنتهك القبور والجثث وتسرق بيوت الهاربين أو الموتى وتقتل النساء والأطفال وهم يحاولون الفرار، وفصائل متطرفة مرتزقة من جهة أخرى تبيع تلك المناطق وتتحرك كالدمى بأوامر تأتي من الخارج، من يلقب نفسه بالمنتصر اليوم هو مجرم حرب استجلب كل أنواع التدخلات إلى سوريا، فباتت سوريا محتلة من الروس والإيرانيين بشكل كامل بينما باتت الفصائل في الشمال مرتهنة للأتراك بالكامل، بينما بقية المناطق في سوريا موزعة كنفوذ بين ميلشيات وأخرى بأجندات مختلفة أو قواعد عسكرية تابعه لعشرات الأقطاب والدول، وبين مناطق تأكلها الفوضى وتسيطر عليها عصابات الخطف والسرقة ويختنق قاطنوها بالضغوط الاقتصادية وعدم القدرة على تأمين أبسط الحاجات الأساسية لاستمرار الحياة، إذاً كيف يجرؤ أياً كان على التغني بانتصارات بينما نصف الشعب السوري لاجئ ونازح والنصف الآخر يعيش بضغط اقتصادي وأمني لم يسبق له مثيل؟
من انتصر في سوريا إذاً؟ انتصرت في سوريا الحرب على السياسية، والطائفية والمناطقية والتعصب على المواطنة والإنسانية، انتصرت في سوريا كل دول العالم بينما خسر السوريون وحدهم، انتصر تجار الحروب والأزمات وخسر المدنيون، انتصرت قارورة الغاز ومن يتحكم بقوت الشعب على دفء الوطن، والموت على حب الحياة، وصلافة السياسة الدولية على الضمير العالمي، انتصرت الرصاصة على زجاجة الحليب، وانتصرت الوحشية على الإنسانية، انتصرت المصالح الدولية على الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والأيدولوجيات الضيقة على الحراك الشعبي الجامع، وانتصرت عصابات تهريب البشر على حق الهاربين من الموت بإعادة التوطين، نعم هؤلاء هم المنتصرون في سوريا ونحن جميعاً كل السوريين الحقيقين خاسرون حتى نقي العظام في هذه المرحلة.
ولكن وأكاد أجزم أن المشهد الحالي ليس هو المآل النهائي لسوريا، والحقيقة وعلى الرغم من أن من ينتمي لهؤلاء المنتصرين لا يرغب حقيقة بانتهاء المعارك ولا نهاية الحرب لأن نهاية الحرب تفشل مشاريعهم ولا تلاقي مصالحهم وتفشل رغبة التغيير، فالمرحلة الحالية بقسوتها هي مرحلة عبور لا بد ستنتهي حتماً حين سيبدأ التغيير، والتغيير يعني نهاية مصالح كل هؤلاء المنتصرين الآنيين. فالتاريخ يقول أن الرصاصة لا يمكن ان تقتل فكرة، والفكرة لا يمكن أن تموت طالما هناك سوري واحد يحب سوريا وطناً جامعاً عادلاً حراً لكل السوريين ويريد أن ينتقل بوطنه إلى مرحلة جديدة تحقق استقراراً وتغييراً سياسياً تزدهر فيه الحريات وحقوق الإنسان ويعيش فيه الناس بكرامتهم ويحاسب فيه مجرمو الحرب، المشهد لن يكتمل قبل أن يحصل التغيير الديموقراطي المنشود في سوريا عبر حل سياسي نهائي يجلب السلام إلى سوريا، والسلام الحقيقي يعني انتصار المدنية على السلاح، والديموقراطية على الاستبداد السياسي والديني، والمدنية على العسكر، وبانفتاح نحو العالم يبنى على المصلحة الوطنية لا على التبعية والذل وليس من خلال منطق الحفاظ على الحكم، حينها فقط قد يمسح السوريين الدماء والدموع عن وجوهم وينفضوا غبار الأنقاض والمخيمات ويحتفلوا بالانتصار.
ريما فليحان – كاتبة سورية
————————————–
الأسد في الذكرى التاسعة للثورة:النظام قد ينهار قريباً
يصف موقع “يو إس إي توداي” في تقرير أعدته عشية الذكرى التاسعة لاندلاع التظاهرات المطالبة بتغيير النظام في سوريا والتي تحولت إلى ثورة على النظام، الرئيس بشار الأسد بأنه “أكثر القادة وحشية ودموية في القرن الحادي والعشرين”.
رغم أنه تدرب كي يكون طبيب عيون ولم يكن مرشحا لرئاسة سوريا بسبب خجله وخوفه من الدم كما كان والده حافظ الأسد يعتقد، فقد أثبت بشار الأسد أنه أكثر القادة وحشية ودموية في القرن الحادي والعشرين، وفق تقرير “يو إس إيه توداي”.
ويشير التقرير الذي اعتمد شهادات من دبلوماسيين وزملاء سابقين للأسد، أنه نجا وتمسك بالسلطة رغم سقوط طغاة آخرين في الشرق الأوسط.
وما بدأ كانتفاضة مفعمة بالأمل تضخم إلى صراع مدمر ومستعص على الحل ساهم في أزمة اللاجئين الأكثر حدة منذ الحرب العالمية الثانية. وأدت الحرب في سوريا إلى مقتل مئات الآلاف، وتشريد الملايين، وساعدت على تحفيز صعود تنظيم “داعش”.
ويشير التقرير إلى أن قصة بقاء الأسد ــ وتفكك سوريا ــ تشكل جزءاً من اللاإنسانية الشخصية، وجزءاً من اللامبالاة الدولية. وقبل خمس سنوات، اعترف الأسد في خطاب متلفز بأن جيشه كان متعباً وأن جيشه بدأ يفقد أرضه. لكن اليوم، عادت معظم سوريا إلى سيطرة الأسد.
ووفق التقرير، وصف روبرت فورد، الذي شغل منصب سفير الولايات المتحدة في سوريا في الفترة من 2011 إلى 2014 وتعامل معه، الأسد بالقوي جدا وأنه تحول إلى “قاتل شعبه”.
وينقل التقرير عن الأمم والجماعات الإنسانية والهيئات الرقابية في سوريا، أن عنف الأسد اتخذ أشكالاً منها: فرض حصار التجويع على المناطق التي يسيطر عليها المتمردون؛ القصف المتكرر بمساعدة روسية للمستشفيات والبنية التحتية المدنية؛ اعتقال وتعذيب الآلاف من النشطاء والمدونين والمدنيين، ثم اعتقالهم في سجون سرية في أعماق الأرض، حيث يقبعون دون محاكمة. كما استخدم قنابل الكلور وغاز السارين – الأسلحة الكيميائية – ضد مقاتلي المعارضة، مما أسفر عن مقتل الأطفال والمدنيين في هذه العملية.
وينقل التقرير عن أيمن عبد النور، وهو صديق سابق للزعيم السوري منذ أيام دراستهما الجامعية في الطب في دمشق قوله: “كل من يعرف الأسد يعرف شيئين عنه، أولا: أنه يكذب، عن كل شيء. ثانياً: أنه غيور للغاية. إذا كان لديك ساعة لطيفة أو كاميرا، سوف يسعى للحصول على أفضل منها”.
بعض المعارضين للأسد يعتقدون أن النظام سقط بحسب ما ينقل عنهم “يو إس إي توداي”. ويقول فراس طلاس، الذي كان أحد أغنى الرجال في سوريا وأحد المقربين السابقين من عائلة الأسد، في مقابلة هاتفية من دبي، حيث يعيش في المنفى، إن هناك “مزاجاً داخل سوريا اليوم يشير إلى أن النظام قد ينهار قريباً، وأنه لا يمكن أن يستمر”.
وقال إنه في “حين أن الأسد قد يكون له حالياً اليد العليا إقليمياً وعسكرياً، إلا أن الوضع يتغير كل بضعة أشهر والحياة اليومية، حتى بالنسبة للموالين للنظام داخل سوريا، صعبة: انقطاع الكهرباء، وقلة فرص الحصول على الرعاية الصحية”.
ويخلص التقرير إلى أنه مهما كان تقييم نظام بشار الأسد، فقد أثبت أنه ربما سفاح وقاس مثل والده، إن لم يكن أكثر منه.
——————————————
الحرب السورية تبدأ عامها العاشر مخلّفة مأساة إنسانية هائلة ودماراً واسعاً
تبدأ الحرب السورية عامها العاشر الأحد، مخلّفة مأساة إنسانية هائلة ودماراً واسعاً، فيما لم تفلح كل الجهود الدولية المبذولة في التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع توقف معاناة المدنيين.
حين اندلعت الاحتجاجات السلمية منتصف مارس 2011، لم يتخيّل المتظاهرون أن مطالبهم بالديموقراطية والحريات ستكون مقدمة لأكبر حروب القرن الواحد والعشرين، وأن حراكهم الذي سرعان ما واجهته قوات الأمن بالقوة والقمع سيتحول حرباً مدمرة تشارك فيها أطراف عدة خصوصاً مع صعود نفوذ التنظيمات الجهادية.
وبعد مرور تسع سنوات، ما زال الرئيس بشار الأسد على رأس السلطة. وباتت قواته، التي تدخّلت روسيا عسكرياً لصالحها عام 2015 وتتلقى دعماً إيرانياً، تسيطر على سبعين في المئة من مساحة البلاد، وتعمل على توسيع نطاق سيطرتها، وآخر ما حققته تقدم استراتيجي في محافظة إدلب (شمال غرب) حيث سُجلت أسوأ كارثة إنسانية منذ بدء النزاع.
ويتزامن دخول النزاع عامه العاشر مع بدء روسيا الداعمة لدمشق، وأنقرة الداعمة للفصائل المعارضة، دوريات مشتركة لأول مرة في إدلب، تطبيقاً لوقف إطلاق نار توصلتا إليه دخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي وأوقف هجوماً تسبب بفرار نحو مليون شخص، في أكبر موجة نزوح منذ اندلاع النزاع.
وأودت الحرب بحياة 384 ألف شخص على الأقل بينهم أكثر من 116 ألف مدني، وفق حصيلة نشرها المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت، وخلّفت عدداً كبيراً من الجرحى والمعوقين عدا عن عشرات آلاف المعتقلين والمفقودين.
وبحسب الأمم المتحدة، نزح أكثر من ستة ملايين سوري داخل البلاد، يقيم عدد كبير منهم في مخيمات عشوائية بينما بات أكثر من 5,6 ملايين سوري لاجئين في دول أخرى، لا سيما لبنان وتركيا والأردن.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “يدفع المدنيون الثمن الأكبر” في سوريا حيث “لم يجلب عقد من القتال إلا الدمار والفوضى”.
“فقدنا كل شيء”
في مدينة الدانا في إدلب حيث تقيم مع عائلتها بعد محطات نزوح عدة أعقبت فرارها من مسقط رأسها في مدينة حلب، إثر سيطرة قوات النظام عليها بالكامل نهاية عام 2016، تقول حلا إبراهيم (35 عاماً) لوكالة فرانس برس “تسع سنوات من الثورة كانت كافية لايضاح عمق الألم الذي مرّ بنا من تهجير قسري ونزوح وقصف وشهداء”.
وتضيف وهي أم لأربعة أطفال وتعمل في متابعة ملف مفقودي الحرب “فقدنا كل شيء في لحظة واحدة” موضحة أن الحرب حرمتها الكثير “تركت جامعتي وعملي ومنزلي الذي قصف ولا أعلم حتى اللحظة شيئاً عنه”.
وألحقت الحرب دماراً كبيراً بالمنازل والأبنية والبنى التحتية والمدارس والمستشفيات، واستنزفت الاقتصاد وقطاعاته على وقع انخفاض قيمة الليرة مقابل الدولار بشكل غير مسبوق وارتفاع قياسي في أسعار المواد الاستهلاكية.
وترزح الفئة الأكبر من السوريين تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، في وقت يحتاج ملايين الأشخاص إلى “الدعم لإعادة بناء حياتهم وموارد رزقهم (..) وخلق وظائف ومصادر دخل والحفاظ عليها”.
وأوردت في تقرير قبل يومين أن “الناس بحاجة الى المساعدة للتعامل مع التداعيات النفسية والعقلية التي نجمت عما مروا به خلال سنوات الحرب”.
في مخيم للنازحين في ريف إدلب الشمالي، تقول سهام عبص (50 عاماً) لفرانس برس “لم أرَ أصعب من هذه الأيام”، مضيفة بحسرة “لم أر ولديّ وهما في الغربة منذ عشر سنوات”.
وتسأل “لماذا فعلوا بنا هذا؟ (..) الثورة تعني أن نبقى في منازلنا لا أن نتشرّد”، مضيفة “الطيران فوقنا وروسيا وإيران والدول كلها علينا”.
ساحة مبارزة
مع دخول الحرب عامها العاشر، تحوّلت سوريا ساحة تتبارز على جبهاتها جيوش دولية ضخمة، فيما ذهبت هتافات صدحت بها حناجر مئات الآلاف من أبنائها المنادين بإسقاط النظام بدءاً من محافظة درعا جنوباً، أدراج الرياح.
وتنشط في سوريا اليوم خمسة جيوش نظامية على الأقل، غير المجموعات المحلية أو الخارجية الصغيرة الموالية لهذه الجهة أو تلك. ولكل قوة دولية أهدافها ومصالحها الخاصة. فينتشر إيرانيون من قوات “الحرس الثوري” ومقاتلون لبنانيون وعراقيون وقوات روسية بطائراتها وعسكرييها في مناطق سيطرة قوات النظام.
وتنتشر في شمال شرق البلاد قوات أميركية في مناطق سيطرة الأكراد، الذين أنشأوا إدارة ذاتية باتت مهددة بشدة بعد شنّ تركيا ثالث هجوم عسكري على مناطقهم في أكتوبر.
ولا تكفّ الطائرات الحربية الإسرائيلية عن اختراق الأجواء واستهداف مواقع للجيش السوري أو للمقاتلين الإيرانيين وحزب الله، وهدفها المعلن منع الإيرانيين من ترسيخ وجودهم.
وتسيطر القوات التركية على منطقة حدودية واسعة في سوريا. وتنشر قواتها في إدلب، حيث من المقرر أن تبدأ الأحد تسيير دوريات مشتركة مع موسكو على طول طريق دولي يعرف بإسم “إم فور” يربط محافظة اللاذقية الساحلية بمدينة حلب.
ويأتي تسيير الدوريات تطبيقاً لوقف اطلاق نار بدأ سريانه في السادس من الشهر الحالي ووضع حداً لهجوم واسع شنّته قوات النظام بلغ ذروته مع مواجهات عسكرية بين الجيشين التركي والسوري.
ولطالما كررت دمشق عزمها استعادة السيطرة على كافة المناطق الخارجة عن سيطرتها بالقوة أو عن طريق المفاوضات، فيما فشلت جهود المجتمع الدولي في تسوية النزاع سياسياً.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة الخميس “لا يوجد حل عسكري. حان الوقت الآن لاعطاء الدبلوماسية فرصة للعمل”.
————————————–
كورونا الأسد والمقاومة الشعبية/ بسام يوسف
هل كان توفيق الحكيم يتوقع- عندما كتب مسرحيته “نهر الجنون”- أن يأتي يوم، يكون الواقع المعاش أكثر غرابة مما فيها؛ فقد كان نهر مسرحيته ماءً، وكان الناس يشربون من مائه، أما اليوم فقد تحول نهر الماء إلى نهر دم، وقد صارت الناس تغرق فيه.
لم يتخيل أحد- عندما تقرر إلحاق سوريا باسم عائلة مغتصبها، حافظ الأسد، فأصبح اسمها “سوريا الأسد”- حجم الكارثة التي بدأ تأسيسها، يومها كان الجميع يظن أنها تسمية بلا معنى، وأن لا أهمية لها، وأن الزمن وحده كفيل بأن ينهي هذه المسرحية التافهة.
وها إن عقوداً مضت، وكل ما في سوريا ملك لعائلة الأسد. حسناً، إذاً لماذا لا تكون حصة سوريا من فايروس “كورونا” ملكاً حصرياً لهذه العائلة؟ وعلى هذا، وحرصاً على تسلسل النتائج من مقدماتها الصحيحة، لماذا لا يحمل هذا الفايروس اسم هذه العائلة، وكل منهما أكثر قرباً من شرف قرينه الرفيع، وأكثر جدارة له، مادام كل منهما شديد التطابق مع آخره في الجوهر والمعنى، وفي المبنى والأثر؛ فيكون الاسم: كورونا الأسد، أو عائلة كورونا؟
وبالتتابع، وفي نفس السياق: أليس الأجدر للمعارضة، التي تجد أن من الضروري والوطني والثوري أن تنخرط في انتخابات مجلس الشعب القادمة التي ستجرى في سوريا، أن تحمل هي أيضاً اسم هذه العائلة؛ فتكون قوى الأسد، أو قوى كورونا، للمعارضة الداخلية (من المهم جداً توضيح أنها معارضة داخلية، تمييزاً لها عن قوى المعارضة الخارجية العميلة والخائنة وفق رؤية منظرها العتيد)، لا سيما أنها معارضة توشك أن تقول قول شبيحة النظام: (ليست المشكلة في الرئيس، إنها في المؤامرة الكونية عليه) لكن، لأنها معارضة من طراز ماركسي خاص، ولأنها تستمد لغتها وحكمتها من مقولات الديالكتيك والمادية التاريخية؛ فإنها تقولها بلغة أقل فجاجة.
إنها السوريالية السورية التي تبتكر كل يوم فصلاً جديداً من عبثيتها، فيفيض نهر الجنون، أو نهر الحقد؛ ليصبح الحديث عما يجري هو الجنون بعينه.
لنحاول أن نقول الأمر بقول آخر، بعيداً عن غرابته وعبثيته وجنونه، إن استطعنا:
لقد أصبح واضحاً للجميع، كيف قررت سلطة الأمر الواقع أن تتعامل مع فايروس كورونا، وعبره مع الشعب السوري، حين اعتمدت منهجها الدائم في مثل هذه الحالات، وهو: منهج التجاهل وطمس الحقائق، مهما تكن نتائج هذا التجاهل وهذا الطمس.
هكذا قرر النظام – بكل راحة وأريحية- عدم الاعتراف بفايروس كورونا، وبجرة قلم من قلمها المعهود ألغت وجوده، وتركت لمن يفتك بهم هذا الفايروس أسبابها الأخرى.
ولأن المهزلة عادة تجر إلى مهزلة لا تقل عن سابقتها غرابة، فقد جاءت الدعوة التي أطلقها تيار التغيير السلمي للمشاركة في انتخابات مجلس الدمى، المسمى مجلس الشعب السوري، ولكي يعطي لسفاهته هذه وجهاً آخر؛ فقد أضاف إليها ما توهم أنه يجملها ويلبسها ثوب الوطنية، فأوضح: أن هذه المشاركة ستكون مقدمة لخلق مقاومة شعبية تأخذ على عاتقها تحرير سوريا من الاحتلالات. وبالتالي، عن أية مهزلة يمكن الحديث، عندما يريد أن يصبح بطل التحرير من طالب مراراً بقدوم جيوش الاحتلال؟
إن السوريين لا يفتقدون مفارقات كثيرة لا تقل غرابة عن قرار عدم الاعتراف ب “كورونا”، ولا تقل سخفاً عن بطولة التحرير المتوهمة عند تيار التغيير السلمي؛ فعلى مساحة هذا البلد المنكوب تتوالى الأحداث الصادمة، فهناك سوريون ينقسمون، ويختلفون، حول مناصرة أي احتلال من احتلالات بلدهم، وهناك سوريون ينقسمون، ويختلفون، حول عدد الكيلومترات التي نص عليها اتفاق سوتشي، ومتى يكون هذا العدد انتصاراً، ومتى يكون هزيمة.
قد تكون نعمة الجغرافيا التي أحالها الطغاة إلى نقمة، كأن سوريا لا يكفيها أربعة عقود من حكم قد جفف كل ما فيها، ليعقبها عقد خامس من القتل والتدمير والتهجير واستقدام الجيوش والمرتزقة، ثم تكتمل حلقات الفجيعة بأن تتصارع على أرضها ثلاث دول مأزومة، تاريخها سلسلة من الحروب فيما بينها، ترى أن خلاصها من أزمتها سيكون على هذه الجغرافية المسماة سوريا.
ولقد قالت تلك الأم السورية التي كانت تقف أمام تابوت ابنها الضابط القتيل في حرب الجنون، بعد أن تقدم إليها الضابط الذي رافق التابوت؛ لكي يسلمها العلم: إنها مستعدة أن تذهب هي إلى ساحة المعركة؛ لكي تقاتل حتى بأسنانها؛ ولقد تعالت الزغاريد، ودمعت أعين الرجال من شدة التأثر، وانتفخ صدر الضابط بعد أن شعر بالفخر فجأة. أية مسرحية عبثية هذه! وأي فاجعة يمكنها أن تحتوي هذا الحقد الذي يتغول، ويبتلع كل شيء؟
حتى اليوم لا يزال القسم الأعظم من السوريين يدير ظهره للحقائق التي كشفت عنها تسع سنوات المقتلة، ولا يزال القسم الأعظم من السوريين على عناده في قراءة الحالة التي وصلنا إليها بدلالات لم يعد بطلانها خافياً على أحد، فلا المؤامرة قادرة على تفسير ما جرى ويجري، ولا الطوائف، ولا السماوات. وحده الدم المراق، والقهر الذي ينام السوريون كلهم تحت وطأته، يمكنه أن يقرأ هذه الحال كما ينبغي؛ هذا إذا لم يعمنا نداء الحقد.
لم يعد لهذا الجنون حد، فقد استفحل الحقد إلى الحد الذي بات فيه مجرد الحديث عن الحكمة والتعقل خيانة، ومجرد لفت النظر إلى سبب هذا البلاء وأسّه كفيل بأن يحيل الحاضرين إلى كتلة من غضب؛ يمكنها تفتيت جسد هذا الذي يقول ما لا يريدون سماعه. لقد أصبحنا حشوداً متعطشة للقتل.
ولكي تكتمل فصول الفاجعة، فيغدو الخلاص أقرب ما يكون إلى الاستحالة؛ تتمدد اللوحة لتكشف عن عالم يفيض بالوحشية، عالم لا يتردد قادة دوله الكبرى عن نزع قناع القيم والحقوق عن وجوههم معلنين: أن صياغة جديدة للنهب والتوحش ستكرس على هذه الأرض مهما كان عدد ضحاياها.
هل يمكن إنقاذ شعب أعزل، ومقسم، ومستباح؟ وهل يمكن إنقاذ شعب فاض نهر الدم فيه؛ ففاض نهر حقده؟ وهل يمكن إنقاذ شعب يتزعمه الخونة وتجار الدم؟ وهل يمكن إنقاذ شعب يحاصره الموت من ست جهات الأرض؟
هذه أسئلة الكارثة المفجوعة التي تستحق أن نقف جميعاً في حضرتها عراة إلا من سوريتنا.
تلفزيون سوريا
————————————–
تسع سنوات روسية في سورية: نحو مستنقع أفغاني جديد؟/ سامر إلياس
وظّف الكرملين كلّ إمكاناته السياسية والعسكرية والأمنية والإعلامية، طوال تسع سنوات من عمر الحرب السورية، من أجل استخدام ورقة هذه الحرب، بأكبر قدرٍ ممكن في سياساته الداخلية، وطموحاته لاستعادة الدور العالمي كطرفٍ لا يمكن الاستغناء عنه في حلّ الأزمات الدولية، من آسيا إلى أميركا اللاتينية، مروراً بأوروبا وأفريقيا. وسمحت الظروف الدولية، خصوصاً سياسة التردد واستراتيجية الانكفاء لدى الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بفرض وصايةٍ كاملة روسية على سورية، عزّزتها سياسة التنسيق مع الأطراف الإقليمية المستثمرة في أزمة هذا البلد (تركيا، إيران، وإسرائيل)، وسط تراجعٍ ملحوظ للدور العربي، جعلته الأزمة الخليجية ومقاطعة قطر يكاد يكون معدوماً.
وعلى الرغم من نشوة “الانتصارات” العسكرية والدبلوماسية الروسية، فإن الوصول إلى حلٍّ سياسي شامل وفق رؤية موسكو، ويحظى في الوقت ذاته بقبول السوريين والأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة، لا يزال بعيداً، ويتطلب تنازلاتٍ روسية كبيرة لقوى إقليمية تتناقض رؤيتها حول مستقبل سورية، وبات من الصعب التوفيق بين مطالبها. ولعل الأهم أن موسكو مجبرةٌ على الاستعانة بجهود بلدان الخليج وأوروبا والولايات المتحدة وغيرها، من أجل ضمان استقرار سورية، التي فقدت أكثر من 90 في المائة من اقتصادها، وتحتاج إلى مئات المليارات لإعادة الإعمار لا طاقة لروسيا وحلفائها على ضخّها. ومن الطبيعي أن تتطلّب هذه الاستحقاقات تنازلات سياسية دونها غوص روسيا في مستنقعٍ أفغاني جديد، وتكرار ما كانت حذرت منه واشنطن في تدخّلاتها في أفغانستان والعراق.
وفي بداية ثورات الربيع العربي، كشفت مواقف موسكو عدم تحمسها لأي حراكٍ جماهيري، ورأت أنها تأتي في سياق “الثورات الملونة” التي اجتاحت بلداناً في الاتحاد السوفييتي السابق. ومع وصول رياح التغيير سريعاً إلى سورية، لم تكن روسيا تملك استراتيجية واضحة للتعامل مع آخر حليفٍ لها في الشرق الأوسط، لكن مواقفها دعمت رؤية النظام في تفسير الحراك على أنه “مؤامرة كونية” لإسقاطه، مع دعوات شكلية للإصلاح السياسي وتلبية مطالب المتظاهرين السلميين. ودعمت روسيا نظام بشار الأسد سياسياً ودبلوماسياً، وزودته بالعتاد والأسلحة لمواصلة الحرب ضد “الإرهابيين والمندسّين”. والواضح أن صعود حركات الإسلام السياسي في بلدان عربية عدة كونها الطرف الوحيد المؤهل لملء الفراغ في السلطة لعوامل أورثها غياب الحياة السياسية لعقود من قبل الأنظمة الشمولية، أثار حفيظة روسيا ودفعها نحو التشدد. وغطّت موسكو تشددها بـ”متلازمة 1973″، وهو رقم القرار الدولي الذي سمح لحلف شمال الأطلسي والغرب بالتدخل في ليبيا. وقالت موسكو إنه تمّ خداعها لتوافق على القرار الذي استُخدم لاحقاً من أجل شنّ حملة على حليفها معمر القذافي. وبحجة منع التدخل الخارجي، ومحاولات إسقاط الأنظمة من الخارج، عطّلت موسكو عشرات القرارات الدولية، وأشهرت حق النقض (الفيتو)، مانعةً معاقبة النظام السوري، ما منحه غطاءً لاستمرار قمع وقتل السوريين. ومع رفضها كل العروض العربية من أجل إيجاد حلٍّ لحقن الدماء في سورية، مع ضمان مصالحها في حال خلع الأسد، بدا واضحاً أن موسكو تريد استخدام الورقة السورية حتى النهاية لخدمة أهداف جيواستراتيجية كبرى بهدف إعادة دورها العالمي.
وعلى الرغم من موقفها الثابت في دعم نظام الأسد، لم تتوقّف موسكو عن بحث الحلول مع جميع الأطراف الإقليمية والدولية، لكنها لجأت إلى تكتيكاتٍ تهدف لكسب الوقت من أجل إطالة عمر النظام، منها التوصل إلى توافقات دولية بعد نقاشات طويلة، ومن ثم محاولة فرض تأويلاتها الخاصة للاتفاقات. وحدث ذلك مع بيان “جنيف 1” في يونيو/ حزيران 2012، أو مع الوصول إلى صفقات تضمن عدم معاقبة النظام كما جرى في عام 2013 بإتمام صفقة الكيميائي مع الولايات المتحدة التي تضمّنت وقف أي ضربة لنظام الأسد مقابل تخليه عن ترسانته الكيميائية، في صفقة سحبت سلاح الجريمة ولم تعاقب المسؤولين عن قتل المئات بهذا السلاح في دوما، وسمحت للنظام بمواصلة إبادة كل من يشق عصا الطاعة، بالبراميل والصواريخ والقذائف.
وازدادت أهمية الورقة السورية لدى الكرملين بعد أحداث شرقي أوكرانيا وضمّ القرم والعقوبات الغربية على خلفيتها. وشكّل التدخل العسكري المباشر في سورية خريف عام 2015 سابقةً في تاريخ روسيا بعد السوفييتية. واللافت أن التدخل جاء بطلبٍ من إيران التي باتت عاجزة عن حماية النظام، ومباركة من بلدان الخليج العربي التي انطلقت من أن أجندات ومصالح روسيا غير الطائفية يمكن أن تمنع دمشق من السقوط نهائياً في فلك نفوذ الملالي.
وباستخدام أسلوب الأرض المحروقة، وكثير من التركيز على المعارضة غير الإسلاموية، وضرب أهداف محدودة لـ”جبهة النصرة” وتنظيم “داعش”، استطاعت موسكو وقف تقدّم المعارضة، وقلب المعادلات على الأرض لصالح النظام الذي كانت قد انحسرت مساحة سيطرته بحسب المسؤولين الروس عشية التدخّل العسكري إلى 17 في المائة من الأراضي السورية. وتعرضت الجهود الروسية لنكسةٍ كبيرة بعد إسقاط إحدى مقاتلاتها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 من قبل تركيا. وعلى الرغم من خلافات الطرفين التركي والروسي بشأن مصير الأسد ودعمهما طرفين متحاربين في الميدان، تجاوزت موسكو وأنقرة العداء التاريخي المستأصل بينهما منذ قرون، وبدأ البلدان بنسج علاقات لإدارة الأزمات وفصل الملفات. وتسبّبت حادثة إسقاط الـ”سوخوي 24” في 2015 بقطيعة بين “القيصر” و”السلطان” لم تدم طويلاً، لتعود العلاقات أقوى بعد موقف موسكو من الانقلاب الفاشل على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (يوليو/ تموز 2016)، وتراجع العلاقات بين أنقرة وكلٍّ من بروكسل وواشنطن.
ومثّلت السيطرة على حلب الشرقية في نهاية عام 2016 محطةً فاصلة في تاريخ الثورة السورية، وسارعت موسكو إلى السعي لاستغلال الاختلال في موازين القوى لصالح النظام، لإطلاق مشروعها للحل السياسي بعيداً عن جنيف وتفاهمات فيينا، والاعتماد على روافع إقليمية تساعدها في الحل وتشرعنه وتثبته. وقبلها رعت موسكو مئات الهدن والاتفاقات المحلية في جنوب دمشق، والقلمون وغيرها لتثبيت الأوضاع وعدم تشتيت قوة النظام والمليشيات المساندة له على الأرض. وفي بداية عام 2017، أطلق الروس مسار أستانة مع تركيا وإيران، وفيه عمدت موسكو إلى التوصل إلى حلول عسكرية للأوضاع، وابتكرت في مايو/ أيار من ذلك العام مناطق خفض التصعيد في غوطة دمشق والجنوب، وشمال حمص وإدلب. وفي 2018، بدأ النظام بمساعدة القوة الروسية المفرطة في إنهاء ثلاث من هذه المناطق واحدة بعد الأخرى، عبر مقايضات مع تركيا، ونيل موافقة إسرائيل في ما يخص الجنوب. ومع التراجع عن الهدن والسيطرة على هذه المناطق، انتشر النظام على نحو 60 في المائة من مساحة سورية، وضمنت روسيا الاستيلاء على “سورية المفيدة” بشرياً، ووجود دائم شرق المتوسط كخيار أدنى في حال الخلاف مع الجانب الأميركي الذي كان يسيطر عبر حلفائه الأكراد على قرابة 30 في المائة من الأراضي الغنية بالنفط والغاز والماء والتي تنتج المحاصيل الغذائية الاستراتيجية.
وفي الوقت ذاته، لعب الكرملين على عامل تفتيت المعارضة إلى منصات متنافرة (موسكو، القاهرة، الرياض) ودمجها في الهيئة العليا للتفاوض. ولم يقتصر جهد الروس على محاربة المعارضة، بل ذهب إلى ترتيب أوضاع تسمح لهم بنفوذ واسع في المؤسسات الأمنية للنظام وجيشه.
وبعد ميل الكفّة بشكل واضح إلى مصلحة النظام، دفعت موسكو بفكرة مؤتمر سوتشي للحوار السوري، رغبةً في احتكار الحلّ السياسي بعد تسوية الأمور العسكرية على الأرض مع الفصائل المعارضة باستثناء إدلب، واستباقاً لإعلان النصر على تنظيم “داعش”. وأبصر المؤتمر النور في نهاية يناير/ كانون الثاني 2018. وعلى الرغم من تأكيدها المستمر على التعاون مع المبعوثين الأمميين لحل الأزمة السورية، فإنها أفرغت كل مبادراتهم من فحواها، ولعبت على عامل الوقت والخوض في تفاصيل التفاصيل من أجل تقويض جهودهم، واستغرق موضوع اللجنة الدستورية وتشكيل وفد النظام والمعارضة أكثر من عام ونصف العام، على الرغم من ذهاب المبعوث الأممي السابق ستيفان دي ميستورا إلى تغيير أولوياته والتركيز على اللجنة الدستورية التي لم تظهر إلا بعد أشهر من تولّي خلفه غير بيدرسن.
ومن الواضح أن الكرملين حقّق خلال تدخّله في سورية اختراقات مهمة، من عودة موسكو بقوة إلى الملفات الدولية، إلى تحقيق أحلام الإمبراطورية بوجود دائم في المياه الدافئة، ووضع قدم لروسيا في شرق المتوسط لتكون لاعباً مهماً في مراكز إنتاج ونقل الطاقة إلى أوروبا بعد اكتشافات النفط والغاز الكبيرة، وغيرها من المكاسب الاقتصادية، وزيادة بيع الأسلحة بعد حقل الرماية السوري.
ومع دخول ثورة السوريين عامها العاشر، لا يبدو أن موسكو قادرةٌ على إعلان نصرٍ نهائي بعد إعلانات سابقة، فمواصلة استراتيجية القضم التدريجي للأراضي لفرض سيطرة النظام الكاملة على الجغرافيا السورية، ستؤدي إلى صدام مع تركيا والولايات المتحدة. كما أن حجم التناقضات بين تركيا وإيران من جهة، وإيران وإسرائيل من جهة أخرى، تتزايد، ما قد يبقي سورية ساحة حرب بالوكالة بينهما. واقتصادياً، يبدو الروس عاجزين عن الدفع بإعادة الإعمار مع سريان قانون قيصر الأميركي قريباً، وعدم تشجع الأطراف الإقليمية والدولية على ضخ أموال من دون استقرار سياسي. وتلعب الظروف الاقتصادية ضد قدرة الكرملين على الصمود طويلاً، في ظلّ الأزمة الاقتصادية العالمية الوشيكة بسبب “فيروس كورونا” واشتعال الحرب على الأسواق، والتي حرقت حتى الآن نحو 300 مليون دولار يومياً من دخل روسيا مع إمكانية زيادة الخسائر. وأخيراً فإن بوتين الذي استطاع “تصفير” فترات رئاسته الأربع السابقة، لن يكون قادراً على “تبييض” صفحة نظام قتل مئات الآلاف من السوريين، وأخفى قسرياً عشرات الآلاف منهم، وشرّد الملايين. وربما بات على الروس التفكير ملياً في تقديم تنازلات تضمن لهم جزءاً مما تحقق، وتمنع انزلاقهم في مستنقع “أفغاني” جديد، بعدما لعبت أفغانستان عاملاً كبيراً في كسر شوكة الاتحاد السوفييتي وانهياره.
————————————————
كاتب بريطاني: بدخول سوريا عامها العاشر من الحرب أصبحت يائسا تماما
دعا الطبيب ديفد نوت، الجراح البريطاني ورئيس مؤسسة ديفد الخيرية الطبية، إلى إنشاء كيان بديل للأمم المتحدة وفريق طوارئ دولي للتفاوض لحل الأزمة الإنسانية في سوريا ووضع حد لمعاناة المدنيين المحاصرين في إدلب يتكون من قادة دول سابقين.
وقال نوت في مقال بصحيفة تلغراف بعنوان “مع دخول سوريا عامها العاشر من الحرب أصبحت يائسا تماما”، إن فريق الطوارئ المقترح من شأنه العمل نيابة عن المدنيين الفقراء الذين لا صوت لهم ويشعرون بأن العالم قد تخلى عنهم.
وأضاف أن قادة الدول السابقين يملكون من القوة والنفوذ وتأنيب الضمير ما يمكنهم من العمل من أجل التغيير دبلوماسيا وسياسيا، واختراق البيروقراطية للقاء الأطراف المتحاربة وحملها على التعقل.
وأشار نوت، الذي زار سوريا مرات عديدة خلال السنوات الأخيرة لعلاج ضحايا الحرب وأشرف على تدريب الجراحين هناك، إلى أنه على اتصال دائم مع 15 طبيبا ما زالوا يعملون في إدلب حيث يناقش معهم الحالات التي يعالجونها ويستشيرونه بشأنها.
وقال إن الأطباء في إدلب باتوا يفتقرون إلى المعدات والموارد اللازمة لعلاج المرضى، وإن تواصلهم معه للأخذ برأيه قد قل خلال الأسابيع الأخيرة بسبب هذا النقص، فبعد أشهر من القصف لم يعد لديهم الوقت أو المساحة أو الطاقة الكافية للتعامل مع الحالات.
وأشار إلى أن الرسائل التي تصل إليه من داخل إدلب، آخر معقل للمعارضة السورية، تكشف عن تدهور الوضع الإنساني في المدينة، حيث تكشف تلك الرسائل في معظم الأيام من طبيب جراح في إدلب كان قد دربه وعمل معه يدعى أبو وسيم، عن أن الطريق الرئيسي في المدينة أصبح مزدحما بالنازحين الذين فروا من القصف، ولم يعد بوسعهم العودة لمنازلهم التي دمرتها قوات النظام السوري والقوات الإيرانية المساندة لها.
وقال إن أبو وسيم شاهد الناس يلجؤون إلى الاختباء من برد الشتاء تحت الشاحنات المتوقفة على الطريق العام، كما شاهد الأطفال الحفاة يموتون في الشوارع بسبب انخفاض درجة حرارة أجسادهم.
المصدر : ديلي تلغراف
————————————
من التغيير إلى النزوح.. أحلام تتبدد في ذكرى الثورة السورية/ منتصر أبو نبوت
قبل تسع سنوات كان المواطن السوري سامر أبو محمد ضمن جمع من المتظاهرين احتشدوا عند أبواب مسجد الزاوية في مدينة سراقب بريف إدلب، مرددين هتافات تطالب بالحرية، لكنه اليوم يقيم مع عائلة في خيمة النزوح على الحدود التركية دون أفق لنهاية ثورة الشعب السوري.
يعود سامر بذاكرته للمشهد الأول للثورة في سراقب قائلا، “جالت المظاهرة شوارع المدينة، وسط دهشة الجميع، فالأمر لم يكن سهلا، فهذا الحراك الأول في مدينتهم بعد عقود طويلة من حكم حزب البعث للبلاد، وكنا نحلم بمستقبل مشرق لسوريا حضارية تحترم حقوق الجميع”.
لم يرد ببال سامر حينئذ أن مصيره كمصير الآلاف سيكون أحد مخيمات النزوح بريف إدلب قرب الحدود مع تركيا، يجلس فيه منتظرا فرجا يغير حياتهم إلى الأفضل، بعد أن بات همهم الأول تأمين احتياجاتهم الأساسية، وتوقف القصف الجوي على مدينته سراقب.
بحزن وألم شديدين على ما وصلت إليه الحال في سوريا، يتحدث سامر للجزيرة نت عن حلم العودة ليس فقط بالنسبة له، فقد أصبح له جيران غير الذين كانوا في مدينته، هم جيران الخيام والمخيم ينحدرون من مدن وبلدات مختلفة من محافظة إدلب وخارجها.
جميع هؤلاء النازحين -حسب سامرـ لا يطيقون حياة الخيام، وجميعهم شاركوا في الثورة لأهداف تتعلق بالكرامة. وهنا يشير إلى أن “النظام نجح في تحويل تفكيرهم وثورتهم إلى قضية إنسانية بسبب الصمت العالمي على المجازر التي يرتكبها بشكل متكرر”.
ويضيف أن إحدى تلك اللحظات التي شعر فيها باليأس عندما أسعف أطفالا بعد قصف سراقب بغاز الكلور السام، فقد تيقن وقتها أن “الأمور تذهب في طريق لا رجعة فيه”.
لجوء
خارج حدود الوطن وفي مدينة غازي عنتاب جنوبي تركيا استقر الحال بالحلبي عمر محمد حبو، الذي خرج بعد سيطرة جيش النظام على أحياء المدينة الشرقية عام 2016.
يقول حبو للجزيرة نت، “إن الأرض ضاقت بأهلها، وذلك ما دفعه إلى الخروج من سوريا خصوصا أن منزله في الأحياء التي سيطر عليها النظام قد أُحرق من قبل شبيحة النظام”.
لكنه لا ينسى أيضا خروجه في لحظات حرجة ومفصلية مرت بها سوريا، يتحدث للجزيرة نت عن مظاهرات عام 2011 في مدينة حلب، حيث كانت يد النظام أشد قبضة فيها لأنها عاصمة البلاد الاقتصادية.
لم يفكر حبو للحظة، ذلك الوقت، أنه سيضطر للخروج بعائلته إلى دولة أخرى، فقد كانت أهدافه تتركز على رفع الظلم الذي يمارسه النظام ضد الشعب السوري.
ويردف أن هذه الأهداف ثابتة في وجدانه، إلا أن تخاذل العالم حوّل نظرته كرب أسرة إلى مشاكل أخرى، فما يحدث في البلاد ينعكس مباشرة على العوائل، وهذا ربما ما يدفعه لمحاولات الاستقرار والحصول على جنسية في بلد مثل تركيا، في ظل تخاذل كبير لقيه الشعب السوري، دون أن يخفي رغبته بعودة قريبة إلى البلاد إن عادت لأهلها.
المصدر : الجزيرة
———————————-
الجحيم المستمر: وفي آذار سوريا التاسع حلّ كورونا/ يوسف بزي
بلاء البشرية بوباء كورونا، أتى حدثاً منفرداً على دول ومجتمعات “طبيعية”. بدأ فيها حالة ناشزة في سيرتها اليومية، ونافرة فوق مشاكلها وهمومها وهواجسها السياسية أو الاقتصادية والاجتماعية. خطر استثنائي غير معتاد في سياق المخاطر التي تكيفت معها: حوادث السير، جرائم القتل الفردية، انهيار ثلجي، سقوط طائرة، غرق سفينة، انهيار مبنى على سكانه، حريق غابات، إعصار عنيف، أو حتى وقوع زلزال..
هناك، في المجتمعات “الطبيعية” ثمة معايشة متوازنة مع حقيقة الموت. بل ثمة غلبة للحياة بكل متاعبها وصخبها وقلقها. هناك ثمة “غد أفضل” مأمول، وربما في متناول اليد. ويحدث أن نرى منسوباً معقولاً من الوئام الاجتماعي، من حضور للحب، وللتسامح والتعاطف. منسوب من الطمأنينة السياسية، إذا صح التعبير. وبالتأكيد هي موصوفة كمجتمعات “طبيعية” لتوافر الكرامة لمواطنيها وحقوق إنسانية أساسية غير معرضة للانتهاك، مصانة دستوراً وأعرافاً وقيماً أخلاقية. بعبارة أخرى هي بلاد “مستقرة”.
فوق كل هذا، مغالبة الحدث الطارئ أو مواجهة الكوارث العارضة، وإدارة الأزمات، إنما هي “فرصة” تُمتحن فيها جدارة الدولة وأجهزتها كما جدارة النظام السياسي والاجتماعي وقيمه ومعتقداته وسلوكه العام.
أما نحن، أهل البلاد المنكوبة والمجتمعات المريضة والدول الفاشلة، فبلاؤنا بوباء كورونا جاء تتويجاً لكوارث متلاحقة ومترافقة مع بعضها البعض، على مثال العقاب التوراتي. فاجتماع الحقارة السياسية
والفساد الاقتصادي والاضطرابات والحروب والانهيار الأخلاقي عدا انحطاط الدولة ومؤسساتها، مع جائحة مثل “كورونا”.. ليحيلنا كل هذا إلى كابوس يُضاف فوق كوابيسنا، ويرخّص حياتنا فوق رخصها الأول، ويحطمنا فوق حطامنا السابق، في مشهد قيامي (أبوكاليبسي) أشبه بأزمان الطواعين وأهوالها.
وعلى نحو عياني لما نحن فيه، سنجد مئات الآلاف من اللاجئين محشورين ومتكدسين في مخيمات بائسة، تفتقر إلى الحد الأدنى من الشروط الصحية. وتنعدم فيها القدرة على الحماية الشخصية أو الخصوصية الفردية. وتفتقر إلى مقومات النظافة العامة والبيئة الملائمة للعيش الكريم، وللأمن الغذائي وللطبابة والعناية. تتسم بالفقر المدقع والحاجة الدائمة للوقاية من المرض. هؤلاء نُكبوا بالتهجير وبضياع أرزاقهم وأموالهم ومواردهم، ومعظمهم فقدوا أفراداً من عائلاتهم أو حتى معيلهم وراعيهم، فكثر أيتامهم وأراملهم وتفاقم عجزهم وعوزهم. وقبل هذا، خسروا بلادهم وذاقوا الذل والهوان وانتهكت كرامتهم.. مشردين بائسين في بلدهم وفي منفاهم. هؤلاء الذين تعرضوا للاضطهاد السياسي، الجسدي والمعنوي، ولأهوال الحرب وصدماتها، وحُشروا في الفقر وسوء التغذية، وأُخرجوا من أرضهم، وتكاثرت بينهم الأمراض وانهالت عليهم مصائب لا تُحصى، إلى حد الاختناق باليأس.. يقفون اليوم عراة بلا حماية أمام جائحة كورونا.
وإذ نرى العالم كله يواجه فيروساً لئيماً، كحدث استثنائي وطارئ يجمع البشرية في مصابها، على صورة استنفار أنظمة الاستشفاء، وإجراءات التعقيم وحظر التجول أو التجمع، وإقفال الفضاءات العامة، والإجراءات في المطارات ووسائل النقل، واستنفار الأطقم الطبية، وتقارير أعداد الإصابات والوفيات اليومية، والحملات الإعلامية والميدانية.. فهناك أيضاً صورة أخرى خاصة بنا، في مخيمات اللاجئين وخارجها: صورةُ مضاعفةِ الجحيم والرعب والموت.
هناك في العالم سبب واحد وموت واحد. وهنا عندنا أسباب كثيرة وموت أكثر.
أن نُبتلى بمجرم كبشار الأسد، بجيش البراميل المتفجرة والصواريخ الكيماوية والمجازر وقصف المستشفيات واغتيال الأطقم الطبية، بعصابات مخابرات التعذيب والتنكيل والإعدامات الجماعية والاغتصاب والتوحش السادي. أن نُبتلى باحتلالات ميليشيات مذهبية تستبيح البشر والحجر والزرع. أن نُبتلى باحتلالات جيوش القسوة الأجنبية والقتل اليومي والمهانة الوطنية. أن نبتلى بجماعات التكفير والذبح والتعصب القاتل.. أن نُبتلى بغياب الرحمة والعطف وانعدام الوئام الاجتماعي وبعداء “الدولة” لمواطنيها.. أن نُبتلى بفقدان البيت والأمان وفقدان الأحبة والأصدقاء.. أن نبتلى بالفقر المدقع وضياع المستقبل وتبدد الأمل، إلى حد فقدان الرغبة بالحياة. وفوق كل هذا مصائب لا تُحصى، فردية وجماعية، في هذه الحروب المتناسلة منذ تسع سنوات.. ثم يأتي “امتحان” بلاء كورونا!
هذا هو جحيمنا الخاص، جحيم سوريا. وهذا ما يخرجنا عن العالم السوي ومشهده المريض اليوم.
على هذا النحو يستمر الاستثناء السوري، لعنة ونكبة مستمرتان، عقاباً يمارسه نظام آل الأسد تحطيماً وقتلاً بلا رحمة لتلك الـ”سوريا” التي أرادت ذات آذار أن تلاقي المستقبل، أن تفتح باباً للحرية وللكرامة، أن تبدأ السير نحو دولة لمواطنيها، نحو مجتمع موفور الكرامة والأمان والرعاية، مجتمع حكم القانون ومبدأ المساواة.
كان الحلم أن تصير سوريا، ببساطة، دولة “طبيعية”، تغلب عليها معاني “الحياة” بمتاعبها وصخبها وقلقها ومرحها ودموعها وضحكاتها، وتشعر أنها جزء من العالم، وتشاطره حتى المشاهد الأليمة أو القصص البطولية والإنسانية في مواجهة وباء كورونا أو غيره من الكوارث التي لا راد لها.
ما حُرم منه السوريون طوال عقود، وعوقبوا عليه منذ تسع سنوات، منذ التظاهرة الأولى والهتاف الأول، هو أن يكونوا “مواطنين” تقف همومهم عند مساءلة الحكومة في تقصيرها أو تقاعسها بحمايتهم من مرض أو أزمة. أن يبدو “كورونا” منغصاً لعيشهم واستقرارهم، وحدثاً طارئاً على عاديات يومياتهم ومخالفاً لنمط عيشهم، لا أن يأتي وكأنه شقاء إضافي.. نزولاً أكثر في طبقات جحيمهم.
في ذكرى ذاك الربيع المغدور، ومع كل الألم المخزون في نفوسنا، ليس للسوريين سوى مشاطرة العالم مآسيه وإبداء التعاطف صوناً لإنسانيتنا، لمعنى ثورتنا، عسى أن يبادلنا هذا العالم – في لحظة وعيه بوحدة المصير البشري – خيراً وعطفاً وخلاصاً من بلائنا.
تلفزيون سوريا
——————————
9 سنوات من الحرب… هل نجا نظام الأسد من السقوط؟: المصير لا يزال عالقاً على التطورات السياسية المقبلة ومستقبل المسار التفاوضي لبدء الإعمار/ أحمد عبد الحكيم
بعد أن وصلت سيطرته على ما دون الـ20 في المئة من مساحة الأراضي السورية في العام 2015، واقتربت فصائل من المعارضة المسلحة من تهديد العاصمة دمشق، تدخل الحرب المدمرة في سوريا عامها العاشر، بوقائع مغايرة على المستويين العسكري والسياسي، لتعيد معها أسئلة “المستقبل والمصير” لتلك الهتافات الديمقراطية الأولى التي صدحت انطلاقاً من درعا (جنوب) منتصف مارس (آذار) 2011، مطالبةً بإصلاحات في بلد تحكمه أسرة الأسد منذ عقود بقبضة من حديد.
وفي وقت باشرت روسيا وتركيا الأحد تسيير أول دورية مشتركة في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا حيث يخيم وقف هش لإطلاق النار بعد أسابيع من أعمال العنف، انطلقت آليات مدرعة وعناصر من الشرطة العسكرية الروسية من قرية ترنبة لتسلك الطريق الدولي “إم فور” بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه الجمعة، على ما أوضحت وكالات تاس وإنترفاكس وريا نوفوستي الروسية.
فكيف تغيّرت الأوضاع؟ وهل باتت تقترب أكثر لصالح القوات الحكومية ما يعزز من اعتباره “نجاة سياسية” للرئيس السوري بشار الأسد من السقوط مثل أقرانه في عدد من الدول العربية الذين سبقوه؟ أم لا يزال “صراع السياسة” طويلاً لحسم الحرب؟
تتباين آراء المراقبين والمتخصصين، وإن أجمعوا على أن غمار الحرب تسبب في أكبر مأساة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية، وفق توصيف الأمم المتحدة، إذ سقط أكثر من 380 ألف قتيل، ونزح وشرد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها، فضلاً عن تعرض مناطق كاملة للدمار.
وتشهد سوريا منذ منتصف مارس (آذار) 2011 نزاعاً دامياً، بدأ باحتجاجات شعبية سلمية ضد النظام مطالبة بالديمقراطية والحريات، سرعان ما قوبلت بقمع مارسته أجهزة النظام، قبل أن تتحوّل إلى حرب مدمرة تشارك فيها أطراف عدة.
هل نجا الأسد من السقوط؟
حسب عدد من المراقبين والمتخصصين، الذين تحدثت إليهم “اندبندنت عربية”، تباينت الآراء حول تقييم مستقبل نظام الرئيس السوري بشار الأسد بعد 9 سنوات من الحرب المدمرة في البلد، إذ يرى البعض أن مصير الرئيس لا يزال عالقاً على التطورات السياسية المقبلة، ومستقبل المسار التفاوضي “الضروري” لبدء مرحلة إعادة الإعمار، فضلاً عن ارتهانه إلى طبيعة التوافق أو الاختلاف بين أقرب حلفائه (الروس والإيرانيون).
ويرى آخرون أن استعادة القوات الحكومية نحو 70 في المئة من الأراضي في العام 2020 تمهّد لبسط كامل لسيطرته على الأرض بفضل دعم حلفائه وفشل فصائل المعارضة في تقديم بديل سياسي كامل وواضح منذ السنوات الأولى من عمر “الثورة”، ما يعني “النجاة من فخ السقوط”.
وحسب قاسم الخطيب، عضو لجنة مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية، والقيادي في الائتلاف السوري، “لا يمكن أن ينتصر حاكم على شعب”، مضيفاً “حتى مع السيطرة على الأرض واستعادة مساحات واسعة تمكّنت فصائل المعارضة في سنوات سابقة من السيطرة عليها، إلا أن ما فعله نظام بشار الأسد في سوريا لا يمكن أن ينساه الشعب الذي خرج سلمياً مطالباً بإصلاحات وحريات، سرعان ما ردّ عليه النظام بالقمع الدموي”.
ويقول الخطيب، “لا تزال الأوضاع قابلة للانفجار السياسي في أي وقت بكل الأحياء التي يسيطر عليها النظام السوري وحلفاؤه، فالمطالب برحيل النظام باقية، والعمل متواصل لإنشاد سوريا جديدة ما بعد أسرة الأسد”.
ويضيف، “من يتمعّن المشهدين السياسي والأمني في سوريا اليوم يرى أنهما مرهونان بيد الخارج، وحكومة الأسد باتت بالكامل مرهونة لمصالح الروس والإيرانيين، وهو ما يعني تزايد احتمالات التصادم وتضارب المصالح قريباً”.
ومنذ سبتمبر (أيلول) 2015، انضمت روسيا رسمياً إلى الحرب الدائرة في سوريا لدعم قوات الأسد، وتمكّنت عبر نشرها لمقاتلات وقوات على الأرض، فضلاً عن الدعم العسكري الواسع، بمساعدة إيران من تغيير معادلة الصراع على الأرض ومساره ضد مقاتلي المعارضة.
في الاتجاه ذاته، يرى فراس الخالدي، عضو هيئة التفاوض السورية وعضو لجنة صياغة الدستور، أن “فكرة نجاة الأسد بصورة كاملة بعد مرور 9 سنوات على الحرب مستبعدة”، معتبراً أن مصير الرئيس السوري متوقف على “ضرورة المضي في المسار السياسي التفاوضي مع الأطراف السورية من أجل بدء مسار إعادة الإعمار”.
وحسب الخالدي، أيضاً، “فالأحداث السورية بدأت بمطالب سياسية في الإصلاح والديمقراطية ولا تزال باقية، ولم يتحقق منها شيء. إطالة أمد الصراع والنصر الزائف بالسيطرة على الأرض لا يعنيان انتهاء المطالب السياسية”، معتبراً أن “تحقيق سلام جاد وحقيقي على الأرض يتطلب المُضي في المسار السياسي التفاوضي، وهو ما يجعل عملية إعادة الإعمار مرهونة ببدئه”.
وأحدث النزاع منذ اندلاعه دماراً هائلاً، قدرت الأمم المتحدة في وقت سابق تكلفته بنحو 400 مليار دولار، بينما تشير تقديرات البنك الدولي في عام 2016 إلى أن تكلفة إعمار سوريا تصل 780 مليار دولار، إذا استمرّ الصراع حتى عام 2021، معتبرة أن عملية إعادة بناء البلاد ربما تستغرق أكثر من 50 عاماً، في حال توفّرت عدة شروط من بينها انعدام الفساد.
ووفق الخالدي، فإنّ “مصالح الحلفاء الرئيسين لنظام الأسد متضاربة ومرشحة إلى الصدام”، في إشارة إلى الروس والإيرانيين، مضيفاً، “يوجد إجماع وتوافق دولي وأممي على ضرورة المضي قدماً في المسار السياسي شرطاً لإعادة الإعمار، وهو ما يمثل امتحاناً لجميع الأطراف”.
في المقابل يقول فبريس بلانش، متخصص الشؤون السورية وأستاذ في جامعة “ليون الثانية”، إن “بشار الأسد فاز بالحرب”، معتبراً أن “عام 2012 كان عاماً حاسماً بالنسبة إلى سوريا، بمعنى أن المعارضة المسلحة لم تتمكن من بناء جيش قوي ومتماسك، ولا مشروع سياسي جدي للسوريين. في حين أنّ القوات الموالية بشار الأسد بقيت متماسكة إلى حد بعيد، وفارضة سيطرتها على المدن الكبرى، والمناطق المهمة والحيوية بالنسبة إلى النظام”.
وحسب بلانش، فإنّ “وتيرة الأحداث تسارعت بعد أن استعاد النظام مدينة حلب في 2016، وباتت تقود كل المؤشرات إلى أنّ القوات الحكومية ستستعيد تدريجياً السيطرة على غالبية المناطق المهمة في سوريا”، مشيراً إلى “محورية الدورين الروسي والإيراني في قلب موازين الصراع لصالح القوات الحكومية”.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2016، تمكّنت قوات الأسد وحلفاؤها من هزيمة فصائل المعارضة بأكبر معقل حضري لهم في حلب بعد أشهر من الحصار والقصف، في تأكيد الزخم الذي اكتسبه الأسد.
واستمر زحف القوات الحكومية على مناطق سيطرة المعارضة تدريجياً، لتتمكّن في أبريل (نيسان) 2018، بعد أشهر من الحصار والغارات الجوية من استعادة الغوطة الشرقية، ثم تلتها في يونيو (حزيران) من العام ذاته، من السيطرة على معقل المعارضة الجنوبي في درعا، ما مثّل “انتكاسة” لفصائل المعارضة.
ماذا عن المرحلة المقبلة؟
في غضون ذلك، ووفق لينا الخطيب، مديرة مركز كارنيغي في بيروت، فإنه “ومع اعتبار حتى اللحظة، أن نظام بشار الأسد صمد نحو تسع سنوات في الحرب الأهلية. إلا أنّ السؤال بالنسبة إلى أولئك الذين استثمروا في المستقبل السوري لم يعد عمّا إذا كان النظام سينجو من عدمه، إنما عن كيفية سعيه لتثبيت أركان قوته قبيل إنهاء الحرب التي تجتاح البلاد”.
وحسب الخطيب في مقال لها، بمجلة “فورين أفيرز”، “قد يكون الأسد دخل المعركة معتقداً أنّ النظام سيستطيع الاحتفاظ بالسلطة التي تمتّع بها قبل عام 2011، لكن لكي يثبت الأسد للعالم بأنه لا يزال يُمسك بزمام السلطة، وأن علاقات نظامه جاهزة للتطبيع، فلا شكّ أنه سيسعى لاستعادة الأراضي السورية كلها”، معتبرة أنه “بهدف الحفاظ على تماسكه الداخلي لن يلتفت نظام الأسد إلى حاجات الشعب السوري، فطموحه منصب على النجاة المحضة التي يمكن أن يكفلها الحفاظ على شبكة موالاة باتت شريان الحياة للنظام على مدار الصراع”.
ويذكر الخطيب، “نجح الأسد في هدفه المتمثّل في استعادة السيطرة على الأراضي السورية، لكنّ المشكلة الرئيسة هي الشمال، حيث يسيطر الإسلاميون على الشمال الغربي مقاومين تقدّم الأسد. أمّا الشمال الشرقي فيقع تحت هيمنة أكراد (قوات سوريا الديمقراطية) التي دحرت تنظيم داعش خارج المنطقة عام 2018، وأسست نوعاً من الحكم الذاتي بدعم من القوات الأميركية”.
وبعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحاب قوات بلاده من سوريا، عقدت قوات سوريا الديمقراطية في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، اتفاقاً مع الحكومة السورية يتيح لقوات النظام دخول مناطق الشمال الشرقي، ومواجهة الهجوم التركي. واليوم، تدير القوات الكردية المنطقة في ظل وجود الجيش السوري.
صراع مستمر والمأساة باقية
ورغم تباين آراء المتخصصين في شأن مستقبل الحرب المدمرة في سوريا مع بداية عامها العاشر، فإنهم يجمعون على تلك المأساة الإنسانية التي خلّفتها، واعتبرتها الأمم المتحدة أكبر المآسي الإنسانية في العصر الحديث منذ الحرب العالمية الثانية.
وحسب آخر إحصائية للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فتسبّبت تسع سنوات من الحرب الدامية والمدمرة بسوريا في مقتل 384 ألف شخص على الأقل، بينهم أكثر من 116 ألف مدني (بينهم أكثر من 22 ألف طفل، و13 ألف امرأة).
وأحصى المرصد السوري الذي يعتمد منذ بدء النزاع على شبكة واسعة من المراسلين والمصادر في مختلف المناطق، مصرع أكثر من 129 ألف عنصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، أكثر من نصفهم من الجنود السوريين، وبينهم 1697 عنصراً من حزب الله اللبناني الذي يقاتل بشكل علني إلى جانب دمشق منذ العام 2013.
كما تسبب النزاع في سوريا بأكبر موجة نزوح منذ الحرب العالمية الثانية، واضطر أكثر من نصف سكان سوريا ما قبل الحرب إلى النزوح داخل سوريا أو اللجوء إلى خارج البلاد.
ويرتفع عدد اللاجئين حسب أرقام الأمم المتحدة إلى 5,5 مليون نسمة، بينما تخطّى عدد النازحين ستة ملايين نسمة، وفق أرقام فبراير (شباط) 2020.
ووفق الأمم المتحدة أيضاً، بات 83 في المئة من السكان يعيشون اليوم تحت عتبة الفقر، مقابل 28 في المئة قبل الحرب، بينما يجد نحو 80 في المئة من العائلات صعوبة في تأمين حاجاتها الغذائية الأساسية، حسب برنامج الأغذية العالمي.
وتواجه البلاد حالياً نقصاً في المحروقات، كما تشهد أزمة اقتصادية خانقة، وقدرت السلطات السورية خسائر قطاع النفط والغاز منذ 2011 بـ74 مليار دولار، الذي يعد أحد أبرز مصادر الدخل في البلاد.
———————————-
انتفاضة السوريين في عامها التاسع… فوضى أم حرية؟ “سيطرة النظام على الأرض لا تعني شيئاً… لأن الحرب كرّ وفرّ”/ رولا اليوسف
يعيد منتصف مارس (آذار) في كل عام إلى ذاكرة السوريين، يوم اندلعت فيه أوسع انتفاضة شعبية عرفتها بلادهم، بدأت شراراتها من جنوب سوريا في عام 2011 واتسعت لتعمّ أرجاء البلاد، يوم لا ينساه السوريون من معارضين ومؤيدين على حد سواء كونه غيّر وجه وطنهم.
نشبت على خلفيته أوسع التظاهرات في حراك سلمي، من دون أن تنكفئ، وتحولت الساحات العامة من دمشق العاصمة إلى ساحات صراع بين المتظاهرين وسلطة سعت جاهدة نحو تقويضها بكل الطرق حتى السلمية منها عبر مسيرات مؤيدة لها.
دمشق الياسمين
15 مارس من عام 2011 تاريخ محفور أكثر في ذاكرة معارضين للحكومة السورية وكأنه الأمس، عقب حقبة من حكم حزب “البعث” امتدت منذ ثورة جاءت به في الثامن من مارس عام 1963 أنهت بموجبه حكم الانفصاليين، وما زال يحكم حتى الآن.
من “الحميدية”، أشهر أسواق دمشق القديمة، وسط العاصمة، جنوب البلاد، تقاطر السوريون تلبية لدعوات “فيسبوكية” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محتشدين بعد صلاة الجمعة في الجامع الأموي ومطلقين نداءات “الحرية وتغيير النظام”.
ويستذكر الشاب منير ديبو، أحد أفراد الحراك السلمي حينها “سار المتظاهرون بمنطقة الحريقة، لم تهدأ حناجرهم عن ترديد شعارات الحرية وبس، كان الاندفاع والحماسة يغلبان على كل من شارك، كنا كثراً، نقدّر بعشرات الآلاف”، ولم يتوقع منير يومها أن تمتد تظاهراتهم بهذا الشكل الواسع، ويتسع معها حراكهم السلمي في مدن وبلدات، وانضمت إليها النخب المثقفة من أدباء وفنانين وسياسيين.
بين الداخل والخارج
لكن ما رمزية هذا اليوم ومدلولاته على الرغم من وضوح الاتجاهات، إذ يوحي بانقسام شديد ما يفتأ يتسع، حتى بعد جلوس المعارضة على طاولات المفاوضات السياسية.
إزاء ذلك، يبدو أن الشارع السوري رسم لنفسه ملامح جديدة، بعد اتساع الانقسام وتغلغله واصلاً إلى أفراد البيت الواحد، يقول أحدهم “بين الإخوة أنفسهم، بتنا نشاهد المؤيد والمعارض، وهناك قصة وقعت بين شاب يحارب في صفوف المعارضة، التقى وجهاً لوجه بشقيقه المجند في الجيش النظامي في إحدى المعارك”.
منذ ذلك التاريخ وإلى الآن، لا مكان لمن يوصفون “بالرماديين”، وهم الأشخاص الذين لا يميلون إلى أي طرف سياسي “إما أن تكون معنا أو ضدنا”، هكذا يحكي العمّ “أبو رامي” من سكان دمشق متذمراً من الحالة التي وصلت إليه بلاده، متابعاً “عن أي انتصار أو هزيمة نتحدث، المعركة لم تنته بعد، وهي طويلة، هل من المعقول أن ينتصر السوري على السوري، صرخاتنا أن توقِفوا القتال لن تجدي نفعاً”.
استقطاب متناه
بلا شك، تمكنت الانتفاضة الشعبية مع بداية انطلاقتها من زيادة رصيدها من مئات الآلاف إلى ملايين السوريين، في حين لا يوجد إحصاء دقيق لعدد المعارضين، وما يعزو سبب انتفاضة مارس 2011، تصرفات أمنية في محافظة درعا الجنوبية، المجاورة للعاصمة، على إثر توقيف أطفال، تلاميذ مدرسة، وتعذيبهم على خلفية كتابتهم شعارات مناوئة للسلطة في أول شهر مارس نفسه، إلا أن الحراك الشعبي في دول الربيع العربي شجعهم.
وأثارت تلك الحادثة أجواء محتقنه ضد ما قابلته إجراءات النظام باللامبالية، وبعد الضغط الشعبي، أوفدت الحكومة في ذلك الوقت وفداً لدراسة الحادثة، واكتفت من دون محاسبة الفاعلين من أصحاب القبضات الأمنية النافدة في الدولة.
ردود صاخبة
تلت كل هذا، دعوات نحو التجمّهر بيوم “غضب سوري”، وساعدت جرأة الناس في حينها النزول إلى الشارع، ومراقبتهم نجاح ثورات اندلعت في دول مثل تونس ومصر وبقية دول وصل إليها ما سمي بالـ “الربيع العربي”. ومقابل كل ذلك، واجهت دمشق هذه التظاهرات بتحركات مضادة تحت مسمى “مسيرات” محركة إحدى أهم أذرع السلطة السورية، وهي كوادر حزب “البعث” مستفيدة من سطوة الحزب الحاكم على المؤسسات كافة للزّج بكوادره إلى الشارع، وإعطاء صورة مغايرة للأحداث المعارضة.
مترافقة مع تسيير ما يسمى “شبيحة” أو “بلطجية” لفض هذه التظاهرات بالهراوات والعصي، ذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن الكثيرين ممن وصفتهم بـ “المندسين”، يستغلون تلك التحركات الشعبية بالشارع لإطلاق الأعيرة النارية وخلق الفتن، متهمة جهات خارجية داعمة من دون أن تشير إليها بالاسم.
الصفحة المأساوية
اللجوء إلى السلاح، كان أكثر المراحل خطورة، وأكثر صفحات الحراك السلمي مأساوية، وسوداوية، لكن، وبحسب ما أكده معارضون، ومنهم نضال العمّ المقيم خارج سوريا في ألمانيا بحزن، ويرى العمّ “أن الثورة السلمية أُجهضت بعد أن تسلحت، يا ريت بقينا من دون تسليح، نخرج بصدورنا العارية، لقد دفعنا ثمناً باهظاً، هو التهجير القسري، بنزوح ما لا يقل عن ستة ملايين سوري إلى بلاد العالم”.
مقابل ذلك، يخالف هذا الرأي ممن يوصفون بـ “صقور” المعارضة التي تلفت النظر إلى أن كل هذا الحراك السلمي لن يفضي إلى نتيجة تفيد انتفاضة شعب ضد الظلم والفساد وتغيير السلطة”. واستمرت “تنسيقيات الثورة” بتظاهرات يومية خدمهم في ذلك التطور التقني ووسائل التواصل الاجتماعي.
حمام الدم
النزاع بلغ أوجَه منذ عام 2013 مع اشتداد أعنف المعارك العسكرية بين المعارضة التي نظمت صفوفها، واشتد عودها، ومع قوات الجيش النظامي، وعلى إثرها قُسمت سوريا إلى مناطق نفوذ استحوذت المعارضة على أكثرها.
حمام الدم الذي اغتسل به السوريون واكتووا بنار حرب ضروس ما زالت تداعياته ماثلة أمامهم، منها مصرع حوالى 380 ألف شخص، منهم 115 ألف مدني بينهم حوالى 22 ألف طفل، وأكثر من 13 ألف امرأة، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن، ومضيفاً أن عدد المعتقلين والمخطوفين حوالى 88 ألف شخص.
وما زالت عمليات الفرز بين المواطنين وقوى النزاع مستمرة بحسب ولاءاتهم، وامتحان الوطنية مستمر بين كلا الطرفين بين “مؤيد” و”معارض”، وكل منهما يرمي تهم تدمير البلاد صوب الآخر، وحال البلاد ما زالت تدور في حلقة مفرغة، تعيش أصعب الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
الانتصار والهزيمة
ومع كل التطورات الأخيرة، خصوصاً في معارك الشمال، يثمّن مراقبون معارضون ما أظهرته تركيا من دعم حقيقي للجيش الوطني الحرّ بمدهم بمضادات طيران تحميهم من القصف المستمر، مع تقدم وسيطرة دمشق منذ إطلاق حملتها العسكرية في مايو (أيار) العام المنصرم حملة عسكرية باتجاه إدلب، غيرت فيها خريطة الصراع لصالح الجيش السوري.
من جانبه، يرى عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني ياسر فرحان لـ “اندبندنت عربية”، أن الثورة مستمرة بنهجها، والسيطرة على الجغرافيا من قبل السلطة لا قيمة لها لأن إرادة الصمود ستفرض نفسها بالنتائج النهائية، وقال في تعليقه على ما يجري شمالاً “إن سيطرة النظام على الأرض لا تعني شيئاً لأن الحرب كرّ وفر، وأكثر من نصف عدد السكان مهجر والأهالي سيعودون يوماً ما إلى مناطقهم”.
—————————————–
الأزمة السورية… بين واقعية المجتمع الدولي وأخطاء المعارضة الاستراتيجية: عسكرة الانتفاضة لم تمنح المتظاهرين الحماية المطلوبة وأعطت النظام ذريعة شيطنة الحراك/ حسن فحص
لم يكن تقدير الموقف الذي عرضه الموظف في الخارجية الأميركية بداية الانتفاضة السورية في أبريل (نيسان) عام 2011 بعيداً عن الواقع، عندما أكد أن الإدارة الأميركية تواجه أزمة على الساحة السورية.
فهي من ناحية ترغب وتريد إحداث تغيير في سلوك النظام السوري، وإبعاده عن التأثير الإيراني ومحوره بالمنطقة، وعليه فهي تدعم الحراك السوري “السلمي” الذي بدأت تشهده بعض المدن.
أزمة الإدارة الأميركية
ومن ناحية أخرى، تدرك صعوبة التعامل مع هذه الساحة، خصوصاً أنّ واشنطن لا تملك أوراقاً بيدها لتكوّن أو تشكّل بديلاً للرئيس السوري، فضلاً عن شكوك في قدرة المعارضة المتصدية لأمور الثورة في توفير انتقال سلمي ديمقراطي، وإحداث تحوّل جذري في النظام القائم وقيادته في المرحلة التالية.
وأضاف الموظف أنّ الساحة السورية تختلف في تعقيداتها وصعوبتها عن الساحات العربية الأخرى التي شهدت انتفاضات شعبية، مثل ليبيا على سبيل المثال، إذ سمح الإجماع الدولي والتراجع الروسي بفعل القرارات التي اتخذها الرئيس الروسي آنذاك دميتري ميدفيديف، وتمرير قرار مجلس الأمن الدولي حول الأزمة الليبية في توفير الأرضية لتدخّل دولي تحت غطاء حلف الناتو، وحسم الأمور بسرعة، وإخراج الرئيس الليبي معمر القذافي ونظامه من المشهد السياسي.
في المقابل، وفي حوار وصل إلى حد الجدل مع بعض الأصدقاء المتصدين الحراك السوري منذ بدايته، واستمروا لاحقاً قيادات ومؤثرين في توجهات هذا الحراك خلال العامين الأولين، حول التأثيرات السلبية التي ربما تترتب نتيجة التوجّه الذي يسود الحراك السلمي للانتقال إلى العمل العسكري تحت شعار حماية التظاهرات السلمية من خلال التركيز على إنشاء ما بات تشكيلات عسكرية مسلّحة تحوّلت لاحقاً إلى مُسمّى “الجيش السوري الحر”.
خيار الجيش الحر وعسكرة الحراك
المعارضة السورية ذهبت إلى تبني خيار “الجيش الحر” بناءً على التجربة الليبية، حيث حظيّ التشكيل العسكري الذي أنشأته المعارضة الليبية حينها “جيش ليبيا الحرة” بدعم دولي ومساندة واضحة من الدول المؤثرة في هذه الأزمة، فضلاً عن موقف مجلس الأمن الدولي الواضح في هذا الاتجاه، الذي استطاع الحصول على الموافقة الروسية لإصدار قرار يوفّر الغطاء الأممي للتدخل العسكري، من دون أن تقرأ هذه المعارضة الظروف الموضوعية والأبعاد السياسية والاستراتيجية التي دفعت هذه الدول لدعم هذا التشكيل ووجود قرار دولي بإنهاء نظام القذافي.
وذهبت إلى الدفع باتجاه “عسكرة” الحراك السلمي تحت ذريعة الحماية في البداية، وحاولت جرّ المجتمع الدولي إلى تبني هذا الخيار ودعمه، من دون الالتفاف إلى الفارق بين الحيثيات الليبية والحالة السورية، هو موقف كشف عن مستوى من القصور في قراءة المتحوّلات والمواقف الدولية من الأزمات، خصوصاً في الشرق الأوسط.
عسكرة الانتفاضة السلمية للشعب السوري لم تنجح في منح المتظاهرين الحماية المطلوبة والمستهدفة من هذه الخطوة التي كانت متعجّلة، وفي المقابل منحت النظام الذريعة التي كان يبحث عنها، ويعمل على الوصول إليها، من خلال شيطنة الحراك المُطالب بالحرية والديمقراطية، وتحويله إلى المستويين الأمني والعسكري، لتسهيل عملية القمع الدموي، التي سرعان مع حوّلها النظام إلى فرصة لممارسة أعلى مستويات القمع من أجل إعادة فرض سيطرته، والقضاء على كل مظاهر الحراك السلمي، الذي يشكّل له تهديداً حقيقياً ووجودياً.
اللاعب الروسي والحليف الصيني
وعلى الرغم من رغبة المعارضة وبعض الدول في تسريع عملية التغيير والانتهاء من النظام وإقصاء رئيسه بشار الأسد عن المشهد السوري، فإنّ هذه الرغبة اصطدمت، فضلاً عن تردد غربي، بإرادة مستجدة وجديدة من اللاعب الروسي، ومعه الحليف الصيني برفض هذا المسار الذي يشكل تهديداً استراتيجياً لمصالحهما في الشرق الأوسط والساحة الدولية.
وتزامن هذا التغير مع عودة فلاديمير بوتين إلى سُدة الرئاسة، الذي عمل على تصحيح ما عدَّه خطأ استراتيجياً قام به سلفه ميدفيديف بتمرير قرار مجلس الأمن الدولي حول لبيبا، الذي أضعف الموقف الروسي في منطقة غرب آسيا، فعمد بمؤازرة الصين إلى عرقلة كل المساعي الدولية والمجموعة العربية لإصدار قرارات تدين الأفعال القمعية والدموية التي يمارسها النظام ضد الشعب السوري، فضلاً عن تعطيل أي تحرك عسكري يؤدي إلى تغيير جذري في المشهد السوري، خصوصاً ما حدث في تعطيل خيار الرئيس الأميركي باراك أوباما بتوجيه ضربة عسكرية للنظام بعد إدانته باستخدام السلاح الكيماوي ضد المدنيين والمعارضة في أكثر من منطقة سورية.
النظام الإيراني واستهداف مصالحه
وإلى جانب الحلفاء الدوليين للنظام السوري على قاعدة المصالح الاستراتيجية، روسيا والصين، وجد النظام الإيراني بما هو الحليف الإقليمي للنظام السوري، وأيضاً على قاعدة المصالح الاستراتيجية، في الأحداث التي تشهدها سوريا ومساعي بعض الأطراف لإطاحة الأسد ونظامه استهدافاً مباشراً لمصالحه الاستراتيجية ومحاولة لمحاصرته وإخراجه من جغرافيا الشرق الأوسط، وإبعاده عن الحدود مع إسرائيل، وإنهاء التهديد الذي يشكّله لاستقرار المنطقة.
من هنا، لم يكن أمام قيادة النظام الإيراني سوى الذهاب إلى آخر الخيارات الممكنة والدخول العسكري المباشر على خط دعم النظام الذي بات في دائرة الخطر والسقوط، ولم يكن المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي بعيداً عن القلق الحقيقي للنظام عندما اعتبر الدفاع عن دمشق هو دفاع عن طهران، وأن سقوط الأهواز في خوزستان ربما يكون أقل تكلفة على النظام من سقوط سوريا.
الدخول الإيراني العسكري جاء تحت عنوان “مستشارون عسكريون” من قوات فيلق القدس التابع إلى حرس الثورة الإسلامية، وشكّلت تشكيلات حزب الله اللبناني الذراع القتالية لهم، وكانت المهمة الأولى حماية العاصمة دمشق، واستعادة السيطرة على محيطها وريفها، الأمر الذي سمح بإبعاد شبح السقوط عن قصر تشرين الذي كان يُسمع في أرجائه أزيز الرصاص ودوي الانفجارات.
معركة القصير والتحول إلى الهجوم
ولعل التطور الأهم الذي حدث في هذا السياق، الذي نقل النظام السوري من مرحلة الدفاع إلى الهجوم، كان في معركة “القصير” التي شكّلت تحولاً استراتيجياً في الأزمة السورية، ونقلت المعركة من مواجهة بين النظام وقوى مدنية، وتطالب بتغيير النظام الشمولي، إلى مواجهة بين قوى المحور الإيراني وجماعات متطرفة في مقدمتها تنظيم النصرة الفرع السوري لتنظيم القاعدة، ولاحقاً مع تنظيم داعش الذي تمدد من العراق إلى سوريا قبل أن يعلن دولته في حركة ارتداديه في الجغرافيا، انطلاقاً من عاصمته في الرقة باتجاه الموصل.
الحراك المصري والتراجع التركي
وتزامنت “معركة القصير” مع الحراك الشعبي المصري، الذي أدّى إلى إسقاط حكومة الرئيس محمد مرسي، وانتهاء مرحلة حكم تنظيم الإخوان المسلمين، الأمر الذي انعكس في نتائجه، إضافة إلى نتائج “معركة القصير” على وضع النفوذ التركي بالمنطقة العربية، خصوصاً على الساحة السورية، الأمر الذي وضع السلطة التركية ورئيسها رجب طيب أردوغان على سكة تراجع الدور وتقديم التنازلات، التي تزايدت حدتها وفاتورتها لاحقاً بعد الدخول الروسي العسكري المباشر، لدعم الأعمال الحربية للنظام الإيراني وحلفائه ضد المعارضة السورية، وعجزه عن حسم المعركة، وارتفاع فاتورة الخسائر البشرية في صفوفه، الأمر الذي أسس لمرحلة جديدة من تقاسم النفوذ والسيطرة بين الجانبين الروسي والإيراني على الساحة السورية، في حين اكتفى وما زال النظام التركي بالمراقبة وحساب خطوات التراجع، إن لم تكن الخسائر، التي تلحق به، بينما حافظت واشنطن على حدود دورها من خلال رسم حدود النفوذَين الروسي والإيراني في مناطق شرق الفرات، بانتظار بلورة الحل السياسي.
————————————
الثورة السورية تطوي عامها التاسع وما يزال سؤال الخلاص قائما/ عمر كوش
فيما تودع الثورة السورية، ثورة الخامس عشر من آذار/ مارس 2011، عامها التاسع، لتدخل عامها العاشر، فإن السؤال الذي يطرحه غالبية السوريين، يطاول المدى الذي ستستمر فيه الكارثة الكبرى التي حلّت بهم، بسبب نهج نظام الأسد الدموي وتعامله الوحشي مع الثورة وحاصنتها الاجتماعية، وتحويل سورية إلى مسرح لصراع إقلمي ودولي، تستعر فيها حروب متعددة الأطراف، إقليمية ودولية، تتمظهر في حرب النظام على غالبية السوريين، وحرب بالوكالة، وأخرى على النفوذ والسيطرة، وسوى ذلك.
ولا يجد سؤال السوريين عن الخلاص سوى غصّات ثقيلة على صدور السوريين، مع غياب أي أفق لحل سياسي ينهي معاناتهم، واستمرار صراع عسكري دامي على بلدهم وفيها، تخوضه خمس دول، حولت سورية إلى ساحة صراع وتوترات وتفاهمات روسية – أميركية من جهة أولى، وروسية – تركية من جهة ثانية، وإيرانية – إسرائيلية من جهة ثالثة، وتحول الصراع ليس إلى مجرد نزاع دولي بسيط، تتواجه فيه الدول المتدخلة عبر وكلاء محليين وإقليميين، بل تمتلك كل منها أجندات ومصالح خاصة مختلفة.
ويعيد دخول الثورة السورية عامها العاشر إلى الأذهان تلك المظاهرات الاحتجاجية السلمية، التي انطلقت قبل تسع سنوات، حيث خطّ تلاميذ إحدى مدارس درعا على جدار مدرستهم عبارة “إجاك الدور يا دكتور”، وخرج سوريون كثر إلى الساحات والشوارع كاسرين حاجز الخوف، الذي بناء النظام الأسدي في نسختيه، الأب والابن، ومتحدّين بأجسادهم العارية رصاص قوات استخبارات النظام وسكاكين وسيوف الشبيحة وحقدهم. في ذلك الوقت، اكتشف السوري صوته وجسده، وراح يعبر عن ذاته في تظاهرات وتجمعات غير آبه بالثمن الذي يدفعه، نتيجة خروجه من القوقعة التي حبسته فيها أجهزة النظام لمدة تزيد عن أربعة عقود مديدة.
وعلى مدى أشهر عديدة، ارتبطت شخصية المتظاهر السوري ببطولة مفهومية في حدث الثورة، جسدته تظاهرات درعا وبانياس والبيضاء والميدان والزبداني وحمص وحماة ودير الزور وجامعة حلب وسواها. لكن كل ذلك تحطم، بعد ترك السوريين ضحايا قمع نظام الأسد العنيف والوحشي، واستقدمه ميليشيات نظام الملالي الإيراني الطائفية، المتعددة القوميات، للدفاع عنه، ثم جاء التدخل الروسي المباشر إلى جانبه، ليحدث تحولاً كبيراً في ميزان القوى، ليتركز الصراع العسكري في الشمال السوري.
وبعد تسع سنوات على انطلاقة الثورة، فإن كل محاولات الحل السياسي قد فشلت، سواء في جنيف أو استانة أو سوتشي، بسبب عدم جدية المجتمع الدولي في إيجاد حل سياسي، وعراقيل وألاعيب نظام الأسد وحلفائه في نظام بوتين ونظام الملالي القابع في طهران، إذ حتى اللجنة الدستورية، التي حظيت بموافقة المجتمع الدولي، وكانت بمثابة تغطية لعجزه حيال القضية السورية، لم تستطع إكمال الجولة الثانية من اجتماعاتها، بسبب محاولة النظام حرفها عن مهمتها، وبالتالي، لم يجد المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسون سوى الإعلان عن خيبة أمله من تعثر عمل اللجنة، لكنه لم يُحمّل النظام مسؤولية إفشال أعمالها، وترك الباب مفتوحاً دون أي مقترح لتفعيل عملها، مع أن الأمم المتحدة ومعها هيئة الرياض2 التفاوضية، كانت تأمل في أن تفتح تلك اللجنة العتيدة المجال أمام حلّ سياسي في سورية.
أما المعارضة السورية، فبالرغم من فقدان تشكيلاتها السياسية والعسكرية دورها المؤثر في الأحداث وارتهانها للقوى الإقليمية والدولية، فإن من المستغرب أن تلك القوى لا تعمل إلا على تغيير هيكليات وتركيبات تشكيلات المعارضة السياسية، من دون العمل على تقويتها وتفعيل أدوارها الغائبة عما يعتري القضية السورية، فضلاً عن التمزق الذي يعتري تلك التشكيلات، بسبب الانقسامات الإيديولوجية والجهوية وسواهما.
وبالرغم من التفاهمات الروسية – التركية، إلا أن التصعيد العسكري الأخير على مناطق عديدة في محافظة إدلب، يكشف بوضوح أن النظام الروسي يريد السيطرة على ما تبقى من مناطق المعارضة السورية والتنظيمات المتشددة في شمالي سورية، واستكمال عودة سيطرة نظام الأسد على جميع الأراضي السورية، من خلال حرب الإبادة التي يقوم فيها. لكن ذلك يواجه معوقات عديدة، إذ أن معركة السيطرة على ما تبقى من محافظة إدلب ليست سهلة، ولا تريد تركيا في أن تتحمل موجات أخرى من تهجير السوريين ولجوئهم إليها، فضلاً عن أن سيطرة القوات الأميركية على حقول النفط في الجزيرة السورية، يفشل خطط ساسة الكرميلن في الاستحواذ على سورية، لذلك يعمل الروس على إبرام صفقة مصالحة بين نظام الأسد وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي والميليشات التابعه له. كما أن ازدياد الضغط الدولي على ساسة الكرملين، من أجل حملهم على وقف تصعيدهم العسكري، يشكل عامل إعاقة قوي في وجه ما يطمحون إليه، لذلك فإن استعجال ساسة الكرملين في استثمار ما حققوه عسكرياً على الصعيد السياسي يواجه الفشل، حيث لم يتمكنوا من تسويق ملف إعادة الإعمار وإعادة اللاجئين، إلى جانب فشلهم في التوصل إلى تسوية سياسية، يمكنها المحافظة على مصالحهم.
بالمقابل، تواجه قيادات الفصائل الإسلامية المتشددة، وخاصة هيئة تحرير الشام، مشكلات تتصل بالتفاهمات والاتفاقات الروسية – التركية، إضافة إلى مشكلة الفصائل التي تدور في فلكها، للتصدي لهجمات النظامين الروسي والأسدي، وذلك في ظل الانقسام القائم بين غرف عمليات الفصائل في إدلب. ويبقى أن أهل إدلب ونازحيها ومهجريها باتوا رهينة ما بين قبضة التنظيمات المتشددة وبين نيران هجمات الروس والنظام الأسدي.
ويعاني نظام الأسد معضلات عديدة، حيث تشهد المناطق التي يسيطر عليها، حالات تذمر كبيرة، نظراً للتردي الاقتصادي والأمني المستمر، الذي أدى إلى ضائقة معيشية خانقة، تتمظهر في الطوابير الطويلة على المواد الأساسية والغاز والمازوت، إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتدهور سعر صرف الليرة، وتفشي البطالة، وانتشار الجريمة، فضلاً عن انعدام الأمن والاحتكار والمحسوبية، وسطوة ميلشيات حزب الله وميليشيات نظام الملالي الإيراني الأخرى، وما يسمى القوات الرديفة الخارجة عن سيطرة النظام. وأفضى ذلك ارتفاع أصوات تطالب بإنقاذ الأوضاع ووقف الانهيار، إلى جانب تجرأ بعض الأصوات الموالية على انتقاد بشار الأسد، واتهامه بالوقوف وراء شبكات الفساد والنهب، وأدى ذلك إلى نشوء حملات ضد رأس النظام والحاشية المقربة منه، خاصة في مدن ومناطق اللاذقية وجبلة وسواهما. كما تشهد مناطق في درعا وحمص والرستن والغوطة الشرقية، حيث وثق “تجمّع أحرار حوران” خلال شهر فبراير/ شباط الماضي 37 عملية ومحاولة اغتيال في محافظة درعا، إلى جانب هجمات ومواجهات بين الأهالي ومقاتلي المعارضة السابقين من جهة، وقوات النظام وأجهزته الأمنية من جهة أخرى، وخاصة في مدينة الصنمين، حيث اضطر الروس إلى التدخل في محاولة لتهدئة الوضع، ومساعدة النظام على فرض سيطرته في المحافظة.
وحدثت تطورات عديدة، مع دخول الثورة السورية عامها العاشر، في ظل انهيار مشروع نظام الملالي الإيراني، واستمرار خضوع هذا النظام لعقوبات أميركية المشددة، وانطلاق الحراك الاحتجاجي في كل من العراق لبنان ضد نظام المحاصصة الطائفية في البلدين التابع لنظام الملالي، بما يهدد مشروع نظام الملالي للهيمنة على المنطقة.
والحاصل هو أن دخول الثورة السورية عامها العاشر يأتي مع استمرار الأحداث المأساوية التي تطال غالبية السوريين، وليس هناك ما يشير إلى سير الأمور نحو الأفضل، بل ستستمر معاناة السوريين في الداخل وفي بلاد المهجر، في ظل عدم اكثرات ولا مبالاة المجتمع الدولي بدماء السوريين، وغياب أي أفق للحل السياسي، وإصرار النظام وحلفائه في النظامين الروسي والملالي الإيراني على المضي في الخيار العسكري.
بروكار برس
—————————————
أسد على السوريين في إدلب وأبكم أمام الإسرائيليين في دمشق
على غير عادته في معظم الهجمات المماثلة السابقة، سارع جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى إعلان المسؤولية عن الغارات التي شُنت على جنوب العاصمة السورية ومحيط مطار دمشق مساء الأحد الماضي، موضحاً أنها استهدفت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، بالتزامن مع هجمات على قواعد للحركة في قطاع غزة. وفي مقابل تأكيد الحركة استشهاد اثنين من كوادرها في الغارات جنوب دمشق، أفادت مصادر أخرى أن العدد قد يكون أكبر بالنظر إلى أن نطاق الضربات كان واسعاً وحجم القوة الصاروخية كثيفاً.
من جانبه لم يفوّت رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو فرصة استثمار هذه الغارات سياسياً وعلى صعيد شخصي فكشف النقاب عن معلومة لوجستية يحرص جنرالات الجيش الإسرائيلي على التكتم حولها، وهي أن الغارة على جنوب دمشق استهدفت اغتيال قيادي كبير في الجهاد الإسلامي ولكنه نجا. وفي أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي كانت غارات إسرائيلية قد استهدفت ضواحي العاصمة السورية أيضاً، وتردد يومذاك أن أحد الأهداف كان منزل القيادي في الحركة أكرم العجوري، مما أسفر عن استشهاد ابنه ومقاتل آخر.
وليس خافياً أن نتنياهو يدرك قيمة استعراضات القوة من هذا النوع إجمالاً، ولكن في هذا التوقيت تحديداً وقبل أسبوع من انتخابات الكنيست الثالثة خلال أقل من عام، والتي تضع على المحك مجدداً ليس مستقبله السياسي كرئيس للحكومة وزعيم لليكود فحسب، بل كذلك مآزقه مع القضاء الإسرائيلي وتهم الفساد التي تلاحقه وسوف تؤذيه بشدة إذا لم يحتفظ بموقع رئاسة الحكومة. ولهذا فإن تهديداته بصدد الغارات الأخيرة شملت التلويح بحرب ضد قطاع غزة سوف تكون أشد شراسة هذه المرة، بالإضافة إلى إبلاغ رسائل جديدة إلى إيران عبر الاستمرار في استهداف فيلق القدس وميليشيات طهران الأخرى على الأراضي السورية.
كذلك يدرك نتنياهو أن سياسة الغارات في سوريا وضد القطاع تعزف على وتر شعبوي لدى الجمهور الإسرائيلي بصفة عامة، ولكنها تكتسب طابعاً تحريضياً خاصاً قبيل الانتخابات من زاوية استكمال «انتصارات» نتنياهو الدبلوماسية بعد إعلان «صفقة القرن» والعزم على ضمّ المستوطنات وأراض في الغور والضفة. ولم تكن مصادفة أن تصريحاته حول الغارة على دمشق وتهديد القطاع بحرب جديدة تزامنت مع زيارة إلى مستوطنة أريل في الضفة، بصحبة السفير الأمريكي دافيد فردمان واللجنة الإسرائيلية ــ الأمريكية المكلفة برسم خرائط الضم.
وليس مدهشاً أن طيران دولة الاحتلال يسرح ويمرح في أجواء دمشق، فلا تتصدى له سوى صواريخ قديمة عاطلة عن الفعل. وليس غريباً ولا جديداً أن الرادارات الروسية، التي تغطي شبكاتها كامل المنطقة وليس سماء سوريا وحدها، بقيت كالعادة متعامية عن الطيران الحربي الإسرائيلي، وغاب عنها حتى الشجب اللفظي المعتاد. ذلك لأنها، مثل نيران النظام السوري وطيرانه وبراميله المتفجرة، منهمكة بقصف أبناء الشعب السوري في قرى وبلدات ومدن إدلب، ومنشغلة بقذف مئات الآلاف من النازحين نحو العراء والمجهول والصقيع.
وكما في المثل الشهير، أسد على السوريين العزل في إدلب، وأصم أبكم أعمى أمام الإسرائيليين في سماء دمشق.
القدس العربي
——————————————————

============================
تحديث 19 أذار 2020
————————————-
في ذكراها التاسعة ماذا بقي من ثورة السوريين؟ / فراس حاج يحي
على السوريين جميعاً قلع أِشواكهم بأيديهم، واستعادة قرارهم الوطني المستقل المنفصل عن أي أجندات أخرى، فدول العالم منشغلة بشؤونها الداخلية ومصالحها الذاتية
9 سنوات مرت على انتفاضة الشعب السوري في ثورة وصفها أحد أبرز منظريها ومفكريها الدكتور برهان غليون في كتابه “عطب الذات” بأنها ثورة لم تكتمل، إذاً بعد هذه السنوات أين هي هذه الثورة؟ أين أبناؤها؟ ماذا بقي منها؟ وما هي مآلاتها؟
أسئلة على السوريين كلهم أو معظمهم الإجابة عنها على الأقل إن أرادوا إنقاذ ما تبقى من وطنهم، ومن أبنائه في ضوء أرقام لتضحيات فاقت حدود التصور، ودمار لحق البشر والحجر والشجر.
ضحايا ومهجرون ونازحون
أطفال درعا الذين خطت أصابعهم على جدران مدرستهم في آذار/ مارس عام 2011، عبارات مثل “اجاك الدور يا دكتور”، و”الشعب يريد إسقاط النظام”، لم يعوا وقتذاك أن عباراتهم ربما ستغير شكل سوريا إلى الأبد دولة وشعباً، ولم يكن يتوقع من شارك في أولى تظاهرات الثورة السورية مطالباً بالحرية والكرامة، أن السوريين كلهم سيدفعون ثمناً لا يمكن تحمله. واليوم بعد 9 سنوات لا يوجد سوري رابح، فالكل قد خسر وأي حل مقبل في سوريا هو اتفاق بين خاسرين.
“الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، وهي منظمة حقوقية سورية غير حكومية نشرت تقريراً تضمن توثيقاً لما حصل في سوريا خلال سنوات الثورة السورية، استعرضَت فيه حصيلة أبرز الانتهاكات التي نفَّذها أطراف النِّزاع الرئيسيون الفاعلون في سوريا منذ آذار 2011 حتى آذار 2020. وأشار إلى مقتل226247 مدنياً، بينهم 29257 طفلاً، و16021 سيدة (أنثى بالغة) منذ آذار 2011، 91.36 في المئة منهم قتلوا على يد قوات الحلف السوري- الروسي، وتفوق نسبة الضحايا من الأطفال والسيدات إلى مجموع الضحايا الإجمالي، حاجز 18 في المئة، وهي نسبة مرتفعة جداً وتُشير إلى تعمُّد قوات الحلف السوري- الروسي استهداف المدنيين.
وقدَّم التقرير إحصاء تحدّث عن 129989 شخصاً لا يزالون قيدَ الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التابعة للنظام السوري، مُشيراً إلى أنَّ 14221 شخصاً قُتِلوا بسبب التعذيب في سجون النظام السوري.
وبحسب التقرير فإن ما لا يقل عن 3087 شخصاً لا يزالون قيدَ الاعتقال أو الاختفاء القسري في سجون قوات سوريا، وسجل التقرير اعتقال التنظيم ما لا يقل عن 8648 شخصاً منذ تأسيسه حتى آذار 2020، فيما ذكر أن ما لا يقل عن 2057 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد “هيئة تحرير الشام”. كما أن فصائل في المعارضة المسلحة نفَّذت عمليات اعتقال استهدفت 3044 مدنياً.
كما ذكر التقرير أنَّ ما يقارب 15.2 مليون شخص تعرَّضوا للتشريد القسري منذ آذار 2011، بينهم 9 ملايين شخص تم تشريدهم داخل سوريا، كما تشرَّد قرابة 6.2 مليون لاجئ خارج سوريا، وبحسب التقرير ظلَّت قوات الحلف السوري- الروسي هي المسؤول الأكبر عن عمليات التشريد القسري.
وفي هذه الحرب المستعرة لم يتبقَ نوع من أنواع الأسلحة المحرمة دولياً لم يستخدمه نظام الأسد وحلفاؤه لإخماد ثورة السوريين، وجعلهم عبرة لشعوب المنطقة التي قد تفكر يوماً بالثورة على حكامها، ابتداءً بالأسلحة الكيماوية والذخائر العنقودية مروراً بسلاح الحصار والتجويع وانتهاء بالتشريد والتغيير الديموغرافي.
تحولات مسار الثورة السورية
مرَّت الثورة السورية منذ انطلاقها وحتى الآن بتحولات وتبدلات وإرهاصات لا يمكن حصرها، ولكن على رغم انطلاقتها السلمية بتظاهرات عمت قسماً كبيراً من المدن والقرى السورية، إلا أنها فشلت في الوصول إلى نهاية تحقق فيها أهدافها بفعل عوامل ذاتية، داخلية وخارجية بسبب التدخل الإقليمي والدولي لمناصرتها أو استعدائها والعمل على إنهاء حلم السوريين بدولة جديدة، دولة العدالة والقانون والمواطنة التي نشدها ملايين من السوريين. ونتيجة للعقلية الأمنية والقبضة الحديدة التي واجه بها نظام الأسد الثورة السلمية، عبر عمليات القتل والاعتقال الواسعة والزج بمؤسسة الجيش بمواجهة الانتفاضة الشعبية، تحولت الثورة إلى صراع مسلح، الغلبة فيه لقوة السلاح لا لقوة الفكر والتغيير لتتحول إلى حرب مستعرة غير متكافئة الأطراف، وبخاصة بعد التدخل الإيراني العسكري المباشر، وبعده التدخل الروسي في نهاية عام 2015، وتمسك النظام السوري بالسلطة حتى وإن كان على حساب دمار الدولة ومؤسساتها واستجلاب احتلالات متعددة.
رافق تلك العوامل الخارجية عوامل ذاتية داخلية في بنية الثورة وكياناتها السياسية والعسكرية أهمها: فشل المعارضة السياسية في قيادة الحراك ودفة الثورة سياسياً عبر عدم امتلاكها برنامجاً وطنياً جامعاً، وخطة عمل واستراتيجية تصل بالثورة وأبنائها إلى بر الأمان، ليتحول المشهد السياسي للمعارضة الى ممثلين للدول الداعمة لهم بدل أن يكونوا ممثلين لشعبهم. الائتلاف السوري وحكومته الموقتة تابعان للسياسة التركية واستراتيجيتها تجاه الملف السوري، ومثلها منصة القاهرة تتبع لمصر، وهيئة المفاوضات تتبع للسعودية ومنصة موسكو تتبع لروسيا، ووحده الشعب السوري الرازح تحت القصف والخيام ودول الشتات، ما زال يناضل لتحقيق أهداف ثورته أو ما تبقى منها.
وفي الجانب العسكري وعلى رغم انطلاق الجيش السوري الحر والذي تشكَّل من المنشقين عن جيش النظام والمدنيين وحمل في بداياته أهداف الثورة السورية وشعاراتها، إلا أن قسماً كبيراً منه تحول بعد سنوات قليلة الى كتائب تقاتل تحت رايات ومسميات متعددة لا تجمعها راية ولا هدف محدد ولا يعنيها الحرية ولا الديمقراطية. رافق ذلك ظهور مجموعات وكتائب إسلامية بمشروعات خاصة لا تمت للثورة السورية بصلة وترتكب انتهاكات تشبه ممارسات نظام الأسد، إلى أن ظهرت التنظيمات الجهادية الإرهابية مثل تنظيم “داعش” وجبهة “النصرة” منذ عام 2013. وهذه الجماعات منحت نظام الأسد ما كان يتمناه من دعم لروايته بوصم هذه الثورة بالإرهاب والتطرف، عبر ما قامت به من ممارسات وجرائم جعلت أولوية المجتمع الدولي التخلص من هذه التنظيمات ذات الخطر عابر الحدود بدل دعم الشعب السوري، ومساعدته على الوصول إلى حريته التي ضحى لأجلها. ثم استكملت هذه الفصائل الجهادية دورها في محاربة فصائل الجيش الحر والسيطرة على المناطق التي كانت تحت حكمه، ليستعيد نظام الأسد بمساندة حلفائه الروس والإيرانيين أجزاء واسعة من سوريا لتعود تحت حكمه وسيطرته العسكرية.
سوريا إلى أين؟
ربما يكون الرأي الغالب بأن سوريا قبل عام 2011 لم تعد موجودة من كافة النواحي الا في خيال الحالمين من أبنائها، أو المنفصلين عن الواقع، شعب نصفه بين نازح ومشرد، دمار كبير في البيوت والمرافق العامة والبنية التحتية (مدارس – مستشفيات)، تغيير ديموغرافي على نطاق واسع، هجرة رؤوس الأموال والكفاءات العلمية السورية إلى دول الجوار والاتحاد الأوروبي، احتلالات متعددة بقوات عسكرية (روسية، إيرانية، تركية، أميركية، إسرائيلية)، نسيج اجتماعي مدمر، سيطرة روسية- إيرانية- أميركية على مصادر الطاقة من نفط وغاز وفوسفات، انهيار نقدي كبير وقرابة 80 في المئة من الشعب السوري تحت خط الفقر ويحتاج إلى مساعدات إنسانية.
يضاف إلى ذلك أكثر من مليوني طفل سوري خارج منظومة التعليم، ونظير هذا العدد لم يكمل تعليمه بعد عام 2011، ملايين الأطفال الأيتام والنساء الأرامل، ومئات آلاف المصابين وجرحى الحرب. هذه الكوارث التي حلت بسوريا وشعبها مع خطر يلوح في الأفق بتقسيم في شمال غربي سوريا، قد ينهي وحدة الدولة السورية وما زال قسم من السوريين يعتقد أنه انتصر عسكرياً وقسم آخر يعتقد أنه قادر على النهوض من جديد والانتصار.
ربما استطاع السوريون هدم مزرعة آل الأسد، وحكمهم الوراثي الاستبدادي ولكن الثمن كان كبيراً وكبيراً جداً دفعه السوريون جميعاً، ولكنهم لم يصلوا إلى مبتغاهم بعد في التغيير والتحول الديموقراطي وإنما امتد ليهدم سوريا وشعبها، فهل كانت حرية السوريين تستحق كل هذا الثمن؟
يكتفي المجتمع الدولي تجاه سوريا وشعبها بالتصريحات والقرارات الدولية التي لا تجد لها طريقاً للتنفيذ، والتلويح بالعقوبات الاقتصادية على نظام الأسد، وعدم دعم عملية إعادة الاعمار قبل بدء الانتقال السياسي وهي آلية قد تستغرق سنوات طويلة حتى تحقق أهدافها.
وأمام هذا الواقع السوري المؤلم، يبقى الأمل بأن يولد جيل جديد، يحمل مشروعاً وطنياً جامعاً ويعمل لإعادة بناء وطنه ويتجاوز مسألة “إن كانت ثورة أم مؤامرة”، ويرتقي بمسؤولياته إلى حجم وطنه ويعمل على إعادة توحيد سوريا فعلياً، لا بالقول فقط، جيل يناضل لطرد الاحتلالات المتعددة التي جلبت إلى الأرض السورية، جيل يؤمن بسوريا جديدة لكل أبنائها، يضمد جراحهم، ويبني الإنسان والوطن الذي تهدم ويعيد النازحين والمهجرين إلى ديارهم، ليبني دولة المواطنة التي تنتقل بسوريا الى دولة جديدة تضمن السلام المستدام والعدالة، وتحفظ خيرات الدولة وتحميها. فعلى السوريين جميعاً قلع أِشواكهم بأيديهم، واستعادة قرارهم الوطني المستقل المنفصل عن أي أجندات أخرى، فدول العالم منشغلة بشؤونها الداخلية ومصالحها الذاتية وبناء مجتمعاتها وتطويرها، والدول المشتركة في الصراع السوري تتهيأ لتقاسم هذا الجسد الممزق المريض المسمى سوريا، ومجتمع دولي لم يحركه مليون ضحية وملايين النازحين والمشردين، لن يتحرك لتحرير بلد محتل وبناء وطن مدمر وانتشال دولة غدت بمصاف الدول الفاشلة بالمقاييس كلها.
درج
————————-
الأسباب التسعة لعدم انتصار الثورة السورية/ ياسر أبو هلالة
تدخل الثورة السورية عامها العاشر، ولا يزال الشعب السوري، بصمودٍ لم يعرفه التاريخ، يواصل صموده، والمجرم الوضيع بشار الأسد باقيا على كرسيه، ناكثا وعده: “الأسد أو نحرق البلد”، فقد أحرق البلد وبقي! في هذه العجالة، محاولة لرصد الأسباب التي أبقته، ومنعت الثورة من تحقيق أهدافها.
أولا، طبيعة النظام الطائفية. صحيح أن الثورة بدأت وطنية جامعة، ولم تتبنّ خطابا طائفيا، إلا أن النظام نجح، منذ اليوم الأول، مستغلا أخطاء لاحقة، في إقناع الطائفة بأنها تخوض صراع وجود، وأن بقاءها مرتبطٌ ببقاء النظام، وأن زوال النظام يعني تهجيرها وتقتيلها وانتهاك أعراضها. لذا وجد النظام من يقاتل دونه، إلى اليوم، وكأن القصر الجمهوري بيته الذي يضم نساءه وأطفاله.
ثانيا، إمكانات النظام العسكرية والأمنية، فمع أن نظام الأسد فشل في بناء الدولة، إلا أنه بنى منظومةً أمنيةً وعسكرية، قادرة على سحق السوريين، مع أنها عاجزةٌ عن الدفاع عن وطنهم أمام العدوان الخارجي، أو استعادة ما احتل من أرضهم. وتلك الإمكانات كمية، من حيث عدد المنتسبين، إضافة إلى الخبرة القمعية المتراكمة، والرعب التاريخي الذي سببته.
ثالثا، تشتت المعارضة السورية وغياب القيادة الجامعة لها، وهي لا تزال عاجزة عن تقديم أي قيادي أو هيئة قيادية يستطيع السوريون، ومن حالفهم، التعامل معها بديلا للنظام. منذ اليوم الأول، ظلت القيادات فصائلية وفئوية ومحلية ومناطقية، وحتى عندما تتقدّم لموقع قيادي عام تبقى أسيرة الحسابات المحلية التي لا ترقى إلى مستوى تمثيل الشعب السوري.
رابعا، الاحتلال الإيراني. على الرغم من كل عيوب المعارضة السورية وأخطائها، إلا أنها تمكنت من بسط سيطرتها على نحو 80% من الأراضي السورية. وليس هناك وصف لانهيار بشار الأسد أدق مما أورده القائد السابق للحرس الثوري الإيراني في سورية، الجنرال حسين همداني، في كتابه “نداء الأسماك”. فالجزار ابن الجزار “كان يبحث عن مهرب” لولا أن أقنعه همداني بالصمود. قتل همداني وهو يدافع عن نظام بشار الأسد، ولكن الحرس الثوري، بكل إمكاناته، وتسخير مقدّرات الدولة السورية تحت تصرفه، واحتلاله البلاد، إضافة إلى نفوذه السابق، لم يتمكّن من هزيمة الثورة.
خامسا، الاحتلال الروسي. لم ينجح الإيرانيون، بكل إمكاناتهم على الأرض، وما جلبوها من فصائل عراقية وأفغانية ولبنانية، في جعل النظام يصمد، فاضطر هذا إلى جلب الاحتلال الروسي بكل إمكاناته، سواء في فيتو مجلس الأمن أو في قدراته الجوية التدميرية، فضلا عن قدراته الاستخبارية واللوجستية.
سادسا، الدعم الصهيوني الخفي. اشتغل ذلك الدعم في منع وصول السلاح النوعي إلى المعارضة، وفي التأثير على الدوائر الأميركية والغربية، وإقناعها ببقاء بشار ضعيف أفضل من ديمقراطية تنتج نظاما معاديا لإسرائيل، أو فوضى تهدّد أمن حدودها التي يحرسها نظام الأسد منذ عام 1973.
سابعا، الدعم العربي الخفي لبشار. دول عربية كثيرة كانت تدعم النظام السوري سرا، كما تكشّف من الموقف الإماراتي أخيرا، والذي ظل يتظاهر بدعم الثورة والمشاركة في غرفة عمليات الموك. كما أن نظام عبد الفتاح السيسي زوده بالسلاح. وكذلك تغير الموقف السعودي لصالح النظام، بعد وصول محمد بن سلمان زعيم أمر واقع.
ثامنا، “داعش” والتنظيمات المتطرفة. صحيح أن هذه قاتلت النظام وأثخنت به، لكنها خدمته، بحيث نفّرت قطاعا واسعا من السوريين من الثورة، وجعلتهم، كما المجتمع الدولي، يرون في النظام بديلا أقل سوءا. لم يكن نظام الأسد يحلم بجائزة مثل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). وبات هذا التنظيم، موضوعيا، شريكا للمجتمع الدولي في محاربة الإرهاب، بدلا من أن يحارب بوصفه نظاما إرهابيا لا يقل إجراما عن “داعش”.
تاسعا، موقف الرئيس الأميركي السابق، أوباما، المتردّد الذي تحول تواطؤا مع بشار الأسد، فمع أن الأميركان وصلوا، ومن حالفهم، إلى لحظة العمل العسكري ضد النظام، بعد استخدامه السلاح الكيماوي، إلا أن أوباما تردّد، وتمت محاسبة السلاح وتدميره، بدلا من محاسبة المجرم الذي استخدم السلاح.
بعد تسع سنوات، النتيجة تعادل، لا الشعب هُزم ولا النظام رحل. أُحرق البلد وبقي الأسد. يبقى الأمل أن عقد الثورة يتوج العام المقبل بانتصارها.
العربي الجديد
——————————-
الثورة السورية في غيبوبتها/ ساطع نور الدين
رسالة الى صديق سوري في المنفى:
لم يكن فيروس كورونا والغيبوبة التي يفرضها على العالم أجمع، سبب مرور الذكرى التاسعة للثورة السورية مرور الكرام، بصفتها حركة من الماضي، من التاريخ البعيد، لا تجوز عليها سوى الرحمة، ولا يستحق روادها سوى العطف، ولا يكسب جمهورها سوى سبيل جديد الى الموت.
كان الفيروس القاتل مبرراً للسكون، لكن الاهم أنه كان مهرباً من الحساب، أو على الاقل من النقاش الذي تستدعيه الذكرى التاسعة، أو يفرضه الدخول المفترض في السنة العاشرة من عمر الثورة، إذا كان ثمة سؤال يطرح في المناسبة، وإذا كان ثمة أجوبة تقدم، لما يربو على العشرين مليون إنسان، ممن بقوا على قيد الحياة ، لكنهم خسروا الهوية، وفقدوا الصلة بالزمان والمكان، وصارت عناوين التواصل في ما بينهم تقتصر على تعداد القتلى والجرحى والاسرى، وعلى تعقب النازحين في مختلف أرجاء المعمورة.
لم يعد هناك ثورة يمكن ان يحكى عنها، عن تجربتها، عن وعودها، عن مستقبلها. وهو ما لا يعوض بالقول مثلا انه لم يعد هناك نظام أيضاً، يمكن مقارعته. بات الوجود السوري برمته وهمياً، بل يبدو لمعظم السوريين، موالين ومعارضين، أنه كان في الاساس مفتعلاً، ولم يكن له أي سند على أرض الواقع. التمزق الراهن للوطنية السورية، كان هو الأصل، وكل ما عداه أوهام وخرافات. ظاهرة نبش القبور المتكررة ليست أمراً عارضاً لا في السلوك ولا في الوعي ولا الثقافة. ومثلها أيضا ظاهرة تصدير المرتزقة السوريين الى طرفي الحرب في ليبيا.
عندما لا يبقى للآخر الحق بقبر في سوريا، يصبح الكلام عن حل سياسي، عن مصالحة وطنية، عن مسامحة، سابقاً لأوانه جيلين أو ثلاثة أجيال، وربما أكثر، وتكون التصفية النهائية هي المراد الوحيد.. برغم ان الصراع لم يعد صراعاً حصرياً بين السوريين أنفسهم، لا سيما وأن المتحاربين غير السوريين على بعض الجبهات، باتوا أغلبية، وصار التناحر الخارجي على سوريا أهم وأبعد من كل ما كان مطروحاً قبل تسع سنوات على جدول الاعمال السوري.
الإشتباك التركي الروسي الاخير، الذي هدأ لكنه لم ينته، لا يمكن أن يغطي على الذكرى التاسعة للثورة، أو أن يلغيها. يمكن إعتباره حقبة من الانفجار السوري، ما زال ملايين السوريين خارجها، بعيدين عنها، يمضون الوقت في الردح للروس او للاتراك، أو للنظام او حتى للمعارضة، كأنهم في مبارزة لغوية أو لسانية، او مباراة على كسب الجمهور الافتراضي على السوشيال ميديا.
هذه الملايين باتت نصفين: نصف في الداخل ينتمي الى النظام او يخشاه، ونصف في المنفى لا يجد في المعارضة سوى بقايا هيئات وتشكيلات وتنظيمات وحتى تجمعات هرمت بسرعة فائقة. وهم يعبرون عن أنفسهم وعن مواقفهم ويخوضون النضال بطريقة عفوية فردية إنفعالية، تنبىء بأن النظام لن يتغير على أيديهم.. إلا بعد عقود من الزمن.
من خارج سوريا، من بيروت على سبيل المثال، ما كان يبدو خياراً مريحاً، صار طريقاً مسدوداً: السنوات الاربع الأخيرة من عمر الثورة أتاحت الفرصة للنأي عن سوريا، حيث يستحيل التسامح مع النظام بعدما تكشف من وحشيته، كما يصعب التلاقي مع الاشكال الاسلامية الحالية من المعارضة التي غلبت عليها البربرية. أما الرهان على الشتات السوري فهو أمر يفوق القدرة على الصبر، خاصة وأن الوعد بإطلاق ما يمكن ان يسمى جدلاً، “منظمة التحرير السورية”، هو محض خيال، لن يربك موسكو ولا طهران ولا يقلقهما طبعا.
مع ذلك، لم يبق، للأسف الشديد، سوى تلك المقاربة للشأن السوري، التي تعلي شأن النازحين في شتى أصقاع الارض، وتزعم أنهم الأمل الوحيد، ولو البعيد، في تغيير النظام لا في إسقاط الرئيس فحسب. فهؤلاء كانوا ولا يزالون يستحقون أفضل من بشار الاسد، وأفضل من تلك الفصائل الاسلامية السورية المهينة لفكرة المعارضة وجوهرها. وهؤلاء أيضاً تحرروا نهائياً من النظام ونجوا من قبضة روسيا وإيران، وفتحت الآفاق الواسعة أمامهم أكثر من أي وقت مضى.
النزوح فرصة، أمل، ربما . هي مجرد خاطرة، تتحدى الغيبوبة في زمن الكورونا.
المدن
—————————–
في ذكرى الثورة السورية… “قبلة دمار” من طوكيو إلى دمشق / أحمد الأحمد
بمجرّد النظر إلى دمار سوريا والصور الأرشيفية التي تحكي دمار اليابان، يظهر الشبه الكبير ويُحلُّ لغز هذا التشبيه.
محاولة لمقاربة دمار الحرب العالمية في اليابان بالدمار الحاص في سوريا
في كلِّ مرّةٍ تدور أحاديث بين السوريين عن الدمار الحاصل في البلاد، جراء عمليات القصف المستمرّة منذ 9 سنوات، يشبّه السوريون وغيرهم دمار المدن السورية بدمار المدن اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية.
ومُنيت اليابان بخسائر فادحة خلال هذه الحرب، إذ دُمّرت أجزاءٌ واسعة منها، فضلاً عن تعرّض مدينتي هيروشيما وناكازاكي لدمار شديد، وخسائر بشرية، جراء تعرّضهما لقصفٍ بقنابل نووية خلال الحرب العالمية الثانية.
وبمجرّد النظر إلى دمار سوريا والصور الأرشيفية التي تحكي دمار اليابان، يظهر الشبه الكبير ويُحلُّ لغز هذا التشبيه.
تشابه ذكريات الموت
في الذكرى التاسعة لانطلاق الثورة السورية، نفّذت مجموعة من الناشطين في طوكيو وقفة للتضامن مع الشعب السوري وشجب استهداف المستشفيات من قبل النظام السوري والطيران الروسي.
الوقفة التضامنية كانت أمام لوحة “أسطورة المستقبل” للفنان التشكيلي الياباني الشهير تارو أوكاموتو، في محطة شيبويا للقطارات وهي من أكبر محطات العاصمة اليابانية.
ويعدّ أوكاموتو من أبرز مبدعي الفن الحديث في اليابان كما تعتبر لوحة “أسطورة المستقبل” التي أنجزت عام 1969 من أشهر الأعمال الفنية التي تتناول ويلات الحروب، إذ يشبّه البعض مكانتها في السياق الفنّي الياباني بمكانة لوحة “غيرنيكا” للرسام الإسباني بابلو بيكاسو في السياق الأوروبي.
وبحسب بيان حصل عليه “درج” من المشاركين في الوفقة التضامنية، فإن الناشطين يسعون إلى الربط بين ما يحدث في سوريا الآن وما عانته مدينة طوكيو من قصف أميركي دمر أجزاءً واسعةً منها في أواخر الحرب العالمية الثانية، إذ أحيا اليابانيون في العاشر من شهر آذار/ مارس الحالي الذكرى الخامسة والسبعين للقصف الذي أودى بحياة أكثر من 100 ألف مواطن ياباني.
وفي هذا السياق، رفع المشاركون، صوراً لمدينة طوكيو المدمرة عام 1945 جنباً إلى جنب مع صور توثق مشاهد الدمار الحالي في سوريا.
ويأمل المشاركون بأن يحوز حراكهم على اهتمام اليابانيين وتعاطفهم على نطاق واسع، وهم الذين عرفوا أهوال الحروب وشهدوا الآثار الدموية لقيام الدول الكبرى بإفلات عقال جيوشها لاقتراف جرائم حرب مروعة بحق المدنيين، من دون أدنى اكتراث بالمبادئ الإنسانية والقانون الدولي، الأمر الذي يتكرر الآن بحق المدنيين السوريين، إذ شرّد القصف الهمجي للنظام السوري وحليفه الروسي أكثر من مليون منهم مجدداً خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة فقط.
كيف ترى اليابان الثورة السورية؟
خلال سنوات الثورة السورية، قدّمت اليابان منحاً مالية للسوريين، وتحديداً للنازحين وللمنكوبين جراء الحرب.
واستضافت اليابان عام 2012 مؤتمر “أصدقاء سوريا” الذي كان يهدف إلى إيجاد حشد دولي لمساندة الثورة السورية.
وفي العام ذاته، وسّعت اليابان من عقوباتها الاقتصادية التي فرضتها على النظام السوري مطلع الثورة، إذ أدرجت 36 شخصاً و19 كياناً على قائمة الأهداف التي تشملها هذه العقوبات، بينهم رئيس الوزراء السوري المنشق وائل الحلقي، وحاكم المصرف المركزي السوري السابق أديب ميالة، إضافة إلى الشركة السورية للنفط، ومصارف وشركات صناعية ووزارات، ليكون إجمالي عدد المعاقبين المقرّبين من النظام السوري حينها 59 شخصية و35 منظمة وكياناً، ومن هؤلاء ابن خال الرئيس السوري رامي مخلوف، وهو رجل أعمال نافذ يملك سلسلة شركات في سوريا، ومُدرج على قائمة العقوبات في دول عدة حول العالم.
وسحبت اليابان بعثاتها الديبلوماسية من سوريا، وأغلقت سفارتها ضمن عملية “القطيعة الجماعية الدولية” ضد النظام السوري في مطلع الثورة.
واستمرّت اليابان بتقديم منح مالية مساعدات للنازحين السوريين المتضرّرين من القصف والعمليات العسكرية، كان آخرها إعلان السلطات اليابانية في العاشر من شهر آذار 2020 إرسال منحة قدرها 4.75 مليون دولار للنازحين في محافظة إدلب.
ولكن على السياق السياسي والعسكري، لم تكن مشاركة اليابان فاعلة في هذا المضمار، سواء في ما يخص دعم فصائل معارِضة أو تقديم أسلحة أو معدّات قتال.
ولكن قبل الثورة السورية، كانت هناك منظمة “جايكا” اليابانية، التي نفّذت مشاريع في سوريا، فضلًا عن وجود تبادل ثقافي بين سوريا واليابان، إذ كان انتقل الكثير من اليابانيين إلى دمشق لتعلّم اللغة العربية، لكنهم انتقلوا جميعاً إلى الأردن بعد الثورة السورية.
حتّى أن واحدة من أجمل الحدائق في العاصمة دمشق، كانت حديقة يابانية وتقع قرب منطقة قدسيا.
بالنسبة الى الرأي العام الياباني هناك ميل لمقاربة ما يجري في سوريا من زاوية انسانية بحتة، كما أن هناك الكثير من المنظّمات التي تعمل على تقديم العون والمساعدة للسوريين. ولكن نظراً للبعد الجغرافي والثقافي لا تزال النظرة لما يحصل في سوريا نظرة تبسيطية أحياناً وأسيرة ما يتم تداوله في الإعلام خصوصاً لجهة التركيز على “داعش”، والذي كان مسؤولاً عن اعدام صحافي ياباني خلال سيطرته.
كما أن النظرة العدائية التاريخية التي يحملها جزء من اليابانيين للولايات المتّحدة جراء تداعيات الحرب العالمية تؤثر في فهم ما يحصل في سوريا، إذ ينظر الكثير من اليابانيين إلى أن الولايات المتحدة تقصف سوريا وتحاول تغيير النظام، من دون الالتفات إلى القصف الروسي أو التدخّل الإيراني الذي يساند النظام منذ سنواتٍ عدّة.
———————
معالم الحياة في الثورة.. موت النظام/ منير الربيع
بين آذار وآذار، يطول الانتظار. يقسو الوقت ويستبد الزمن. قسوة الأيام وسخرية القدر، تشاء أن تسيّر الدوريات التركية الروسية المشتركة في إدلب يوم الخامس عشر من آذار، ذكرى اندلاع ثورة الاستقلال والتحرر في سوريا. إمعاناً في اغتصاب الثورة، التي بدأت بقصيدة، وتحولت إلى أغنية وأهازيج، أبت الانزواء في حالات الطوارئ، وثارت منتفضة بوجه الرصاص الذي أطلق على الصدور والأفكار.
فجّرت ثورة الشعب السوري لغة السوريين. قبلها كانت سوريا عاصمة الصمت. في بداية صراخ الحناجر “حرّية” كان الانقلاب على الرطانة الإنشائية الحاكمة، والفارضة للصمت المطبق. بدأ الشعب السوري اختراع لغته، ألف باء الحراك، كان “الشعب السوري ما بينذل” واللي بيقتل شعبه خاين”. هي اللغة الأولى خارج الإنشائيات السائدة، والتي تفاعلت مع فيديوهات حيّة وأغان. كانت هذه الرمزيات تشكّل باكورة ثقافية جديدة، تحت عنوان “أنا إنسان وليس حيوان”. كان ذلك الفعل الثوري الأول لانتفاضة العام 2011.
من اللغة الخطابية والكلامية في الفعل الأول للانتفاضة، تحددت لسانيات الثورة في الفعل الثاني، كانت مشاهد السوريين في الحارات والشوارع، كانت احتفالات ليلية، عبّرت عن لغة الجسد السوري، صفوف بشرية متراصة، تتكاتف متراقصة، في حركات جماعية تصفيقاً وهتافاً وتلحيناً. كان السوريون يستعيدون أجزاء من تراثهم، في تجليات نوستالجيا لحقبة ما قبل البعث. جاءت الهتافات والأنغام من حقبة الخمسينيات والستينيات، ترافق ذلك مع إعادة
اكتشاف العلم السوري. هكذا بدأ الشعب السوري يشكّل هويته السياسية، بمشهد متخيّل ومتكامل منفصل عن سوريا النظام، أو سوريا الأسد.
مدهشة كانت إنتاجات الثورة الثقافية، والموسيقية، مقابل عجز تام للنظام عن الخروج على أدبياته السائدة منذ السبعينيات. كانت المواجهة بين سوريا المتخيّلة، وسوريا الأسد القائمة على نظرية المؤامرة وثقافة التخوين. سوريا المتخيّلة كانت انقلابا على جمهورية الخوف، والفروع الأمنية وحجب الشمس بالمدافع.
بدأت الثورة من الريف، من الأحياء المهمشة، أو الناس من الأصول الريفية داخل المدن، وسريعاً دخلت بعض المدن، حمص، حماه، وأحياء في اللاذقية، ودرعا، دمشق، الحسكة ودير الزور والرقة، بدأت شمولية الثورة، وتمددها. اندفعت المدن الأولى إلى الثورة، بفعل الضغينة على ما عانوه طوال سنوات، ردّاً على مجازر الثمانينيات في جسر الشغور، حلب، وحماه.
لم يغيّر النظام أسلوبه، بقي في تحجره وداخل أقبية أسره العقلي، أول أهدافه، كان الناشطون المدنيون، في السنة الأولى، اعتقل حوالي ألفا من هؤلاء الناشطين، منهم من قتل ومنهم من نفي، كانت استراتيجية النظام في القضاء على هؤلاء لصالح عسكرة الثورة وأسلمتها، قطع أيدي الرسامين، وانتزع حناجر المغنّين والشعراء. زج بالسياسيين في السجون والمعتقلات، وأطلق سراح المتطرفين والإرهابيين، الذين كان مشروعهم يخدم مشروعه الخبيث في تأبيد بقائه بذريعة مواجهة الإرهاب، ولم يكن الإرهاب إلا صنيعته.
وصلت الثورة السورية إلى مصاف النكبات الكبرى. تتخطى نكبة فلسطين، المشروع الإسرائيلي الذي كان يدّعي النظام السوري مواجهته، هو مشروع استعماري، نجح في تأسيس دولة إسرائيل عام 1948، لكنه فشل في إنكار وجود الشعب الفلسطيني، منذ تلك اللحظة إلى اليوم تواجه إسرائيل مأزقاً وجودياً، يتمثل بوجود شعب حيّ يطالب بحقوقه، ما يجبر الإسرائيلي على الذهاب إلى حل الدولتين عاجلاً أم آجلاً، وسيسقط صفقة القرن.
بينما النكبة السورية مختلفة، أقسى وأجرم، فهي لا تواجه مشروعاً استعمارياً ولم تبدأ كحرب أهلية، هي عبارة عن جرح تاريخي لم يندمل، يصل وصف ما تعرّض له السوريون إلى حرب إبادة، فيما عمل النظام على سنّ قوانين تشبه القوانين الإسرائيلية في إدارة أملاك الغير. في فلسطين كان الصراع بين شعبين، أما في سوريا فالشعب كان يتعرض لإبادة من داخله. كان المشروع الأساسي للنظام هو منع وجود أي حياة سياسية في سوريا.
انتهى مفهوم الدولة الوطنية في كل المنطقة العربية لصالح الدويلات والفوضى، فبقيت المجتمعات معلّقة بلا أي صيغة وطنية مقنعة أو واضحة للمستقبل. ولكن رغم كل الخيبات، يقول الواقع السوري إن هذه الدولة انتقلت من مرحلة النظام المستبد إلى الدولة المحتلة، ولا بدّ بعد كل احتلال أن يأتي التحرير والاستقلال، خاصة أن مبررات الثورة لا تزال حاضرة، وعلى الرغم من كل ما أتيح للنظام من دعم فهو عاجز عن الحفاظ على نفسه وبقائه.
تلفزيون سوريا
———————-
في بلاغة المقارنة بين الأسد وفيروس كورونا/ علي سفر
ليس ترفاً أو “فضاوة بال” أن يقوم سوريون بتشبيه فيروس كورونا (كوفيد 19) برأس النظام بشار الأسد! فقد فعل الفيروس بالبشر خلال مدة وجيزة لجهة القتل وتعطيل الحياة ومنع التواصل، شيئاً مشابهاً لما فعله ديكتاتور سوريا وداعموه بالشعب السوري، لهذا فإنه من الطبيعي أن يجد هؤلاء في قصة الفيروس مناسبة لإعادة الحديث عن مآسيهم، وإن بشكل ساخر.
المقارنة بين فيروس كورونا وبين الأسد تبدو إلى الآن غير متكافئة بين المُشبه وبين المُشبه به، فالأول عرضي وطارئ، بينما الثاني مُؤسس له ويمارس أفعاله عبر سبق إصرار وترصد!
كما أن سياق الإجراءات العالمية حيال الفيروس مازال حتى اللحظة يحاذر المساس بالقيم الديموقراطية، فقد فرض انتشار فيروس كورونا على الناس حول العالم حالياً القيام بعزل تطوعي لمحاصرة انتشاره، تحول مع الوقت ومع تراخي الغالبية في تطبيق الإجراءات إلى عزل إجباري ملزم بقوة عربات الجيوش ورجال الشرطة الذين باتوا حاضرين عند محطات النقل في المدن الأوروبية!
وقد كتب كثيرون عن أن ما يفرضه حضور الفيروس والإجراءات المضادة له بات يهدد مدنية المجتمعات المتحضرة، ولاسيما جزئية الحريات فيها، لهذا تجد الرئيس الفرنسي ماكرون ومثله عدد من زعماء العالم يتحدثون عن إجراءات الحماية عبر فرض الطوارئ، دون استخدام عبارات القسر والزجر الفاقعة، رغم الإشارة إلى أن الفرنسيين الآن باتوا في حالة حرب!
السوريون الذين تابعوا ردود فعل الأوربيين الذين أصيبوا بالهلع فسارعوا إلى المتاجر للتبضع بشكل محموم، سخروا في تعليقاتهم من الأمر وضاهى بعضهم بين حالتهم كشعب منكوب بحاكم قاتل، قام بذبح وتجويع وتشريد مواطنيه، وبين تعاطي الحكومات الأوروبية مع مواطنيها!
وفي المحصلة كانت هذه المقاربة تقودهم للسخرية من حالهم وواقعهم عبر استدعاء صورة الأسد بالتقابل مع صورة الفيروس!
المقارنة الساخرة مسألة تتعدى حقاً أغنية طريفة أو صورة كوميدية هنا أو منشور على فيس بوك هناك. إنها في جوهرها محاولة جدية عبر أدوات بلاغية لإيصال رسالة للعالم؛ أي لمن هم خارج حدود المذبحة السورية، لتنبيههم إلى أننا عشنا ومازلنا نعيش ما تقاسونه حالياً بسبب فيروس كورونا، ولكن بفارق وحيزٍ زمني مدته تسع سنوات ممتلئة بموت وآلام واعتقال وتهجير ونزوح ولجوء مستمرين دون توقف!
سابقاً كان الممانعون العرب مؤيدو نظام الأسد يأخذون على السوريين الثائرين أنهم قالوا في سياق غضبهم من هول ما يتعرضون له من جرائم؛ إن إسرائيل أفضل من نظام الأسد! ولكن ما لم يستوعبه هؤلاء المعترضون أن البلاغة تقتضي مقارنة الأسوأ المحكي عنه لتثقيل حجم أفعاله السيئة في عقول من يستمعون، بمن هو أشد سوءاً منه، وبموجب هذه الآلية العفوية في التفكير يصبح نظام الأسد أشد قبحاً وإجراماً من إسرائيل القبيحة والمجرمة، وبهذا يذهب النبض العفوي إلى عدم منح البراءة للاثنين من دم السوريين والفلسطينيين!
البلاغة هي الأداة اللغوية الأهم في سياق المرافعات والمجادلات وغير ذلك من نصوص متداولة بين البشر، واللجوء لألعاب التشابيه اللغوية كان في العصور الماضية السبيل الأساسي لإضفاء أقصى معاني التهويل ضمن سياق توصيل الرسائل بين البشر، طالما أن الأخبار تنتقل عبر اللغة، وكذلك يقوم على عاتقها كل تواصل ممكن بين الناس!
ولكن وبعد كل هذا الاجتهاد هل كانت هذه الرسائل البليغة تصل للمرسل إليه؟
أم أنها كانت تضيع في ضباب صنعته بعض وسائل الميديا التي تواطأت مع المجرمين القتلة ضد أحلام وطموحات السوريين، فغرزت فيها فزاعات وأشباح داعش والنصرة المخيفة والمرعبة للعالم كله بعد تاريخ دموي صنعه الجهاديون حول العالم وتعامت عن وجه حقيقي مختلف للثورة صنعه ثوارها الأوائل!
من المؤسف أن السوريين وبعد تسع سنوات من قيام ثورتهم، التي تداعت قوى عالمية وإقليمية ومحلية لمنع نجاحها، إضافة إلى ظروف الصراع المحلية ونشوء التيارات المتطرفة التي حرفت
من جرب كارثة حكم عائلة الأسد بالتأكيد لن يقلل من مآسي الآخرين! فهل تبقى رسائل السوريين ضائعة، وهل يبقى العالم أصم وأعمى وأخرس عن مآسيهم؟!
مساراته، باتوا منسيين بأحلامهم وطموحاتهم، لا يتم تذكر أحوالهم إلا حين يتم التفكير بأخطار لجوئهم إلى الدول الأخرى! ما يؤشر فعلياً إلى أن أياً من الرسائل التي اشتغلوا عليها وأرسلوها إلى العالم كله لم تصل أبداً، بدليل أن كارثتهم مستمرة، ويتم إذكاء نيرانها بدعم من روسيا وإيران وصمت دولي فادح عن جرائم النظام، يقزم المأساة إلى أزمة لجوء ولاجئين!
المقارنات الساخرة لدى السوريين لم تر في كارثة فيروس كورونا مجرد قصة مرض ومرضى، بل إنها تشير إلى تحسسهم للخطر الكبير الذي يكتنف انتشار العدوى بين البشر، فهي تهدد وجود الجميع، كما هدد ويهدد استمرار حكم الأسد لسوريا كينونة وحياة السوريين، وهم بهذا يتقدمون من حيث الالتقاطة الإنسانية على غيرهم!
فمن جرب كارثة حكم عائلة الأسد بالتأكيد لن يقلل من مآسي الآخرين! فهل تبقى رسائل السوريين ضائعة، وهل يبقى العالم أصم وأعمى وأخرس عن مآسيهم؟!
تلفزيون سوريا
————————-
ببيان مشترك من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا بشأن الذكرى التاسعة لانطلاق الثورة السورية.
منذ تسع سنوات، خرج عشرات الآلاف من السوريين بسلام إلى الشوارع مطالبين باحترام حقوق الإنسان وإنهاء فساد الحكومة. بدلاً من الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب السوري، رد نظام الأسد بحملة لا هوادة فيها من الاعتقالات التعسفية والاحتجاز والتعذيب والاختفاء القسري والعنف.
مع دخول الصراع السوري عامه العاشر، أدى سعي نظام الأسد الوحشي إلى تحقيق نصر عسكري إلى نزوح أكثر من 11 مليون شخص – ما يقرب من نصف سكان سوريا قبل الحرب – وقتل أكثر من 500000 سوري.
يجب أن يقبل نظام الأسد إرادة الشعب السوري الذي يطالب ويستحق العيش بسلام وخالي من القصف، والهجمات بالأسلحة الكيماوية، والبراميل المتفجرة، والغارات الجوية، والاحتجاز التعسفي، والتعذيب، والمجاعة.
نعرب عن ارتياحنا للتحرير الذي تم من قبل التحالف العالمي والقوى الديمقراطية السورية لجميع الأراضي التي كانت تسيطر عليها داعش.
لكن التهديد من داعش باق، ونحن عازمون على مواصلة جهودنا المشتركة من خلال التحالف لضمان هزيمتهم الدائمة.
نحن نحارب الإرهاب بتصميم ونكون في الخطوط الأمامية للقتال.
لكن مكافحة الإرهاب لا يمكنها ويجب ألا تبرر الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي أو استمرار العنف.
إن الهجوم العسكري المتهور من قبل الأسد وروسيا وإيران في إدلب يسبب المزيد من المعاناة وأزمة إنسانية غير مسبوقة، حيث يتم قتل البنى التحتية الطبية والإنسانية والعاملين، وكذلك المدنيين.
في آخر هجوم دموي على إدلب، قام نظام الأسد، بدعم من روسيا وإيران، بتهجير ما يقرب من مليون مدني منذ ديسمبر / كانون الأول وحده، وهو أسرع نزوح منذ بداية الصراع.
لكي يستمر أحدث وقف لإطلاق النار في شمال غرب سوريا، يجب تأسيس وقف إطلاق نار على الصعيد الوطني على النحو المطلوب في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254.
على الرغم من الجهود الكبيرة التي يبذلها المجتمع الدولي، لا تزال المساعدة المنقذة للحياة لا تصل إلى أعداد كبيرة من أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها.
بصفتنا مانحين رئيسيين منذ بداية الحرب، سنستمر في دعم المساعدة الإنسانية للشعب السوري، بما في ذلك من خلال المساعدة عبر الحدود التي تعد ضرورة حيوية، ونطالب جميع الأطراف، وخاصة النظام السوري وحلفائه، بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى جميع المحتاجين في سوريا.
ومع ذلك، لن نفكر في تقديم أو دعم أي مساعدة لإعادة الإعمار حتى يتم إجراء عملية سياسية حقيقية وموثوقة وحقيقية بشكل لا رجعة فيه.
في غياب مثل هذه العملية، فإن المساعدة في إعادة الإعمار لسوريا لن تؤدي إلا إلى ترسيخ حكومة معيبة ومسيئة للغاية، وزيادة الفساد، وتعزيز اقتصاد الحرب وزيادة تفاقم الأسباب الجذرية للصراع.
نشجع المجتمع الدولي على الاستمرار في تقديم المساعدة لجيران سوريا لمشاركة تكاليف أزمة اللاجئين السوريين.
يجب السماح للسوريين النازحين بالعودة الطوعية والآمنة إلى منازلهم، دون خوف من الاعتقال التعسفي وانتهاك الحقوق والتجنيد الإجباري.
ومع ذلك، يواصل النظام السوري منعهم من القيام بذلك.
سنستمر في المطالبة بالمساءلة عن الفظائع التي ارتكبها نظام الأسد وسنواصل جهودنا للتأكد من تحديد المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات والتجاوزات ومحاسبتهم.
يجب أن يتعاون المجتمع الدولي لدعم جمع ونشر وثائق انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك العمل الحاسم للجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة؛ آلية الأمم المتحدة الدولية والنزيهة والمستقلة لسوريا ؛ ومجلس التحقيق التابع للأمين العام للأمم المتحدة.
الحل العسكري الذي يأمل النظام السوري في تحقيقه، بدعم من روسيا وإيران، لن يجلب السلام.
نكرر دعمنا القوي للعملية التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف وقرار مجلس الأمن الدولي 2254 من أجل إقامة سوريا سلمية ومستقرة.
نحن – فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة – نطالب نظام الأسد بوقف القتل الوحشي والانخراط بشكل هادف في جميع جوانب قرار مجلس الأمن 2254، بما في ذلك وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، والدستور المعدل، والإفراج عن الأشخاص المحتجزين تعسفاً، وكذلك انتخابات حرة ونزيهة.
لا يمكن أن تقتصر عملية سياسية ذات مصداقية على محاولات عقد لجنة دستورية.
يجب السماح لجميع المواطنين السوريين، بمن فيهم المواطنون النازحون واللاجئون، بالمشاركة في انتخابات حرة ونزيهة، تحت إشراف الأمم المتحدة.
The text of the following statement was released by the Governments of France, Germany, the United Kingdom, and the United States. Begin Text: Nine years ago today, tens of thousands of Syrians peacefully took to the streets calling for respect for human rights and the end of government
——————————–
===========================
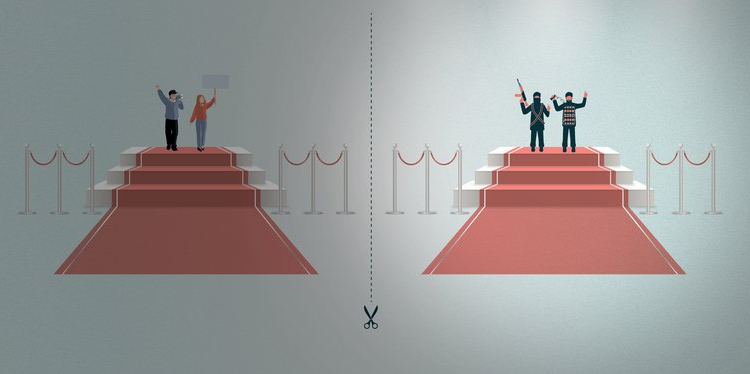
============================
تحديث 21 أذار 2020
——————————–
الثورة والدولة.. مقاربة نقدية بين اللغة والسياسة/ ماهر مسعود
بعد تسع سنوات على بداية الثورة السورية، لم تعد الانقسامات المتعلقة بالثورة تتوقف على التسمية؛ مع أن التسمية هي المنظور الذي يقود إلى رؤية الواقع وهي الحكم العقلي/النظري الذي يوجه أفعالنا، بل باتت انقسامات هيكلية طالت بنية الدولة ذاتها، وغيرت بنية المجتمع السوري، انقسامات اجتماعية وسياسية وثقافية لابد من رؤيتها عند التفكير بمستقبل سوريا..
الثورة..
إحدى أهم النتائج التي خرج بها الفيلسوف الفرنسي جاك ديريدا في كتاباته حول فلسفة اللغة، ولاسيما في كتابه “of grammatology” والذي تمت ترجمته بعنوان “في علم الكتابة”، هي أنه ليس هناك معانٍ أصيلة وثابتة للكلمات أو المفاهيم اللغوية، بل إن معاني الكلمات تتغير في صيرورة الزمن وعبر التاريخ، تاريخها، وتفارق بذلك معناها الأصلي لتكتسب معان جديدة، وهذا ما يسميه ديريدا diachronic meaning of the word، من جهة ثانية فإن كل كلمة تأخذ معناها أفقياً من علاقتها الحالية/المتزامنة مع غيرها من الكلمات ضمن بنية اللغة، وهذا ما يسميه synchronic meaning of the word، فلكي نشرح معنى أي كلمة شفاهية أو في القواميس، نستخدم كلمات أخرى لشرح وفهم تلك الكلمة.
عبر تلك الرؤية التي تبدو معقدة للوهلة الأولى، أراد ديريدا التأكيد على مسألتين: الأولى هي أنه ليس هناك معنى أصلي، مُنزل أو مكتوب في “اللوح المحفوظ” لمفاهيم اللغة التي نستخدمها في الكتابة والكلام، بل إن المعنى ذاته ينمو ويتغير ويتحول وقد يموت إن لم يتجدد. وبتطبيق هذا الأمر على مصطلح “الثورة” الذي يعنينا في الحالة السورية، نجد أن الخلافات حول التسمية فيما إذا كانت ثورة أو أزمة أو حرب أهلية، تعود منذ تسع سنوات إلى معيار متعالٍ للقياس “لوح محفوظ”، فمثلاً يتم وضع الثورة الفرنسية كمعيار أعلى للقياس والحكم، وبالتالي يصبح مدى انطباق الثورة السورية مع ذلك المعيار المثالي الأعلى هو المقياس، وتكون النتيجة دائماً أنه لا ينطبق، فإذاً هي ليست ثورة. هذا المقياس فاسد تماماً استناداً إلى رؤية ديريدا، فالثورة السورية أضافت جديداً لمصطلح الثورة لا يمكن فهمه إذا توقفنا عند المعيار القديم الذي أنتجته الثورة الفرنسية، وذلك الجديد مرتبط بالتاريخ والتحول التاريخي للكلمة، وما يجب عمله هو إضافة ذلك الجديد للمصطلح القديم لفهم ما يجري بطرق جديدة ودمجها في معنى مصطلح “الثورة”.
المسألة الثانية والأهم التي يحيل إليها منطق ديريدا، هي أن المعنى نفسه هو مسألة صراعية، ومرتبطة بالقصة والسرد “Narrative” حيث تتنافس مجموعة روايات/سرديات متزامنة حول المفهوم نفسه لتفوز واحدة بالمعنى ضمن ذلك الصراع، وبتطبيق ذلك على مصطلح الثورة، سنجد أن جميع المحاولات الثقافية؛ إن كانت من قبل مثقفين محسوبين على الثورة، أو من قبل النظام أو حتى الإعلام العالمي، تصب في الصراع على استحقاق كلمة ثورة فيما يخص الأحداث في سوريا، وهنا يفيدنا رولان بارت في المسألة، حيث يعتبر بارت أن كل صراع لغوي هو في المحصلة صراع سياسي وأيديولوجي، وبكلمات أخرى يتم ببساطة الانتقال من “السيميولوجيا” إلى “الأيديولوجيا”، حيث هناك هدف أيديولوجي واعٍ أو غير واعٍ، خلف كل من يريد تسمية الثورة بأزمة مثلاً أو حرب أهلية، لكي يتعامل معها أخلاقياً وقانونياً وعملياً بطريقة مختلفة، ولذلك فالصراع على الاسم هو صراع سياسي قبل أن يكون صراع لغوي، وهذا ما يعطي صراع أبناء الثورة على تسمية ثورتهم باسمها معنىً أكبر بكثير من مجرّد كونه صراع بسيط على الكلمات، وهذا أيضاً ما يمسُّ استراتيجياً مستقبل سوريا عندما يريد شعبها النظر فيما حصل وتعريفه وتسجيله في التاريخ السوري، ثم تعليم الأجيال القادمة من خلاله.
الدولة..
لم تكن الدولة السورية قبل الثورة دولة بالمعنى الحديث للكلمة، لم تكن دولة رفاه، طبعاً، ولا دولة حيادية، ولا حتى دولة رعاية بالمعنى التقليدي، بل كانت مُبتَلعة من قبل النظام السياسي الحاكم منذ عام 1970، وهذا ما يفسر سهولة انهيار الدولة مع بقاء النظام السياسي الذي ابتلعها وسيطر عليها. ولا يبدو هذا الأمر غريباً في السياق العربي حيث عمل الميكانيزم ذاته في دول عربية أخرى، مثل ليبيا واليمن وحتى العراق، التي لم تتخلى أنظمتها الديكتاتورية عن الحكم إلا بعد الانهيار شبه المطلق للدولة وتحولها إلى دول فاشلة، نتيجة ذلك الربط الكامل بين الدولة والنظام وابتلاع النظام في المحصلة للدولة.
يعتبر ماكس فيبر أن الدولة بالتعريف هي “المُحتكر الشرعي للعنف”، وهو يؤسس تلك الرؤية على تصوّر توماس هوبز للعقد الاجتماعي الذي قامت عليه الدولة الحديثة، حيث يتخلى الأفراد عن بعض حقوقهم وحرياتهم ويدفعون الضرائب، مقابل تأمين حمايتهم وأمنهم عبر القانون الذي اختاروه لأنفسهم بالتعاقد، وذلك حسب هوبز لكي لا نعود إلى “الحالة الطبيعية” التي يقتل فيها الجميع الجميع، ويضطر كل شخص لحماية نفسه بنفسه ضد الآخرين. لكن ما حصل فيما يخص الدولة السورية هو أن احتكار الدولة للعنف لم يتضمن الجزء المتمم له، وهو الأهم، أي أن يكون العنف شرعياً، بمعنى قوننته وانطباقه على جميع الأفراد، بل إن السلطة التنفيذية التي كانت تنفذ العنف والعقوبات في سوريا، أي أجهزة الأمن والشرطة، لم تكن تلقي بالاً إلى السلطة القضائية، إنما كانت أعلى واقعياً من السلطة القضائية، وبعيداً عن الفساد المستشري في كلا السلطتين وعدم استقلال القضاء، كان الامتياز وحصانة أجهزة الأمن والاستثناء في تطبيق العنف تبعاً للواسطة أو الخلفية الطائفية أو الغنى والفقر..الخ، كافياً ليقوّض بشكل كامل الشرعية المفترضة للعنف التي تحدث عنها ماكس فيبر. بالإضافة إلى أن السلطة التشريعية ذاتها لم تكن سلطة منتخبة ديمقراطياً؛ وهو الشرط اللازم لشرعيتها، بل سلطة معينة تعييناً من الأعلى بما يتناسب مع طبيعة النظام السياسي الذي احتل السلطة احتلالاً عبر الانقلاب العسكري وليس عبر الاقتراع الديمقراطي التمثيلي.
الأمر ذاته حصل فيما يخص العقد الاجتماعي الهوبزي، فقد أخذت الدولة السورية الجزء الأول من العقد، وهو تخلي الأفراد عن بعض حقوقهم وحرياتهم، وحولته إلى تخليهم عن مجمل حقوقهم الأساسية وحرياتهم السياسية دون مقابل تقريباً، أي دون تأمين حمايتهم ولا ضمان أمنهم وحقوقهم، بل إن الدولة كانت هي المهدد الأساسي لأمن الأفراد والأكثر فشلاً في حمايتهم. المؤسسة العسكرية التي يفترض أن تحمي حدودهم تفرغت لقتلهم بعد أربعين عام من تجهيزها وتمويلها على حسابهم، والسلطة الأمنية التي يفترض أن تحمي أمنهم كانت هي المهدد الأساسي لأمنهم والمنتهك الأساسي لحقوقهم وبيوتهم وكرامتهم، وليس من فراغ أن اخترع السوريون تلك السخرية السوداء عندما كانوا يقولون مثلاً أن “الشعب في خدمة الشرطة” قلباً للشعار الشهير الذي تستخدمه وزارة الداخلية رأساً على عقب.
بعد الثورة فقد النظام السوري سيطرته على دولته التي ابتلعها، فخسر الحدود واحتكار السلاح؛ وبالتالي احتكار العنف، ثم فقد السيادة الوطنية واحتكار الثروة بعد أن أصبحت سوريا محتلة من محتلين “شرعيين” هما إيران وروسيا، وآخرين “غير شرعيين” هما أمريكا وتركيا، وجميعهم يقاسمونها كل ما سبق ذكره، أي الحدود والسلاح والثروة والسيادة.
بعد الثورة أيضاً تحولت الدولة الأمنية التي شكلها نظام الأسد إلى دولة عنف محض، ثم تحولت دولة العنف المحض إلى “لا دولة” بعد انتشار السلاح وفقدان القرار الوطني والسيطرة على الحدود وتهجير الملايين من بيوتهم، لتصبح دولة النظام هي جزء من عدة دول تتقاسم سوريا واقعياً بالتعاون مع القوى المحلية التابعة لتلك الدول، وبات النظام ذاته مجرد قوّة محلية أخرى تابعة لدول خارجية، مثله مثل القوى الإسلامية أو الكردية بغض النظر عن حجم الأرض التي يسيطر عليها بالقياس للقوى الأخرى، وبغض النظر عن الشرعية الشكلية والوظيفية التي ما زال يحوزها في الأمم المتحدة (مع أن تلك الشرعية ذاتها تساوت مع شرعية المعارضة عندما تعلق الأمر باللجنة الدستورية التي يفترض أن تكتب الدستور المستقبلي لسوريا). ومن يظن أن تلك الدول المتدخّلة والمتداخلة في سوريا ستخرج كيفياً ليس سوى واهم، فالمسألة لم تعد تتعلق بالدولة السورية ذاتها بقدر ارتباطها بالأمن القومي لتلك الدول، إن كان فيما يخص تركيا أو إيران أو روسيا أو أمريكا، تلك الأخيرة التي تربط وجودها في شرق سوريا بالأمن القومي الإسرائيلي ومنع إيران من استكمال مشروعها الإقليمي.
في المحصلة، إن حالة اللا دولة، الموازية لحالة “عدة دول في دولة واحدة”، رأيناها سابقاً بطرق مختلفة في التجربة اللبنانية المستمرة حتى اليوم، والتي يتقاسم قرارها الوطني عدة دول خارجية بالتقابل مع عدة قوى محلية تابعة، وهذا النموذج الذي يبدو هو الأقرب فيما يخص مستقبل الدولة السورية، ما زال هو ذاته بعيداً عن التحقق نتيجة انعدام التوازن بين القوى الدولية المتدخلة والأوهام الروسية الإيرانية بحسم الصراع عسكرياً.
إن الحقبة الحالية التي تعيشها سوريا هي الحقبة الفاصلة بين نهاية الدولة المركزية اللاشرعية، إلى غير رجعة، وبداية الدولة اللامركزية التي لا يمكن إقرارها أو الوصول إليها قبل إنجاز التفاهمات الدولية وتثبيتها على الأرض وفي الدستور، ربما على غرار اتفاقية يالطا التي تمّ عبرها تقسيم ألمانيا عام 1945، تحت “وصاية” ورعاية أمريكا والاتحاد السوفييتي وبريطانيا، وهو ما يبدو أيضاً بعيد المنال ولا يُتوقّع حدوثه في المستقبل القريب.
بروكار برس
—————————-
إلى عمار ديوب: ما هكذا تورد الإبل/ علي العبدالله
انطوى نقد الكاتب عمار ديوب للتعقيب الذي كتبته على مقالة الأكاديمي برهان غليون (في نقد “نقد طفولتنا السياسية”، العربي الجديد:2/3/2020) على أحكام متسرعة وغير مدروسة، ما استدعى هذا التوضيح.
1- في تعليقه على قولي “ما زال مجتمعنا، في العمق، يراوح عند مرحلة الانتقال من النظام السلطاني، بتجسّده الأخير: السلطنة العثمانية، إلى نظام الدولة – الأمة، الدولة الوطنية” وضع بعد كلمة العمق معترضتين، بينهما عبارة بعدها علامة تعجب “لاحظ العمق التاريخي الذي لا يطرأ عليه أي تغييرٍ!”، مع أن قولي لا يشير إلى عمق تاريخي، وإنما يشير إلى الجوهر الذي خلف المظهر، كالذي عكسه قول الفيلسوف اليوناني سقراط، عندما قابل في السوق رجلا ضخما حسن المظهر جميل الثياب، فقال له: “يا هذا تكلم حتى أراك”، فالعمق في قولي يتعلق بما وراء موقف المجتمع السوري من الدولة الحديثة الذي يعيش في ظلها، ظاهريا، وعقله ووجدانه متعلق بسواها، جوهريا؛ فحاله كحال طالب محمد عابد الجابري الذي نقل معاناته له بقوله :”أنا في الجامعة متحرّر أرقص وأغني وأتعاطى الكحول، والماريجوانا أحيانا، وفي البيت والحي مسلم محافظ؛ وقد تعبت من هذه الازدواجية”. تابع، عمار، معلقا “وأين الخطأ في إظهار مشكلة غياب “الدولة الأمة” مشكلةً حقيقيّة لدى العرب؟.”، مع أن قولي ليس فيه تحفظ على إظهار مشكلة غياب الدولة الأمة؛ وأن ملاحظتي تتعلق بعدم تحول القبول بها إلى موقف شعبي راسخ، فأغلبية المجتمع السوري، كما أرى، واقفة على التخوم بين الدولة السلطانية والدولة – الأمة.
2- علق على قولي “فشعارات المواطنة والدولة المدنية التعدّدية شعارات نخبوية تتبنّاها قوى سياسية واجتماعية صغيرة، مدينية في الغالب”، بقوله: “ليس صحيحاً أن الوعي المدني (دولة مدنية) يخص جماعاتٍ صغيرة”، من دون أن يقدم دليلا أو مؤشرا على هذا الحكم. هل ثمّة إحصاء أو استطلاع رأي يؤكد هذا الحكم الجازم؟ مع أن الواقع السوري يقول بعكس ذلك عمليا من خلال عدم استجابة المواطنين لدعوات الأحزاب اليسارية والديمقراطية للانضمام إلى صفوفها أو المشاركة في نشاطاتها العامة، حيث لم ينجح أي منها بالتحوّل إلى حزب جماهيري واسع الانتشار راسخ القواعد. فـ “ما زال التوجه الحديث نخبويا لم يخترق التشكيلات الاجتماعية الشعبية، ويقنعها بصلاحيته لحل مشكلاتها المادية والروحية”.. و”لم تدخل كل القيم والتصورات والمحدّدات الحديثة في صميم قناعة القوى الشعبية العريضة، ولم تلامس وعيها، وتغير من طبيعة مخيالها السياسي والاجتماعي”، كما جاء في تعقيبي على برهان غليون.
3- استغرب نقدي المعارضة الديمقراطية، واعتبره دفاعا عن القوى الإسلامية. ورأى في ذلك خطأ. كتب: “يؤكد العبدالله، في رّده على غليون، حق الإسلاميين في الاختلاف بالمنظور السياسي، وهذا ما لا يرفضه غليون، وإن انتقد السلفية بصورة خاصة. وبالتالي، لماذا يدافع العبدالله عن قضية خاطئة، وقد انتقد الإسلاميين، ورؤيتهم الطائفية والفئوية في الثورة السورية في مقالاتٍ كثيرة؟”. أولا، لم أتحدث عن الاختلاف السياسي، بل عن “حق كل جهة سياسية في العمل على فرض رؤيتها وخيارها في إطار صراع الأفكار والبرامج”، وهذا غير ذاك. وركزت نقدي على المعارضة الديمقراطية، لأن دعوة غليون موجهةٌ إليها، فهي فرس الرهان، ما استدعى نقدها وكشف نقاط ضعفها ومطالبتها بالعمل على التخلص من هذا الضعف، حتى تكون قادرة على القيام بالمهمة المطلوبة. أما تساؤله “لماذا يدافع العبدالله عن قضية خاطئة”، فمستغرب، ما هي القضية الخاطئة التي دافعت عنها وأين هو هذا الدفاع؟ لقد رفضت موقف المعارضة الديمقراطية التي تسعى إلى ستر فشلها بإلقاء اللوم على الآخرين من دون أن تواجه ذاتها وتقوّم ممارستها، “لم تستطع المعارضة الديمقراطية لعب دور وازن في الثورة، لهشاشة تكوينها، من جهة، ولافتقارها للعمق الشعبي من جهة ثانية”. وفسّرت نجاح حركات الإسلام السياسي في تصدر المشهد، وربطته بجملة أسباب: “وارتباط ما حصل (تصدّر حركات الإسلام السياسي المشهد)، بأسباب كثيرة من قدرات سياسية وتنظيمية واستعدادات فردية ودعم خارجي كبير من قوى إسلامية، قريبة أو مماثلة، ومن دول لا تريد نجاح تجربة سياسية بإرادة شعبية. صحيحٌ أنها ارتكبت كبائر سياسية وتنظيمية ومالية، خصوصا “داعش” وسلوكه المتوحش وجرائمه بحق المدنيين العزّل … الخ”. فهل في هذا دفاعٌ عن هذه الحركات؟ إنه وصف لما حصل، وفيه نقد لها “ارتكبت كبائر سياسية وتنظيمية ومالية”.
4- كتب في فقرة أخرى “يركز علي العبدالله على شكل الوعي السوري، ويراه “في العمق” شكلاً دينياً، وأن الدين ما زال “المحرّك الطبيعي للسياسة” في مواجهة “الحكومات الاستبدادية العلمانية”. لن أجادل بأن ذلك ليس صحيحاً من أصله؛ فهناك بيئاتٌ اجتماعيةٌ وعيها ديني. ولكن، وعكس ذلك، الثورات العربية، وإن كان الوعي الديني منطلقاً لبعض قطاعاتها المجتمعية، فهو لم يكن سبباً في حدوث الثورة”. عجيب تسرّع عمار بالجزم “لن أجادل بأن ذلك ليس صحيحاً من أصله”، والأعجب طرحه أحكاما تحتاج إلى أدلة ملموسة، مثل قوله “وإن كان الوعي الديني منطلقاً لبعض قطاعاتها المجتمعية”، هل هي “بعض” حقا أم أغلبية؟ ونقله الحوار بعيدا عن الفكرة “فهو لم يكن سبباً في حدوث الثورة”. كان كلامي عن الإسلام ودوره في تكويننا السياسي والاجتماعي، وما منحه لحركات الإسلام السياسي من أفضليةٍ على صعيد الاستقطاب والحشد الجماهيري، لم أربط بين الثورات والوعي الديني، بل بين نجاح حركات الإسلام السياسي في الاستقطاب والتحشيد وهذا الوعي، وفشل المعارضة الديمقراطية في ذلك. قلت: “لكن السبب الرئيس لخسارة المعارضة الديمقراطية، برأيي، وجود هوةٍ واسعةٍ بين حواضن الثورة ورؤية المعارضة الديمقراطية السياسية والاجتماعية، وفشل الأخيرة في جسر هذه الهوة”، و”تركها الإسلام لحركات الإسلام السياسي توظفه في معاركها الفكرية والسياسية، فتفوز بالشعبية، وبتحشيد القوى الاجتماعية حول شعاراتها وأهدافها”… “لقد أخطأت المعارضة الديمقراطية بتجاهل هذا الاستحقاق، مع ما للإسلام من موقع مركزي ودور في تكوين شخصية السوري، وانطوائه على طاقة ثورية عظيمة، ودفع قوي للتضحية في سبيل العقيدة والقيم الأخلاقية”، ودعوتها إلى “العمل على جسر الهوة مع الرؤى والقناعات الشعبية، بالبحث عن تقاطعاتٍ، وطرح تأويلاتٍ وحلولٍ وسط تجعل الرؤى والخيارات الحديثة قريبةً من المزاج العام”. كتب في فقرة أخرى “أتفق مع العبدالله على أن شكل الوعي لم يتغيّر كثيراً، ولكن هذا لا يتعلق بالماضي، ولا بالدين، ولا بأن الدين ما زال يشكل مخيال المسلمين، منذ وجد الإسلام. ويتعلق الأمر بالقوى التي تخوض الصراع السياسي والاجتماعي، وقبل الثورة بالنظام وبعده بالنظام والمعارضة وبالفاعلين الثقافيين بكل تنويعاتهم”. لم يكن كلامي عن المسؤولية، بل عن موقع الإسلام في وعي السوريين ووجدانهم، توصيف الواقع بدقة كي يكون قاعدة لتحرك واقعي، وهذا ينطبق على معظم العرب والمسلمين، نحن “نعيش في مجتمع ثقافي وفكري ديني بامتياز، يتجلى ذلك في علاقاتنا مع الآخر، مع المختلف، مع الثقافة، مع الفكر، مع العلم، مع التربية، ومع السياسة، كل شيء نفسره بالدين ونحيله إلى الديني، نفضله ونتعاطف معه لأن فيه رائحة الدين ونرفضه ونعاديه لأن فيه سؤال العقل، نتعاطف مع رجل الدين حتى ولو كان على خطأ، ونحاسب الفيلسوف العقلاني، حتى ولو كان على حق”، وفق الكاتب الجزائري اليساري أمين الزاوي. أضاف عمار ديوب “لا يمكن إعطاء أهمية كبيرة للوعي التقليدي، وأنّه ما زال يتمحور حول هذا الصحابي أو ذاك، أو حول هذا الزعيم الديني أو ذاك، ولو كان فعلاً يتمحور حولهم، فإن ذلك لا يتعلق بهم. لا، فهذه الاستعادة تتعلق بالفاعلين في الحاضر، أنظمة وقوى إسلامية وتيارات فكرية، وهي تستثمر في التديّن والتطييف.”. دعوة عجيبة أن يطلب الكاتب عدم إعطاء أهمية للوعي التقليدي، مع أنه الغالب بين السوريين، وأن تجاهله سيجعل أي تقدم على طريق التغيير غير ممكن؛ علما أن التغيير لا يكون حقيقيا من دون تفاعل القوى الشعبية ومشاركتها، وإلا كان تغييرا سطحيا قابلا للانهيار في أي مواجهة مع الخصوم والأعداء.
5- علق عمار على دعوتي إلى جسر الهوة بين المعارضة الديمقراطية والقناعات الشعبية، قائلا: “ولكن ما هو غير دقيق ردّ الفشل، ولنقل مشكلات الثورة وتعقيدات مآلاتها ومآلات سورية إلى عدم تبصّر المعارضة الديمقراطية لروح الشعب (الإسلام)، وأن مشكلة المعارضة تكمن هنا! وقد أوضحت أن ثورات الموجة الثانية كانت بالضد من الإسلاميين، ولم يكن لديها مشكلة مع الإسلام، وأن أهدافها تمحورت حول الديمقراطية والمدنية والعلمانية، والخروج من الأزمة الاقتصادية، وتأمين فرص عمل وهكذا”. هنا أيضا خلط وعدم تمييز بين الإسلام دينا وثقافة اجتماعية وحركات الإسلام السياسي، فما قلته فشل المعارضة الديمقراطية لافتقارها العمق الشعبي وتجاهلها الهوة التي تفصلها عن القاعدة الشعبية ذات الثقافة والخيارات الإسلامية، من جهة، وأن هذا مختلف عن كون الثورات ضد الإسلاميين، من جهة ثانية، لأن كون الثورات ضد الإسلاميين، إن كانت كذلك، لا يلغي ضرورة جسر الهوة والتعاطي مع الإسلام الدين والثقافة بما يليق بمكانته بين الناس، وعدم تركه للحركات الإسلامية المنغلقة والمتطرّفة، توظفه في سعيها إلى كسب تأييد المواطنين وحشدهم في معاركها السياسية والاجتماعية.
وكتب في فقرة أخرى “بل أوضحت الثورات، في موجاتها الثانية، طبيعة الموجة الأولى، وهي ضد الأسلمة بالكامل، وضد حكوماتٍ كانت تدّعي الأسلمة “العراق، السودان، لبنان، ولديك إيران”. قول عجيب كيف توضح الموجة الثانية طبيعة الموجة الأولى، مع أنها وقعت في دول أخرى، وضد أنظمة مختلفة، واحتجاجا على مشكلات مختلفة، بقوى سياسية واجتماعية مختلفة. ثم كيف تبين أنها ضد الأسلمة، كما أن نظامي العراق ولبنان لم يتبنيا الأسلمة، الواقع أنها لم تقل أنها ضد الأسلمة، بل ضد الاستبداد والفساد الذي تمارسه أنظمة ترفع شعار الإسلام، وتتصرف عكسه في معظم القضايا ما جعلها منبوذة حتى من الإسلاميين، حزب المؤتمر الشعبي العربي الإسلامي، حزب حسن الترابي، وحزب الأمة، حزب الصادق المهدي، وحزب الإخوان الجمهوريون، حزب الشهيد محمود طه، أحزاب إسلامية، وقفت ضد نظام عمر البشير.
6- علق عمار ديوب على قولي إن معظم المعارضة الديمقراطية “كانت يسارية”، قائلا “والتي يسميها العبدالله خطأ يساريّة” هي معارضة ليبرالية، علما أن ليس في سورية أحزاب ليبرالية، والتي أعلنت أنها ديمقراطية في العقدين الأخيرين جاءت من صفوف اليسار، وقد ميّزت بين اليسارية والديمقراطية في فقرة أخرى، عندما قلت: “كرر الكاتب، غليون، موقفا تبنّته المعارضة اليسارية والديمقراطية”، لأن ثمّة أحزابا تمسّكت بموقفها اليساري القديم، مثل حزب العمل الشيوعي.
7- اعتبر قولي “ثمّة واقع جديد يحتاج إلى مواجهة ومعالجة، نجاح النظام في دفع أغلبية الشعب السوري إلى الانغماس في همومه الخاصة، والتفكير في ظروفه المباشرة، ما جعل ويجعل محاولات الثورة والتغيير حرثاً في بحر”، اعتبره موقفاً يائساً. لم ير لقولي “يحتاج إلى مواجهة ومعالجة” دلالة ولا قيمة، وأن “الحرث في البحر” محصلة لعدم مواجهة هذا الواقع الجديد، فـ “لا يمكن تغيير كل ما يواجهه المرء، لكن لا يمكن تغيير أي شيء حتى تتم مواجهته”، وفق قول الكاتب الأميركي جيمس بولدوين.
العربي الجديد
—————————–
المبعوثون الدوليون إلى سوريا.. إخفاقات متتالية في البحث عن تسوية سياسية
انتهت مهام كل المبعوثين العرب والدوليين السابقين إلى سوريا بالاستقالة من مناصبهم، ولم يستطع حتى الآن المبعوث الدولي الحالي، غير بيدرسون، تحقيق اختراق يذكر في مهمته التي بدأت في كانون الثاني/يناير 2019، خلفاً للمبعوث السابق ستيفان دي مستورا.
وحملت الاستقالات في طياتها ما هو أبعد من فشل المبعوثين في مهام الوساطة التي كلفوا بها لحل الأزمة السورية، حيث دلّت الوقائع على أن المجتمع الدولي، ممثلاً بمجلس الأمن، لم يقدِّم الدعم المطلوب للمبعوثين، جراء الانقسامات الحادة التي شابت مواقفه تجاه الأزمة السورية، وأشدها تأثيراً وقوف روسيا والصين إلى جانب نظام حكم بشار الأسد. ولم يكن وضع جامعة الدول العربية أفضل حالاً.
وأشارت تلك المواقف المتناقضة، والانقسامات الدولية والعربية، إلى انسداد أفق التسوية السياسية مبكراً، ودوران جهود المبعوثين إلى سوريا في حلقة مفرغة بانتظار جولات عنف أكثر دموية.
وكان السؤال الذي يطرح نفسه بقوة كل مرّة عند تولي مبعوث جديد للأمم المتحدة إلى سوريا متى سيعلن فشله ويستقيل؟ ليس تشكيكاً بقدرات المبعوثين، بل انطلاقاً من قراءة الواقع الذي سوف يواجهونه. وللإنصاف كان من بين المبعوثين الدوليين مبعوثان يشهد لهما بالخبرة والمثابرة والنزاهة والمصداقية، هما الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان، ووزير الخارجية الجزائري الأسبق الأخضر الإبراهيمي. وليس من قبل المصادفة أنهما اتفقاً على وصف مهمتها بأنها كانت مستحيلة.
الجامعة العربية.. فشل منذ المحاولة الأولى
بداية رحلة الأزمة السورية مع المبعوثين بدأت بتعيين الجامعة العربية الفريق محمد أحمد مصطفى الدابي (ضابط سوداني) رئيساً لبعثة المراقبين العرب في سوريا، في كانون الأول/ديسمبر 2011، وكلّفت اللجنة بوقف عمليات القمع التي يقوم بها النظام ضد المتظاهرين، وسحب الآليات والمظاهر العسكرية من المدن، والإفراج عن المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة، والسماح لأجهزة الإعلام بالدخول ورصد الواقع، وفقاً للبروتوكول النظام لعمل البعثة.
ومنذ بداية تكليفه بالمهمة ارتفعت أصوات تستنكر تعيينه على رأس بعثة المراقبين، لكونه كان من المقربين للرئيس السوداني السابق عمر حسن البشير، المتهم بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور. واستقال الفريق الدابي بعد ما يقارب 3أشهر فقط من توليه المهمة، تعرض خلالها هو وفريقه لانتقادات حادة، من اتجاهات مختلفة، حول الأداء والتقرير الذي قدمه للجامعة العربية.
الفريق الدابي نفسه انتقد البعثة، حين نقل عن مراسلات سرية له قوله “إن بعض المراقبين في البعثة كانوا في زيارة استجمام، وكثيرين منهم غير مؤهلين للمهمة”. بعض التقارير الصحفية أكدت، وبصرف النظر عن الملاحظات التي سيقت على عمل البعثة، أن وجود المراقبين شجع نسبياً المدنيين السوريين على الخروج بمظاهرات معارضة لنظام الحكم.
إلا أن التقييم العام لأداء الفريق الدابي وأعضاء البعثة كان يميل إلى السلبية، وبرزت اعتراضات كثيرة على التقرير الذي قدمه لمجلس الجامعة العربية، وادعى فيه أن النظام قلَّل كثيراً من استهداف وقمع المظاهرات المعارضة له. وتجاهل التقرير القمع الدموي الذي تعرض له المتظاهرون خلال فترة عمل البعثة، مدعياً أن “مهمة البعثة التحقق وليس التحقيق في مدى التزام الحكومة السورية ببنود بروتوكول عمل البعثة”.
ومع استقالة الفريق مصطفى الدابي، في شباط/فبراير 2012، دخلت معالجات الأزمة السورية مرحلة جديدة، باستعانة جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، أو بمعنى آخر تحويل الملف للأمم المتحدة عملياً، رغم توصية الفريق الدابي في تقريره بإبقاء الحل ضمن الدائرة العربية وعدم تدويل الأزمة.
كوفي عنان والبحث عن حل يقوده السوريون أنفسهم
عينت الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية الأمين العام السابق للمنظمة الدولية كوفي عنان، في 12شباط/ فبراير، مبعوثاً دولياً وعربياً إلى سوريا، وأثار ذلك تفاؤلاً كبيراً بإمكانية حدوث اختراق في جدار الأزمة، ووضع أسس لتسوية سياسية يتوافق عليها أبناء الشعب السوري.
عنان أطلق شعار “حل يقوده السوريون”، إدراكاً منه أن الأزمة السورية تغذيها التدخلات الخارجية، سواء لجهة دعم النظام من قبل روسيا والصين ودول أخرى تسير في ركبهما، أو لجهة محاولة دول أخرى السيطرة على قرار المعارضة.
ويسجل لكوفي عنان أنه عمل بدأب واجتهاد خلال فترة توليه لمهمته، التي امتدت سبعة شهور فقط، واستطاع خلالها أن يخلق أكثر من فرصة للتسوية، اصطدمت كلها بخذلان المجتمع الدولي، وعدم جديته بالتعاطي مع الأزمة السورية، وسياسة التعطيل التي مارستها روسيا ومن خلفها الصين.
أول تلك الفرص اقتراح عنان ورقة من 6نقاط، في نيسان/ أبريل 2012، والنقاط باختصار هي: الالتزام بالتعاون مع المبعوث الدولي في عملية سياسية تشمل كل الأطياف السورية. وقف أعمال العنف. ضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت الملائم لكل المناطق المتضررة في القتال. تكثيف وتيرة الإفراج عن معتقلين. ضمان حرية حركة الصحفيين في البلاد. احترام حرية التجمع والتظاهر السلمي.
ولم يتوقف عنان عن المحاولة مجدداً، رغم تصاعد العنف من قبل النظام وحلفائه، وتكثيف روسيا لمناوراتها الدبلوماسية لإجهاض فرص إيجاد تسوية سياسية للأزمة. جهود عنان أثمرت عن عقد مؤتمر في جنيف، بتاريخ 30حزيران/يونيو 2012، شاركت فيه “مجموعة العمل من أجل سوريا”، وصدر عن المؤتمر إعلان مبادئ، اصطلح على تسميته بـ(بيان جنيف1).
أهم النقاط في البيان: إقامة هيئة حكم انتقالية باستطاعتها أن تهيئ بيئة محايدة تتحرك من خلالها العملية الانتقالية، وأن تمارس هيئة الحكم الانتقالية كامل السلطات التنفيذية. التزام جميع الأطراف بوقف دائم للعنف بكل أشكاله. إفراج النظام عن المعتقلين. احترام حرية التظاهر السلمي.. الخ.
ولفت عنان في مؤتمره الصحفي إلى أن مجلس الأمن الدولي يمكنه أن يصدر قراراً وفقاً للبند السابع، وأردف قائلاً :”ترك الأمر للسوريين ليس سهلاً”، ومن الواضح أنها دعوة لتدخل مجلس الأمن بشكل حازم. غير أن الروس ظلوا يلعبون على وتر تفسيرات خاصة لمقولة “حل يقوده السوريون”لإفراغ أهم قرارات مؤتمر “جنيف1″من مضمونها، وخاصة ما يتعلق بإقامة هيئة حكم انتقالية، وحسب تفسير موسكو يجب أن يقود بشار الأسد المرحلة الانتقالية.
استقال عنان من مهمته في آب/ أغسطس 2012، خشية أن يصبح كبش فداء صراعات القوى الدولية والإقليمية. وحملَّ عنان المجتمع الدولي مسؤولية عسكرة الصراع، ونقص الإرادة في التوصل إلى حل سياسي. وكتب في مذكراته: “بشار الأسد يرغب في استخدام كافة الوسائل من أجل الاحتفاظ بالسلطة”.
الأخضر الإبراهيمي ومتاهة تفسيرات بيان “جنيف1”
سمي وزير الخارجية الجزائري الأسبق الأخضر الإبراهيمي خلفاً لكوفي عنان، كمبعوث دولي وعربي مشترك إلى سورية في آب/أغسطس 2012، وحاول أن يقلل من التشاؤم باعتباره أن مهمته “شبه مستحيلة”وليس “مستحيلة”كما قال سلفه عنان.
الإبراهيمي أكد أنه سينطلق في مهمته من النقطة التي انتهى إليها عنان، في المبادرة التي أصبحت أساساً لـ”جنيف1″، وكان يحدوه الأمل في أن ينجح بتحقيق اختراق جدي على الأرض، فشل في تحقيقه صاحب المبادرة كوفي عنان، لكن حسابات الإبراهيمي التي زرعها في حقل مهمته لم تعط غلالاً في البيدر، وذلك لا يعني أنه هو من يتحمل مسؤولية الفشل نتيجة طريقته في أداء مهمته.
أول فشل واجهه الإبراهيمي انهيار الهدنة التي أعلن عنها في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، بعد جهود مضنية وحثيثة. وشكّل فشل تنفيذ مخرجات مؤتمر”جنيف2″، عقد في 22 كانون الثاني/يناير 2014، ضربة قاتلة لمهمة الإبراهيمي الذي لم يستطع تجاوز العقبات التي وضعها النظام وحلفائه الروس، بإثارة الخلافات ذاتها التي رفعوها بوجه كوفي عنان بعد “جنيف1″حول مفهوم الهيئة الانتقالية ودورها ومهامهما وحدود صلاحياتها، ودور بشار الأسد شخصياً في المرحلة القادمة. واستطاع الروس والنظام إغراق المباحثات اللاحقة بالتفاصيل، مع رفض أي جداول زمنية لما يجري الاتفاق عليه، فقرر الإبراهيمي الاستقالة في أيار/مايو 2014.
ومثلما لم يفاجئ عنان أحداً باستقالته بعد فشل تطبيق قرارات “جنيف1″، كانت استقالة الإبراهيمي متوقعة على نطاق واسع، وكان السؤال بعد فشل مؤتمر “جنيف 2”: متى سيستقيل الدبلوماسي المخضرم؟ إذ باتت فرص نجاحه معدومة في ظل المعادلة الصفرية التي تعاطت من خلالها الأطراف المباشرة في الصراع المسلح، وفشل المجتمع الدولي في بلورة تفاهمات حول كيفية دعم التسوية السياسية للأزمة الدامية، تكون لها أجندة ورزنامة زمنية واضحة ومحددة، تبدأ بوقف العنف واعتماد الخيار الدبلوماسي كمخرج وحيد وممكن لتسوية الصراع.
ستيفان دي مستورا وتغيير جدول أولويات
وافق مجلس الأمن الدولي على تعيين ستيفان دي مستورا في تموز/ يوليو 2014، بينما كان المجتمع الدولي يغير أولوياته بالنسبة لملفات الأزمة السورية، بعد ظهور تنظيم (داعش) في العراق وتمدده داخل سوريا. ووقعت الكثير من الانقلابات في التحالفات بين القوى الدولية والإقليمية المؤثرة، ناهيك عن الانقسامات في مكونات المعارضة السياسية والفصائل المسلحة.
روسيا استغلت الخلافات بين الولايات المتحدة الأميركية وتركيا حول ملف “وحدات حماية الشعب”الكردية شرق الفرات، فنشأ تنسيق متقدم بين موسكو وأنقرة وطهران، استند عليه الكرملين لإطلاق مساري “أستانة”و”سوتشي”، كبديل عن مسار جنيف.
ونفذَّت روسيا مخططها بإغراق المباحثات التي عمل عليها دي مستورا بالتفاصيل، جنباً إلى جنب مع تكثيف العمليات العسكرية بمشاركة روسيا والنظام والميليشيات الإيرانية. حتى انتهى الحال بالمبعوث الدولي دي مستورا إلى وصفه من قبل كثير من المحللين بأنه أصبح غطاء للسياسات الروسية، وبأنه كان يحابي النظام.
قدم ديمستورا استقالته في تشرين الأول/أكتوبر 2018 ليخلفه الدبلوماسي النرويجي غير بيدرسون.
المبعوث غير بيدرسون ميراث ثقيل
باشر غير بيدرسون مهمته في كانون الثاني يناير 2019، ولم يستطع أن يفعل شيئاً حتى الآن سوى إطلاق مناشدات متلاحقة من أجل وقف معاناة الشعب السوري، وضرورة البحث عن حل سياسي للأزمة في سوريا. وتبدو مهمة بيدرسون أصعب كثيراً ممن سبقوه، فقد ورث إملاءات مسار “أستانا”، ومتاهة تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد وفقاً للقرار (2254)، وتجاهل روسيا والنظام لباقي بنود القرار المذكور التي نصت على وقف إطلاق النار، وتحقيق انتقال سياسي عملاً بـ”بيان جنيف1”.
وحتى لا يتكرر مع بيدرسون ما حدث مع عنان والإبراهيمي ودي مستورا يجب أن يقتنع الجميع، قولاً وعملاً، بأنه لا يمكن حل الأزمة عسكرياً، وأن أي حل سياسي يجب أن ينطلق من احترام روح بنود “جنيف1″وآليات “جنيف2″، ضمن سقف زمني محدد وملزم، وبما يحقق مصالح كل أبناء الشعب السوري، بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، وهذا كله رهن برحيل نظام بشار الأسد.
————————
=======================
الثورة السورية بين المعنى والجدوى.. في “الكلام الفاضي” و”الدوال الفارغة”/ حسام الدين درويش
من الشائع الحديث عن الدولة بوصفها، محتكرة العنف المشروع، كما قال ماكس فيبر. ويتسم عنف الدولة بالمشروعية، بقدر كونه ضروريًّا لحفظ السلام الاجتماعي، وضبطه بقوانين عادلةٍ ومنصفةٍ، من وجهة نظر المحكومين، عمومًا. وتزداد حاجة الدولة/ السلطة إلى ممارسة العنف، بقدر افتقادها و/ أو افتقاد عنفها للمشروعية، من وجهة نظر المحكومين. وعلى هذا الأساس، يمكن أن نفهم ممارسة الدولة/ السلطة الاستبدادية عنفًا أكبر من ذاك الذي تمارسه الدولة/ السلطة الديمقراطية. فجزءٌ من ذلك العنف يهدف، تحديدًا، إلى تعويض افتقاد السلطة وعنفها للمشروعية والمقبولية وإكراه بعض الخاضعين، أو الرافضين للخضوع لها، على الخضوع والإذعان.
ولا يكفي عنف الدولة/ السلطة، مهما بلغت قوته، وامتد زمنه، للسيطرة على المجتمع وإخضاعه، بل لا بد من خطابٍ أيديولوجيٍّ، موازٍ لهذا العنف، ومبرِّرٍ له وللطرف الذي يمارسه. وتزداد الحاجة إلى هذا الخطاب الأيديولوجي بازدياد طغيان الدولة وعنفها وافتقادها للمشروعية. وتصعُب مهمة هذا الخطاب الأيديولوجي بمقدار ازدياد عنف السلطة وازدياد درجة افتقادها وعنفها للمشروعية. وتتنوع مضامين هذا الخطاب، لكنها تتخذ، في كثيرٍ من الأحيان، صيغة السفسطة، بالمعنى السلبي للكلمة، أو البلاغة الخطابية السفسطائية التي ترمي إلى إقناع المحكومين، أو بالأحرى إفحامهم ولجمهم، بحججٍ شكليةٍ و”فارغةٍ”، على الأرجح. وهذا ما يحصل، خصوصًا، في حالة الخطاب الأيديولوجي المسوِّق أو المسوِّغ للمستبد ولاستبداده. وفي محاورة “جورجياس”، بيَّن أفلاطون، محقًّا، ملازمة “السفسطة”لكل “طغيانٍ”سياسيٍّ.
لم يخرج الاستبداد أو الطغيان الأسدي عن هذه القاعدة، منذ وصوله إلى السلطة، حتى يومنا هذا. وإضافةً إلى استخدامه العنف المادي لإخضاع السوريين، منذ وصوله إلى السلطة بانقلابٍ عسكريٍّ أسماه حركةً تصحيحيةً لثورةٍ مزعومةٍ هي، في حقيقتها، انقلابٌ عسكريٌّ آخر؛ استخدم هذا الطغيان خطابًا أيديولوجيًّا، يمكن وصفه بالعنف الرمزي. ومن مفردات هذا الخطاب: “التصحيح والثورة”و”الوحدة العربية أو التضامن العربي”، “التوازن الاستراتيجي مع العدو الصهيوني”، “التقدم”و”الوحدة والحرية والاشتراكية”، و”المقاومة”و”الممانعة” … إلخ. ويكمن العنف الرمزي لهذا الخطاب في إفراغه تلك الكلمات، وغيرها الكثير، من معانيها، وجعلها، من منظور الكثيرين، “كلامًا فارغًا”/ “كلامًا فاضيًا”.
والمقصود ﺑ “الكلام الفارغ أو الفاضي”، في هذا السياق، هو ذاك الكلام الذي لا يتطابق معناه المفترض مع توظيف قائله له، وقصده أو غايته منه، بحيث يحيل، عمليًّا، على ما هو منافٍ أو مناقضٌ لمعناه “الأصلي”المُفترض. فحديث النظام عن “الوطنية”يفتقد إلى الحد الأدنى من معاني الوطنية المفترضة؛ لأن “الوطنية”تعني، من منظور النظام، الخضوع له، والقبول باستبداده، مع أن ذلك يفضي بالضرورة إلى تدمير “الوطن”ونفي مواطنية المواطنين/ الرعايا. والحال ذاته بالنسبة إلى شعار الحرية الذي استُخدِم لتبرير القمع، وانعدام الحريات، أو بالأحرى إعدامها. كما استُخدِم شعار “السعي إلى التوازن الاستراتيجي مع العدو الصهيوني”ومن ثم، شعار “الممانعة”، لتسويغ مهادنة النظام للعدو المفترض “إسرائيل”، وتفرغ النظام لقمع الشعب ونهب ثروات البلد.
لا شك أن هذه الشعارات الأيديولوجية قد ساندت عنف النظام، وسوَّغت وجوده، أو ساعدت على اعتقاد أو توهُّم بعضٍ من السوريين، وغير السوريين، بتمتع هذا النظام بمشروعيةٍ ما، تمتعًا جزئيًّا ونسبيًّا. وقد أفضى ذلك الاعتقاد الواهم، أحيانًا، إلى قبول بعض الناس استبداد النظام، على مضضٍ، أو حتى تقبُّلهم إياه، بوصفه ضرورةً أو شرًّا لا بد منه، في سياق المعارك “الوطنية”الأساسية، ضد الامبريالية والصهيونية، في الخارج، وضد الجهل والتخلف والرجعية، في الداخل. لكن التناقض، المستمر والمتزايد، بين هذه الشعارات، من جهةٍ، والمعنى الذي يفترض بها تضمُّنه، والواقع الذي يُفترض بها أن تحيل عليه، من جهةٍ أخرى، جعلها تفقد “سحرها”وتأثيرها ومعناها، وتصبح بالنسبة إلى كثيرين، كلامًا فارغًا/ كلامًا فاضيًا، لا يدل على قصد قائله، ويفتقد بالتالي لأي مصداقيةٍ. وبوصفه عنفًا رمزيًّا، يتكامل إفراغ الكلام من معناه مع العنف المادي، ويفضي إلى تأثيراتٍ سلبيةٍ هائلةٍ في القيم الأخلاقية والسياسية واللغوية التي يتضمنها الخطاب والنشاط السياسي، أو الخطاب والنشاط، في المجال العام، عمومًا.
يؤرِّخ قيام الثورة السورية (بداية) انتهاء فترة سيادة الكلام الفارغ الذي كان يهيمن على الفضاء السياسي في سوريا. فحينها، بدا أن كلماتٍ مثل “حرية”و”كرامة”وثورة”قد استعادت شيئًا من رونقها أو اكتسبت رونقًا جديدًا، يتعارض تعارضًا كاملًا، مع حالها في إطار الأيديولوجيا الأسدية. وفي إطار مجابهته أو محاربته للثائرين عليه، لم يكتف النظام بالعنف المادي المتمثِّل، على سبيل المثال، في الملاحقة والضرب والاعتقال والتعذيب أو حتى القتل، بل بذل كل جهوده لإبقاء خطابه الأيديولوجي مهيمنًا، وإبقاء الكلمات فارغةً من أي معنىً إيجابيٍّ فعليٍّ. وعلى هذا الأساس، يمكننا أن نفهم رفض النظام وإعلامه ومؤيديه الاعتراف بثورية الثورة عليه. فعند النظام لا ثورةً، أو لا ينبغي أن يكون، في سورية، ثورةٌ، إلا “ثورته”المزعومة، والمتمثلة في ثورة/ انقلاب 8آذار أو حركته التصحيحية/ انقلابه في 16تشرين الثاني. أما ثورة السوريين عليه فهي “فورةٌ”أو “مؤامرةٌ”أو “خيانةٌ” … إلخ.
وقد تعرض شعار الحرية الذي رفعه السوريون الثائرون إلى هجومٍ أسديٍّ، خاصٍّ ومكثفٍ، لعِلمِ النظام أن حرية السوريين تعني أو تقتضي سقوطه أو إسقاطه بالضرورة. ولهذا السبب، بدأ إعلام النظام، منذ انطلاق الثورة، بتحويل شعار الحرية الذي رفعه السوريون الثائرون إلى مسألةٍ ميتافيزيقيةٍ غايةً في الغموض، بغرض تفريغ هذا الشعار من معناه. فظهرت أسئلةٌ، من قبيل: “ما نوع أو مضمون الحرية التي يطالب بها هؤلاء الناس؟”، ألا يعلمون أن شعار الحرية هو أحد/ أول شعارات النظام والدولة وحزب البعث؟”. واتخذت إجابات النظام عن سؤال الحرية الذي أطلقته الثورة، صيغة الكوميديا التافهة حينًا، كما ظهرت، على سبيل المثال، في قول مشهور لأحد المؤيدين للنظام، في مقابلةٍ مع قناة الدنيا: “طالبين الحرية؟! أنو حرية؟!… أنا واحد من الشعب السوري، أنا عايش بحرية، أنا وأهلي. أنا أختي بتطلع الساعة تلاته بالليل مأمنين عليها، كلو أمان، سورية كلها أمان!”. لكن تلك الإجابة اتخذت، أحيانًا أخرى كثيرةً، صيغةً ميلودراميةً إجراميةً ووحشيةً. ونجد هذه الصيغة، على سبيل المثال، في السؤال الخطابي والاستنكاري الذي وجهه بعض شبيحة النظام إلى أسرى ومعتقلين ثائرين أثناء تعريضهم لتعذيب وحشيٍّ: “هاي هي الحرية يلي بدكون ياها؟”.
لقد قدمت الثورة السورية إجاباتٍ مختلفةً عن إجابات النظام الأسدي، وأعادت فتح آفاق سؤال الحرية في سورية، بعد أن أغلقه ذلك النظام، وكتم أنفاسه، لسنواتٍ طويلةٍ. وبهذه الإجابات، بدا أن الثورة السورية قد حوَّلت بعض ما كان كلامًا فارغًا إلى دوالٍ فارغةٍ، جزئيًّا ونسبيًّا. ووفقًا لإرنستو لاكلاو، الدال الفارغ “empty signifier”هو دالٌ يحسم الصراع السياسي الاجتماعي معناه أو مدلوله، من خلال هيمنة خطابٍ ما، يحظى بقبولٍ واسعٍ ما، وإقصاء خطاباتٍ الأخرى. ولفترةٍ وجيزةٍ، هيمن خطابٌ ثوريٌّ عن الحرية والوطنية والكرامة، مختلفٌ تمامًا عن خطاب النظام الأسدي، لكن المقاومة والممانعة الشرسة التي أبداها هذا النظام، بدعمٍ هائلٍ من قوىً محليةٍ وإقليميةٍ ودوليةٍ، جعلت تلك الدوال الفارغة دوالًا عائمةً وغائمةً ومختلفًا عليها. وأصبحت كل الكلمات والشعارات والمفاهيم موضع جدالٍ واختلافٍ وشبهةٍ أيضًا أحيانًا.
ولأسبابٍ كثيرةٍ، بدا، في الفترة الأخيرة، أن معظم الكلمات قد فقدت معناها وتأثيرها، بالنسبة إلى سوريين كثر، كانوا في بداية الثورة يرون فيها معانٍ كثيرةً. في المقابل، ما زال سوريون كثر حريصين على ألا يعيد النظام سيطرته و/ أو هيمنته على الخطاب السياسي السوري، وعلى معاني الدوال الفارغة، بحيث يعيد إفراغها من معانيها الإيجابية، لتصبح من جديدٍ “كلامًا فارغًا”. لقد أخفق الصراع المسلح للثورة السورية مع النظام الأسدي، وأفضى إلى سيادة شعورٍ متزايدٍ بأن هذه الثورة لم تحقق الجدوى المطلوبة أو المنتظرة منها (حتى الآن). لكن الصراع، مع النظام، في مستوى الكلمة والمعنى، لما ينته بعد، وهو لا يقل أهمية عن كل أنواع الصراع الأخرى، بل ربما يفوقها أهميةً. وفي هذا المستوى تحديدًا، سيتحدد مصير الثورة السورية، ومعناها، على المدى الطويل، بغض النظر عن تكرار إعلانات موتها ودفنها، بحقٍّ و/ أو بدونه.
إذا كانت الثورة السورية قد خسرت معركة الجدوى، من منظورٍ ما، فإنها كانت وما زالت قادرةً على منع النظام من الفوز في معركة المعنى، لا بل وعلى الانتصار في هذه المعركة. وإذا كان غياب الجدوى قد أضعف همم بعض السوريين، وفتَّر حماسهم للاستمرار في معركة المعنى، فهناك إمكانيةٌ لأن يفضي أي إنجازٍ للثورة السورية، في مجال المعنى، إلى الإسهام في فتح آفاق معركة الجدوى، في المستقبل المنظور و/ أو غير المنظور.
يمكن الثورة السورية أن تصبح عملًا سوريًّا/ إنسانيًّا كلاسيكيًّا بامتيازٍ. والكلاسيكي وفقًا لمعناه المعياري، “هو كل شيءٍ جيدٍ”، كما يقول غوته. والكلاسيكي، بالمعنى المعياري، يعلو التاريخ، كما يقول غادامر؛ أي أنه عابرٌ للتاريخٍ، رغم أنه حدثٌ تاريخيٌّ بامتيازٍ. ويمكن لمعنى الثورة السورية أن يكون أو يصبح كلاسيكيًّا، بقدر منع الخطاب الأسدي من الانتصار في معركة المعنى، وبقدر إبراز المعاني الإنسانية، الجميلة أو الإيجابية، التي كانت تلك الثورة حبلى بها، وأسهمت في إنجاز/ إنجاب الكثير من الأجنة منها.
لقد كان وما زال للثورة السورية معنىً، بغض النظر عن كونها قد انتهت، بوصفها فعلًا بشريًّا، أو ما زالت مستمرةً بنتائجها، بوصفها حدثًا تاريخيًّا.
وللثورة السورية معنىً، بقدر وجود معنىً لهتافات مئات الآلاف، بل والملايين، للحرية والكرامة، و/ أو بقدر وجود معنىً للتضحيات الكثيرة والكبيرة التي قدمها السوريون الثائرون، طوعًا أو كرهًا، في سبيل نجاح ثورتهم أو إنجاحها، و/ أو بقدر وجود معنىً للآمال والطموحات التي حفزت سوريين كثر على رفض ظلم النظام الأسدي والتطلع إلى نظامٍ سياسيٍّ يحقق العدالة لجميع السوريين، و/ أو بقدر وجود معنىً لسعي الإنسان السوري الثائر إلى استرداد كرامته، ونيل حريته، وتحقيق الحد الأدنى، على الأقل، من شروط أو متطلبات أو مقتضيات إنسانيته.
بروكار برس
=================

مُقدِّمات للقيام عن الكرسي المدولب/ مصعب النميري
سطت سنوات الثورة السورية على الجانب الأعظم من اهتمامنا وطاقتنا، وأسست لمرحلة جديدة، بدا فيها ما قبل 2011 ظلاً في الخلفية، وأخذ في التلاشي، رغم الدور الأساسي لتلك المرحلة في إيصالنا إلى ما نحن فيه اليوم.
ونحتاج اليوم إلى مزيدٍ من الحديث عن مرحلة ما قبل الثورة، بأكبر قدر من العمق والاقتراب، ووضع ما جرى في 2011 في سياق تاريخي أشمل، يُتيح لنا ولسوانا فهم الخط العريض لتاريخ هذا البلد، الذي تحول خلال خمسين عاماً، بأهله ومقدّراته، إلى رهينة للثقافة العسكرية والبعثية التي حاولت ابتلاع المجتمع وتشويهه، ودفعته في النهاية إلى الانفجار غضباً، مثل بقية الشعوب العربية التي رزحت طويلاً تحت حكم العسكر والأنظمة الديكتاتورية المتشابهة.
في هذا السياق، تأتي رواية الصديق نبيل محمد، دورة أغرار، الصادرة عن منشورات المتوسط مؤخراً، لتُسلط الضوء على ما كان يجري في أجواء المؤسسة العسكرية والإعلام في «سوريا الأسد»، خلال الفترة السابقة لاندلاع الثورة السورية، تزامناً مع الأخبار الواردة عن ثورات الربيع العربي آنذاك، في مصر وتونس وليبيا.
تعرض هذه الرواية حياة عائلة الضابط أبو حسام، التي تعيش في العاصمة دمشق، وبطلتها بنت هذا اللواء، شوشو، أو شهيرة، التي تحلم بالدخول إلى عالم الإعلام وتقديم برنامج «بدو يكسّر الدنيا»، تستضيف فيه المشاهير، لتصبح بدورها واحدة منهم، يباهي بها أبوها الضابط أمام رفاقه الضباط، مثلما «يباهي بخصيتيه حين يجلس بأقدام مفتوحة قرب الضباط الأصغر منه، ويمتنع عن ذلك قرب الضباط الأعلى رتبة».
الرواية هي «زوم إن» على الأجواء العسكرية، والضباط وأحاديثهم الفيّاضة بـ«الحكم العميقة» التي ترسم صورة الوطن المنشود، حيث يتعاظم الولاء للقيادة التي «تتولى زمام الأمور في مراحل تاريخية حرجة من الصراع مع العدو الغاشم». وهي في الحقيقة أجواء الفساد العسكري، والترفيعات، والمحسوبيات، والخوف على الرتبة، وامتهان العساكر، وبناء تصورات مضحكة عن النضال والوطنية: «تنقل أبو حسام بين مختلف القطع العسكرية الميدانية في الجيش، كان شهيراً بصرامته وقدرته الفائقة على منع المجندين من النوم يومين متتاليين بسبب إتقانه فن العقوبات المستمرة التي كانت بنظره السر في جعل العسكري قوياً وصبوراً ومحباً لجيشه وقائده. يُعتبر أحد مكتشفي عقوبة قياس طول ساحات التدريب وعرضها باستخدام عود ثقاب، وأحد المطورين على الجاموقة… هو الضابط الوحيد الذي كثيراً ما كان يمارس العقوبة مع مجنديه. كثيراً ما كان ينسى أن ما يفرضه هو عقوبة وليس تمريناً رياضياً أو تدريباً عسكرياً، فيقوم باتباع ما يأمر به.. لقد نزل في الجاموقة خطأً وهو يُعلّم المجندين كيفية الغوص بها، وقد انبطح على الرمل الساخن أكثر من مرة بسبب اندماجه التام مع العقوبة. عشرات التشكيلات العسكرية في لبنان وسوريا تعرف اسمه».
دخول شوشو إلى هذا الوسط لم يكن مسألة غاية في التعقيد، فعلاقات والدها اللواء ستسهل لها ذلك. هي ابنة اللواء، التي لا ينبغي عليها الكفاح كثيراً للوصول إلى مسعاها، خلافاً لعامة السوريين، الحاضرين رمزياً بشخصية الشاب مدين، المُقعد على كرسيه المدولب، والذي يكافح بمرارة لإنجاز أبسط الأمور، مثل الخروج من المنزل، والدخول إلى الحمام، وذلك بعد أن صدمته سيارة ابن ضابط آخر، ثم تمت تسوية القضية وامتصاص غضبه عبر إيجاد وظيفة له بدوام مؤقت، في «دار الأسد». سيكون الأسدان، «الأب القائد»، و«الأخ القائد»، كما يسميهما اللواء، حاضران في تسمية معظم الأماكن، وفي أغلب الحوارات، مثل التماثيل التي تتوسط الساحات والميادين. هما موجودان في كل «قلب كل شيء بسوريا»، التي هي بدورها، «قلب العروبة الصامد، وقلعة الصمود والتصدي»، وفق ما يحلو للواء أن يقول دائماً.
نرى في الرواية سوريا التي كنا نعيش فيها، بكل الأفكار والمفاهيم البالية والبليدة التي فرضتها العقلية العسكرية. وكما في طوفان أميرلاي، ترشح من محاولات اللواء الفاسد، ورجل الأعمال الموالي للنظام، ومسؤولي الدولة، كوميديا تعكس السذاجة والرخص في تحديد ما هو وطني، كـ«مُلتفّ حول القائد»، وما هو غير وطني، ويصب في صالح القوى الإمبريالية، التي تُعتبر سوريا على «خط المواجهة» الساخن معها.
سوريا تلك، التي تظهر في المباني المتسخة، والإسمنت السوفييتي، ودوائر الدولة المتهالكة، والبزة العسكرية، وفروع الأمن، والمؤسسات الاستهلاكية، ودعايات فواز الجابر، والمدارس ذات الأسوار، وكتب القومية، ومخصصات الوقود، يحاول الكاتب الغوص فيها، عبر شخصياته، واضعاً أمام أعيننا ذلك الكوكب الذي يبدو بعيداً اليوم، والذي انسلخ عنه ملايين السوريين، بفعل الثورة لاحقاً، ليتحول إلى براميل وصواريخ وأسلحة كيماوية وزنازين وموت تحت التعذيب، حين أراد الشعب الانتفاض على البلادة. هذا الكوكب سيصبح مثاراً للاستهزاء لدى معظم السوريين في جلسات المنافي، رغم ذلك الشعور بالحسرة، الذي يخلقه تمكّنُ النظام من انتزاع السيطرة مجدداً على معظم الخريطة السورية، وإعادتها إلى حظيرته، فارضاً ذلك «التجانس» الذي حلم به، عبر إخضاع المجتمع للبسطار مرة أخرى، مقابل تقديم البلاد على طبق من ذهب لتتقاسمها الدول والجيوش.
تدخل شوشو إلى الوسط الإعلامي السوري بقوة، وسنعرف عبر احتكاكها بالعاملين والمشرفين والمدراء خبايا وقصص هذا الإعلام، الذي سيتألق ببلاهته وإجرامه بعد انطلاق الثورة، كذراع ضاربة للنظام، تخترع نظريات سقوط المطر لكتم أخبار المظاهرات، وتطلب من ضحايا المجازر المخضبين بالدّم تجريم أنفسهم على الهواء. تعرض الرواية ما يدور في أروقة هذا الإعلام، الذي كان منذ تأسيسه مادة للترفيه والتسلية بالنسبة لمن يمتلك الحد الأدنى من المنطق والقدرة على المحاكمة. سنرى سامر، البيغ بوس لقناة الوداد ورئيس مجلس الإدارة، هو ابن أحد المسؤولين الكبار، الذي يحاكي طبقة رجال الأعمال المقربين من النظام، وتربطهم علاقات عائلية ببشار الأسد، وهي الطبقة التي ظهرت مع استلام الأخير للسلطة نتيجة توريث حيتان النظام القديم النفوذ والثروات لأبنائهم. الطبقة التي تعيش حياة مُترفة وباذخة، بعد السطو على اقتصاد البلاد، والتمكن من وضع القطاع الخاص في الجيب، عبر سياسة المافيا الرسمية، بما في ذلك وسائل الإعلام الموازي، التي بدأت بالظهور خلال السنوات القليلة السابقة للثورة، وتبنت «خطاباً وطنياً»، يجعل التمييز بينها وبين الإعلام الرسمي صعباً، ففوهة المدفع ستخرج من هذه القنوات جميعها على السواء، حين يخرج السوريون إلى الشارع، وسيتنافس هذان الإعلامان، الرسمي والخاص، على التحول إلى أدوات فعالة في يد «السلطات المعنية»، للتوجيه ونشر البروباغندا الحربية، إثر اندلاع الثورة، بعد أن كانا قد أسسا قبلها قلعة حصينة، لا تظهر فيها وسيلة إعلامية واحدة تعارض السلطة.
هو الوسط الإعلامي، الذي يعمل مُكملاً للماكينة العسكرية في الاقتحامات، ويسابقها في الفساد المشوب بلوثة من الكوميديا، استطاعت عين الكاتب التقاطها، في علاقة الضابط بمجنّده، القائمة على الاستغباء والبلف وشراء الإجازات بوحدات الموبايل، وعلاقة البيغ بوس مُدعي الثقافة والنخبوية، بموظفي القناة، البارعين في المنافسة والمكائد، ثم في علاقة الوزراء والمسؤولين بعامة الشعب. كل هذه العلاقات ترتبط بخيط متين وتتجه إلى مركز واحد، يوزع عليها الإسفاف بالتساوي، وهو الرئيس الشاب، الذي استلم دفة القيادة من والده، ومن ورائهما حزب البعث، بمنطلقاته النظرية العتيدة، التي استطاعت إلقاء هالة من الرداءة على امتداد خريطة البلاد.
تمكنت الرواية من رصد الأنماط التي خلقتها «سوريا الأسد»، وسلّطت الضوء على مصائرها التي تتدافع، وصولاً إلى نقطة التحول الكبرى، وهي الثورة السورية، التي يصمت عندها الجميع كمن تلقى صفعة مفاجئة، مع بدء عموم السوريين بالخروج عن عصا الطاعة، عبر أصواتهم الصادحة في الشوارع، ناسفين نهج النظام التاريخي في تدجين المجتمع، وسيكون هذا، بالضرورة، خلافاً لما كان يحلم به اللواء، الذي «يبتسم كارهاً التنويعات في أثاث المنزل. كؤوس ملونة وصحون متنوعة وفناجين. علب محارم تحمل أسماء مختلفة لا تنتمي لما عاشه هو وزملاؤه عندما كانوا ضباطاً صغاراً.. يتحسّر على فناجين القهوة ذات الشكل والواحد وعلب محارم كنار الموجودة من شرق سوريا إلى غربها في كل منزل، وكبريت الحصان، ذو الغلاف المميز الذي يباع قسراً مع بونات الأرز والسكر، كان يعشق ذلك التشابه فقد كان كل الناس مثل بعضهم وكل أثاث وأدوات المنزل من نبع واحد».
من ضاحية الأسد، حيث تعيش شوشو، إلى المزة 86، حيث تعيش خالتها، تضيء الرواية على تلك الأحياء، التي حاوطت العاصمة بعد استلام حافظ الأسد للسلطة، وكانت مسكناً للضباط والعاملين في الجيش والمخابرات. تدور ثمة نقاشات بين الضابط أبو حسام، وسومر، ابن خالة ابنته شوشو، الرافض للالتحاق بالمؤسسة العسكرية وزج الطائفة العلوية بهذا السلك الفاسد، هي حوارات تُعرّج على الاختلاف الطبقي وتضارب الرؤى في تلك الدائرة الضيقة، لتمتد وتصبح أكثر حدة مع ورود أنباء الثورة المصرية، وتصاعد التوقعات بامتداد موجة الربيع العربي إلى سوريا، حيث سُيبدي سومر حماسه لإسقاط مبارك، ويتوقع امتلاء ساحة الأمويين على طريقة ميدان التحرير، فيما سيكون الضابط متسلحاً بنظرية المؤامرة، متوعداً بـ«تفعيس» من يتجرأ على معارضة القيادة إذا لزم الأمر.
اللواء، الذي يتوعد بسحق من يتمرد على النظام، ينسى أنه لا يملك الصلاحات لفعل ذلك، فهو قد تسرّح من الخدمة العسكرية، بسبب رفض ابنته شوشو الزواج من ابن «اللواء المغوار»، المسؤول عن جدول الترفيعات في قطاع الجيش، إضافة إلى إصابته بمرض السكري وتراجع حالته الصحية. كل هذه الانهيارات تتزامن مع بعضها في حياة عائلة الضابط أبي حسام خلال فصل الرواية الأخير، الذي يحمل اسم «العجز». فشوشو أيضاً، التي أصبحت نجمة، ستتورط بالدخول في حديث سياسي، تناولت فيه ما يجري في مصر بعد سقوط مبارك، وتساءلت إن كان من المتوقع انتقاله إلى سوريا، فاتُّخذ قرار بإيقاف برنامجها. فيما أصبحت أمها على الكرسي المدولب، بسبب حادث تعرضت له، وهو الكرسي المدولب ذاته الذي كان الشاب مَديَن أسيراً له، وتمكن من التخلي عنه في المشهد الأخير، مع الأخبار التي تذاع عن بدء الاحتجاجات في محافظة درعا. حينها، ستقرر عائلة الضابط التخلي عن طبق الفول الشامي، الذي واظبت على تناوله في يوم الجمعة، عائدة إلى حصنها القديم، ذلك أن يوم الجمعة، من الآن فصاعداً، سيحمل تسميات مختلفة، لا يحبها اللواء المُغتاظ، الذي يأمر بتغيير القناة إلى الفضائية السورية: «قال كرامة قال».
موقع الجمهورية
=====================

—————————————–
هل هزمنا؟/ ميشيل كيلو
كثيرا ما طرح هذا السؤال في السنوات السابقة من عمر الثورة السورية. وقد كتبت، في وقت مبكر من عام 2014، مقالةً جعلت عنوانها: ماذا لو هزمنا؟ قبل الإجابة على السؤال، لا بد من التمييز بين مستويات ثلاثة لما درجنا على اعتباره الثورة: مستوى الفصائل، وهي على ثلاثة أصناف: بقايا الجيش الحر، الفصائل الإسلامية، وتنظيمات الإرهاب. مستوى التمثيل الرسمي من ائتلاف، وحكومة مؤقتة، وهيئتي تفاوض في جنيف وأستانة/ سوتشي. المستوى الشعبي، وقد ابتعد خلال ثورته عن المستويين، الأول والثاني، ولذلك بقي ثوريا ورقما صعبا رافضا للأسدية وروسيا وإيران.
لو كان عائد الثورة سيقاس بإنجازات الفصائل والمؤسسات، لكان علينا الاعتراف بأننا هُزمنا. ولكن استمرار المعارك التي طرفها الآخر شعب، لم تنجح الأسدية، ويرجح أنها لن تنجح في ليّ ذراعه وإركاعه، يجعلنا نؤمن أن هزيمة الفصائل والمؤسسات التمثيلية لن تكون هزيمةً له، ولن تعيده إلى الزمن السابق لثورته.
ـ بدأ تقويض الجيش السوري الحر باعتقال مؤسّسه، المقدّم حسين هرموش، وتسليمه إلى مخابرات الأسد، والسبب قراره بناء جيش وطني من المنشقين عن الأسدية، ينضم إليه الراغبون بالتطوع أو التجنيد الإجباري، كي لا يتسلح المدنيون، وتستشري ظاهرة الفصائل، المبعثرة طاقات الشعب وقدراته، والعاجزة عن كسب معركة عسكرية، طرفها الآخر جيش يدار مركزيا، وينال دعما بشريا إيرانيا وتسليحيا روسيا، بينما تغرق الفصائل في الحاراتية والأدلجة المذهبية، وتنشر الفوضي العسكرية والسياسية، وترفض الحلول السياسية، وتؤمن، كالأسد، بالسلاح أداة وحيدة لحسم الصراع الذي يقتصر الجانب الثوري فيه على “أهل السنة والجماعة”. بعد تغييب مؤسسه، تلاشى الجيش الحر بقدر ما تصاعدت الفصائلية، وتبعثر مقاتلوه، بينما اغتال تنظيما داعش والقاعدة ثلاثين من قادته وضباطه خلال شهر يوليو/ تموز وحده من عام 2014.
ـ بانفراد النمط الفصائلي بالساحة العسكرية، أكدت هزائمه استحالة انتصاره على دولة عظمى هي روسيا، وأخرى إقليمية هي إيران، ومليشيات الأسد المعادة هيكلتها وتدريبها وتسليحها على أيدي الروس، وتنظيمات الإرهاب متعددة الجنسيات. وبدا تشتت تنظيماته وتناحرها كقدر لا راد له، وظيفته الرئيسة منع بناء جيش وطني، وقيادة سياسية فاعلة، وتقسيم سورية إلى نتف صغيرة يسيطر كل فصيل على أشبار منها، ويديرها بقدر من القسوة والفساد، يناظر أو يبز ما لدى سفاح دمشق ودولته العميقة .
ـ لعب نمط التنظيم الفصائلي دورا خطيرا في تراجع طابع الائتلاف التمثيلي، وتدنّي قدرته على الحركة والتأثير، وتحوله إلى كيان يرى المسألة السورية بأعين الآخرين، فلا عجب أنه احتجز تكوّن قيادة ثورية موحدة وفاعلة، ترى نفسها بدلالة الشعب، أسوة بالفصائل التي احتجزت تكوين جيش وطني موحد وفاعل.
ـ لو كان ما سيحصل السوريون عليه مرتبطا بالفصائل وائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية، لخرجوا صفر اليدين من أي معركة أو حل. لكن المستوى الثالث: الشعب الذي صنع معجزة الثورة، وقدّم الغالي والرخيص على دربها، وصمد كما لم يصمد شعب قبله، لم يهزم ولن يهزم. وإذا كان لن ينال كل ما ثار من أجله، فلأنه ابتلي بالفصائلية العسكرية والسياسية التي قوضت فرص نجاح ثورته كفعل هدفه الحرية، وتعرّض لحرب إبادة أسدية زادت الفصائل تكلفتها البشرية والسياسية. مع ذلك، لم يستسلم الشعب الغارق في دمائه، وأقنع صموده الأسطوري العالم أن سورية لن تكون قابلة للتهدئة، ما بقي السفاح في السلطة، أو إن حاولت روسيا وإيران إعادتها إلى نظام استعباد وتمييز: أسديا كان أو غير أسدي.
ـ لن يهزم شعب سورية، وكيف يهزم إذا كانت الأسدية قد صارت وراءه، وبقي متمسكا برهان ثورته الذي لطالما هتف له من أعماق روحه: سورية بدها حرية، والشعب السوري واحد.
العربي الجديد
——————————-
الثورة السورية .. أسماء ودلالات/ خديجة جعفر
للثورة السورية في مسارها المتعرّج والمتناقص في نهاية عامها التاسع أسماءٌ عدّة. لكلّ اسمٍ دلالةٌ تكشفُ عن وجهِ حقيقةٍ من حقائقها المدهشة والمفجعة في آنٍ. حين اندلعت في أوّل أسبوعٍ من عمرها، تنبأ الكاتب السوري مجاهد ديرانية بأنّها ستزلزل الأرض من تحتها، فسماها الزلزال السوري، وما لبث يدوّن، في مدونته المسمّاة بهذا الاسم، يومياتِ الثورة تسعة أعوام متصلة، منذ بدايتها السلمية في التظاهرات الأسبوعية وحتّى نهايتها المنحسرة في هذه اللحظة، وما تخلّلها من أحداثٍ عظام. وقد شهدنا هذا الزلزال في وقائعه المتتالية، فشهدنا الدعم الإيراني واللبناني والعراقي لنظام الأسد، وشهدنا سيطرة الثوار على مناطق شاسعة من سورية، ثم انحسارهم لصالح تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الذي استدعى حربًا دولية على الإرهاب، قادتها الولايات المتحدة، ثمّ شهدنا انحسار مناطق الثوار بفعل الدعم الإيراني برًّا، والقصف الروسي المتوحش جوًا، وشهدنا استفادة القوميين الأكراد من الزلزال السوري باستحواذهم على مناطق الشرق مكافأة لهم على استئصالهم تنظيم داعش. ثم كانت آخرُ زلزلةٍ بالتدخل التركي في الشمال السوري لردع الأكراد القوميين عن تكوين كيان شبيه بالدولة على الحدود الشمالية. انشقّت الأرض إذن في الزلزال الذي لم يترك حجرًا في مكانه.
أما الكاتب ياسين الحاج صالح فاعتبر أن الثورة السورية تقارع المستحيل، فسماها “الثورة المستحيلة”، وهذا المستحيل هو الواقع السوري الذي ثارت عليه. ويُحيل صالح سبب هذه الاستحالة إلى أمرين: المجتمع الذي وصّفه بأنّه “مفخّخ” بفعل عملٍ منظمٍ من النظام الأسدي نصف قرن، فالمجتمع مفخّخ بعدد كبير من الأجهزة الأمنية والمخبرين، كما تقسّمه “أزمة ثقة وطنية عميقة” لم تنجُ منها المعارضة، ولم تنج منها الفصائل الثورية، وهو ما سماه صالح “الانقسام المعنّد للمعارضة السورية”. السبب الثاني للاستحالة “العنف بلا ضفاف”، فقد عاين الكاتب المعروف عنف النظام الوحشي الذي بلا ريبٍ يفجّر عنفًا مجتمعيًا مضادًا. سماها صالح الثورة المستحيلة في عامها الأول، ويرى التراجيديا الكامنة في “مقارعة المستحيل”، فيكتب أنّ “الثورة المستحيلة وقعت مع ذلك، غير أنّ مغالبة المستحيل مأساوية، مثل منازعة القدر في التراجيديا اليونانية”. واستطرد في ألم: “ما الذي نشهد عليه غير مأساة متمادية يقف العالم أمامها مشلولاً تتنازعه دواعي الإقدام والإحجام”. واستمرّ العالم بالفعل في هذا الإقدام والإحجام بعد نبوءة صالح تسعَ سنين، وصولا إلى “سورية ما بعد الزلزال” كما قال مجاهد ديرانية.
ثمّ يأتي من داخل الثورة صوت محمد طلال بازرباشي، أحد مؤسسي حركة أحرار الشام الإسلامية التي أسهمت بفاعلية في الثورة السورية، ليسمّيها “الثورة اليتيمة”. لم يوضح سبب تسميته هذه لها، على غير ما فعل ياسين الحاج صالح حين شرح لماذا هي مستحيلة، وذلك لأنّ الواضحات لا تُوضّح، فمعلومٌ ما يعني اليتم. وجه بازرباشي كلمته إلى المجتمع الدولي في حوار له مع قناة الحوار في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2012 : “كفاكم تخاذلاً.. كل الذي يجري في سورية صار واضحًا”. ومعلوم أنّه لم تستجب أي دولة ولم تتدخل الدول الإقليمية سوى لمصالحها. يقول بازرباشي من الداخل عن انعطاف محوري في سيرة “اليتيمة”، انعطاف السلاح: “كان من الواضح أنه لابد من البندقية، فهدير هتافاتنا العزلاء لم يكن كافيًا لمحو عارٍ تلطخنا به خمسين عامًا. رشقات رصاصٍ ليليةٍ متقطعةٍ هنا وهناك تشي بقلة ذخيرتنا، وتشهد أننا أحرقنا مراكبنا واخترنا اللارجعة”. ثم يقول: “هي بضعة مشاهد نقشتها هنا، لأنها كانت البداية، بداية الحياة الحقيقية، هي خطوتنا الأولى سعيًا إلى الوصول إلى حريتنا السليبة”.
وهنا يأتي الناشط البارز في الثورة السورية، أحمد أبازيد، ليسميها، من دون كناية اليتم التي يستعيرها بازرباشي، “ثورة المتروكين”. ويقول إنه ما من شعارٍ عبّر عن متروكية الثورة السورية أكثر من هتاف “ما لنا غيرك يا الله”، ثمّ أخذ في تفصيل أوجه هذه المتروكية، فمن وجهٍ، الثورة السورية متروكة اجتماعيًا، يقول أبا زيد: “هي ثورة المجتمعات المحلية الفاقدة لنخب المدينة”، فيصفها بأنّها “ثورة من لا صوت لهم أو لا خبرة لهم لتكون بذلك أقرب إلى ثورة من لا وزن لهم”. ومن وجهٍ ثانٍ، الثورة متروكة تقنيًا، فقد فقدت الثورة الخبرات الطبية والقتالية والإدارية اللازمة للنجاح والانتصار. ومن وجهٍ ثالث، الثورة متروكة دينيًا، فالخطاب الإسلامي معزول عن الحركية أو الجهادية أو فاقد التأثير، بحسب أبا زيد. ومن وجهٍ رابع، الثورة متروكة عسكريًا، إذ كان معظم المقاتلين من غير المحترفين، والمنشقون العسكريون ظلّوا قلة. ومن وجهٍ خامس، الثورة متروكة ثقافيًا، وهي متروكية تابعة للمتروكية الاجتماعية، فالنخب الثقافية الضيقة كانت من غير الفئات والطبقات الاجتماعية المحلية التي انخرطت في الثورة، فاتخذت تلك النخبة موقفًا مضادًا ونقديًا للثورة بالضرورة. ومن وجهٍ سادس، الثورة متروكة سياسيًا. ويشرح أحمد أبا زيد كيف أنّ النخبة السياسية السورية في الخارج كانت غير ممثلة للثورة السورية في الداخل، وكيف كرّست لقطيعة أيديولوجية مع الواقع الميداني السوري. ومن وجهٍ سابع، الثورة متروكة إقليميًا ودوليًا، وهذا واضحٌ للعيان، فلم يجد المجتمع الدولي سببًا كافيًا للتدخل لأجل نجدة المدنيين تحت القصف والقتل اليوميين. ولم تتدخل الدول الكبرى إلا لدحر تنظيم الدولة الإسلامية، بل استمر المجتمع الدولي بالتعامل مع النظام السوري ممثلاً لسورية. وقد يظن ظانّ أنّ أوجه المتروكية هنا قد انتهت، لكن أبا زيد يصدمنا أنّه حتّى “الباقين” من نشطاء وإعلاميّين ومقاتلين قد تركوا الثورة بين نزوحٍ من القصف، أو هروب من تنكيل النظام، أو من تهديد “داعش”، أو من عسر الحياة داخل الحصار وتحت القصف، فظلّت الثورة هكذا متروكة لا ناصر لها.
ولم تبتعد كاتبة هذه السطور كثيرًا عن دلالات الأسماء السابقة، حين سمت الثورة السورية الثورة الكاشفة، حيث كشفت هذه الثورة عن مستويات من الصراع في المنطقة، بخلاف الصراع العربي الإسرائيلي الذي ظلّ الصراع المركزي أكثر من نصف قرن. كشفت عن صراع عربي – إيراني وصراع كردي – تركي. كما أذكت الصراع بين المذهبين الشيعي والسني السلفي، ووُظّف هذا الصراع ببراعة في الصراع السياسي. وآخر ما كشف عنه الثورة السورية هو الصراع الدولي الأميركي – الروسي.
وهكذا، فبكشف الثورة السورية عن مستويات ومحاور أخرى من الصراعين، الدولي والإقليمي، لم تكن في بؤرة الاهتمام من قبل، فإنّ الثورة اليتيمة قد زلزلت أرض مشرقنا العربي عقودا مقبلة، بعد إصرار متروكيها على مقارعة المستحيل.
العربي الجديد
——————————-
========================
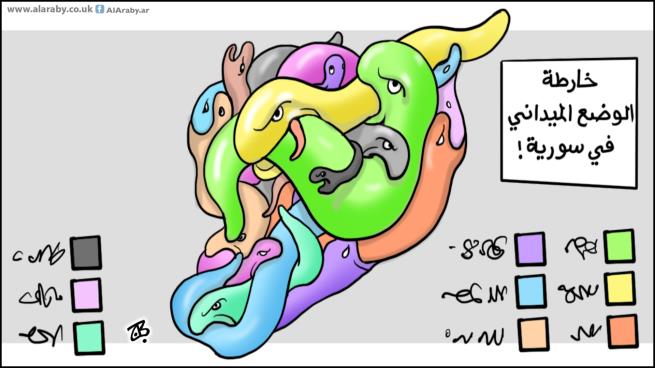
=============================
في المساجلة “عن طفولتنا السياسية” .. مبالغات وأخطاء/ حيّان جابر
أثار مقال المفكر والسياسي المعارض السوري، برهان غليون، “حان الوقت لتجاوز طفولتنا السياسية” والمنشور في “العربي الجديد” في 14/2/2020 نقاشاً قيماً بين الكاتبين، علي العبد الله في مقالتيه “المعارضة السورية وطفولتها السياسية.. تعقيب على برهان غليون” في 21/2/2020، و”إلى عمار ديوب: ما هكذا تورد الإبل” في 20/3/2020، وعمار ديوب “في نقد نقد طفولتنا السياسية” في 2/3/2020. وأضاءت المقالات بشكل متفاوت على أوجه خلل عديدة عانت، وما زالت تعاني، منها المعارضة السورية السياسية، الأمر الذي ساهم في إضعافها، وبالتالي في إضعاف الثورة السورية، ودخولها في متاهات عديدة، حتى ضلت الطريق، وتبوأت مواقع الفعل فيها قوى الثورة المضادّة التي تعمل على كسر الثورة، وفرض مصالح داعميها الدوليين أو الإقليميين.
وعلى أهمية الحوار الدائر في هذه المواد القيمة، إلا أنها لم تخل من مبالغات وأخطاء منهجية، انطلاقاً من نزعات رغبوية، وأحياناً بحكم قولبة الماضي وفق معطيات الحاضر، وهو ما يفقد الحوار عنصراً مهماً، يتمثل في دوره في تحليل الماضي وتفسيره ودراسته بدقة وعلمية، بهدف معالجته وتجاوزه نحو مستقبل أفضل، يلبي طموحنا وآمالنا وأهدافنا الوطنية الجماعية في وطن حر وديمقراطي تسوده قيم العدالة والمساواة بين جميع أبنائه. ومساهمة في هذا الحوار البناء، تحاول هذه المقالة الإضاءة على جوانب يراها الكاتب هنا غير واقعية وغير منطقية تضمنتها المواد المشار إليها سابقاً.
النقد بغرض النقد فقط
استند مقال برهان غليون، في غالبيته، على فكرتين مركزيتين، يمكن اختصارهما بنقد سياسات التعويل على الخارج واستدعائه من غالبية أطياف المعارضة السياسية، وافتقاد المعارضة السورية ثقافة الحوار الوطني الديمقراطي الحقيقي، بعيداً عن “تحطيم بعضنا بعضاً، وإقصاء واحدنا الآخر، وتشويه وجهة نظره وتسويد صفحته واسمه”، وفق كلمات غليون الحرفية. وبعيداً عن جمالية النقد وصوابية التوجه العام فيه، إلا أن المقال يترفع عن الدخول في بعض التفاصيل المحورية التي يصعب دونها الاستفادة من أي توجه نقدي، حيث لا يُقصد بالتوجه النقدي مقال غليون فقط، بل مجمل الكتابات والأصوات التي نقدت، بل وصرخت محذرة من هاتين الخطيئتين منذ اليوم الأول للثورة السورية.
ما هو النقد وما الغرض منه؟ وكيف نستفيد من تجاربنا الماضية، ومن تجربة الثورة السورية تحديداً؟ والأهم، كيف نضمن عدم تكرار الأخطاء المنهجية نفسها بعد عشر سنوات جديدة؟ لا يتطرق مقال برهان إلى أي من هذه المسائل بذريعة توحيد الجهود، وهو ما قد يؤدي إلى سلب النقد قدرته على التغيير الجذري، بغضّ النظر عن احتمال حدوث تغيير في الخطاب الآني لدى بعض الأطراف. كذلك يتجاوز المقال قوة تأثير المصالح والأهداف الذاتية المرتبطة بمصالح الأطراف الخارجية، وبالتالي قدرة هذه المصالح على إفساد أي إجماع وطني. ولا أعني تضمين المقال تعريفات نظرية عن النقد ومغزاه وأدواته ووسائله. ولكن يمكن أن نستشفّ ذلك من الخطوات والمرتكزات التي تنطلق منها المادة الناقدة بذاتها، وهو ما افتقده مقال غليون.
في الحالة السورية، وفي ظل تبعية عدة أطراف وقوى لداعميهم الخارجيين الذين هيأوا لهم قدرات وإمكانات مالية وسياسية، وأحياناً عسكرية، قادرة على فرض خياراتهم التي تمثل مصالح هذه الفئات التابعة، والتي باتت جزءاً من مصالح داعميهم، لا بد من أن يطاول النقد هذه البنية المستعصية على الحل، والإقرار بحتمية تجاوز هذه المنظومة وتخطيها، بكامل أركانها الجماعية والفردية، في خضم أي عملية نقدية وطنية تهدف إلى استعادة الزخم والمسار الثوري الذي يلبّي مصالح السوريين الوطنية وآمالهم وأهدافهم الوطنية. وبذلك يحدّد المقال ماهية النقد الذي يمارسه وأهدافه، بكونه نقداً ثورياً يسعى إلى عزل (ومحاصرة) المجموعات المأجورة وقوى الثورة المضادة على مختلف ألوانها ومواقعها، واستبدالها بجسم ثوري معبر عن الشارع، ومستمد منه، وخاضع مستقبلاً لمحاسبته، يقوم على أسس ديمقراطية، وشفافية مالية وسياسية، وخاضع لسلطة قضائية ثورية قانونياً أولاً وشعبياً ثانياً. من دون ذلك يصبح من السهل انحراف النقد عن أهدافه الثورية إلى أهداف أخرى، لا تمت لمصلحة سورية والسوريين بأي صلة، إذ لا تكمن الغاية من النقد بالنقد ذاته، بل بمدلولاته الثورية والتغييرية.
بين النقد أو المحاسبة والتشهير
يدعو مقال برهان غليون إلى إعطاء الحوار السوري – السوري أهمية قصوى، نظراً لحاجتنا إلى توحيد الجهود والرؤى قدر الإمكان، من أجل وقف حالة التفرقة والتضارب التي فرضتها، وفق المقال، التبعية الخارجية لقوى متناحرة، كما يدعو إلى وقف المهاترات والمزايدات الإنشائية الفارغة من أجل تحقيق هذا الغرض. لكنه يغفل مرة أخرى الإشارة، ولو على عجالة، إلى ضرورة التمييز بين النقد بغرض المحاسبة والمساءلة والتشهير بوصفه سلوكاً سلبياً يهدف إلى تشويه سمعة بعض الأشخاص، واتهامهم جزافاً بما لا يمتّ للواقع بصلة، سياسياً أم مالياً، فمن الطبيعي، بل ومن الواجب اليوم؛ وخطوة أولى لتعديل المسار الثوري؛ العمل على محاسبة جميع المسؤولين عن الوضع الحالي، بداية من النظام السوري وانتهاء بفصائل المعارضة السورية العسكرية والسياسية، وقواها وهيئاتها، على المستويين الجماعي والفردي، فما دون ذلك سوف يعني التستر على المفسدين والناهبين والمرتزقة والمجرمين، بغض النظر عن مكان وجودهم وطبيعة اصطفافهم السياسي، وسوف يفضي ذلك لا محالة إلى حمايتهم، وتمكينهم من المضي في الممارسات المسيئة للثورة والضارّة بمصلحة سورية والسوريين. ولذا من واجبنا، مثقفين ومعنيين بالشأن السوري، التمييز بين ضرورة تشجيع النقد العلمي والموضوعي المبني على حقائق مثبتة، ودعمه بنظام قضائي يستقصي الحقائق، وينظر في صحتها ويحاسب جميع المسيئين بغض النظر عن موقعهم الراهن أو السابق، وضرورة نبذ التشهير بأي جهة أو شخص كان، ومحاصرة ذلك ومنعه، وبغض النظر عن مدى توافقنا أو تعارضنا مع هذا الشخص أو الجهة، فالتشهير سلوك مدمر لجميع الجهود الوطنية، وهو على النقيض من المحاسبة التي تعتبر بداية مسار الحوار والبناء الوطني.
التضحية بين الإيمان الديني والديمقراطية
لا يُولد تكرار بعض المزاودات في بعض النقاشات العامة البعيدة عن الموضوعية والدقة الاستغراب والاستهجان، على اعتبارها من أنواع التفريغ النفسي الضروري أحياناً. لكن؛ وعلى العكس؛ فإن ورودها، ولو على عجالة، في أي نقاش جدي؛ كالحاصل في مقال علي العبد الله الأول؛ يحتم علينا نبذ هذ الظاهرة ونقدها، كي لا تتحول بفعل تكرارها إلى حقائق دامغة وثابتة. ومنها مفهوم التضحية وعلاقته بالإيمان الديني أو بالانتماء الديمقراطي أو اليساري، والذي يمكن نقده بسهولة، استناداً إلى وقائع الثورة السورية ذاتها، فضلاً عن إمكانية نقاشه وفق أبعاده التاريخية والعالمية التي شهدت بروز قوى ثورية يسارية أحياناً، وغير يسارية أحياناً أخرى، على القدر ذاته من التضحية والإيثار، وهو ما يكشف خطأ هذه الافتراضات الجوفاء. وعليه، وبما يخص الثورة السورية تحديداً، يبدو واضحاً الالتباس عند الكاتب، بالمقارنة بين تضحيات الشباب الثائر عموماً (ينسبها في جلها خطأ إلى أحزاب يمينية أو إسلامية) وتضحيات الأفراد والرموز ذات التوجه اليساري. حيث لن نختلف على تضحية الشباب السوري الثائر داخل المدن والأرياف والبلدات السورية قاطبة، وبغضّ النظر عن هويتهم الفكرية، من دون التنكر لرجاحة كفة الشباب غير المنتمين إلى أي تيار سياسي أو حتى فكري، دينياً كان أم ليبرالياً أم ماركسياً، وذلك بحكم انعدام الحياة السياسية والثقافية والمطلبية في سورية الأسد قبل الثورة، في مقابل انعدام شبه كامل لتضحيات القيادات، ذات الميول اليمينية أو اليسارية على السواء.
وفي ما يخص ظاهرة هروب رموز المعارضة من عنف النظام وجبروته، أتفق مع المقال بشأن آثارها السلبية، مع تحفظي على تعميمها، فهناك من تم إبعاده وترحيله من النظام بشكل مباشر أو عبر اتفاقات ومعاهدات لتبادل المعتقلين؛ ولنا بإبعاد المناضل العربي سلامة كيلة خير مثال على ذلك؛ وتحفظي كذلك على لوم المغادرين أو الهاربين؛ كما وصفهم المقال؛ فلكل منا ظروفه وأوضاعه وقدراته الجسدية والنفسية. وخطيئة ثانية تضمنها مقال علي العبد الله في هذا الخصوص، تتمثل بحصر هذه الظاهرة ضمن الوسط المعارض الديمقراطي واليساري السوري فقط، وهو ما تكذبه ظاهرة خواء الساحة السورية الداخلية من جميع قيادات الإسلام السياسي بشقيه، التنظيمي والتعبوي، نتيجة خشية بعضهم من العودة إلى سورية في المرحلة التي سبقت الثورة، وهي بالمناسبة مخاوف مشروعة، ونتيجة مغادرة أو هرب القسم الأكبر من الموجودين داخل سورية قبل بدء الثورة، وبحكم صمت جزء لا يستهان به منهم وتحفظهم على تأييد الثورة ومعارضة النظام مدة طويلة نسبياً، امتدت على طول مدة بقائهم داخل سورية، وهي ثلاث حالات تعكس مدى تحفظ قيادات قوى الإسلام السياسي على التضحية بالذات، على نقيض تضحيات الشعب السوري، يساريين وإسلاميين وليبراليين من غير الفئة القيادية، وفق نسب تعكس حجم التيارات الفكرية الأساسية؛ على محدوديتها؛ مع ضرورة التمييز بين الإسلام ديناً وثقافة عامة والإسلام السياسي خياراً أيديولوجياً وحزبياً وعقائدياً.
الإسلام الحزبي والشعبي والسياسي
الإسلام الشعبي اتجاه ديني يصفه بعضهم بالفطري؛ ولا يمكن اعتباره فطرياً كونه نتاج ثقافة وبنية المجتمع المتوارثة؛ والإسلام السياسي خيار حزبي وأيديولوجي، ورؤية شمولية للدولة والمجتمع. التناقض بينهما صارخ وكبير، ولا مجال في العمل السياسي والثقافي والاجتماعي لأي خلط بينهما، سواء في المجتمعات ذات الغالبية الإسلامية أو في غيرها، فهي ظاهرة عالمية عالجها المفكر عزمي بشارة في كتابات وتوضيحات كثيرة مهمة. لكن، وبغض النظر عن نقاش الظاهرة وتداخلها عالمياً، علينا التعاطي معها بدقة في مجتمعاتنا وأوساطنا السياسية والثقافية، عبر التمييز بين الاثنتين، فظاهرة التدين الشعبي عامة ومنتشرة في كل سورية، حتى في الأوساط غير المتدينة، وتتمظهر في لغة الخطاب والتعبيرات اليومية، وأحياناً بالملابس والأمثال الشعبية وبعض المفاهيم العامة التي يرددها الجميع، بغض النظر عن مدى إيمانهم المطلق بها. أما الإسلام السياسي فيسعى إلى بناء نظام صارم ومحدّد وثابت للدولة والمجتمع، وهو ما يدفع أوساطاً متدينة وغير متدينة عديدة إلى نبذه، ورفضه بالحد الأدنى. لذا من الخطأ اعتبار كل من قال باسم الله، أو الله أكبر، أو الله الحامي أو الله على المفتري والظالم، جزءاً عضوياً من قوى الإسلام السياسي، بل قد يكون صاحب هذه العبارات قومياً أو يسارياً، وفي بعض الحالات قد يكون ملحداً أيضاً، كونها تعبيرات اجتماعية ذات مدلولات غير دينية، وإن كانت تعبيرات دينية ظاهرياً.
ويخلط مقال علي العبد الله بين تيارات الإسلام السياسي المتطرّفة، كالقاعدة وداعش وجبهة النصرة، والتيارات الحزبية كحركة الإخوان المسلمين السياسية، وهو ما حاول مقال عمار ديوب الإشارة إليه بصيغة تستهجن هذا الخلط بقوله “لماذا يدافع العبد الله عن قضية خاطئة، وقد انتقد الإسلاميين، ورؤيتهم الطائفية والفئوية في الثورة السورية في مقالاتٍ كثيرة؟” انطلاقاً من انجرار مقال علي العبد الله الأول نحو الدفاع عن حق التيارات الإسلامية في العمل، وإبراز حجم قوتها الشعبية، إلى درجة ضرب المثل بشعبية قوى رجعية متطرّفة كداعش وجبهة النصرة، لا خلاف بشأن دور أجهزة المخابرات في وجودها، ولا مدى عدائية الشارع السوري لها، بدليل خروج مظاهرات عديدة رافضة لها داخل مناطق سيطرتها، من دوما وغوطة دمشق الشرقية، إلى محافظة إدلب ودرعا وأرياف حمص. لذا كان الأجدى أن يوضح العبد الله الفرق بين التوجهين الإسلاميين، والتمييز بين أسباب وجود وظهور كل منهما، وتبيان مدى استنادها لقوة التأييد الشعبي، أو لعوامل وأسباب خارجية لا قدرة للسوريين اليوم على مواجهتها في ظل الحرب القذرة المستمرة عليهم منذ تسع سنوات.
ويعرض مقال علي العبد الله الأول ملاحظة دقيقة، أشاركه الاتفاق في أهميتها، من دون المبالغة في تحميلها الأسباب الكاملة، وهي “لكن السبب الرئيس لخسارة المعارضة الديمقراطية، برأيي، وجود هوة واسعة بين حواضن الثورة ورؤية المعارضة الديمقراطية السياسية والاجتماعية، وفشل الأخيرة في جسر هذه الهوة، هذا إذا كانت تقرّ بوجود هذه الهوّة وخطورتها وتدرك ضرورة العمل على جسرها”. ولكنه ينطلق من هذه الملاحظة إلى نتيجة غريبة وعجيبة، لا تمت للملاحظة الأساسية بأي صلة مفادها ” فشعارات المواطنة؛ والدولة المدنية التعدّدية؛ شعارات نخبوية.. ما جعل تشكيل ألوية جهادية ومكاتب شرعية وحسبة وبيت مال ورفع شعارات تنادي بالخلافة أو الإمارة التقليدية تحصيل حاصل”!!. تنطوي الخلاصة على عثرات وأخطاء تحتاج إلى جهد كثير لتوضيحها وشرحها. ولكن التركيز هنا على أهم مواضع الخلل فيها، كانطلاق الكاتب من إبراز فوقية الشعارات السياسية الثقافية، وانعزالها عن هموم الشارع السوري ومشكلاته، بشقي هذه الشعارات، اليساري والديمقراطي فقط، معتبراً شعارات الإسلام السياسي أقرب إلى هموم الشارع ومشكلاته، وهو أمر يناقض الواقع، فقد فشلت غالبية قوى الإسلام السياسي تماماً كما فشلت غالبية القوى اليسارية والديمقراطية في اجتذاب الشارع إلى هياكلها التنظيمية، وهو ما عبر عنه الشارع الثوري في الهتافات، وفي الآليات التنظيمية الجديدة التي أفرزها، من التنسيقيات واللجان الأهلية، على طول مراحل الحراك الثوري الشعبي، وقبل الولوج في مرحلة العسكرة. ولا يضر التذكير هنا مرة جديدة بأن هناك فرقاً بين شعارات قوى الإسلام السياسي وأهدافها وبعض التعبيرات والمدلولات الإسلامية الشعبية التي لا تعبر عن توجه سياسي محدد.
كان من الأفضل لو انتقل الكاتب من نقد الشعارات الفوقية للأحزاب والقوى التقليدية، وابتعادها عن هموم الشارع، إلى دعوة هذه القوى إلى رفع شعارات وأهداف تمسّ حياة السوريين اليومية على جميع الأصعدة، خصوصاً الاقتصادية والاجتماعية والخدمية والوطنية والسياسية والقانونية طبعاً، وفق كل مرحلة من مراحل النضال، واستناداً إلى حجم الوعي الثوري المكتسب في الشارع السوري، عبر ممارسة النضال والتظاهر. وهو بالمناسبة جهد نجحت به نسبياً بعض القوى اليسارية، وبالتحديد الماركسية، في مناطق جغرافية محدودة المساحة في مرحلة النضال الثوري السلمي، أي قبل العسكرة، لكنها واجهت بعد الانتقال إلى مرحلة العسكرة استبداد النظام وقواه الأمنية وإجرامهما؛ واستبداد الجماعات التكفيرية المتطرفة وإجرامها الذي وصل إلى حد تصفية عديد منهم فردياً وجماعياً.
قولبة الماضي
يقع باحثون وكتاب في الإشكالية المنهجية، استعادة قراءة الماضي أو التاريخ انطلاقاً من نتائج الحاضر، وهو ما وقع فيه مقال علي العبد الله الأول، إذ اعتبر أن أسباب سيطرة قوى الإسلام السياسي على المناطق المحرّرة تعود إلى قوة الدعم الشعبي الذي تحظى به، وهي عملية قولبة للماضي وتغيير للحقائق، تتيح تفسير سيطرة قوى إسلامية متعددة على المشهد المعارض السوري بأسباب غير حقيقية. في حين يفرض علينا فهم الحالة السورية، ودراسة تاريخها، العودة إلى المرحلة السابقة بدقّة وموضوعية، كما أشير إلى جزء منها أعلاه، بخصوص هامشية تأثير قوى الإسلام السياسي في مرحلة النضال الثوري السلمي.
بدأت العسكرة بمجموعات صغيرة محلية غير مؤدلجة بغالبيتها، وذات طابع وطني عام، عملت على حماية المظاهرات الخاطفة، المعروفة في سورية بالمظاهرات الطيارة؛ إشارة إلى سرعتها وتعدد مناطقها؛ وهي شكل جديد ابتدعته الحركة الثورية لمواجهة آلة النظام الأمنية التي حالت دون تنظيم مظاهرات كبيرة وجماهيرية، بفعل القمع الهمجي والإجرامي باستخدام القناصة والعيارات النارية الحية. ومن ثم ونتيجة تصعيد النظام لحملته القمعية، واقتحامه المدن والبلدات بقواه الأمنية والعسكرية، وبفعل كذب أطراف محسوبة على قوى يمينية وتضليلها، تم فرض منهجية جديدة على المجموعات المسلحة، عبر تحميلها مسؤوليات ومهام لا تقوى عليها قدراتها الذاتية، كحماية المدن والبلدات، بدلا من حماية المظاهرات فقط، وهو ما جعلها تقع بين نار النظام ونار الخضوع لطلبات الداعمين القادرين على تزويدها بالمال والسلاح اللازم؛ وهم في غالبيتهم العظمى؛ الداعمين، من المحسوبين على قوى الإسلام السياسي، وهو ما انعكس رويداً على هذه التشكيلات العسكرية بتغيير عناصرها وقادتها وأسمائها ونوعية سلاحها وشعاراتها، بعدما كانت تحرص على شعارات وأسماء وطنية، كتسمية الجيش الحر عموماً؛ بغض النظر عن تحفظنا على صحة استخدام تعبير جيش في هذه المرحلة.
من المفيد للكاتب العزيز علي العبد الله العودة إلى تجارب مئات المجموعات العسكرية الأهلية والمدنية الأولى في سورية، والتي كشفت عن امتناع الداعمين عن تزويدها بأي قطعة سلاح مهما كانت بسيطة ومحدودة، حتى في أقصى حملات النظام العسكرية والأمنية، من دون خضوع هذه القوى لرغبات الداعمين الكاملة، وهو ما كان يؤدي إلى سيطرة النظام على المنطقة، واقتحامها وسلبها وتدميرها واعتقال شبابها. ومن ثم وبعد الرضوخ لمطالب الداعمين، يتم تزويد المجموعات الشبابية والأهلية المسلحة الباقية بقدر معين من السلاح الكافي لطرد قوات النظام، وفرض سيطرة ورؤى الداعمين على هذه المنطقة. وقد تكرّر هذا السيناريو في مئات المواقع، وفي جميع المحافظات السورية. لذا يمكن للكاتب التيقن منه بكل سهولة، عبر الاستفسار عن تجارب المناطق الذاتية من نشطائها وثوريّيها غير المؤدلجين.
ولم يكتف المقال بهذه القولبة لتاريخ الثورة السورية، بل تبعته قولبة أخرى، تناست مئات المظاهرات والاحتجاجات المناطقية في المناطق المحرّرة، رفضاً لهيمنة قوى مسلحة محسوبة على تيارات الإسلام السياسي، بداية من “داعش” وجبهة النصرة، وليس انتهاء بجيش الإسلام وما شابهه، وتم رفض هيئاته الشرعية على مختلف تسمياتها وتقسيماتها. لكن وبحكم حصار هذه المناطق، وسيطرة قوى الإسلام السياسي العسكرية على السلاح، وجميع طرق إمداد المناطق، ونتيجة استبداد هذه القوى وقمعها وإجراميتها، تم إخضاع المجتمع المحلي في هذه المرحلة، حيث كانت المجتمعات المحلية والأهلية، والسوريون عموماً من أنصار الثورة، يعزون أنفسهم بسهولة تجاوز هذه القوى الدخيلة على الثورة وعلى السوريين في المرحلة التي تعقب الخلاص من نظام الأسد. ولذا حاولت المجتمعات المحلية أن تؤجل معركتها مع هذه القوى الإسلامية الاستبدادية، خدمة لمعركتها الكبرى مع النظام.
بين موجتين ثوريتين
انطلق عمار ديوب في مقاله من قراءة الموجة الثورية العربية الثانية، كي يحلل توجهات الموجة الأولى، من دون أن يوفق بذلك. وكان من الأفضل لو حلل الموجة الأولى للثورات انطلاقاً من معطياتها التي يعلمها جيداً، كما أغفل أهمية إبراز موضع الترابط بين الموجتينالثوريتين. فمن ناحيةٍ، قدمت الثورة السورية مئات الأدلة على جوهرها الوطني غير الديني، لا سيما في مرحلة النضال المدني السلمي الذي اعترف رأس النظام باستمراره ستة أشهر، من الشعارات والهتافات، إلى لوائح المطالب التي نظمتها الجماهير الثائرة في أكثر من مدينة وبلدة، كدرعا البلد وغوطة دمشق الشرقية، وحمص وغيرها من التجمعات الشعبية. وفيما يخص الموجتين الثوريتين، الترابط بينهما على المستويات، السياسي والثقافي والوطني، واضح جداً، وهو ما أوضحته مئات المقالات والدراسات التي تناولت الموضوع، لكنه ترابط تراكمي لا يمكن عكسه. لذا لا يمكن تفسير الموجة الثورية الأولى استناداً إلى هتافات الموجة الثانية وأهدافها، بسبب اختلاف الزمان والمكان. ولكن قد يمكن تفسير الموجة الثانية انطلاقاً من الموجة الأولى، على اعتبارها امتداداً وتطوراً وتعبيراً عن استفادة الشعوب من تجارب الموجة الأولى، بغض النظر عن موضع كل ثورة، فالثورة مدرسة يومية تراكمية، تنهل منها الشعوب الثائرة، بغض النظر عن مكانها وموقعها، لذا نجد دائماً بصمات واضحة لجميع الثورات في ثورات أخرى، كبصمة تونسية في الثورة اللبنانية، أو سودانية في العراقية، وعراقية في الجزائرية، وسورية في السودانية وهكذا.
.. وأخيراً، يمكن الخروج بخلاصات مهمة من هذا النقاش الحيوي والضروري، قد تمكّن من تجنب تكرار أخطاء الماضي مستقبلاً، وتدفعنا نحو تجارب جديدة، تهدف إلى استعادة زمام المبادرة، وإحياء الخطاب الوطني الجامع، والاتفاق حول برنامج تحرري وتنموي يقود المرحلة النضالية المقبلة.
العربي الجديد
—————————————
عن سورية الثورة والشعب العنيد/ حسام الحميد
يجدر، في ذكرى انطلاقة ثورة الحرية والكرامة في سورية، التفكير في السنوات التسع التي مرّت على الشعب السوري بكل ثقلها الأسود، محمّلة، مع كل يوم من أيامها، بكل أشكال العنف الدموي الذي مارسه النظام الأسدي ضد شعب أعزل، خرج يحلم بالحرية والكرامة، ومطالباً بأبسط حقوقه، العيش الكريم. خرج منادياً “الشعب السوري ما بينذل”. وكانت هذه العبارة الركلة الأولى التي أسقطت جدار الخوف من هذا النظام الطائفي المقيت، الذي دمّر النسيج الاجتماعي في سورية خمسين سنة، قبل أن يدمر اليوم البشر والحجر. ولم تكن السنوات التسع، بقضها وقضيضها، كافية لكي يدرك المجتمع الدولي مدى حقد النظام المجرم ودمويته، ولم تكن هذه السنوات كافيةً للعالم، ولا حتى العرب، للعمل على منع النظام من ارتكاب مزيد من جرائم الإبادة الجماعية في سورية، بل تجرأ بعضهم على المطالبة بعودة النظام إلى جامعة الدول العربية.
ولكن منذ الأيام الأولى لثورة الحرية والكرامة، أدرك الشباب الثائر أن ثورته ضرورة حتمية للخلاص من حكم عصابة العائلة الأسدية التي استولت على السلطة، فحولت سورية مزرعة تمتلكها، وعانى الشعب، تحت حكم نظام الاستبداد والشمولية خمسة عقود، من الفقر والبطالة وفساد كبير في كل قطاعات الدولة، وعانى من قبضة أمنية شديدة، أدت إلى موجات من القمع والاعتقالات الواسعة لفئات كثيرة من الشعب. وبالتالي، صار الإيمان لدى هذا الشباب الثائر بأنه مهما كان الثمن غالياً، فالثورة من أجل إسقاط النظام أكثر من ضرورة، للخلاص من العصابة المجرمة، وبقاؤها حتماً سيكلف الشعب السوري كل ما يملك.
ولم يدرِ الشباب السوري الذي خرج يطالب بحريته أن هذا المطلب لن يغير النظام فحسب، بل سيكون خطراً قد يغير العالم، فلم يشهد العالم، منذ نهاية الحرب الباردة، صراعاً عالمياً كالذي يحدث في سورية، يبدو في ظاهره محلياً، لكنه أكثر تعقيداً بين الإقليمي والعالمي، فقد أصبحت الأرض السورية المستباحة اليوم من عدد لا متناهٍ من الدول مسرحاً للصراع العسكري والسياسي بين هذه القوى، العالمية منها والإقليمية، وتُرك الشعب السوري يواجه قوى عسكرية كبرى وحده، من دون أي دعم أو مساندة.
تسع سنوات من سياسة تحويط الأزمة لم تعط أكلها، فلم يسبق أن شهد أيٌّ من صراعات العالم هذا الكمّ الهائل من التصريحات والتصريحات المتناقضة والمضطربة لقادة الدول اللاعبة في الملف السوري ومئات من الاجتماعات الأممية والقرارات الدولية واللجان، واللجان المختصة والقرارات الصادرة عنها. ولم يعرف أي صراع في العالم هذا العدد الهائل من قرارات الفيتو ضد قضية شعب أعزل، خرج مطالباً بحريته، فلماذا كل هذا التناقض، ولماذا يرغب المجتمع الدولي في بقاء الأزمة السورية بلا حل إلى أجل غير مسمى؟ للإجابة، يجب أن نعرف أن المعادلة الوحيدة التي يتفق عليها كل الأطراف المتصارعة اليوم أنه لا مصلحة لأحد في الجوار الإقليمي بأن تنجح الثورة السورية، وتبني بلداً ديمقراطياً، فتغيير النظام الأسدي كان سيؤدي حتماً إلى قلب كل توازنات المنطقة التي اشتغل الغرب والشرق على بنائها عقوداً طويلة. وتغيير النظام في سورية، وهو الحليف الوثيق لإيران في المنطقة، كان سيؤدي مباشرة إلى تغيير النظامين في لبنان والعراق التابعين للوصاية الإيرانية. وقد تصل شعلة التغيير إلى دول الخليج، الخزان النفطي الاستراتيجي، وحتى إلى تركيا التي لن تكون بعيدة عن هذا التأثير. لذلك وقف الجميع يتأمل مصيره في حال نجاح الثورة، وحصول المواطن السوري على حريته من نظام استبدادي، جعل من البلد جسراً ليلعب دوره في خدمة العالم ثمناً لبقائه في السلطة. ولهذا كان الموقف العالمي كله معادياً لهذه الثورة العظيمة التي تهدد فعلاً بتغير المنطقة، وهذا ما يعرفه اللاعبون الإقليميون، فقد فعل الجميع، (نعم الجميع) أقصى ما في وسعهم وقوتهم لوأد هذه الثورة العظيمة وإفشالها، منذ بدا لهم أن النصر حليف الثورة، وأن سقوط النظام بات قاب قوسين.
ولندرك قوة هذه الثورة، وصلابة الشعب السوري الثائر، ولنعرف ماهية الصراع الذي يخوضه اليوم ضد دول وقوى خارجية وداخلية، علينا العودة إلى بداية الثورة السورية، والانتصارات التي حققتها، واتساع رقعتها وسيطرتها على مدن وقرى كثيرة، لنعرف لماذا بات على الشعب السوري، بعد أن واجه النظام بكل قوته ووحشيته، أن يواجه إيران التي زجّت عشرات آلاف “المجاهدين” من حزب الله، ثم المليشيات الطائفية العراقية، ثم الحرس الثوري الإيراني وتوابعه. وبعد أن اقتربت قوى المعارضة من إسقاطه، دفعت إيران لذلك مليارات الدولارات، وقدمت كل احتياجات السلاح، ودفعت الأسد إلى استخدام طيرانه وصواريخه الباليستية ضد المدنيين، ولكن ذلك كله لم يكن ليكسر عزيمة الثوار على الأرض، وفشلت إيران، كما فشل النظام في إخماد هذه الثورة، ما دفعها إلى طلب تدخل الجيش الروسي، بكل ترسانته من الأسلحة الثقيلة والطيران، الذي لم يترك سلاحاً لديه، قديماً أو جديداً، إلا جرّبه في قتل المدنيين السوريين، وتدمير المدن باستخدامه سياسة الأرض المحروقة، ولا يزال، بعد مرور نحو خمس سنوات على التدخل الروسي في سورية، غير قادر على إنهاء الثورة عسكرياً.
ولأن التدخل الخارجي، الإيراني والروسي، حقق مكاسب كبيرة عسكرياً على الأرض، كان لزاماً على كل من تركيا والمملكة المتحدة وفرنسا وأميركا أن تعمل على تدخل مضاد، ولكن ليس لمصلحة الشعب السوري، بل لمصالح خاصة بها، وهو تدخل جاء بعدما أيقن الجميع انتهاء سورية الأسد وسقوطها تماماً، فبدأ الجميع يبحثون عن محاولة للإمساك بما يمكنهم من التأثير في رسم خريطة المصالح في صياغة مستقبل سورية، وعمد كل طرف إلى تغطية أهدافه الحقيقية بأهداف وهمية، فكان تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وكان التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب جسراً لأن تتدخل هذه الدول في الصراع عسكرياً، من خلال دعم وحدات حماية الشعب الكردية تحت مسمى قوات سوريا الديمقراطية، للسيطرة على المنطقة الشرقية في سورية كاملة بعد هزيمة “داعش”، وهذا ما شكل خطراً حقيقياً على حدود تركيا التي تعتبر هذه الوحدات منظمة إرهابية، غرضها زعزعة الأمن القومي التركي. ولذلك، لم يكن لدى الأتراك خيار سوى التدخل عسكرياً في الأراضي السورية من خلال عملية درع الفرات في 2016، ثم أتبعوها بعملية غصن الزيتون في 2018، لاحتواء التمدّد الكردي على الشريط الحدودي المتاخم لتركيا، ثم كانت عملية نبع السلام في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وتالياً، عملية درع الربيع في فبراير/ شباط 2020.
وبهذا يمكن القول إنه ليس لأيٍّ من الجيوش الخمسة المتحاربة على الأرض السورية مصلحة في انتصار الثورة السورية، وهي لم تفعل أي شيء لتحقيق مطالب الشعب السوري، بل عملت جاهدة على سلب القرار من يده، وتحطيم عزيمة الثورة وتفتيت قواها، من خلال مسرحيات جنيف وأستانة وسوتشي. ولكن على الرغم من مرور السنوات التسع، ووجود كل هذه الجيوش والمليشيات والعصابات والمنظمات الإرهابية على الأرض السورية، فإن ثورة الشعب السوري التي يقف كل العالم بوجهها عظيمة، وسيذكرها التاريخ بأنها الثورة الأكبر والأكثر تميزاً والأكثر تأثيراً في العالم. لقد حققت انتصارها المحلي منذ اللحظة الأولى لانطلاقها، فقد أسقطت جدار الخوف، وكسرت مملكة الصمت، وأسقطت شرعية النظام المجرم. وعلى الرغم من صعوبة الظروف المحيطة بها الآن، وعلى الرغم من دخولها في متاهة صراع المصالح الدولية والتغيير الإقليمي، ستعيد سيرتها الأولى وستنتصر، حتماً ستنتصر.
العربي الجديد
—————————————–
==========================
————————————–
فيروس كورونا السياسي/ ميشيل كيلو
سبق فيروس بشار الأسد ونظامه الأمني فيروس كورونا إلى تقديم نموذج مريع للفتك بالبشر. ويمكن القول، في المستوى الأخلاقي، إن الفيروس الأسدي لم يفتك بالسوريين وحدهم، بل فتك أيضا بالعالم الذي انحدر بجرائمه إلى مستوىً غير إنساني، قوّض جميع مرتكزات الإجماع البشري وأخلاقياته، وأغرقها في الهمجية التي صمت بعض المجتمع الدولي عليها، وانخرط بعضه الآخر بحماسةٍ فيها، وشارك في قتل آمنين وعزّل، باغتتهم وحشيتها، مثلما باغت فيروس كورونا البشر في كل مكان من عالم حلّت عليه “لعنة سورية”، وما بلغته الإنسانية من انحطاط، تعايش معه عتاتها الذين فتكوا بمن طلبوا حريتهم، ودمروا وجودهم وقوّضوا مجتمعهم ودولتهم وقدرتهم على العيش. ومثلما يفتك اليوم الفيروس بمواطني العالم بلا تمييز، ويغتالهم من دون رحمة، فتك فيروس الأسدية بالسوريين من دون تمييز، بعد أن أحكم قبضته على وجودهم قرابة نصف قرن، مزّقهم خلاله شر ممزّق باسم توحيدهم، واستعبدهم بذريعة منحهم الحرية، وانتزع اللقمة من أفواه أطفالهم باسم الاشتراكية. وها هو فيروس يستخدم فيروس كورونا ليُجهز على من نجا من براميله المتفجرة وصواريخه، وطائرات حلفائه الروس والإيرانيين، تنفيذا لأمر من قال في بدايات الثورة لبشار الأسد: أعدهم ستة ملايين، كما كان عددهم عندما “استلمهم” أبوك عام 1970!
فعل الكورونا الأسدي فعله تسعة أعوام من ثورة، شارك العالم خلالها في قتل السوريين بالسلاح من جهة، وبدم الفرجة البارد على موتهم من جهة مقابلة. وها هي دوله تدرك، وهي تستغيث، أن انقساماتها التي مكّنت للأسدية من الشعب السوري، ليست نقطة قوة لأي طرف منها، وأن الإنسانية تواجه الموت، لأنها لم تكن جسدا واحدا في مواجهة قتلة السوريين وموتهم الذي تغطي دلالاته الأخلاقية والسياسية الإنسانية بأسرها، وتخبر جبابرة زماننا أن أحدا لن يبقى آمنا، إن هو سمح بانتهاك حق غيره في الحياة والأمن، أو أسهم في انتهاكه، وتجاهل أن الرد على كورونا كالرد على الأسدية: ينجح بقدر ما يكون إنسانيا وشاملا، ويصدر عن بني البشر، بوصفهم جسدا مترابط الأجزاء، يضرب على أيدي القتلة بالسلاح، ليحصّنهم ضد موتهم بالأمراض، باعتبارهما معركةً واحدة هدفها حماية الإنسان من كل شر، بشريا كان أو طبيعيا، ومنع أيٍّ أحد من وضع نفسه أو سلطته ونظامه فوق أية قيم ومعايير أخلاقية وتشاركية، يرتبط مصير البشرية بها، وتكريس جهود العالم وذكائه لخير مواطنيه، وحفظ حقوقهم، وفي مقدّمها حقهم في الحياة الذي تتشارك جميع الفيروسات السياسية والمرضية في انتهاكه، وها هو كورونا يعلمنا أن استمرار البشرية يتوقف على تضامنها وما تنعم به من سلام، وأن التقدّم التقني لا يحصّنها ضد ما فيها من شرور من دون تضامن وإخاء، لو توفرا لنيويورك، عاصمة المال والتقانة، لواجهت كورونا خيرا مما تفعل!
بعد فيروسي كورونا، الأسدي والمرضي، سينهار العالم إن لم يذهب إلى نمط من التعايش التضامني، يضع حدا لمواقف من يقولون “اللهم أسألك نفسي”، و”لا شأن لي بجاري، قتل أو حرق”، ويفتح صفحةً جديدةً، لحمتها وسداها تضامن بلا حدود، فيه وحده إنقاذ بني الإنسان بأيديهم، مثلما يفعل اليوم الأطباء الصينيون والكوبيون والألبان والصوماليون الذين يواجهون الموت بأرواحهم، ليحموا حياة مواطني إيطاليا.
يذكّر كورونا جبابرة الليبرالية المتوحشة بالإخاء الإنساني الذي يدفعون ثمنا فادحا لتناسيه، ويريهم أنهم لا يسيطرون حقا على عالمٍ يغرقه الاستبداد في الدم، بينما تعاني بلدانهم من الهشاشة التي فضحها كورونا. وتتحدّى كورونا الليبرالية، وتؤكّد أنها لا تقل استهانةً بالحياة من الاستبداد الأدي. تُرى، ألم يحن الوقت لليبرالية إنسانية تنقذ شعوبها، وتنقذ البشرية من فيروس الاستبداد الذي فاق فتكه بشعب سورية فتك أي فيروس مرضي بأي شعب آخر؟
العربي الجديد
—————————————-
================================





