هل مازال الشعر ديوان العرب؟ -مقالات مختارة-
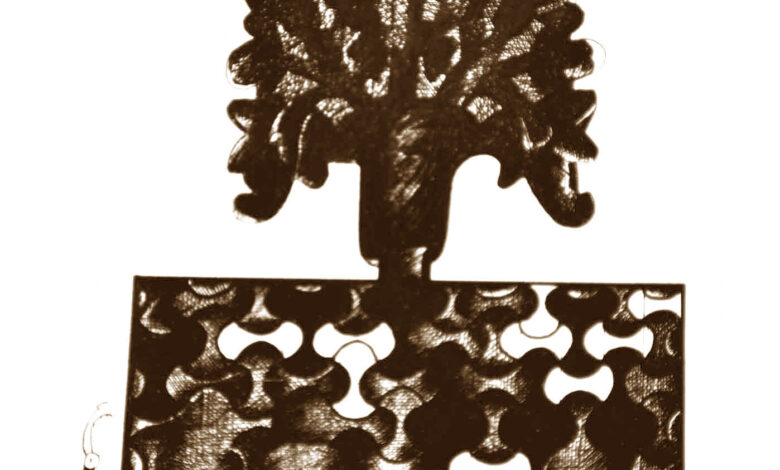
قصيدة النثر.. ليست خالصة للشعر/ عباس بيضون
عندما ظهرت قصيدة النثر لأول مرة في الأدب العربي، كان هذا قبل قصيدة التفعيلة. ظهرت كأثر مباشر للاتصال بالغرب. لا بد أن أمين الريحاني وبشر فارس وبعدهما ألبير أديب كانوا، في لبنان ومصر، حصيلة مباشرة لقراءة ويتمان والسريالية الفرنسية. مع ذلك، لم تخصب هذه القصيدة آنذاك في الشعر العربي ولم تصبح موجة، وتكسّرت على حاجز القصيدة الموروثة. كان على قصيدة النثر أن تنتظر حتى الخمسينيات ولتتواصل، هي وقصيدة التفعيلة، وتبنيان، كل لنفسها، مساراً خاصاً. مع ذلك، بقيت قصيدة النثر، حتى أيامنا، غريبة ومثار جدل دائم. خرجت قصيدة التفعيلة من معترك الجدل، وفرضت نفسها وريثة شرعية للقصيدة العربية، وقُبلت على هذا الأساس، في ما تبقى قصيدة النثر أمام سؤال يتناول وجودها وشرعيتها.
لعل محمد الماغوط هو الوحيد الذي نجا من هذا الجدل، وقُبل على مضض، فيما بقي الآخرون، جميعهم تقريباً، أمام إنكار معلن، ليس فقط من شعراء ونقاد، ولكن أيضاً من جمهرة واسعة من قرّاء للشعر. لا يقرّ هؤلاء بشرعية لقصيدة النثر ويعتبرونها، فضلاً عن ذلك، افتعالاً بحتاً وادعاءً فحسب. أما أنصار هذه القصيدة، وهم في العادة من أهلها، فيردّون هذا الإنكار بدعوى أن الشعر لا يقوم على الوزن، الذي طالما نُظمت به مطوّلات يتفق الجميع على عدم انتسابها إلى الشعر، ألفية بن مالك على سبيل المثال. وبدعوى أن الوزن والقافية قد يثقلان الشعر، وقد يربكانه ويسوقانه إلى ما ليس شعراً، بينما لا تواجه قصيدة النثر عقبات كهذه، إذ تخلص للشعر كما هو في مبدئه وجوهره، وتقوم فقط به.
ينسى هؤلاء في حومة الجدل كل هذا التاريخ للشعر الذي لم تعقه القافية ولا الوزن عن أن يمتلئ بجوهره، وعلى أن يؤسس، بالتجربة عمارات يُستدلّ منها على حقيقته وجوهره. ذلك الماضي الطويل الذي اتصلت به قصيدة الوزن، وهي القصيدة كما عُرفت وكما انتظمت، لا يمكن أن نحيط به كله، بدون أن نعرف، أننا من هنا، عرفنا الشعر وفهمنا مبدأه وجوهره. إذا كان همّ بعض شعراء قصيدة النثر وأنصارها، أن يثبتوا أن قصيدة النثر بديل للشعر في كليته، وأن فيها شعراً أكثر وأنقى مما في قصيدة الوزن، فإننا هكذا لا نجد أنفسنا على طريق واضح. إذا لم يكن الوزن معياراً، فإن قصيدة النثر تحمل في اسمها كلمة النثر، والنثر غير الشعر، ولذا لا يصح أن تكون بديلاً للشعر، ولا يمكن أن تكون وحدها القصيدة.
ليست قصيدة النثر كما يرى مؤرخوها جديدة. لقد نشأت أبكر من ذلك في كل الآداب، ومنها الأدب العربي، بيد أنها انتشرت وتحولت إلى نمط دارج في هذا العصر، أي أنها نمت في عصر لم يتغيّر فيه مفهوم الشعر وحده، بل تغيّر فيه مفهوم الأدب نفسه. مع كافكا والرواية الجديدة تغيّر مفهوم الرواية، ومع مسرح المعقول أو العبث تغيّر مفهوم المسرح. كان ذلك جزءاً من ثورة شملت الفن كلّه، لذا لا تقوم قصيدة النثر عياراً للشعر، بل هي بدون أن تنفك عنه، أحد تجلياته، بل يمكن أن نقول إنها نمط آخر له، بالدرجة التي يسعنا فيها القول بأن قصيدة النثر نمط قائم بذاته، بل هي نمط جديد في الأدب، وليست بالطبع بديلاً من قصيدة الوزن، كما أنها، كما يدل اسمها، ليست خالصة للشعر. إنها نمط آخر من الشعر يشترك فيه النثر، إنها النص الذي يتولّد من اجتماع الشعر والنثر وحلول بعضهما في بعض.
يمكن القول إنَّ الشعر، كما هو في قصيدة الوزن التي وحدها تختصّ بتسمية الشعر، كان في أصله غناءً ومديحاً. لعل المديح يمكن أن يُطلق، بعامّة على الشعر، إنه مديح العالم ومديح الحب، احتفال بالكون والحياة وليس هذا شأن النثر، بل ليس هذا شأن النثر إذا أضيف وأُخذ على كونه ركناً ثانياً لقصيدة النثر.
حين يدخل النثر في مخاض الشعر وولادته، فإن النص لا يبقى هنا مديحاً ولا تغنياً بالعالم والحياة. النص بهذا الازدواج هو أقرب إلى السلب، بل هو سلبي تماماً. لن يعود هكذا تغنياً، بل سيصير اعتراضاً ورفضاً ونقداً. قصيدة النثر، على هذا، لم تعد احتفالاً، إنها، على غرار النثر سلبية. هي قصيدة نفي وإنكار واعتراض، إنها قصيدة اللامعقول وقصيدة العبث، وعلى هذا ليست بديلاً من القصيدة. إنها نمط آخر يحوّل الاحتفال إلى مهزلة والغناء إلى تمتمة.
* شاعر وروائي من لبنان
العربي الجديد
————————-
شعرية الستينيات: “تتغير الموسيقى… تهتز المدينة”/ قاسم حداد
1
عندما بدأت التجربة الشعرية الجديدة في بداية ستينيات القرن الماضي، تطرح نصوصها ومنظوراتها، التي أخذت تغاير السائد الشعري، وتعبر عن خروجياتها المبكرة على قالب الوزن، بما سماه البعض (قصيدة النثر) آنذاك كانت التجربة تضرب في أرض مجهولة بكر، عذراء التضاريس وغامضة الملامح في الكتابة العربية قاطبة. وقتها استنفرت، لمواجهة تلك التجربة، كل منظومات التقليد، والتقليد الحديث، لكي ينظم إليهم بعد ذلك عدد كبير من رموز التجديد الشعري أيضاً. تلك الرموز التي كانت تحصد معاركها (حيث كانت لم تزل محتدمة) مع التقليد المستقر. فقد كانت حركة شعر التفعيلة (الذي سماه البعض آنذاك بالشعر الحر) في أوج معركتها.
ويبدو أن الواقع الأدبي، في مجال الشعر خاصة، لم يكن يحتمل ثورتين تغيريتين متتاليتين معاً. في الوقت الذي كان المحافظون يترنحون تحت صدمة الثورة الأولى التي قادها السياب ورفاقه، بدا أن كتابة الشعر خارج الوزن ستكون إجهازاً كاملاً على هيكل القصيدة العربية التقليدية، وتدميراً لعناصرها البنيوية الأولى، خاصة أن الاندفاعة التي بدأ بها محمد الماغوط ورفاقه نصوصهم، بعد مقدمة أنسي الحاج الشهيرة في كتابه الأول «لن» إضافة إلى الإسهامات المبكرة الجريئة لأدونيس، وحماسة مجلة «شعر» كل ذلك أشار إلى الذهاب برغبة جارفة في التغيير إلى الحد الأقصى، بحيث بدت أطروحات حركة التفعيلة تشبه المأزق. فهي تجربة لم تتوضح، ولم يستقر لها عنصر التأسيس، بالمعنى التقني للحركة. لذلك فإن المناخ كان مهيأ لأن يجعل القارئ يضطرب أمام هذه الاحتدام، القارئ الذي «لم يفق بعد من صدمة العمود المطوّر، فكيف بهذا الشعر الذي لم يلتزم عموداً على الإطلاق) حسب تعبير الناقد العراقي عبد الواحد لؤلؤة. وعليه فإن الخروجيات الشعرية ستواجه لحظتها رفضاً واسعاً يشارك فيه، بطبيعة الحال، رموز شعر التفعيلة، لتظل التجربة الجديدة (في حركتها الثانية) هدفاً للهجوم المزدوج، القديم والحديث في آن.
النموذج القديم: لأنه يرى الشعر في نظام القصيدة التقليدي وشروط الخليل بن أحمد وزناً وقافية، ولا بأس ببعض الاجتهادات التي قدمها شعر (النهضة) الذي لم يخرج عن ذلك القانون.
النموذج الحديث: لأنه عندما طرح دعوته للتجديد الشعري، أكد على تحرره من القافية والعمود وقيود البحور، بدون أن يتخلى عن الوزن كنظام إيقاعي يحقق الشرط الموسيقي الخارجي لقصيدة القالب، وبذلك يكون قد وصل إلى الشعر (الحر) بما فيه الكفاية. ولكي يثبت تمسكه بهذه الأطروحات «وحسن نيته الأدبية» سيرفض أي (خروج) أكثر من ذلك، وسيعتبره تخريباً للشعر العربي، كنص يأتي من التراث ليغني التجربة الحديثة من جهة، كما أن الخروج من جهة أخرى تخريب لمشروع التحديث الذي تعمل عليه تجربة الشعر (الحر).
ولن تتردد نازك الملائكة في مجابهة الخروج عن الوزن، منسجمة مع تنظيرها المبكر «والمهم» لما سمَّته (الشعر الحر). فما دامت لا ترى (وجهاً يبرر ميل الناشئة إلى أن يكتبوا شعرهم كله بالأوزان الحرة) طيف يمكنها أن تقبل التخلي الكامل عن هذه الأوزان؟ وسرعان ما ينحرف أي حوار أدبي محتمل، لنسمع نازك الملائكة تقول في ما بعد، عن تجارب الشعر خارج الوزن، إنها (تحقير للشعر، وللغة العربية وللجماهير العربية والأمة العربية، وهو من شأنه بلبلة القراء وتشويه الحقيقة، لأنه اعتداء وتحقير للذهن الإنساني الذي يحب بطبعه تصنيف الأشياء وترتيبها).
2
على الرغم من أن حواراً نقدياً شاركت فيها أطراف شعرية من شتى الاتجاهات الفنية، في محاولة كما يبدو، لبلورة بعض المفاهيم الشعرية، إلا أن الأمر لحظتها كان يتجاوز المفاهيم الأدبية، إلى طبيعة المرحلة السياسية وعناصرها الفكرية. ففي غمرة الاندفاعة القومية والحماس الذي انتاب جميع الأطراف، تدخلت المنظورات الأيديولوجية لتمنح الموقف الأدبي (مشروعيته) وهي لم تكن بالضرورة خالية من التعسف. فقد كان المدّ القومي العربي من الاكتساح بحيث تتاح له الفرص كاملة لأن يعتقد (بانحراف) بعض المنظورات الفكرية والسياسية، في مقابل بعض الاجتهادات الأيديولوجية المتواجدة في الساحة العربية آنذاك. ومقابل اتهام (الشعر الحر) من قبل عباس محمود العقاد وصالح جودت وغيرهما كثير، بأنها مؤامرة شيوعية ضد الثقافة العربية، ستكون الكتابة خارج الوزن مؤامرة إمبريالية ضد الأمة العربية، كما تفضلت الشاعرة والناقدة نازك الملائكة وغيرها. ولن يعوز الاتهام الدلائل، التي ستكون أكثر استثارة للشك بالنسبة لمن يرتبط اسمه بحزب مثل (الحزب القومي السوري) وستكون مجلة «شعر» معرضة بالدرجة الأولى للعديد من الشبهات بسبب كون عدد من كتابها ينتمون لذلك الحزب، الذي شكل آنذاك تعدياً سافراً على مسيرة القومية العربية، الشمولية، ومشروعها الأثير للوحدة العربية، وغير ذلك. وبناء عليه أصبح شعراء مجلة «شعر» هدفاً مكشوفاً للاتهامات والمحاربة، تحت شعارات فكرية وسياسية، لم يجد أصحابها مبرراً موضوعياً لمراجعتها طوال الوقت، حتى بعد أن أثبت بعض جماعة «شعر» تخليهم عن ذلك الحزب، وإعلان استقلالهم الفكري (يوسف الخال من 1949 وأدونيس بعده بقليل) ما سيؤكد في ما بعد (وبلا هوادة) أن موقف التشويه والمحاربة ضد تلك التجربة الشعرية، لم يكن متصلاً بوهم المشكل الأيديولوجي دائماً. إنما يتجاوزه إلى الجذر الحقيقي للتجربة الشعرية الجديدة في عمقها البنيوي (اجتماعياً / فكرياً / حضارياً) وعلى ما يمكن أن يمثل تهديداً جذرياً لطريقة التفكير ومسلماتها، في نصه الأول وليس في تحولاته وأصدائه المتوارثة فقط. فمثل هذا التهديد يمسّ مباشرة طبيعة العقل السائد، ليس لأن اجتهادات شعراء التجربة الجديدة الفكرية مكتملة وصائبة، ولا لا يأتيها الباطل من بين يديها أو من خلفها، لكن لأن وضع التراث الشعري، بكل تجلياته الثقافية، تحت سطوة التغيير، يتجاوز مجرد المغايرة في الشكل، فإن تغير الإيقاع الشعري يطال رمزياً تغيراً أكثر عمقاً. مثلما قال «أفلاطون» قديماً (عندما تتغير الموسيقى تهتز أركان المدينة).
3
إن المناخ السياسي المهيمن آنذاك، وجد في تلك الاجتهادات التي صدرت عن شعراء مجلة «شعر» وملابساتهم الحزبية، أخطاء غير قابلة للغفران، بل إنها مبررات ستتيح المجال لمحاولات التصدي لهؤلاء الشعراء، والإجهاز على تجربتهم. وإذا كانت تلك المحاولات لم تحقق أهدافها كاملة، فإنها استطاعت أن تجعل من تجربة الخروج عن الوزن مشروعاً متعثراً آنذاك. وهذا ما يفسر لنا الآن، ما يمكن أن نعتبره حال الكمون الطويلة التي لجأت إلى تلك التجربة. منذ منتصف الستينيات. وربما أتاح هذا الكمون للجيل اللاحق أن يتعرف، بهدوء وتأمل، على هذه التجربة، لتتفجر في أوائل ثمانينيات القرن الماضي، على أيدي شباب جدي يطلعون بتجاربهم الجريئة في كل أرجاء البلاد العربية، بدون استثناء، ليشكلوا حركة انتقال عميقة شعرياً، ليس فقط في حقل قصيدة التفعيلة ونص الحداثة الأولى، لكن في ذروة المرحلة التي كمنت بالشعر الخارج على الوزن. وقد تجلى (في ذلك الهدوء التأملي الطويل) في عدد رئيسي مؤسس من التجارب الشعرية، لتنعطف هذه الحركة نحو فضاء شعري، استطاع أن يتسلح بكل ما يصدم من أدوات التعبير الأدبي، فناً وأسئلةً، وبما لا يقبل المهادنة، لأنه سيذهب بحرياته إلى أقصاها، مشتملاً على موهبة ومعرفة، تصدران عن معاناة حياتية وفكرية، أرأف منها الموت المحقق، ما سيجعل هؤلاء الفتية الجدد، من القوة والثقة والخبرة والحرية، بحيث تدفع جميع المنظومات المحافظة والتقليدية والتقليدية الجديدة، على صعيد الفن والفكر، تقع في ارتباكات جوهرية، كمن لم يتوقع الكلام في هذا الصمت المهيمن، فيباغت بالعاصفة.
وعندما تعيد تلك المنظومات ترتيب أسلحتها، لن تجد جديداً تقوله، فتعود لتجتر ما قالته سابقاً، عن جماعة مجلة «شعر». أكثر من هذا، أن المنظومات ذاتها سترجع لتكيل الاتهامات القديمة نفسها للشعراء الذين بدأوا مع تجربة التجديد بالذات، بل إن هؤلاء الفتية أعادوا اكتشاف في شعراء تلك التجربة، الآباء المبجلين لمستقبل الكتابة الجديدة. كل ذلك جعل الذخيرة الفاسدة التي يعيد التقليديون والمحافظون استخدامها في معركة هزلية، لم تعد تغري سوى بالرثاء.
قديماً، كمثال، حدث أن الناقد المصري رجاء النقاش نشر في مجلة «المصور» كلاماً استهدف فيه رأس تجربة شباب الشعر المصري آنذاك، فأعاد تنكيله بجثة الحزب السوري القومي، مستحدثاً أشلاء أدونيس وأنسي الحاج ويوسف الخال، كما لو أن مصادفة السيرياليين الموضوعية جعلت النقاش ينشر كلامه المستحدث في المكان نفسه الذي سبق لصالح جودت أن نشر فيه هجوماً قديما على أدونيس. وما على أصحاب الذاكرة الرصينة، إلا العودة إلى رد رجاء النقاش على صالح جودت بالذات مدافعاً عن أدونيس بالذات، المنشور في كتاب «أصوات غاضبة» 1970).
4
يبدو أن الذين يجترون الاعتراضات نفسها على تجاوز القانون الوزني للشعر، يفتقدون للحس التاريخي في أبسط صوره، فهم لا يقدرون أن يعتبروا بكل هذه السنوات التي تضاهي الخمسين، وبكل التحولات الفكرية والاجتماعية والشعرية، ومعطيات النص الشعري العربي، والاختراقات النقدية التي تتمثل في مساءلات أكثر من جيلين كاملين لتراثهما الحديث. كل هذه الظواهر لم تمثل لأصحاب الاعتراضات التقليدية أي مدلول تاريخي جدير بالتأمل والرصانة الفكرية، تلك الرصانة التي يبدو أن على الشباب أن ينصحوا بها شيوخهم الآن.
* من جهة أخرى، نعتقد بأن ما يدفع التقليديين للذهاب إلى شعراء مجلة «شعر» مرة تلو الأخرى، هو ذلك الاختلاف الكبير في الملابسات التي ترافق الحركة الشعرية الجديدة، والطبيعة الفكرية والاجتماعية التي تتميز بها تجربة عدد كبير من الشعراء الجدد على امتداد الخريطة العربية، مما لا يترك مجالاً لأي اتهامات وتشويهات فكرية أو سياسية، خاصة بعد الانهيارات الأسطورية التي خلخلت الواقع العربي في الثلاثين سنة الأخيرة على شتى الأصعدة. وليست الهزائم والحروب الهزلية إلا تجلياً مباشراً لتلك الانهيارات. هذا المشهد أعطى للجيل الجديد من الشعراء طبيعة ليس صعباً التكهن بمصداقيتها المأساوية، وعلى الرغم من كافة المآخذ النقدية والأدبية التي يمكن مصادفتها في أي تجربة مماثلة، على أنها مآخذ لا تتجاوز ذلك لتطال المبادئ والانتماءات والأيديولوجيات وما إلى ذلك. مما تعرضت له رموز التجربة السابقة في ستينيات القرن الماضي، شعراء «شعر» خاصة (وهي الملابسات التي سوف نتحفظ على طبيعتها الأخلاقية من الآن وإلى الأبد).
* الشعراء الجدد، في معظمهم يصدرون عن تجارب نضالية تقدمية، واضحة المعالم والرؤية، أو يصدرون عن رفض راديكالي لكل ما من شأنه أن يصادر حريتهم الفكرية والفنية، معتبرين الشعار السياسي ابتذالاً لن يقع الشاعر الجديد في شراكه. وفي هذا الجيل سوف يتبلور امتزاج خبرة المعرفة بتآلف الموهبة في فعل الحرية، حيث يتمرد على كل أشكال المنظــومات على الصعيد الأيديولوجي والموقف من الموروث.
* في مثل هذا المناخ الذاتي لتجربة الشعر الجديد، ستأتي الظروف الموضوعية للواقع العربي لتؤكد المشروعية الأدبية والتاريخية لهذه الحركة. ففي هذا الانهيار الفاجع الذي يتدهور إليه (وفيه) الراهن العربي، تبدو حركة النص الشعري الجديد، بكافة تجلياته الفنية والرؤيوية ظاهرة تنهض بشهوة التعبير العربي من رماد بارد، يكاد أن يصبح هباءً. ولعل كل هذه المتغيرات التاريخية ستعطي الحركة الشعرية العربية طابعاً حضارياً ينبغي أن تكون جديرة بحمل عبئه.
وسوف يستوي أمام هذا الجيل، الموروث القديم والحديث معاً، ليكونا عرضة للمساءلة والشك بلا هوادة.
٭ شاعر بحريني
القدس العربي
——————————-
«لم تعد للشعر أهمية»/ قاسم حداد
(تحية للشاعر عماد أبوصالح
لمناسبة سركون بولص)
1
هذا اختصار جارح لفرط واقعيته، يطلقه الباحث الفرنسي جاك روبو ويوصل «وبالتالي غير قابل للبيع».
ربما يجد كتّاب كثيرون أن هذه المعضلة سببا موجبا ليهجموا على شبكة الإنترنت لإشاعة أكبر كمية من الكتابات التافهة تحت يافطة الشعر، بزعم مجانيتها المادية. من جهة الحقيقة، ورغم (شعريتها) بحجة المواقع، بالطبع ثمة الفرق، الذي نراه بين ألا تكون للشعر أهميته في قانون السوق، وأن يكون الشعر لا يزال ضروريا بصفته الإنسانية. الإنترنت سيؤكد هذا، لكن بعد أن يأخذ سياقه الرصين.
2
حريات (الأصح مجانية) النشر في شبكة الإنترنت (حاليا) ستتيح لمتحذلقي الكتابة تعميم المزاعم المتصلة بكسر طوق القمع والكبح والمصادرات لممارسة الحق الإنساني في التعبير، لكن خلال ذلك سيجري التضحية والتفريط (هل أقول التجاهل سبب فقد) الموهبة الشعرية أساسا.
3
إذا تأخر بعضهم في الإطلاق الشخصي لصفحته الخاصة، سوف يجد الفضاء مفتوحا في ما لا يحصى من المواقع الفضفاضة القيمة والحدود الفنية، لينشر كل يوم نصا، بدون مجرد مراجعته بعد كتابته الأولى. هلهلة المقاييس الأدبية، وضعف المعنى الفني، يجعل هذا الموقع سلة مهملات هائلة، تنشر كل شيء، تحت يافطة «الشعر» لكن بدون أن يتمكن أحد من مراجعة الناشر، ناهيك عن مساءلته، الذي سيردعك بشعار «حريات النشر» وحذار أن تكون إعادة لسلطة الرقابات الرسمية وغيرها في النشر التقليدي.
4
قلة كلفة النشر الالكتروني في الإنترنت، وانعدامها، ساعدت على انتشار قلة الشعور بالمسؤولية الأدبية، وتعميم ضئيلي الموهبة وانعدامها في شبكة الإنترنت.
5
غياب وانحسار النقد الأدبي، الشعري خصوصا، أدى إلى ضعف حضور القيمة الأدبية، التي تنشر في حقل النشر التقليدي في السنوات الأخيرة، لكن هذا السبب هو أيضا أتاح لانفلات نشر الشعر في حقل النشر الإلكتروني في شبكة الإنترنت خصوصا.
6
ولئلا نقع في شراك الأساليب الرقابية والمصادرات التقليدية، ونحن نتكلم عن تراكم المواد الأدبية التافهة، سنشير إلى ضرورة العامل الشخصي لدى الناشر في شبكة الإنترنت، خصوصا الحاجة الملحة لتشجيع المتابعات والعمل النقدي الجديد لكل ما ينشر في الإنترنت. وخلال ذلك سنكون، يوما بعد يوم، أحوج إلى منظورات وقيم نقدية تستقيم وتناسب وسائط النشر غير التقليدية، وأقترح حدودا وشروطا ومفاهيم ومصطلحات أدبية نقدية تسهم في ترصين كل ما ينشر من نصوص ومواد أدبية وشعرية في شبكة الإنترنت.
7
عربيا، سيشكل النشر في الإنترنت أحد أضخم وسائل التنفيس، بشتى أشكاله، عن الاحتقانات الكثيرة في الحياة العربية، وعند العرب يبقى الأدب (الكتابة) الوسيلة الأولى للتعبير، بل إن الشعر خصوصا هو في مقدمة ما يشعر العربي أنه قادر على كتابته. وبما أن النشر في الإنترنت يبدو أقل كلفة ماديا وأسرع انتشارا، والأهم هو بلا رقابة، سوف يجد فيه العربي الوسيلة الوحيدة التي لا يمكن التفريط في استقلاليتها.
الفوضى هنا ستصدر، ليس فقط من الأشخاص الذين يكتبون ما يزعمون أنه الشعر، لكن المسؤولية ستقع خصوصا على المواقع الثقافية، التي سيلجأ إليها كثيرون للنشر في منصاتها. وكلما كان محررو ومشرفو هذه المواقع متساهلي الشعور بالمسؤولية، سنصادف السيل الجارف من الكتابات، التي ستنشر تحت طائلة الشعر. وفي ظل غياب النقد الأدبي الصارم في حقل النشر التقليدي، سنشاهد مقدار الفداحة، حين ينتقل كل ذلك إلى حقل النشر الإلكتروني في شبكة الإنترنت، حيث لا حدود ولا قيمة نقدية ترصد وتقيد المواد التي تنشر في هذه المواقع. أكثر من هذا، سوف ينشئ ويربي أوهاما نقدية لدى الكثيرين الذين سوف يتبادلون أدوار الشاعر والناقد، لترويج وتكريس الأسماء التي ستواصل نشر كتاباتها بوصفها عماد المشهد الآن.
8
لكن رغم كل هذا السيل الجارف مما صار يطلق عليه البعض أدب الإنترنت، سيقصر عن بلورة تجربة شعرية حقيقية واضحة الملامح، بالمعنى الفني للشعر. وسوف يتحتم عليك الحذر الكبير لكي تكتشف الصوت الشعري الرصين الموهوب. وهو عادة سيكن يمارس كتابته بعيدا عن هذه الفوضى، وإذا صادق ونشر نصه في مكان، فسوف يكون بمعزل عن شروط هذه الفوضى، وربما كانت بعض الأصوات الشعرية الجديدة النادرة، قد تفتحت في هامش هذه الفوضى، وساعدها حذرها وقدرتها على عدم الخضوع، أو الانجراف لشروط النشر الإعلامي المرتجل، الذي أصبحت مئات المواقع تتيحه أمام كل من يسعى إلى سهولة الانتشار وسطحيته.
9
كل ذلك، لا يدفعنا إلى القلق السلبي الذي يؤدي إلى ردود الفعل التقليدية، المتصلة بأوهام الحجب والمنع والمصادرة، لأن هذا سيضعنا مجددا في السلوك التقليدي النقيض، في جوهره وشكله، لأكثر وسائط النشر والاتصال الحضارية حداثة، حيث الأفق الرحب من حريات التعبير الشخصي والجماعي.
فعلى الرغم من كل هذه الفوضى العارمة التي تضرب مشهد النشر الجديد في الإنترنت، يظل الأفق الحر هو خيارنا الوحيد الجديد الذي يتطلب المزيد من مراجعة وتأمل التجربة، لكي نعيد ابتكار لياقتنا الثقافية لتحسين التعامل مع شكل غير مألوف من النشر الأدبي. لأن أخطاء استخدام الوسائط ليس دليلا على سلبية هذه الوسائط ذاتها، ولا يشير إلى خلل في شبكة الإنترنت ذاتها تقنيا. لكنه سوء استخدام يتمثل في طبيعتنا المعرفية والحضارية. وفي حالة الأدب والشعر، سيكمن الخلل في مفاهيمنا ورؤانا في حقل المعرفة الأدبية. وبالتالي، في قدرتنا على إدراك الفرق الجوهري الشاسع بين الذهاب إلى الانترنت بوصفه وسيلة للانتشار الإعلامي السطحي، أو الذهاب إليه باعتباره أحدث الأساليب للاتصال الإنساني والحوار الثقافي الحضاري الحر الجميل والمسؤول. لذلك علينا أن نصرف النظر عن أي بادرة ردة فعل تتصل بفرض وسائل الرقيب على النشر الثقافي في الإنترنت. فهذا شأن، إذا كان يناسب المؤسسات الرسمية التقليدية، فهو لا يناسب ولا يليق بنا ونحن بصدد الزعم بحياتنا في القرن الواحد والعشرين.
10
يبقى الكلام الممكن عن الدور الذي يقع على كاهل ومسؤولية أصحاب المواقع الثقافية والأدبية والشعرية، وعلى المشرفين عليها والمحررين فيها. لأن الأمر يتصل دائما بالوعي النقدي، وبارتقاء الذائقة الأدبية والفنية لدى القائمين على هذه المواقع. ففي هذا الأمر لابد أن يكون الرأي الحاسم والقيمة الفنية من جنس العمل، حيث الدوافع والروادع تصدر من داخل الفعل الثقافي ومنتجيه، نصا ونقدا. وهذا ما نقول به دائما من أجل أن تستطيع تجربتنا الثقافية الأدبية العربية مع النشر الإلكتروني قادرة على فرز وبلورة رؤية نقدية تستوعب طبيعة هذا النشر بحريته وجماله. وتصغي لاقتراحات الإبداع الجديد الذي يتخذ من شبكة الإنترنت وسيلته الجديد ة للاتصال بالعالم.
11
أقول إنه لا تجوز المبالغة في القلق والخوف من هذه الفوضى المرافقة لتجربتنا مع النشر الأدبي في شبكة الإنترنت. فربما كانت هذه الفوضى طبيعية في لحظات التحولات الكونية الذاهبة إلى مخاض الخلق، حيث يحدث الانتقال النوعي، وتبرز لنا معطيات التجربة، بعد أن يذهب الكم الهائل من المادة المنشورة إلى جفاء، ويبقى الابداع الإنساني.
٭ كاتب بحريني
القدس العربي
—————————————
الشعر العربي: جنايات الحداثة/ خضر الآغا
اتخذ الشعر العربي الحديث، شعر الحداثة خاصة، بمجمله طابعًا بلاغيًا، وذلك عبر / أو من خلال التأكيد الشديد اللهجة على أن الشعر هو اللغة ذاتها، وأنه لا فصل، بأي شكل كان، بين الشعر وبين لغته، فكانت الاستجابة القصوى لهذا التأكيد تتمثل في العبور نحو البلاغة. فتعقدت الجملة الشعرية، وازدادت المسافة بين المفردات إلى درجة يصعب ردمها، وتحكمت إيديولوجية اللغة، أو اللغة كإيديولوجية، بمفاصل القصيدة، الأمر الذي أدى إلى أن القصيدة الحديثة راحت تحلّق عاليًا عاليًا في السماوات، وبدا أنه لا توجد أرض يقف عليها الشعراء ويعيشون فوقها، بل إنهم كائنات أثيرية لا يخاطبون أحدًا، أو إنهم إذا ما ادّعوا أنهم يخاطبون أحدًا، فإنه، بالتأكيد، لا يسمعهم، لشدة وجودهم في السماء، ولشدة وجوده على الأرض!
بدت القصيدة الحديثة عبارة عن بحيرة لغوية تتصارع فيها الدوال والمدلولات صراعًا لا هوادة فيه، وبدا الدال فيها هاربًا من أي مدلول قد يدل عليه، إذ يتوجب على القصيدة الحديثة، وفق منظّريها، ألا تركن، إلا بعد لأي، لمعنى! وربما، حتى بعد لأي، لا تركن!
إضافة إلى هذا الغلوّ بالبلاغة، وهذا العلوّ عن القارئ، وعن الأرض، وعن الحياة المرئية، اهتمت القصيدة الحديثة بالأبطال، بالإنسان القادر، بالقوي، بالمحارب… إلى آخر ما هنالك. فيما بدا البسطاء والمغلوبون والمهمشون… مجرد يافطات يرفعها الشعراء بين الحين والآخر على سبيل الظهور بمظهر المنتمي لا أكثر، فلا الشعراء وضعوهم في متن قصيدتهم، ولا أولئك نظروا إليهم في أية مرة نظرة جدية، أو أخذوهم على محمل الجد حتى لو عرفوا أسماءهم أو أسماء بعضهم، فبقوا متروكين للريح. كان التعبير الأكثر صراحة في هذا نظرة الشعراء إلى أنفسهم على أنهم الراؤون، الأنبياء، الخالقون.
وبوصفهم شعراء من هذا العيار “الضخم” كانوا أن أتوا بموضوعات لا تقل ضخامة: التغيير، التحرير، التحرر، البعث من الرماد، مواجهة العالم والطبيعة… وقد أدّوا هذه الموضوعات –الدعوات بيقينية لا يخالجها أدنى شك! ولم لا؟ أليسوا الخالقين؟
كان لا بد أن يتغير هذا الوضع الشعري المتعالي، ساعد على ذلك تغيّر المرحلة التاريخية التي ظهر فيها الشعر الحديث، وبخاصة شعر الحداثة الذي أسس لكل تلك الصيغ المستحكمة وتأسس فيها. إذ تبين أن تلك الأفكار التي تبنتها الحداثة وهي أفكار التحرر والتحرير والمواجهة وبناء المجتمع والدولة… إلى آخره، لم تكن أكثر من أوهام دفعت ثمنها الشعوب العربية وشعوب المنطقة الكثير من جانب، وشعارات تسلّقها السياسيون للوصول إلى السلطة والتأبيد فيها من جانب آخر، فظهر شعر جديد على تضاد مع القصيدة الحديثة على أكثر من وجه.
غالباً، اتخذ هذا الشعر الجديد شكل قصيدة النثر التي تخطّت أولًا الوزن الشعري، وهو هنا التفعيلة، الذي اتخذته القصيدة الحديثة في مسار انقلابها على الشعر التقليدي. وقد نظّر أصحاب هذا الاتجاه لأنواع أخرى من الموسيقى خاصة بقصيدة النثر، بدعوى أن التفعيلة، كما البحور، نوع من الموسيقى الخارجية، فيما موسيقى قصيدة النثر داخلية. فيما أرى، شخصيًا، أن الموسيقى نوع يهتم به علم الموسيقى لا الشعر، وهكذا…
ونظر –الشعر الجديد- إلى البلاغة، غالبًا أيضًا، نظرة مستريبة نافيًا أن تكون حاملًا للشعر، فلجأ إلى لغة غير معقدة، بسيطة، هي لغة الناس في حياتهم اليومية كما زعم.
وانقلب، إلى درجات كبيرة، على تلك الأفكار والصيغ التي لاكها الشعر الحديث طويلًا. فنظر ليس إلى البطل والمحارب وشديد البأس، بل إلى الإنسان “الصغير” وفق تعبير رايش، وإلى الأشياء في وجودها اليومي والعابر والبسيط.
هذه المسائل تعتبر وفق وجهة نظر الكثيرين إيجابية، لصالح الشعر ولصالح الحياة اليومية للبشر، لكن المشكلة ظهرت بعمق وبشدة عندما كتب العديد من أولئك الشعراء الذين ظهروا ،عربيًا، ابتداءً من سبعينيات القرن العشرين بلغة الناس ذاتها التي يتحدثون فيها، بلغة التداول اليومي، فلم يعد ثمة فرق بين لغة الشعر ولغة الحديث اليومي سوى أن لغة الشعر فصيحة! بالأحرى لم يعد ثمة فرق بين الشعر والنثر، وبدا أن تقطيع القصيدة إلى أسطر غير قادر على تحويل ذلك الكلام الذي يُكتب على أنه شعرٌ إلى شعرٍ فعلًا!
عندما ظهر ذلك الشعر أطلق عليه بعض أصحابه وبعض النقاد مصطلح: “الشعر الشفوي” قاصدين بذلك أن الشاعر يكتب مثلما يتكلم، وهذه شفوية فعلًا، إنما من نوع آخر.
من المعروف أن الشعر الشفوي، ذلك الذي ظهر في عصور ما قبل الكتابة، كان يعتمد عدة تقنيات أهمها، بل على رأسها: الصيغة، وكانت تقاس براعة الشاعر في طريقة استخدامه لها، وقدرته على إيصال/ أو خلق معنى عبر استخدام هذه الصيغ “الملقاة على قارعة الطريق”! لكن حتى في تلك العصور لم يكن الشعراء يصوغون قصائدهم كما يتكلمون، وإن كان ذلك الشعر قريبًا من الناس، حسيًا، إذ إن الكلمة هي ذاتها الشيء، أي أن الدال هو ذاته ما يدل عليه، إلا أن الصيغ هي ما أسسه الشعراء جيلًا بعد جيل، ولم تكن هذه الصيغ هي ذاتها التي يتحدث بها الناس، صحيح أن نمط التفكير الشفوي يقوم أيضًا على الصيغ، إلا أنها، شعريًا، تُنقل من مكان إلى آخر في القصيدة، وبالتالي يمكن أن يتم منحها معنى ليس هو نفسه في كل مرة! فلم تقدم لنا مرويات الناس في العصر الجاهلي، مثلًا، أنهم كانوا يقولون خلال أحاديثهم: “يعلو بها حَدَبَ الإكام”! أو “أغتدي والطير في وكناتها”… الأمر الذي يعني أن الشفوية هي لغة الناس لكن على نحو شعري، أما أن تكون هي ذاتها لغة الناس في الحديث اليومي فذلك ينزع عنها صفة الشعرية، لتكون كلاماً، مجرد كلام!
لقد قال دارسو هوميروس إن لغة ملحمتيه ليست هي اليونانية التي تكلم بها الناس في عصره، بل هي لغة خاصة أسّسها الشعراء واستخدموها جيلًا إثر جيل، وقال دارسو الشعر الجاهلي إن لغته هي لغة أدبية خاصة، هي من ضمن لهجات العرب التي كانوا يتحدثون بها، إلا أنها مختلفة عنها جميعًا بوصفها لغة أدبية خاصة استخدمها الشعراء في قصائدهم.
الترا صوت
——————————————–
هل مازال الشعر ديوان العرب؟
ملف مجلة الجديد
هل مازال الشعر ديوان العرب؟ سؤال حملته “الجديد” إلى عدد من حملة الأقلام العرب من نقاد وشعراء وحتى روائيين، مشيرة، في الوقت نفسه إلى دعوة جابر عصفور في التسعينات التي اعتبرت أن الزمن الإبداعي العربي بات زمن الرواية، ولم يعد، بالتالي، زمن الشعر، مغلّبة جنساً أدبياً على جنس أدبي، عابرة على حقيقة أدبية تمثلت في انهدام الجدران بين أشكال الكتابة الإبداعية، وانفتاح النثر على الشعر والشعر على النثر وتحول الشعري إلى ملمح أساسي في فنون القصة والرواية والمسرحية والخاطرة الأدبية، وغيرها من فنون الكتابة.
إعادة طرح السؤال تصدر عن الحاجة المستمرة إلى إعادة قراءة الظواهر والأفكار والصيغ التي حكمت التفكير الثقافي العربي، انطلاقا من وعي نقدي يرى ضرورة في طرح الأسئلة واستكشاف ما طرأ على التفكير العام في القضايا الثقافية والإبداعية الكبرى. ولقد عزز من جدارة طرح السؤال مرور أكثر من ربع قرن على هذه الدعوة التي تسمح بالمراجعة النقدية، بصرف النظر عما ما لقيته في حينه من استنكار من قبل الشعراء العرب على اختلاف أعمارهم وتجاربهم ومرجعياتهم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ما لاحظناه في السنوات الماضية من اهتمام بالشعر في العالم لم يتوقف، وذلك عبر نشر الأعمال الشعرية في كبريات دور النشر، وإقامة الأمسيات والندوات والمهرجانات الكبرى التي لا يمكن للروائي مهما اشتهرت روايته، ومهما تعددت طبعاتها، أن يحظى كاتبها بما يحظى به الشاعر من حضور عالمي، بصرف النظر عن عدد طبعات ديوانه. ولم تغفل الجوائز الأميركية والأوروبية الكبرى عن تكريم الشعراء وتتويجهم بالجوائز، وهو ما درجت عليه نوبل التي اختارت لجائزتها في غضون خمس سنوات فقط ثلاثة شعراء بينهم شاعر ومغن أميركي هو بوب ديلان.
هل مازال الشعر ديوان العرب؟
———————————————-
هل مازال الشعر ديوان العرب؟/ نوري الجراح
المسافة المشوشة بين شاعر الأمس وشاعر اليوم
“لم يعد هناك شعر”، “انتهى زمن الشعر مع رحيل (الشعراء الكبار)”، و”ما يكتب اليوم هو عبث لغوي يسمّونه الشعر”. بمثل هذه الإعلانات وكثير غيرها يشبهها تخرج علينا من حين إلى آخر أصوات تقيم على الشعر صلاة الغائب وتنصب له سرادق العزاء، متحسرةً على الغائبين من أساطينه، فهم شوقي وبدوي الجبل وسعيد عقل ونزار قباني. تتلكأ الذاكرة، قبل أن تضيف السياب ومحمود درويش. وبعد ذلك لا أسماء أخرى يمكن الاعتداد بها في حاضر الشعر العربي.
إنها نظرة عين غاربة، تنتمي إلى ثقافة “الشاعر الفحل” نظير “الزعيم الفحل”، الدكتاتور بوجهيه وقد ملأ، بحضوره الملهم، كل ثغرات الحياة في المجتمع، وتكون لصوته في القصيدة، كما لصوته في الخطاب السياسي، رنة ورجة وتهدج سلطة مطلقة تغزو الأذن وتأسر الوجدان، ولها في نبرة الكلام صلف طاووسي. شيء فكاهي حقاً، لكنه لا يزال يفعل فعله في وجدانات لم تبرح ترى في الشاعر صوت الناس، وقصيدته المتنزلة عليهم من قدسية القضية المشتركة بين الشاعر والجمهور هي الأثر الذي لا يجوز تعريضه لشمس الذائقة، أو المساس بقيمته المطلقة .
***
الطريف في الأمر، أن جل البكّائين على الشعر، وبعضهم ينتمي، نظريا على الأقل، إلى ما يسمى بـ”حركة الحداثة”، لا علم لهم بتطورات الشعر في جغرافياته العربية، ولو امتحنت حجم معرفتهم بالأصوات والتجارب الشعرية الجديدة المنتشرة على خارطة الشعر العربي، خلال ربع القرن الأخير، لكانت النتيجة مؤسفة. ومع ذلك فإن لهؤلاء آراء في مستقبل الشعر!
***
ليس من الإنصاف أن نضع كل ما يُكتب ويريد أن يكون شعراً في سلة كبيرة نسمّيها “المشهد الشعري”، فلم يكن هناك زمن شعري أو أدبي كل ما فيه مثير للإعجاب، إنما أستطيع القول، بكل ثقة، إنني أقيم اعتباراً لكل جديد لا يقطع صلته بالإرث الثقافي، ولا يتعالى على المرجعيات التي تحدّر منها، ولا يغلق، بالمقابل، النوافذ التي تهب منها هواءات التجديد الأدبي من كل لغة وثقافة في الأرض. وأظن أن بعض الشعر العربي يرقى اليوم إلى أفضل الشعر في العالم، وإن كانت لي ملاحظات ترى، من جملة ما تراه من مثالب، أن الأفق الفلسفي يكاد يغيب عن القصيدة العربية الحديثة، ويختفي الميتافيزيق من لغة الشعر وميول الشعراء وتطلعاتهم، وهذا من شأنه أن يلحق ضرراً كبيراً بقيمة الشعر.
وكذلك ألاحظُ أن لغة الشعر وتراكيبه باتت تميل أكثر فأكثر إلى التشبع بلغة الشعر المترجم وتراكيبه اليسيرة، غالباً، وهي عملياً ثمرة اجتهادات مترجمين بعضهم مترجمون متأنون، لكونهم شعراء، وكثرتهم أدركتهم العجلة. ومن ثم فإن لغة الشعر المترجم وتراكيبه التي نادراً ما كانت ملهمةً ومجنّحةً، تسللت إلى لغة الشعر العربي، وباتت دليل الشاعر العربي الجديد إلى لغة القصيدة، وهي غالبا تلك التي يسمونها “قصيدة النثر”. وهذه معضلة حقيقية مسكوت عنها في الحياة الشعرية العربية.
***
كلما قرأت حواراً مع شاعر، إلى أيّ تيار، أو لغة شعرية انتمى، وجدت السائل في ميل والشاعر في ميل، ووجدت الجواب يراوغ السؤال، أو يناقضه، أو يتعالى عليه، أو يبتعد عنه، حتى لكأن الأول جاء من عالم، والثاني من عالم آخر، وها هما يلتقيان في برزخ من الاحتمالات والالتباسات، لا دافع لها ولا عاصم منها. هذه مسألة صعبة، ومزعجة غالباً، لكنها حقيقية. والواقع أننا نادراً ما يواجهنا سؤال ذكي في الشعر. هذه أيضاً حقيقة عربية للأسف. العمل الصحفي في ما يتعلق بالشعر يبدو لي على درجة فاقعة من الجهالة والبؤس. هناك أسباب وأسباب. إنما لا بد من الاعتراف أن هذه العلاقة البائسة إنما تعكس، على نحو ما، طبيعة تلقي الشعر اليوم، وتشير إلى تدني المستوى العام للقراءة، والتخبط في فهم الأشياء. من المؤكد أن ثمة سوء فهم كبير بين الكتابة الشعرية الجديدة والناس.
***
الشعر، بداهةً، ليس عِلماً محروساً بقواعد صارمة. الشعر مغامرة في اللغة، وشطح في الخيال، وهو حمّال أوجهٍ وبئر غوامض. لا الشاعر ولا القارئ، مهما قُيّض للأول من موهبة وللثاني من معرفة، بقادرين على تفكيك لغة الشعر، وهتك أستار تجلياته وصولاً إلى كنهه العميق، وكنوز أسراره.
***
لا يقين في الشعر، ليمكن لفصاحة في لغة نقدية ملهمة أن تحيط بغوامضه، ولا توجد، في حوزتنا، أداة منظورة يمكن أن نتوصل من خلالها إلى مطابقة جلية بين حياة القصيدة وحياة شاعرها، وليس بلا عواقب ما رأيناه من أعمال الناقد العربي بروكريست بسريره المخيف، ومنشاره الحاذق وهو يشدّ ويمطّ، أو ينشر بالمنشار ليطابق بين قامة القصيدة وطول السرير. لا بد أن نعترف بأن الشعر ليس بعلم، ولا هو وثيقة نلزمها بأن تنطق بحقيقة صاحبها، بل حلم وخيالات وظلال وشطح رؤى حرة وحواس ملغزة. ومن ثم فإن مغامرة من هذا النوع يليق بها بالمقابل، في حيز القراءة، مغامرات متعددة السبل أساسها البحث عن المتعة قبل البحث عن المعنى أو المغزى أو الخلاصة.
ما من خلاصة في الشعر، فالشعر خلاصة ذاته، مغامرة جمالية متعددة الأوجه والاحتمالات. علينا إذن أن نؤمن لا بالقراءة، بل بتعدد القراءات.
***
ما من مرَّة عدت إلى الحديث عن قصيدة لي أو لغيري، أو طرقت فكرةً حول الشعر، سبق وتطرقت إليها، إلا وذهبت من طريق مختلف، ولربما خالفت كثيراً أو قليلاً قراءتي السابقة، ليأتي كلامي مختلفاً، بصورة مدهشة، عمّا سبق ورأيتُ وما سبق وقلت في الأثر نفسه.
قراءة الشاعر لشعره هي أيضاً قراءات متعددة، لا قراءة واحدة، ويمكن أن تكون قراءات متعارضة.
***
يفضل أن نسأل الشاعر لماذا تكتب؟ بدل أن نسأله لمن يكتب، فالشاعر لا يشتغل عند أحد، ولا حتى عند نفسه، وهو إذ يكتب إنما يكتب خروجه عليها.
ربما كنت أكتب لأكتشف نفسي، كما يقول البعض، لست متأكداً من ذلك. لكنني متأكد من حقيقة أعرفها وهي أنني أكتب لفرط حبي للكلمات، ولعلّي بعد رحلة شيقة مع الكتابة أجد في اللغة كياناً موازياً لكياني، وأختبر في الكتابة أشياء جديدةً، ألج عوالم لا قبل لي بها، ولا وجود لصورة لها عندي قبل أن أغامر في تشكيل الكلمات على نحو وغيره.
هل يعني هذا أنني أكتب لنفسي؟ ربما، لكنني أشعر، أحياناً، أنني أكتب لأعثر على شيء ما ضائع منذ زمن بعيد، ومرات أشعر أنني أكتب لأسمِع صوتي لأحد ما، لكائن أشعر به يتجول في عالمي، كيان غائم الملامح. أحياناً أفكر بأنني أكتب لأخرجه من ذلك الضباب، ليمكنني، من ثم، أن أتعرف على ملامحه.
وفي مرات أشعر بأنني أراوغ نفسي إذ أحاول أن أصل إليه، وأساله أن ينزع القناع عن وجهه، فما وراء ذلك الضباب ليس سوى وجهي يوم كنت صبياً في دمشق.
هل كنت أكتب لنفسي طوال الوقت؟
ليس في همي أن أرضي قرّاء. وإنني في دخيلة نفسي لأشفق على الشعراء الذين يكتبون لينالوا رضى القراء، فيضطرون في مراحل من حياتهم إلى مداهنة قراء مفترضين، فيزرون بالشعر ويزرون بأنفسهم.
الشاعر ليس خطيباً يُسمع جمهوره ما يحب أن يسمع ليضاعف من عدد أنصاره، وليس نائباً في برلمان يداهن جمهوره بوعود مغرية. والشاعر ليس نجماً في فلك ومن حوله الكواكب، وليس طاغيةً يلعب بالألفاظ، ويغزو الغرائز ليخضع ضحاياه ويتحصن بالمسبّحين باسمه، ولا هو صاحب طريقة يجمع من حوله المريدين الهائمين بهالته.
الشاعر فرد متمرد، سارق نار من محفل الآلهة، وباعث جمال في كينونة الإنسان وكينونة الوجود، صوت العوالم الخفية في النفس الإنسانية، وصوت الوجود العميق، وهو باعث حياة جديدة في الكلمات، خالق لغة. هل يشتغل خالق عند مخلوقاته؟
***
ليس خليقاً بالشاعر أن يتسول القرّاء كما يتسول السياسي الجمهور الذي سيرفعه على الأكتاف ويوصله إلى غايته. وعندما يتطلبُ شاعر ما يتطلبه سياسي، إنما يمتهن كرامة القصيدة، ويهين الكلمات، يحوّل القصيدة إلى خادم لأغراضه اللاشعرية، ويتحول إلى أيديولوجي مراوغ وجلاد في اللغة. إذّاك، مهما بلغ الشاعر من الموهبة والبراعة في صنعة الشعر، ستصيب قصيدته السويداء، وتذبل براعم أزهارها من قبل أن تتفتح. فاللغة في الشعر كائن حي، ينصت ويرى ويزهو ويتألم. خيانة الشعراء للشعر أعظم الخيانات. والشاعر الخائن للشعر قصيدته مثله ملفقة ومراوغة تخفي وراء أزيائها العصرية شيخوخة الزمن.
ولعل مأساة الشاعر الخائن الكلمات تصبح أكبر عندما تصطدم كائنات المستقبل بأشباح الماضي ممثلةً بطغاة المجتمعات. وإذ يهرب الشاعر من شوارع الحرية إلى عتمة الذات، فهو يخون توقعات من رأوا فيه شاعر وجدانهم العميق، من اعتبروه يوماً صوت المستقبل، ورأوا في قصيدته عروس الحرية.
***
خلاصة القول، وبالعودة إلى مبتدأ الكلام، هل يمكن لمن أسروا أنفسهم في زنازين الماضي أن يصفوا للذاهبين إلى المستقبل شعر المستقبل؟
—————————
لا زمن للشعر/ وائل فاروق
منذ قرابة القرن كتب نجيب محفوظ مقالًا يدافع فيه عن فن الرواية واصفا إياه بـ” شعر الدنيا الحديثة”، هذه العبارة التي اختارها محفوظ عنوانًا لمقاله تطالب للرواية بالدور المستقر للشعر منذ القدم وهو أنه “ديوان العرب”، سجلهم المعرفي والتاريخي والجمالي، “الدنيا الحديثة”، بعبارة محفوظ، تحتاج إلى صيغة إبداعية جديدة تتسع لما لا يتسع له “قالب” الشعر، فقد جاء زمن عصيٌّ على الإيقاع، لا يأسره نمط، كان محفوظ نجيبًا عندما أدرك أن الشعر في حاجة إلى الرواية، في حاجة إلى آخر يدفعه لتأمل ذاته واستكناه جوهره ليتحرر من أسر تاريخه الجمالي، وليفيض نهره عن مجراه فيسقي ما وراء ضفاف ألفته. وإني لأدّعي أن هذا هو ما حدث.
لقد كان الرواج الأول لفن الرواية في النصف الأول من القرن الماضي أحد أهم الدوافع الجمالية لثورة الشعر التي بدأت قلقة متطرفة في التجريب في بدايتها متأثرة بالحراك الجمالي الغربي لاسيما في فرنسا، ولكنها ما لبثت أن استقرت على مقولاتها الجمالية الجديدة، كما وجدت في راهن التحرر من الاستعمار وما بعده موضوعًا لاشتباكها مع واقعها، وعاد الشعر للازدهار، وللتغلغل مرة أخرى في الوعي الجمعي بوصفه صوته وبصيرته. وعلى مدى نصف قرن أثرى الإبداع العربي ذلك الجدل الجمالي، فقد استمرت فنون الكتابة العربية تتجادل وتتوالد من رحم ذلك الجدل حيث تُوظَّف آليات السرد في الشعر وآليات الشعر في السرد، فانفتحت آفاق جديدة للكتابة، وراجت مصطلحات مثل: القصة القصيدة والسرد الشعري، ثم تماهت حدود الشكل مع ظهور تجارب ناضجة من قصيدة النثر التي وصلت بشعرية السرد إلى حد قصيٍّ.
كان الشعر في أوج اشتباكه مع واقعه، ومع جوهره الجمالي، في تجربة التسعينات الشعرية الفريدة، عندما أطلقت مقولة “زمن الرواية” التي من الجليّ في هذا السياق أنها لم تكن، كما ادّعى المروّجون لها، تعبيرا عن واقع جمالي تتطور فيه فنون السرد الروائي بينما الشعر مكتف بذاته، منطوٍ على نخبته المحدودة، لم تكن تلك المقولة إلا تعبيرا عن حالة “سوقية” للنشر في مجتمع عالمي، وليس فقط محليًا، تحتل فيه قيمة الانتشار محل قيمة العمق، مجتمع أفقي/سطحي، مجتمع، كما يراه باومان، لا يقوم على الإنتاج وإنما على النفايات، حيث ترتبط ديمومة الاستهلاك بسرعة تحول الأشياء إلى نفايات وإعادة تدويرها – ليس الجدل حول تفاهة الأكثر مبيعًا وعدم تعبيره عن جماليات الكتابة عنا ببعيد – هكذا شاهت في الوعي الجمعي القيم الجمالية، فما حاجة من يعيش رائيًا مرئيًا عبر الشاشات إلى بصيرة!
الشعر.. الألفة والزمن
الشعر فن الصوت وفن الزمن، في الثقافة الشفاهية كان الشعر محاولة للقبض على العالم المتسرب من الوعي والإدراك تماما كالزمن الذي يتلاشى مع كل لحظة تكتمل ومع كل خبرة تصل إلى منتهاها، مع الكتابة تم تقييد الصوت وبتقييد الصوت انفتحت آفاق اللغة أمام الشعر الذي لم يعد فقط قادرًا على القبض على الزمن والخبرة والحياة بل تجاوز ذلك إلى اقتحام عوالم جديدة ما كان للوعي المتطلع إلى ذاته من ثغرات النسيان أن يحيط بها، صار الشعر قادرًا على تكثيف هذه العوالم في رموز وإشارات، يتحرر الشعر اليوم مرة أخرى من صمت الكتابة، الشعر عاد ليبحث عن الصوت عن الحركة يحاول الانفلات من ذلك الوعي المزدحم بالإشارات والرموز، الشعر يبحث عن حرية الزمن في التلاشي، عن حقه في الذهاب بلا عودة، الشعر يسعى خلف سلطة الزمن في أن يكون وعاء للوجود، ولا يعي الوجود اللامتناهي إلا اللامنتهي، إلا الذي يولد في لحظة الموت ويموت في لحظة الولادة، إلا الذي ينقص في لحظة الاكتمال ويكتمل في لحظة النقص، فكل لحظة تمر في حياتنا لا ندرك انتهاءها إلا بوصول أخرى.
يكاد يتفق المؤرخون على ظهور الفردية بمعناها الحديث في بداية القرن السابع عشر، وقد ارتبط ظهورها بعاملين رئيسيين هما ظهور الغرفة الخاصة والمطبعة وهما الشرطان اللذان وفرا لأول مرة فرصة القراءة وانتقال المعرفة في عزلة، ليس لنخبة محدودة، ولكن للجمهور العام، فظهر القارئ، ومع فضيلة العزلة تحول الشعر من فردية الشاعر إلى فردية القارئ، وأمام فردانية القارئ تخلى الشعر عن موسيقاه الصاخبة وعباراته الرنانة التي تليق بجمهور المستمعين واكتفى بإيقاع هادئ يهمس به في أذن الواحد الذي لا يتجزأ، الفرد، مع ميلاد القارئ الفرد اتسعت آفاق السرد وتبدلت اهتماماته من حكايات الفرسان الممتلئة بالأغاني إلى مأساة الفرد الذي ضاقت الغابات والمراعي والجبال والبحار عليه لتصبح مدينة مكتظة بالأفراد، متاهة لا يسهل الخروج منها، في المسافة بين دون كيشوت لسيربانتس وعوليس لجيمس جويس، في عالم يفترسه الاغتراب، ألقى الشعر قيثارته واتجه إلى صناعة الألفة من لامرئيات الحياة اليومية: العادي المفرط في عاديته والغرائبي المفرط في هامشيته، تلك الأشياء التي نحدق فيها دون أن نراها، لأنها منداحة في تيار زمن لا ندرك وطأة مروره إلا عندما يجرفنا بعيدا.
صناعة الألفة هي حركة الشعر المضادة للزمن هي انتزاع لكل ما هو إنساني من تياره العارم، من وهم التكرار الأبدي للحظاته/لممارساتنا، نحن نتناول الطعام كل يوم، فهل حقا ليس في تناول الطعام إلا تكراره، لا يرى في اليومي تكرارًا إلا من فقد تواصله مع الأشياء والأشخاص، فليس رغيف الخبز الذي نضج على حرارة التنهدات كذاك الذي تمتد به يد لم تفتأ تمسح الدموع، فقط الشعر قادر على فضح وهم التكرار، الشعر بصيرة تحتضن ما يولد أمام أعيننا كل لحظة، وما يموت أمام أعيننا في كل لحظة.
الألفة ليست إلا محصلة تاريخ، لقاءات كثيرة تزداد معها المعرفة عمقا، يختلف العادي عن الأليف، العادي هو المكرور، هو ما لا يتميز أو يتمايز عن غيره، تلك المسافة بين العادي والمألوف ضل فيها كثير من الشعراء، فذهبوا يبحثون في اليومي عن الغرائبي أو بتعبير أدق يصطنعون من اليومي الغرائبي بدلا من سرد خبرة الألفة بمعناها وبمبناها، فما الشعر إلا تأليف للقلوب، للسرديات الصغيرة التي لن تفتأ أن تصبح سردية كبرى، ليس اليومي عاديا، إنه حضور متجدد، معنى متجدد، ولا يسقط اليومي في العادية إلا عندما يغيب المعنى، عندما يغيب الشعر.
الشعر.. لا زمن له ولا حدود
الشعر إذن عملية ابتكار دائمة للوجود، عملية رسم لحدود الكينونة داخل التيار العارم للزمان والمكان، وذلك من خلال بصيرة الشعر التي تنتزع أماكن ولحظات من عاديتها، من وهم تكرارها داخلهما فتضفي عليها قداسة تميز حضور ذات تطفو على صفحة النهر الأبدي للوجود، يوم الميلاد، عيد الزواج، حيث التقينا الأحبة أول مرة، كل هذه “العاديات” تشكل ملامح الكينونة، نتشبث بها لنشعر بحضورنا في هذا العالم، إن الشعراء صناع الاستثنائية، كل قصيدة هي دين جديد وكل شاعر هو نبي متمرد، الشعر هو هوية العالم، لأنه ديمومة الانفكاك من سديم الزمان والمكان، ليس للشعر دين أو صيغة أو منهج أو طريقة، ليس للشعر حدود لأنه ديمومة التمرد على كل حد، ولكن الشعر أيضا ليس بزائل أو عابر أو مؤقت، لا ينكر الشعر ذاته، لا يتواضع ولا يتضع ولا ينسحب من الذاكرة حتى لو كان وخزة أو ارتعاشة مبهمة لا تثير التفكير أو تستدعي التأمل، ليست اللغة العادية كما يرى البنيويون نقيض الشعر، إنها منطلقه ومادته الأولى وهي أيضا منتهاه، لا نقيض للشعر إلا العدم.
الزمن هو وعاء الوجود، ورغم ذلك ليس للشعر زمن لأنه ديمومة انتزاع العادي من سديم الزمن لاصطناع الألفة التي تجعل من الإنسانية وعاء رحبًا للزمن. لا زمن للشعر.
باحث وأكاديمي مصري مقيم في ميلانو
————————
من يملك الزمن؟/ حاتم الصكر
يبدو لي أن المتصدين لمقولة زمن الرواية ورافضيها يحتكمون أحياناً في حمأة المناكفات النظرية لنوع من الحِجاج لا يختلف كثيراً عما ساقه جابر عصفور لإثبات صحة حكمه بسيادة الرواية على الزمن الأدبي.
إنهم يسوقون الحجج السياقية في مطالعاتهم، كالاستشهاد بالفائزين بنوبل من الشعراء في السنوات الأخيرة، وتزايد الجوائز الشعرية العربية، وكمّ الدواوين والكتب الشعرية المنشورة، والمنابر والمواقع والمناسبات الشعرية، والندوات والمؤتمرات المتزايدة بصدد الشعر. وهذا لا يبعد في جوهره عن الذرائع السياقية المضادة، ويقع في ما تقع فيه ردود الأفعال في العادة. كما يكشف نمطية الخطاب المهيمن على النظر إلى الزمن أو العصر، والتكهن بمزاجه وتوقّعات الكتابة والقراءة، ومسألة تباري الأنواع الأدبية والأجناس أو تنافسها فيه تحت هاجس البحث عن ضرورة البقاء وإزاحة الآخر، وكذلك يكشف رؤية المتجادلين إلى الكتابة كتقليد فني، وكجماليات معروضة للتلقي.
إن الخطأ نشأ أصلاً في تصوير التدافع النوعي كضرب من النقابية والتسويق التداولي. كان جابر عصفور قد بدأ كتابه عن زمن الرواية التي نشرها في كتابه بالعنوان نفسه، مستشهداً بما كتبه نجيب محفوظ عام 1945 في مجلة “الرسالة” رداً على العقاد الذي رأى أن الشعر فن الخاصة، والقصة فن الطبقات الدنيا أو الدهماء، فلجأ نجيب محفوظ إلى الدفاع الحماسي ووصف “القصة” بأنها “شعر الدنيا الحديثة”.
وتلقف جابر عصفور هذه الصيحة ليطورها إلى القول بأن الرواية هي “ملحمة العرب المحدثين” بافتراض أن المصطلح لم يكن واضحاً في وصف القصة والرواية معاً بمسمى القصة. ولا أتيقن من صحة نسبة ما قاله نجيب محفوظ إلى النوع الروائي، فتشبيهها بالشعر يوحي أنه يقصد “القصة القصيرة” لقربها من بعض تقنيات القصيدة كالقصر والبناء الفني، واستمر جابر في التطوير ليقول إن هذا الزمن هو زمن الرواية تحديداً، مصرّحاً بالانقلاب على التراتب الأجناسي المألوف وإزاحة الشعر عن الهيمنة. وذهب إلى القول بعد صفحات إلى أن “الرواية أصبحت ديوان العرب المحدثين”، مستخدماً خطاب الشعر ومصطلحاته في هفوة تشير إلى تسيد الشعر أصلاً في قراءاته. كما يدعو إلى التساؤل عن حقيقة الحاجة إلى ديوان جديد يسجل أيامنا ووقائعنا “المشرّفة!”، فقد ذهبت النصوص إلى طريق لا تؤدي إلى تلك الوقائع بل تسمو عليها، وغدا حصر النصوص شعراً أو سرداً في مهمة تسجيل الوقائع والأيام مقترحاً تراجعياً، كما أن مقولة نجيب محفوظ تلك أتت في سياق حماسي وإثبات ضدي أو سلبي لا ينبني عليه تحول كبير.
أما الاحتجاج بالسيرة وانتشارها الحالي فهو لا يزكّي سيادة الرواية على الزمن، فالسيرة الشعرية شهدت أيضاً تجارب لافتة فنيا وجماليا لا ترهن الكتابة السيرية بتسجيل الوقائع.. بل ترتفع بها لتمزج الخيال بالمادة السيرية، بينما تعتمد السيرة السردية على حيثيات تاريخية خارجية.
يقول جابر عصفور إنه لا يقوم بعقد مفاضلة بين الشعر والرواية، بل يسجل “واقعاً قرائياً، يرتبط بالانتشار واسع المدى الذي يتمتع به النتاج الروائي بالقياس إلى الشعر”. كيف تكون المفاضلة إذن؟ ثم أيحق لنا أن نبني على ميزة تداولية وانتشار ظرفي أفضلية نوع على آخر؟
كنّا نودّ أن يسوق طرفا الخلاف أسباباً وحججاً فنية تتعلق بطبيعة كل فن، وليس الوصف الإنشائي كالقول إن الشعر كالبرق والرواية كالنهر بحسب جابر عصفور، أو دحض ذلك بالقول إن الرواية سرد وصفي والشعر تصوير خيالي، فالأمر أبعد من ذلك. إنه يتصل بطبيعة الفن الشعري من جهة والطبيعة السردية للرواية. الشعر يتمثل ذاتياً ويدوّن تلك الاستجابات للأفعال بحزمة خيال وصور وإيقاع ولغة تعمل على نفسها ولنفسها، فيما تتم قراءة الرواية جمعياً بالقياس إلى بنيتها الملحمية ومحفلها السردي منصهر العناصر والأحداث. وبين الشعر والرواية ما بين التجريد والتشخيص في الرسم من فرق. لذا تفلح الرواية والسرد عامة في تمثل قوي للوقائع ما يغري بالقراءة وتلمس انعكاسات الوقائع، فيما يتطلب الشعر قراءة أخرى تنكبّ على موضوعه وبناه المتحققة برهافة لا يمكن تحديدها في قوانين ثابتة.
أرى كخلاصة أن التعايش بين الأجناس والأنواع ممكن كما هو بين النصوص والأجيال.. وأن الزمن ليس حكراً لفن ما. واستمرار الشعر طبيعي احتكاماً إلى تاريخ الشعرية وتأمل مزاياه وخصائصه الفنية والجمالية.
ناقد من العراق مقيم في نيويورك
ناقد من العراق
—————————–
استعادة نظام الأجناس الأدبية/ ناهد راحيل
تحدث الألماني إريك كوهلر عن التحولات التي يمكن عن طريقها أن يتأثر نظام الأجناس بالتغيرات الاجتماعية، فنظام الأجناس وفق كوهلر ليس “سلبيا”، بل يستطيع التأقلم مع الأوضاع الجديدة بفضل عمليات انتقاء بعض الخيارات التي يحتوي عليها والتجريب في الخصائص التي تميزه وتفضيلها لمواجهة تلك التغييرات؛ فاستطاع نظام الأجناس على سبيل المثال أن يستبدل التراجيديا بالملحمة لاتفاقها مع إرساء الحكم المطلق وتطلعات نبالة البلاط التي حلت محل نبالة السيف القديمة، ومع سقوط الحكم المطلق ظهرت البرجوازية كقوة ثقافية جديدة مسؤولة عن فكر التنوير، صاحبها صعود الراوية التي حلّت محلّ التراجيديا.
فمن الممكن أن تزداد قدرة بعض الأنواع الأدبية لتتبادل الأدوار مع أنواع أخرى خفتت في وضع اجتماعي بعينه وتتفاعل هي مع الأوضاع الاجتماعية الجديدة، وقد يتكوّن نوع جديد يتفق شكلا وموضوعا مع تطلّعات جماعة اجتماعية تسعى للتحرر من قيود شكل أدبي، أو يمكن لأشكال هجينة أن تظهر في فترات انتقالية من حياة المجتمعات تسمح بنوع من التوازن النوعي مقابل أنواع أخرى مهددة بالاختفاء.
ولكي يكتسب كل جنس أدبي وظيفة اجتماعية خاصة ويتفاعل مع مصالح جماعية محددة، يجب أن توضع تلك الأجناس الأدبية داخل سياق اتصالي يتسم بالصراعات وبالحوارات الجدلية بين الأيديولوجيات المختلفة؛ فالأجناس الأدبية المختلفة يمكنها التعبير عن رؤيا جماعية للعالم في مواقف تاريخية بعينها، بوصفها شكلا فنيا يجسد معنى اجتماعيا معينا، مما يسمح بحقيقة استنتاج الترابط الوظيفي بين النظام الاجتماعي ونظام الأجناس الأدبية.
وإذا حاولنا استعادة هدف كوهلر الخاص بالترابط الوظيفي بين النظام الاجتماعي والنظام الأدبي أو نظام الأجناس، نجد أن الشعر هو اللغة العليا التي استخدمتها الأجناس الأدبية – المسرح تحديدا – أداة تعبيرية لها، إلى أن هجر المسرح الشعر واتجه إلى النثر في الفترة التي ازدهر فيها التيار الواقعي، وصعدت خلالها الرواية بمساحاتها المرجعية والتوثيقية وإشكاليتها “التيمية”، لكن هذا لم يلغي وجود الشعر الذي تكيف مع تحولات النظم الأجناسية والتغيرات الاجتماعية.
فإذا تمثلنا الشعر العربي، نجد أنه قد طرأت عليه تغيرات شكلية عديدة في العصر الحديث نتيجة لتحولاته الاجتماعية والتاريخية المتلاحقة؛ مع تقويض التيارات الفكرية الخاصة بمرحلة الحداثة، والتمرد على أيديولوجياتها المعتمدة على أحادية النسق وذاتيته، والانتقال إلى تعددية الأنساق وغيريتها؛ ليصبح التجريب في البناء الشكلي للقصيدة والتمرد على قواعد الكتابة التقليدية للشعر الخاضعة للوزن والقافية لخلق الإيقاع الشعري معادلا موضوعيا للتمرد على الأيديولوجيا التي تحكم مصالح مجتمع ما، بحيث تتخلى القصيدة عن تلك القواعد وتخلق لنفسها إيقاعا خاصا يتنصل من كل محاولة تقييد شكلية أو رؤيوية.
فتبادلت قصيدة التفعيلة الدور مع القصيدة العمودية التي خفت وجودها في شرط زماني ومكاني حالي وتفاعلت مع الأوضاع الاجتماعية الجديدة، واتضحت معالم قصيدة النثر التي ظهرت كشكل هجين ونفت التعارض بين الشعر والنثر لتوجد باعتبارها نصا جامعا – بتعبير جيرار جينيت – له خصائصه النوعية وسماته الشكلية الجديدة.
يبقى أن نشير إلى دور المتلقي في انتقاء جنس أدبي وتفضيله على آخر، وهو ما يتوقف في الأساس على ما يمتلكه من خبرة اطّلاعية وذائقة فنية تؤهله لاستقبال النصوص والوقوف على معاييرها وإجراءاتها النوعية، فإلى جانب نظام الأجناس وعلاقته بنظام المجتمع، يمكننا اقتراح مصطلح إضافي وهو “نظام التلقي” الذي يتأثر بدوره بتحولات النسق الثقافي ويؤثر بالتبعية في ازدياد قوة جنس وتفوّقه على جنس آخر وفق ما يحدده له من قيمة جمالية وقوة أسلوبية تعبيرية، وحسب ما يلبي له من توقعات وما ينهض به من وظائف تخدم تطلّبات النظام الاجتماعي.
ناقدة وأكاديمية من مصر
كاتبة مصرية
——————————–
ضوءُ الشعر وظلُّ الرواية/ محمد صابر عبيد
يسترشد العربيّ بضوءِ الشعر منذ زمن سحيق لا نعلم بدايته وقد لا نعلم نهايته على الأرجح، ضوء ضاجّ بالنور البهيّ الساطع المغرور الطالع نحو الأعالي دائماً وأبداً، هكذا تشكّلت الثقافة الشعريّة في وجدان الإنسان العربيّ ومخياله ومزاجه وتطلّعاته الحيويّة والجماليّة، ويمكن القول إنّ تاريخيّة الشعر العربيّ على هذا النحو هي الضمانة الحقيقيّة الأبرز لتوكيد استمراريّته وديمومته وبقائه، مهما تعرّض في مناسبات مُعيّنة للتهميش والإقصاء والإهمال والتبسيط والعزل والتسقيط، فروح الإنسان العربيّ في جوهرها هي روح شعريّة، وحياته شعريّة، ليكون ارتباطه بالشعر جدلياً ومصيرياً بلا حدود.
تكشّفَ العصرُ الأدبيّ والثقافيّ الراهن عن هيمنة شبه مطلقة للرواية بحكم عوامل كثيرة تحتاج إلى كلام كثير جداً، والرواية فنّ مستورد من الثقافة الغربيّة يعبّر عن حضريّة الغرب ومدنيّتهم لأنّ الرواية هي فنّ المدينة، وإذا كان الشعر يتميّز بالحساسيّة الفردية فإنّ الراوية ذات حساسيّة جماعيّة أكثر قُرباً للفكر الديمقراطيّ والحريّة التعبيريّة والتشكيليّة، فضلاً على أنّ المَيلَ البشريّ إلى الحكي بحريّة أكثر استقطاباً وإغواءً للناس من ضوابط الشعر والتزاماته وسُلّمه الطويل.
إنّ حصول الشاعرة الأميركيّة لويز غلوك على جائزة نوبل للآداب هذا العام 2020 أو شعراء آخرين سبق أن حازوا عليها لا يعدّ حدثاً تاريخياً لصالح إعادة النظر والاعتبار للشعر العربيّ على سبيل المثال، إذ أنّ فوز شاعرة مجهولة تقريباً مثل غلوك لدى الشارع القرائيّ العربيّ العام لا يمكن أن يغيّر مزاج الشارع السائر بكليّته نحو فضاء الرواية، وهو أمر ثانويّ على صعيد التداول لأنّه حتّى بعد الإعلان عن فوزها قد يجري الاهتمام بترجمة بعض أعمالها إلى العربيّة، ثمّ ما يلبث هذا الاهتمام أن ينحسر ولا يبقى له أثر في الوقت الذي تبقى الراوية تلتهم اهتمامات الشارع الأدبيّ والثقافيّ العربيّ إلى أجلٍ غير مُسمّى، ربّما لو فاز بها الشاعر العربيّ الذي يستحقها وربّما هو أكبر منها أدونيس مثلاً لكان تأثير ذلك على الشعريّة العربيّة الحديثة حاضراً وبارزاً ومؤثّراً فعلاً، لكن أن تفوز بها شاعرة أميركيّة فلا قيمة لذلك أبداً على صعيد ترجيح كفّة الشعر على الرواية عربياً، ونكاد نقول حتّى عالمياً أيضاً.
الرواية ابنة البروباغاندا المدلّلة وقد تمكّنتْ من الهيمنة على الشارع القرائيّ العربيّ هيمنة تكاد تكون مطلقة، إذ ضاعفت من عدد قرّاء الرواية إلى مستويات غير مسبوقة بصرف النظر عن هُويّة هذه القراءة وطبيعة مقاصدها ومستواها المعرفيّ، وقد وصلت طبعات روايات بعض الروائيين العرب إلى عشرات الطبعات ومئات الآلاف من النسخ المُباعَة، بعد أن كان نجيب محفوظ الفائز بجائزة نوبل لا تستطيع دار النشر التي تطبع له رواية جديدة أن تبيع أكثر من خمسة آلاف نسخة، وصار بعض الروائيين ممّن خدمهم الإعلام جيداً نجوماً كباراً تجاوزوا نجوميّة نجيب محفوظ تداوليّاً على صعيد عدد طبعات رواياتهم وأعداد النسخ المباعة الهائلة، مع أنّ بعضاً من هذه الروايات على صعيد التحكيم الفنيّ التقانيّ تفتقر إلى كثير من الشروط الإبداعيّة فيما يتعلّق باللغة والصنعة وعناصر التشكيل الأساسيّة الأخرى، غير أنّ هذه الشروط لم تعد هي الحدّ الفاصل بين رواية تكتسب شهرة وأخرى تُهمل، بل ثمّة عوامل أخرى ذات طبيعة سوسيوثقافية وسايكوثقافيّة تتدخّل على نحوٍ سافر لإشعال نجوميّة روائيّ مّا أو رواية مّا، وهي جزء فعّال من طبيعة العصر العولميّ السائر – كما يبدو – باتجاه تسليع الثقافة والفكر والأدب على نحو مقصود، وله علاقة وثيقة بحركيّة الاقتصاد العالميّ وأنشطته الجبّارة القائمة على هيمنة رأس المال وسلطاته غير المحدودة.
ولعلّ كثرة الجوائز الخاصّة بالرواية عربياً تغري كثيرين بركوب هذه الموجة بمن فيهم الشعراء أنفسهم، وقد تحوّلوا إلى روائيين بحثاً عن هذه الجوائز وأقيامها الماديّة المغرية، إذ كيف في مجتمع عربيّ شاسع يقترب في عدد نفوسه من نصف مليار من البشر، لا يستطيع شاعر عربيّ قد يتفوّق على معظم شعراء العالم المعاصرين أن يعيش من إيرادات بيع كتبه الشعريّة؟ في حين صار للرواية على صعيد هذه الجوائز وحتّى في أحيان معيّنة على صعيد النشر والانتشار موارد ماديّة مريحة، تشجّع كلّ من له قدرات معيّنة على تجربة الكتابة السرديّة الدخول إلى نادي الرواية الواعد.
يمكن القول على صعيد الشعر إنّ أهم شاعر عربيّ حيّ أو حتّى شاعر عربيّ راحل بالغ الأهمية تطبع أعماله الشعريّة لا يُباع منها سوى النزر اليسير، وانطفأت نجوميّة الشعراء التي كانت في ستينات القرن الماضي هي الأعلى حضوراً وتألّقاً وتأثيراً، فمنذ أكثر من نصف قرن والشعر العربيّ ينحسر إلى حدود ضيّقة جداً على صعيد التداول والتلقّي، ولولا الدراسات الأكاديمية في مرحلَتَي الماجستير والدكتوراه في تخصّص الأدب الحديث والنقد الحديث لانحسرت العناية بالشعريّة العربيّة على نحو أشدّ وأكثر إيلاماً، إذ بدأ الاهتمام بالشعريّة العربيّة الحديثة في هذه المنطقة البحثيّة الجامعيّة؛ بصرف النظر طبعاً عن قيمة ما يُنتَج من رسائل وأطاريح في هذا المجال، حيث أنّ هدف الغالبية العظمى لأصحابها هو الحصول على الشهادة العلميّة بأقصر الطرق وأيسرها وأقلّها عناية بالأسئلة الكبرى المطلوب محاورتها، ويحصل هذا الأمر للأسف أكثر من محاولة تقديم رؤية جديدة في مجال البحث الأكاديميّ النقديّ الجديد حول مصير هذه الشعريّة وتحوّلاتها وآفاقها.
ستبقى الرواية إلى حين هي المهيمن الأدبيّ على سوق التداول في المنطقة العربيّة على حساب الشعر، وقد لا نرى أفقاً ظاهراً يدفعنا للأمل بشأن مستقبل قريب يعيد فيه الشعر العربيّ ألقه وتسيّده للمشهد الثقافيّ والأدبيّ العربيّ، وستظلّ القصيدة العربيّة صديقة حميمة لشعراء معدودين يرون فيها نافذة حرّة أصيلة للحياة، وينتمون لها بإخلاصٍ وتفانٍ وجمالٍ وقدرٍ كبيرٍ من الضوء، حتّى تحصل المعجزة الكبرى فنصحو على أسواق شعريّة عربيّة جديدة تملأ الآفاق، ويُنادى فيها على الشعر والشعراء أكثر من أيّ شيء آخر.. (ولاتَ حينَ مناص).
ناقد وشاعر عراقي
———————————
الجديد والأجد/ نادية هناوي
إن لمتغيرات الحياة وتطوّرها قوانينها الفاعلة والمؤثرة في كينونة الإبداع في هذا الشكل من فنون الأدب أو في ذاك. وكلما طرأت على الحياة ظروف جديدة؛ فإن الإبداع سيتعدد ويتنوع ومعه تتعدد وتتنوع النظريات والمدارس والتيارات.
ولقد ذم أفلاطون الشعر لأنه صادر عن إلهام وعن قوة لا عقلانية لكنه بعد تطور فلسفته لم يعد يذمّه نظراً لما وجده فيه من حدس ورؤيا تعبّر عن الجمال وتتوجه نحو الخير. وما كان للقصيدة العمودية ثم قصيدة التفعيلة والرواية والقصة القصيرة وغيرها أن تكون أجناساً لولا مهيئات توفّرت لها وساهمت فيها ظروف معينة فجعلتها سائدة في أزمان ماضية أو راهنة، متغلبة على حساب أجناس أخرى.
وإذا كان الشعر مرآة تحاكي الذات في ما هو محتمل وقوعه وممكن حدوثه؛ فإن الرواية مرآة تحاكي الواقع في ما هو حاصل وقوعه ومتحقق حدوثه. ولأن التلاقي بين الواقع والذات أمر طبيعي فكذلك التداخل بين الشعر والرواية أمر قائم، لكن ليس بصورة منفلتة بل محددة بإمكانية أن يكون أحد المتداخلين أرسخ قالبا وأقوى قدرة على صهر الجنس الآخر وإذابته في داخل قالبه.
وبذلك لا يعود صحيحا القول إن للقصيدة العمودية زمنها الغابر الذي كانت صالحة له ولم تعد الآن كذلك ممّا يتمسك به دعاة نظرية الأنواع الأدبية المؤمنون بتفسير الأدب تفسيرا فسيولوجيا هيراركيا كما لا يعود منطقيا القول بأن زمننا هو زمن الرواية الذي فيه تهيمن على سائر الأجناس وتتفرد جنسا لا يجاريه الشعر بأجناسه (قصيدة العمود وقصيدة التفعيلة وقصيدة النثر) أو لا تصل إلى منافسته القصة القصيرة بأنواعها كافة، مما يتمسك به دعاة نظرية الأجناس المؤمنون بتفسير الأدب تفسيرا تاريخيا.
ولا خلاف أنّ الذاكرة الجمعية تنقل لنا جينالوجيا تراكمات أسلافنا الثقافية فكيف يمكن نفي تلك التراكمات وادعاء الموت والذواء لما كان قد اُنجز في الماضي بينما هو ممتد حاضرا وسيظل منتقلا مستقبلا؟ ولا فرق في ذلك بين أن يكون جنس مثل الشعر قادرا على تغيير العالم أو بين جنس مثل الرواية قادرا على تعرية المجتمع وكشف غموضه وخطف أنظار متلقيه.
من هنا أجد بطلان دعوى ملاءمة الشعر لزمن دون زمن أو دعوى القول بموت الشعر وحلول الرواية محله، أو ما شاع طرحه منسوبا إلى جابر عصفور بأنه قال: إن الرواية ديوان العرب، وسبقه بعقود العلامة جواد علي الذي فسَّر كون الشعر ديوان العرب بأنه تسجيل من لا تسجيل له ولذلك لجأت إليه الشعوب القديمة حين لم تعرف الكتابة.
وما نراه هو أنّ لا فنّ يُبتدع فيموت؛ إنما هو يتجدد بالانصهار أو الذوبان في ما هو أجدّ منه وأكثر مرونة. ولولا أن الرواية تمتلك الجدة والمرونة لما كانت حاملة بعض تراكمات الملحمة ولما كان الشعر المسرحي حاملا تراكمات الشعر الغنائي والملحمي اللذين سبقاه ولما كانت الحكاية تمهيدا طبيعيا للقصة بمختلف أشكالها التي بدورها كانت تمهيدا طبيعيا للرواية وستكون الرواية بدورها مستقبلا قادرة على التبدل لتترك بعض تراكماتها على جنس سيعبر عليها ويحتويها وهو القصة القصيرة بسبب ما تمتلكه من المرونة التي بها ستغلب غيرها من الأجناس السردية والشعرية أو نوع آخر يرثهما مختزلا أو مطوّرا أفضل خصائصهما.
ناقدة وأكاديمية من العراق
—————————-
الرواية تتقدم على الشعر/ أبو بكر العيادي
أن تحوز الأميركية لويز غلوك جائزة نوبل فهذا لا يعني أنها الأفضل، فكم من شاعر وشاعرة قبلها نالوا هذا الشرف دون استحقاق (جوزيف برودسكي، فيسلافا شمبورسكا، فضلا عن مؤلف الأغاني بوب ديلان على سبيل الذّكر لا الحصر). وأن تسند لجنة نوبل جائزتها إلى شاعر أو شاعرة فلا يعني أنها تكرّس طغيان جنس على آخر، وأنّها سوف تعدّل خيارات الكتّاب كي يقلعوا عمّا بين أيديهم ويهبّوا إلى الشعر، فهي عادة ما تتوّج مغمورين وكأنها تستخف بإجماع العالم على كتّاب وشعراء حقيقيين، بل إن بعض أعضائها صرّحوا علانية أن اللجنة تتجنب الأسماء المتوقَّعة، ذات الشهرة الواسعة. أي أن لها اعتبارات بعيدة عن الأدب في أغلب الأوقات، وبالتالي لا يمكن أن تكون مقياسا لحكمنا على الشعر ومدى حضوره مستقبلا.
إن ملاحظة جابر عصفور تنطبق أكثر ما تنطبق على الساحة العربية، التي تشهد إقبالا منقطع النظير على الأدب الروائي، أما في الغرب فالرواية لا تزال في المقام الأول منذ ظهورها، وهي التي ترصد لها الجوائز أكثر من سواها. ورغم ما يندّ بين الحين والآخر من أصوات تتنبأ بنهايتها، فهي لا تني تتكاثر في شتى أصقاع المعمورة، في أشكال مستحدثة أحيانا كالواقعية التخييلية والرواية السيرذاتية ورواية الخيال العلمي بوجهيها الاستباقي والديستوبي. والقول بموتها لا يعدو أن يكون سوى استعادة لما واجهته من نقد راديكالي عند ظهور الرواية الجديدة في فرنسا، حين أعلن دعاتها عن موت الرواية وموت المؤلف معا. ثم اختفى تيار الرواية الجديدة باختفاء رموزها ولم تمت الرواية، بل نهضت من رماد تلك الحقبة لتعانق العالم برؤية جديدة.
الشيء نفسه حدث في الولايات المتحدة في المرحلة ذاتها، عندما ظهر إنتاج روائي يخالف الذائقة السائدة، اعتمد ما أسماه النقاد “ميتاخيالي”، أي تشويش الحدود بين التخييل والسيرة الذاتية. وكان في جملته أدبا استفاد من تيار الرواية الجديدة في فرنسا، من حيث تمرّدها على الرواية الكلاسيكية واقتراحها رؤية مغايرة. ورغم ظهور أسماء أمثال جاك كيرواك ووليم بوروز وجون بارث، فإن عناوين بعض الصفحات الثقافية كانت لا تنفك تنعى موت الرواية الوشيك. وقد رأى المؤرخون في ذلك تعبيرًا عن نوستالجيا نقاد تعلقوا بتقاليد أدبية معينة مثّلها جيل العمالقة، ورفضًا لتصور جديد للأدب الروائي ومِراسه.
لقد وصل الشعر إلى مأزق حقيقي، رغم تزايد الشعراء، لأن ما يكتب اليوم في عمومه تغلب عليه النمطية ورغبة إحداث الدهشة على منوال النكت التي تراوغ انتظار المستمع، وشيوع قصيدة النثر بشكل أطمع كثيرا من ضعاف الموهبة، وخلق فوضى عارمة يتجاور فيها الجيّد والرديء، خاصة بعد ظهور المواقع الاجتماعية، إضافة إلى انسياق شعراء كثر في تيار جرف كل راغب في الظهور، بعد أن اجتاح الساحة العربية في الأعوام الأخيرة هوس الرواية، كمطية لإثبات الذات وتحقيق مكانة لم يبلغها بكتابة الشعر. وأضحت كتابة الرواية مطمح الجميع، لاسيما في هذه المرحلة التي تقلص فيه عدد قرّاء الشعر في العالم، نتيجة عوامل كثيرة أهمّها طغيان الأدب السرديّ دون شكّ، ومنافسة المحامل الإلكترونية أيضا.
لا نشكّ أن ثمة اليوم حاجة ملحّة إلى الحس والمعنى، وإذا كانت الرواية قادرة على تصوير العالم وتحليل عناصره، فإن الشعر أقدر على التقاط الجمال فيه. فالشعر باق ما بقي الإنسان، وكذا الرواية، ولكن لا نعتقد أنه سيزيح الأدب السردي من موقعه، لأن مدمني الحكي وسماعه يفوق شُداة الشعر وهواته.
كاتب من تونس مقيم في باريس
—————————
لن يختفي الشعر إلا باختفائنا/ محمد محمود صارم
الشعر، أجل الشعر مجدداً، الشعر دائماً وأبداً.. وهل كان من المفترض أن نصدّق أنّ الشعراءَ كانوا قد غادروا الزمن الذي نعيبه مراراً وتكراراً ودفنوا كل مُترَدَّمٍ من القول تحت ردمٍ مما تهدَّمَ في الزمّن؟ القيم، الجمال، الذوق.. وإن كانت الأزمنة كلها معيبة، ولا يهمّني كثيراً سبب العيب الذي يعتريها، أفلم يحضر فيها الشعر جميعاً؟ ألم يَعلق على جدرانها المتهالكة المتآكلة كالطحالب الخضراء وهو “الجيفة الخالدة”؟
يبدو زمننا متفرّداً على كل حال. صحيح أنّ الهمجيّة والظلم والاستعباد ما فارقوا حوادث التاريخ قطّ، ولكنّ البشرية منذ بدأت مداخن الإمبراطوريات المترهّلة تنفث دخان صناعاتها المستجدّة والعالم في تسارع مستفزّ. ثمة منحنى لا يكفّ عن الصعود، قد تفيدنا الرياضيات المجرّدة بإمكانية استمراره بالصعود إلى ما لا نهاية، ولكن كوكبنا الأزرق محدود الأبعاد على اتساعه فقيرٌ على امتلاء حسابات مصارفه بمليارات المليارات. هنا بالذات تكمن أزمة الشعر إذن. الشعر فقط؟
عم ولا. إذا نظرنا إلى الشعر على اعتباره جنساً أدبياً سيبدو لنا الشعر تحديداً ضحيّة لطبع ما من طبائع عصرنا الراهن أو ربّما لجملة طبائعه وسماته. السرعة، الاستهلاك، الماديّة، إلخ… ولكننا لو فكّرنا فيما يجعل الشعر شعراً، تلك الخاصيّة السحريّة العصيّة على التوصيف والتحديد، فلتكن شعرية الشعر، نعم: الشعريّة، فإنّ ما ينتابنا من قلق على الشعر سينسحب على كل فنّ وعلى كلّ تصرّف وعلى كلّ طقس.
يشعر المرء أننا في عالم ناقص الشعر والموسيقى والأدب والفن عموماً، وكذلك، الفلسفة والأخلاق والدين، ربّما ناقص الإيمان، أيكون قبل ذلك كله ناقصَ المعنى؟ أزعم ذلك. السرديات الكبرى دينية كانت أم لا دينية تكلّست أو باتت معروضة للزوار في متحف الشمع. الأيديولوجيا؟ رؤوس أقلام وشخصيات بهلوانية وشعارات فضفاضة، تسويق انتخابي في ربع العالم وطبل أجوف في ثلاثة أرباعه المتبقية. هناك فنّ وأدبٌ ونضالات على أيّ حال، هناك دراسات اجتماعية، لا أنكر ذلك، لكن ثمة ثابت ناقص لتستقيم المعادلة بثوابتها القليلة ومتغيراتها الكثر. ثمة تصحّر على مستوى المعنى، هناك في الينابيع. وما علاقة كل ذلك بالشعر؟ أقول: وهل مثل الشعريّ في توليد المعنى وإثراء الواقع المسطّح الأجرد بما يمكن ذكره؟
أستطيع تلخيص انطباعي عن العالم بهذا النقص نقص المعنى، نقص الشعريّة. وإذا اعتبرنا جائزة نوبل معبِّراً عمّا يجري في بعض مواطن هذا العالم، وسيلة قياس، وغيرها الكثير من الوسائل، فقد يكون احتفاء الجائزة الأكثر شهرة و”بريستيجا” مؤخراً بشاعراتٍ وشعراء مؤشّراً يجدر أخذه في الحسبان. أمّا عربيًّا فلا بدّ من مراجعة المقولات القديمة والمعاصرة على إيقاع المخاضات المتعاقبة محلياً وكونياً. هل نفهم جميعنا مصطلح الشعر المتضمن في عبارة “الشعر ديوان العرب” بنفس الطريقة؟ ليس عندي شك في امتلاك الكثير من شعر التراث شعريّة عالية عنت لناس الأمس ما تعنيه الشعريّة لنا اليوم، ولكن ليس كل ما سُطِّر في ذلك “الديوان” العظيم بجميع المقاييس يمكن النظر إليه كما ننظر اليوم إلى الشعر. في قصيدة الأمس شعريّة وصحافة وأخبار وحكمة وسياسة وحرب وسلام ومناسبات اجتماعية وكل شيء، وأخال عبقرية العبارة التي رُددت كثيراً تكمن في تعبيرها عن هذا الاحتواء العام.
أظنُّ استبدال الصيغة السابقة بالصيغة المحدّثة “الرواية ديوان العرب” تنطوي على مأساة هي مأساتنا منذ تغيّر سَمْتُ هذا العالم. من الواضح والمفهوم أن يلعب شعر الأمس كل تلك الأدوار وأن يحتوي بين دفتيه الشعريّ وسواه. كان من المفترض أن تحمل الحداثة لربوعنا الحريّة، فضاءات جديدة وميادين تسرح فيها خيل الفنون العصيّة على الترويض كيف تشاء. لا يمكنّ للصورة أن تكون على هذا المستوى من التفاؤل على كل حال، حتى في أكثر الدول نجاحاً، فسريعاً ما يتولّى صاحب رأس المال مهمّة تحويل الروح الإنسانيّة إلى سلع شتّى، فَلْأكُن أكثر دقّة وواقعيّة ولْأتكلّم عن الهوامش بدل الميادين، حيث “لا عرشَ لنا إلّا الهوامش”. المهمّ أنّه ليس من المفترض بعد أن طرأت الحداثة أن يتابع فنّ من الفنون مهمّة احتواء كلّ شيء. لا أنتقص بذلك من قدر روايات عظيمة كتبها أدباء كبار، الفكرة هي أنّ اختناق المجال العام وحرمة السياسة وصعوبة التأريخ والتوثيق قد تكون أدّت بمجملها لرواج “سوق الرواية”.
أمّا المشهد الشعري العربي اليوم فيجعلني متقلّباً تماماً بين ندب واحتفاء وتعاسة وحبور. مزيج عجيب، وهذا جيد على كل حال. تتعايش مفاهيم قديمة وحديثة، شعر ونظم، شعر وهذيان، منصات تقليدية ومنصات جديدة، هوامش، شعراء كبار من أجيال مختلفة، أدعياء من كافّة الأجيال أيضاً، باختصار هو ليس بهذا السوء.
هل يعودُ زمن الشعر إذن؟ وهل كان غادرنا أصلاً؟ لا أظنّ. المسألة مسألة مفاهيم، وجهات نظر. أبشّر بالشعريّة لا بجنس الشعر؛ الشعر كمعنى وكأسلوب حياة ولا يمكن لهذا أن يغرب عن سمائنا، لأن الإنسان يولد في مدّ الشعر أما جزره فسيحدد تاريخ ولادة عصر الروبوت. ما دمنا بشراً فلنعلم أننا بصحبة الشعر، سيكون هناك شعر في مكان ما. وبهذا المعنى فإننا لن نسمع أبداً بذلك اليوم الذي يختفي من تفاصيله الشعر، لأننا ببساطة لن نكون موجودين.
شاعر من سوريا
——————————-
الشّعر دوما وأبدا/ أيمن حسن
قرأتُ روايات كثيرة ويمكن وصف البعض منها بالشّعريّة لما تتضمّنه من عوالم سحريّة وشخصيّات ضاربة في العمق والحياة وصولا إلى المأساويّة. قرأتُ روايات كثيرة بالعربيّة والفرنسيّة، واطّلعتُ على أمّهات “فنّ الرّواية”، كما يحلو للتشيكي الفرنسي ميلان كونديرا تسمية الكتابة السّرديّة، مُتَرْجَمَةً للفرنسيّة، التي صارت بفعل الممارسة وشيء ما يُشابه المصير، لغتي الأولى وربّما لغتي الأمّ.
قرأتُ إذن الكثير من الرّوايات وأحببتُ حتّى الجنون راسكلنيكوف وجوليان سوريل وفريديريك مورو وباردامو وسكّان قرية ماكوندو ومصطفى سعيد وغيلان، لكنّي لم أعتقد أبدا أنّ الرّواية فنّ أو جنس أهمّ من المسرح أو الشّعر. بل بالعكس، لطالما اعتبرتُ الرّواية فنّا تكميليّا يأتي للتّسلية، لملء وقت الفراغ، مقارنة بالشّعر وهو الأدب الأساسيّ والمسرح وهو الفنّ المكتمل بالنّسبة إليّ بمعنى أنّه حوار مباشر مع الجمهور.
صحيح أنّ الشّعر يعيش أزمة كبيرة بالمعنى الاقتصادي للكلمة، أي أنّ كبريات دور النّشر عزفت منذ عدّة سنين وربّما عقود عن نشر الشّعر الذي صار “ابن العمّ الفقير” للأدب، خاصّة مقارنة بالرّواية الّتي احتلّت أكثر من تسعين في المائة من برامج النّشر ومشاريعه. يرجع السّبب أساسا إلى ارتباط دور النّشر الكبرى بوسائل الإعلام الكبرى، فهو إذن لقاء أصحاب المشاريع الماليّة لا الفكريّة أو الحضاريّة، هذا ما يعني أنّ المال يبحثُ عن المال، وأنّ الشّعر لا يدرُّ مالا وفيرا كالرّواية لأنّه صعب المراس والقراءة والفهم. الشّعر صراع مع الزّمن، أو ربّما هو اختبار للزّمن.
أمّا الرّواية، فعلينا أن نقول إنّ ما يُباع ليس دوستويفسكي ولا ستاندال ولا فلوبير ولا سيلين ولا غبريال غارسيا ماركيز ولا الطيّب صالح ولا محمود المسعدي. (أذكرُ على سبيل المثال المرحوم السيّد محمّد المصمودي، صاحب دار الجنوب للنّشر بتونس، وهي الدّار التي أصدرت “السدّ” و”حدّث أبو هريرة قال” للمسعدي، أذكرهُ يقول إنّ المسعدي وهو موجود كلّ سنة في برنامج مناظرة الباكالوريا لا تُباع كتبه كما ينبغي). أي أنّ الكتب المقرّرة في البرامج الرّسميّة، والحال كذلك في فرنسا، لا تُمثّلُ أرقاما هامّة مقارنة ببعض الكتب التي يمكن اعتبارها تافهة، على الأقلّ ثانويّة، فما قيمة البرازيلي باولو كويلهو ورواياته المكتوبة بنفس النّمط كوصفات الطّبخ مقارنة بمواطنه “جورجي أمادو”؟ يمكن طرح السّؤال نفسه في كلّ بلاد العالم: في فرنسا، مثلا، المدعوّان فريدريك موسّو ومارك ليفي يبيعان من كتبهما أضعاف أهمّ ما يبدعه كتّاب اليوم. هل يعني هذا شيئا آخر غير أنّ ثقافة المال والمركنتيليّة استفحلت وأخذ القطيع في السّير بكلّ نحو المسلخ؟
في الحقيقة، للقارئ الحقّ في متابعة ما يريد: عندما يقرأ رواية لأحد هؤلاء، فكأنّه قرأها جميعا، وعندما يقرأ رواية جديدة، فسيتذكّر القديمة. هذا الفعل، المبنيّ على التّكرار، طريقة ماهرة لاستملاك القرّاء وجعلهم مستهلكين خاضعين لسلطة السّوق المتمثّلة هنا في كتب مصنوعة على طريقة “الفاست فود” و”الدجنك فود”، تلك الوجبات السّريعة التي احترف في توزيعها الغرب الأميركي القاتل صحيّا وفكريّا.
ليس للشّعر مكان في هذا الخضمّ. إن صحّ التّعبير، قصيدة واحدة لإيف بونفوا أو فيليب جاكوتّي أو صلاح ستيتيّة أثرى لغويّا وثقافيّا وإنسانيّا ألف مرّة من روايات هؤلاء. فكم نحن بعيدون عن سنة 1857 التي شهدت صدور كتابين من أهمّ الكتب في تاريخ الأدب الفرنسي والعالمي، وهما “السيّدة بوفاري” لغوستاف فلوبير، و”أزهار الشرّ” لشارل بودلير. الجميل في الأمر، هو قراءة الشّاعر للرّواية في مقالة جدّ بديعة، والأجمل هو محاكمة الكتابين والأديبين، لكن في نهاية المطاف قرّر القضاء ترك الرّواية لأنّ “العالم لن يكترث لخيانات امرأة ريفيّة”، لكنّه حكم بالإعدام على ستّ قصائد كاملة بتهمة “جريمة إهانة الآداب العامّة والأخلاق الحميدة”. دام هذا الحكم من يوم الإدلاء به، أي يوم الـ21 من آب/أغسطس 1857، إلى – تماسكوا أعصابكم – إلى يوم الـ31 من مايو/أيار 1949 بعد قرار “غرفة الإجرام بمحكمة التّعقيب” بباريس كسر الحكم الأوّل.
من خلال هذه القصّة الضّاربة في الواقعيّة وفي التَّأْريخ للأدب، يتجلّى لنا أنّ الشّعر والرّواية، وإن كانا يتبعان عالم الأدب، فهما لا يخضعان للمعايير نفسها. وقتُ الشّعر ليس وقت الرواية كما أنّ أغراض الشّعر ليست أغراض الرّواية. فالشّعر، منذ لحظة جلجامش إلى حصول الأميركيّة لويز غلوك على جائزة نوبل للآداب 2020 (بالرّغم من أنّي شخصيّا لم أقرأ لها ولا أعرف عنها إلاّ الشّيء البسيط)، يعيشُ مسيرته الخاصّة بعيدا عن الحسابات والانتظارات والأحزاب والأنساب.
للشّعر إيقاعه في المشي والرّكض والوقوف والقعود وحتّى النّوم. هو الحريّة بالأساس. يأتي عندما لا ننتظره ويصوم عندما نقرع جرس المأدبة، لكنّه دائما موجود: في زرقة السّماء أو سوادها، في جرعة الماء أو كأس النّبيذ، في بسمة الوليد أو رسمة البنت التي ترى أباها في شكل “سنفور شاعر”. الشّعر في كلّ مكان، وعلى الشّاعر التنبّه إليه. للأسف، لا يمكن أن نقول الشّيء نفسه عن الرّواية، فكما كان يقول سيلين، صاحب رائعة “رحلة في أقاصي الليّل”، “القصص موجودة في كلّ مكان.. في المستشفيات ومراكز الشّرطة والمطلوب هو الأسلوب”. بهذه الطّريقة، يكون الرّوائي الحقيقي شاعرا كما كان هوميروس وفرجيليوس ورابلي وسرفانتيس شعراء كبار لا روائيّين.
الأدب الحقيقي، كما الموسيقى الحقيقيّة، كما كرة القدم الجميلة، وفنّ الطّبخ الرّاقي، وصناعة الموضة وصناعة العطور وكلّ ما هو بديع في هذا العالم المليء بالخراب، يستحقّ أن يُلقّب بالشّعر. الشّعر، دوما وأبدا، سيكون اسم الجمال والإبداع والحريّة على حدّ السّواء.
شاعر من تونس
—————————–
القلب النابض للغة/ كاهنة عباس
الشعر هو استعمال اللغة على غير الصيغ المألوفة بتحوير علاقة الدال بالمدلول وابتكار لغة جديدة مختلفة عما درج الناس على استعماله أثناء تواصلهم بين بعضهم البعض أو في خطبهم المكتوبة، هو إذن، لغة مارقة عن الميثاق الاجتماعي الذي يعتبر المرجع المحدد لمعانيها وسياقاتها، إذ يحولها الشعر بفضل “خيال الشاعر وانتقائه لمفرداتها الأكثر إيقاعا” إلى لغة التفرد، تلك المعبرة عن عالمه الخاص كي تمنحه إمكانية التحرر من سطوة النظام الاجتماعي الاقتصادي والسياسي، لقدرتها على أن تكون مرآة لذاتيته.
الشعر هو القلب النابض للغة الحامل لوجدانها وهو أيضا أحد مصادر تجديدها، فلو عدنا إلى التراث العربي الإسلامي إلى المعلقات السبع في العصر الجاهلي، لتبينا قيمة الشعر وعلاقته الوثيقة باللغة في تحديد خصائصها وملامحها الكبرى، لقد مكّن الشعراء من تقلد دور ريادي في إحياء اللغة وتجديدها على المستوى الرمزي والمعنوي بفضل قدرتهم على خلق تصورات جديدة للعالم وتغييرهم لموقع الإنسان في الحياة وفي الوجود .
في هذا المضمار، يمكن أن نذكر بعض الأمثلة بالرجوع إلى الشعر القديم من خلال ما أضافه المتنبي وأبو تمام والبحتري على المستوى اللغوي سواء من حيث الشكل مع ما يستلزمه من جماليات، أو المعنى وتعدده، أو استنادا إلى الشعر الحديث وما أضافه رواد الشعر الحر من بينهم بدر شاكر السياب، نازك الملائكة ومن بعدهم نزار قباني ومحمود درويش، وتجدر الإشارة إلى أن دور الشعر في تجديد اللغة لا يقتصر على الثقافة العربية الإسلامية رغم مكانته المتميزة، بل وكذلك في ثقافات أخرى فلو عدنا إلى قصائد أرتور رامبو أو ستيفان مالارميه أو شارل بودلير الشعراء الفرنسيين، أولئك الذين عرفوا بالملعونين لتبينا أنهم ابتدعوا لغة وإيقاعت جديدة (خاصة رامبو ومالارمي) وكذلك قدموا تصورات حديثة للعالم خاصة في قصائد شارل بودلير.
أما الرواية، فيمكن تعريفها على أنها تلك القصة التي تروي أحداثاً معينة وتدور في أزمنة وأمكنة متعددة تعيشها شخصيات رئيسية وثانوية وتقوم بنيتها الكلاسيكية على الحبكة وفكها، هي فن غربي بامتياز كما ذكر الروائي التشيكي ميلان كنديرا في كتابه “فن الرواية” نشأ إثر التحولات الكبرى للمجتمع الغربي على امتداد مراحل عديدة، بداية من تقهقر النظام الإقطاعي وظهور الفردانية ثم الطبقة البورجوازية ومع الانهيار التدريجي للقيم الموروثة وظهور الحداثة، ومعنى ذلك أن لكل رواية نظامها الداخلي بما يحمله من مناهضة أو ترسيخ أو كشف عن تناقضات النظام القائم الاجتماعي السياسي الثقافي والاقتصادي بواسطة فن الحكي بإبراز الصراعات المختلفة التي يعيشها أفراد مجتمع ما في حقبة معينة من تاريخه، من هذه الزاوية يمكن القول إن للرواية علاقة وطيدة بالتاريخ و الأمثلة على ذلك لا تعد ولا تحصى، نذكر منها رواية “جرمينال” للروائي إيميل زولا وعلاقتها بالثورة الفرنسية أو رواية “الأوهام الضّائعة” للروائي أونوريه دي بلزاك ما ترويه من الصراعات مردها التفاوت الطبقي الذي عرفه المجتمع الفرنسي خلال القرن التاسع عشر، أو ثلاثية نجيب محفوظ “بين القصرين، قصر الشوق، السكرية” وما ترويه من تفاصيل حول خصائص المجتمع المصري بتقاليده وعاداته ومشاغله وصراعاته، أو “البحث عن وليد مسعود” للروائي جبرا إبراهيم جبرا وطريقة تناوله للقضية الفلسطينية، أو “موسم الهجرة إلى الشمال” للروائي الطيب صالح وما رواه عن المجتمع السوداني وطريقة تناوله لإشكالية الحداثة وعلاقتها بالاستعمار الغربي.
والرأي عندنا، أن الشعر في أعلى مراتبه يجدد، بينما الرواية على تعدد مدارسها غالبا ما تؤرخ ولو بأشكال مختلفة، ولأن الرواية ما انفكت تجمع بين الأجناس الأدبية، فالشعر تجاوز بنيته الكلاسيكية ليدمج النثر ويحوله إلى صور وإيقاعات، فلا شك أن كلا منهما تأثر بالآخر، فما طرحناه تأسس على الملامح الكبرى لكل منهما، وهو يرمي في نهاية المطاف إلى طرح السؤال التالي :
لمَ أسندت جائزة نوبل للآداب لشاعرة أميركية هي لويز غلوك؟ هل يعني ذلك أن الشعر أفلح في افتكاك مكانة الرواية التي تصدرت المشهد الأدبي العالمي طيلة عقود عديدة، خاصة وأن الشاعرة الفائزة بنوبل لم تكن تحظى بشهرة واسعة؟
ما يمكن استنتاجه أن جوائز نوبل بالنسبة إلى سنة 2020 جاءت للاعتراف بأعمال النّساء وقدرتهن على المساهمة بإبداعية في تطور الإنسانية جمعاء، فقد أسندت جائزة الكيمياء لسيدتين أيضا هما جينفر دودنا وإيمانويل شاربنتيي. أما في خصوص جائزة نوبل للآداب، فقد اعتبرت لجنة التحكيم أن شعر لويز غلوك قد ارتقى بالوجود الفردي إلى أن يكتسب قيمة إنسانية عالمية .
بقطع النظر عن الأسباب الظاهرة أو الخفية لذلك الإسناد، فهل يدل حصول الشاعرة الأميركية لويز غلوك على جائزة نوبل على تقهقر مكانة الرواية التي عرفت منذ الخمسينات أزمة عميقة إثر نشأة الرواية الجديدة؟
إن كنّا قد طرحنا هذا السؤال فمرد ذلك ما أحدثته الرواية الجديدة من زعزعة في بنية الرواية الكلاسيكية كما عرفت لدى بلزاك وزولا بأن أعادت النظر في أسسها من زمان وتسلسل في الأحداث وارتباطها بالمكان وبتقنيات السرد والوصف التي اعتمدتها، فقد اختار تيار الرواية الجديدة القطيعة التامة مع النظام الاجتماعي القائم بكل ما يحمله ويعبر عنه من قيم.
وهو ما حدث منذ سبعين سنة تقريبا، ومع ذلك استمرت هيمنة الرواية على مشهد الأدبي بفضل تأثرها واستفادتها من الفنون الأخرى مثل المسرح والسينما ومن العلوم الصحيحة والإنسانية ومن الأجناس الأدبية الأخرى من بينها الشعر، إلى جانب ما عرفته من ظهور تيارات جديدة كتلك التي برزت في أميركا اللاتينية وسميت بالواقعية السحرية بأن منحت الرواية روحا جديدة ورؤية مختلفة للعالم.
حصول الشاعرة لويز غلوك ليس وليد مصادفة، بل هو مؤشر على أن العالم يشهد تحولات عميقة وجذرية، تتمثل في إعادة النظر في كل ما يصدر عن الأنظمة الاجتماعية والسياسية والأفراد المبدعين في عالم الكتابة والبحث عن لغة جديدة وعلاقات مغايرة بالذات والآخر في بالعالم.
——————————-
ما فرّقه المسرح لن يجمعه إلا الله/ فارس الذهبي
إنّ قبولنا بواقع أن الشعر يكرّم ويرتقي مؤخراً بفعل الجوائز الأدبية، (جائزة نوبل كمثال في السنوات الأخيرة) ليس إلا إقراراً منا بواقع أن تلك الجوائز بالفعل هي الفيصل والمؤشر الصادق في تفاضل الفنون الأدبية في عالمنا المعاصر، وفي ذلك حكماً تجاهل كبير لصوت البشرية الشامل من القراء والمقتنيين للأعمال الروائية، فالمفاضلة بين الشعر والرواية كانت ولا تزال مسألة شدّ وجذب منذ عشرات القرون بين النقاد والفنانين وصناع السرد والنثر والشعر، فمنذ انفكاك الرواية المسرحية عن الشعر، بعد أن كانا يندرجان في صنف واحد هو المسرح، الذي كان يُكتب في عهد اليونان الإغريق والرومان وحتى الإنجليز الإليزابيثيين وصولاً إلى ملحمة فاوست التي كتبها الأديب الألماني غوته ونظم تراجيديتها في فصول من الشعر مثله مثل الكاتب الإنجليزي ذائع الصيت وليم شكسبير الذي كتب أعماله التراجيدية بالكامل في صورة أشعار أليكساندرية متنقلاً بين بحور الشعر الإنجليزي، لتشكل أعماله أحد أهم الروايات التراجيدية والكوميدية في التاريخ.. فمنذ انفكاك الشعر عن الرواية المسرحية، بات الصراع محموماً لإثبات أيهما أقوى وأيهما أبقى وأفضل.. في تناحر عاشقين انفصلا وبقيا يناكفان بعضهما البعض.
إنه زمن الرواية، دون أدنى شك، الرواية التي باتت ديوان الشعوب، ومرآة صورتهم في أوراقها، فمن فصل الرواية عن الشعر، لم يكن يفعل سوى أنه بسّط السرد ليجعله أقرب إلى الناس، ولم يكن يفعل سوى أنه نزع عن اللغة مجازيتها وصورها الرمزية من أجل أن يطلق العنان للفكرة على حساب الزخرف اللغوي والإيقاع الشعري والقافية المتحكمة بالشكل والصورة.. الرواية هي ملحمة البسطاء حيث لا مكان للاختزال، وملحمة المهمشين والمهزومين التي يحتاج شرحها لتفاصيل وفيرة، وما أكثرهم في زمن العولمة المعاصر، حيث لا رفاهية لدى المهمّشين لفك طلاسم الشعر وضبط ايقاعه ووزنه.. رغم أن الزمن هو زمن السرعة والمعاني السريعة، حيث لا وقت للإطالة، لكن العشاق يجدون وقتهم في تفاصيل الرواية مثلما يجدون الوقت للوقوف ساعات طوال أمام المرآة بحثاً عن شعرة بيضاء في الشعر أو اللحية أو حاجب غير منتظم في الوجه، الرواية هي سردنا في مواجهة حياتنا.. كل تلك التفاصيل تفتح الباب لمبيعات هائلة للرواية في مقابل اضمحلال الشعر في منطق السوق.. فالأدب كبضاعة تسويقية في زمن العولمة لا يؤمن سوى بالأرقام، وكم يجد الشعراء من صعوبة في نشر ما يكتبون، حول العالم بينما تنشر سنوياً ملايين الروايات/المرايا باحثة عن وجوه أصحابها المتناثرين حول العالم.
مذ انفصلت الرواية عن الشعر فوق خشبة المسرح لم يلتقيا مجدداً ومضى كل منهما في طريقه، طريق للنخبة الشعرية، وطريق للجماهير الضائعة الباحثة عن معنى لوجودها، ومنذ سقطت التراجيدياً بسبب فناء البطل التراجيدي في عالمنا المعاصر، بسبب التطور العلمي وتقدم علم النفس والتكنولوجيا، حيث بات صراع البطل التراجيدي مع الآلهة ضرباً من السذاجة لانتفاء الإله على الطريقة النيتشوية، وبات سقوط البطل التراجيدي الذي لم يعد موجوداً في زمننا الحديث، بفعل الشك العلمي الذي قتل كل روحانية الغيب وخضوع للضعف البشري أمام الخالق، وربما تحديه.
من تلك النقطة تلاشت التراجيديا في القرن العشرين أو تضاءلت حتى اقتربت من العدم، وانفتح الباب للرواية النفسية التي غاصت في ثنايا الإنسان البسيط، وليس ذلك البحث في حيوات الملوك وحاشيتهم والآلهة وأنصاف الآلهة. الرواية هي ديوان الشعب ديوان الإنسان العادي ومرآته، والشعر هو ديوان المسترخين.
ومع انتفاء التراجيديا، وجد الشعر نفسه وحيداً، لا يمكن له الاندماج مع الرواية المعاصرة، السريعة النفسية، ذاتية أو الوجودية، أو الوصفية. فاندفع القيمون على الثقافة من أجل دعم ذلك الفن النبيل الذي أنشده الأنبياء وارتقوا به وصولاً إلى الحكمة والدين. اندفعوا لدعمه وتدعيمه في مواجهة حركة السوق القاسية ضده.. من أجل هذا لا بد من التدعيم النفسي له بالجوائز.
وهذا لا يعني أن الشعر منزل ذو حائط منخفض، ولا يعني أن رواج الرواية يعني عدمية للشعر، بل وبكل تأكيد فإن الشعر العالمي وصل إلى مطارح هُلل له فيها لدرجة البكاء، ووصلت تصاويره إلى بقاع غير مسبوقة، ولكن يبقى لكل مقام مقال، ولكل عصر ديوان.
كاتب سوري
——————————-
لا جنس يعلو على الآخر/ نهلة راحيل
هل نعيش زمن الرواية أم زمن الشعر؟ سؤال متكرر تتجدد إجاباته وتتعدد لاعتبارات متنوعة يرتبط بعضها بتغير المشهد الثقافي وحراك المحيط الاجتماعي، وبعضها بذائقة المتلقي والحركة النقدية، والآخر بدور النشر ووسائل ترويجها للإبداع الأدبي عموما وفق استراتيجيات السوق ومتطلباته الاستهلاكية.
فرواج الرواية وسطوتها في الآونة الأخيرة – رغم عدم وجود كتابات تُصنف كأيقونات روائية يمكنها التأثير والاستمرار – لا يمكن أن نعزوه فقط لقيمتها الجمالية المتجددة أو لاستيعابها لقضايا المجتمعات وانفتاحها على الفنون الأخرى، وإن كانت كلها عناصر تكفل لها التسيّد على غيرها من الأنواع الأدبية، إنما ننسب هذا الرواج في الأساس إلى اعتبار العمل الأدبي سلعة تجارية تخضع لاحتياجات السوق وتحقق الربح المادي، وهو ما أسهم في ميل الناشرين إلى طباعة الروايات – ومؤخرا الرواية المترجمة ذات الصفحات القليلة التي يترجمها شباب المترجمين – التي تغري المتلقي وتجذبه نحو الشراء.
وقد أصاب هذا الفكر الاستهلاكي العديد من المبدعين فاتجهوا إلى كتابة الرواية ليست لكونها جنسا أدبيا مرنا يمزج بين الخيال والواقع ويتيح حرية التجريب، بل بوصفها خطابا رائجا يمتلك فئة عريضة من الجمهور ويتمتع بشعبية كبيرة. وقد دعّم هذا التوجه تعدد الجوائز الأدبية – العربية والعالمية – المخصصة للرواية ووفرة الأقلام النقدية المهتمة بها، إلى جانب تنوع الأشكال الروائية القادرة على استيعاب الثورة الرقمية بأبعادها المرئية والسمعية والتفاعلية، كروايات الديستوبيا والخيال العلمي والفانتازيا وغيرها من أنماط كتابية سهلة الانتشار بين الشباب- كشريحة واسعة من القراء- من مستويات اجتماعية مختلفة، مما يكفل رواج العمل وشهرة كاتبه.
ومع ذلك، فإن مركزية الرواية على الساحة الأدبية الراهنة لا تعني بالطبع تهميش الشعر أو تبعيته للسيادة الروائية التي تحددها عناصر تجارية ومنافع ربحية وليس فقط قيما جمالية إبداعية كما أسلفنا، فالشعر لا زال هو المُعبّر الأبرز عن اللحظات المصيرية الفاصلة في تاريخ الشعوب، يبرهن على ذلك حضوره الدائم في زمن الثورات العربية والتحولات الاجتماعية، وتجاوبه المباشر مع الحراك الجماهيري، لقدرته على توثيق تلك الأحداث في آنيتها وتجسيد ما يصاحبها من مشاعر إنسانية وهموم قومية وأحلام وطنية. كما كان الشعر على مدار عصور عديدة هو ديوان العرب الذي يسجلون عبره أسرار تاريخهم وأخبار حضارتهم وأحوال مجتمعاتهم، وقد ظل ينعم بالسيادة ويحظى بالأولوية لفترات طويلة حتى جاءت الفنون السردية – وفي مقدمتها الرواية – لتزحزح هذه المركزية وتتشابك مع القصيدة بمرجعياتها الثقافية ورافدها الشعرية المختلفة.
لذلك فإن ارتداد المساحة القرائية للقصيدة مؤخرا قد يرتبط بإحجام العديد من الناشرين عن طباعة الدواوين وتخلّي الحركة النقدية عن متابعة الشعر والشعراء بنفس القدر من اهتمامها بتثمين/تقليل الرواية والروائيين أو رفض الخطاب الرسمي بالاعتراف بأشكال شعرية متمردة كقصيدة النثر أو قصيدة الومضة وغيرها من أشكال لا تلتزم بثوابت الشعر العمودي من ناحية، وربما تسبب فيه كذلك تعالي الشعر – أحيانا – على قرائه وعزوف الشعراء عن متابعة ناشريهم/مترجميهم وتحفيزهم على الترويج لإصداراتهم بالشكل الذي تستحقه وإيصالها إلى القراء من ناحية أخرى. فعودة الشعر، إذن، مسؤولية تقع على عاتق الشعر والمجتمع معا.
من هنا يمكن القول إن تراجع الشعر ورواج الرواية لا يرتبط، بأيّ حال من الأحوال، بانعدام الذائقة الشعرية لدى المتلقي أو بغياب أصوات الشعراء أو قلة أعدادهم مقابل المزاج الروائي للقارئ أو وفرة كاتبي الرواية، فانتشار جنس أدبي في عصر ما وانحسار نظيره لا يعني بالضرورة غياب أحدهما التام عن المشهد الثقافي، بل يعنى وجودهما معا في ثنائية دينامية تتحكم في صياغتها اشتراطات تسويقية عديدة وتغيرات مجتمعية مختلفة. ففي النهاية، لا رواج الرواية يعني كساد الشعر، ولا مركزية مكانة الشعر تدل على هامشية فنون السرد. فلا جنس يعلو على الآخر، وقد لا يكون هذا الزمن هو زمن الرواية أو زمن الشعر، بل هو زمن الأفضل مبيعا والأكثر ربحا والأسرع انتشارا.
كاتبة من مصر
——————————
الشّعر يتنفّس في سمائه السّابعة/ أيمن باي
إلى الشّاعر، ضوء في غمامة، وإلى القارئ، نسْل اليقين الأبديّ.. لا شيء في آخر الطّريق غير بوح البلاغة عن سرّ القول والخيالْ. ليس الشّعر ناكثا بوعده، وإنّ من السّحاب ما يمرّ، ولو بعد حين.. فالشّاعر النبيّ والقصيدة الرّسالة.
أطلق النّاقد المصري جابر عصفور منذ تسعينات القرن الماضي فكرة “زمن الرواية”، وهي رؤية نقدية تقوم على إعلاء النّثر عموما وجنس الرواية خصوصا والحطّ، بذلك، من الشّعر، لأنّ الرواية العربيّة عند جابر عصفور تجسّد عقليّة الاستنارة التي انبنى عليها مشروع النّهضة، وهي، بذلك، ستزدهر لأنّها أداة فنيّة لعقلية الاستنارة تلك.. فهي ديوان العرب الجديد ومرآة عصرهم.
وبعد ذلك، أخذ الإعلاميّون والنقّاد والأكاديميّون، يروّجون للرواية في الندوات والملتقيات واختصّت دور النّشر، أو تكاد، بنشر الروايات ورفض الشّعر نظرا للجوائز المالية الكبرى المخصّصة للرواية حتّى صارت الروايات أكثر الكتب، وأضحى الروائيّون أكثر من القرّاء.
إنّ هذا كلّه، يبدو إلى حدّ بعيد ممنهج ومقصود، لبنة فوق لبنة، في صرْحٍ زائفٍ، والجمهور مثل حاطب ليل تستوي عنده الأشياء جميعها، وَهْمٌ تغذّيه اتهامات ضد الشّعر بالغموض والنخبويّة والابتعاد عن الهم الجمعي وعن الجمهور وبالتخلّي عن مكانته كديوان العرب للرّواية.. وفي هذا جهل غير مقصود أو إخفاء مقصود لتطوّر الشعر العربي المعاصر في بنيته وفي علاقته بالمرجع.
لكن ضوء هذا الزيف أخذ يخفت.. والتّهليل للرواية أخذ يتراجع نسبيّا.. ولم تستطع شجرة الرواية أن تحجب غابة الشّعر كما أراد لها صاحب الشّجرة وقاطف ثمارها.
إنّ انفتاح الشّعر على الفنون واستدعاءه عناصر سرديّة عديدة واقتراب الرواية في لغتها من الشّعر جعل من مقولة زمن الرواية دون معنى، ذلك أن الأدب قرّب في السنوات الأخيرة، أكثر من أيّ وقت مضى، الأجناس الأدبيّة بعضها إلى بعض مما جعل الحدود المائزة بين بنياتها الأولى غائمة فأطلق “جيرار جينات مصطلح “جامع النّص” ورولان بارت “مفهوم الكتابة” رؤيتان تسعيان إلى إلغاء الحدود بين الأجناس الأدبيّة فلا زمن للرّواية ولا آخر للشّعر.. بل زمن الأدب في كلّيته.. حيث المطلق يحوي الجزئي.
إضافة إلى ذلك، فقد تطوّر الشّعر العالمي من حيث البناء والمعنى وتنوّعت نوافذه المطلّة على العالم والإنسان، وتعدّدت مصادره وتعمّق مفهومه، فملأ ماؤه الكون وظلّلت أشجاره المسافر إلى الأبديّة.
وليس أدلّ على ذلك من عودة الشّعر إلى واجهة الثقافة الكونيّة وحيازته أسمى الجوائز في ميدان الأدب والفنون فقد تحصّلت الشّاعرة الأمريكيّة ” لويز جلوك ” على جائزة نوبل لآداب لسنة 2020 وفي العام 2019 بيتر هاندكه نال نوبل وهو شاعر وروائي، وفي 2016 حاز على نوبل شاعر وموسيقي ومغن هو بوب ديلان. وفي هذا العام نال شّاعر عربي هو التّونسي ” المنصف الوهايبي” جائزة الشّيخ زايد لآداب لسنة 2020 عن ديوانه ” بالكأس ما قبل الاخيرة” وهي المرة الأولى التي يفوز فيها الشّعر بهذه المسابقة.
إنّ الشّعر إذن حيّ، يتنفّس من علٍ في سمائه السابعة، يرى العالم فيحوّله إلى كلمات ويعكس صورة الإنسان في ماء الوجود بكل الألوان.. فهو الجذر الذي منه تشتق الفنون بكلّ ظلالها.. وهو ديوان العرب اليوم وغدا.. وديوان الإنسان الموغل في التجربة والزّمن.
ناقد من تونس
——————————
هل عاد زمن الشعر/ عواد علي
حين نتحدث عن أهمية الشعر في حياتنا غالباً ما نستذكر عبارة جان كوكتو “الشعر ضرورة.. وآه لو أعرف لماذا”. وأرى أن أفضل مَن أجاب عن التساؤل في هذه العبارة هو الفيلسوف إدغار موران بقوله “الشعر أول مهارات حسن العيش وآخرها، فهو تمسك بجمال العالم والحياة والإنسان، وفي الوقت نفسه مقاومة لقسوة العالم والحياة والإنسان”. وذلك لأن الشعر يحاول أن يعبر بالكلمات إلى ما لا تستطيع الكلمات أن تقوله، حيث يتقدم إلى حدود اللغة، وإلى حدود ما يُقال، وإلى حدود الوعي، إنه يرى من خلال المرئي ما وراء المرئي، وهذا ما يطلق عليه رامبو الاستبصار.
إذن، حاجة الإنسان إلى الشعر مثل حاجته إلى الماء والهواء والنبات، ولولاه لما وُجد الغناء ولا الموسيقى، ولا معنى لأن يكون زمنه قد مات أو خبا أو وُضع في غرفة العناية المركزة. وأذكر أنني كتبت يوماً ما “أظن أن آدم أول ما نطق به حين هبط إلى الأرض كان قصيدةً غازل بها حواء تعبيراً عن امتنانه لها لأنها عصت الربّ، وصار بإمكانهما ممارسة الحب بحرية”.
ما يقال عن سيادة الرواية على الشعر، وتربّعها على عرش الأدب في عصرنا الحالي، خاصةً في عالمنا العربي، لا ينبع من إدراك قائم على تفوّق الأولى إبداعياً على الثاني، ولا على انحسار الشعر أو عجزه عن استكناه قلق الإنسان، وسموّ روحه، وحيرته الوجودية، وكشف مواطن الجمال والمآسي والمواجع والجروح والعواطف، ومشاكسة اليقينيات، وغير ذلك، بل لأسباب كثيرة في مقدمتها إغراءات المسابقات والجوائز التي تمنحها بعض المؤسسات الثقافية العربية للرواية، مثل جائزة البوكر وكتارا والشيخ زايد والشارقة ونجيب محفوظ (الجامعة الأميركية في القاهرة) والطيب صالح في السودان وغيرها، وإقبال العديد من دور النشر على نشر النتاج الروائي لدوافع مختلفة، وتراجعها عن إصدار الدواوين أو المجموعات الشعرية، ما دفع العديد من الشعراء إلى ركوب الموجة والتراخي أو التوقف عن تطوير مشاريعهم الشعرية، وكذلك انجراف مَن يفتقرون إلى موهبة الكتابة، ومَن لم يقرأوا عشر روايات في حياتهم، إلى عالم الرواية، وهوس الجيل الشاب به، وانحسار اهتمامه بكتابة أشكال أدبية أخرى، اعتقادا منه بأن الرواية غدت الفسحة المناسبة له للتعبير عن مكنوناته، وتحولت إلى فعل حرية تتناسب عكسيا، أو تأتي ردة فعل على حياتنا المحافظة والمنغلقة على نفسها.
كل ذلك، إلى جانب ركاكة الكثير من تجارب قصيدة النثر التي تنشر هنا وهناك إلكترونياً من دون معيار، أدى إلى شيوع وهم “زمن الرواية”، بالرغم من أن ثلاثة أرباع الروايات التي تنشرها بعض دور النشر، مقابل مبالغ يتكبدها مؤلفوها، هزيلة تنحو منحى رومانسياً مائعاً أو تقليديا، ويعوزه الإتقان والإحكام من الناحية الفنية، بل تتسم بضعف مكونات أبنيتها السردية من حبكة وشخصيات وحوار ومنظور سردي وما يتصل بها من تقنيات وركاكة في الأسلوب، ما يدعو إلى السؤال عن أحقية انتمائها إلى الفن الروائي!
هل عاد زمن الشعر، أو أنه سيعود؟
أظن أنه نعم، وعلى النقاد والمنابر الثقافية والمؤسسات الأكاديمية أن يسهموا في تعزيز مكانته.
كاتب من العراق
—————————–
الشعر يسري في الدم/ محمد العامري
لم يتخل الشعر عن بهائه يوما من الأيام، فهو قلب الأرض الذي يؤشر على ديمومة الحساسية الجمالية للإنسان، فقد فاز بنوبل كثير من الشعراء على رأسهم بابلو نيرودا شاعر الحب ورابندرانات طاغور وتوماس ستيرنز إليوت وريس باسترناك، وكذلك في هذه السنة ينتصر الشعر بفوز الشاعرة الأميركية لويز غليك.
أعتقد أن المنظومة النقدية العربية هي منظومة تلهث خلف المناسبة السائدة في حقبة ما، لتنقاد إلى مواقع واهمة منسلخة عن ضمير العالم، لذلك سادت مقولة ساذجة تقول “الرواية ديوان العرب” وقد عمّق تراجع الضمير الجمعي الشعري طبيعة الجوائز المغرية التي خصصت للرواية دون الشعر، هذا الأمر ساهم في شيوع مفاهيم واهمة حول تراجع أهمية الشعر وضرورات السرد وتتابع تلك المفاهيم لدى دور النشر التي أصبحت تتثاقل في نشر الشعر ولكنها شغوفة في نشر الرواية والترجمات دون الأخذ بعين الاعتبار أهمية النص سواء كان شعراً أو سرداً.
لكن العالم بشموليته لم يتغير كثيراً، خاصةً العالم الغربي الذي ينظر إلى الشاعر كقيمة نادرة ومهمة في حياة المجتمعات.
الشعر موجود في ضمائر الناس لكنه تراجع في المشهدية العامة في الميديا، وطبيعة الجوائز والنشر والبرامج الثقافية.
ولم يزل إلى هذه اللحظة معظم الناس يستشهدون في أحاديثهم بأبيات شعرية للمتنبي مثلاً، وهذه دلالة على سريان الشعر في الدم العربي منذ بزوغ القصيدة وتجلياتها ما قبل الإسلام، أو ما يسمونه جزافاً “العصر الجاهلي” وهي تسمية تحمل في طياتها دلالةً إقصائيةً واضحةً.
الشعر مكبّل بأكثر من قيد، لكنه ما زال يقاوم، ويتواجد في الحراك الثقافي والاجتماعي رغماً عن تلك القيود
فالشعر كمنجز نصيّ لم يتراجع، بل تطاول ليصل السماء بكوننا نمتلك فرصةً حرةً في اختبار تنويعات النصوص وتجلياتها الإنسانية، لكننا نحن أردنا له تلك العتمة والإخفاءات التي تراكمت حتى سادت مقولة “الرواية ديوان العرب”، وهي أيضاً مقولة إقصائية ظالمة، علماً ان السرد يرمم جمالياته بالشعرية، وكذلك السينما والفعل المعماري، فالشعر موجود في الفيزياء وكل مناحي الحياة، موجود منذ هوراس وهو في علوّ مطّرد، فقد قامت عليه الحضارة اليونانية في المسرح وشتى مناحي الحياة.
نحن ما زلنا نعاني من التباس في مفهوم الشعر نفسه، عبر محاربة الحداثة في المنابر الإعلامية التي انتصرت في غالبها لعمود الشعر، وكذلك الشعر المحكي “العامي” بكونه يناغي أحاسيس دهماء الثقافة، بل أقيمت مهرجانات بملايين الدولارات لمثل هذه القصائد التي غالباً ما تتورط في المدحوية لهذا الحاكم أو ذاك.
لكن العالم يدرك أن الشعر هو الحضارة الإنسانية النابضة، لذلك كثر الذين حازوا على جائزة مثل نوبل من الشعراء العظماء، على عكس ما يحدث في عالمنا العربي، فقد عانى الشعر من مجموعة هائلة من الإقصاءات المبرمجة، والتي ساهمت في سيادة الشعر الخطابي الذي يمتدح السلطة السياسية، ومجموع ما يبث من هذا النمط يفوق بكثير ما يبث من شعر جيد له فضاءاته الناقدة، وما زلنا نعاني من ممنوعات هائلة لبعض الأسماء الشعرية العربية الكبيرة من دخول كتبهم بعض البلدان العربية، والسبب الرئيس في ذلك هو السلطة الدينية والسياسية.
فالشعر مكبّل بأكثر من قيد، لكنه ما زال يقاوم، ويتواجد في الحراك الثقافي والاجتماعي رغماً عن تلك القيود. فحين تنتصر نوبل للشعر يعتبر الأمر بمثابة رسالة ساطعة لعالمنا العربي بأن المبدع الحقيقي هو ضمير الكون، بغض النظر عن الشكل الإبداعي الذي يقوم به، وخاصةً الشعر الذي توّج مجمل الفنون عبر التاريخ.
وقضية شيوع زمن الرواية ما هي إلا وهم بائن إذا تفحصنا المشهد بشكل حيادي، نعم هناك انتعاش للفعل السردي لكنه لم يستطع أن يقصي القصيدة أبداً، والذي غلّب طرفا على الآخر هو طبيعة سلوك المؤسسات الثقافية الرسمية منها والأهلية كذلك، وخاصةً دور النشر والتوزيع. لذلك فالشعر باقٍ إلى يوم الدين.
شاعر وفنان تشكيلي من الأردن
——————————-
لعبة الأزمنة والجوائز/ هيثم حسين
هل يمكن توصيف مسألة تغليب جنس أدبيّ على آخر بأنّها لعبة جوائز، أو بتعبير أقسى؛ خدعة الجوائز؟ ومن المعلوم أنّ الجوائز تلعب دوراً في توجيه دفّة الأدب صوب هذه الوجهة أو تلك، من جهة الاحتفاء بها تباعاً، والإيحاء بأنّ هذا الجنس أكثر حضوراً وتأثيراً فتمّ تكريمه وتتويجه، من دون أن يلغي الآخر أو يعتّم عليه؟
لا أعتقد أنّ الفكرة تُطرح بهذا الشكل، أن يلغي فنّ فنّاً آخر، أو يأتي على حسابه، بحيث يأخذ من حيّزه ليفترش مساحة أكبر من الاهتمام، ويحظى بمزيد من المتابعة والانتشار والجماهيرية..
للشعر زمنه الخاصّ الذي يستحيل أن يزاحمه عليه أيّ فن آخر، وهذا الأمر ينطبق على الرواية، وعلى الفنون والأجناس الأدبية الأخرى، ذلك أنّ القول بموت هذا الفنّ، أو انحساره، أو تبدّل زمنه، وتقهقره وكأنّه في صِدام مع الفنون الأخرى، أو في حالة بحث عن الهيمنة معها، يبتعد عن جوهر الفنّ نفسه، وينساق وراء مقولات فضفاضة بعيدة عن حقيقته وواقعه وتاريخه.
لا أظنّ أنّ أيّ جائزة، مهما بلغت من القيمة والاعتبار، ولو كانت نوبل نفسها، يمكن أن تساهم بتسييد زمن فنّ على آخر، لأنّ الأمر يتعدّى التتويج إلى عالم برمّته، فقد ينصبّ التركيز على الفنّ المتوّج بنوبل هذا العام، أو الذي يليه، لكنّه لا يحدّد معالم تاريخ الأدب ولا خرائطه.
فلو كان الشعر في أزمة، وينازع للبقاء، فلن تنقذه أيّ جائزة، ولن تعيده إلى الصدارة أو تخرجه من أزمته، بل قد تطيل عمره قليلاً وتوقف موته لمحطّة لاحقة..
وإذا كان منح نوبل معياراً لتصدّر نوع من الأدب، فلماذا لم نجد أيّ اهتمام يُذكر، على الأقلّ عربيّاً، بقصائد بوب ديلان الغنائية سنة 2016، ولا أذكر أنّ كثيرين استساغوا قصائده، أو ظنّوا أنّ أسلوبه في الكتابة الشعرية الغنائية سيسود ويصبح سيّد الزمن الراهن أو المستقبليّ، بل كان التتويج ذاته وُصف من قبل بعضهم بأنّه هفوة نوبل، وهذا بالطبع بعيداً عن قيمته الموسيقية والأدبية.
لو كان الشعر في أزمة، وينازع للبقاء، فلن تنقذه أيّ جائزة، ولن تعيده إلى الصدارة أو تخرجه من أزمته، بل قد تطيل عمره قليلاً وتوقف موته لمحطّة لاحقة
لعلّ أزمة الشعر تقبع في مكان آخر، ولا ترتبط بانحسار الاهتمام به في الجوائز، لأنّه ما تزال هناك جوائز عديدة للشعر، بل هي تكمن في طبيعة الزمن نفسه، وفي استراتيجيات الكتابة والتلقّي، ولربّما لم تعد القصيدة لدى بعضهم قادرة على التعبير عن مكنونات قلوبهم، لا لمشكلة بالقصيدة، أو لقصورها عن ترجمة ما يعترك في دواخلهم، بل لأنّه تعقيدات الحياة فرضت إيقاعاً مختلفاً يواكبها عليهم، وملأت الرواية هذا الشاغر وتصدّرته.
وقد توجّه العديد من الشعراء إلى الرواية، ولا أدري هل كان ذلك عن تهافت من قبلهم على ما راج بأنّه زمن الرواية، أو أنّهم صدّقوا مزاعم بأنّ الشعر مات أو يكاد، ووجدوا أنّ عليهم إنقاذ أنفسهم من سفينة الشعر التي شعروا أنّها تغرق وتغدو طيّ النسيان أو تعود إلى الهامش، أو أنّهم أرادوا صيغة تعبير جديدة بالإضافة إلى القصيدة ليوصلوا من خلالها رسائل مختلفة جديدة..
ولا أودّ القول بأنّ الشاعر الهارب إلى ميدان الرواية مسكون بالشكّ بقدرة قصيدته على منافسة الرواية، فتراه رضخ لمقتضيات العصر كي لا يقبع في الظلّ أو يبقى في العتمة، لأنّ الأمر يمكن أن يكون انطلاقاً من إثراء معرفيّ وأدبيّ، وارتحال بين الأجناس الأدبية وتجريبها، وإضفاء لقيمة يجد أنّ الرواية تفتقر إليها وأنّ بإمكانه أن يسبغ عليها بصمته الشعرية الخاصّة.
لا يهدّد الشعر عرش الرواية، كما أنّ الرواية لم تحظِ بأهمّيتها على حساب الشعر، لأنّ لكلّ منهما عالمه وزمنه وجمهوره، ولا يكون الأمر بالحلول والاتّحاد والتنافس بقدر ما يكون بالتكامل والإثراء. والشعراء ينافسون أنفسهم فقط، وكذلك الروائيّون، وحين تُسلّط الأضواء على أحدهم تكون هناك أضواء أخرى بانتظار الآخر في محطة قادمة قريبة.
ويبقى ما أجمل في عالم الأدب أنّه يستوعب الفنون ويتجمّل بها، يكتسي بها حلله وجمالياته، لذلك فإنّ كلّ زمن هو زمن الشعر، وزمن الرواية، وزمن القصّة، وزمن المسرح، والسينما والدراما كلّ الفنون الأخرى.
كاتب من سوريا
——————————–
أيُّ مستقبل للشعر؟/ أحمد سعيد نجم
لستُ شخصياً ممن ينكرون أهمية جائزة نوبل، حتى وإن استفزّتني بعض قراراتها. غير أنها ليست معياراً وحيداً، كي يُقالَ إن منحها في دوراتها الأخيرة لثلاثة شعراء يشير إلى استعادة الشعر لمكانته التاريخية، بعد عقودٍ هيمنت فيها الرواية على الأجناس الأدبية الأخرى وكادت تودي بها إلى حتفها.
ففي آخر كلماتٍ ينطقها الكورس في مسرحية “أوديب ملكاً” يجري نُصحُنا بأن لا نحكم بشقاء إنسانٍ ما أو بسعادته إلا بعد أن يموت. والأمر نفسه هنا، إذ لا يمكننا أن نحكم لا أدبياً، ولا حتى سياسياً، على عصرٍ من العصور، إلا بعد أن يصبح ذلك العصر ماضياً. فالصعود والهبوط والتذبذب بين الحالين سمات ملازمة دوماً لكُلّ حاضر.
وفي الربع الأخير من القرن التاسع عشر ساد النقدَ الأدبي مزاجٌ متفائلٌ عبّر عنه الناقد الانجليزي ماثيو أرونولدز من أنّ “للشعر مستقبلاً هائلاً، لأن الانسانية ستجد في الشعر الجدير بهذا المستقبل مستقرّاً لها، يتجدّد الاطمئنان إليه على مرّ الأيام”.
غير أن مواطنه الناقد الأكاديمي أ. إ. ريتشاردز سعى في كتابه “العلم والشعر” إلى تحطيم ذلك الرأي، وتأكيد عكسه، من أنه بحكم أن العالم من حولنا يتغيّر يومياً على نحوٍ سريع، فإنه لا مستقبل بتاتاً للشعر “والشاعر في عصرنا نصفُ متبربر في مجتمعٍ متحضّر. إنه يعيش في الأيام الخوالي”.
وإلى رأيٍ شبيه بهذا الرأي ذهب الناقد البريطاني تيري إيجلتون في كتابه “مدخل إلى نظرية الأدب” عندما قال إن البشرية قد تُنتِجُ في المستقبل “مجتمعاً لا يكون قادراً على استخراج أيّ شيء على الإطلاق من شكسبير. وقد تبدو أعمال هذا الأخير آنئذٍ على نحوٍ مؤسٍ، مليئة بأساليب من الفكر والشعور التي يجدها مثلُ ذلك المجتمع محدودةً، لا أهمية لها”.
الشعر “محاولة للإجابة عن أسئلة لا إجابات عليها، لأنها في الأصل ليست أسئلة حقيقيّة”
ورغم الدور الهام للنُقّاد في توجيه الأدب وتقويم مسيرته إلا أنهم ليسوا في النهاية مسؤولين مسؤولية مباشرة عن سيادة جنسٍ أدبي أو احتجاب جنسٍ آخر، في هذه الفترة الزمنية أو تلك. فهذه عملية تاريخية معقّدة تتحكّم فيها عوامل عديدة.
والحقيقة، وإن لم تعجبنا، هي أن فنّ الرواية استحوذ منذ بداية انطلاقه، علي يدي سرفانتس أو ديفو، بل يعيد الناقد الروسي باختين بداياته إلى قصص الرومانس اليونانية واللاتينية، على أوراق قوّة، يضيق المقام عن عدِّها، تفتقر الأجناس الأدبية الأخرى لمعظمها، أوراقٌ قد تبقي فنّ الرواية حيّاً ومهيمناً لأجيال كثيرة قادمة.
على أن كلّ التنظير الماضي لا ينزع عن الشعر أهميّته الخالدة، فهو الجنس الذي ربما كان أوّل الأجناس الفنيّة التي اخترعها البشر، جنسٌ أحبّوا وقعه على آذانهم، وأحبوا وفرة المعاني التي ينطوي عليها الترتيب المخصوص لكلماتٍ قليلة، أحبوه وجعلوه هو والفلسفة سُلّماً للمطلق، يطرحون عليه أسئلة لا إجابات عنها. ومهما تقدّم العلم، ومهما استجاب فنّ الرواية لذلك التقدم، إلى أن وجودنا في هذا الكون، بل وجود الكون ذاته، سيبقى على الدوام يطرح علينا ألغازاً لا حلّ لها، وليس بمقدور جنس غير الشعر أن يعيد طرح تلك الأسئلة ثانيةً، وأن يجمع المتنافرات في وحدةٍ لا تخطر على بال.
أو كما جاء في كتاب أ. إ. ريتشاردز في الكتاب الذي اقتطفنا منه قبلاً “لا يستطيع العلم أن يقول لنا: ما كُنهُ هذا الشيء ولا يستطيع أن يخبرنا مَنْ نحن، ولماذا نحن في هذا العالم، ولا ما هو هذا العالم”.
وبالتالي فالشعر “محاولة للإجابة عن أسئلة لا إجابات عليها، لأنها في الأصل ليست أسئلة حقيقيّة”.
كاتب من فلسطين مقيم في الإمارات
—————————
المكانة الأصيلة
في البدء كانت الكلمة، سواء كانت منطوقة أو مكتوبة، فهي لسان حال اللحظة التي انبثقت من حاجة الإنسان. ولهذا فهي إن كانت منطوقة أو مكتوبة، فإن التوصيل هو ما يحدّد الهدف والماهية والمبتغى والقصد. وأمام حاجة الإنسان لاكتشاف ذاته والمحيط من جهة، والحاجة الى مخيّلةٍ قادرة على مساعدة الذات والتفكير في رؤية جوهرية من جهةٍ أخرى، غير منظورة للآخرين، فإن الأدب كان أولى الخطوات التي عبّرت عن تلك الحاجة، التي سوّرها الشعر كنوعٍ من المخالفة عن الكلام المنطوق أو المكتوب. ولهذا فالشعر كان حاجةً ومن ثم تأمّل ومن ثم رؤيا ورؤية، ويحمل أبعادًا أخرى في لحظات الصيرورة الأولى، ومن ثم إلى ممكنات تجريب في المراحل اللاحقة.
ولهذا فإن الشعر لن يكون في غافلة الزمن، كون المتغيّرات التي حصلت مع بداية الحاجة، لم تنهِ المخيلة، ولم تنهِ الحاجة التي باتت ماسّة أصلًا لمعاجلة التحشيد الهائل من المشاكل، ليكون العلاج بطريقة الشعر، وإن كان هذا القول لا ينطبق على الجميع، لكنه أيضا يكون مهمًا للجميع حين يذهب أو يستعين المرء بالشعر لإطلاق المكبوت من داخله أو الاستعانة به لتبيان المقارنة أو إعطاء الحكمة أو الدليل على توضيح ما يريد توضيحه، بمعنى أن الشعر ليس دخيلًا على النفس البشرية لأنه استلم القول شعرًا في البدء، لذا يمكن القول إن الكلمة الأولى كانت شعرًا، لهذا انتبه له العرب فصار ديوانهم.
ومن تلك الفاصلة الزمنية صار الشعر هو سيد المواقف، أو على الأقل هو المرجع في التوضيح والاستبيان، مثلما هو إظهار القدرة على الوعي والثقافة والاستنتاج، وهو ما يعني أن لا تراجع أصلا لمكانة الشعر أمام أيّ جنسٍ أدبي، مثلما لا يتراجع أي جنس أدبي أمام الشعر، فلكلّ من هذه الأجناس من يذهب باتجاه من يريد إنتاجه أو الاطلاع عليه كجزءٍ من الحاجة أو جزءٍ من المعرفة أو الموهبة او حتى استكناه الداخل الذي قد يجده البعض في نصّ مسرحي أو حتى مقالةٍ نثرية، بل إن الأمر لا يحتاج إلى تثبيت صحة المقولة في مكانة الشعر، فرؤيةٍ واحدةٍ إلى الصحف العالمية والعربية منها، نجد أنها تنشر بشكلٍ يومي نصًا شعريًا، بل أكثر من نصّ، وهو دليل على أن عدد منتجي الشعر أكثر من عدد منتجي الأجناس الأخرى وربما ستكون الكفّة للشعر أمام كل الأجناس، بغض النظر عن الجودة، كون الأمر نسبيا.
إن مقولة جابر عصفور كانت في مرحلةٍ أراد بها أن يستصرخ الشعر من داخل الأديب المنتج للنص، بعدما رأى أن مكانة الشعر تراجعت، ليس في الترتيب الأجناسي، بل عند الجمهور، أو تراجع أثر الشاعر لدى الجمهور أو السلطة السياسية الذي قمعت الشاعر والمثقف وجعلت الشعر يتراجع عمّا كان في الخمسينات والستينات وحتى السبعينات من القرن الماضي، وربما يكون الإعلام قد سلط الضوء على الأدباء الآخرين، ومنهم الروائيون، باعتبار أن الرواية هي مكان الفكر والخلق للحياة بطريقة مستقيمة لا تحتاج إلى التدوين الشعري الذي تحول من بناء القصيدة العمودية إلى التفعيلية والتحولات الدراماتيكية، ومن ثم إلى النثر والتحوّلات الجوهرية التي جعلت الكثير من القراء التقليديين مثلا لا يحبّذون هذا النوع من الشعر، كونهم يبحثون عن الموسيقى أكثر من بحثهم عن الخلق الشعري.
ومن هذا المنطلق يمكن القول إن الشعر مكانه العقل غير واسع الإنتاج، والسرد أو الرواية مكانها المخيلة التي تحتاج إلى عالمٍ واسعٍ وكبيرٍ، ولهذا نجد الشاعر يكتب قصيدته نهارًا ويقرأ الرواية مساء، لأنها أي عملية تلقّي الرواية تحتاج استرخاء، وعملية تلقّي الشعر تحتاج إلى تحفيز الخلايا لمتابعة الحيثيات التي تتوزّع داخل النص، الذي توزّع وتوسّع وتعدّد وتنوّع، وصارت قصيدة النثر ترتدي أثوابًا عديدةً لا تعترف بزي مدينةٍ أو بيئةٍ أو دولةٍ أو قارة، فهي ابنة العالم وليس مجتمعا محدّدا.
إن هذا الأمر قد لا يكون مرئيًا إعلاميا وهو الذي جعل الشعر وكأنه في تراجع، فضلًا عن سعي النقاد بشكلٍ لافت إلى مطاردة الرواية وتأليف كتبٍ نقديةٍ سواء تطبيقية أو تنظيرية، أو البحث عن مجترحٍ نقدي جديد يعتمد على الرواية، مما جعل الكثير من الشعراء يذهبون باتجاه الرواية لأنها تمنحهم شهرةً أكبر، وحضورًا نقديًا فضلًا عن المسابقات سواء منها العالمية أو العربية التي اختصت بالرواية، وجوائزها التي تغري اللسان والإنسان، إضافة إلى أن الرواية تحتاج إلى عملية هدوء واستكناه الواقع والغوص فيه وتخليق عوالم وشخصيات وأحداثًا وأزمانا مختلفة، وكذلك تحتاج إلى حضور الرأي سواء السياسي أو الأيديولوجي في مواجهة الواقع. ومطاردة السلطة للشاعر، وغيرها من الأسباب التي تحول دون استمرار الشاعر بالدخول إلى المنطقة المحرّمة سياسيًا أو حتى اجتماعيا، في حين أنّ لا حدود للرواية وخاصة في زمن ما بعد التغييرات التي شهدتها العالم العربي.
إن الشعر حاجةٌ إنسانية، ولهذا فهو لا يموت، ولم يكن متراجعًا أصلا لأن الماكنة الإعلامية والنقدية كانت باتجاه الرواية وهو الأمر الذي ينطبق على السينما، التي ربما نراها تراجعت في البلدان العربية إنتاجًا وقبولًا وإقبالًا وتقبّلًا على اعتبار قلّة الحضور إلى دور السينما، وبعض الحقيقة أن روّاد السينما تحوّلوا من الحضور إلى دور السينما الى المتابعة عبر وسائل الاتصال الحديثة.
الشعر لم يمت أو يتراجع، لكي تقول إنه عاد إلى مكانه، بل هو موجود أصلا وفق المؤشرات التي ذكرناها، فحتى الروائي يلجأ إلى الشعر أو الكتابة الشعرية في النص الروائي، كونه يدرك مفعول الكلمة الشعرية على إنتاجه ومتنه السردي، أكثر من مفعول الكلمة النثرية الطبيعية إن صح التعبير في إنتاج فاصلٍ حياتي من خلال الرواية.
إن العلاقة قائمة مهما تعدّدت الأجناس، خاصة بعد ظهور مصطلح تداخل الأجناس. فإذا ما أخذنا مقولة بول فاليري إن الشعر “لغة داخل لغة” فإن الأمر ينطبق أيضا على الأجناس الأخرى وقد وضحت في قول لي “رؤية تأملية من داخل الشعر، بنية الكتابة وخاصية التكوين” بما يفسر جملة فاليري من أن “التخليق الدلالي لكثافة هذه الجملة البسيطة التكوين العميقة المغزى تعطي مفهوما انزياحيًا خارجًا من اللغة الإشارية لتكون دالًا ودليلًا بين الصوت، قراءة المفردة، وبين الصورة المدونة، رسم المفردة، لأن الشعر عملية إعادة خلق الأشياء وتكوينها من جديد، على وفق نظرة عصرية لمفهومها الحديث”.
إن عودة الشعر إلى مكانته ليست القرائية أو الإنتاجية بل الإعلامية، كون الإعلام أو ما نقصده التسليط الإعلامي على مقالات الرواية ونشرها ومتابعتها والترويج لها يبدأ من الإعلام نفسه، والذي يبدأ من النقاد أنفسهم حين لا يتبنّون غير الكتابة عن الرواية كونها تتيح لهم الشهرة أكثر من كتابتهم عن الشعر، وإن المدارس النقدية الأوروبية التي يستعينون بها اعتمد على الرواية أكثر من الشعر، وإذا ما أقيمت مسابقات ضخمة خاصة بالشعر، سنرى أن الشعر متوهّج بطريقةٍ عجيبة، وأن عدد المتعاطين به إنتاجًا وتلقيًا أكثر من متعاطي الرواية أو الحقول الأخرى ومنتجيها.
إن المتابعة النقدية كفيلةٌ باكتشاف الأمر، خاصة وأن مكانة الشعر والشاعر هي مكانة ارتباطية مع المجتمع، فالشاعر صاحب صوت، على العكس من الروائي الذي يعد صاحب عزلة، وأن مكانه في الندوات أو من المنصات. في حين أن المهرجانات مثلا تستعين بالشاعر ولا تستعين بالروائي، إلا لربما ليكون ضيف شرف في الحضور، كون صوت الشاعر مؤثّر جدا في الوسط الاجتماعي في أزمان الأزمات أو المتغيرات التي تشهدها هذه البلاد أو تلك. فالشعر خبب في الصوت والرواية خبب في المخيلة. وقارئ السرد يقرأ وهو يتمدّد على الفراش، وقارئ الشعر يقرأ وهو مستفز لملاحقة المعنى. وهذا الأمر لا يعني الاستهانة بالرواية، فتلك موضوعةٌ أخرى، كون الرواية هي إمساك العالم كلّه من طرفيه، والشعر مطاردة العالم من داخله.. بمعنى إن كانت الرواية تمتلك المنصة الحالية فالشعر يمتلك الأصالة الأولى.
علي لفته سعيد
كاتب من العراق
—————————–
=============================




