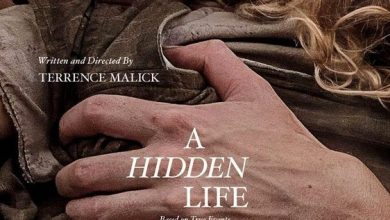فيلم عن الآباء والأبناء لطلال ديركي مشاهدة مباشرة و مقالات مختارة تناولت الفيلم

السينما سينما… وللخطابية منبرٌ خارج الـ”كادر”/ نديم جرجوره
يُثير البعض ضجّة حول غياب إدانة النظام الأسديّ، بسبب جرائمه، في الوثائقي الجديد لطلال ديركي، “عن الآباء والأبناء” (2017)، وفي غياب أية إشارة إلى “الثورة السورية”، في حوار مُصوّر معه لحساب الموقع الإلكتروني للصحيفة اليومية اللبنانية “النهار”. يُدخِل هذا البعض وثائقيٌ آخر بعنوان “لسّه عم تسجّل” (2018)، لسعيد البطل وغياث أيوب، ضمن خطاب جامد ومنغلق، يقول ضمنًا إنّ غياب الإدانة يعني أن العمل غير صالح أو غير سوي أو غير جدّي، أو أنه “مُتعالٍ على الثورة، وعلى صانعيها”.
الضجّة هذه ـ المُتمثِّلة بتعليقات “فيسبوكية” تأتي في لحظة الترشيح الرسمي لـ”عن الآباء والأبناء” لـ”أوسكار” أفضل فيلم وثائقي (2019) ـ تنزع عن الفيلمين، وعن المُخرجين الثلاثة، خياراتٍ، هي جزء من انفعالٍ شخصي وتأمّل ذاتيّ، ومن محاولة فنية ـ ثقافية لتوثيق لحظةٍ أو حالةٍ أو حكاية، وفقًا لأدوات التعبير السينمائيّ. المهاجمون يريدون أن تنسجم اشتغالات هؤلاء المخرجين، وغيرهم أيضًا، مع تصوّراتهم هم والتزاماتهم هم ومبادئهم هم، وإنْ يعترف بعضهم بـ”عجزٍ” ما لديه عن تحقيق أفلامٍ، يُفترض بها ـ عند إنجازها ـ أن تكون مُلكًا لتصوّراتهم والتزاماتهم ومبادئهم.
هذا يُذكّر بحدثٍ مماثل، تشهده بيروت مطلع عام 2001. فالعرض البيروتي (24 فبراير/ شباط 2001) لـ”الرجل ذو النعل الذهبي” (2000)، للسوري الراحل عمر أميرالاي (1941 ـ 2011)، يؤدّي إلى نقاشٍ صاخب، جزء منه ينعكس في مقولة لا علاقة لها بالسينما إطلاقًا، تُروّج حينها فتظهر كـ”إدانةٍ” لعمر أميرالاي لأنه غير مكترث بأهواء آخرين، وبأمزجتهم وانفعالاتهم ومواقفهم والتزاماتهم، كأن المطلوب منه أن يكون بوقًا لهم، فيُلغي نفسه وتأمّلاته ومشاعره وأمزجته ومواقفه وأسئلته وهواجسه، إرضاءً لهم. وهذا على نقيض معنيين بأهمية الفعل السينمائي الوثائقي في الفيلم، وإلى صدق مخرجه، في ارتباكاته وأسئلته ومحاولاته، الثقافية والأخلاقية والإنسانية، الهادفة إلى مقاربة شخصية عامة كالرئيس السابق لمجلس الوزراء اللبناني، الراحل رفيق الحريري (1944 ـ 2005)، بما تحمله الشخصية من ثقل وتأثير وحضور، لبنانيًا وعربيًا ودوليًا. هؤلاء المعنيون يختزلون الضجّة المثارة حينها بتلك المقولة، من دون تبنّيها طبعًا، لاهتمامهم بالسينمائيّ الوثائقيّ في الفيلم، وفي اشتغالات أميرالاي، وفي السينما: “جماعة رفيق الحريري يريدون فيلمًا لهم، لم يعثروا عليه في “الرجل ذو النعل الذهبي” فنبذوه وهاجموا مخرجه؛ وأعداء رفيق الحريري يظنّون أن عمر أميرالاي، من موقعه اليساري المتمرّد، “يجب” عليه أن يصنع فيلمًا يُعبّر عن موقف هجوميّ متوتّر وغاضب ضد الحريري وما يُمثّل، وربما حاقد عليه وعلى ما يُمثّل أيضًا”.
لن تكون المقولة عابرة. فهي واقعية جدًا وحقيقية جدًا، وتبدو أنها اليوم أقوى مما هي عليه سابقًا. مضمونها يعكس رغبة كثيرين في أن يفرضوا على السينمائيّ ما يعمل السينمائيّ على الخروج منه أصلاً، ويطلب من السينمائيّ ما يجتهد السينمائيّ للحؤول دون الوقوع في أفخاخه. والذين يهاجمون عمر أميرالاي من الطرفين يستعيدون، بوعي أو بلا وعي، مفهومًا يبدو أنه لن يتبدّد بسهولة: “خدم السلطان”. اليوم، ينكشف واقع أن السلطان لن يكون حاكمًا فقط، ففي الجانب النقيض والمُقاوِم ـ المُعارِض له سلاطين أبشع وأعنف وأحقد.
مقولة تكشف أنّ الطرفين “مُذنبان” بحقّ السينما أولاً وأساسًا، وبحقّ السينمائيّ أيضًا. هذا يحصل اليوم، عبر كلامٍ يُهين، ضمنًا، السينمائيّ وحريّته في اختيار مواضيعه وأشكال التعبير السينمائي عنها؛ ويرفض نقاشًا يُفترض به أن يتناول آليات العمل والأسئلة المطروحة وكيفية المعالجة، وألاّ تكون له أدنى علاقة بما “يريد” السينمائيّ قوله أو البوح به أو نقله أو كشفه أو تعريته أو طرحه السينمائي على النقاش. هذا غير محصور بـ”الرجل ذو النعل الذهبي”، ولا بـ”عن الآباء والأبناء” و”لسّه عم تسجل” فقط، فهو منسحبٌ على أفلام كثيرة، بعضها متوغّل في أحوالٍ وحالات وأناس وتفكير، إنْ تنبثق من سورية في ظلّ الحرب الأسديّة عليها وعلى مواطنيها، وفي ظلّ الهجوم الأصوليّ على الثورة السورية بحجّة مواجهته النظام الأسديّ أيضًا؛ أو تعكس وقائع وتفاصيل مرتبطة ببلدان وشعوب ومجتمعات وحكايات وأفكار وتأمّلات أخرى.
المقولة تلك صائبةٌ، لأنها الأقدر على كشف تحجّر يُصيب كثيرين، وإنْ يكن هؤلاء الكثيرون معارضون للنظام الأسديّ ومناوئون له ومحاربون لبطشه؛ ولأنها الأصدق في التعبير عن انغلاقٍ وقمع يتمتّع بهما مدّعو مقاومةٍ لنظام أسديّ قاتل، يتحوّلون سريعًا إلى شبيهٍ به عندما يفرضون على الآخرين ما يتوجّب على هؤلاء الآخرين فعله والتفكير به. هؤلاء يريدون تسخير كلّ شيء لخططهم ومصالحهم وادّعاءاتهم، ويتغاضون عن الجوهر: السينما لن تكون درسًا في التاريخ ولا بوقًا للترويج ولا أداة للقمع والتزوير، بل مرآة واقع. وللسينمائيّ حرية مُطلقة في الاختيار والمعالجة، وللآخرين حقّ في النقاش السوي والهادئ.
لسه عم تسجل
يقول كوانتن تارانتينو ـ أحد أكثر السينمائيين إثارة لجدل حاد حول العنف السينمائي وتأثيراته الاجتماعية، و”المتّهم” (!) بـ”مسؤوليته” (!) عن أعمال عنفية وإجرامية مُنفّذة بـ”تأثير” (!) من أفلامه ـ إنّه غير مسؤول “عمّا يفعله الناس بعد مشاهدتهم أفلامي”، مضيفًا أن “المسؤولية الوحيدة التي أتحمّلها تكمن في صنعي شخصيات حقيقية إلى أبعد حدّ ممكن”. هذا في الروائي المُتخيّل، المُستَنِد إلى حقائق الاجتماع والنفس البشرية (فردًا وجماعة) والاقتصاد والسياسة والثقافة والتربية والسلوك؛ فكيف إنْ يذهب سينمائيٌ وثائقيٌ إلى شخصيات حقيقية أصلاً، فيُقابلها ويحاورها ويُصوّر يومياتها كي يكشف ثقافتها التربوية والمسلكية، من دون إدانة أو أحكام مسبقة أو لاحقة؟ هل عليه أن “يؤبلس” شخصية يختارها، وإن يكن على نقيض تام مع أفكارها والتزاماتها ومفاهيمها، كي ترضى عنه جماهير المعارضة ـ المقاومة، ومثقفوها وإعلاميوها؟ أم أن عليه أن يوثّق حقائق ووقائع، وإنْ يتلاعب سينمائيًا، فجمالية الوثائقي السينمائي (بل جمالية السينما برمّتها) كامنةٌ، في جزءٍ منها، في التلاعب السينمائيّ الذي لن يكون مغايرًا لحقائق ووقائع، وإلاّ فتكون السينما مجرد “بروباغاندا” وترويج يبرع بهما نظام كالنظام الأسديّ وحلفائه تحديدًا، فإذا بمعارضين ومناوئين له يتفوّقون عليه بفرضهم على الآخرين ما يجب على الآخرين فعله والتفكير به؟ أيتحمّل طلال ديركي وغياث أيوب وسعيد البطل (وغيرهم أيضًا) “مسؤولية” ما، غير تلك المعنيّة بالنتاج السينمائي الذي يصنعون، وبكيفية صُنعه، وإنْ يحمل الصنيع ما لن يُوافق عليه الجميع، فموافقة الجميع ورضاهم امتدادٌ لمفاهيم البطش والأحادية والديكتاتورية والأنظمة الشمولية؟ هل يُطلب منهم “إشارة جدّية لإجرام النظام السوري” أو “ذكر كلمة ثورة”، كي يحصلوا على “شرعية” ما من أطراف ما، ربما تحتاج هي (الأطراف) أصلاً إلى شرعية وجود أو موقف؟
أما التأثّر بشخصية مختارة في فيلم وثائقيّ تحديدًا، أو عدم التأثّر بها، فهي من “أعمال” المُشاهِد، الذي وحده يتحمّل مسؤولية كيفية مُشاهدته، وكيفية التأثر بما يُشاهده.
وإذْ يبتعد السينمائيون عن مُباشرةٍ في القول السينمائي، أو عن خطابية ممجوجة فيه، أو عن رفع شعارات مستهلكة وبائدة، كأن يقولوا “دائمًا” و”أبدًا” إنّ بشار الأسد مجرم وقاتل، وهو هكذا فعلاً؛ أو كأن يقولوا “دائمًا” و”أبدًا” إنّ الأصولية الدينية والجهاد المتزمّت يتوجّب محاربتهما والتصدّي لهما بشتى الوسائل، وهذا صحيح للغاية؛ فهذا (الابتعاد) شرط سينمائيّ كي يكتمل الفعل الإبداعي بأمثل صورة له وأجملها. والابتعاد لن يُلغي موقفًا لمخرج ربما يُعبّر عن إدانته مجرمًا يفتك ببلد وشعب وتاريخ وثقافة وحضارة خارج السينما أو معها، لكن بموارية واحتيال وتحرّر مطلق من كلّ خطابية جوفاء ومُباشَرة باهتة؛ وله من الأصولية والجهاد موقف ما أيضًا. فالمخرج يرى الفيلم سينمائيًا أولاً وقبل أي شيء، ويرى أن جماليات الفيلم تنكشف إنْ يبتعد الفيلم عن المباشرة والخطابية هاتين، وعن الإدانة الواضحة أيضًا.
المطالبون بإدخال الإدانة في أفلام، هي سينمائية بامتياز، يُسقِطُون السينمائيّ عن الأفلام، معتبرينها مجرّد “أشرطة دعائية ترويجية” لأفكار يلتزمونها ويفشلون، في الوقت نفسه، في إنجاز أشرطة دعائية تروّج لتلك الأفكار، فيطالبون الآخرين بما يعجزون عن فعله. المطالبون أنفسهم يظنّون أن “إعلان إدانة” هو الركيزة الأساسية لأي فعل إبداعي، وهو المدخل للاعتراف بشرعية المقاومة والمناهضة والتمرّد على القاتل، التي يُمكن لأي كان الحصول عليها شرط إدخال إدانة النظام الأسديّ والفصائل الجهادية المتزمّتة والمتشدّدة في أي عمل سينمائي أو ثقافي، كيفما كان.
لديّ قناعةٌ مفادها أن لا طلال ديركي ولا غياث أيوب ولا سعيد البطل، ولا أحد إطلاقًا، محتاجٌ إلى أن يُبرّر أو يوضّح، فأفلامهم تقول، ومن لن يفهم ما تقوله أفلامهم أو تعبّر عنه أو تبوح به، فهو المذنب بحقّ السينما وصانعيها، وربما بحقّ نفسه أيضًا. هذا كلّه لن يعني أبدًا تحييد كلّ صنيع سينمائي (وغيره) عن القراءة النقدية، التي يُفترض بها أن تنبثق من الفعل السينمائي بحدّ ذاته.
أما جوقة المهاجمين “الفيسبوكيين” وأشباههم، في حالات سينمائية وغير سينمائية في الوقت نفسه، فيليق بهم قولٌ للإيطالي الراحل أمبرتو إيكو (1932 ـ 2016)، صائبٌ وحقيقيّ وعميق: “وسائل التواصل الاجتماعي تتيح غزوًا للبلهاء”، مضيفًا أنها “تمنح حقّ القول لجحافل من البلهاء الذين، قبل وسائل التواصل الاجتماعي، غير مُتحدّثين إلاّ في حانة، بعد احتسائهم كأسًا من النبيذ، ولا يُسبّبون أي ضرر على الجماعة، التي تُسكتهم فورًا، بينما اليوم لهم حقّ التعبير نفسه الذي لحامل جائزة نوبل أيضًا”.
رمان
فيلم “عن الآباء والأبناء”: طلال ديركي يُهمّش المتن/ عبد الرحمن حلاق
كتب عساف العساف على صفحته ما يلي: “في فيلم (عن الآباء والأبناء) ترد لقطة تكاد تكون غير ملحوظة لسرعتها لأبي أسامة، الشخصية المحورية في الفيلم، وهو ينشد أناشيد جهادية وفي لحظة كأنه نسي نفسه فيها يغني جملة من أغنية سعدون جابر المدهشة:
البارحة صوتك اسمعا يعتّب من بعيد..
أين المتن وأين الهامش هنا؟ أغاني الجهاد، أم أغنية البارحة؟”.
إن الصراع بين المتن والهامش يشبه إلى حد ما الصراع بين المُعلن والمسكوت عنه. ففي لعبة المواقف الإيديولوجية والمواقف السياسية عموماً يتراجع المتن ليتصدر الهامش المشهد ويتراجع المسكوت عنه لصالح المعلن. والمعلن في الفيلم أن رجلاً جهادياً له من الأبناء ثمانية يربيهم لهدف وحيد فقط وهو متابعة الجهاد إلى أن تتمكن دولة الخلافة الإسلامية من بسط سيطرتها على بلاد الشام وتنتصر في المعركة التي بشّر فيها الدين قبل 1400 سنة من الآن. يدربهم على الذبح، يدربهم على الجهاد، يبعدهم عن المدرسة، يزج بهم في المعهد الشرعي، يحلل ويحرم، يبدي رأيه في السياسة، كان معتقلاً وأفرج عنه النظام. أما المسكوت عنه فكل ما عدا ذلك، فلقد أضحى هذا الرجل هو المتن في مقاطعة إدلب، وكل ما عدا ذلك مجرد هامش. وفي مقابلته التلفزيونية يعلن طلال ديركي أن “القاعدة” في إدلب تعيش عصرها الذهبي، ومن خلال هذا العصر وعبر مساحة المحافظة الشاسعة اختار المخرج أن يكون فيلمه في قرية صغير من قرى ريف معرة النعمان (خان السبل) ليجعل من الهامش متناً معلناً يسهل من خلاله طي صفحة المسكوت عنه.
في مضمون الفيلم
يتناول الفيلم أسرة واحدة لأب سلفي خبير ألغام وصانع متفجرات، ويكشف عن سطحية تفكيره وسذاجة آرائه اليقينية بقيام دولة الخلافة، يُخرج أبناءه من المدرسة، ويرسل كبيرهم إلى المعهد الشرعي ليستكمل إعداده الذهني شرعياً وإعداده الجسدي ليصبح مقاتلاً في دروب الموت. لم تخرج الكاميرا خارج حدود شخصيات الأسرة ولم تلتقط أي كادر خارج هذه الأسرة باستثناء لقطة واحدة يقوم بها الأبناء بشتم وضرب طالبات المدرسة بالحجارة، ليبرز موقف “جبهة النصرة” من التعليم عموماً ومن تعليم الإناث خصوصاً. وفي لقطة ثانية نرى أفراد “النصرة” وهم يجمعون أسرى من جيش بشار يخطب فيهم أحد الشرعيين موجهاً كلامه لأهالي الأسرى
(السنّة) الذين يرسلون أبناءهم للموت. فيما عدا ذلك يحاول المخرج أن يقنع المتلقي بأن العنف الإرهابي ينتقل بالوراثة بين الآباء والأبناء، ويقوم الآباء بدور المحفز والدافع الأهم لاستمرار هذه الدورة العنفية. وإذا كان المتلقي السوري على دراية بكل هذه التفاصيل وأكثر من ذلك على دراية تامة بالدور المشبوه لهذه الفصائل الإسلامية فهو يعيشها بشكل يومي وقد خرجت المظاهرات المنددة بهذا الفصيل وبغيره في معظم مناطق سيطرة هذه الفصائل بدءاً بالغوطة وليس انتهاء بالمعرة التي يحتضن ريفها وقائع هذا الفيلم، فلمن يتوجه الفيلم بخطابه؟ هل يريد إقناع المشاهد الغربي بأن “مقاطعة إدلب” كلها إرهابيون وبالتالي لا ضير في تدميرها كما حصل في الموصل والرقة؟ خاصة وأن المخرج يعيش في ألمانيا ويعرف تماماً قوة تأثير الميديا بالغرب وتشكيل رؤيتهم عن ثورتنا من خلال ما يُعرض عليهم.
لقد تعمّد المخرج تجاهل الكثير من الحقائق بحجة أن الفيلم تربوي مع أن الفيلم وثائقي وحصل على جائزته الغربية ضمن هذا التصنيف. ولأنه وثائقي فلنا أن نطالب الفيلم بتقصي الحقائق التي أجبرت بعض المقاتلين على الانخراط مع “النصرة”، ونطالب الفيلم بتقصي الحقائق التي جعلت بعض الناس في الشمال السوري يؤيدون “النصرة” في بداية انطلاقتها، ولأنه وثائقي فلنا أن نطالب الفيلم بتسليط الكاميرا على المسبب الأول لكل هذا العنف والإرهاب، لا ضير مطلقاً في ذكر إرهاب الفصائل الإسلامية لكن غض النظر عن إرهاب بشار المولّد لكل هذا العنف والإرهاب هو موقف محدد مسبقاً ويثير تساؤلات كثيرة. ولأن الفيلم وثائقي فلنا أن نطالبه بعرض الصورة كاملة دونما انتقاص، فأبناء محافظة إدلب ليسوا ملائكة لكنهم أيضاً ليسوا إرهابيين أصحاب تفكير ساذج.
من أهم هذه الحقائق التي قفز عليها وتجاهلها: إفراج المالكي عن سجناء “داعش” في سجن أبو غريب وإرسالهم إلى سورية. وإفراج الأسد عن سجناء “القاعدة” في سجونه ليشكلوا مجموعة فصائل جهادية مسلحة. كذلك التدمير الممنهج لفصائل الجيش الحر من قبل “جبهة النصرة” و”داعش”. وأيضاً خنق أي حالة وطنية مدنية وعدم السماح لها بالنمو. وربط الجميع بالداعم غير السوري. وربط المواطن السوري في المناطق المحررة بالسلة الغذائية وعدم دعم أي مشروع من مشاريع التنمية المستدامة من قبل المنظمات الإغاثية. فإذا أضفنا لكل ذلك التجاهل التام لمدنية الحراك ووطنيته وتجاهل كل صرخات الاحتجاج التي أطلقها السوريون في وجه قنوات الإعلام العربية والغربية التي لم تر على الأرض السورية غير “جبهة النصرة” و”داعش”، فإننا نخرج بنتيجة أن هذه الحقائق تفسر الواقع المعاش بدقة وبالتالي تتطلب مخرجاً يتمتع ليس فقط بمعرفة وافرة ثقافياً وتقنياً بل وأيضاً بموقف مبدئي ثابت تجاه الحق والعدل.
في ظل هذه الحقائق على المخرج أن يتوقع المآلات التي سيفرزها هكذا واقع، والتي قد تبدأ باضطرار الإنسان البسيط إلى التوجه لرواتب “جبهة النصرة” التي تعيله وتعيل أسرته ولن تنتهي عند تفكك البنية المجتمعية وتفشي الفقر والجهل والجريمة المنفلتة، والطائفية، والتعصب.
بعد إيديولوجي وموقف غير أخلاقي
لا شك في أن غياب تلك الحقائق عن وعي المبدع يشكل علامة استفهام كبيرة وكبيرة جداً. وكذلك يشكل تجاهل تلك الحقائق من قبل أي مبدع إشارة واضحة إلى بعد إيديولوجي أو إلى موقف غير أخلاقي مطلقاً. والقول بأن تلك الحقائق غير موجودة إلا في أذهان من يعتقد بنظرية المؤامرة هو مؤامرة بحد ذاته. وإلا ماذا نسمي هذا التواطؤ العالمي أمام كل تلك الجرائم التي ارتكبت خلال ثمانية أعوام وما تزال مستمرة؟
لقد غيّب طلال ديركي تلك الحقائق متعمداً فهو مخرج أكاديمي محترف خرّيج «معهد ستافراكوس العالي لفنون السينما والتلفزيون» 2003 في أثينا، حقق المرتبة الأولى على دفعته، وهو أوّل أجنبي يحقق ذلك منذ تأسيس المعهد قبل نحو نصف قرن. ونال فيلمه “عن الآباء والأبناء” جائزة لجنة التحكيم الكبرى لأفضل وثائقي أجنبي في “مهرجان صندانس السينمائي” 2018.
في أحد تصريحاته اللاحقة عن الفيلم أعلن المخرج أن فيلمه تربوي غير سياسي، يرصد توارث مفاهيم العنف في المجتمع وانتقال هذه المفاهيم من الآباء إلى الأبناء، ليبرر صمته وعدم ذكره لكلمة ثورة، ويبرر عدم ذكره لجرائم النظام، مع أنه اختار بيئة مكانية في الشمال
السوري مستبدلاً تسمية “محافظة إدلب” بتسمية اختارها السلفيون “مقاطعة إدلب”. وإذا أردنا تحليل العنوان فقط نجد أنه جاء بصيغة الجمع مضافاً إليها “أل العهدية” لتشمل كل الآباء وكل الأبناء في هذه المقاطعة، فهو لم يقصد أباً واحداً أو آباء محددين وإنما الكل بإطلاق وهذا أول تعميم ظالم يقع فيه صانع الفيلم، ولا نستطيع القول إنه غير مقصود لأننا بذلك نحط من قيمة المخرج ثقافياً وفكرياً، فهو على درجة من الوعي والمعرفة تمكنه من فهم الانزياحات الدلالية للعنوان. وهو على درجة من المتابعة تمكنه من تذكر الصورة الشهيرة لأبناء سراقب والتي كتبوا فيها لافتات تجمع كل المذاهب والطوائف والإثنيات السورية في لوحة واحدة (أنا سنّي – أنا علوي – أنا كردي – أنا مسيحي… إلخ).
في محافظة إدلب اليوم ما يقرب من ستة ملايين سوري بين نازح أو مهجر أو مقيم يعيشون واقعاً مأساوياً جديراً بالبحث والدراسة بطريقة علمية للوصول إلى نتائج من شأنها أن تساعد هؤلاء الناس للخروج من هذا الواقع، أما أن نسلط الضوء على شخص واحد وننمذجه ونجعله صورة عامة (لمقاطعة) فهذا لا يستقيم ضمن أي منظور أخلاقي بغض النظر عن فكر ويقينيات هذا الشخص. فلماذا تعمد صانع الفيلم تجاهل كل هذه الحقائق إن لم يكن يضمر موقفاً يعرف تماماً أنه بعيد عن الموضوعية؟ في نهاية المطاف يشكل أي عمل فني موقفاً ولا يمكن لهذا الفيلم ضمن خطه الدرامي هذا إلا أن يتماهى بشكل واضح مع موقف الغرب المتواطئ مع بشار مؤسس العنف والإرهاب في سورية الحديثة، وبالتالي لا يمكن لهذا الفيلم ضمن هذا الطرح إلا أن يخدم وجهة نظر الطاغية المستبد ويقدم له كل الدعم والمساندة في حربه المزعومة ضد الإرهاب. إنه يقدم محافظة إدلب إلى الغرب بالصورة التي يريدها الغرب وليس بصورتها الحقيقية، كما ظهرت في لافتات كفرنبل أو حيطان سراقب، إنه يريد أن يظهر الوجه الجهادي لأبي أسامة (الهامش) دون أن يفسر لنا الوجه السابق (المتن) لأبي أسامة الذي يغني لسعدون جابر.
همسة أخيرة: من حقك يا طلال أن تصنع مجدك الشخصي، لكن ليس على حساب أبناء وطنك.
اضفة ثالثة
السوريون ومتلازمة المحتال المعكوسة/ رشا عمران
على مدى ثمان وأربعين دقيقة، يقدم المخرج السوري الراحل، عمر أميرلاي، شهادات ومقابلات مع تلاميذ في المدارس ومسؤولين حكوميين ومدرّسين، يردّدون في شهاداتهم وحواراتهم شعاراتٍ حزبيةً وهتافاتٍ تمجّد الرئيس حافظ الأسد، ويتحدّثون عن الإنجازات الكبيرة للسيد الرئيس وللبعث، في الوقت الذي تعرض فيه كاميرا المخرج الدمار والتهميش الذي تعاني منه قرية الماشي، وهي إحدى القرى التابعة لمحافظة الرّقة السورية، والتي لم تكن سوى نموذج عن طوفان الدمار النفسي والاقتصادي والاجتماعي الذي أغرق به نظام الأسد المجتمع السوري عموما.
بالتأكيد، حينما استخدم عمر أميرلاي كاميرته لتوثيق شهادات وآراء من حضروا في فيلمه الذي منع من العرض في سورية زمنا طويلا، مثل معظم أفلامه، لم يخبر شخصيات الفيلم أنه سوف يصوّر فيلما ضد النظام السوري، ومن البديهي أنه لم يطلب منهم قول ما قالوا له، إذا كان خطابهم هو خطاب غالبية السوريين العلني في ذلك الوقت، ترك أميرلاي لشخصياته أن تقول ما اعتادت قوله وترداده، من دون تدخلٍ مباشر منه. والمؤكد أنه، في مونتاج الفيلم، اختار من الكلام الذي تسجل من المشاهد التي تم أخذها ما يتناسب مع ما يريده من فيلمه، مع رؤيته الفنية والثقافية والسياسية، حتما لم يكن حياديا في أثناء المونتاج، مثلما لم يكن حياديا تجاه الشخصيات التي اختارها. هل يمكن القول إن عمر أميرلاي تحايل على الشخصيات التي اختارها لتتحدّث في فيلمه؟ هل خدعها حينما جعلها في الفيلم نماذج عن الانهيار المجتمعي السوري؟ هل كانت تلك الشخصيات التي تحدثت أمام كاميرا مخرج معارض كما لو أنها تتحدّث أمام شاشة التلفزيون الرسمي تدرك أصلا أن من يصوّرها ويستنطقها هو مخرج معارض للنظام الذي تمجّده في حديثها؟
ما الذي كان سيحدث لو أن أميرلاي أخبر الناس في قرية الماشي أنه يصور فيلما ضد النظام، وضد الخطاب الذي يصحون وينامون عليه، وضد كل الخوف الذي تأصل في اللاوعي الفردي والجمعي لديهم، هل كان أحدٌ منهم سوف يقبل أن يشارك في التصوير أو أن يتحدّث كلمة واحدة؟ هذا إذا لم يتبرّع أحد ما، ويخبر الأجهزة الأمنية، وقتها، بما يحدث، ويبلغ عن أميرلاي وفريقه، بوصفهم أعداء للوطن ومتآمرين وعملاء للصهيونية، وهي أقل التهم التي كانت تطلق على كل من يعارض نظام الأسد. لم يتطرّق أميرلاي في فيلمه إلى العوامل الاجتماعية التي نشأت فيها شخصياته، حتى تحولوا إلى ببغاوات تردّد الكلام ذاته، قدّمهم كما هم، تاركا للمشاهد أن يحلل ما يرى.
ما الذي فعله طلال ديركي، المخرج السوري الشاب، في فيلمه “عن الآباء والأبناء” الذي استطاع الوصول إلى ترشيحات الأوسكار، بعد سلسلة طويلة من الجوائز الدولية، أكثر مما فعله عمر أميرلاي في أفلامه كلها، أو أكثر مما يفعله عادة مخرجو السينما الوثائقية في أفلامهم؟ وضع طلال ديركي فكرة واحدة لفيلمه، واشتغل وصور على أساسها، في ظل حربٍ قاهرة، وفي ظل سيطرة تنظيماتٍ جهاديةٍ على منطقة الشمال السوري التي صوّر بها الفيلم، من الطبيعي أن يلجأ إلى المواربة والتحايل، كي يتمكّن من التصوير، من الطبيعي أن يشتغل في المونتاج على ما يريده من فيلمه، من الطبيعي أن لا يركز على تفاصيل أخرى، قد تكون أكثر أهميةً من فكرة الفيلم نفسه، لكنه فيلمه وفكرته، مثلما كانت فكرة أميرلاي وفيلمه، وأنا هنا لا أعقد مقارنات بينه وبين أميرلاي، ولا أضعهما في ميزان التفضيل أو المساواة الفنية، ليس هذا من اختصاصي، أنا أبيّن الجوانب التي جعلت بعض السوريين يهاجمون طلال ديركي، وينعتونه بأسوأ النعوت والأوصاف، بينما يمجّدون آخرين فعلوا الشيء ذاته.
يخيّل إلي أحياناً أننا، نحن السوريين، مصابون بما تسمّى متلازمة المحتال (imposter) ولكنها معكوسة، أي هي ضد الآخرين لا ضد أنفسنا، ولمن لا يعرف هذه المتلازمة فهي “عقبة تؤثر على أشخاص عديدين ناجحين ومبدعين، ما يجعلهم يشكون في قدراتهم الخاصة، ويمتنعون عن الاستمتاع بالنجاح الذي يحظون به”. ليست الاتهامات التي تعرّض لها طلال ديركي، ومنها العمالة للنظام، وعدم الخروج من أقلويته (الكردية)، والتسلق على مآسي بيئات الثورة، واستغلال الثورة للظهور والبروزة، وما إلى ذلك من تهم عجيبة، سوى واحدة من الحالات التي تتكرّر مع السوريين لدى أي نجاح أو ظهور لسوري معاصر، يبدو أن القرب حجاب فعلا، يحجب الإيجابيات والسلبيات معا!
العربي الجديد
عن الآباء والأبناء والحكايات العاقة/ أحمد أبازيد
يجمع كتاب سيرة جوزيف ستالين على عشقه للسينما، اتباعاً لمقولة لينين أن السينما هي أهم الفنون بالنسبة للحزب، إضافة إلى رغبات الديكتاتور وهواياته الخاصة، وفي كل ليلة كان يجمع ستالين رفاق الحزب في قاعة مخصصة للسينما في الكرملين ليسأل وزير السينما في عهده: ماذا سيعرض لنا الرفيق بولشاكوف اليوم؟
لم يقتصر اهتمام ستالين السينمائي على الأفلام السوفيتية ولكنه أحب الأفلام الأجنبية أيضاً، فبعد انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية، كان أحد الغنائم التي فرح بها ستالين هي خزينة أفلام ألمانية وغربية، ولا شك أن الحبّ هنا لم يكن فنياً خالصاً، فالزعيم الذي أصبح أيقونة الحكم الأحادي في العصر الحديث، كان يدرك أن السينما هي الوسيلة الأنجع لتشكيل خيال الجماهير وخلق صورة الاتحاد السوفييتي أمام سكانه وأمام الأجانب، وتبرير إجراءاته ومذابحه الضخمة، ولذلك كان يتدخل في دعم الأفلام أو منعها أو حتى تعديلها، إن وجد أنها تقدم تلميحات مغايرة عن الصورة المثالية للمواطنين والحياة وطبيعة الصراع في ظل حكم الحزب.
توارثت السلطات حب السينما أو الحرب معها، لأن حرب الصورة والرواية لم تنفصل عن حروب القوة والسلاح.
إذن، نتساءل على طريقة ستالين: ماذا يعرض لنا الرفيق ديركي عن سوريا في فيلم الآباء والأبناء؟
الفيلم الذي استغرق 330 يوماً للتصوير على مدى عامين ونصف العام وخلال ست زيارات إلى سوريا، حسب كلام المخرج، تم عن طريق خداع أحد الأشخاص القريبين من جبهة النصرة بأن المخرج مناصر للجهاديين ويريد تصوير فيلم عنهم، فأقام في بيت الرجل ومع عائلته وأطفاله، لتكون العلاقة بين الأب وأبنائه محور الفيلم.
الفلم حسب كلام المخرج، تم عن طريق خداع أحد الأشخاص القريبين من جبهة النصرة بأن المخرج مناصر للجهاديين ويريد تصوير فيلم عنهم، فأقام في بيت الرجل ومع عائلته وأطفاله
الشخصية الرئيسة في الفيلم هو حسين حبوش، المكنّى “بأبي أسامة”، وقد تناقلت صفحات نشطاء من المنطقة خبر مقتله أثناء محاولة تفكيك عبوة قبل أشهر، أبو أسامة يعيش في خان السبل في ريف إدلب، لديه 12 ولداً، سمى ابنه “أسامة” على اسم زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، وابنه “أيمن” على اسم أيمن الظواهري، مختص بالتفخيخ والألغام، هو ليس شخصية جهادية بالمعنى الاحترافي للكلمة، وليس أميراً أو قيادياً في جبهة النصرة، هذا إن كان منظماً فيها بالأساس، وهو أقرب للبساطة وتكرار أدبيات دينية شعبية عن ملاحم يوم القيامة، وإلى مناصرة الظاهرة الجهادية في وجه التدخل الغربي والطموح للخلافة الإسلامية.
يتتبع الفيلم العلاقة بين أسامة وأيمن ووالدهما، الذي يصاب ويتم بتر ساقه، ليعوض عن عجزه عن الجهاد بإرسال أبنائه للتدريب في معسكرات جبهة النصرة، وبينما يتم قبول أسامة المتفوق في المعسكر فإن أيمن يُرفض ويكمل دراسته.
وفي النهاية يغادر طلال ديركي سوريا بعدما تشوهت ولم تعد الوطن الذي يعرفه بسبب السلفية الجهادية.
لماذا هذه الضجة حول الفيلم إذن وهو يعرض واقع حياة عائلة جهادية موجودة فعلاً؟
الضجة في الحقيقة تدور حول سؤال الواقع في الفيلم، أو ما هي سوريا التي يقدمها فيلم طلال ديركي؟
سوريا كما تظهر في فيلم طلال ديركي هي أرض للجهاديين المتطرفين من جبهة النصرة وفي مقابلهم نظام الأسد وحليفه الروسي الذي يحاربهم من بعيد.
يقول طلال ديريكي في بداية الفيلم إنه قد توجه لتصوير الفيلم إلى “أرض الرجال التواقين إلى الحرب”، موضحاً أنها “مقاطعة إدلب الواقعة تحت سيطرة تنظيم القاعدة، جبهة النصرة”، إنها ليست أرض المتظاهرين التواقين إلى الحرية، وليست أرض الشعب الذي وقعت ضده الحرب ليحصل هذا الدمار، ليس هناك سوى جبهة النصرة ورجال مبادرين بسبب شغفهم الذاتي نحو الحرب.
في تلك الفترة من عامي 2014-2015 كانت جبهة النصرة قوة ثانوية في إدلب، ولم تكن تتحكم بمنطقة إدلب كما هو الواقع اليوم في 2019م، وفي تلك الفترة بالذات بدأت جبهة النصرة معاركها ضد فصائل الجيش السوري الحر في الشمال السوري، بدءاً من هجومها على “جبهة ثوار سوريا” (ما بين أيلول إلى كانون الأول 2014)، ثم هجومها على حركة حزم (ما بين تشرين الثاني 2014 إلى آذار 2015) والتي يصدف أن بلدة خان السبل كانت أحد مراكزها الرئيسية وأكبر مستودعات السلاح التي استولت عليها جبهة النصرة من الجيش الحر.
الصراع بين الثورة والجهاديين، أو بين المجتمع المدني والجهاديين، تم تغييبه رغم أنه جرى من قبل الأشخاص أنفسهم وفي المكان والزمان نفسه الذي تم تصوير الفيلم فيه، أمام إبراز كلام “أبو أسامة” عن الحروب مع أمريكا وأوروبا والروم والمعارضة التي في تركيا، ليأتي هذا التغييب في تأكيد تصوير أن الثورة والشمال السوري هو فقط جبهة النصرة وحواضن متطرفة تريد الهجوم على الغرب ويقف في وجهها روسيا والنظام.
القوة العسكرية الوحيدة التي تظهر من مناطق سيطرة الثوار في الشمال السوري هي جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة (يتم ذكر وجود أحرار الشام عرضاً)، والقصف الوحيد الذي يتم عرضه في الفيلم هو قصف استهدف الغرفة السرية لخبير الألغام الجهادي، رغم وقوع عدة مجازر في بلدة خان السبل خلال الفترة نفسها.
والظهور الوحيد لنظام الأسد في الفيلم هو عبر أسرى خائفين يتم سوقهم بين الجهاديين ذوي اللحى المخيفة، تقترب الكاميرا من وجه أحدهم المرتجف بينما يبكي، الشاب المتطوع في قوات الدفاع الوطني –الميليشيا الرديفة لنظام الأسد- هو الشخصية الوحيدة في الفيلم التي يمكن أن يتعاطف معها المشاهد العادي.
حتى الطفل الأكبر أسامة، الذي كان يمكن أن تتعاطف معه، يخبرنا المخرج في النهاية أن براءته وابتسامته انتهت وأصبحت من الماضي.
المجتمع السوري الذي يظهر في الفيلم هي عوائل الجهاديين وحدهم، ولا تظهر أي امرأة فيما عدا صوت بكاء زوجة أبي أسامة حين تُبتر قدمه، ثم في حديثه مع أصدقائه عن الزواج من أربعة نساء معاً، والجغرافيا نفسها تصبح موحشة وجافة بينما المناطق الخضراء تظهر غالباً مع الاقتراب من خطوط القتال مع النظام، مدرسة الأطفال تظهر في مشهدين سريعين في أحدهما نرى المدرّس وهو يضرب الأطفال.
المجتمع السوري في المناطق الحاضنة للثورة كما يرسم صورته طلال ديركي هو بيئة كاملة من العنف والتطرف المستدام والذي يتم صنعه وتوريثه محلياً وذاتياً فقط.
عائلة أبي أسامة هنا هي صورة المجتمع وليست قصة فردية، فنحن لا نرى سواها في الفيلم، والفيلم نفسه اعتمد عليها في البداية والنهاية في استنتاجات عن طبيعة الصراع وعن تشوه البلاد وتوريث العنف للمستقبل.
لا يقدم الفيلم –أي فيلم بالعموم- صورةً عن الواقع كما هو، وإنما عن الواقع كما يريده المخرج، وكما يظهره وينتقي أو يحذف منه حسب الرسالة التي يريد إيصالها، ورسم هذه الصورة بإتقان لإيصال رسالة متماسكة هو غاية أي عمل فني.
لذلك فالتساؤل عن رسالة الفيلم والصورة التي يقدمها عن الثورة والمجتمع السوري وأي سردية يخدم؟، هو تساؤل مشروع وبديهي جداُ، لأن أي عمل فني هو كيان قائم بذاته ويقدم خطابه الخاص، ونقد هذا الخطاب ليس من باب الدخول في النوايا ولا المحاكمات الشخصية، ما الذي يعنيه نقد أي عمل فني إذن ؟
والاعتراض على نقد السردية التي يروج لها الفيلم بأنه ليس تحقيقاً استقصائياً، هو تضليل آخر واستمرار لعقلية التعالي واحتقار المجتمع وتشويهه واستباحته التي أسّس عليها المخرج فيلمه، وكأن نظام الأسد هو تفصيل صغير وثانوي في الصورة من الممكن التغاضي عنه، وكأنه مجتمع من الجهاديين المتطرفين فقط بطبيعته، وهو السبب في دمار سوريا وتشويهها لوحده، ولذلك فهو مجتمع مستباح وبلا حقوق، سواء بخداع آبائه أو تلقين أطفاله، وليس من حقه حتى نقد التهم والسرديات التي تخدم شيطنته واستباحته.
موجة لوم المجتمع بديلاً عن لوم السلطة، قد عادت للرواج في بعض أوساط السوريين والمعارضين أيضاً، لتبرئة الذات وإحالة أسباب الهزيمة إليه: إما بسبب تدينه أو ريفيته أو كونه حاضنة للتطرف، كما ذكرت شخصيات محسوبة على المعارضة -وليس النظام- عن الغوطة أو المنطقة الشرقية أو إدلب اليوم، وهذا عدا عن أنه يقدم صورة كاذبة ومناقضة للواقع عن المجتمع، فهو تنظير مجاني يتم تقديمه لعقيدة الإبادة والتجانس الأسدية التي يتم تطبيقها بصواريخ السكود والسلاح الكيماوي.
تم إنتاج الفيلم ليقدم صورة معدة سلفاً، توافق خيالات اليمين الغربي الصاعد عن الشرق الغارق بالعنف والتطرف والمخاطر والشهوات المخبأة، مكان متخيل وغامض لا يشبه المدن التي نعرفها ولا يسكنه مجتمع وليس فيه اختلافات، يتطابق فيه الأهالي مع التنظيمات المتشددة وتتطابق المعارضة مع التطرف والمقاومة مع الإرهاب، صورة ذهنية نمطية تم حشد هذه الصور والانتقاءات لأجل إثباتها في الحاضر وتأكيد استمراريتها في المستقبل.
من أبسط حقوق السوريين بعد حروب الإفناء وحرب الرواية التي تتم اليوم لطمس تاريخهم القريب وحقوقهم البعيدة، أن يطالبوا صناع السينما السوريين المحسوبين على الثورة والذين عُرفوا وصعدوا إلى المهرجانات العالمية بسببها، ألا يقدموا سينما تطابق بروباغندا الديكتاتور وتمتعه في المساء.
تلفزيون سوريا
“عن الآباء والأبناء” لطلال ديركي: كابوس جديد/ راشد عيسى
عالَم يفاخر بأن أطفاله الذكور قد بدأوا ينهرون فتيات صغيرات لم يتجاوزن الثالثة من العُمر
“في صغري، علّمني أبي أن أكتب كوابيسي كي لا تعود إليّ مجدداً”. إعلان بصوت المخرج السوري طلال ديركي، في بداية فيلمه “عن الآباء والأبناء” (2017)، يفسّر ويصف أي نوع كابوسيّ سيكون فيلمه الجديد.
ديركي، وهو صاحب فيلم “العودة إلى حمص” (2013)، الوثائقي الذي يَعرض لشطر من حياة نجم كرة القدم السوري عبدالباسط الساروت في ظل الثورة السورية، يقول في مقابلة إنه عاش الكابوس الأول هناك، في ريف حمص الشرقي، أثناء مرافقته للساروت، حينما وجد نفسه أمام أحزمة ناسفة وأعلام سُود وأناس كانوا يطالبون للتوّ بالحرية فأصبحوا ينادون بالخلافة وحكم الشريعة. لكن وجود أطفال بين الجهاديين كان هو بالذات ما دفعه تالياً للبحث في “جذور العنف”، و”كيف تصبح ما أنت عليه اليوم”، ولذلك اختار لفيلمه ثيمة الآباء والأبناء، والعلاقة بين الأجيال.
هكذا اختار ديركي أن يخوض هذه التجربة الوثائقية الخطرة مع مصوّره قطحان حسون، حين ذهب إلى تلك البقعة الخاضعة لحكم “النصرة” في مدينة إدلب شمال سوريا، مموّهاً نفسه بهيئة مصوّر محب للجهاديين، ليعيش تفاصيل العلاقة بين جهاديين وأبنائهم، وأي مصير سيؤول إليه الجميع.
مشهد الفيلم الافتتاحي سيكون نقطة انطلاق بصرية ملائمة للفيلم، حيث تقوم الكاميرا، وبإيقاع بطيء، بتصوير لعبة كرة قدم للأطفال في ساحة ترابية في البلدة. فمن جهة هو إيحاء ببداية اللعبة، الفيلم، كتابة الكابوس باعتبارها نوعاً من اللعب لتبديد الكوابيس. ومن جهة ثانية، هو إشارة إلى عالم الأطفال البريء، كما هو في كل مكان، وكيف سيتغير المشهد تماماً ويختفي بعد قليل، لصالح تحوّل هؤلاء إلى مصائر وألعاب خطرة أخرى. لكن، مع دوران الكاميرا وابتعادها عن كرة الأطفال واتساع اللقطة لتأخذ محيط الملعب الشاسع كلّه، سيظهر أيضاً كم أن هؤلاء متروكون لمصائرهم، في قلب ذلك الفراغ الرهيب. وهنا، لن يتردد المخرج/الراوي في تقريع نفسه: “هربتُ كغيري إلى شمال الأرض، وبينما بدأنا ببناء وطن جديد في المنفى، كانت السلفية الجهادية تعيش عصرها الذهبي خلفنا، حصدتْ خلف الجميع”.
يعثر المخرج على أبطال فيلمه في عائلة أحد مقاتلي “جبهة النصرة”. معتقل سابق لدى النظام (تحديداً في سجن صيدنايا كما سيقول لي المخرج لاحقاً في دردشة حول الفيلم)، وقد أطلق على أطفاله أسماءهم تيمناً بقادة جهاديي تنظيم “القاعدة” و”طالبان”، أسامة وأيمن وخطاب ومحمد عمر.. وعبر هذه الشخصية، وعلاقته بأطفاله وأسرته سيبني فيلم “عن الآباء والأبناء” حكايته.
طرق وعرة
“سيمضي الجميع إلى الحرب، لكني سأختار البقاء مع أسامة وأيمن شاهداً على تركة الحرب الثقيلة”، يقول المخرج، من دون أن يمنعه ذلك من الخروج أحياناً لتصوير عمل الأب، في مهنته الخطرة: نزع الألغام.
ملاحقة الكاميرا لشخصية الأب ضرورية لرؤية الأثر الذي سنلاحظه على الفور في شخصيات الأطفال. ترصد الكاميرا أبو أسامة (وهذا هو اسم الأب) سواء في بيته، بين أطفاله، أو منكباً فوق الصخور والأشواك لنزع لغم. سيظهر حنوناً مداعباً لأطفاله، متألماً بشدة بعد بتر ساقه إثر انفجار لغم (بتر الساق سيكون أمراً محزناً من دون شك، لكن لن يخطر في بال صنّاع الفيلم أن يحظوا بمثل هذه الهدية -بالمعنى السينمائي البحث- والتي ستضفي مسحة مأساوية على شخصية البطل/الأب). لكن شيئاً لن يتمكن من التأثير في صلابة الشخصية الرئيسية ونهائيةِ معتقداتها. قد يصلح المشهد من قلب المتراس، دليلاً لشخصيته: يصوب بندقيته من فتحة المتراس بين أكياس الرمل، متحدثاً في الوقت ذاته إلى المخرج بجانبه وكيف أنه اشتمّ رائحة ابنه أسامة من بعد حين كانت سيارة السجن تنقله من سجن إلى آخر، لكن أبو أسامة لن يتردد، حتى قبل أن يكمل هذه العبارة، في أن يطلق النار على عابر على دراجة نارية شاهدَه عبر عدسة البندقية القناصة، وسيرى كيف سقط العابر عن دراجته بفعل الرصاصة. لن يفكر أبداً في أن احتمال أن يكون الآخر أباً.
أما اتجاه أولاده وكيف يفكر بهم، فإن مشهداً آخر سيختصر تلك العلاقة. إذ يقول الأب، فيما ينحر أضحية: “سبحان الله، لو أن سيدنا ابراهيم لم يفْدِ ابنه بكبش لكان على كل منا أن يذبح أحد أولاده”. إن تقديم الولد كقربان أمر مسلّم به، وعلى ما يبدو في الفيلم فإن كان الأب قد أُعفي من “نحر” ابنه بالفعل، فهو لن يتردد في “نحره” بطريقة أخرى، حين يقدمه لقمة سائغة للحرب وهو لما يكمل سنواته العشر.
عالم الأب والكبار محْكَمٌ في عقائده، وإلى جانب ذلك هو عالم أحمق، ومتهور. الفيلم يقدم هذا العالم عبر مشاهد وصور وحكايات. سنرى فيه الحق بقطع الرؤوس (نسمع صوت أحدهم يأمر عبر اللاسلكي ببدء قطع الرؤوس)، استسهال تعدد الزوجات، كثرة الأولاد، إقصاء المرأة كلياً من المشهد، صوتاً وصورة، بل والتفاخر بأن الأطفال الذكور قد بدأوا منذ الآن نهْر الصغيرات، حتى من لم يتجاوز منهم سنّ الثلاث سنوات، وإصدار الأوامر إليهن بارتداء الحجاب، إرسال الأطفال إلى الحرب، التهور في تفكيك الألغام ومحاولة استخراج المواد المتفجرة من قلبها بأدوات حادة بمشاركة الأطفال… كل ذلك كان له صداه عند الأولاد.
بعد ذلك سيأتي عالم الأطفال مشابهاً إلى حد بعيد. فهؤلاء، لعبتهم المفضلة العنف والقتل والحرب. عندما يلقون القبض على عصفور، سيأمرهم الأب بقتله لأن هذا أفضل له من العذاب، كما يقول. سيتلهّون بصناعة قنبلة، يتقاذفونها بأرجلهم. يتعاركون. يرمون بنات المدرسة بالحجارة والشتائم البذيئة. وكذلك الحافلات العابرة. وشيئاً فشيئاً، سيدخلون في حياة الجِد، تعلّم الوضوء والصلاة حسب الأصول، التدرب على السلاح، ثم الذهاب إلى أرض المعركة في سن مبكرة. هنا سينفصل الشقيقان أسامة وأيمن. الأول سيجسد حلم الأب، سيثبت مقدرة أفضل من شقيقه الصغير الذي سنراه لاحقاً على مقاعد الدراسة، مع أطفال آخرين ونَحار إن كان علينا أن نرى فيهم أملاً ما، أم حيوات مهددة بطرق وعرة ومصائر مماثلة. مشهد وداع وعناق محزن بين الطفلين، أحدهما يودع الآخر ذاهباً إلى الحرب، مشهد استثنائي لن ترى له مثيلاً.
في المَشاهد الأخيرة سنرى سيارات تحمل أطفالاً ببدلات عسكرية مموهة، ملثمين بالقبعات السود، وبوجوه عابسة.. ذاهبين باتجاه الصعب، كما يبشرهم قادتهم. في الطرق، دخان كثيف أسود، وحرائق. هنا سيعود صوت الراوي/المخرج ليتحدث عن شخصيتيْ الطفلين الشقيقين: أسامة الذي اقتيد إلى طرقات الموت، وأيمن الذي صار فتى يافعاً يتابع دراسته ويعتني بإخوته الصغار.
الطقس في لقطة الختام موحل، بارد، وماطر، والرؤية مشوشة. ديركي يحث الخطى كمن يتعجّل الهروب من الكابوس. هو على الطريق، فيما صوته يروي: “وأنا بدوري أقلب صفحة قديمة، وأنهي هذا الكابوس. أعود إلى بيتي وأسرتي في برلين، مع ذاكرة عن وطن تغيّرت معالمه بطريقة مرعبة، وطن لا يشبه مطلقاً ذاك الذي أعرفه”.
طرق مشوشة ومصائر غامضة. لكن الفيلم شديد الوضوح في ما يرمي إليه. ليست السياسة مقصده، إنه يتحدث عن البشر، الأطفال خصوصاً، وما حلّ بهم. وأي مستقبل يتهدد ذلك المكان، الكابوس.
المدن
(عن الآباء والأبناء) الطفولة المنذورة للموت/ علاء رشيدي
العبارة الافتتاحية التي تقال على لسان السارد وصانع الفيلم، وهو المخرج طلال ديركي، هي: (في صغري، علمني أبي أن أكتب كوابيسي كي لا تعود مجددًا)، هي إشارة من صانع الفيلم إلى أن التيمة التي يعالجها، حساسة، مؤلمة، وهي باعثة على القلق، وبما أن كوابيس (موضوعة الفيلم) ليست ذاتية بقدر ما هي ظاهرة اجتماعية؛ فإن نيّة المخرج تظهر من اللحظات الأولى: التطرق إلى موضوعة ما (ظاهرة تهم المجتمع والتجربة الاجتماعية السورية بأكملها).
فيلموغرافي المخرج ديركي، يظهر وكأنه يشرع في تحقيق سلسلة سينمائية عن التجربة الاجتماعية والسياسية التي يعيشها المجتمع السوري، منذ سنوات. في فيلم (بطل البحار، 2010) يتناول هجرة الأكراد غير الشرعية إلى أوروبا، قبل عالم 2011. وفي فيلم (العودة إلى حمص، 2013) يرصد شخصية الثائر، من خلال لاعب كرة القدم ومغني التظاهرات عبد الباسط الساروت، إذًا هي تجربة الثورة. وفي فيلم (قصيدة إلى ليسبوس، 2016) يتناول موضوعة اللجوء وتجربة الهجرة إلى أوروبا. وفي (عن الآباء والأبناء، 2018) نكون أمام موضوعات مثل: الأبوة، البنوة، الطفولة، والعنف في الثقافة.
كما أن المونولوج الافتتاحي للسارد في الفيلم، يشي بالموضوعة التي يعالجها، كذلك المشهد الافتتاحي الذي يركز عليه الناقد راشد عيسى في مقاله عن الفيلم، فيكتب: “مشهد الفيلم الافتتاحي سيكون نقطة انطلاق بصرية ملائمة للفيلم، حيث تقوم الكاميرا، عبر إيقاع بطيء، بتصوير لعبة كرة قدم للأطفال في ساحة ترابية في البلدة. فمن جهة هو إيحاء ببداية اللعبة، الفيلم. لكن، مع دوران الكاميرا وابتعادها من كرة الأطفال واتساع اللقطة لتأخذ محيط الملعب الشاسع كلّه، سيظهر أيضًا كم أن هؤلاء متروكون لمصايرهم، في قلب ذلك الفراغ الرهيب”.
الفيلم تسجيلي، تفتح الكاميرا في محافظة إدلب السورية، حيث نتابع الحياة اليومية لأبٍ هو (أبو أسامة) وأبنائه الذكور الثمانية. بالتعرف إلى أسماءهم، ندرك أنهم أطفال منذورون لمصير مأسوي، المصاير التي آلت إليها الشخصيات التي استلهم منها والدُهم أسماءهم: محمد عطا، أيمن الظواهري، وأسامة بن لادن. الأب معجب بهذه الشخصيات، وهو يتمنى لأبنائه مصيرًا مماثلًا لهم. أبو أسامة هو نازع ألغام ملتزم بالعمل مع (جبهة النصرة)، مبينًا بين الحين والآخر، التزامه بتعاليم الفكر الجهادي، وكذلك هي رؤيته السياسية التي يكررها أمام الكاميرا بوضوح.
إذًا، هي سلطة التربية الأبوية الذكورية، تأثير أيديولوجيا الأب على تنشئة الأطفال، هي ما سنتابعه عبر أحداث الفيلم وتفاصيله. واحدة من الثيمات الرئيسية، هي كيف يحقق الأب رؤيته المفروضة على أبنائه ومصيرهم.
تأثير الأبوة:
عبر أحداث الفيلم، نتعرف إلى حكاية الأب (أبو أسامة) المقاتل، نازع الألغام وخبير المتفجرات، بينما ترصد الكاميرا، من دون أحكام، تفاصيل العلاقة بينه وبين أبنائه: تصور تلك العلاقة العاطفية بين الأب وأبنائه، اللعب بينهم، القبلات ولقطات أخرى تصورهم في أحضان والدهم، وحين تكتسب العلاقة بينهم تلك الإنسانية التي تربط أي علاقة أبوّة وبنوّة؛ يبدأ الفيلم بالتركيز على الثقافة التي يبثها الأب لأبنائه، والتي تساهم في بناء مصيرهم المستقبلي.
يأخذ أبو أسامة أبناءه إلى المشارف المطلة من إدلب على منطقة معرة النعمان، حيث حدثت معركة بين الجهاديين والجيش النظامي، ويروي أبو أسامة لأبنائه تفاصيلها، عن البطولات التي قدمها المقاتلون، وعن الشهداء حسب تعبيره. هكذا يثبت الفيلم، عبر الروي، أن رغبة القتال والانتقام تنتقل من جيل إلى آخر، كما أنه يصبح لكل جيل منظوره الخاص لمن هم أبطال، ولمن هم معتدون في المجتمع الواحد.
ليست أيديولوجيا الأب التربوية مجرد أفكار سلمية، بل هي أيديولوجيا تحض على الهجوم والقتل. في مشهد يصور من قلب المتراس، وبينما هو يصوب بندقيته من بين أكياس الرمل، يتحدث أبو أسامة للمخرج – الكاميرا عن حكاية اعتقاله، عن تجربة السجن، وعن لحظة استرجاعه لرائحة ابنه أسامة، حين خرج من السجن مجددًا إلى عائلته، بينما يروي أبو أسامة هذه الحكاية العاطفية، يطلق النار من بندقيته على راكب دراجة نارية يمر بالمنطقة التي يشرف أبو أسامة على حراستها، هذه الازدواجية بين الشعور بالعاطفة، وبين ممارسة العنف هي الموضوعة الأدق التي يحاول الفيلم أن يرصدها، خلال مئة دقيقة.
تعتبر فرقة زقاق المسرحية في عرضها “راسين بالإيد” أن رؤية الأطفال لطقس الذبيحة الحيوانية، أضاحي العيد، نوع من انتشار العنف في الثقافة العامة. وهكذا، يحرص فيلم (الآباء والأبناء) على تسجيل مشهد مماثل، يتم أمام أعين المتلقي على الشاشة؛ حيث تذبح عنزة كضحية، تنحر فيسيل دمها على الأرض بحضور الآباء والأبناء. وهنا يقول الأب: “سبحان الله، لو أن سيدنا إبراهيم لم يفْدِ ابنه بكبش، لكان على كل منا أن يذبح أحد أولاده”، عبارة توضح تغريب علاقة الأب عن أبنائه، ليصبحوا منذورين للدين، ولمنظمة قتالية تقاتل باسم الدين، مثل (جبهة النصرة)، باختصار: إنهم منذورون للموت. هذا الفكر أراد الفيلم أن يظهره في مقابل العلاقة العاطفية بين الأب وأبنائه.
دور البنوة:
الثقافة المحيطة، وضعف الخيارات والاحتمالات المعرفية، تجعل الأبناء أمام خيار وحيد، هو محاولة تحقيق صور المجد والبطولة التي يراها الأب في أبنائه، تصبح خيارات الأبناء هي تحقيق الصورة المثلى التي يتخيلها الآباء عنهم، إنه حلقة حتمية في حال ضعف التنمية، وقلة المنابع الثقافية التي تغذي المنطقة، وبالتالي فقدان الطفولة أي خيارات معرفية أخرى، سوى تلك التي يقدمها الآباء.
للحديث عن الطفولة في الفيلم، نبدأ بوصف عالم الكبار –البالغين– الآباء، المحيط بهؤلاء الأطفال، في مقاله بعنوان كابوس جديد، يصنف الناقد راشد عيسى عالم الكبار في الفيلم، فيكتب: “عالم الأب والكبار محْكَمٌ في عقائده. الفيلم يقدم هذا العالم عبر مشاهد وصور وحكايات. سنرى فيه الحق بقطع الرؤوس (نسمع صوت أحدهم يأمر عبر اللاسلكي ببدء قطع الرؤوس)، استسهال تعدد الزوجات، كثرة الأولاد، إقصاء المرأة كليًا من المشهد، صوتًا وصورة، والتفاخر بأن الأطفال الذكور قد بدؤوا منذ الآن نهْر الصغيرات، حتى من لم يتجاوز منهم سنّ ثلاث سنوات، وإصدار الأوامر إليهن بارتداء الحجاب، إرسال الأطفال إلى الحرب، التهور في تفكيك الألغام ومحاولة استخراج المواد المتفجرة بمشاركة الأطفال”، بهذه العبارات يختصر الناقد العديد من مشاهد الفيلم التي ستحاول رسم معالم عالم البالغين وثقافتهم.
أما في وصفه لعوالم الطفولة في الفيلم، فيكتب: “بعد ذلك، سيأتي عالم الأطفال مشابهًا إلى حد بعيد. فهؤلاء، لعبتهم المفضلة العنف والقتل والحرب. عندما يلقون القبض على عصفور، سيأمرهم الأب بقتله، لأن هذا أفضل له من العذاب، كما يقول. سيتلهّون بصناعة قنبلة، يتقاذفونها بأرجلهم. يتعاركون. يرمون بنات المدرسة بالحجارة والشتائم البذيئة. وكذلك الحافلات العابرة. وشيئًا فشيئًا، سيدخلون في حياة الجِد، تعلّم الوضوء والصلاة حسب الأصول، التدرب على السلاح، ثم الذهاب إلى أرض المعركة في سن مبكرة”.
إنه تأثير الفكر الجهادي – العنفي على الأطفال، وهو واحد من الدوافع الأساسية التي دفعت المخرج إلى تحقيق هذا الفيلم. يروي صوت السارد في الفيلم: “هربتُ كغيري إلى شمال الأرض، وبينما بدأنا ببناء وطن جديد في المنفى، كانت السلفية الجهادية تعيش عصرها الذهبي خلفنا، حصدتْ خلف الجميع”.
هكذا يصير الفيلم أشبه بالدراسة السيوسيولوجية عن العنف في الثقافة. يتحدث أبو أسامة للكاميرا عن اعتقاده الراسخ بقدوم معركة (أرماجدون) المعركة التي تبشر بها الثقافة الدينية، وهي المعركة الأخيرة بين الديانات. الحرب جزء من نبوءة الدين عن العالم. في كتابه (العنف والمقدس) يدرس الفيلسوف الفرنسي رينيه جيرار جذور العلاقة بين الديني والعنفي، ويجد بينهما تفاعلًا مستمرًا وترابطًا عضويًا، عبر التاريخ.
وثائقي “عن الآباء والأبناء”.. أربعة تقسيم عشرة يساوي خمسة/ عبد الله القصير
قبل النوم بقليل يطرح الطفل “أسامة” (12) عامًا على شقيقيه السؤال التالي: أربع تفاحات، تقسيم عشرة، شو بيساوي؟ فيجيب الأخ الأول: خمسة. ثم ينقل أسامة السؤال لأخيه الثاني: وأنت؟ فيقول الأخير: خمسة. هنا يشرد أسامة للحظات ويقول لهما بلهجة مترددة: صح.
ورد هذا المشهد الذي سأعود إليه لاحقًا ضمن سياقه الدلالي في الفيلم الوثائقي السوري المرشح لجائزة الأوسكار “عن الآباء والأبناء”، وفيه يخوض المخرج طلال ديركي مغامرة خطيرة تقوده إلى معايشة عائلة سورية في ريف محافظة إدلب، وعلى فترات متقطعة وطويلة نسبيًا. تلك العائلة المؤلفة من الأب وهو مقاتل وخبير ألغام في تنظيم جبهة النصرة، وأطفاله الثمانية الذين حمل معظمهم أسماء قيادات تنظيم القاعدة: أسامة (ابن لادن)، أيمن (الظواهري)، محمد عمر (الملا عمر)… إلخ.
إن الكتابة الفعلية لفيلم وثائقي من هذا النوع – كما أعتقد- تبدأ بعد الاكتفاء أو الانتهاء من التصوير، وبالتحديد في مرحلة المونتاج. وغالبًا ما يضع المخرج تحت مبضع التحرير لقطاتٍ يبلغ مجموعُها الزمني مئات الساعاتِ المصوّرة. وعلى الرغم من أن مشروع الفيلم يقوم عادة على فكرة محددة وخطة عمل، وسيناريو تصوّري مسبق، فإنه يبقى محكومًا بمجريات التصوير التي قد توصله أحيانًا إلى منعطفات غير محسوبة وغير مخطط لها سابقًا. لذلك فإن الطرح البصري لمشهد أو لقطة ما، يعادل جملة سردية في نص مكتوب أو فكرة عُبِّرَ عنها بمجموعة من الجمل المكتوبة. ومع أن شخصيات الفيلم الوثائقي لا تكون عادة مقيدة بحوار، كما هو الحال في السينما الروائية التي تعتمد على ممثلين يحفظون أدوارهم ويتحكم المخرج بحركاتهم إلى حد كبير، فإنه يمكننا – تجاوزًا- أن نحيل مسؤولية ما تقوله شخصيات الفيلم الوثائقي إلى المخرج كما لو كان هو كاتب حواراتها ومهندس أفكارها، وذلك بناءً على سلطته المطلقة في إدراج أو استبعاد هذه اللقطة أو تلك من حساباته النهائية والشكل النهائي للفيلم، وللأمانة هي إحالة من الصعب اعتمادها كقاعدة.
من هنا يمكن الحديث عن الكثير من الدلالات التي ساقها طلال ديركي سينمائيًا من خلال تلك الثنائية: الآباء والأبناء. الآباء الذين ظهروا في الفيلم كبارًا لم يكبروا بعد، كبارًا على قدر كبير من السذاجة الواضحة، يحللون واقع سياسات القوى الإقليمية والعالمية العظمى بكل حماقة، وبعبارات معلّبة وجاهزة. يصنفون ويفرزون المعارضة السورية والمعارضين، يتغزلون بقادة تنظيم القاعدة في أفغانستان بطريقة شِعرية رومانسية، وهنا يسرد أبو أسامة إجابة استخدمها ذات مرة عندما كان معتقلًا في سجون نظام الأسد: الحب الذي في داخلي لهذه الشخصيات (القاعدة، طالبان.. الخ)، لو يُلقى به على كوكب الأرض، لأطلقوا عليه اسم “كوكب الحب”.
أعتقد أن المخرج نجح في إحراج كل من يشاهد الفيلم من خلال جمعه للمتناقضات بحِرفية عالية، وبشكل لا يصدق أحيانًا، فكيف للمتلقي أن يستوعب حديثًا عن كوكب الحب وتنظيم القاعدة معًا؟ كيف له أن ينصت لعاطفة أب يتذكر رائحة ابنه التي باغتته عن بُعد أثناء اعتقاله في سيارة لأجهزة النظام الأسدي، فيقطع حديثه ويطلق النار على جندي ويوقعه جريحًا أو قتيلًا ربما؟ كيف لجهادي سلفي أن يتكئ ويدندن أغنية لسعدون الجابر؟
قد يتساءل المرء مستغربًا: أيّ النقيضين متأصّل أكثر في شخصية ذلك الأب السوري وما يمثله من شريحة الآن؟ أهو ذلك الإنسان البسيط، الطيب، ذو العاطفة الأبوية الفياضة؟ أم أنه المقاتل الجهادي الذي لا يرحم أسيرًا أو معتقلًا عنده؟ هل هو المسلم التقليدي الذي يلتقط منه ابنه الصغير شتائم تطال الذات الإلهية؟ أم المتشدد السلفي الذي ساهم في محو كل آثار الصوفية من المنطقة؟ وبات يتحدث مع رفاقه عن زواج بالجملة من الأخوات المؤمنات بنفس الطريقة التي يتحدث بها مربو الحمام “الحميماتية” عن طيورهم؟
هؤلاء الآباء يلقنون أطفالهم الصغار معادلات حياتية خاطئة تشبه العملية الرياضية البسيطة التي وردت على لسان الطفل أسامة، أربعة تقسيم عشرة يساوي خمسة، مع فارق مهم أنها ذات أثر مدمّر عليهم وعلى غيرهم، ولربما يحقّ لأبسط مُشاهِد لهذا الفيلم أن يخشى ليس على مصير جيل أسامة وأقرانه من الأطفال فقط، بل على مصير عدة أجيال تليه. الأمر الذي يقدم الفيلم على أنه محاولة لدقّ ناقوس الخطر ليس في سوريا وحسب، بل في الشرق الأوسط كله، وربما في العالم بأسره.
في مشهد آخر، يملأ الأب بركة ماء صغيرة لأبنائه الصغار لكي يسبحوا فيها. تبدو المياه التي أُفرغَتْ من أحد الصهاريج في قمة ثورانها، وكأنها أمواج متلاطمة على أحد الشواطئ. وبذات الطريقة يلقي الأطفال بأنفسهم في البركة الجهادية الضحلة الموجودة في رأس والدهم، بنفس الحماس، ونفس الشغف ونفس البراءة. وبكل بساطة ينقل لك المخرج إحساس الأطفال وكأنهم يسبحون في بحر واسع، لكنها في الحقيقة ليست سوى بركة صغيرة ذات أبعاد محدودة، وإمكانيات بائسة غير مبشرة على الإطلاق، البركة الجهادية التي أثبتت أنها لا تستطيع أن تقدم للعالم إلا العنف.
وهو ما بدا واضحًا في: لقطة لمعلم المدرسة يضرب الطلاب في الباحة بحزام بنطاله. لقطة لقتال عنيف بين الأطفال. لقطة للصبية وهم يعنفون الفتيات الصغار ويرمونهم بالحجارة. لقطة للأب وهو يعاقب أطفاله ويضربهم بقوة، ولقطة أخرى له وهو يعلمهم استخدام السلاح. وهو ما يؤدي في النهاية إلى انضواء الصغار في معسكرات للتدريب على القتال، ليتحولوا بين ليلة وضحاها إلى أشخاص مدرَبين على استخدام الأسلحة الخفيفة، ومعتادين على تلقي الرصاص الحيّ على بعد سنتميترات قليلة من رؤوسهم وبين أرجلهم أثناء التدريب. ولم يكن ينقص كل هذا العجز الفكري والعاطفي والأخلاقي والديني إلا عجز جسدي تَمثّلَ بقطع قدم أبي أسامة بعد أن داس على أحد الألغام.
يَدخُل أطفال طلال ديركي إلى قلب دبابة مدمّرة وصدئة وكأنها قبرهم المحتوم، ثم يُخرجهم منها وكأنها الرحم الجديد الذي سيخرجون منه إلى العالم، ثم يلقي في حضن العالم فيلمه مثل كرة من النار، ومع ذلك فهو لم يغلق كل نوافذ الأمل، فعمد على إظهار شيء من التباين بين مساري الشقيقين الطفلين، في مشهد لأيمن وهو ينجح في حل عملية حسابية بسيطة في صفه، لكن يبقى جلّ خشيته أن يكون الحلّ المنشود غير متاح إلا على طريقة أسامة نفسه، عندما تورط وأطلق على شقيقه أيمن لغزًا أو “فزورة” تنتهي عادة بسؤال: ما هي؟ أو ما هو هذا الشيء؟ وقد بدت معقدة جدًا بالنسبة لشقيقه فيجيبه: لا أعرف! فيشرد أسامة ثانية ويقول: وأنا نسيت الحل.
الترا صوت
عن آباء طلال ديركي وأبنائه/ تهامة الجندي
قرأتُ الكثير من الآراء المتضاربة حول فيلم طلال ديركي “عن الآباء والأبناء” لاسيما بعد ترشيحه لجائزة الأوسكار، وحين شاهدته شعرت باستياء كبير، ليس فقط لاختلافي معه في المقولة التي قدمها، إنما لإحساسي بالخديعة كمتلقٍ من حقه أن يحصل على صورة صادقة في فيلم وثائقي، فمنذ البداية اعترف المخرج أنه ضلل مضيفيه، ودخل المكان الذي سيلتقطه بعدسته متنكرًا بهوية المصوّر الموالي للفكر الجهادي والمعجب بالنصرة، خشية من البطش الذي يمكن أن يطاله لو كشف حقيقته، وعلى الفور قفزت إلى ذهني صورة ماري كولفين التي دفعت حياتها ثمنًا لقول الحقيقة في حمص.
اختار المخرج منطقة صحراوية في الشمال السوري، تبدو نائية عن ساحة الصراع، والتقط بعدسته يوميات أسرة بسيطة، تنتمي إلى الوسط الشعبي، معيلها أبو أسامة، معتقل سابق، وأب لثمانية أطفال، يعمل على تفكيك الألغام التي زرعتها قوات النظام السوري قبل أن تُجبر على مغادرة المنطقة. صوّر مشاهد الفيلم بعين سياحية معادية، الأكل باليدين، القنص، الأسرى، ذبح الشاة، وانفجار لغم برب الأسرة أدى إلى بتر بساقه، وصولًا إلى تدريب الصبية على حمل السلاح.
حاور طلال أبا أسامة وعدداً من أولاده وضيوفه بنفس استعلائي ممزوج بالاشمئزاز، وورطهم بأحاديث مفككة، كانت قمتها التقاط تصريح الضيف المرتبك عن الخنزير الأميركي، وتأكيداته أن النصرة وحدها هي من تقاتل نظام الأسد، فيما يغفو ائتلاف قوى الثورة في الفنادق، وتنشغل معارضة الخارج باستجداء المال والمعونات. نقل عدسته من شخص إلى آخر، من دون أن يخبر المشاهد ما هي صلة هؤلاء بالنصرة، أو يسأل نفسه إن كان أولئك البسطاء الذين ضللهم يقولون الحقيقة؟ أم يجاملونه حسنًا للضيافة، أم أنهم مثله يظهرون الولاء خشية من البطش.
قدم مقولة تحريفية خطيرة، أن ما يحدث في سورية منذ سنوات هو حرب بين نظام الأسد والنصرة، وختم الفيلم بصوته من وراء الكادر يقول، إنه يغادر هذا الكابوس إلى حضن أسرته في ألمانيا، ولم يكترث أو يبدي مجرد تعاطف لحال أولئك المدنيين الذين تركهم خلفه في الشمال السوري، محاصرين ومهددين بكل أشكال العنف والكوابيس.
تجاهل طلال تمامًا واقع الثورة السورية والحراك السلمي، تجاهل نحو ربع مليون من المعتقلين في سجون النظام السوري لانتمائهم أو لمجرد تعاطفهم مع الثورة، هل لا يزال زكي كورديللو وخليل معتوق وعلي الشهابي ورانيا العباسي قيد الاعتقال لأنهم من النصرة؟ هل قُتل بطل فيلمه “عائد إلى حمص” أسامة الحبالي بالتعذيب، ومعه الآلاف ممن وردت أسماؤهم في قوائم الموت لأنهم من النصرة؟ هل كانت صور الجثث المشوهة التي هربها قيصر من أقبية الزنازين صور لجماعة النصرة؟ هل اختنق السوريون بالسارين والكلور، وقُتلوا بالذخيرة الحية، وتهدمت بيوتهم، وتشردوا بالملايين لأنهم مع النصرة أو منها؟
هؤلاء هم الثورة السورية التي لم يلحظها طلال للأسف الشديد، الثورة التي قدمت نحو مليون شهيد من ضحايا جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية، ارتكبها نظام الأسد بحق معارضيه. لم يشر من بعيد أو قريب إلى أن العنف المفرط والممنهج الذي بقي بلا رادع أو حساب، هو من أفرز كل أشكال التطرف في المجتمع السوري. لم يلحظ وهو مشغول بالطفولة المعذبة الدورات التي تُقام في روسيا لتدريب الأطفال السوريين على حمل السلاح. كما أنه لم يلحظ ميليشيات حزب الله وإيران، وهي تصول وتجول على الأراضي السورية، تقتل وتعتقل وتهين من تشاء من السوريين، أم أنها ميليشيات علمانية، يحق لها أن تسحق شعب النصرة؟
المدن
عن الفن والسياسة.. حصى “صافون” وألغام “ديركي”/ بسام يوسف
ضجت وسائل التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين بحدثين مهمين. لا تأتي أهميتهما من تأثيرهما في الأحداث، ولا من أهميتهما في الثقافة والفن، بل تأتي أهميتهما من دلالتهما في قراءة كيف يتعاطى السوريون مع تفاصيل المشهد السوري.
الحدث الأول هو فيلم “الآباء والأبناء” للمخرج السوري الكردي (كما يحب هو أن يعرّف عن نفسه) “طلال ديركي”، ويحكي الفيلم قصة عائلة تعيش في قرية من قرى محافظة إدلب، ويقرر الأب السلفي الجهادي الذي يوالي تنظيم القاعدة مصير أطفاله، عبر دفعهم باكرا لحمل فكرة الجهاد من أجل تحقيق الخلافة الإسلامية.
والحدث الثاني هو ظهور فنان سوري اسمه “نزار علي بدر” على برنامج للمواهب مخصص للبلدان العربية، ويقدم فيه موهبته في رسم لوحات عبر رصف حجارة لتشكل مشهدا أو لوحة، واختار هذا الفنان أن يقدم في هذا البرنامج لوحة تجسد هجرة السوريين ورحيلهم القسري الفاجع عن سوريا.
في كلا الحدثين انقسم السوريون في النقاش حولهما كالعادة، وتباينت الآراء بين حدين متطرفين من التأييد والاستنكار، ولم يكن هذا غريبا، فنحن السوريين
الذين خرجنا من قمع شديد امتد عقودا طويلة إلى فضاء الرأي وحريته، وإمكانية قوله وتداوله عبر وسائل غيرت كثيرا من مفهوم الإعلام وطرقه وأدواته، لن يكون سهلا علينا أن نهدأ قليلا في هذه الفسحة الجديدة من الحرية، ولذا فنحن نعيشها بكل ما يمكننا من الصخب والعنف، وبحجم الكبت الذي عشناه خلال عقود إسكاتنا عن قول أي رأي.
عندما تدفق سيل اللاجئين السوريين الهاربين من الموت في سوريا باتجاه أوروبا، انتشرت إشاعة عند هؤلاء اللاجئين وهي أن الأوروبيين، ولأنهم مسيحيون، فسوف يرحبون بك أكثر إن كنت مسيحيا، لذلك حاول كثيرون أن يظهروا دلالة ما في لباسهم، أو فيما يحملونه، تدل على أنهم مسيحيّون.. اشتروا صلبانا وعلقوها في رقابهم، وبعضهم وشموا صلبانا في أماكن ظاهرة من جسدهم، وبعضهم حمل إنجيلا في يده وتعمد أن يظهر غلافه. الخ.
لا يختلف “نزار علي بدر” راصف حجارة “صافون”، ولا “طلال ديركي” مخرج فيلم “الآباء والأبناء” كثيرا عمن حملوا الصليب في رقابهم، أو وشموه على أجسادهم… إنها أوجه متعددة لمنهجية واحدة تستثمر في قضية ساخنة من أجل مصلحة شخصية، وكلاهما لا يختلف كثيرا عن ذلك اللاجئ الذي يركب قصة معاناة يعتقد أنها ستحظى بأكبر قدر من التعاطف معه، وتتيح له لجوءاً مريحاً.
كل هؤلاء يرتكزون على جوهر واحد، هو محاولة الوصول لهدف شخصي محض، لكنهم يختلفون في الأداة وفي طريقة تسويق رؤيتهم، وهذا الاختلاف في العرض لا يحدده أصلا الفارق الثقافي، أو الفارق الموضوعي بين قصصهم، بل يحدده أساسا تصورهم المسبق عن الطرف الذي سيتلقى رسالتهم، ولهذا فهم يصيغون هذه الرسالة وفق ما يعتقدون أنه أكثر تأثيرا فيه.
يتوجه طلال ديركي للـ”غرب”، مواكبا للموجة السائدة الآن، والبالغة السخونة والإغراء، ألا وهي قضية الإرهاب والتطرف، وهاجسه في توجهه ليس القيمة الفنية، ولا حقيقة وأهمية الفكرة أو مصداقيتها، إن هاجسه الأهم في صناعة مادته هو كيف يحدث أكبر قدر ممكن من القبول لعمله عند هذا “الغرب”، بعبارة أخرى، لم يشتغل طلال ديركي على فيلمه بدلالة الحقيقة، والفن ودوره، لقد كانت دلالته في عمله هو كيف يسوّق نفسه لدى جهات تمتلك منظومة ما من المعايير، وبالتالي فإن هذه المعايير هي الأهم، حتى لو اضطره ذلك إلى الكذب والاختزال والاجتزاء والتشويه، وحتى لو اضطره ذلك إلى المس بقوانين إنسانية تتعلق بالخصوصية وبالطفولة وبالمهنية.
في مقابلة له مع محطة أميركية حول الفيلم، لا يتردد ديركي في إشهار كرديته لاستحضار تعاطف أكبر، (أنا هنا لا أدين هذا الإشهار، فهو حق أحترمه، لكنني لا أحترم استثماره) ولا يتردد في إعلان موقفه الديني وربما إلحاده، (وهنا أيضا لا أدين ذلك) كي يقول للغربي أنا مختلف، وأنا أكثر انسجاما معك، تماما كما يشهر مسيحي مسيحيته أمام محقق الهجرة، وكما يخترع علوي قصة معاناة درامية من تطرف سني أسود كي يوافق محقق الهجرة على أسباب لجوئه وكما… وكما.
في جانب آخر، يحاول نزار علي بدر إثارة موجة تعاطف شديدة مع لوحته التي تصور مأساة السوريين
هل يبرر السعي لمنفعة شخصية غض النظر عن أساليب الوصول إليها، وهل سنعود إلى جدل فصل الفن والرياضة والثقافة والموسيقى و..و.. عن السياسة …؟
الهاربين من الموت كي يلقى قبولا لها، وهو يعرف جيدا كيف تحفر هذه المأساة عميقا في نفوس الآخرين، بينما لا يتردد في نفس الوقت عن تأييد من تسبب بهذه المأساة السورية.
إذا كان للاجئ الهارب من الموت ما يبرر له البحث عن تعاطف قد يمنحه بعض الأمان والحياة، لكن هل يبرر البحث عن الشهرة والمجد الشخصي لمثقف أو فنان أو سياسي ذلك؟ وهل يبرر السعي لمنفعة شخصية غض النظر عن أساليب الوصول إليها، وهل سنعود إلى جدل فصل الفن والرياضة والثقافة والموسيقى و..و.. عن السياسة …؟
وبالتأكيد فإن السؤال الحاضر دائما عن ضرورة، سيطل برأسه هنا؟
إنها أسئلة كثيرة قد تصعب الإجابة عنها، وقد نختلف حولها كثيرا، وقد نتركها للزمن، لكن هذا لا يصح عندما يكون لهذه المواقف ثمن من لحم ودم، ثمن من مصير بشر، ومصير أطفال ووطن وشعب.
طلال ديركي، نزار علي بدر، أنتما مختلفان سياسيا، بل متناقضان -ظاهرياً على الأقل- أحدكما معارض لسلطة غاشمة، والآخر مؤيد لها، وأنتما متفقان على إيصال رسالتكما عبر عمل فني، لكن ما يحز في النفس أنكما تجتمعان على الاستثمار بدم وأشلاء شعب يعيش أكبر مأساة في تاريخ البشرية المعاصر.
تلفزيون سوريا
فيلم “عن الآباء والأبناء”.. ذلك العنف المتوارث/ أمير العمري
لا أتحمس كثيرا للكتابة عن “أفلام الحرب السورية”. والأسباب عديدة. أولا لأن غالبية هذه الأفلام تتشابه في ما تحتويه من صور ولقطات بل وتتشابه أيضا في مداخلها ومخارجها وأهدافها ومناهجها. وثانيا: أن معظمها لا يقدم جديدا على صعيد “الفن” أو حتى “الصنعة” السينمائية بحيث يمكن أن تثري الفكر والخيال قبل أن تكون مجرد “بيانات” أو “بلاغات” ضد نظام بشار الأسد أو ضد الجماعات الإسلامية المسلحة لحساب النظام أو لخدمة التوجهات الدولية في الغرب، بل وحتى “ضد الحرب” على صعيد مجرد. وهو نوع من الأفلام أراها مهما خلصت نوايا صناعها، “أفلاما دعائية” أي “بروباغندة” وهو أدنى أنواع الأفلام.
من المؤكد أن الجانب الإنساني في الصراع مهم، وبالتالي ينتظر الجميع اتخاذ موقف ما من جانب السينمائي أو حتى الناقد الذي يتناول الفيلم. ولكن كيف يمكن اتخاذ موقف واضح “نقي”، بعد أن أصبح الصراع الدائر في سوريا منذ سنوات، صراعا بين قوى شريرة وأخرى لا تقل عنها شرا؟ وبعد أن أصبح الثوار الحقيقيون الذين بدأوا الثورة السلمية التي كانت تحمل مطالب إنسانية نبيلة، قد أصبحوا مع ملايين السوريين الأبرياء، لاجئين خارج بلادهم؟ عن أي ثورة إذن يمكن أن نتحدث، وأي موقف يجب أن نتخذ؟
لهذه الأسباب يتعين على المرء أن يتوخى الحذر الشديد أمام أي عمل سينمائي جديد عن “الحالة السورية” المعقدة. وينسحب هذا القول على فيلم “عن الآباء والأبناء” للمخرج طلال ديركي، وهو الفيلم الذي حصل على عدد من الجوائز في بعض المهرجانات السينمائية الدولية، كما وصل إلى التصفيات النهائية ضمن مسابقة الأوسكار لأفضل فيلم تسجيلي طويل.
فهو عمل يوقع المشاهد في حيرة مشابهة ربما للحيرة التي تتعلق بتحديد موقف من الوضع العام القائم في سوريا. هذه الحيرة ليست نتيجة غياب الموقف السياسي في فيلم يتناول بالضرورة وضعا سياسيا بامتياز، بل إن ديركي يتبع أسلوبا في تصوير ومونتاج وبناء فيلمه، يبدو للوهلة الأولى كما لو كان فيلما آخر من أفلام “البروباغندة”. ولكن هذه المرة، لحساب الطرف الآخر، أي الجماعات الإسلامية المسلحة، وتحديدا ما يسمى بـ”جبهة النصرة” التابعة لتنظيم القاعدة.
من عوامل الإرباك في الفيلم أن طلال ديركي، السوري المقيم في برلين، يعود إلى سوريا للمرة الثانية (بعد أن كان قد صور فيلمه السابق “العودة إلى حمص” في 2013) ويذهب إلى محافظة إدلب حيث يتمكن من دخول إحدى بلداتها التي يسيطر عليها عناصر من تنظيم جبهة النصرة، بعد أن يزعم أنه مصور صحافي يعتنق فكر الجهاديين السفليين ويريد أن يصنع مع مصوره قحطان حسون، فيلما عن نضالهم لا بد أن يعتبر بالضرورة عملا دعائيا.
لذلك يكتسب طلال ومصوره ثقة أحد زعماء التنظيم وهو رجل في الأربعينات من عمره يدعى “أبوأسامة”. وهو أب لثمانية أولاد. أكبرهم هو “أسامة” سماه على اسم زعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن. أما البنات والزوجات فيغبن عن الفيلم. لكن سيأتي وقت نسمع صراخهن بعد أن يصاب أبوأسامة إصابة تفقده ساقه اليسرى ويعود إلى المنزل بعد أن يغادر المستشفى (الميداني).
وكما أننا لا نرى النساء في الفيلم احتراما لـ”خصوصيات” أبوأسامة الإسلامي الأصولي المتشدد الذي يستند في كل ما يقوم به في حياته اليومية إلى أحاديث ينسبها إلى النبي محمد، ليس معروفا بالطبع مدى صحتها أو دقتها أو على الأقل الأمانة في تفسيرها، لا نرى الجانب الآخر في الصراع سوى في لقطات محدودة كما في المشهد الهائل الذي يقتاد فيه أبوأسامة ورفاقه مجموعة من الشباب الغض من جنود الجيش السوري الأسرى تمهيدا على ما يبدو لذبحهم خاصة وأننا نسمع في بداية الفيلم عبر مكبر صوت رجلا ينادي ويحذر من أن وقت قطع الرقاب قد حان وأن على الجميع أن يستعدوا للموت.. أو شيء من هذا القبيل.
أبوأسامة رجل بسيط في تكوينه وأفكاره، وهو عندما يتحدث في السياسة يبدو كما لو كان يستقي من عالم الأحلام.. بل إنه يتطرق بالفعل إلى “الكوابيس″ أحيانا.. فهو مثلا يرى أن الحرب لن تستمر إلى الأبد، بل لا بد أن يأتي وقت تتعادل فيه الأطراف المختلفة، ولكن ستظهر بشارة تؤكد انتصار المسلمين على “الروم” طبقا لما ينسبه إلى النبي محمد، فهو بالقطع من أصحاب “اليقين المطلق” لا يراوده أدنى شك في انتصار الإسلام وإقامة دولة الخلافة الإسلامية ولكنه رغم ذلك يتحدث بنوع من الازدراء عن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) رغم أنه لا يختلف في مبادئه وأهدافه عن تنظيم جبهة النصرة. ومرة أخرى وعلى نحو شديد السذاجة، ينسب إلى النبي محمد حديثا عن الرجل الذي لديه ولدان، ولد مطيع والآخر عاق.. ويرى أن تنظيم “داعش” هو الولد العاق!
حصل فيلم “عن الآباء والأبناء” للمخرج طلال ديركي على عدد من الجوائز في بعض المهرجانات السينمائية الدولية، كما وصل الى التصفيات النهائية ضمن مسابقة الأوسكار لأفضل فيلم تسجيلي طويل
حصل فيلم “عن الآباء والأبناء” للمخرج طلال ديركي على عدد من الجوائز في بعض المهرجانات السينمائية الدولية، كما وصل الى التصفيات النهائية ضمن مسابقة الأوسكار لأفضل فيلم تسجيلي طويل
ينتقل الفيلم طوال الوقت بين أبوأسامة وأبنائه الثمانية بتركيز خاص على ولدين هما الأكبر أسامة (13 سنة) الذي يشرح والده للمخرج أنه ولد في 11 سبتمبر 2007 أي في الذكرى السادسة بالضبط لهجمات 11 سبتمبر 2001، وهو ما يعتبره بمثابة “معجزة”، أما ابنه الثاني “أيمن” (12 سنة) فقد سماه على اسم أيمن الظواهري الرجل الثاني في التنظيم. ويقول إن ابنه الثالث محمد عمر سماه على اسم زعيم طالبان (الملا عمر).
الأب وأبناؤه
الفيلم إذن ليس عن “الآباء والأبناء” بل تحديدا عن أب واحد هو أبوأسامة وأبنائه الثمانية الذين تتم تربيتهم وتنشئتهم لكي يصبحوا مستقبلا مقاتلين في صفوف التنظيم المسلح. وترصد كاميرا طلال ديركي بدقة وبشكل مثير، كيف يمارس هؤلاء الأطفال الذين تشع عيونُهم بالبراءة، حياتهم اليومية، بعد أن انقطعوا عن الذهاب إلى المدرسة استجابة لرغبة والدهم الذي يلقنهم مع رفاقه من القائمين على شؤون الشبيبة في التنظيم، مبادئ الشريعة ويغرسون في عقولهم غرسا، فكر الجهاد.
في لهوهم ولعبهم اليومي هم يترجمون العنف الذي نشأوا في ظله، فيعتدي أسامة على شقيقه بالضرب، ثم ينال بدوره عقابا جسديا صارما من والده الذي يلكمه ويركله ثم يأمر بحلق شعر رأسه، وعندما يلقي الأطفال بأنفسهم في بركة للسباحة عبارة عن حفرة في الأرض يملأونها بالماء عبر أنبوب موصل بشاحنة للمياه، يطلقون هتافات كما لو كانوا ذاهبين إلى معركة حربية.
لكن التغير سيصبح تدريجيا ملحوظا فقد تابع ديركي ومصوره تلك الأسرة خلال عامين، أي أن الأطفال يكبرون ويفقدون طفولتهم ثم سيأتي يوم يرسلهم فيه أبوهم جميعا إلى معسكر التدريب العسكري حيث يتعين عليهم ممارسة التسلق والقفز وسط النار والانتظام دون حراك بينما يطلق مدربهم الرصاص قرب أقدامهم. سيبدو أن أسامة قد بدأ يفقد براءته ويندمج في دوره الذي وُعد به كمقاتل، أما شقيقه أيمن فيفشل في استكمال التدريبات لكونه دائما منصرفا بتفكيره بعيدا عن فكرة القتال والعنف.
الصرامة والقسوة والمشاعر الدموية تجعل أبوأسامة في لحظات المزاح يقول لرفيق له إنه يمكن أن يعذب ابنه الصغير بالصعق بالكهرباء، وعندما يداعب الطفل الذي يتطلع إليه في براءة ودهشة طفولية محببة، يقول له إنه يمكنه أن يخرق عينيه أو يدس السم له. يكرر مثل هذه الأقوال البشعة وهو يضحك في سعادة بينما يحدق الطفل في وجهه لا يمكنه أن يفهم ماذا يعني…
ورغم ذلك وفي مواقف أخرى، يمكن أن يكون أبوأسامة جذابا مرحا محبا للحياة، يتحدث عن رغبته في الزواج من ثلاث نساء أخريات، يقبل على الطعام، يمرح ويمزح مع المخرج الذي لا نراه أبدا في الفيلم بل يظل كامنا وراء الكاميرا، لا يتوقف ليسرد لنا مشاعره (ولو في مرحلة تركيب الفيلم) حتى بعد أن نشاهد أكثر المشاهد في الفيلم إثارة للقشعريرة وأكثرها إرباكا أيضا. فقد اختار طلال ديركي دور “الشاهد الصامت”.
داخل بعض أطلال المنازل المهدمة ومن خلال فتحة في الجدار يجلس أبوأسامة يصوب بندقية آلية، يطلق النار ويقول إنه أصاب شخصا سقط من فوق دراجته.. ثم يلتفت ويطلب في لهفة، بندقية أخرى بعد أن تعطلت بندقيته، فيناوله شخص من خارج الكادر بندقية أخرى مزودة بمنظار مكبر وعندما يصوب لكي يقضي على الشخص المصاب لا يجده في عين المكان، ويقول إنهم قد أبعدوه.. ولا يهتم طلال ديركي بمعرفة من الذي أصابه، وماذا كان يفعل، وهل كان يشكل خطرا أو كان مسلحا؟ فاهتمامه الأساسي ليس بالضحية بل بالصيد. بعقلية وتناقضات القاتل المدفوع بقناعاته “الأيديولوجية” التي لُقن إياها بدوره تماما مثلما يلقنها لأولاده.
سؤال أخلاقي
من المفهوم أن المخرج كان يخشى على حياته لو انكشف أمره كما يخبرنا في بداية فيلمه، لكن المشكلة أنه لا يضيف أي تعليق في ما بعد. وهنا يمكن أن يبرز تساؤل حول الموقف الأخلاقي للفيلم. طلال ديركي ليس مشغولا بتسجيل موقف سياسي، فهو غير معني بالضحايا، ولا حتى بالصراع الدموي الدائر في سوريا، بقدر ما يهتم برصد وتسجيل وتوثيق الحياة اليومية لأسرة بطريركية (الأب وأبناؤه) تنتمي وتعيش وينشأ أطفالها حسب تقاليد وأفكار القرون الوسطى.. كيف يتعامل أب مقاتل جهادي قناص، خبير قنابل وإزالة ألغام، مع أبنائه، وما مصير هؤلاء الأبناء، وكيف يتم تغذيتهم بالفكر الجهادي وتدريبهم على أعمال القتال بينما يعلم أبوهم علم اليقين أنهم سيلقون حتفهم في خضم النزاع المسلح.
هل يبرر هذا الرصد الصورة الإنسانية التي نراها بعد أن يصاب أبوأسامة وهو ينزع أحد الألغام فيفقد بالتالي ساقه اليسرى ويحمد الله لأنه ادّخر له ساقه اليمنى لكي يمكنه قيادة السيارة، ثم يرقد وهو يتألم وقد أصابته بعض الشظايا في وجهه فأفقدته القدرة على الرؤية بإحدى عينيه؟ هل يصبح مطلوبا منا الإعجاب بقوة شكيمة أبوأسامة ويقينه الديني الذي يجعله يواصل “الجهاد” ضد “الروم” والنظام السوري والأتراك والمعارضة والجيش الحر، الذين يعتبرهم جميعا “أعداء” لتنظيمه الذي يرى أنه الوحيد النقي الذي يكافح من أجل هدف عظيم؟ أم ندينه وندين ما يقوم به من أفعال، ونتعاطف مع أبنائه الأبرياء الذي يتم توريثهم عقيدة العنف والقتل والدماء؟
هذا ما يبدو أن المخرج قد تركه للمشاهدين حسب أنواعهم وانتماءاتهم وخلفياتهم.
كاتب وناقد سينمائي مصري
العرب
عن الإمتاع والمؤانسة في فيلم طلال ديركي “عن الآباء والأبناء”/ هشام الزعوقي
إذا كان من إنجازاتِ الانتفاضةِ السوريةِ في ثورةِ الألفين وأحدَ عشرَ ظهورُ كمٍّ غيرِ قليلٍ من الأفلامِ والفيديوهاتِ السوريةِ المتنوعةِ، والتي حاولت الإحاطةِ بمختلفِ جوانبِ الحياهِ في ظلِّ هذا الحراكِ، عبرَ سنواتِ الاشتباكِ الأمني والسياسي والعسكري بين إجرامِ النظامِ تُجاهَ الشعبِ السوري المنتفضِ من جهةٍ وازديادِ نفوذِ الفصائلِ المتشددةِ على مستوى أرضِ الوطنِ (سوريا) من جهةٍ أخرى.
نجد أنَّه من الطبيعي أن يكونَ هناك تنوعٌ في المواضيع المطروحةِ وطرقِ تناولِها، هذا التنوعُ الذي انعكسَ أيضاً في الجودةِ بين هذه النتاجاتِ نفسِها، حيث تتراوحُ ما بين أفلامٍ عاليةِ الجودةِ فنياً شكلاً ومضموناً. إلى أفلامٍ متوسطةٍ، وانتهاءً بأفلامٍ رَثَّةٍ.
سبق صحفي
من العدلِ أنْ لا نقللَ من أهميةِ القرارِ الجريءِ الذي اتخذه المخرجُ الصديقُ طلال ديركي بالدخولِ إلى هذه البيئةِ “الجهاديةِ” و” فضحِها”. إنَّه أشبهُ ” بالسّبقِ الصحفي” ونادراً ما اقتحم أحدٌ ما تلك البيئة، وخرج منها سالماً. ومن ثَمَّ تابعَ هذا الجهدَ رغمَ خطورتِهِ، وانتهى به الأمرُ إلى إنتاجِ فيلمٍ رُشِّحَ للأوسكار. إذاً هناك جهدٌ واضحٌ مبذولٌ لإنتاجِ هذا الفيلم .
في الوقتِ نفسِه من حقِّ طلال ومن حقِّ الجميعِ أيضاً إنجازُ أيِّ مشروعٍ فنيٍّ أو سينمائيٍّ عن أيِّ موضوعٍ يناسبُهم. لكنْ أيضاً من حقِّ المشاهدين التعبيرَ عن آرائِهم حول هذه المنتجاتِ والأعمالِ.
بعيداً عن التجريحِ الشخصي، وبعيداً عن التوترِ والانفعال. تكمنُ أهميةُ فيلمِ طلال أيضاً أنَّه فتحَ بابَ النقاشِ الجادِّ والحرِّ حولَ الأعمالِ السينمائيةِ السوريةِ، وعلاقتِها بالوضعِ السوري، ومدى قربِها أو بعدِها عن تصويرِ وتوثيقِ هذه الكارثةِ الإنسانيةِ .
في البدايةِ من الجيدِ الاتفاقُ على بدهيةٍ معروفةٍ في عالمِ السينما والفن عموماً. إنَّ اختيارَ موضوعٍ جيدٍ ليس بالضرورةِ أنْ ينتجَ عنه فيلمٌ جيدٌ. مع الانتباهِ إلى أنَّه هناك سمةٌ إضافيةٌ لها علاقةٌ بمفهومِ السينما كصناعةٍ، أيْ ” كمنتجٍ ” له علاقةٌ ما بمنطقِ السوقِ (العرض والطلب) أيْ أنَّ بعضَ الأفلامِ تكونُ (شغّالةً) بمعنى أنَّها تعرضُ وتلاقي استحساناً من شريحةٍ واسعةٍ من الجمهورِ، وأحياناً حتى من بعضِ النقادِ دونَ أنْ يكونَ لها أيُّ قيمةٍ فنيةٍ جماليةٍ أو حتى إنسانيةٍ .
“الكابوس السوري”
(أبو أسامة) الشخصيةُ الرئيسيةُ في فيلمِ (عن الآباء والأبناء) أبٌ سوريٌّ بامتيازٍ تجدُ كثيراً من أمثالِه في كافة أرجاء الوطن سوريا، لكن خصوصيته هنا أنه أيضاً أب لمجموعة أطفال يعيشون وينمون في مناخ بيئة خاصة اسمها بيئة “جبهة النصرة” المتشددة دينياً والمسيطرة على جزء من الأراضي المحررة في محافظة إدلب. (حسب الفيلم اسمها إقليم إدلب) .
منذ اللحظات الأولى للفيلم يفصح المخرج عبر التعليق عن سبب مغادرته سوريا “إنه الكابوس..” و”إنها الحرب التي فرقت بين الأخ وأخيه وهرباً من الظلم “
هذه الجملة تبدو صادقة فعلاً بالنسبة إلى طلال وإلى كثيرين، ممن غادروا سوريا وطلبوا اللجوء في أوروبا، طلباً لحياةٍ آمنة كريمة. ولكن هذه الجملة هي ليست جملة لفيسبوك، أو للجنة التحقيق في ملف قبول اللاجئين في ألمانيا، وإنما هي افتتاحية لفيلم سيأتي بعد ثوانٍ، لا نشاهد فيه سوى أجواء وحياةٍ يومية وتصريحات لجهاديين يريدون بناء الخلافة مع بعض المناوشات مع “جيش النظام” الذي نراه ممثلاً ببعض الأسرى من الجنود. بالإضافة إلى مزاولة أبو أسامة لعمله كمزيل للألغام الأرضية في هذه البقعة الجغرافية من سوريا.
أي أنه بطريقة ما هو اختزال للصراع في سوريا على أنها حرب بين النظام والجهاديين. الفيلم يقول لنا ذلك وهذا ليس تجنِّي على الفيلم أو على المخرج الذي يشرح في أماكن متعددة ” أنه فيلم عن بيئة محددة ” وليس عن سوريا. يبدو الأمرُ أشبهَ ما يكون وكأنَّنا نطالب الطبيبَ عندما يناقشُ موضوعَ الحَمْلِ أن لا يتحدث عن الجنين لأنَّ موضوعنا هو تحديداً الحمل.
منذ بداية الفيلم وبعد العناق “الدافئ” ما بين أبو أسامة المضيف وما بين شخصية الضيف المخرج الذي وصل للتوِّ بوصفه “أخ ورفيق درب جهادي” في تلك اللحظة بالضبط يكون أبو أسامة قد بلع الطعم.
ونحن كجمهور منذ تلك اللحظة عرفنا شيئا مهما لا يعرفه أبو أسامة وبالتالي سنتابع الفيلم على هذا الأساس. من الآن فصاعداً ستكون كل جملة يقولها أبو أسامة “المُغَّفل” أو كل تصرف منه سيكون تحت سيطرة حضور مسطرة نقدنا وانتباهنا الحاد. وحسب بوح المخرج ذاته في بداية الفيلم هو يقوم ” بمهمة ” عالية السرية والخطورة. المخرج هنا لديه “أجندات” غامضة إلى حد ما، لكنه سيتغلغل في أجواء هذه العائلة السورية فيما بعد وسيتعرف على أدق تفاصيل حياتهم، وسيتفرد بالأطفال، ويجري معهم مقابلات وحدهم، وحتى في أماكن نومهم ولعبهم ووحدتهم، وبالتالي سيستمع إلى أفراحهم وأتراحهم. هو لا يشاركهم حياتهم إلا بمقدار ما تسمح كاميرا هذا الغريب (المخرج) بتسجيل كل ما هو ضروري لفيلمه القادم. العائلة أبوابها ونوافذها مشرعة لهذا الشاب الوسيم، والذي هو ضيف عزيز على قلوب هذه العائله، والمكان الوحيد الذي لم تصله الكاميرا لحسن الحظ هو غرفة النوم الخاصة بأبي أسامة.
حيادية السينما
في اللغة السينمائية لا توجد أيُّ مفردةٍ عبثية، سواء كانت صوتاً أو صورةً. ولهذا عموماً نستطيع بعد أن نشاهد الصورة أن نقرأها جيداً في وعينا أو في اللاوعي. نتلقاها ونفهمها عن طريق تجربتنا وخبرتنا الشعورية، وكذلك نتذوق الصوت. نتابع الحوارات عندما تكون مسموعةً أو غيرَ مسموعةٍ. في أحيانٍ كثيرةٍ يكون الصمتُ ربما أقوى وأشد تأثيراً من الكلمات.
في فيلم (عن الآباء والأبناء) نلاحظ بوضوح اللقطات الطويلة الصامتة والخالية من أيِّ حوارٍ أو تعليق، بل إنَّ الفيلمَ يكاد يكون مبنياً في لغة سردِه البصرية على هذه اللوحات البصرية التي تعطي متعةً أحياناً رغم هولِ المضمون، وهذه جماليةٌ من جماليات السينما وقوةُ تأثيرها وإيهامها. ولكن في الوقت نفسه، من الضرورة أن نميِّزَ بين نمطين في استخدام الكاميرا التوثيقية، الأولُ هو نمطُ ” المعايشة ” مع شخصياتِ وأحداثِ الفيلم، وهذا يفترض على الأقل نوايا طيبة تُجاهَ موضوع الفيلم، ونمطٌ آخرُ هو أقرب إلى نمط “التجسس “
في اللقطة الأولى من بداية مشوار الفيلم تظهر لقطةٌ سريعةٌ لوجه أبو أسامة وهو يضحك ضحكةً عنيفةً، لا نعرف سببها، لكنَّه يذكرنا بشخصيات الجِنِّ الخارجةِ من قمم علاء الدين في الأفلام الهوليودية، أو المارد في حكايا ألف ليلة وليلة.. رأسٌ كبير حليقٌ ولحيةٌ كثيفة وضحكة مجلجلة، وكأنَّ هذه الشخصية تكاد تقول: ” شبيك لبيك ” أنا الجهادي أبو أسامة بين يديك.. أو تكاد تكون صورته شخصيةً هاربةً من أفلام الرعب لهيتشكوك. لتأتيَ بعدها مباشرةً لقطةٌ لرجلٍ يرمي طفلاً وليداً في الهواء ليلتقطه رجلٌ آخرُ ذو لحيةٍ. لقطةٌ تحبس أنفاسنا نحن كمشاهدين خوفاً على وقوع الطفل. لكن في الفيلم على عكس ذلك نجد أن كلَّ من في الغرفة مبتهجٌ، والجميع يضحك. ونحن مستمتعون كمشاهدين
الاستشراق السوري
لو أنَّ أحداً ما صوَّر هذه اللقطة فيديو -لأبٍ ملتحٍ يعيش في أوروبا، أو في الغرب يلعب مع طفله بهذه الطريقة – ثم أخذ هذه الصورة إلى مكتب رعاية وحمايةِ الطفولة، لكانت النتيجةُ أخذ الطفل من العائلة بتهمة الإهمال، والعنف، والتعذيب تُجاهَ الطفولة
هكذا يتعامل الغرب مع مفردات أفلامنا. لديه مرجعياته وخزانته الشعورية واللاشعورية الجاهزة لتحليلنا، لقراءتنا ولفهمنا. تتالى المشاهدُ ” الاستشراقية “. هل لاحظتم التوحشَ والافتراسَ الذي يُمارس أثناء تناول العائلة لوجبة طعام “رأس خاروف” لقد كانت الكاميرا تقترب من الطعام بطريقةٍ نهمةٍ لتصورَ بشاعةَ وتوحشَ جريمةِ تناولِ الطعام، وكأنَّه بعد لحظاتٍ ستقفز هذه الشخصياتُ من الشاشة لتفترسنا وتلتهمنا نحن المشاهدين. لقد كانت تبدو وكأنَّها وجبةُ طعامٍ “لأَكَلَةِ لحومِ البشر” هكذا تقول الكاميرا، ليس أنا أو أنتم. مع أن أبو أسامة كان يكرم ضيفه (المخرج)، ويحاول أنْ يوجِّبَه ويُدلِّلَـه بتقديم الأفضل من وجبة الطعام للضيف
في عيد الأضحى مشهدُ “الإجرام” في ذبح الخاروف..معاقبةُ الأب لابنه بحلاقة شعره، أو حتى أحياناً بركلِهِ. ومشاهدُ عديدةٌ في الفيلم هي في الحقيقة ممارساتٌ يوميةٌ منتشرة في كثيرٍ من الأماكن، لكنَّ طريقةَ تقديمِها في الفيلم كانت مدروسةً تماماً؛ لتقدمَ وجهةَ نظرٍ محددةٍ عنا .
علاقةُ أبو أسامة مع أبنائه بشكلٍ عام، هي علاقة تشبه الغالبية العظمى من الآباء مع الأبناء في الشرق، فمثلاً مَن مِنَّا من لم يعاقبه أبوه في الصغر لأمرٍ ارتكبه، ومن منا لم يحضر أضحياتِ ذبح الخرفان في عيد الأضحى، حتى سمح لنا بإطلاق النار من مسدس الآباء والأعمام كعلامةِ بدايةِ الرجولة، أو من منا لم يتشاجر مع أخيه، و يعاقب الاثنين معاً… إذاً لا يوجد أيُّ شيءٍ استثنائي هنا عند أبو أسامة، إلا كونه متشدداً في الدين، والتزامه الجانب الشرعي في نمط حياته. كثيرٌ منا عايش هذه البيئة سابقاً، ولكن لم نصبح جهاديين ولا سلفيين ولا حتى ” إرهابيين ” .
هذا لا يعني أبداً أنَّنا نُدين المخرجَ أو ندعوه لطمس الواقع أو التغاضي عن تصوير ” الحقيقة “. ولكنَّنا نقرأ مفرداتِ فيلمِه بطريقةٍ تحليليةٍ نحاول فيها أن نفهم ما يريد دون أنْ نُفسدَ ” متعة ” الاستئناس لهذه النظرة الاستشراقية في صناعة الفيلم.
ويجب الاعتراف أن طرح هذا الموضوع بهذه الطريقة ” الاستشراقية / الإثنيةِ ” في أيِّ عملٍ فني أو أدبي، ولا سيما في السينما، هو موضوعٌ جذَّاب، و” بيَّاع ” ويجلب ” الشهرة “.
كرامة الأطفال
لكن في الوقت نفسِه من أبجديات العمل التوثيقي، حمايةُ مصادرِك أو شخصياتِ فيلمك. أنت ملزمٌ من الناحية الأخلاقية والمهنية بحمايتهم من الآثار المترتبة على كلامهم وتصريحاتهم وتصرفاتهم. وخاصةً الأطفال .
مشهدُ عودةِ أبو أسامة من المشفى إلى البيت، بعد أن انفجر فيه لغمٌ أفقدَه ساقه. قد يعتبر البعضُ أنَّ هذا المشهدَ من أهم المشاهد المؤثرةِ في الفيلم، لكن في الحقيقة هذا المشهد كان اقتحاماً لأكثرِ اللحظاتِ خصوصيةً وحميميةً في تاريخ العائلة.. تصوير وعرض نكبةِ العائلة بعودة الأب “العاجز”. عويل الأطفال والنساء في هذه الفجيعة والتي كانت الكاميرا تصورها وتعرضها، ليس كلقطاتٍ سريعةٍ وإنما ككادرٍ ثابتٍ يصور ويصور، ويتطاول الوقت والعويل يزداد، ولا يصيب الكاميرا أيُّ خجلٍ لتغضَ الطرف. إنَّه امتهانٌ لكرامة هذه العائلةِ بنفس درجة الامتهان الذي يمارسه الجهادي، وهو يلقي خطبته كـ ” الموجه السياسي ” للأطفال، ويروي لهم نضالات الجهادية في أفغانستان أو في 11 أيلول .
الحدودُ كثيراً ما تكون ضعيفةً أو حتى تكاد تكون واهيةً، ما بين أن تظهر أحزان ومعاناة الناس، مع الأخذ بعين الاعتبار احترام كرامتهم الإنسانيةِ، وبين أن تظهرهم كعروض الفريك شو (وهي عروض لشرائح غريبة من الناس التي أشبه ما تكون محبوسةً في قفص أو في السيرك، وهي تجلب المتعة لغرابة تصرفها ونمطها وحديثها)
لقد كان أبو أسامة مع عائلته وأطفاله يبدون وكأنَّهم كائناتٌ “خرافية” من كوكب آخر، محبوسين في قفص من أقفاص السيرك، ونحن بدورنا نستمتع ونستغرب حياتهم وتصرفاتهم، بغض النظر عن دوافعهم الأيديولوجية والدينية. أي ظهروا أشبه ما يكونون بسكان أمريكا الأصليين، الهنود الحمر. في الأفلام الهوليودية. أظن أن الشعب السوري الذي انتفض وهُجِّرَ لم يكن على نمط أبو أسامة ولا على نمط طريقة تفكيره. فلماذا إذن هذا التزييف.
لقد استمتعنا بصرياً في مشاهدة البيئة الجغرافية والمكانية لهذه البقعة من العالم، لأنه بالرغم من “رثاثتها” هي جذابةٌ. بلادٌ مشمسةٌ وآفاقٌ ممتدةٌ لتضاريس متنوعة ووجوه مشرقة تلونها الشمس والنور.
هوليوود والعودة إلى سوريا
إنَّ هذه “الكائنات الخرافية” التي ظهرت في الفيلم رغم أنَّها موجودةٌ في الحقيقة على الأراضي السورية، لا يستغرب أن تكونَ مادةً ملهمةً قريباً للسينما الهوليودية. وحقيقةُ الأمر لا يستغرب أن يلهم الفيلم الوثائقي “عن الآباء والأبناء” في إنتاج “سيناريو” فيلمٍ روائي.
عن الجهادية، لكن عوضاً عن أن يكون بطله على نمط رامبو في أفغانستان، هذه المرة سيكون رامبو في الرقة أو إدلب. وسينتحل هذه المرة البطل شخصية (مخرج الفيلم) .
السردية السورية
بعد ثماني سنواتٍ تقريباً من انتفاضة الشعب السوري، وانتقال الصراع إلى مستوى آخر، وإلى منصاتٍ جديدة. نجد أنَّ صراعنا الأخلاقي والإنساني مع هذا النظام التعسفي لم ينتهِ بعد. صراعُ السردياتِ والمروياتِ عن وقائعِ سنواتِ الثورةِ من ألفين وأحدَ عشرَ لم ينتهِ، لا بل إنَّه بدأ بجدية الآن ومستقبلاً .
لقد انتبه النظامُ أكثرَ من الجميع إلى هذه النقطة، وبدأ بتشكيل هيئةٍ لإعادة كتابة وتوثيق الذي حدث من وجهةِ نظرِه (وبغض النظر أنه سيكتب روايةً مزورةً ومزيفةً عن الحدث) إلا أنَّه بدأ بالاستعانة بأسماء لها خبرتها في هذا المجال، ومنها الدكتور “سامي مبيض” أحد المسؤولين عن هذا المشروع.
من هنا أجد أهميةَ مسؤولية إنجاز روايتنا ببعدها الأخلاقي والإنساني والمادي، لأننا بطريقةٍ ما نحن الذين قُتِلنا وهُجِّرنا، ونحن الذين سُرِقت منازلُنا وقُصِفت، ومات إخوتنا وأصدقاؤنا وآباؤنا وأطفالنا. والقاتل ليس شبحاً غيرَ معروف، إنما هو نظام الأسد وامتداداته سواء كانت قوى مساندة له بشكلٍ مباشرٍ أو قوى تعمل معه أو لصالحه في الخفاء، من تنظيماتٍ متنوعةٍ متشددةٍ دينياً أو منفتحة. أظن الإشارة إلى المسؤول الأساسي عن هذا الدمار هو أمر لا يمكن التغاضي عنه، ولا يدخل في نطاق وجهات النظر والآراء. الإشارة إلى المجرم الأساسي لا تعني بالضرورة أن تكونَ من خلال عباراتٍ سياسيةٍ جافةٍ ومملةٍ. هناك كثيرٌ من الطرق للإشارة إلى ذلك، ولاسيما في الفن …لا يمكن التهرب عبر تبريراتٍ ووجهاتِ نظرٍ تدَّعي “موضوعيتها “وحياديتها”. لا حياديةَ مع الدم، ولا حياديةَ في محاكمة ومحاسبة المجرميين المسؤوليين عن دمار سوريا. لا يمكن التنصل من تحميل المسؤولية للنظام ورئيسه وأجهزته وجيشه من الدمار الذي لحق بالوطن .
في الوقت نفسِه هذا لا يعني أبداً التغاضي عن إشكالات بقية الأطراف المناهضة للنظام والتي جلبت الكوارث أحياناً على نضالات وتضحيات الشعب السوري سواء من أشخاص أو قوى سلفية متشددة أو غيرِ متشددة.
تلفزيون سوريا