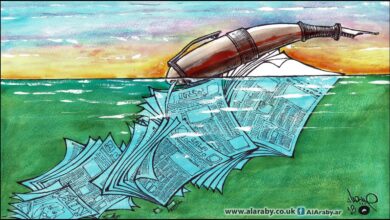الرقص الشرقي: خلاص أنثوي وهلع سلطوي/ إيمان عادل

“مع الرقص انتهى زمن الردف الممل العديم الحيل وعديم المنظور في الحياة، لأن الرقص يخلق في الردف شيئًا غير عاديًا، ألا وهو الهزة ويصبح الردف بواسطة الرقص سعيدًا بكونه ردفًا”
بهذه العبارة للكاتب جن ليك هينيج في كتابه “موجز تاريخ الأرداف” ندرك أن الرقص خاصة المرتبط بهز الأرداف، وهو المفهوم الأقرب للرقص الشرقي، في أحد وجوهه إعادة اعتبار للجسد الأنثوي وحيويته ولغته من خلال افساح المجال له كي تمارس الحياة خلاله فعلها وإيقاعاتها الحيوية، فنرى الردف ينساب بحرية في كل اتجاه، فلم يعد يمكث متحجراً عالقاً بين الظهر والسيقان!
هذه الروح المنفلتة من القيود التي تتلبس جسد الأنثى الراقصة قد تحدث هذه الغواية المحظورة على مدار التاريخ دينيًا واجتماعيًا، لكن إلى جانب ذلك قد يتخطى الرقص منطق الغواية، ليحدث إشكالًا فكريًا وإنسانيًا من الصعب فكه أو حتى الاستقرار حول بنيته، فيصبح الرقص منفلتًا عن كل الأطر المحددة والمحسومة، عالقاً طوال الوقت بين ثنائيات متضادة؛ فن / انفلات، مهنة / متاجرة، يعزز الصورة النمطية للمرأة / يكسرها، يروج لقضية أم لغواية، بصمة ولغة عالمية أم وصمة إنسانية، نسق ثقافي أنثربولوجي جماعي أم مشروع فردي.
على المستوى النظري نرى أن الرقص الشرقي رغم غزارة منتجه عربيًا ورواجه على المستوى العملي ورغم الجدل القائم حوله، تعرض نظريًا لتهميش واضح في الدراسات خاصة المتعلقة منها بدراسة انثربولوجيا الشعوب، ورغم أن الرقص يعد أحد التخصصات الفرعية لعلم الانثربولوجي، إلى جانب فروعه الأخرى، كدراسة العرق واللغويات وعلم الآثار، إلا أن التهميش الواضح لدراسة هذا الفرع يكلف الحقل المعرفي خسارة الإطلاع على جانب من الثقافة والسلوك الإنساني، فضلًا عن دراسة الأشكال التعبيرية والجمالية للثقافة، وليس هذا فحسب، بل أن اقصاءه نظريًا على هذا النحو يفسح أيضًا المجال لانتشار الأفكار المناهضة للرقص كسلوك إنساني طبيعي، فيسمح للتبريرات الدينية والاجتماعية المنغلقة بأن تأخذ حيزًا لمحاولة تقويض الرقص من جذوره.
الدراسات التي تتناول الرقص الشرقي في غالبيتها جاءت على لسان الرحالة الغربيين، ونتذكر هنا رحلات فلوبير إلى مصر. وجاءت هذه الكتابات منصبة على اشتهاء الغرب لنساء الشرق، وما تحمله أجسادهن من غواية. خاصة إذا ترافقت هذه الغواية مع حركات راقصة، ثم جاءت الدراسات التحليلية المناقضة لهذه الزواية لتتناول الاستشراق في المرحلة الكولونيالية وما بعد الكولونيالية من وجهة نظر نسوية، دون التركيز على الرقص في حد ذاته بقدر التركيز على الجسد الأنثوي.
ولقلة الدراسات حول الرقص الشرقي نحن لا ندرك حتى ضرورة مراجعة مصطلح “الرقص الشرقي”، هل الرقص المعروف عربيًا ومصريًا تحديدًا رقص شرقي فعلًا؟ وأي شرق بالتحديد؟ أم هو خليط من رقصات عالمية قديمة، وثقافات تداخلت بحكم الاختلاط الثقافي خاصة مع بلاد اليونان ومصر القديمة وبلاد الشرق الأقصى والهند.
في كتاب موجز تاريخ الأرداف ندرك أن اليونان منذ القرن الأول الميلادي كانت شهيرة برقصات هز الردف على وقع الطبلة، فقد اشتهرت حوريات المينادس بهز ردفهن أثناء الرقص مع رد ضفائرهن إلى الخلف، مع حركات ذراعين تشبه حركة الأمواج، وكانت الراقصات يرتدين الصناجات كي يحدثن أصوات أثناء الرقص.
وهي حركات لازال يحتفظ بها الرقص الشرقي رغم أنها قد لا تكون كما يبدو حركات شرقية أصيلة، إلا أن انتشارها عربيًا ومصريًا بشكل خاص له أسبابه؛ ففي تحقيق للكاتب المصري فاروق أباظة بعنوان “الغروب الكبير في شارع العوالم” المنشور بمجلة الكواكب عام 1960 تحدث عن بدايات ظهور العوالم، أي الراقصات في شارع محمد علي، وهو الشارع الطويل الممتد من ميدان العتبة حتى القلعة، وانشأه محمد علي عام 1845 . يقول فاروق أباظة في تحقيقه أن الرقص كان محرمًا على النساء المصريات في القرن التاسع عشر، وبالأخص المسلمات منهن، فظهرت في الصالات والملاهي الليلية في شارع محمد علي وملاهي روض الفرج الراقصات الأجنبيات، حتى كسرت إحدى الفتيات المصريات الجريئات هذه القاعدة وأطلقت على نفسها اسم مريم “وهي جدة الفنانة سميحة توفيق” كي تستطيع العمل في مجال الرقص وعملت بدأب متنقلة بين ملهى الألدروادو وملهى ألف ليلة وليلة ومونت كارلو وليلاس وسان ستيفانو.
بعدما كسرت مريم القانون السائد بمنع المصريات المسلمات من العمل في الرقص، بدأ شارع محمد علي يعرف مواهب نسائية تجيد الرقص مثل “فايزة أم برقع” التي كانت تقدم فقرتها بالبرقع، و”توحيدة” و”سعاد محاسن” و”عزيزة فتحي” و”زوبة الكلوباتية” التي فاقتهن شهرة لأنها كانت تجيد الرقص وهي تحمل الشمعدان على الرأس بحيوية.
ويبدو أن تحدي “مريم” الراقصة كان فتحًا لكي تمارس باقي الراقصات من بعدها تحديات أخرى تتشابه جميعها في تحدي السلطة والرقابة، فشفيقة القبطية رغم أنها كانت مسيحية ولم تواجه هذا النقد لامتهانها الرقص في البداية لكنها تحدت كما يقول التعبير الدارج “أكبر رأس في البلد” أي الخديوي عباس حتى أنها كانت تواجهه مواجهة الند للند وفي أحيانًا كثيرة كانت تكسب معاركها ضده، لما تمتعت به من سلطة كراقصة جماهيريًا ووسط بشاوات هذا العصر.
ففي كتاب “شفيقة القبطية” للكاتب جليل البنداري، والذي تحول فيما بعد إلى فيلم سينمائي بطولة هند رستم، يتحدث في كتابه عن قوة شفيقة وصلابتها في مواجهة السلطة قائلًا: “كانت شفيقة القبطية أول امرأة من عامة الشعب في عصرها تتحدى الخديوي، فقد كانت تجوب شوارع القاهرة بالعربة الفخمة الموشاة بالذهب التي تجرها ستة خيول مطهمة، وبجوار كل جواد قمشجي يلبس الطربوش الأحمر المغربي ذا الزر الطويل، ويتقدم العربة اثنان من القمشجية يفسحان الطريق للموكب صائحين “وسع يا جدع”.
كان موكب شفيقة القبطية صورة طبق الأصل من موكب الخديوي عباس، وكان الناس يصفقون لها في الشوارع مثلما يصفقون للجالس على العرش عباس. لذلك حقد عليها الخديوي وأرسل لها من يأمر بتسليم موكبها للخديوي، إلا أنها رفضت، واشترت عربة أخرى بيضاء مذهبة لتركبها بالنهار نكاية في الخديوي بجوار عربتها السوداء الموشاة بالذهب التي كانت تركبها بالليل.
يتحدث جليل البنداري عن سلسلة طويلة من مظاهر تحدي السلطة في وقت كان من الصعب على “أتخن شنب” أن يتحدى عائلة أسرة محمد علي. ويذكر جليل البنداري أيضًا أن شفيقة القبطية اعترضت على استخدام السودانيين والنوبيين المصريين كخدم في قصور أسرة محمد علي، وردّت على ذلك بأن استخدمت فتيات شركسيات -أسرة محمد علي شراكسة- شقراوات في قصرها بحارة السقايين وفي صالة “ألف ليلة” التي كانت تملكها في مكان سينما رمسيس الآن بميدان العتبة.
يذكر جليل البنداري في كتابه بدايات ولع شفيقة القبطية بالفن، وللمفارقة أن ولعها الأكبر كان بالغناء والعزف على العود، كانت شفيقة متزوجة من موظف بسيط في السكة الحديد، يسيء معاملتها لغيرته الدائمة عليها، ولرغبته في كبح جرئتها الواضحة في الملبس والحديث، فقد كانت شفيقة ترفض لبس البرقع مثلما اعتادت النساء في ذلك الوقت، وكانت تتمايل في ملاءتها اللف مكشوفة الشعر والرقبة والساقين، وكانت تلتهي عن قسوة زوجها بالغناء أثناء غسل ملابسهما في الطشت، حتى سمعها الشيخ حسن أحد جيرانها وبدأت شفيقة مرحلة تعلم العزف العود على يديه بشكل احترافي.
يذكر الكتاب كيف تعلقت شفيقة القبطية بدراسة العود حتى غار زوجها ابراهيم من هذا التعلق وكسر على رأسها العود أكثر من مرة، وظلت شفيقة متشبثة بصوتها وعودها وجسدها المتمايل تنتمي أكثر إلى عالم فني متكامل استطاع أن ينتشلها من عنف زوجها حتى اختارت الفن وهجرت زوجها في عزبة نخلة إلى رحاب شارع محمد علي.
وبالتوازي مع الفترة الزمنية التي تألقت فيها شفيقة القبطية، أو قبلها بقليل، جاءت الراقصة اللبنانية بديعة مصابني إلى مصر، لتؤسس كإمرأة أول صالة في ثلاثينات القرن العشرين وتتحدى احتكار الرجال وبالأخص الخواجات لإنشاء الصالات والملاهي الليلية، ولم تكن بديعة مصابني تهدف فقط لتحقيق الربح من خلال الرقص والطرب، بل هدفت إلى تعليم فنون الرقص على أصوله وتخريج راقصات من ملهاها، أبرزهن سامية جمال، حتى أن بديعة مصابني أدركت أهمية السينما وقررت أن تجعل للراقصات دورًا مؤثرًا فيها.
بديعة مصابني التي تعرضت لحادثة اغتصاب مؤلمة في مراهقتها جعلت طريقة تعاطيها مع جسدها اشكالية، فبعد مرحلة نبذها لجسدها الجميل الذي سبب لها مأساة عائلية بعد اغتصابها ثم قيام أخيها بقتل صديقه مغتصبها وتشتت العائلة بين أمريكا ومصر فوجئت بديعة بأن جسدها ظلم بشكل كبير وبعد وقوعها في الحب عرفت معنى نسيان الماضي واعادة الاعتبار للجسد واعطاءه المساحة لكي يبوح هو بآلامه ويمضي في اتجاه خلاصه وكان الرقص هو اللغة التي تمكن بها جسد بديعة مصابني من البوح والتطهر.
حاولت مصابني أن تنتج أفلام استعراضية و فشلت كمنتجة، لكن مبادرتها استمرت، وأصبحت الراقصات يأخذن أدواراً رئيسية في أفلام سينمائية، منهن الراقصة كيتي وتحية كاريوكا وسامية جمال وغيرهن، وتم انتاج فيلم عن بديعة مصابني في السبعينات بطولة نادية لطفي.
كلما كان يزدهر وضع السينما في مصر والصحافة كلما كان ذلك لصالح الراقصات، فقد كانت حياتهن تُكتب بشغف وأحيانًا كانت هذه الكتابات يملؤها المبالغات والخيال والأساطير، وإلى جانب ذلك كان يملؤها التطعيم بالمواقف التي تنم عن الحس الوطني ولا ندري هل كان إلصاق الوطنية ببعض الراقصات كان طبيعيًا أم محاولة لتعزيز صورتهن أمام أعين المثقف والسياسي المتعالي عن النظر للرقص الشرقي بجدية.
فقصة تحية كاريوكا لا يمكن النظر لها ليس فقط باعتبارها من أهم الراقصات المصريات على مدار تاريخ الرقص بشكله الحديث فقط، بل باعتبارها أيضا راقصة اهتمت بقضايا محورية أهمها قضايا النقابات حتى ارتفعت ربما في نظر بعض المفكرين العرب كي ينظروا لها بجدية، وهو ما يطرح السؤال؛ هل ينبغي للراقصة أن يكون لها دورًا مجتمعيًا لينظر إلى مشروعها الفني بجدية أكثر؟ وهل كانت هناك راقصات على شاكلة كاريوكا لم ينلن هذا الحظ من جدية التناول لأنهن لم يحملن همّاً اجتماعيًا أو وطنيًا.
التعاطي مع قصة تحية كاريوكا شهد هذه الازدواجية الواضحة. صحيح أن تحية كاريوكا نالت اهتمامًا واضحًا أثناء حياتها، و بعد وفاتها، بعد المقال -المرثية الذي كتبه إدوارد سعيد، لكنها أُخذت على محمل الجد بعدما بدأت في الدخول في سلسلة وقائع سواءً فنية أو سياسية لها علاقة بالجدل السياسي وقتها، بداية من مشاركتها في نمط المسرح الانتقادي بالتمثيل والرقص في عدة مسرحيات تنتقد الأوضاع السياسية والاجتماعية مثل مسرحية “يحيا الوفد” ثم سلسة من “التعلب فات” “البغل في الابريق” “كدابين الزفة” “روبابيكيا” ، فكانت هذه الأدوار كافية لإحداث جدل يسلط الضوء عليها كراقصة، ثم دعمها لحقوق نقابة المهن التمثيلية، مما جعل أقلام كتاب كبار مثل إحسان عبد القدوس ومصطفى أمين وصالح مرسي يكتبون عنها.
حتى وصفها محمد عبد الوهاب بأنها “حررت الرقص الشرقي من تأثير الأجنبيات – الأوروبيات والشاميات- مثلما حرر سيد درويش الموسيقى المصرية من تأثير الأتراك” وهو ما يعد مجاملة فيها من المبالغة ما يقصي تجربة شفيقة القبطية ونعيمة عاكف وسامية جمال وزوبا الكلوباتية ومريم وغيرهن من الراقصات المصريات السابقات على تحية والمعاصرات لها.
تحية كاريوكا كانت حالة فنية من الصعب تجاهلها، لكن الوقائع الأخرى تقول أن التعاطي معها لم يخل من النفاق السياسي، ففي واقعة شهيرة وثقها الصحفي فوميل لبيب (1929- 1988) في كتاب “نجوم عرفتهم” بين تحية كاريوكا وجليل البنداري( 1917- 1968) ؛والذي يعد من أهم النقاد الفنيين في الخمسينات، كان قد وصفها البنداري تحية بالعالمة التي حولت شارع كورنيش النيل في الجيزة حيث كان يقع الملهى الخاص بها (مكان فندق هيلتون الحالي) إلى “حوش بردق” و”عشش الترجمان” بعدما اختار أحمد شوقي نفس الشارع ليقيم كرمة ابن هانيء جنة شعره ومكان إقامته وحياته، في مقارنة واضحة أجراها البنداري بين نمطين فنيين الرقص والشعر، ليسقط الرقص من معادلة البنداري.
وذكرت الصحف كيف أقسمت تحية كاريوكا على ضرب البنداري “علقة سخنة”، وفشلت محاولات الصلح لإنهاء مطاردات تحية للبنداري بالسيارة قائلة “اضربه الأول قبل الصلح”.
وفي واقعة ترشيح فيلم “شباب امرأة” لتمثيل مصر في مهرجان كان السينمائي عام 1956 بطولة تحية كاريوكا، أحدث ترشيح الفيلم جدلًا واضحًا؛ هل يستحق ترشيحه للعرض في المهرجان أم أنه سيسيء لسمعة مصر! وقتها حسم عبد الناصر الجدل وعرض الفيلم على لجنة برئاسة حسين فوزي للإدلاء بالرأي، فوافق الأخيرة بعد جدالات.
تعامل تحية كاريوكا مع الرقص كان نفس تعاملها مع التمثيل فقد كانت ترى الرقص وسيلة للإقناع برسالة معينة تحاول إيصالها من خلال البانتومايم، وقد كانت تشعر أنها من خلال الرقص تقوم بمهمة الإنسان الأول منذ بداية التاريخ الذي كان يعبر من خلال الرقص عن كل آلامه وأفراحه تقول في إحدى حواراتها” الحصاد كان له رقص والجنائز لها رقص والمطر له رقص، الرقص ساعدني على أن تصبح أذني موسيقية كما أن الرقص عموما يجعل المرأة جميلة حتى لو كانت في الواقع غير جميلة الرقص مش هز وإثارة ولا يقل عن رقص البالية”.
الراقصات يتعرضن لسلطة وحصار ليس فقط مجتمعي وسياسي ويحاولن التمرد عليه، لكن أحيانًا تكون هذه السلطة من داخل الوسط الفني والوسط الثقافي، فهناك واقعة تشير إلى طريقة تعاطي أصحاب الوسط الفني الواحد مع الراقصات، ففي حكاية سردتها الراقصة سهير ذكي في خلاف جمعها مع أم كلثوم، حينما قررت سهير ذكى الرقص على أغنية “أنت عمري” فغضبت أم كلثوم من أن تؤدي راقصة نمرتها على أغنية من أغانيها، لكن بعد وساطة من عبد الوهاب ذهبت أم كلثوم لتقيّم رقص سهير ذكي، لترى إن كانت ستقاضيها وتمنعها من الرقص على أغانيها أم ستقبل هذا التعاون الفني بين حنجرة أم كلثوم وجسد سهير ذكي، إلا أن الأخيرة نجحت في اختبار الست، فمنحتها أم كلثوم السماح على مضض.
لا أدري إن كان من الصائب إطلاق مصطلح سلطة الانفتاح للنظر للتحديات التي واجهت الرقص الشرقي مصريًا بشكل خاص بعد مرحلة الانفتاح الاقتصادي. صحيح جاءت موجة اعتزالات فنية كبيرة لكن لا يمكن حسم سبب الاعتزال إن كان ديني صرف أم بسبب تقدم في العمر لكن إلى جانب اعتزال نجوى فؤاد وسهير زكي وسامية جمال غير الديني، لمع نجم عدة راقصات منهن فيفي عبده ودينا.
فيفي عبده ودينا تحديدًا يبدو أنهما تأثران بشكل كبير بهذه الموجة الانفتاحية وبدا رقصهما أبعد من مربع تحية كاريوكا أو سامية جمال، و بشكل أدق هن تأثرن ببعض الحركات الخليجية الراقصة، من المبالغة في لف الشعر في الهواء على شكل دوائر، و تأثرهن برقصات أشبه بالباليه و والرقص على مساحات أوسع والقفز، ليبدو رقصهن ممتزجًا بالحماسة الواضحة، وحركة الأيدي وتحدي الخفة، وهو نمط الرقص الشبيه برقص الاجنبيات الذي لا يعتمد على”ثقل الجسد الذي يسمح للراقصة بتثبيت موقعها على الأرض بشكل متزايد وكأنها تحفر مكانا فيه”. بحسب ما كان يصف إدوارد سعيد طريقة رقص تحية كاريوكا.
الراقصات الجدد رفضن الرقص تحت عباءة تحية كاريوكا وزمنها بإيقاعه الهادئ و رقصها العمودي وليس الأفقي، أو كأن الرقص الأفقي أصبح متناسب بشكل موضوعي مع هذا العصر الذي بدا يستهلك الإنسان بطريقة متسارعة حتى بدا الانسان موتوراً يلهث وراء المادة والفرص ليبدو ضائعاً وتائهاً في اتجاه أفقي أشبه بنمط الرقص الأفقي المتسق بشكل كبير مع عصره.
فيفي عبده أو سكاكر السكر تتحدى هنا سلطة الجمهور وهي ليست على خلاف مع سلطة سياسية أو سلطة فنية بقدر ما تحاول التمرد على سطوة الجمهور الذى يسخر منها احيانًا ويطالبها بالاعتزال وتتحدى هي هذه الدعوات بالاستمرار بالرقص بشكل يومي ليس فقط في المناسبات، بل على صفحتها الشخصية على انستجرام. فيفي عبده الراقصة أنثى برج الثور- الحسية تمامًا بالغة الذكاء في التواصل مع لغة جسدها- لن تستطيع ببساطة التوقف عن الرقص، لأنها لازالت تتمتع بروح الراقصة بغض النظر عن الإمكانات الجسدية، فهذه الروح المتشبثة بالإيقاع الغارقة فيه والمنتشية به، تسمح لها بالاستمرار، متحدية من يصر على أن يرى الراقصة إمكانات جسدية فقط.
خارج صالات الرقص هناك رقص شرقي يعيش محاصرًا، رغم ولع المجتمع المصري بالرقص في الخفاء “بدلة الرقص قطعة أساسية في تجهيز العروس المصرية” إلا أن العائلات لازالت تنظر للرقص الشرقي في المجال العمومي بشيء من الوصمة الاجتماعية، ورغم ذلك يبدو هذا الصراع الذي جسده فيلم “خلى بالك من زوزو” قائما على أرض الواقع بشكل كبير، فقد تعرفت أثناء العمل على هذا التحقيق على أكثر من زوزو، فتيات مثقفات خريجات جامعة يعشن تيمة “زوزو” ببراعة.
سلمى الديب طبيبة مصرية كانت مشغولة طوال أيام أعداد هذا التحقيق بالسهر في النبطشية داخل المستشفى بقسم الطوارئ، وبعد أن حصلت على متسع من الوقت حدثتنا عن ولعها بالرقص الشرقي، هذا الرقص الذي كان خلاصها في أوقات كثيرة من الاكتئاب حتى نظمت ورشات لتعليم الرقص الشرقي بجوار مهنة الطب التي تمارسها بشكل منتظم.
تقول سلمى الديب في تصريحات لدرج: “كنت أرى عمتي منذ صغري ترقص في خطوبات صديقاتها وأعراسهن. كنت أرقص معها وعمري 4 سنوات، لم تتعرض عمتي ولا أنا وقتها للنبذ، كان الأمر ممتعًا وكبرت وأنا أحب الرقص ولم أره أبدًا شيئًا سيئًا، وحينما قررت دخول كلية الطب أدركت أهمية الرقص نفسيًا في علاج الاكتئاب باعتبار الرقص صديق مخلص للجسد”.
تضيف سلمى؛ حينما نظمت ورشات لتعليم الرقص الشرقي لاحظت أن أغلب المشاركات يرغبن من خلال الرقص في محاربة صراع ما داخلي، فبدأت بإدخال ما يسمى بالعلاج بالرقص والحركة، وذلك لمساعدة النساء على الخروج من منطقة الأمان والراحة التي يحصرهم فيها المجتمع.
تشير سلمى أن الرقص الشرقي يتعرض دائمًا للوصم لأن مجتمعاتنا توصم من الأساس جسد المرأة، ولأن الرقص معتمد بشكل كبير على لغة الجسد الأنثوي فهو موصوم بالتبعية، وزاد على ذلك ما تحاول الراقصات الاجنبيات اليوم فعله من مبالغة في الإغواء أثناء الرقص، مما يسمح للمجتمع بأن يجد مبررًا ليتمادى في وصم الرقص بشكل أكبر.
غدير أحمد الناشطة النسوية تعرضت منذ عامين تقريبًا لتسريب فيديو لها وهي ترقص، كان التسريب يهدف بشكل كبير إلى محاولة وصمها اجتماعيًا، لكن غدير كانت تدرك اللعبة جيدًا فردّتها بمنتهى الذكاء بنشر فيديوهات رقص شرقي لها، لتقول إنها ليست مرمى للوصم الاجتماعي والرقص الشرقي فنًّا تعتز به وتستمر إلى اليوم في نشر فيديوهات رقص شرقي على صفحتها على انستجرام تبدو فيها منسجمة تمامًا مع جسدها وايقاعاته وكأن محاولة الوصم الفاشلة ساعدتها على أن تخوض تجربة التعبير الراقص بالجسد في المجال العمومي بشجاعة.
إيناس كمال الصحفية في قسم الفن ترى أن الرقص الشرقي لا يعد ولا يدعو بأي شكل لأي فكرة تحررية فهو منذ ظهوره وهو مقترن بالإمتاع خاصة من نساء الحرملك لإمتاع الملوك والسلاطين، ولم يكن يمثل من جذوره أو جوهره أفكار تحررية مثلما تمثل رقصات أخرى مثل التانجو والصالصا”.
كانت إيناس ترى أن أي دعوة لتنظيم حفلة رقص شرقي بفاعلية الفن ميدان أثناء الثورة، هو ابتذال للقضية ببساطة، وبناء عليه “أنا لا أستطيع أن احترم الرقص الشرقي رغم كونه فناً مثلماً احترم قصيدة شعرية أو رقصة تعبيرية”.
ظهور ناشطات نسويات مصريات يرقصن في فيديوهات على صفحاتهن الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي تراه إيناس لا يخدم القضية النسوية “النسوية المفروض تعبر عن قضايا الستات الأهم، ولا أرى أهمية قصوى لمناقشة موضوع مثل هل الرقص حق للمرأة في جسدها ولا لأ”.
تعرضت الدكتورة منى برنس المدرسة بقسم اللغة الانجليزية بكلية الآداب جامعة قناة السويس للعزل من التدريس في الجامعة العام الماضي ردًا من رئيس الجامعة على الفيديوهات التي تنشرها على صفحتها الشخصية وهي ترقص في منزلها، ورغم أن منى برنس ترقص عادة مرتدية العباءة المصرية المنزلية التي لا تكشف في العادة مفاتن الجسد إلا أن تمايل جسد الدكتورة الجامعية مع إيقاع الموسيقى كان كفيل بأن يثير غضب الأكاديميين الجامعيين، ليعقدوا مجلس تأديبي يقرر في النهاية فصلها من الجامعة، وتواصل منى برنس حتى بعد فصلها نشر فيديوهات راقصة معلقةً “الرقص حريتي”.
الكاتبة والممثلة والراقصة المسرحية نورا أمين تعرضت هي أيضًا لنوع من محاولات القمع لأن مهنتها على جواز السفر “راقصة”، وهي واحدة من الأعضاء المؤسسين لفرقة “الرقص المسرحي الحديث” بدار الأوبرا، وأجبرها موظف الأمن بمطار القاهرة على تغيير المهنة في جواز السفر من راقصة إلى خريجة ليسانس آداب قسم لغة فرنسية، في حكاية طويلة سردتها في كتابها “تهجير المؤنث”.
تقول نورا أمين في كتابها “تعاني الثقافة المصرية من ازدواجية واضحة عندما يتعلق الأمر بصورة الراقصة الشرقية، فالجمهور المصري مفتون بالرقص الشرقي عبر العصور وبحسية صورة الجسد الأنثوي في رداء الرقص… في مصر يعشق كل رجل وامرأة الفرجة على الرقص الشرقي وعادة ما تجرب غالبية النساء الرقص في منازلهن أو بصحبة صديقاتهن المقربات، إلا أن الجميع لن يتورع عن إدانة من يمارسنه في هذا المجال العمومي أو كمهنة”.
درج