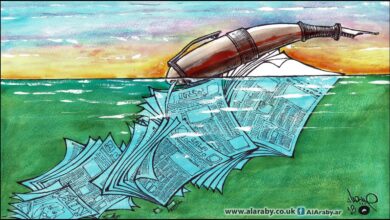مدينة الوحدة: مغامرات في فن الوحدة

الوحدة تكون على المستويين الشخصي والسياسي كذلك، فالوحدة جماعية.. ونحن نعاني منها معًا، حيث ذلك الركام من الندبات.. ولكن ما يهم في النهاية هو طيبة القلب، ما يهم هو التضامن.
“كل شخص يولد بمفرده، ويموت بمفرده. وقيمة المساحة بين هذين المصيرين هي الثقة والحب.”
هكذا كتبت الفنانة لويس بورجوا في يومياتها في نهاية حياتها الطويلة والحافلة وهي تتأمل كيف أن الخلوة تثري العمل الإبداعي. إنها وجهة نظر رائعة، ولكن ورغم ما فيها من دعم للراغبين في اعتناق الخلوة، إلا أنها قد تؤدي إلى وحدة عميقة بالنسبة لأولئك الذين قلصت الوحدة لديهم تلك المساحة من الثقة والحب وجعلتها سجنًا خانقًا. ففي الخلوة كما يقول الروائي الأمريكي ويندل بيري بكلماته الخالدة “يمكن سماع أصواتنا الداخلية، كما يمكن أن نستجيب على نحوٍ أكثر وضوحًا لحياة الآخرين.”، أما في الوحدة وهي شيء آخر عن الخلوة فترتفع أصواتُ صرخاتنا الداخلية حتى تصم الآذان، صرخات مميتة، وتقطع أي خيط للاتصال مع حياة الآخرين.
كيف يتحرر المرء من هذا السجن ويسكن من جديد في مساحة الثقة والحب؟ هذا هو ما تستقصيه الكاتبة الأمريكية أوليفيا لاينغ في كتاب مدينة الوحدة: مغامرات في فن الوحدة. وهو كتاب رائع، ولا يقتصر على مجرد يوميات، فهو نوع من اليوميات وأكثر من ذلك، ويمثل وسطًا بين كتاب الكاتبة الإنجليزية هيلين ماكدونالد يوميات صقر ويوميات الكاتبة الإنجليزية فيرجينيا وولف، يمثل حكاية غنائية عن الخوض في فترات من اغتراب الذات، على المستويين المادي والنفسي، وفيه ترسم لنا لاينغ لوحة حميمية عن الوحدة بوصفها “مكانًا مأهولًا، ومدينة في حد ذاتها.”
نرشح لك: جون شيفر: آلام الوحدة وكيف تثري الجمال والهياج الإبداعي في مرحلة الشباب
فبعد الانهيار المفاجئ لقصة حب تميزت بالبهجة الشديدة غادرت لاينغ بلدها الأصلي إنجلترا، وذهبت وقلبها منفطر إلى نيويورك: “تلك الجزيرة المزدحمة بالصخر الصواني والخرسانة والزجاج.” فكان الإحساس اليومي والعميق بالوحدة التي عاشتها هناك يصيبها بالشلل من فرط قوته وتأثيره. ولكنه في الوقت ذاته كان يدعوها على نحوٍ غريب للحياة، ومن المؤكد أن اختيارها مغادرة المنزل والتجول في مدينة أجنبية يُعد في حد ذاته مجازًا خصبًا عن طبيعة الوحدة المتناقضة التي تقوم على قدر متساوٍ من الهياج والخدر، إذ يمكنها أن تحول الشخص إلى متشرد بمِلْء إرادته، تحوله إلى شخص منعزل لا يقدر على الحياة في الوقت ذاته، ولكنها تُعد أيضًا مختبرًا مفعمًا بالحيوية لاكتشاف الذات إلى حدٍ ما، فكان من الممكن أن تؤدي بها تلك الوحدة التي عانت منها إلى “تأمل بعض القضايا الأكثر أهمية المتعلقة بمعنى الحياة.”
فهي تقول:
“كان ثمة بعض الموضوعات التي تؤرقني، ليس فقط بوصفي فردًا،ولكن بوصفي مواطنة في هذا القرن، حيث العصر الذي ماتت فيه الفردية، فما معنى الوحدة حينها؟ كيف نعيش إذا لم نرتبط عن قرب بغيرنا من البشر؟ وكيف نرتبط بالآخرين لاسيما ونحن يصعب علينا الحديث؟ هل الجنس علاج للوحدة؟ وإذا كان ذلك صحيحًا فماذا يحدث إذا كان الجسد أو النشاط الجنسي شاذًا أو مريضًا، أو إذا كنا نعاني من المرض أو حُرمنا من نعمة الجمال؟ وهل التقنية تساعد في تلك المسائل؟ هل تقربنا من بعضنا البعض أم أنها على العكس تحبسنا خلف الشاشات؟
وفي ظل هذا الألم العاطفي الحاد تسعى لاينغ لتعزية نفسها برفقة عدد من المبدعين العظماء الذين عانوا من الوحدة في ظل الثقافة الإبداعية في القرن العشرين، ومن بين تلك المجموعة الانتقائية من المنعزلين التي تشمل الرسام الأمريكي جان ميشال باسكيال، والمخرج السنيمائي الأمريكي ألفريد هيتشكوك، والمصور الأمريكي بيتر هجر، ومغنية الجاز الأمريكية من أصل أفريقي بيلي هوليداي، والمصورة الأمريكية نان غولدين، تختار لاينغ أربعة فنانين لترافقهم في رسم خريطة لتلك الأرض المجهولة التي تسمى الوحدة: الرسام والنحات الأمريكي إدوارد هوبر، والفنان الأمريكي آندي وارهول، والفنان الأمريكي هنري دارغر، والرسام والمصور الأمريكي دافيد ووجنارويكز، إذ كانوا جميعهم “في صراع مع الوحدة والمشكلات المصاحبة لها في حياتهم وكذلك في أعمالهم.”
وتتأمل على سبيل المثال في الفنان الأمريكي آندي وارهول، الذي كان من الفنانين الذين كانت تصرف النظر عنهم حتى غرقت في الوحدة هي نفسها، (“لقد رأيت تلك البقرات المطبوعة بشاش الحرير والرئيس ماوز ألف مرة، وفكرت أنهم فارغون ولا حياة فيهم، وتغاضيت عنهم كما نفعل غالبًا مع تلك الأشياء التي ننظر إليها ولكن لا نراها على حقيقتها.”) فتقول:
“إن فن وارهول يمشطّ الفراغ بين البشر، ويجري استقصاءً فلسفيًا كبيرًا عن القرب والبعد، والحميمية والاغتراب. كان هذا الفنان لا يختلف عن الكثير ممن عانوا من الوحدة فكان يجمع الأشياء بعناد، و يحيط نفسه بالأشياء، والحواجز التي تحميه من الألفة مع البشر، كان يخاف من الاتصال الجسدي فنادرًا ما كان يغادر المنزل دون أن يحمي نفسه بدرعٍ من الكاميرات والمسجلات، ويستخدمها للتفاوض على التفاعل مع البشر أو منعهم: وهو سلوك يوضح لنا كيف نستخدم التقنية في هذا القرن الذي يتميز بما نسميه الاتصال”.
كانت لاينع تبحث في طبيعة الحياة لدى هؤلاء الفنانين الأربعة، وأعمالهم، وسياق تلك الحياة، وتلك الأعمال، وخلفية تلك الحياة ومنجزاتها التي امتلأت بالوحدة، وكان ذلك البحث جزءًا لا يتجزأ من نسيج خبرتها الشخصية، ولكن من الظلم أن نسمى رائعة لاينغ “يوميات” وحسب، ومن الظلم كذلك أن نسمي تلك الموضوعات “تاريخ الفن”، لأنها بالأحرى العكس، إنها نوع من “حاضر الفن”، فهي تأملات رائعة وتتسم بالمعرفة الواسعة، وتتناول كيف يكون الفن حاضرًا معنا، وكيف يدعونا إلى أن نكون حاضرين مع أنفسنا، وكيف يصبح شاهدًا على هذا الحضور، ويخفف من وحدتنا كذلك.
تتطرق لاينغ إلى ذلك النوع الخاص من الوحدة ذلك الشكل الذي ينتشر في مدينة تعجّ بالبشر فتكتب:
تخيل أنك واقف بجانب النافذة ليلاً في الطابق السادس أو السابع عشر أو الثالث والأربعين في أحد المباني، ستَظهر لك المدينة كمجموعةً من الخلايا، مئة ألف نافذة، بعضها مظلم، وبعضها الآخرمغمور بالضوء الأخضر أو الأبيض أو الذهبي، وبالداخل يتحرك غرباء جيئة وذهابًا وهم يقومون بأعمالهم الخاصة، يمكنك رؤيتهم ولكن لا يمكنك الوصول إليهم. وهكذا فإن هذه الظاهرة الحضرية الشائعة الموجودة في جميع المدن في العالم في كل ليلة تصيبنا جميعًا بقشعريرة الوحدة حتى لأولئك الأكثر اختلاطًا، واجتماعية بيننا، إنها خليط مضطرب من الانفصال والاتصال.
يمكن لنا أن نصاب بالوحدة في أي مكان، ولكن للوحدة التي تأتي من العيش في مدينة وأنت محاط بملايين البشر طعم خاص، وقد نظن أن تلك الحالة تناقض الحياة الحضرية، وتناقض وجود أعداد هائلة من البشر غيرنا، ولكن الجوار بالجسد فقط لا يكفي أبدًا لطرد الإحساس بالعزلة الداخلية، فمن الممكن بل ومن السهل كذلك أن تشعر بالكآبة والهجر من الداخل، حتى وإن كنت تعيش مع الآخرين بتلاصق. فقد تتحول المدن إلى أماكن موحشة، وعند الإقرار بذلك فإننا نرى أن الوحدة لا تتطلب بالضرورة العزلة المادية، فهي عبارة عن غياب أو ندرة في الاتصال والقرب والقرابة: إنها عدم القدرة -لسببٍ أو لآخر- على العثور على القدر المطلوب من الحميمية، إنها التعاسة نتيجة عدم الصحبة، وفق التعريف المعجمي، ولا عجب إذًا في أنها قد تصل إلى ذروتها وسط الحشود.
وبعد تلك الاكتشافات المتواصلة للعلماء بخصوص التأثيرات الفسيولوجية للوحدة لن يكون مدهشًا أن يكون لتلك الحالة النفسية أثر جسدي، وهو ما تعبر عنه لاينغ بوضوح:
ما هو الشعور بالوحدة؟ إنها تشبه الجوع: الجوع في الوقت الذي تجد فيه الجميع من حولك يحضّرون لوليمة، إنها شعور الخزي والرعب، وبمرور الوقت تخرج تلك المشاعر إلى الخارج، فيصبح المصاب بالوحدة منعزلًا تدريجيًا، ومغتربًا تدريجيًا، إنها مؤلمة، بذلك الألم الذي تسببه المشاعر. كما أن لها أيضًا نتائج جسدية تعمل بخفية داخل الغرف المغلقة للجسد، إنها تتطور، وهذا ما أحاول قوله، إنها باردة كالثلج، وواضحة كالزجاج، وتحيط بنا وتبتلعنا.”
ولكن ثمة فرق كبير بطبيعة الحال بين الخلوة والوحدة، إنهما توجهان نفسيان مختلفان تمامًا تجاه الظروف الخارجية ذاتها المتمثلة في عدم الصحبة، إننا نتحدث عن “الخلوة المثمرة” بوصفها تعبيرًا عن الإنجاز الذي حققناه في تطوير أنفسنا، ذلك الإنجاز الذي لا غنى عنه لقدرتنا الإبداعية، ولكن الوحدة عقيمة ومدمرة، إنها تغلف إرادة الإبداع باللامبالاة، والأكثر من ذلك أنها تبدو علامة على الخلل الوجودي، إنها وصمة عار اجتماعية، وتتطرق لاينغ إلى المعاني الدقيقة لتلك الوصمة على نحو رائع فتضيف:
“من الصعب الاعتراف بأنك وحيد، ومن الصعب كذلك تصنيف الوحدة، إنها مثل الاكتئاب الذي غالبًا ما تتشابه معه، فبإمكانها التغلغل بعمق في نسيج الشخص، فهي تمثل جزءًا لا يتجزأ من كيان الإنسان مثل الضحك بسهولة، أو التمتع بالشعر الأحمر.ويمكن أن تكون عابرة أيضًا، تأتي وتذهب كرد فعل للظروف الخارجية المؤقتة، مثل تلك الوحدة التي تأتي في أعقاب الفقد أو الانفصال أو تغيير الأوساط الاجتماعية.
إنها مثل الاكتئاب أو الكآبة أو القلق تحكمها قواعد علم الأمراض، فيمكن اعتبارها مرضًا، ويُقال على وجه التأكيد إن الوحدة لا تخدم غرضًا.. ولعلي أكون مخطئة هنا، لكني لا أعتقد أن أي خبرة تُعد جزءًا من حياتنا المشتركة بهذا القدر يمكن أن تخلو من المعنى بشكل كامل، دون أن يكون لها نوع من الثراء والقيمة.”
وباهتمام بالغ وهي تُسلط انتباهها على الكاتبة الإنجليزية فيرجينيا وولف ويومياتها الرائعة التي لا تُنسى عن الوحدة والإبداع تقول لاينغ متأملةً:
“قد تدفعك الوحدة إلى اكتساب خبرة للواقع لا يمكنك الحصول عليها بأي طريقة أخرى”.
وحيدة بلا هدف في مدينة تبشّر قاطنيها “بهدية الخصوصية ومتعة المشاركة”، تتذكر لاينغ ذلك الشعور وهي تتنقل بين مجموعة متنوعة من المنازل المؤقتة: شقق مستأجرة من الباطن، وشقق الأصدقاء، والعديد من المساكن المؤقتة. وأثناء ذلك كانت لا تشعر سوى بزيادة ذلك الإحساس بالغربة، والاغتراب لأنها مجبرة على أن “تعيش بين متعلقات الآخرين، في منزل بناه شخص آخر منذ زمن بعيد.”
لكننا نرى في ذلك مجازًا للحياة ذاتها ولا مهرب منه، فنحن على أية حال نستأجر وجودنا ذاته من الباطن من المدينة، والمجتمع، والعالم الذي ظل موجودًا لفترة أطول بكثير منا. ذلك العالم المنظم بالفعل بطريقة قد لا تروقنا، بتصميم يختلف عن تصميم المبنى، وديكوراته فيما لو كنا نحن من قام بتصميمه من العدم بأنفسنا. لكنهم تركونا لنستريح كما لو كنا في منزلنا، وعلى الحال الذي كانت عليه تلك الأمور: ناقصة وفي بعض الأحيان قبيحة تمامًا. إن أسلوب الحياة يجب ألا ينفصل عن تلك القدرة على التأجير من الباطن، يجب ألا ينفصل عن مدى قدرتنا على الاستقرار في هذا المنزل المستعار الناقص، ومدى الجمال الذي يمكننا أن نضفيه على الوجود مهما كانت سيطرتنا ضعيفة على تصميم هذا الوجود.
ولعل هذا هو على الأرجح السبب في أن لاينغ وجدت الراحة الوحيدة -وإن كانت مؤقتة- من الوحدة في ذلك النشاط الذي تحفزه المغادرة من ذلك المنزل المستعار ذاته: إنه المشي، ففي إحدى الفقرات التي تذكرنا بكتاب اللحن الرائع لغذاء الروح بالمشي للمؤلف السويسري الشهير روبرت فالسر فنجدها تقول:
“في بعض الأحيان يكون الخروج وعدم الملاءمة مصدرًا للرضا بل والمتعة، فثمة أنواع من الخلوة تمثل راحة من شعور الوحدة: قُل إنها تمثل إجازة من الوحدة إن لم تكن علاجًا لها. ففي بعض الأحيان وأنا أسير متجولةً تحت دعامات جسر ويليامزبيرغ أو على ضفاف إيست ريفر حتى مبنى الأمم المتحدة الفضي الضخم، يكون بمقدوري نسيان ذاتي الحزينة، فأتحول عندها إلى كيان شفاف لا حدود له مثل الضباب، وأسبح بمتعة فوق تيارات المدينة.”
ولكن مهما كانت تلك الذات الداخلية متمتعةً بأكثر مراحلها صلابةً، تلك الصلابة التي نحصل عليها خلال فترات الهروب إلى الخلوة بالمشي والتنقل، فإنها تظل صلابةً هشة:
“لم أكن أشعر بذلك الإحساس عندما كنت في شقتي، فقط عندما أخرج أشعر به، عندما أكون بمفردي تمامًا أو غارقة وسط الحشود.ففي تلك الحالة أشعر أنني تحررت من ذلك العبء المتواصل للوحدة، ذلك الإحساس بالخطأ، والاهتياج بسبب وصمة العار، وأحكام الآخرين، والظهور. ولكن ذلك الشعور لم يدم طويلاً إذ سرعان ما تحطم وهم نسيان الذات، إذ لم يكن من الصعب أن أعود ليس فقط إلى ذاتي، ولكن إلى ذلك الإحساس المألوف والموجع بالاحتياج أيضًا.”
لقد وجدت لاينغ نفسها مشدودة إلى الفنانين الذين أصبحوا رفقائها في تلك الرحلة نحو الوحدة وبعيدًا عنها في الوقت ذاته، وذلك عبر تلك الفجوة بين نسيان الذات واكتشاف الذات. لقد ترك لنا الرسام والنحات الأمريكي إدوارد هوبر ذلك العمل الشهير والرمزي الذي يحمل اسم طيور الليل المتوهجة بذلك الضوء المخيف، وعن ذلك الفنان وذلك العمل تكتب لاينغ:
“لا يوجد في الوجود لون يدل بتلك القوة على الاغتراب في المدن، وتفكك البشر داخل تلك المباني الضخمة التي يقومون ببنائها بأنفسهم، مثل ذلك اللون الأخضر الشاحب البغيض، فلم يظهر إلا مع ظهور الكهرباء، ويرتبط على نحو معقد بالمدينة في الليل، تلك المدينة المشكلة من الأبراج الزجاجية، والمكاتب الفارغة المضاءة، ولافتات النيون.
[…]
كان المطعم الصغير ملاذًا لي بكل تأكيد، ولكن لم يكن ثمة مدخل أراه، حيث لا سبيل إلى الدخول أو الخروج، فقط كان ثمة باب كرتوني أصفر في الخلف يؤدي على الأرجح إلى مطبخ متسخ، لكن الغرفة كانت معزولة عن الشارع: إنه حوض أسماك حضري، خلية زجاجية.
[…]
وكان الإحساس باللون الأخضر، وبالزجاج يزداد تدريجيًا، فعرفت أنني كلما تريثت في المكان كلما زدت توترًا.”
لقد كان هوبر ذاته متضاربًا تجاه التفسير الشائع لأعماله بأن فكرتها الرئيسية هي الوحدة، فرغم إنكاره الدائم أن يكون ذلك الخيار الإبداعي متعمدًا من جانبه، إلا أنه أقر بذلك ذات مرة في أحد اللقاءات التي أجراها: “لعلي إنسان أشعر بالوحدة.”
إن الانتباه والحساسية اللذان تتمتع بهما لاينغ تجاه أقل أثر من الخبرة، هما ما يضفيان على الكتاب تلك الروعة، فنجدها تتأمل تلك اللغة التي اختارها هوبر وتصف جوهر الوحدة بها:
“يالها من صياغة غريبة للعبارة“ (إنسان أشعر بالوحدة). فهي لا تشبه مطلقًا الإقرار بالوحدة، فبدلاً من ذلك نجدها تشير بالتنكيرالذي ينم عن التواضع، إلى أن الوحدة بطبيعتها تقاوم، فرغم أنها تعطي الإحساس بالعزلة التامة، وتمثل عبئًا شخصيًا لا يمكن لأحد آخر على الأرجح أن يعرفه أو يشارك في حمله، إلا أننا نجدها في الحقيقة حالة شائعة تعتري الكثير من الناس [أو دولة اشتراكية يسكنها الكثير من الناس]. بل إن الدراسات الحالية تشير إلى أن أكثر من ربع البالغين من الشعب الأمريكي يعانون من الوحدة، بغض النظر عن العرق أو التعليم أو المجموعة العرقية. في حين أن 45 بالمئة من البالغين من الشعب البريطاني يقولون إنهم يشعرون بالوحدة إما في أغلب الأحيان أو في بعضها. ويحول الزواج والدخل المرتفع دون الشعور بالوحدة إلى حدٍ ما. ولكن الحقيقة أنه لا يوجد من بيننا سوى أقل القليل ممن يتمتعون بمناعة ضد الشعور باشتياق للتواصل يفوق قدرتنا على إشباع ذلك الاشتياق. والمصابون بالوحدة، أكثر من كل تلك النسب بمئة مليون مرة، فلا عجب إذًا من أن تظل لوحات هوبر شهيرةً على هذا النحو، وأن يتم تكرارها على الدوام على هذا النحو.
وعند قراءة هذا الاعتراف المتردد، يتبدى لنا السبب في أن ذلك العمل لا يثير الإعجاب فقط، ولكنه أيضًا يقدم نوعًا من العزاء، وخاصةً عند استعراضه في مجموعة. فمن الحقيقة القول أنه عبّر بالرسم عن الإحساس بالوحدة في المدن الكبيرة في مرات عديدة، وليس لمرة واحدة فقط. تلك المدن الكبيرة التي تنمحي فيها فرص الاتصال مرارًا وتكرارًا بفعل تلك الآلة المجردة من السمات الإنسانية التي تتميز بها الحياة في الحضر. ولكن ألم يقم أيضًا برسم لوحات تعبر عن الإحساس بالوحدة بوصفها مدينة كبيرة، فأظهرها بوصفها مكانًا ديموقراطيًا مشتركًا، يسكنه العديد من الناس، سواءً برغبتهم أم لا؟
[…]
إن ما يعبر عنه هوبر يتميز بالجمال وكذلك بالرعب، إن تلك الصور التي يقدمها ليست عاطفية، لكننا ننتبه إليها على نحو غير معهود.. كما لو كان الإحساس بالوحدة يستحق النظر إليه. والأكثر من ذلك أنها تبدو كما لو كان النظر ذاته يجسد ترياقًا، ووسيلة للتغلب على تلك التعويذة السحرية الغريبة والمقصية التي تسحرنا بها الوحدة.”
مقال مترجم بواسطة علي زين
المحطة