الإسلام اليومي في سوريا: شيوخ متمردون وباحثون غربيون/ محمد تركي الربيعو
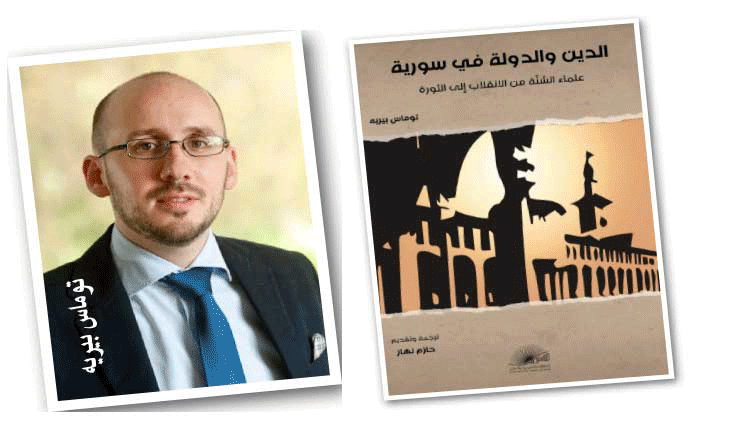
كان عام 1979 عاما استثنائيا في الشرق الأوسط، ففي بداياته الشتوية القاسية كان الخميني ورفاقه قد وصلوا إلى طهران. وسيقفز، في هذه الأثناء، موضوع الإسلام السياسي إلى الواجهة، وسيغدو كما يذكر فواز جرجس في كتابه الشيق «أمريكا والإسلام السياسي»، محل اهتمام جل الباحثين المشتغلين على الشرق الأوسط، الذين أخذو يقرؤون باقي جماعات الإسلام السياسي من زاوية، أو من عدسة الإسلام الخميني.
كان هذا الإسلام المناضل أو الثوري، قد طرح نفسه قوة بديلة عن قوى اليسار والعلمانية، بل إن يساريين كثرا نظروا يومها لهذا الرجل الكهل بوصفه ملهمَ التغيير الجديد في المنطقة. كانت مصر قد سبقت أولاد طهران الإسلاميين، على صعيد الاهتمام بدراسة الجماعات الإسلامية، لكن سقوطَ الشاه، حفز أو دفع إلى حدوث انفجارٍ في دراسة الإسلام السياسي. وخلال هذه الأعوام كان الإخوان المسلمون في سوريا قد انخرطوا جديا في مواجهاتٍ مسلحةٍ مفتوحةٍ مع النظام. كان النظام السوري لأول مرة منذ سنوات يتعرض لخطر حقيقي، وسيدفع هذا الأمر عددا من الباحثين الغربيين لدراسة تاريخ الإخوان، وقد استمر هذا الاهتمام تقريبا لمدة عقد، حتى غدا الفكاك منه أمرا ليس باليسير، فالحديث عن الإسلام اليومي في سوريا، غالبا ما كان يتوجه للحديث عن فترة السبعينيات والثمانينيات وما تلاه لاحقا من مواجهات.
مع بداية التسعينيات، ستزور مدينة دمشق الباحثة الألمانية أنابليه بوتشر، لكن هذه المرة ليس لدراسة الإسلام السياسي، الذي كان مجرد التفكير به يعد بمثابة تهمة وجناية كبيرة، بل لدراسة الإسلام الرسمي المرضي عنه من دوائر الحكم، ولمدة خمس سنوات تقريبا، ستعكف الباحثة على إجراء دراسة أثنوغرافية داخل منزل كفتارو والمعاهد الدينية التي أدارها. وسيكون لهذا الاهتمام الفضلَ في إجراء أول انعطافة جادة في دراسة الإسلام اليومي، بعيدا عن ميدان الإسلام السياسي، وفي هذه الأثناء أيضا، ستقوم الأنثربولوجية الأمريكية كريستا سالامندرا، بإجراء دراسةٍ داخل عاصمة العفة (دمشق)، وفق تعبيرها، بين طبقات النخبة في دمشق، وقد لاحظت هذه الباحثة أن نساء هذه الطبقة، التي توصف عادة بالمحافظة، قد أخذن يعبرن عن أذواقٍ جديدةٍ، بعد سنوات من الحصار الذي عرفته البلاد، وانطلاقا من نقاشات بورديو من أن الذوق ليس مسألة ميل فردي، بل هو موقف جماعي، ستصل المؤلفة إلى أن تغير أزياء هؤلاء النساء المحجبات، كان يلمح بشكل أو بآخر لصورةٍ أخرى عن الإسلام اليومي في الحواضر الرئيسية.
بموازاة هذه البحث، درسَ عدد من المؤرخين الإسلامَ الصوفي والإصلاحي، في بدايات القرن العشرين، واذكر هنا على سبيل المثال كتاب المؤرخ الأمريكي ديفيد كومنز «الإصلاح الإسلامي في أواخر العهد العثماني»، وكتاب إسحاق وايزمن «مذاق الحداثة: الصوفية والسلفية والعروبة في دمشق أواخر الفترة العثمانية»، الذي لم يحظ بترجمةٍ إلى يومنا هذا.
ومع نهاية التسعينيات وقدوم الأسد الابن، كان الحقل السوري على موعدٍ مع موجةٍ جديدةٍ من الباحثين الغربيين الشباب، من أمثال ليزا وادين وسلوى إسماعيل، ولعل انفتاحَ البلاد قليلا، وتراجع مظاهر القبضة الأمنية عن المجال العام، شكل فرصا لهؤلاء الباحثين للتعرف أكثر على عوالم الجوزة الصلبة (وفق تعبير كيسنجر)، ومظاهر السيطرة والمقاومة والحجاب، كما أن هناك من بقي يبدي اهتماما بدراسة جماعة الإخوان المسلمين، التي بقيت الجماعة المعارضة الأكثر تماسكا في الخارج. وسيتيح لنا هذا التطور، بعدها بسنواتٍ، الاطلاع على دراساتٍ جديدةٍ حول تحولات الإسلام اليومي والرسمي في سوريا، إذ سيلاحظ السويدي ليف ستنبرغ أن «توريث البركة»، التي شهدها مجمع أبو النور، بعيد وفاة أحمد كفتارو 2004، لن يكون بالتزكية، بل سيقوم المجمع هذه المرة باللجوء إلى تقنين هذا التوريث، استجابة للتغير في مزاج السوريين آنذاك، بينما سينشغل الباحث البرازيلي باولو بينيتو، بدراسة الطقوس الصوفية.
وفي هذه الفترة تقريبا، سيزور سوريا طالب بلجيكي يدعى توماس بيريه (تقريبا في عام 2004)، وهو تلميذ باحث الإسلاميات الفرنسي الشهير جيل كيبل، لإجراء عدد من الدراسات الأثنوغرافية حول جماعة العلماء. كان بيريه مهموما بضرورة تجاوز مقاربتين (الإسلام الرسمي/كفتارو أو البوطي) و(الإسلام السياسي) لصالح التركيز أكثر على النخب الدينية المحلية (جماعة زيد/دمشق، الكلتاوية/حلب) التي لا تنتمي إلى كلا الطرفين، ورغم أن اهتمامات بيريه استفادت من جهود بوتشر وستنبرغ، بيد أنها جاءت أيضا في سياق اهتمامات أكاديمية غربية بإعادة النظر بدور رجال الدين السنة في العالم الإسلامي، وأخص بالذكر هنا الجهود التي ظهرت مع محمد قاسم زمان، أو مع مائير هاتينا، وعددٍ من الباحثين الآخرين، التي ظهرت لاحقا في كتاب «حراس العقيدة» (ترجم للعربية). سيتمكن بيريه من خلال أدواته الأنثربولوجية إجراء دراسات ميدانية عديدة حول القبائل والجماعات الدينية في حلب، وجماعة زيد في الوسط التجاري الدمشقي، بالإضافة إلى دراسة الأخويات الصوفية في حلب، والموالد وغيرها، وهي دراسات نشرت في عددٍ من الكتب حول الشرق الأوسط، قبل أن تصدر بعض نتائجها وخلاصاتها لاحقا في عام 2011 في كتابه «الإسلام والبعث في سوريا»، الذي ترجم للإنكليزية لاحقا 2013 بعنوان «الدين والدولة في سوريا علماء السنة من الانقلاب إلى الثورة»، إذ سيقدم من خلاله رؤيته الكاملة لمشهد العلماء (حلب ودمشق)، وهو مشهد، كما سيبين، يختلف اختلافا كبيرا عن مشهد العلماء في الأزهر أو السعودية، إذ يرى بيريه أن هذا الحقل الديني لم يشهد تأميما كليا، كما شهدته هذه الدول، ما مكنَ العلماء لاحقا من إجراء أكبر عملية أسلمةٍ للشارع السوري منذ فترة الستينيات، وذلك خلافا للرؤية التي عادة ما تربط الأسلمةَ بحركات الإسلام السياسي.
ولعل النتيجة الأهم من ذلك، أن بيريه استطاع أن يوضح لنا أن هذه الجماعات لم يكن دورها وظيفيا، كما تذهب لذلك تحليلات بعض المثقفين الساخطين، بل على العكس، سيظهر من خلال تحليله كيف استطاعت هذه الجماعات في مراتٍ كثيرة أن تهادن السلطة، لكن مقابل تحقيق انتشارٍ أوسع لشبكاتها في الحياة اليومية السورية. هذا الكتاب، ورغم صدوره في السنوات الأولى للانتفاضة السورية، والدعوات العديدة لضرورة ترجمته، فإنه سيبقى يعاني لسنواتٍ عديدة وهو ينتقل من ناشرٍ إلى آخر، ليفرج عنه مؤخرا عن دار ميسلون، المغلقة رسميا، بنسخةٍ إلكترونيةٍ، وبأسلوبٍ لا علاقة له بتقاليد النشر، ولا يراعي أهميةَ هذا الكتاب.
وخلافا لهذه الظروف، فإن أول ما يلفت النظرَ في النسخة العربية هي مقدمة المترجم حازم النهار، التي جاءت على عكس مضمون الكتاب؛ فبيريه، وكما أشرنا، كان هدفه منذ البداية تجاوزَ عالم الإسلام السياسي والرسمي، لصالح دراسة جماعاتٍ دينية أخرى، في حين يلاحظ من مقدمة المترجم المدرسية، أن الأخير بدا يسرح في وادٍ والمتن والمؤلف في وادٍ آخر، إذ خصصه بالكامل للحديث عن الإخوان المسلمين، مرورا بالمواجهات المسلحة، ليقف بنا لاحقا، وعلى عجالة عند القبيسيات (القريبة من الإسلام الرسمي)، بدون أن يكترث حتى بالاشارة لبعض أفكار الكتاب، وهو ما درج عليه العرف عند التقديم. وربما ما يلفت النظر كذلك أن الترجمة لم تحظ بمراجعةٍ جيدة، ما أدى أحيانا إلى السقوط بأخطاءٍ عديدة في بعض الأسماء الواردة، مثلا يذكر اسم (تاج الدين الحسني/الشخصية السورية المعروفة/ تاج الدين الحساني، والمؤرخ عبد الكريم رافق/يصبح عبد الكريم رفيق، كما أن شيخ القراء تتحول إلى شيخ القرآن)، وكثير من المصطلحات الدينية، التي كان بالإمكان استبدالها بمرادفات علمية أدق وأقرب لحقل الإسلام السني. وبالانتقال إلى متن الكتاب، يؤكد بيريه أنه خلافا لمحاولة حسني الزعيم وأديب الشيشكلي، في وضع الأوقاف تحت سيطرة الدولة، فإن البعث أظهر افتقارا لافتا إلى الاهتمام بتطوير البيروقراطية الدينية، مفضلا اتباع نهجٍ صارمٍ يركز على الأمن، ويهدف إلى الحد من تأثير رجال الدين في الحكم.
يتمثل التفسير الأكثر ترجيحا لهذه السياسة في أن البعثيين لم يكن لديهم الوسائل، أو الرغبة في تأميم العلماء المسلمين، فقد كانت مصادرهم الاقتصادية محدودة. وكانت النخب الحضرية معادية لهم. علاوة على ذلك، ما عادت أيديولوجية الحزب، ولاسيما النسخة الماركسية التي اعتمدها البعثيون الجدد، الذين تولوا السلطة عام 1966 إلى عام 1970، مرتبطة بصورة كبيرة بكمالية الزعيم والشيشكلي، بل كانوا يحلمون بالنظام والتقدم من خلال تأسيس اقتصاد اشتراكي وبنية تحتية جديدة. ستولد بدورها نظاما اجتماعيا لن يكون فيه مكان للعلماء الرجعيين.
كانت هذه الرؤية قد وضعت، رمزيا، نهاية لسيطرة «بيوت العلم» القديمة على المجال الديني، بطرد المفتي الكبير أبو اليسر عابدين، الذي كان ينتمي لعائلةٍ دينيةٍ عريقةٍ، تعود جذورها للقرن التاسع عشر. مع ذلك، ومن خلال اختيار خلفائه من بين القادمين الجدد (كفتارو)، وافقَ النظام ببساطةٍ على عمليةٍ سوسيولوجية كانت جارية منذ عدة عقود، كما أن هناك عاملا آخر ساهم، كما يرى بيريه، في زوال بيوت العلماء، ويتعلق بظهور الجامعات، التي غدت موضعَ تقديرٍ من النخبة الاجتماعية أكثر من التعليم الديني. ومن ثم نلاحظ أن بعض العائلات المرموقة، التي كانت مهيمنة على مدى قرون على صفوف المفتين والقضاء مثل الغزي والكزبري، اختفت من المشهد الديني وتحولت نحو فاعليات أخرى مثل، الطب والقضاء والعلوم الأكاديمية والسياسية.
حسن حبنكة.. شيخ الميدان المتمرد
وسيتيح زوال بيوت العلماء الفرصةَ لبروز نخبٍ دينية جديدة، كما هو حال الشيخ حسن حبنكة الميداني، الذي عمل بقالا.. ودرس مع علي الدقر، الذي عهد إليه بإدارة واحدة من مدارسه، وفي عام 1946 وبمساعدة من أخيه، أسس معهدَ التوجيه الإسلامي. ويعد هذا المعهد الأكثر شهرة، كونه درّب بعض أهم العلماء السوريين في أواخر القرن العشرين، واكتسبوا بعدها سمعة عالمية. كان حبنكة يتمتع بنفوذٍ اجتماعي وسياسي، وقد تحول إلى الزعيم غير الرسمي لعلماء دمشق، وحصل على دعم الأغلبية في انتخابات عام 1964 لمنصب المفتي العام، لكنه خسر في النهاية أمام المرشح المفضل لدى حزب البعث أحمد كفتارو.
أما في حلب، ففي عام 1964 افتتح محمد النبهان (توفي 1974)، معهدا دينيا خاصا سماه دار نهضة العلوم الدينية، وعرف باسم الكلتاوية. وقد أسست الكلتاوية بصورةٍ خاصة لتعليم أبناء الفلاحين ورجال القبائل، وكان هذا الخيار نتيجة لشخصية النبهاني الاجتماعية الخاصة. فقد ولد في عائلةٍ ثرية من الخضيرات، وهي إحدى العشائر التي استوطنت حي باب النيرب، الذي يربط بين مدينة حلب والقبائل البدوية المحيطة بها. كما اختار أن ينتمي إلى المذهب الشافعي، الذي يسود الريف السوري، بدلا من المذهب الحنفي/الذي تنتمي إليه النخبة الحضرية. وكانت كاريزما النبهان متجذرة في التصور الغزير للقداسة، إذ نسبت إليه معجزات، مثل لقاءات مع النبي والصحابة وابن العربي. وعلى الرغم من أن تأسيس المعاهد الدينية المذكورة سابقا كان جزءا من ردة فعلٍ إزاء الشعور بعلمنة المجال العام، إلا أنها بقيت تعالج المشكلة جزئيا. وكانت هذه المعاهد مخصصة لعددٍ محدودٍ من الاختصاصيين. ونتيجة لذلك، لم تكن قادرة على استقطاب طلاب المدارس العلمانية/النخب الجديدة. وهذا ما سيدركه جيدا الشيخ عبد الكريم الرفاعي (1901/1973) الذي سيعمل على تغيير هذه المعادلة بشكلٍ جذري.
ولد الرفاعي في حي قبر عاتكة، وتلقى تعليما دينيا تقليديا من علي الدقر، لم يُعرف بوصفه منظرا، بيدَ أن ما ميزه، أنه استطاع تجاوز الفجوة الثقافية بينه وبين طلاب المدارس الثانوية والجامعات.
يذكر بيريه أن ما أرادَ الرفاعي أن يحييه لم يكن الاستخدام التقليدي للجامع كفضاءٍ مفتوح للصلوات اليومية، ولعددٍ محدد من الدروس الأسبوعية، بل كان هدفه تحويل الجامع إلى جامعة. وهو ما بدا من خلال تغيير طبيعة الحلقات الدراسية، ففي حين كانت تقليديا تجمعا مؤقتا، مؤلفة من طلاب يلتفون حول أستاذ، ليدرسوا قضية مهمة أو كتابا، فإنها مع الرفاعي بدت مجموعة مستقرة من عشرات الطلاب، من أعمارٍ ومستوياتٍ فكرية متماثلةٍ، لتغدو الوحدة التنظيمية الأساسية للحركة، مثل الأسرة في جماعة الإخوان المسلمين، أو الخلية في الحزب الشيوعي.
كان الطلاب يجذبون إلى الجامع، من خلال دروس تكميلية في المنهاج العلماني، ولا سيما العلوم الطبيعية التي يقدمها أساتذة مدارس انضموا إلى الرفاعي. أما التعاليم الدينية فقد بدأت به جماعة زيد بالأساسيات، أي بتذكرة وحفظ القرآن. فقد أدى النمو المتزايد لمعرفة القراءة والكتابة في القرن العشرين إلى زيادة عدد الذين يطمحون إلى أن يصبحوا حافظين للقرآن، وهنا لم يكن الرفاعي يستجيب فقط لواقعٍ اجتماعي جديد، بل أثبت أيضا أنه مرن بدرجة تكفي لكسر جزءٍ من التقليد العلمي، من أجل تسهيل أن يكونَ الناس من الحافظين، فحتى ذلك الوقت، تطلب الحصول على مثل هذه الإجازة حفظ عشر طرائق مختلفة لقراءة القرآن. وبالنسبة إلى طالبٍ متحمسٍ، كانت هذه المسألة تتطلب أربع أو خمس سنوات من التعليم، ولذلك وضع الشيخ الرفاعي نهاية لهذه الحالة، بأن أمر ساعده الأيمن (شيخ القراء) محيي الدين أبو الحسن الكردي (توفي 2009) بإصدار إجازةٍ لأي شخص حفظ قراءة حفص.
كان هذا ابتعادا عن التقليد، لكنه مثّل تحولا كبيرا على صعيد إعادة تعريف حدود العلماء، من خلال فتح الباب أمام إدماج نخبةٍ دنيوية، ما ساهم لاحقا في مزيدٍ من أسلمة شرائح واسعة من النخب الوسطى/العلمانية في مدينة دمشق.
يتطرق بيريه، في فصولٍ أخرى، لعلاقة العلماء الدمشقيين بالوسط التجاري، وموقف نظام الأسد الابن من جماعات العلماء بعد عام 2005، وبروز بعض الوجوه الجديدة مثل الشيخ راتب النابلسي، الذي أخذ ينافس نجومَ الغناء على كسب قلوب المستمعين في وسائل المواصلات العامة، كما يتطرق ليوميات الانتفاضة، وموقف العلماء الدمشقيين والحلبيين منها، والجميل في كتاب بيريه أنه يوفر لنا بيبلوغرافيا غنية عن عشرات رجال الدين في سوريا خلال القرن العشرين، ولذلك فهو يستحق القراءةَ والنقاشَ، وربما الترحيبَ بأسلوبٍ وظروفٍ أفضل من الظروف التي صدر بها عن أحد «أجنحة» دار/ جماعة ميسلون.
٭ كاتب من سوريا
القدس العربي




