جمهورية الحمّام: وثيقة حيّة لرحالة مجهول عن مجتمع سوريا 1841-1843/ محمد تركي الربيعو
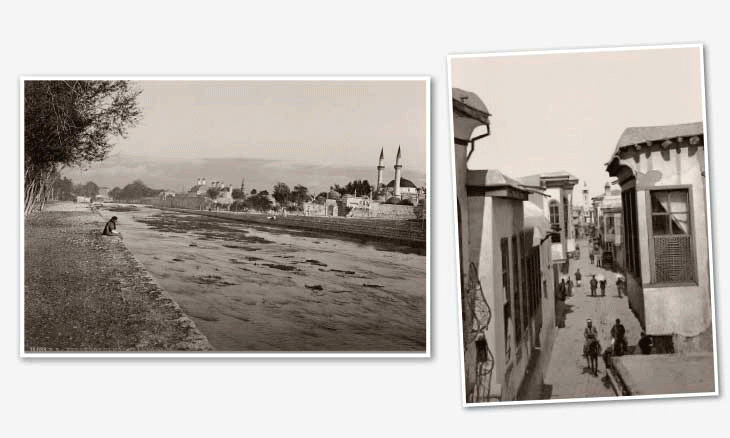
في السنوات الأخيرة، غالبا ما ارتبطت ترجمة أعمال روائيين عالميين من أمثال سلمان رشدي، أو أليف شافاق بالمترجم السوري خالد الجبيلي، الذي عكف في مشواره في حقل الترجمة على نقل عدد كبير من روايات هذين الروائيين، أو غيرهم للعربية، لدرجة بات من المتوقع أو الدارج أنّ أي ترجمة جديدة له، تعني قدوم عمل روائي. بيد أنّ ما يلفت النظر في الجهود التي بذلها هذا المترجم، قدرته بين الفينة والأخرى، على تعريف القارئ العربي بأعمال غير روائية، وفي الأغلب أعمال تعنى بالتاريخ الثقافي والاجتماعي لمدينة حلب (مدينة المترجم)، وعلى الرغم من قلّتها، فقد شكّلت إضافة حقيقية للمكتبة العربية عموما، والسورية خاصة، وأشير هنا إلى كتابين بالأخص صدرا بترجمته؛ الأول عن «تاريخ حلب الطبيعي» للأخوين الطبيبين راسل، الذي يعدّ من أهم الوثائق الأنثروبولوجية عن مدينة حلب في القرن الثامن عشر، إذ نعثر فيه على معطيات ربما تكون من أدق ما وصلنا عن تلك الفترة، فقد عني برسم صورة مشهد الحياة الصحية للأهالي، وأشكال أجسادهم، متوسطي الطول، ويميلون إلى النحافة؛ والنساء مكتنزات الجسم، وطعامهم وأسواقهم، وأخبار الطاعون.
أما الكتاب الآخر، فيتمثّل في أطروحة المؤرخة الأمريكية مارغريت لي ميري وزر «القرابة الحقة»، الذي تناولت فيه موضوع مؤسّسة الزواج عند الحلبيين في القرن الثامن عشر، إذ تظهر السجلّات الشرعية لتلك الفترة (1770 – 1840)، أنّ الرجال الحلبيين لم يتزوجوا امرأة ثانية إلّا في ما ندر، وهذا يخالف الرؤية النمطية عن المجتمعات المسلمة، كما أشارت المؤلفة لنقطة ثانية وجوهرية تتعلق بالزواج ببنات العم. فخلافا لصورة «مدينة الحريم، وأولاد العم»، التي وصفت بها الأنثروبولوجية الفرنسية جيرمين تيلون تاريخ وواقع مدن الشرق الأوسط في الستينيات، بيّنت مارغريت أنّ الزواج من بنت العم لم يكن واسعا بين الأهالي.
وفي سياق الاهتمامات ذاتها، قام الجبيلي بترجمة عمل فريد بعنوان «السوريون المعاصرون»، يتناول أوضاع المجتمع في ولاية سوريا في فترة 1841/1843، وهي الفترة التي عادت فيها هذه الولاية لنفوذ السلطان العثماني، بعد أن حكمها إبراهيم باشا لقرابة عشر سنوات أو أقل بقليل. وما يحسب للمترجم هنا، أنّ دوره لم يقتصر على نقل النصّ للعربية، بل كان له الفضل في الكشف عن هذا الكتاب المجهول للقراء، فبينما كان يبحث في مكتبة نيويورك العامة عن كتب دوّنها رحالة زاروا منطقة المشرق، فإذا به يعثّر في أحد أروقتها على مخطوطة طبعت في لندن عام 1844. ومؤلف المخطوطة شخص مجهول، فكل ما نعرفه عنه أنه «طالب دراسات شرقية» وربما يكون عميلا، كما يحلو لتلاميذ أدوارد سعيد قوله في حق أي رحالة زار المنطقة، فهو لا يترك صغيرة أو كبيرة بدون الإشارة والكتابة عنها، وقد يقول البعض إنّ ذلك من شيم المستشرقين عادة، لكن مع ذلك فإنّ في هذا النصّ فرادة استثنائية في رسم صورة الأسواق والمجتمع والناس، ولن نبالغ إن قلنا إنّ الملاحظات الأثنوغرافية التي كتبها بدت أحيانا أكثر دقة وغنى، من تلك الصور التي رسمها شخص مثل الألماني ماكس فون أوبنهايم، بعده بقرابة خمسين سنة في زيارته لسوريا عام 1892.
وبالعودة للمتن، يبدأ الكاتب المجهول رحلته من بيروت؛ بيد أنّها لن تثير اهتمامه كثيرا، لذلك سيتشوق للصعود إلى الجبل، لكنه سيضطّر إلى المكوث في إحدى القرى لمدة أسبوع، بسبب إجراءات الحجر الصحي. فالطاعون كان قد اجتاح البلاد، ولذلك سيبدي استغرابه قليلا من فكرة الحجر الصحي، فالآفة الحقيقية للشرق، كما يعتقد، لا تكمن في انتشار الطاعون، بل في هذه البيوت. فلا شيء يظهر عدم جدوى الإصلاحات التي تدّعي تركيا أنها أنجزتها أكثر من هذا، ولدعم حجته، يجري مقارنة بين النظامين الصحيين في سوريا وبريطانيا. إذ يؤكد أن الطاعون لم يعد في لندن منذ الحريق الذي اندلع في عام 1666، بسبب شقّ الشوارع الواسعة، وبناء الأرصفة والمجاري، بالإضافة إلى تحسّن الأحوال وإحساس الناس بالراحة والنظافة العامة (سيعود في مكان آخر للثناء على نظافة المدينة عند الحديث عن الحمامات)، وقبل الوصول إلى هذه النقطة، يكمل مؤلفنا رحلته، ليصل إلى جبل لبنان.
قبل وصوله بسنة، كان القتال بين الدروز والموارنة قد أدى إلى مقتل العشرات. وبعد توصيف دقيق لطبيعة الطرقات الواصلة إلى الجبل، وكأننا أمام جغرافي له باع طويل في هذا البلد ودروبه، سيخصّص جزءا مهما من رحلته للحديث عن الدروز وقادتهم ومعتقداتهم الدينية. فهؤلاء القوم ينقسمون إلى فئتين/فئة العقاّل وفئة الجهال. والعقّال هم الأشخاص الذين تلقّوا أسرار الديانة الدرزية. أما فئة الجهال فلم تتلق هذه الأسرار. وليس لهذا التمييز علاقة بالطبقة أو الثروة الدنيوية، إذ يمكن لأي درزي الانتقال من مرحلة عدم التلقين إلى مرحلة التلقين، عندما يعلن تمسّكه بالتزامات معينة، وعدم الانغماس في الملذات المسموح بها لفئة الجهال، والذين يأكلون ويشربون كما يحلو لهم. والدروز، كما يؤكد، أشبه بعائلة، أو عشيرة واحدة، مع ذلك فهو يعتقد أنّ هذه العصبية لم تتولّد جراء كونهم طائفة سرية، بل لأسباب تتعلق بواقعهم الاجتماعي والسياسي آنذاك. ففي الماضي، عندما كانوا يبسطون سيطرتهم السياسية (قبل صعود نفوذ الموارنة) ولم يكن لهم أي منازع، كانت أسرة جنبلاط، وأسرة يزبك، في حالة حرب دائمة مع بعضهما.
ومما لفت نظره أيضا أنّ بين الدروز أناسا في غاية الذكاء في الأمور السياسية، ويتمتّعون بمهارة في الخطابة أكثر بكثير من المسيحيين، إلا أنهم لا يجارونهم في إعداد الوثائق. وبتعبير أدق، فقد يكون الدرزي مناصرا، أو داعية أكثر إقناعا، أما المسيحي فهو محام محنّك. كما يأتي على ذكر طقوس الموت لديهم، ومن الأمور الطريفة التي يذكرها، ولا ندري مدى دقتها، أنه عند وفاة أحد دروز الجبل، لا يغلق غطاء التابوت فورا، بل توضع صخرة كبيرة أمام مدخل القبر ولا يغلق لبضعة أيام، لكي يتاح للشخص إذا لم يكن قد مات حقا، بل كان في غيبوبة، فرصة الصراخ عاليا بحيث يمكن للمسافرين أن يسمعوه وينقذوه.
سهرات شامية
بعد الجبل، سينتقل المؤلف إلى دمشق، و«في الساعة الواحدة وصلنا إلى قمة تل الصالحية»: ومما يذكره هنا أنّ كلمة الشامي جاءت من شؤمي، وهو رجل يحلف يمينا كاذبة عشر مرات قبل أن يسدّد دينا عليه. وحصل على غرفة بالإيجار في منزل تاجر مسيحي، وفي الليل، كان يقضي أوقاته برفقة صاحب البيت، إما في قراءة «ألف ليلة وليلة»، أو حضور بعض السهرات. وكان الحديث خلال الأمسيات يدور، كما يذكر، حول أخبار الباشا فلان، أو عن أحوال الجراد الذي أتى على الذرة الصفراء، وعن ارتفاع ثمن الخبز، كما أنه كثيرا ما سئل عن نفق نهر التايمز، وعن أحوال الحكم في بلاده، و«كانوا يجنّون من فكرة أن تكون الملكة امرأة». في الصباح كان صاحبنا المجهول يدور في أحياء المدينة، وفي أحد الأيام سيقرر التعرّف على عالم الحمّامات. ويذكر هنا أنّ هذا المكان يعدّ فضاء للتسلية واسترخاء الجهاز العصبي، ولا يستحسن الإكثار من التردّد عليه، ففي غالب الأحيان تكفي مرة واحدة في الأسبوع، ولعلّ في هذه الملاحظة ما قد يكشف عن طبيعة النظافة في تلك الفترة، فغسيل البدن لم يكن بالأمر السهل، أو يحدث بشكل يومي، خلافا لبدايات القرن العشرين، مع دخول السواقي والمياه إلى البيوت، ما أدّى فعليا، كما لاحظ ألبير أورتايلي في سياق دراسته لمدينة إسطنبول، إلى تعطلّ وظيفة الحمامات، وتغير مفهوم النظافة، وغسل البدن.
وهناك الكثير من الرحالة، والمؤرخين الدمشقين، الذين وصفوا الحمّام، لكن وصف ضيفنا المجهول حمل صورا مختلفة بعض الشيء، فالجزء الخارجي من الحمّام الدمشقي (البراني) بدا له وكأنه جامع صغير، «ففيه قبة مقنطرة واسعة، وفي الداخل يجلس صاحب الحمام، وهو رجل مسن، في مكان أشبه بمحراب محفور». وقد تبدو الصورة مثيرة للاهتمام كونها تقترب من التصور الصوفي لدور الحمّام. فهذا العالم ليس مكانا لنظافة البدن وحسب، بل هو وقبل كل شيء مكان للتطهّر من النجاسة، ولذا فهو يمثّل ولادة جديدة. كما نعثر في داخله على صبي الحلاق، بحزامه الأسود الذي يتدلّى عند خصره، فيصدر خشخشة، وتراه يفرك ويجفّف أحدهم، ويحلق رأس آخر، أما المدلك (المكيس) فيخرج من الجواني، ويتجه نحو بركة المياه منتظرا زبونا جديدا. ويكمل وصفه ليقول: «وبعد أن خلعت ووضعت منشفة حول خصري ومنشفة على رأسي كعمامة، وأخرى تتدلّى من كتفي مثل رداء روماني، وبعد أن سلقت، وسلخت حيا، رحت أتسلّى بمحاولة التعرف على فئات المستحمين وطبقاتهم من ملامحهم»، لكنه سيكتشف أنّ الملامح قد لا تشي بجوهر الناس الدمشقيين، فهذا «رجل ظننت من قسمات وجهه وملامحه النبيلة أنه من الأعيان الأثرياء، لكن عندما خرجت رأيته وهو يرتدي أسمالا (ثيابا) بالية كالتي يرتديها الناسكون الفقراء، وذاك رجل آخر حدست من قسماته أنّه رجل حقير فظ، لكنه بعد أن ارتدى ثيابه، تبيّن لي أنه أفندي محترم، إذ ارتدى عمامة بصراوية ونطاقا كشميريا». من هنا سيصل إلى فكرة مفادها أنّ الحمام الشرقي هو بمثابة جمهورية، تتساوى فيها طبقات الناس، فهو يلغي المظاهر الزائفة من النبالة والشرف، وبإمكان الخياط، وبائع الحرائر، والمنسوجات الدخول إليه. ولا شكّ أنّ ربطه بين الجمهورية والمساواة يعكس المناخ السياسي والثقافي الأوروبي آنذاك، الذي كان ينظر لنظام الجمهورية بوصفه يمثّل روح المدينة الفاضلة.
ولا ينسى الحديث عن ولعه بلباس أهالي المدينة، كما يثني على جودته وعمليته مقارنة باللباس الأوروبي؛ فنبلاء دمشق كانوا يرتدون ثيابهم الشرقية، التي تتألف من عمامات من الموسلين ناصعة البياض، ونطاقات كشميرية، بينما لا يعرف جندي النظام التركي كيف يرتدي الثياب الأوروبية، وعادّة ما يتلطّخ معطفه بالحوّار الأبيض بسبب التصاقه بجدار أحد المقاهي، وقد تدلّت صدريته خارح بنطاله، وتلوث حذاؤه الجلدي الأسود بالأوساخ. كما لا ينسى الحديث عن طقوس الختان في المدينة، وكيف أنّ الاطفال في تلك الفترة كانوا يختنون في وقت متأخر، وهي فكرة قد تتوافق مع بعض ملاحظات الأنثروبولوجيين الذين تنبّهوا إلى أنّ الكثير من المجتمعات القديمة كانت تجري عمليات الختان للذكور بعد سنوات من ولادتهم، وليس عند ولادتهم مباشرة، كما يحدث في أيامنا هذه، كي يضمنوا مرورهم بتجربة من الألم، تكون بمثابة عتبة للولوج إلى عالم الذكورة، واكتشاف قسوة الحياة. ومن الأمور الطريفة التي يذكرها ما يتعلّق بعادة أهل العروس في الأعراس المسيحية، إذ يقوم أخوتها بتمثيل دور الممانع لظهورها من المنزل، ليظهروا مدى تأثّر العائلة بخروجها.
ومن بين التوصيفات اللافتة للنظر في جولات حديثه عن حيّ الميدان، إذ يذكر أنّه أصيب بدهشة كبيرة، حال عبور مدخل الحي، فقد كان هناك مقهيان كبيران يقعان على جانب الطريق ممتلئان بالرواد الذين لا يبدو عليهم أي مظهر من مظاهر سكان المدينة، أو بشرة الدمشقيين الأنيقة (في إشارة للدمشقين داخل الأسوار). وترى البدو، بمناديلهم الحريرية الصفراء الزاهية تلتفّ حول وجوههم شديدة السمرة، وثيابهم الخشنة وصراخهم بتلك اللهجة القاسية، وهم يساومون على بيع منتجاتهم. أما بيوت هذا الحي، فهي مختلفة تماما كما يذكر عن البيوت الموجودة داخل المدينة. فهنا لا توجد زخرفة بالموزاييك،أو الأرابيسك، ولا توجد برك ماء، بل سجادة سميكة ممددة على الشرفة، ومحاطة بالوسائد. ولعل في هذه الملاحظات ما يتوافق مع ما كتبته ليندا شيلشر عن حي الميدان، الذي أخذ يشهد تطورا عمرانيا في فترة الستينيات من القرن التاسع عشر، بعد أن غدا بعض أعيانه حكّام دمشق، مما شجّعهم على إعادة بناء بيوتهم، لتتلاءم مع واقعهم الجديد في السلطة.
بعد مكوثه في دمشق، سيكمل رحلته هذه المرة إلى الساحل، ولاحقا الإسكندرونة، ولن يسجّل الكثير عن هذه الرحلة سوى مشقّة الطرقات، قبل أن يعرّج في محطته الأخيرة إلى حلب. وقد أقام في حي الجديدة، وهو حي يقع في شمال المدينة، وكانت تقطنه العائلات المسيحية العربية، ومما يذكره في هذا الحي، سماعه لعشرات القصص عن الزلزال الذي ضرب المدينة في عام 1822. وعن عادات الحلبيين، يؤكّد أنّ المسيحيين الحلبيين يغارون على زوجاتهم أكثر بكثير مما يفعل المسيحيون في دمشق، وعلى الرغم من هذه الفروقات، فهو يصف غالبية مسيحيي سوريا بالجهل، وربما يعود هذا الموقف لخلفيته البروتستانتية، كما بدا له أنّ التعليم العام مهمل، والسكان المحليون لا يبدون أي اهتمام بالقراءة باستثناء كتب بعض الشعراء الشعبيين، مع ذلك نراه يثني في أماكن أخرى على علماء المدينة، إذ يأتي في هذا السياق على ذكر تفاصيل زيارته لدار المفتي، ولقائه نائبه، الذي كان يقرأ في منشورات مطبوعة في مطبعة محمد علي في بولاق، يومها سيذكر له هذا النائب بشيء من المرارة قائلا»: «لو أنّ المصريين أطلقوا كمية أقل من الرصاص، وطبعوا عددا أكبر من هذه الكتب، لكان أفضل لنا جميعا». ومن المفارقات التي تذكر هنا، أنّ بعض السوريين سيعودون بعد مئة عام وأكثر، ليكرروا عبارات مشابهة تجاه جنود عبد الناصر، بعد فشل الوحدة بين سوريا ومصر 1958. في الرحلة الكثــير والكثير من التفاصيل الأخرى، وأكثر ما يشدّ الاهتمام إليها، كما ذكرنا، قدرة المؤلف على نقل صورة حية ومعطيات غنية، ما تزال مجهولة، أو مشوهة عن أهل ذلك الزمن وعاداتهم، وتقاليدهم.
٭ كاتب من سوريا
القدس العربي




