«باب الحارة» في الجامعة الأمريكية في بيروت!/ محمد تركي الربيعو
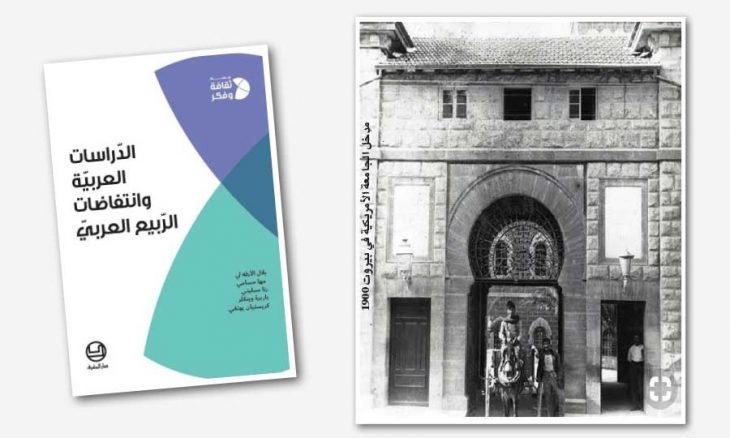
في سياق قراءتها ليوميات حلاق دمشق في القرن الثامن عشر، كانت المؤرخة الفلسطينية في كلية بوسطن دانا السجدي، قد وصلت إلى فكرة تقول بأن يوميات هذا الحلاق (البدير، كما يرد في المخطوطة الأصلية) وغيرها من يوميات العامة؛ وهي اليوميات التي كتبها أصحابها بأسلوب يمزج من ناحية بين العامية والفصحى. ومن ناحية أخرى يركز على فهم الحاضر المعاش ورصد أحواله، بدلا من فهم الماضي وأحداثه، كما فعل العلماء في السابق؛ لم تكون وليدة انحطاط ثقافي، أو بداية حركة شعوبية أخرى، كما يحلو للبعض قوله، بل جاءت هذه النصوص لتعبر عن الاقتصاد السياسي الجديد للمدينة، المتمثل في ظهور بيوتات سياسية، وانتشار للعنف ولبعض المظاهر والسلوكيات في شوارع المدينة، الذي كان له أثر في الفضاء العام للنصوص، أو، وفق تعبير السجدي، في خلق «اقتصاد جديد» يتعلق بالنصوص الأدبية. وكما ذكرنا، فإن أهم ما مثّل ربما هذا الأدب، دخول الأشكال العامية إلى المعتمد الأدبي الراسخ، التي ستبدو هنا بوصفها تطورا إيجابيا، ودليلا على تحولات حضرية في المدينة العربية.
ومن الاستنتاجات الطريفة التي تذكرها السجدي هنا، أن كتب اليوميات هذه بلغتها الجديدة، واهتماماتها كانت أشبه بالصحيفة المحلية، التي ستظهر بشكل كثيف مع غزو المطابع للعالم العربي في القرن التاسع عشر. وبالتالي، فإن البدير، أو البديري كما يحلو للقاسمي ذكره، كان هو ورفاقه بلسانهم العامي، قد مهدوا لبداية نهضة الصحافة العربية في القرن التاسع عشر، بالإضافة إلى ظهور فكرة المفكر الناقد الحديث الذي يخاطب العامة.
ولعل اللافت هنا، أنه بعد مرور ثلاثة قرون تقريبا على نصوص هؤلاء العامة، كانت الأحداث في العالم العربي تدفع العامة مرة أخرى لتوثيق ما يحدث، وهذا ما ظهر من خلال ما سمي بـ«المواطن الصحافي» الذي أخذ ينقل لنا، بكاميرا موبايله وصفحاته على وسائل التواصل، ما يحدث في الأحياء والمدن العربية، حتى غدا مرجعا أساسيا لأهم الوكالات العالمية. ولعل ما ميز هذا المواطن أيضا، أو «البديري الجديد» أو النيوبديري» أن روح لغته أيضا وفوضويتها لم تكن تشبه تعابير الصحافة التقليدية، بل جاءت بعاميتها العفوية لتعبر عن مرحلة جديدة في عالمنا العربي. وكأن الأقدار، كانت تدفع العامية مرة ثانية لتطفو على السطح، بعد أن قمعت في العقود الأولى من القرن العشرين، رغم انتشارها اليومي، وستكون يوميات البديري أولى ضحايا هذا التحول أو الضبط النصي. فقبل وفاته في عام 1900 تقريبا، سيعمل محمد القاسمي (والد الإصلاحي الكبير جمال الدين القاسمي) على تحقيق يومياته عبر نسف وتعديل ما هو عامي فيها، وهذا ما كان يعني تغييب رائحة الزمان والمكان عن النص. وبعد ذلك بعقود، وعلى الرغم من الهم الإصلاحي في تحديث اللغة، فإن العربية الفصحى ستغدو اللغة المجاز، التي يعبر من خلالها عن معارضة الاستعمار، كما أخذ ينظر لها بوصفها تمثل لغة العصر الذهبي للمسلمين، بينما كانت العامية تعني فسادا وانحطاطا ثقافيين، وهذا رأي لن يقتصر على المسلمين فقط، بل شمل أيضا بعض الإرساليات البروتستانتية للمنطقة، إذ لاحظ مثلا أمين معلوف في سيرة عائلته «بدايات» وهو يحلل لنا رسائل جده الأكبر (طنوس/منتصف القرن التاسع عشر) وجده الأصغر (بطرس/بداية القرن العشرين) أن أسلوب رسائل الأول، الفلاح العثماني كما يصفه، كانت أقرب إلى العامية منها إلى الفصحى، وكان جده، كما يقول، هو القوال في الجبل (الشاعر باللغة العامية) بينما نجد أن لغة رسائل جده الأصغر، الذي درس في مدارس الإرساليات، مسبوكة بلغة تراثية متينة، وهذا ما يرده لكون المرسلين فرضوا على تلامذتهم أولا اتقان اللغة العربية، قبل الإنكليزية، وثابروا بدورهم على دراسة هذه اللغة لينطقوا بها ويكتبوها مثل أهلها. وقد تعزز هذا الموقف في الخمسينيات، مع صعود القومية العربية، التي هدفت إلى توحيد كل الديانات، اعتمادا على اللغة الفصحى لا اللهجات المحلية، والتي بدت، وفقا للرواية العروبية، لغة مفرقة، وركيكة، وخالية من أي وفرة لغوية، تستطيع التعبير عن الفكر، فمثلا يصف نجيب محفوظ العامية المصرية في فترة الستينيات بـ«الفقر والمرض» وعلى الرغم من أن النصوص العامية لن تختفي، وبالأخص داخل الحركة اليسارية المصرية، التي ولد منها شعراء العامية مثل، صلاح جاهين وسيد حجاب والأبنودي، وألفوا وكتبوا أشعارا وأغاني شهيرة بالعامية، مع ذلك، ربما سننتظر إلى بدايات القرن الجديد، ليتاح لهذه العامية الظهور مرة أخرى، بوصفها أداة تغيير. فمع صعود وتيرة الاحتجاجات في مصر في 2004، ظهر شعار «كفاية» ذو النكهة العامية، ليحمل رنة وأسلوبا مختلفين عما عرفناه من شعارات سياسية، كما كانت وسائل التواصل والأحداث توفر فرصا جديدة ونوافذ لتدفق فاعلين ولاعبين وشبكات مختلفة، أخذوا يعبّرون عن همومهم من خلال لغة عامية، أو لغة تجمع بين العامية والفصحى، مع إضافة بعض التوابل الأجنبية، وأحيانا تتخاطب في ما بينها بعامية عربية، مكتوبة بأحرف إنكليزية، شبيهة بـ«الخربشات» وفق تعبير الألسني اللبناني نادر سراج، وجاءت الانتفاضات العربية لتعزز من دوراللغة العامية، بوصفها لغة تغيير، أو، وفق تعبير السجدي السابق، بوصفها دليلا على اقتصاد كتابي ونصي جديد، ومؤشرا على تحولات اجتماعية وسياسية كبيرة في المنطقة. ولكن ما علاقة ما ذكرناه بـ«باب الحارة» والجامعة الأمريكية في بيروت؟
ربما التحول الجديد على صعيد عودة العامية بكثافة بعيد الانفجار العربي، لم يكن أو ينحصر تأثيره على مستوى لغة الفضاء العام وهمومه وقضاياه، بل شكّل محل نقاش وتحديا واسعا بين الدارسين الغربيين للمدن العربية. وهو تحول سيحاول عدد من الأكاديميين العرب والغربيين رصد آثاره داخل الجامعة الأمريكية في بيروت وعدد من الجامعات الألمانية، إذ سيدرس هؤلاء الباحثون في كتابهم المشترك «الدراسات العربية وانتفاضات الربيع العربي» دار المشرق (ترجمة ثائر ديب) تأثير الانتفاضات العربية، وانفجار العامية الجديدة، على برامج وأساليب تدريس اللغة العربية للطلاب الغربيين، في برامج دراسات الشرق الأوسط.
يبين كل من بلال أورفه لي، رنا سبليني، مها حسامي، في دراستهم المشتركة حول أثر الانتفاضات في تعليم اللغة العربية في الجامعة الأمريكية في بيروت، أن برنامج التدريس في مركز الدراسات العربية وشرق الأوسطية سابقا، كان يلح على تعليم العربية بالفصحى المعاصرة، بالإضافة إلى تقديم برنامج مكثف بالعربية اللبنانية العامية.
ومما يثير الاهتمام، أن العلاقة بين هؤلاء الطلاب والعربية قد تغيرت وشهدت أطوارا مختلفة خلال الخمس عشرة سنة الأخيرة، إذ يلاحظ مثلا أنه بعد عام 2001 وأحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول، كانت العلاقة بالعربية بالنسبة للطلاب الأمريكيين لا تقتصر على كونها توفر مدخلا مباشرا إلى العديد من الثقافات والتراث وحسب، بل لأنها شكلت لغة تهديد مباشر، ولذلك باتت دراستها واجب وطني. و قد ترك هذا الأمر أثره في الطريقة التي تدرّس بها اللغة العربية، فقد سادت المقاربات التواصلية مناهج اللغة، وحلت محل الطرائق التقليدية التي تركزت على القواعد، وفقه اللغة الضروريين للولوج إلى التراث الكلاسيكي المكتوب. بيد أن ما يلاحظه الباحثون هنا، أنه على الرغم من هذه الرؤية والتغير والإقبال المتزايد على تعلم اللغة العربية، إلا أن الاهتمام باللغة العامية بقي محدودا، مقارنة بما بعد 2010، ولعل في هذه الملاحظة ما يتوافق مع الملاحظات التي ذكرتها الأنثربولوجية الإيرانية نيلوفر حائري في سياق تقديمها للنسخة العربية من كتابها «لغة مقدسة وناس عاديون» (صدر بالإنكليزية عام 2003، وترجم عام 2011 للعربية). إذ تذكر أنها أصيبت بصدمة أثناء قيامها ببحثها الميداني في مصر، فالناس، سواء كانوا دارسين متخصصين أم «خواجات» لم يشعروا بوجود ما يتعلمونه من الوضع اللغوي في العالم العربي. لكن هذه الرؤية ستتغير بشكل كبير مع اندلاع الانتفاضات، إذ ستظهر اللغة العربية، بوصفها لغة احتجاج، ولغة ثورة، ليصبح السفر إلى المنطقة ضروريا بصورة متزايدة للباحثين الغربيين، لمتابعة التغيرات السريعة الجارية، لكن صعوبته أخذت تتزايد هي الأخرى عند طلاب اللغة، خاصة مع رواج العربية غير الخاضعة للرقابة والعامية والسوقية في الشوارع، وفي وسائل التواصل الاجتماعي. فكان لا بد من بذل جهود إضافية للتمكن من شكل واحد على الأقل من أشكال العربية العامية، ولذلك تحول الأكاديميون في مجال تعليم العربية لغير الناطقين بها صوب دمج منظم للعامية والفصحى، بوصفهما شكلين متكاملين من اللغة ذاتها، وهنا يلاحظ الباحثون أن الطبعة الثالثة لأجزاء الكتاب في تعلم العربية، الذي يدرّس للطلاب في مركز الدراسات العربية وشرق الأوسطية، قد أضاف فصولا تتعلق باللغات المحلية والعامية. وسمحت لهجة المشرق التي تعلمها الطلاب في الصف بقراءة الشعارات السياسية للانتفاضة السورية، وبالتواصل مع عدد متزايد من اللاجئين السوريين في لبنان. كما قام مدرسو المركز أنفسهم، في بعض الأحيان، بدمج شكلي العامية الدمشقية والبيروتية في الصف الواحد، متعمقين في خصوصيات كل منهما وفي اختلافاتهما. واستخدم مسلسل «باب الحارة» في الصفوف كمادة داعمة لدروس العامية، فعلى الرغم من أن أحداث المسلسل الدرامية تعود لثلاثينيات القرن الماضي، حاول المعلمون ربطه بالحوادث والأوضاع التي تشهدها الانتفاضة السورية، وقد أفاد الطلاب بشكل هائل من التداخل بين اللغة المستخدمة في المسلسل، واللغة التي سمعوها في بيروت، من اللاجئين، ولعل هناك من يقول بأن استخدام المسلسل يعزز من صور الاستشراق في ذهنية هؤلاء الطلاب، ما يعيدنا لتعليقات إدوارد سعيد حول»الإمبريالية بوصفها مشروعا تعاونيا» كما أن اعتماد اللهجة الشامية الدرامية لا يخلو من بعض النمطية على صعيد اللهجات العامية السورية، خاصة أن غالبية اللاجئين السوريين في لبنان لا يستخدمون مفردات هذه العامية، بقدر ما يعتمدون لهجات وعاميات أخرى (بالأخص القادمين من المناطق الشرقية السورية). ويبدو المركز مدركا لهذه الإشكالية، لذلك زاد من مشاركة الطلاب في الخدمة الاجتماعية والعمل المجتمعي، ليتيح لهم التفاعل الهادف مع أهل البلد واللاجئين من مختلف الأعمار والخلفيات.
وما كان ذا أهمية في عملية تعلم اللغة، هو أن الأطفال أخذوا زمام المبادرة في كثير من الأحيان، وعلموا طلاب مركز الدراسات العربية وشرق الأوسطية كيفية قول بعض الكلمات، وصوبوهم وساعدوهم على التعبير عن أفكارهم.
وبالتالي نلاحظ أن هذه التغيرات والإقبال على دراسة العامية، ساهمــــت في فتح أبواب حرم الجامعة الأميركية على مدينة بيروت، وأعطت عوالم اللاجئين وغيرهم من المجموعات المحرومة منفذا إلى مؤسسة أكاديمية أمكنهم الاســتفادة منهم بطرائق شتى.
في مقابل ذلك، يوضح كل من باربرة وينكلر وكريستيان يونغي، في دراستهما المشتركة حول الدراسات الأدبية في الجامعات الألمانية، أن ظهور اللغة العامية، كلغة تغيير في السنوات الأخيرة، بالإضافة لاستمرار تدفق اللاجئين إلى ألمانيا، قد دفع بعدد من هذه الجامعات والمؤسسات إلى تأسيس برامج بحثية جديدة، عبر دفع الطلاب مثلا لدراسة العالم العربي من خلال الفيسبوك، أو الأفلام المحلية الشعبية، كما قامت بعض الجامعات باقتراح برامج «بكالوريس بلس في الدراسات الشرقية» تموله الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي، ويتيح للطلبة قضاء سنة أكاديمية في الخارج، بحيث تكون جزءا لا يتجزأ من المنهاج، وتتيح جامعة ماربورغ هذه الفرصة لطلاب دراسات الشرق الأدنى والأوسط، إذ يمكن للطلاب أن يختاروا الإقامة في مصر والأردن والمغرب والإمارات العربية وإيران وطاجيكستان، ما يعني التعرف على اللغات العامية وإتقانها بشكل أفضل، بدل الاعتماد على النصوص وحسب، ولذلك نلاحظ، وهذا ما يؤكد عليه الباحثان في مقدمة الكتاب، أن الانتفاضات العربية، وإن لم تؤت ثمارها بتغيير إيجابي على الصعيد السياسي، فإنها قد نجحت بتغيير وتطور دراسة اللغة العربية في عدد من البرامج الغربية، وعبر النظر للعامية بوصفها لغة تغيير، وباعتبارها وثيقة تتطلب اهتماما وحسا واهتماما بحثيا مختلفا، وهي اهتمامات ما تزال بعيدة قليلا عن حاضر معاهدنا وجامعاتنا العربية.
٭ كاتب سوري
القدس العربي




