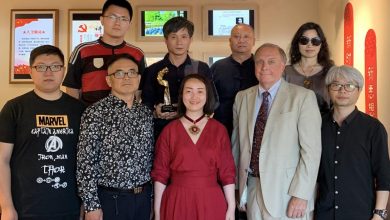أغنية حب لـ ج. ألفرد بروفروك/ ت. س. إليوت

ترجمة: أنس طريف الحوراني
لنمضِ إذاً، أنت و أنا،
حين ينتشر المساء في السماء
كمريض مخدر و ممدد على طاولة؛
لنمضِ في بعض الشوارع نصف الخالية،
تتراجع همهمات
الليالي القلقة في فنادق الهوى الرخيصة
و المطاعم المُغبرة بمحاراتها:
شوارعٌ تلاحقك كجدالٍ مضجر
سيء النية
لتقودك إلى سؤال يغمرك…
آه، لا تسأل، ‘ما الأمر؟’
لنمضِ و نقم بزيارتنا.
في الغرفة حيث تروح النساء و تجيء
يتحدثن عن مايكل آنجلو.
الضباب الأصفر الذي يحك ظهره بزجاج النوافذ،
الضباب الأصفر الذي يحك خطمه بزجاج النوافذ،
لحس بلسانه زوايا المساء،
و توقف عند البرك المتشكلة في المجاري،
و ترك سواد الدخان المتساقط من المداخن يحط على ظهره،
و مر من الشرفة، و قام بقفزة مفاجئة،
ثم تكوّم، لكونها ليلة أكتوبرية رقيقة،
حول المنزل، و نام.
و بالفعل سيكون هناك وقت
للأفعى الصفراء المنزلقة على طول الشوارع،
التي تحك ظهرها بزجاج النوافذ؛
سيكون هناك وقت، سيكون هناك وقت
لتحضير وجه يواجه الأوجه التي تقابلها؛
سيكون هناك وقت للقتل و للخلق،
و وقت لكل الأعمال و أيام الأنامل
التي ترفع و تدني سؤالاً على طبقك؛
وقت لك و وقت لي،
و وقت أيضاً لمئات الحيرات،
و لمئات الرؤى و المراجعات،
قبل تناول الكعك و الشاي.
في الغرفة حيث تروح النساء و تجيء
يتحدثن عن مايكل آنجلو.
و بالفعل سيكون هناك وقت،
لتسأل، ‘أأجرؤ؟’ و، ‘أأجرؤ؟’
وقت للاستدارة و نزول السلالم،
و بقعة صلع تتوسط شعري –
]سيقولون: ‘كم يتساقط شعره!’ [
و معطفي الصباحي، و ياقتي التي تصل ذقني،
و ربطة عنقي، غنية و متواضعة، لكن دبوساً بسيطاً يثبتها، –
]سيقولون: ‘لكن كم نحيلة هما ذراعاه و ساقاه!’ [
أأجرؤ على
تعكير صفو الكون؟
في الدقيقة الواحدة هناك وقت
للقرارات و المراجعات التي ستعكسها دقيقة واحدة.
قد عرفتها كلها سلفاً، عرفتها كلها –
عرفت الليالي، و الأصباح، و الآصال،
و قست حياتي بملاعق القهوة؛
أعرف الأصوات المحتضرة بسقطة محتضرة
تحت الموسيقى الصادرة عن غرفة أبعد.
كيف لي إذاً أن أجرؤ؟
و قد عرفت الأعين سلفاً، عرفتها كلها –
الأعين التي تثبتك في عبارة مُحكمة،
و عندما أثبت، ممدداً على دبوس،
عندما أثبت، متذبذباً على الجدار،
كيف لي أن أبدأ
بصقَ أعقاب الأيام و الطرقات؟
و كيف لي أن أجرؤ؟
و قد عرفت الأذرع سلفاً، عرفتها كلها –
الأذرع البيضاء، العارية، المرتدية للأساور
]لكن التي تزينها، تحت ضوء المصباح، شعيرات بينة فاتحة![
أهو عطرٌ يفوح من فستان
هذا الذي يجعلني أسرح؟
ذراعان تستلقيان على طاولة، أو تغطيان بشال.
أوعلي حينئذ أن أجرؤ؟
و كيف لي أن أبدأ؟
أعلي أن أقول، مضيت عند الغسق إلى الشوارع الضيقة
و رأيت الدخان المتصاعد من غلايين
الرجال الوحيدين المرتدين قمصاناً بنصف كم، و هم يميلون خارج النوافذ؟…
كان عليّ أن أكون زوج مخالب غير مشذبة
تجوب قاع البحار الصامتة.
و الأصيل، المساء، ينام بكل سلام!
و قد مسدته أنامل طويلة،
نائماً… متعباً… أو متمارضاً،
ممدداً على الأرض، هنا بالقرب مني و منك.
أعليّ، بعد الشاي و الكعك و قطع الثلج،
أن أستجمع قواي و أدفع باللحظة إلى أزمتها؟
لكن رغم أنني قد بكيت و صمت، و بكيت و صليت،
و رغم أنني قد رأيت رأسي ]يزداد صلعاً قليلاً[
و قد جيء به على طبق،
لست نبياً – و ليس هذا بالشأن العظيم؛
رأيت لحظة عظمتي تتلألأ،
و رأيت الخادم الأزليّ يحمل معطفي،
و يشخر،
و باختصار، كنت خائفاً.
ثم أسيكون حسناً، في نهاية المطاف،
بعد الكؤوس، و المرملاد، و الشاي،
بين الخزف، في خضم حديث بيني و بينك،
أسيكون حسناً،
العض على المسألة بابتسامة،
و عصر الكون في كرة
تُدحرج باتجاه سؤال غامر،
و القول: ‘أنا لعازر، قم من الموت،
ارجع لأخبرك بكل شيء، سأخبرك بكل شيء’ –
لو كان على المرء، واضعاً مخدة قرب رأسها،
القول: ‘ذلك لم يكن ما عنيته بالمرة.
ذلك لم يكنه بالمرة.’
ثم أسيكون حسناً، في نهاية المطاف،
أسيكون حسناً،
بعد المغيب و الأفنية و الشوارع
المبتلة،
بعد الروايات، بعد كؤوس الشاي، بعد التنانير التي
تجر ورائها أثراً على الأرض –
و هذا، و أكثر منه بكثير؟ –
محالٌ عليّ أن أقول ما أعنيه!
لكن لو أن فانوساً سحرياً فضفض الأعصاب بأنماط
على شاشة:
أسيكون حسناً
لو أن المرء، واضعاً مخدة أو رامياً بشال،
و متجهاً نحو النافذة، قد قال:
‘ذلك لم يكنه بالمرة،
ذلك لم يكن ما عنيته بالمرة.’
لا! لست الأمير هاملِت، و لم يكن مقدراً لي أن أكونه؛
أنا ملازم مستعد لأن يتسبب،
كي يحرز تقدماً، بمشكلة أو اثنتين،
انصحوا الأمير؛ أنا، لا شك، أداة رخية،
مراعية، سعيدة بكونها ذات فائدة،
سياسية، حذرة، و موسوسة؛
فصيحة اللسان، و في ذات الوقت متبلدة؛
و في بعض الأحيان، بالفعل، تافهة –
و في أحيان أخرى، أكاد أكون غبية.
أكبر في العمر… أكبر في العمر…
سأصير أرتدي بنطالي مطويّ الأسفل.
أعليّ أن أفرق شعري في الخلف؟ أأجرؤ على أكل خوخة؟
سأصير أرتدي بناطيل فانيلية بيضاء، و أتمشى على
الشاطئ.
قد سمعت الحوريات تغني، بعضها لبعض.
لا أحسبها ستغني لي.
رأيتها تتجه نحو البحر على الأمواج
تمشط شعر الموج الأبيض إلى الوراء
كلما هب الهواء على المياه بيضاء و سوداء.
بقينا في حجرات البحر
بجانب فتيات البحر المكللات بأعشاب بحرية حمراء و بنية
حتى توقظنا الأصوات البشرية، و نغرق.
__________________________________________________
* 61 لو أني اعتقدت أن إجابتي كانت لشخص سيعود إلى الدنيا أبداً،
لبقيت هذه الشعلة دون أن تحرك ساكناً؛
64 و لكن لمّا لم يكن قد رجع أبداً من هذا العمق إنسان حيّ، إذا صح
ما أسمع، فإني أجيبك دون أن أخشى سوء السمعة.
(دانتي أليجييري، الكوميديا الإلهية، الجحيم: الكتاب 27، الأبيات 61-66. ترجمة حسن عثمان، دار المعارف بمصر).
المصدر: .T.S. Eliot. Selected Poems. San Diego: Harcourt Brace Jovanovic, 1967. Print
S’io credesse che mia risposta fosse
A persona che mai tornasse al mondo,
Questa fiamma staria senza piu scosse.
Ma perciocche giammai di questo fondo
Non torno vivo alcun, s’i’odo il vero,
Senza tema d’infamia ti rispondo.*
—————-
العاشق برفروك في عصر الإنستغرام/ صبحي حديدي
بعد مئة عام ونيف على نشرها، ما تزال قصيدة «أغنية حبّ ج. ألفرد برفروك»، للشاعر الأمريكي ــ البريطاني ت. س. إليوت (1888 ــ 1965) تُلقي بظلال كثيفة على شخصية الإنسان المعاصر، المغترب أو التائه أو الرجيم أو الكسير، العالق في شبكة من المآزق والمعضلات. ولا تجري هذه الإسقاطات في سياق مطالع آلة القرن العشرين الطاحنة وحدها، وقد أعادت إنتاج ذاتها في القرن الراهن، فحسب؛ بل كذلك في إسار مواضعات شتى وليدة أو متجددة، تقذف بها الآلات ذاتها، والتكنولوجيات، التي قيل إنها تتولى التواصل الاجتماعي بين البشر.
أوغست مييرات نشر مؤخراً مقالة في مجلة «المحافظ الجديد» الأمريكية، بعنوان «جيل من البرفروكات»، ساجل فيها بأنّ قصيدة إليوت الشهيرة استبطنت جيلاً كاملاً معاصراً تتطابق صفاته مع شخصية برفروك، وأنّ الشاعر قد تنبأ بهذا النوع من البشر، وتلك الصيغة من علاقات العشق الشرعي (الزواج) وغير الشرعي (الغراميات والتهتك الجنسي)، والتواصل الإنساني الافتراضي عبر فيسبوك وتويتر وإنستغرام وسواها. ولأنّ أطروحة مييرات محافظة في الجوهر، إذْ تدعو إلى قدوة مناقضة لأمثولة برفروك، فإنّ اتكاءه على هذه القصيدة يستلهم إليوت المحافظ والمتدين، صاحب المواقف الرجعية المعلنة. وعلى نحو ما، ورغم أنّ برفروك كان شخصية شعرية محضة، وإذا ذكّرت بنظير فإنّ هاملت شكسبير هو مرشح التذكير الأبرز؛ فإنّ مييرات يرى في القصيدة وثيقة صالحة لمناهضة الانحدار الأخلاقي الراهن، على عكس ما توخى الشاعر منها في واقع الأمر، وطبقاً لغالبية القراءات النقدية.
ولا يخلو هذا من وجهة نظر سليمة الأركان، إذا استرجع المرء تصريح إليوت الشهير بأنه ملكي في السياسة وأنغلو ــ كاثوليكي في الدين وكلاسيكي في الأدب. ستيفن سبندر، في كتابه الممتاز «ت. س. إليوت»، الذي قد يكون العمل الأفضل عن الشاعر حتى اليوم، يرى أنّ جملة الآراء السياسية المبثوثة هنا وهناك في قصائد ومسرحيات ومقالات إليوت تظلّ من حيث الجوهر صادرة عن رجل يؤمن بضرورة انبثاق النشاط السياسي من المبادئ المجردة، وضرورة ارتكاز الأصول على الدوغما، وارتكاز الدوغما على السلطة الماورائية، وهذه الأخيرة لا تضمنها سوى مؤسسات الكنيسة والدولة الملكية (الموناركية). ولهذا فإنّ إليوت رجعي بالمعنى الحصري للكلمة، في قناعة سبندر وآخرين كثر، إذْ جاهر بعدائه للأفكار الليبرالية، واعتبرها حالة انحطاط لرومانتيكية دفينة عند الإنسان المتوهّم في نفسه الكمال والقدرة على تغيير الثابت؛ كما عارض فلسفة التقدم الاجتماعي التي تنخر البنيان الكلاسيكي الصلب الناجز، وعند هذه النقطة تغنّى بأوروبا العصور الوسطى، وما شهدته من وحدة في الإيمان، ومن توافق في القيم الاجتماعية.
ومع ذلك، ومنذ أن سطع نجمه في سماء الأدب الحداثي، تتابع أجيال الدارسين المتضادات الصارخة التي تصالحت عند إليوت: النزعة التقليدية المتشككة، الكلاسيكية الرومانتيكية، التحرّر من الذات بصورة مفرطة في ذاتيتها، دهشة المحافظ الناظر إلى نفسه في مرآة سديمية، المنقلب في غبشها إلى مَلَكي أنغلو ـ كاثولكي. وفي ثنايا ذلك كله كانت ترتسم صورة الرجل الذي أثار المجابهة الأهمّ في زمانه بين الشخصية الروحية السلبية للعالم المعاصر والشخصية الروحية الإيجابية للموروث، وتعايش عنده الماضي والحاضر في تركيب متوازن من الرموز المتصارعة. وما اقترابه من حدود الفاشية، دون الولوج إلى ظلامها للإنصاف، سوى مظهر آخر من مفارقة مركزية ظلّت تحكم مسار رجل كسر القالب الرومانتيكي للشعر في نقطة الذروة من صلابته ورسوخه، ليرسي دعائم «حداثة كلاسيكية» متينة؛ لم تفلح، مع ذلك، في الفرار من الشبح الرومانتيكي، على قياس هاملت مثلاً، ولم تنجح في تفادي ضغوطات روح العصر.
والحقّ أن آراء إليوت السياسية كانت تشبه، في عناصر كثيرة، تلك المواقف التي دفعت بعض معاصريه، وأبرزهم مجايله وصديقه الشاعر إزرا باوند، ليس إلى المسيحية، بل إلى الفاشية. وأمّا أنه لم ينخرط مباشرة في النشاط الفاشي، فذلك عائد بدرجة كبيرة إلى مزاجه المسيحي الذي يتفوّق على مزاج الميل إلى العقيدة الدنيوية؛ وكذلك إلى عزوفه بصورة عامة عن الانضمام إلى أي حزب سياسي، ويؤمن أنّ الأفكار السياسية تندثر حالما تتحوّل إلى وقائع. ذلك لا يطمس تأثره بأفكار الفرنسي شارل موراس، الذي كان أقوى سند فكري لحكومة بيتان خلال الاحتلال الألماني لفرنسا، واعتُقل سنة 1944، وفُصل من الأكاديمية الفرنسية، وحُكم عليه بالسجن المؤبد.
وعند افتتاح القرن الجديد الراهن، اختارت أسبوعية «تايم» الأمريكية أنّ يكون إليوت شاعر القرن العشرين، لأنه رجّح كفة الشعر في زمن أخذ يميل بقوّة إلى ترجيح الرواية، وكانت قصيدته «الأرض اليباب» بمثابة نهضة حيوية وعمر جديد فتيّ كُتب للشعر، كما عبّرت الناقدة الأمريكية هيلين فندلر في تسويغ اختيار المجلة. لكنّ فندلر، على شاكلة محرّري «تايم»، تجاهلت سلسلة السقطات التي تحفر هوّة عميقة أخلاقية وفكرية وفلسفية وسياسية بين إليوت حامل القِيَم، وإليوت الثاني حامل القصيدة الحداثية. وهذا ما تتجاهله مقالة مييرات اليوم، في بحثها المحموم عن جذور رجعية لقصيدة كانت حداثية تماماً في زمنها، وباتت اليوم قرينة انحلال العاشق المعاصر، ابن أزمنة الإنستغرام!
القدس العربي
أغنية حـبّـي لـ ج. ألفرد بروفروك (1)/ مونيكا لوينسكي (2)
كنتُ في السادسة عشرة من عمري، في حصّة الأدب الإنكليزي في المدرسة الثانوية، في صفّ الـمُدرِّسة «باتروورث»، ولم أكنْ أدركُ أنّ عالمي الأدبي، كما كان في تلك السنّ الحسّاسة، سوف يهتزّ بأكمله.
كان قلبي مُفعماً بهواجس المراهقين في تلك السنّ، ومن منّا لم يكن كذلك؟ فهذه هي السنة الأولى في المرحلة الثانوية، السنة التي نحاول فيها أن نثبّتَ أقدامنا وننسجم مع الآخرين، وفي المقابل، نستميتُ في سبيل تحقيق شخصيّتنا المستقلّة والمتميّزة عنهم.
وسطَ بحر من الخوف والقلق والرغبات المضطربة، قرأت «باتروورث» بصوتها الجَهُور أمام الطلاب: «لنذهبْ معاً، أنا وأنت، حين يتمدّدُ المساءُ على السماء، مثل مريضٍ مخدَّرٍ على فراشه»[3]. وفورَ سماعي لهذه المقدّمة، انخطفتُ وانشدهت.
كان سماعي لها، بمثابة إنهاء علاقة حبّي مع إ.إ. كمنغز وقصيدته «مكانٌ ما لم أذهبْ إليه». فوجدتُ نفسي أخونه وأهجرُه مستسلمةً إلى افتتاني بـ ت.س. إليوت، وغارقةً في عشق قصيدته المتوهّجة «أغنية حبّ ج. ألفرد بروفرورك»[4]. ومنذ عشرين سنة إلى اليوم، لم تخبُ مشاعري تجاهها.
مضى قرنٌ كامل على نشر ت.س. إليوت لقصيدة «أغنية حبّ ج. ألفرد بروفروك»في مجلة «شعر»عدد يونيو 1915. (كل مئة سنة وأنت بخير يا بروفروك). وقد كانت أولى القصائد الكبرى التي ينشرها إليوت، بعدما قام صديقة إزرا باوند بمراجعتها وتنقيحها.
يومها، كان إليوت شاباً يافعاً يكتب بحكمة الشيوخ، كان عمره عشرين عاماً عندما ولدت القصيدة، وستة وعشرين عاماً حين نشرها. كانت بمثابة التجربة الأولى للشابّ الأعذر أدبياً وجنسياً، (تزوّج من «فيفيان هايوود»في ذات الشهر الذي نُشرتْ فيه القصيدة). يا لَها من تجربةٍ مخيفةٍ وخطيرة، حماسيّة وعجيبة. كقوله في القصيدة: «كيف لي أنْ أبدأ؟». كان إليوت -على الأرجح- يبحثُ عن معنىً ما، لهذا العالم المتناقض- المنسجم في تناقضه، لكنه معنى لا يُطال.
خضعت القصيدةُ لعشرات الدراسات والتحليلات والتأويلات منذ نشرها وإلى اليوم، أبياتُها الأصيلة ترسّختْ في ذاكرة الأجيال، وترسّبتْ في وعيهم. مثل: «لنذهبْ معاً، أنا وأنت»، «سيكون هنالك وقتٌ، سيكون هنالك وقت»، «هل سأجرؤ على أكل الدرّاق؟»، «في الغرفة تروح النساءُ وتغدو، يتحدّثنَ عن ميكيل آنجلو»[5]. صياغتُها المتينة ودلالاتُها الإشكاليّة لا زالتْ تسحرنا إلى اليوم: «أقيسُ عمري بعدد ملاعقِ القهوة»، «هل لي بعدَ كل هذا الشاي والكعك ومكعبات الثلج، أنْ أجبرَ اللحظة على بلوغ ذُروتها؟».
وعلى خلاف قصيدة «كيف لي أنْ أحبّكَ؟»لـ إليزابيث باريت براونينج، لطالما أربكتْ «بروفروك»النقّاد وأحارتهم. فقد تضاربت آراؤهم حول كلِّ ما في القصيدة تقريباً، بدءاً من تحديد مَنْ هو المخاطَب بضمير «أنت»في البيت الأول. ومع أن هذه الجدالات الأكاديمية مهمّة، إلّا أنّ السؤال الذي يتردّد في ذهني مختلفٌ عنها: أتساءلُ كيف استطاعت هذه الأبياتُ أن تتغلغل في الثقافة، وفي مختلف أشكالها التعبيرية؟ وأنْ تظهر -أحياناً- في تجلّياتٍ غريبةٍ غير متوقعة، حتى بعد مائة عام على نشرها؟!
فهذا الكاتب ريموند تشاندلر يشير إلى القصيدة في روايته «الوداع الطويل»، وكذلك المخرج فرانسز فورد كوبولا في فيلمه «القيامة الآن». أما الممثلة ميغ رايان فقد أسمتْ شركتها الإنتاجية «بروفروك بيكتشرز»، وها هو المخرج مايكل بيتروني يُعنْوِن فيلمه الأول بـ «حتى توقظنا الأصواتُ البشرية»، وهي العبارة الواردة في نهاية القصيدة. ونرى أيضاً الممثّل جاخ براف يُلقي القصيدة في فيلم «أتمنى لو كنتُ هنا». وفي عام 2000، عبّر الممثل بين أفليك عن إعجابه الشديد بالقصيدة في لقاءٍ أجراه مع ديان سوير، مردّداً أبياتاً منها (يحفظها غيباً) على مسامع المشاهدين:
«لستُ نبياً، وليسَ الأمرُ مهمّاً.
شاهدتُ أعظمَ لحظاتِ حياتي، تتبخّرُ أمامي.
رأيتُ الخادمَ الذي أناولُه معطفي، يسخرُ مني خِلسةً.
باختصار، كنتُ مرتعباً».
كما قام المخرج السينمائي الشهير وودي آلن، بتوظيف القصيدة في ثلاثةٍ من أفلامه. ففي فيلم «شهرة» 1998 يردّدُ الممثل كينيث براناه في مشهد احتضاره: «أنا بروفروك الملعون، بلغت الأربعين توّاً، ولا أريد بلوغ الخمسين، لأكتشف حينها أني قِسْتُ حياتي بعددِ ملاعق القهوة اللعينة». وفي فيلم «الحبّ والموت»1975 تُمسكُ إحدى شخصيّات وودي آلن قلماً بيدها، وتخربشُ أبياتاً من القصيدة على ظهر ورقة. أما ممثلي المفضّل، أوين ويلسون، وأثناء أدائه لشخصية «جيل»في فيلم «منتصف الليل في باريس»، يقولها بكل جسارة: «بروفروك… هي صلاتي المقدّسة»!
تظهر تجلّيات أخرى لـ «بروفروك»في الأغاني الحديثة، فالمغني الأمريكي تشاك دي لديه أغنية بعنوان: «هل أجرؤ على خلخلة الكون؟»، وهي من الأبيات الأشهر في القصيدة. كما قام المؤلف الموسيقي جون كارتون بتلحين القصيدة كاملةً، وإعدادها للغناء.
يمكن للمرء أن يشرب الشاي مع قطعة كعك في مقهى «بروفروك»في لندن، أو يتناول عشاءه في مطعم «بيتزا بروفروك»وسط مدينة لوس آنجلس. وما زلتْ «بروفروك»تصل إلى الأجيال الجديدة، حتى خارج الكتب المدرسية ومناهجها، عن طريق واحدة من أكثر الروايات مبيعاً في العالم، رواية جون غرين «ما تخبّئه لنا النجوم»، فقد وظّف القصيدة ضمن الرواية توظيفاً ناجحاً.
نأخذ روائياً آخر، هاروكي موراكامي، وفي أكثر أعماله بروفروكيّةً «يوميات الطائر الدمية»، نجدُ حالة العزلة التي تعبّر «بروفروك»عنها، وظلال الوحشة التي تخيّم عليها. بالإضافة إلى أسئلة الحقيقة والهوية، وآلام العزلة والاغتراب.
بالنسبة لي، أحسستُ وكأني استعدتُ وطني، عندما انضممتُ إلى شبكةٍ نسوية على الإنترنت، وتفاجأتُ أنّ أكثر من نصف الرسائل الإلكترونية التي وردتْني من أعضاء الشبكة، تضمّنت الأبيات التي تُحبُّـها كلُّ عضوٍ منهنَّ مِنْ قصيدة «بروفروك». والسببُ في ذلك، أنّ عنوان بريدي الإلكتروني يحتوي إشارةً إلى القصيدة. (ما زلتُ مخلصةً لحبّي القديم).
وعلى الرغم من الاحتفاء الكبير بالقصيدة، إلا أنّ شاعرها لم يأخذ حقّه من الاهتمام في الألفيّة الثالثة، إذ توشكُ شهرةُ الشاعر النوبلي على الأفول. ومع أن «بروفروك»تعتبرُ أوّلَ قصيدةٍ حداثوية أصيلةٍ ومُؤسِّسَة، إلّا أنّ جرأة إليوت الحداثوية خضعتْ لترويضٍ طويل، وربما تجاوزتها السنوات، بفعل طُروحات ما بعد الحداثيين، ومَنْ جاء بعدَهم. بالإضافة إلى تأثير موقفه الشخصي الـمُعيب، أعني عداءَه للساميّة. وهذا ما يطرح السؤال القديم المتجدّد: هل المهمُّ في عالم الأدب؛ هو تجربة الكاتب؟ أم تجربة المتلقّي؟ أنا شخصياً أقعُ في تناقضٍ معرفيّ إزاء هذه المسألة، لكن الانتقاداتِ التي طالت مواقف الشاعر، لم تؤثرْ يوماً على شغفي بإبداعه.
في يوم كهذا، في عالمٍ يزخر بتغريدات تويتر والرسائل الصوتية الإلكترونية، في زمن الرسائل النصّية الـقصيرة الواضحةِ المعاني، ربما نحن بأمسّ الحاجة إلى النباهة والحيوية والتكثيف البليغ الموجود في الشِعر، إلى الصور الشعرية التي تحفِّزُ الخيَال، وتُولّدُ فيه صوراً ترسُخ في الذاكرة أكثرَ من الصور التي نتبادلها عبر وسائل التواصل الحديث. ربما يجب علينا أن نستعيد الدافع المحفّز على القراءة، فلا نكتفي بقراءة عناوين الصحف أو عناوين المقالات. نحتاج حقاً إلى قصيدة حبّ تأخذنا إلى جوهر الأشياء.
ولهذا، كما أعتقد، أذهلتْني أبياتُ القصيدة حين سمعتُها لأول مرة، وما زالت تدهشني. كانت «بروفروك»تعلّمني ضرورة امتلاك القوة، رغماً عن كل مخاوفي. تعلّمني «أنْ أُجبرَ اللحظةَ على بلوغِ ذروتها». وكيفَ مِنْ قوة الشعر ذاته، أكتشفُ جمالياتِ الحياة المتنوّعة، «كما لو أنّ مصباحاً سحرياً يكشفُ ما يعتري الأعصاب، فتظهر كخرائطَ على اللوح». إيقاعُ القصيدة وأسلوبُـها السرديُّ البديع، بعد سنواتٍ طوالٍ من درس الإنكليزي الذي أعطتنا إياهُ «باتروورث»، ما برَحَـا يقودانني دوماً إلى «السؤال المُفحِم»، بالأحرى: الأسئلة المفحمة!
في النهاية، ليس المهمُّ لماذا أحبُّ قصيدةً ما، أو ما تعنيه بالنسبة لي، أو لماذا تتغيّر دلالاتها مع مرور السنوات. ما يهمُّ حقاً؛ هو إلى أيّ مكانٍ قصيّ يمكن للقصيدة أنْ تحملكَ إليه؟ هناك… ما وراء المعاني.
هوامش للمترجم:
[1] نُشرَ المقال في مجلة «Vantiy Fair»الأمريكية، عدد حزيران/يونيو 2015.
[2] مونيكا لوينسكي: محرّر مساهم في مجلة «Vanity Fair»، اشتُهرتْ عالمياً في تسعينات القرن الماضي، بعد فضيحة علاقتها مع الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلنتون. شغلتْ عدة مناصب سياسية ودبلوماسية.
[3] تشكّل هذه المقدمة ثورةً على الرومانسية ومفاهيم علم الجمال الرومانسي، فالغروب من المواضيع الأثيرة لدى الرومانسيين، وهو من أشجى المناظر وفق رؤياهم الجمالية. لكن إليوت نسفَ كلّ ذلك، عندما شبّه الغروب بمريض مخدّرٍ مستلقٍ على فراشه.
[4] أغنية حبّ ج. ألفرد بروفروك: القصيدة التي صنعتْ بداية ت. س. إليوت كواحد من أعظم شعراء القرن العشرين، تُعرف اختصاراً باسم «بروفروك»، وربما لا تخلو أنطولوجيا للشعر الإنكليزي أو الأمريكي منها. استفاد إليوت من فتوحات علم النفس الحديث آنذاك، واستخدم فيها أسلوب «تيار الوعي».
[5] لهذين البيتين عدة تفسيرات، منها أنه يصف حالة الزيف والرياء في هذه المناسبات الاجتماعية، إذ تتحدث النسوة عن أمورٍ يجهلنها. وهناك تفسير آخر يقول إنه وضع «ميكيل آنجلو»لكي يناسب قافيةَ البيت السابق المنتهية بـ «go»، كنوعٍ من السخرية من شكل القصيدة السائد في القرن 19، حيث يلتزم كل بيتٍ بقافية البيت الذي يسبقه.
ترجمة: عبد الكريم بدرخان
نزوى