نبيل سليمان: سرديات الطغيان الكبرى/ خليل صويلح
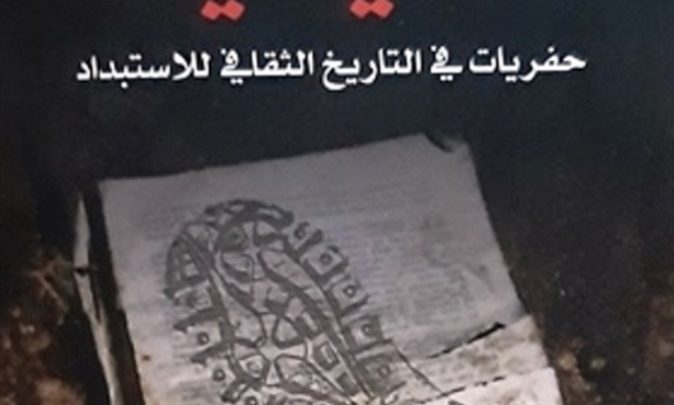
في كتابه «طغيانياذا: حفريات في التاريخ الثقافي للاستبداد» (دار لوسيل ــ الدوحة)، يقتفي الروائي والناقد السوري أثر مفردة «الطغيان» في مختلف الأعمال الفنية، وقوة حضورها في النسيج الثقافي العربي، محاولاً تفكيكها من الداخل، في مشهديات متجاورة تشكّل مجتمعةً، جدارية ضخمة وراسخة في المخيال العربي
لا ملاحم لدينا اليوم عدا الطغيان. ليس لدى هوميروس أو فيرجيل أو أرخيلوخوس ما يفعلونه في هذه الخريطة الممزّقة إلا تفكيك معجم الطغاة بنسخته العربية. الوليمة دسمة بما يكفي في «طغيانياذا: حفريات في التاريخ الثقافي للاستبداد» (دار لوسيل ـــ الدوحة) بتوقيع نبيل سليمان. يقتفي الروائي والناقد السوري أثر مفردة «الطغيان» وقوة حضورها في النسيج الثقافي العربي، محاولاً تفكيكها من الداخل، في مشهديات متجاورة تشكّل مجتمعةً، جدارية ضخمة وراسخة في المخيال العربي. لكن «طغيانياذا» لا تلجأ إلى الشعر وحده في وصف رحلة التيه العربية، إنما تمزج أجناساً إبداعية مختلفة لرسم الصورة الكاملة للاستبداد ومواجهته ميدانياً بنقض ثقافة الطغيان بعدما بلغ العنف أقصاه، على عتبة الألفية الثالثة، ناسفاً أي سردية أخرى بالمقارنة مع «سردية الطغيان الكبرى» التي تمثّلت في انزلاق النخب الثقافية نحو موائد السلطة وتسويق خطابها، باحتلال موقع الرقيب الرسمي، بدلاً من مواجهته بما يسميه صاحب «مدارات الشرق» (الاستبداد الديمقراطي أو الديمقراطية المستبدّة) منادياً بعودة المثقف النقدي، ونبذ المثقف المتواطئ (المثقف السمسار)، بقصد هدم ونقض ثقافة الطغيان، متكئاً على المدوّنة الروائية في المقام الأول، والكتابات الفكرية الموازية، وتفكيك صورة «الطغيان العولمي» بوصفه وجه العملة الآخر للطغيان المحلّي.
في «فضائيات للطغيان»، ينظر إلى الأداء الإعلامي الطائفي الذي تنفثه بعض المحطات الفضائية بجرعات مركّزة للتطرّف، ثم يعرّج على الأغنية في زمن الطغيان، سواء في التحريض على زمنٍ آخر، أو لجهة الانحطاط والإسفاف في المحتوى، مستعرضاً مجموعة من الأغاني التي تمّ تداولها واستثمارها في سنوات الزلزال العربي، خصوصاً تلك التي نسجت كلماتها على ألحان أغانٍ شعبية متوارثة. ولكن هل للغة حصتها من الاستبداد؟ يجيب بأن الاستبداد يعمل على تزييف الكلمات والعبارات بمنحها مدلولات جديدة، خصوصاً في السنوات الدامية (شهيد هنا، وقتيل هناك أو العكس) وفقاً لاصطفاف هذه الجهة الإعلامية أو تلك، كما ستنتقل كلمة «معلّم» من الاستبداد التربوي إلى الاستبداد السياسي والاجتماعي والعسكري. وهناك لغة تتستّر بالدين تأخذ العبارة من فضاء لغوي إلى آخر (الكفاح/ الجهاد). ويرصد صورة المثقف «بين مطرقة الحرب وسندان الطغيان» بحشر المثقفين في سلّة واحدة، ويتساءل: «هل يستوي المثقفون المكبلون بالخوف والعجز مع المكبلين بالأنانية؟»، مستنكراً تحميل المثقفين أوزار القامعين وعجز المعارضين، منذ أن لُفظ السياسي المثقف خارجاً، وتُرك في العراء والهامش.
قاموس الطغيان سوف يستدعي مصطلح «البلطجي» أو «الشبّيح»: البلطجي حامل البلطة، والشبيح: المتسلبط والمتنمّر، في استعارة من ممدوح عدوان في كتابه «حيونة الإنسان». إذ تشتبك مدونة نبيل سليمان وتتقاطع مع هذا الكتاب في مطارح كثيرة، قبل أن تتوغّل في تشريح مصطلحات أخرى مثل «الشبّيح المعارض»، و«الشبّيح المثقّف»، و«الشبّيح غير المثقّف»، وسيجمعها في عبارة واحدة من عبد الرحمن الكواكبي هي «أُسراء الاستبداد». هكذا يمزج نبيل سليمان بين ما هو سوسيولوجي وفكري وأدبي بنظرة خاطفة ومكثّفة لمفردات مثل «عنف»، و«قصل»، و«لذّة الصورة»، فيما يتناول في الفصل الثاني من كتابه «أخيولات الطغاة» مفتتحاً بـ «المبرراتي ويليه التيس» بناءً على قراءات نقدية في الروايات التي رصدت صورة الديكتاتور، كما في أعمال ماريو بارغاس يوسا «حفلة التيس»، وواسيني الأعرج «أصابع لوليتا»، وبوعلي ياسين «خير الزاد من حكايات شهرزاد».
كما سيقيم محكمة للطاغية باستدعاء شخصيات من روايات (أبو بكر العيادي، وعبد الستّار ناصر، وهاني الراهب، وبنسالم حميش وآخرين)، بالإضافة إلى مقاطع سردية للمؤلف مجتزأة من عمله الذي لم يكتمل «مرآة الأحوال»، مما يشحن مدوّنته بما هو ذاتي في توصيف وقائع الدم والخراب والعنف. لاحقاً، سيستدرك ما كان غائباً، فيستعيد «أصناف الطغاة»، شرقاً وغرباً، بدءاً من طغاة أثينا وإسبرطة وحتى اليوم، مستنجداً بما قاله محمد الماغوط يوماً «الطغاة كالأرقام القياسية، لا بد أن تتحطّم في يومٍ من الأيام». وفي «ألوان من الطغيان»، يتوقّف عند الصراع بين الشاعر والطاغية في نماذج شعرية، ثمّ بين الكاتب والرقيب أو «الرابوق» وفقاً لتسمية بوعلي ياسين في «الثالوث المحرّم» وما تلاه من عناوين تؤسس لهذه العلاقة الكابوسية. هكذا فضح الجزائري رشيد ميموني في روايته «النهر المحوّل» صورة الرقيب وخياراته المطروحة على الكاتب «الارتداد، أو السكوت، أو المنفى». كما سيهجو الروائي الليبي محمد الأصفر الرقيب علناً في روايته «عسل الناس» بقوله: «يقوم بإحراق الكتب والمجلات شخصيّاً، فهو العين الساهرة على سلامة الناس كما يسميه أصحابه». الرقيب أو «المكتوبجي» مهنة راسخة في الموروث الشرقي على نحوٍ خاص. لذلك فهو يحضر كشخصية روائية في أعمالٍ عربية كثيرة، وفي هموم الكتّاب. يقول أدونيس: «الرقابة لا تخنق الكاتب وحده، وإنما تخنق اللغة أيضاً. ففي الرقابة تضيق حدود اللغة وتنكمش إمكانياتها وحركيتها وطاقاتها». ويضيف: «تبدو الرقابة كأنها نوع من المحو: محو اللغة، ومحو الفكر، ومحو الإنسان بوصفه كائناً مبدعاً». ويذكر صاحب «سمر الليالي» حادثة شخصية تتعلّق بمصادرة كتاب كان يحمله في حقيبته، على أيدي مباحث أحد المطارات العربية، واحتجازه لليلة واحدة انتهت بدفع «برطيل» أو رشوة لإطلاق سراحه. ملحق كلمات




