من وقائع «العفو» والانتظار/ لين فرح
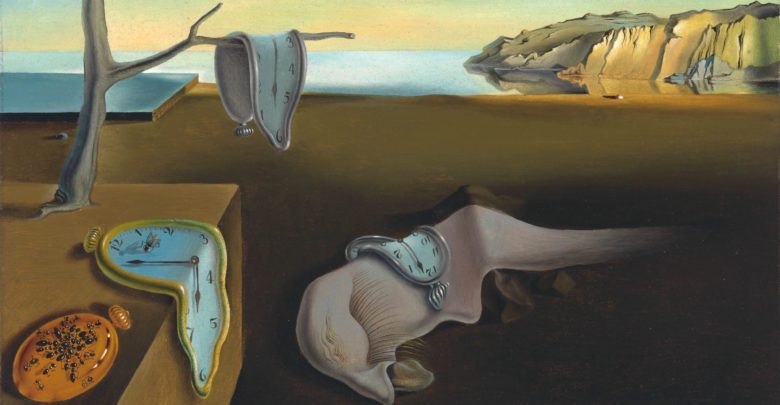
1999
رن جرس الهاتف، ومع خدمة الكاشف التي كانت قد أدخلت حديثاً إلى نظام الاتصالات في سوريا، عرفنا أنه رقم خارجي. أتاني صوت عمتي وهي تصرخ لاهثةً وكأنها على وشك الإصابة بانهيار عصبي: «ولك قريت إسمه بالجريدة! والله العظيم! كان مكتوب غلط بس هو إسمه! قايلين إنو في عفو… وإسمه… مكتوب… غلط!».
أغلب ذكريات تلك المرحلة وما سبقها تتعلق بحالة الانتظار، في العام 1992 لم يكن بعضنا على علم حتى بأن أحد والديه (أو كليهما في حالات كثيرة) معتقل سياسي، كنّا صغاراً بما يكفي لنصدق كذبة كبار العائلة حول أنهما سافرا للعمل في مكان بعيد لتأمين حياة أفضل، وكان فقر التكنولوجيا حينها يساعد بشكل أو بآخر على تصديق الكذبة، فمجرد حجة أن مكان العمل ليس فيه هاتف كانت كافية لقبولنا بالغياب التام، وإن كان لسنوات خمس كاملة. وأما ما يتبقى من الحضور العظيم لذينك الكائنين، فكان يختصر بالذكريات التي ترويها الجدات، والرسالة المحملة بالأشواق والتوصيات بحسن التصرف والوعود بمستقبل مشرق، والتي كانت إحدى الخالات أو العمات اللطيفات تتولى أمر كتابتها بالسر، وقراءتها لنا بين نوبتي بكاء، نحن الأطفال الواقعون تحت وطأة اليتم المؤقت.
ولكن مع شائعات العفو الكثيفة في العام 99، بدأت الحياة تتخذ شكلاً آخر. كانت إشاعة العفو بالنسبة لنا (أطفالاً ومراهقين) مناسبة لعيش مرحلة التحضيرات السعيدة للزيارة الشهرية، وإنما لفترة أطول هذه المرة. كانت تحضيرات الزيارة تستمر يوماً كاملاً قبل موعدها، يتم فيه تحضير الأطعمة وشراء الحاجيات اللازمة، أما شائعات العفو فهي تعني أن المنازل ستبقى لأيام طويلة (طالما استمرت الشائعات) تعبق بروائح الطبخات المشتهاة التي يحبها الغائبون، وأن الأمهات ستصبحنَ أجمل. وستترافق تلك المرحلة مع ظهور ابتسامات تعلو الوجوه بلا مناسبة، ملابس قديمة تم تجديدها وإصلاح ما تلف منها بعد فترة طويلة من التخزين، سيقان ناعمة نجهل تماماً من أين جاءت.
ما أذكره عن تبعات إشاعات العفو هو الحنق المستمر الذي لم نكن نحن الصغار نعي سببه. الخيبة والعجز كانا يلفّان كل المظاهر الاحتفالية السابقة.
لم أتمكن حتى الآن من فهم سيكولوجيا الأمهات والزوجات والعاشقات اللواتي خاب أملهنَّ حينها، كل ما يمكنني تذكره وكان بإمكاني إداركه في ذاك السن هو أمران اثنان: أولاً أن ذلك الانتظار كان ينتهي بمرارة عجيبة، مرارة لم أشهد مثلها بعد ذلك، حتى بعد خذلان الحياة المتكرر اللاحق! وثانياً أنه ربما لم يخرج لأن اسمه مكتوب غلط!
2000
في العاشر من حزيران، خرجتُ من دوامي المسائي في دورة التحضير للشهادة الثانوية، كان الجو العام أمام المعهد يشي بحدوث شيء رهيب، الطلاب يتهامسون ونظراتهم خائفة.
سمعتُ الأمر همساً ولم أصدق، لم أستطع حينها استيعاب أن المعجزة قد حصلت، كنتُ أظن أن الموت هو أمر يحدث للناس العاديين مثلي ومثل من أحبهم، وليس لجبار قادر على التحكم بحيوات البشر. ذهبتُ إلى كشك الهاتف عند الشارع الرئيسي، وطلبتُ رقم المنزل، كلمة واحدة كانت كافية ليأتيني صوت أمي حاسماً: «تعالي فوراً».
– «يعني بابا…. !!؟».
– «تعالي فوراً!».
كان ممنوعاً عليَّ أن أركب سيارة أجرة لوحدي إلا في حالات اضطرارية، لم أكن قد بلغت السابعة عشرة بعد وبالنسبة لفتاة ربّتها أمها وحيدة، كان الخوف عليَّ مضاعفاً، ولكن الحدث العظيم كان كفيلاً بجعلي أتخلى عن أي حذر.
نزلتُ من سيارة الأجرة تاركةً السائق المذهول والمذياع الذي كان قد بدأ ببث القرآن، وتابعتُ ركضي إلى المنزل، وقُعت وقُطع حذائي فتابعت الركض حافية، وأنا أردد كالمسرنمة: «بابا، بابا، بابا!». وكأنه كان ينتظرني هناك!
كيف ستكون رائحته… صوته وشكله عندما يستيقظ، هل سيكون ليديه الملمس البارد نفسه الذي كنت أجدهما عليه أثناء الزيارة؟ وفي حال كانتا كذلك، هل سيردُّ عليَّ إذا أثرتُ موضوعهما بالمثل الفرنسي الذي يقول «يدان باردتان… قلب دافئ»؟؟
دخلتُ إلى المنزل، كان الجميع يبكي «فرحاً»، وأحد أبناء العمومة النبيهين -والذي لا يعرف العم الغائب- علَّقَ أن دموع الفرح تشبه دموع الحزن.
مرت أربعون يوماً، ولم يُبدِ الرئيس الجديد اليتيم أي نية لإصدار عفو للإفراج عن معتقلي الرأي، الذين قام والده المرحوم بسجنهم مراراً طوال أربعين عاماً استمرها وجوده على رأس النظام.
مرت سنة بعدها قبل أن يخرج والدي نتيجة «عفو»، بعد أكثر من أربعة عشر عاماً قضاها في المعتقل، وقبل شهور قليلة من انتهاء مدة الحكم. منذ ذلك الحين، أصبح لكلمة «عفو» بالنسبة لي طعم علقم مضاعف.
*****
2007
العام 2007 كان موعد الاستفتاء على ولاية رئاسية جديدة، كنتُ سعيدةً بعملي في واحدة من أكبر الشركات في البلد، بغض النظر عن كونها تابعة للواجهة الاقتصادية الرئيسية للنظام.
وزعوا علينا قبّعات طُبعت عليها صورة الرئيس، وأعلاماً وأقراصاً مضغوطةً تحوي أغانٍ تم إنتاجها حديثاً من وحي المناسبة. لم أستطع رميها، احتفظتُ بها في الدرج، ثم أخذتها معي في نهاية الدوام كي أتخلص منها وأدعي نسيانها.
كانت إشاعات العفو مرافقة للانتخابات، وكنتُ أمني نفسي بعودة أخي ثائر إلينا بعد مرور الذكرى الثانية لاعتقاله، إثر تقرير يدينه بتهمة العمل على إسقاط النظام، وذلك بعد سنوات من مشاركته في أحد منتديات «ربيع دمشق». كنتُ أعتقد -ربما- أن مشاركتي في احتفالات الصيف، قد تكون كافية لأنفي تهمة الـ «ربيع» عن أخي… كانت مخاوفي تتسع لكل الفصول!
دخلت إلى مكتبي في صباح اليوم الموعود تجتاحني مشاعر متناقضة، «إياكِ والتهرّب… الإجازات ممنوعة في هذا اليوم، حتى الإجازات المرضية، غيابكِ سيكون وصمة عار في سجلك الوظيفي، ولن يفيد أخاك في شيء».
شغلّتُ جهاز الكمبيوتر وفتحت موقع يوتيوب، كانت أغاني السي دي الجديد تصدح في المبنى كله، اخترتُ أنا أغنيتي «أنا بتنفس حرية ما تقطع عني الهوا»، ولكني خشيتُ أن أرفع الصوت عالياً.
ساقوني يومها لارتكاب الخيانة الأولى، لم أكن قد شاركت في استفتاء من قبل، بصراحة لم يكن الأمر يعنيني، كما لم يكن صوتي يعني أحداً، لكن إظهار الولاء هذه المرة كان من متطلبات الوظيفة… والحفاظ على أخي.
2014
الحادي والعشرون من أيار 2014: المكان، نزلة المالكي باتجاه مكتبة الأسد في دمشق، كانت لافتات التأييد والاحتفال المسبق تحتل جانبي الطريق، والمدينة تبدو كفتاة ليل انتُهي من أمرها، عارية بالرغم من خرقها الكثيرة، وقحة، وغير مُشتهاة. ولكنك إن اقتربت أكثر كان بإمكانك ملاحظة كحل العينين يسيل على وجنتيها، وبإمكانك اشتمام رائحة الدمع.
كنتُ أنتظر العفو أيضاً، هذه المرة لأن ثائر لم يستطع كبح الدماء التي تجري في عروقه والتي تشبه اسمه، فبعد خروجه بأربع سنوات تم اعتقاله مرة أخرى بعد إصابته في إحدى المظاهرات في أواسط العام 2012.
حزيران 2014: المكان، غرفتي بعد أن عدت من زيارة صديقة في سجن عدرا للنساء.
رفضت فاتن أن تنتخب، رغم أنها في مكان لا يخولها القبول أو الرفض. هناك يفترض أن تصبح كل الأفعال بلا معنى، والهدف الوحيد هو النجاة، لكن فاتن لم تكن لتقبل أن تقوم بأي فعلٍ خالٍ من المعنى.
التقيتُ فاتن للمرة الأولى في العام 2011، كانت المظاهرة الأولى التي أشارك فيها، ويومها لفتت نظري تلك الصبية المليئة بالطاقة والأمل، وعندما أخبروني أنها أصيبت بطلقة قبل ثلاثة أيام اندهشت، اقتربت منها وسألتها ما إذا كانت مجنونة كفاية لتشارك في مظاهرة قد تضطر فيها للجري تحت وابل من الرصاص وجرحها ما زال طازجاً، فأجابتني: «الحرية بتنكتب بالدم!». نعم كانت مجنونة كفاية، وأنا كنت جبانة بما يكفي بسبب خوفي على ثائر، لكن ليس بعد جوابها ذاك!
واليوم عرفتُ أنه، بالنسبة لفاتن، الكرامة أيضاً «بتنكتب بالدم»! بدأت أبحث عن أخبارها على الانترنت كالمجنونة، بحثت أيضاً عن الفيديو الخاص بتلك المظاهرة التي جمعتني بها، كان ما قامت به مبرراً كافياً بالنسبة لي كي أشعر بأمل جديد، أنا لست وحدي… أنا لست وحدي! فاتن ما زالت هنا، وهي ليست وحدها أيضاً، مئات الفاتنات والثائرين ما زالوا يحاولون الصمود هنا وهناك، وفي داخل كل منهم العديد من الأفعال ذات المعنى.
التاسعة والنصف من يوم الرابع من حزيران 2014: أُعلنَت نتيجة الاستفتاء التي لم يكن أحد منا بانتظارها، ورافقها إعلان العفو الذي لم يكن مُنتظراً أيضاً، كلاهما كانا سيان! وحدهما فاتن وثائر كانا مُنتَظرين بما يكفي، ولكنهما لم يرجعا!
*****
كانون الأول-2015
الساعة الثالثة بعد منتصف الليل، البرودة تلسع أطرافي، أمشي في شوارع بيروت الباردة، وحنيني لا يدفئني، رغم ذلك بيروت أكثر دفئاً من دمشق، دمشق التي كنت أظنها أكثر مدن العالم دفئاً.
ولكن بالطبع، فبيروت مدينة ساحلية، ولكن هل تعرفون أي المدن هي ساحلية أيضاً؟ اللاذقية.
بعد زيارة أمي الأولى لبيروت، لطالما قالت إن لدينا أجمل شاطئ في العالم، «بس الحكومة ما بتهتم فيه»، هنا أيضاً لا يهتمون… ليس مهماً، المقارنة ليست مهمة وكذلك اهتمام الحكومة أو عدمه، المهم الوحيد هو أنني هنا في بيروت، وأن أمي هناك… بين دمشق واللاذقية!
على شرفتي زرعتُ شتلة ياسمين، لطالما تهكمتُ من مقولة «دمشق مدينة الياسمين»، ولكن ياسمين مدينتي بدأ يجتاحني منذ أن بدأ الحنين يتسلل إليّ.
خرجتُ من دمشق مرغمة بإذن مغادرة لمرة واحدة، صادر عن محكمة الإرهاب، وصلت إلى الحدود السورية وأنا أحمل موبايلي في كفي مفتوحاً على صورة تحوي رقم كتاب المحكمة المرسل إلى إدارة الهجرة والجوازات، لأشهرها في وجه ضابط الحدود إن اضطررت، الـ«ون واي تيكيت» خاصتي حسب تعبير سيادة القاضي، الذي أعطاني حريتي وأطلق يديّ.
الساعة الثالثة بعد منتصف الليل، أسير وحيدة في شوارع بيروت، وتنهمر مني الدموع نفسها التي انهمرت لحظة عبرت السيارة الحدود بين البلدين، شهقت شهقة طفل ولد لتوه من رحم ميت، وفي اللحظة نفسها طعن خنجر قلبي، عندما خطر لي فجأة أنها النظرة الأخيرة.
ألم… خدر يسري من القلب وحتى أطراف الأصابع.
بدأتُ حياة جديدة هنا، أحاول أن أحياها من خلال التفاصيل الصغيرة، بعد أن فقدت الكبيرة معناها. لكن كل تفاصيل حياتي هناك تلاحقني، أجلب البن من سوريا لأني قررت بيقين مطلق أن للقهوة هنا طعم التراب.
الحنين لعبة خادعة جداً، دمشق التي أحنّ إليها هي التي كانت قبل أواخر ال2012، وكل ما حدث بعدها لمدينة من المستحيل على أي كائن عاقل اشتياقها، اختفى تماماً من ذاكرتي.
في مشهد من مسلسل سوري، تسأل الممثلة حبيبها الفلسطيني: «إذا رجعت فلسطين بترجع؟»، فيجيبها بعد أكثر من ساعتين أنه طبعاً سيعود. فتضحك هي مستغربة، لأن سؤالها أصلاً لم يكن منطقياً!
مؤخراً بدأ السؤال يلح عليّ: «إذا رجعِت سوريا برجع؟»، ولكن ما هي احتمالات أن «ترجع»؟ كون الاحتمال الأول الذي كنت أحلم به أصبح غير منطقي، فالاحتمال الوحيد الباقي هو أن «يُسمح لي بالعودة»، احتمالٌ يخجلني حتى مجرد التفكير فيه، ولكنني أنتظره انتظار المعتقل لإخلاء سبيله، ليس لأنها الحرية التي حلمَ بها، وإنما لأنه ببساطة اشتاق لرائحة سريره.
لا أدري ما الذي يدفعني للخجل أكثر، شعوري تجاه الموضوع أم ردة فعل الآخرين… «هو لن يرحل… طيب… إن فقد جميع من تعرفينهم الذاكرة ونسوكي تماماً… شو؟؟ بترجعي؟!».
كنتُ دائماً أحاول تجاهل حماس أمي، لهفتها وهي تنقل أخباراً من الجارة «قال في عفو قادم!»، وأنظر إليها بحنق وأنا أردد «أعتقد أنك أنت من يجب عليها المغادرة، بدلاً من أن تتمني عودتي إلي ذاك المستنقع!». ولكن عليّ الاعتراف بأنني منذ مدة أصبحت أنا من تتابع أخبار الجارات، وصفحات التواصل الاجتماعي، ونشرات الأخبار.
أتواصل مع المحامي بشكل شبه يومي لأعرف إن كان لديه أي جديد بخصوص قضيتي:
– «تأجيل غيابي!».
– «طيب طالما أنه لم يحكمني حكماً غيابياً هل برأيك هو بانتظار العفو؟ في هيك إشاعة؟»
أفكر بكل الاحتمالات، بالعار الذي قد أعيشه أمام نفسي إن أنا رجعت إلى حضن الوطن، بالأحكام المسبقة التي قد تُطلق عليَّ هنا وهناك، بوحشة أمي في وحدتها إن أنا لم أرجع، والأهم من هذا كله… وحشة روحي ذاتها!
ما الذي أفكر به؟! الساعة الثالثة والنصف بعد منتصف الليل، جلستُ على طرف الشارع وأشعلت آخر سيجارة، وحيدة كبائعة الكبريت الصغيرة بدأتُ بإشعال أعواد الثقاب واحداً بعد الآخر، وفي اللهب رأيتها… دمشق قبل أواخر العام 2012… لم أعد أشعر بالبرد.
*****
شباط – 2016
«إلى سيادة القاضي رئيس محكمة الجنايات لقضايا الإرهاب المحترم… مع رجائي بأن تنظر عدالتكم في قضيتي بعين الرحمة والشفقة».
– هل هذه الصيغة مناسبة؟
– مناسبة!
– هل سنخرج إن كتبنا طلب الاسترحام؟
– لا أعرف!
لم أعد أعرف شيئاً ولا أبالي، لم أعدُّ حتى أحسبَ الأيام، في البداية كانت كلمة «عفو» تستفزني، كنت أهزأ ممن يتمنينَ العفو، فأنا لا أريد لأحد أن يعفو عني. وكانت ترنُّ في أذنيَّ جملة «العفو عند المقدرة» وهم ليسوا بقادرين! لا أحد يمكنه أن يكون قادراً على منحي عفواً عن جناية لم أرتكبها.
كان الانتظار العلني بالنسبة لي اعترافاً ضمنياً بذنبي وبمقدرتهم، اعتراف لم أكن أملك الجرأة على تقبله وتجرع مرارته، لذا كنت أرفض حتى مجرد الحديث عن هذا الاحتمال، فأنا أفضّلُ أن أبقى سجينة.
المرة الأولى التي فاجأني بها ضعفي تجاه هذا الموضوع كانت بعد عدة أشهر، يوم أعلن التلفاز وفاة «السيدة الأولى».
– توفيت أمه… لا بد أن هناك عفواً قادماً!
– لماذا قد يقومون بذلك؟
– حتى نقوم بالدعاء للمرحومة ربما!
– دعاء؟!! هه!! هل تظنين أنه يتوجب علينا الاحتفال؟
– لست أدري، ولكن لا يبدو الأمر لائقاً! للموت حرمته بكل الأحوال.
– حسنٌ إذن! فلنحزن جميعاً! يا رب يصدر العفو!
يومها بدأ يأسي يتملكني على ما يبدو، فأسوأ ما يمكن أن يحدث لك إن كنت مؤمناً بعدالة قضيتك، هو أن تتمنى الخروج من سجنك بأي ثمن.
أذكر في مراهقتي حملة شنتها قريبات لنا وزوجات معتقلين للضغط على أزواجهنّ للتوقيع، في البداية لم أفهم سبب السجال، ما هو التوقيع الذي يستدعي كل هذا الحزن والدموع؟ لأكتشف لاحقاً أنهنَّ كن يردنَ منهم توقيع ورقة يقومون فيها بالتعهد بعدم ارتكاب أي فعل يمس بهيبة الدولة… اعترافٌ ضمني بالذنب، وكان موقفي غير واضح بخصوص ما إذا كنت أتفهم الرغبة والعجز اللذين تشعر بهما تلك النسوة، أم أتفهم رغبة رجالهنَّ بالحفاظ على ما بقي من كرامة.
وها أنا ذا أعيش الصراع ذاته بين نفسي ونفسي.
اليوم طُلب منا كتابة «طلبات استرحام» للمحكمة الموقرة، لم أستطع أن أقول لا وأنا أتذكر نظرة الذعر في عيني أخي في المحكمة منذ أيام، عندما كان من المفترض أن تكون الجلسة للنطق بالحكم. طبعاً حظيتُ بتأجيل لثلاثة أشهر كحال جميع زميلاتي، وتم تأجيل الذعر!
كيف يمكنك أن تطلب الرحمة من جلادك بكامل العنفوان، كان الاختبار صعباً جداً، ومن المستحيل اجتياره دون الشعور بالقليل من الاحتقار للذات.
على حائط المهجع الأول من الجناح الرابع عُلّقت قصاصة مقطوعة من مجلة الشرطة، كتب عليها: «الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 9-6-2014». كان ممنوعاً علينا نزعها، كانت قد عُلقت أساساً بسبب وجود صورة الرئيس عليها، لكنها بالنسبة لنا كانت كتميمة، كرقية، فيومياً كنا نقوم بتذكير أنفسنا بأنه طالما أصدر عفواً في الماضي، فلا بد من أن يقوم بإصدار غيره في المستقبل!
السادس والعشرون من آب-2016
اختارت دانيا الصفَّ الأول أمام شاشة التلفاز، افترشت الأرض وهي تسند خدها براحة يدها وجسدها يهتز إلى الأمام والخلف، بينما يدها الأخرى تمسك بقضبان السرير الحديدية، وكأنها تحاول أن تبحث عن سند لتبقى منتصبة القامة.
«راحت البلد! راحت البلد»، تُخفض صوتها خوفاً من أن يسمعها أحد، «راحت البلد!» تهمسها همساً وتنهمر دموعها دون أن تبكي فعلاً، وكأنها تخاف أن «تروح» البلد فعلاً وتصبح مخاوفها واقعاً في حال صرخت باكية.
ولكن البلد راحت فعلاً يا دانيا، وما تشاهدينه على التلفاز هو الحقيقة الواقعة، ففي الخامس والعشرين من الشهر، البارحة تحديداً، توصل النظام إلى اتفاق مع الجيش الحر يقضي بتسليمه المدينة، مقابل خروج المدنيين منها إلى مراكز الإيواء في مناطق سيطرة النظام، وإجلاء المقاتلين وذويهم إلى محافظة إدلب بعد تسليمهم سلاحهم المتوسط والثقيل.
المدنيون والمقاتلون وذووهم، هل تعرفينهم يا دانيا؟ هم أهلك الذين قضيتِ حتى الآن سنتين هنا بتهمة تمويلهم، سيغادرون غداً آخذين معهم قضيتك وإيمانك، ماضيك ومستقبلك، وسيتركونك هنا مرغمين، أسيرة الحاضر اللعين.
لم تنم دانيا تلك الليلة، ولم تأكل كل النهار، كما لم تقم باتصالها المعهود للاطمئنان على من تبقى من أهلها الذين يقطنون في مدينة دمشق منذ العام 2012، بعد أن اضطروا للخروج من داريا قبيل حصارها بقليل. وفي اليوم التالي راقبت صامتة هذه المرة خروج الدفعة الثانية والأخيرة، لم تأكل ولم تتصل، ولم تتمكن من النوم أيضاً.
في صباح اليوم الثالث، كانت أول من أسرع من المهجع باتجاه الهاتف، طلبت الاتصال بأهلها، كانت ترتجف وهي تتكلم، ولكن تدريجياً بدأ صوتها يتغير وبدت ملامحها أكثر هدوءاً.
– «أكيد؟ أكيد؟».
كانت تطلب من محدثها بين كل كلمة والثانية أن يؤكد لها ما يقوله.
عادت إلى الغرفة مسرعة وقالت بحماس: «أنا طالعة بكرا».
– «خير يا دانيا، لوين طالعة؟ وكيف طالعة؟».
– «طالعة من هون، طالعة عالبيت، أكيد طالعة، أخبرني والدي للتو، كل بنات داريا طالعين، شو بدهن فينا هون، ما عاد إلنا لزوم!».
– «متأكدة؟».
– «نعم نعم متأكدة، المحامي هو من أخبر والدي وكل العالم عم تحكي هيك برا، كاتبينها عالنت، في عفو عن أهالي داريا».
وكأن النت هو الوحي الذي هبط عليها وأملاها قناعة بحتمية خروجها، بدأت بإخراج ثيابها وأغراضها وتوزيعها على بقية النساء اللواتي التففن حولها طمعاً بأي غنيمة.
مضت عشرة أيام أخرى قبل أن تغمزهنَّ مشرفة المهجع وتهمس لهنّ: «يا بنات، أعيدوا لدانيا أغراضها، حرام المخلوقة ما بقي عندها شي تلبسه!».
امرأة ميتة تمشي… هذا ما كانت عليه دانيا طوال ستة أشهر بعدها، كان شحوبها مخيفاً لدرجة أنك إذا نظرت جيداً، لربما أمكنك أن تلمح الدم يسري في أوردتها، بطيئاً بُطء العفو الذي تنتظره.
الأول من كانون الثاني-2019
سمعتُ صوت الموبايل، نظرتُ إلى الرقم وعرفت أنها هي، منذ خروجي لم تتوقف دانيا عن الاتصال بي من داخل السجن كلما سنحت لها الفرصة، أتاني صوتها وهي تصرخ لاهثةً وكأنها على وشك الإصابة بانهيار عصبي: «ولك قال قرأوا إسمي على النت! والله العظيم! كان مكتوب غلط بس هوي إسمي! قايلين إنو في عفو… وإسمي… مكتوب… غلط!».
هذا النص هو مشاركة لين فرح الثانية في زمالة الجمهورية للكتاب الشباب.
موقع الجمهورية




