“من أنتم؟…نحن الشعب”: سؤال الشعبوية بين الشرق والغرب
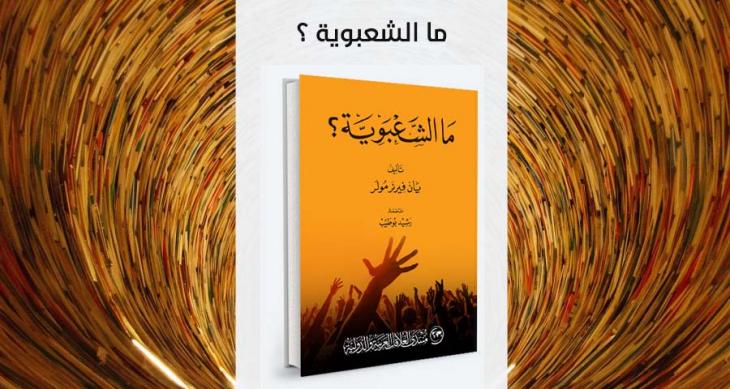
لا يجادل أحد في أننا نعيش عصراً شعبوياً بامتياز، وأن الشعبويين – كما أوضح ذلك المفكر الألماني يان فيرنر مولر في كتابه “ما الشعبوية؟” – “ليسوا معادين للنخبة فحسب، ولكنهم معادون للتعدّد بشكل مبدئي.
إن ادعاءهم الدائم يقول: نحن، ونحن فقط، من يمثل الشعب الحقيقي، ومواقفهم السياسية تنتهي مباشرة إلى تمييز أخلاقي بين الخطأ والصواب، وليس يميناً ويسارا فقطً. فلا شعبوية بدون استقطاب أخلاقي”.
أن يفرد “معهد الدوحة للدراسات العليا” يومين دراسيين لهذه الظاهرة بحضور ثلة من المفكرين والباحثين الغربيين والعرب، في إطار برنامج “حوارات العصر” السنوي؛ هي خطوة أساسية نحو ربط الممارسة الأكاديمية العربية بالأسئلة المطروحة اليوم في السياق الدولي.
كما أن دعوته المفكرة البلجيكية شانتال موف (1943) التي ألقت محاضرتين منذ أيام حول الشعبوية والديمقراطية كانت موفقة لأسباب عديدة، ليس أقلها أنها من من القلائل، الذين فكروا عقوداً في هذه القضية ولأنها أيضاً تنتصر لاستعمال الشعبوية في السياسة من أجل مواجهة الهجمة النيوليبرالية على الديمقراطية، فهي تنطلق مثل إرنستو لاكلو من ضرورة الشعبوية كاستراتيجية سياسية من أجل تجاوز الحتمية الطبقية للماركسية، التي لم تعد تعبر عن حقيقة المجتمع وانقساماته من جهة وما يسميه لاكلو بـ”الفردية المنهجية” للمنظرين الليبراليين من جهة ثانية.
لكن لاكلو ومن بعده موف لم يقولا شيئاً عن الشعبويات المحسوبة على اليسار والتي حكمت دولاً عديدة في أميركا اللاتينية والعالم العربي، وانتهت إلى نوع من الاستعمار الداخلي.
الشعبوية تعبير عن أزمة الديمقراطية الليبرالية
يمكن العودة بالشعبوية – وكما أوضح ذلك المفكر السياسي عبد الوهاب الأفندي في محاضرته الموسومة بـ “ما بعد السياسة؟ لاهوت وبلاغة عصر الشعبوية” – إلى “الطريق المسدود الذي وصل إليه الفكر والممارسة السياسية الليبرالية، بافتراضاتها العقلانية والكونية والفردية”، ويربطها أيضاً، انطلاقاً من موف ولاكلو بتهميش السيادة الشعبية وتوطيد هيمنة النخبة الليبرالية، وهي هيمنة تتجلّى في “التقارب بين اليسار واليمين حول خيارات السياسة الليبرالية الجديدة”، حتى أنه، كما ذكر، أضحت الأحزاب الشعبية اليمينية هي السبيل الوحيد المتبقي للمتضرّرين للدفاع عن مصالحهم.
“ما هي الشعبوية، على وجه الدقة؟ وأين الخط الفاصل بين الشعبوية وبين ظواهر سياسية مختلفة؟ ما ينبغي ملاحظته أولاً هو أن الشعبوية ليست شأناً يخص فئات أو طبقات اجتماعية من دون غيرها. وهي ليست مسألة «حساسية» يتمتع بها، من دون غيرهم، الذين أصابتهم العولمة بخسارة مباشرة وكانت السبب في قلقهم وخشيتهم من المستقبل وما يخبئه. وصفة الشعبوية لا تسوغها السياسات العامة التي تقترحها هذه المنظمة السياسية أو تلك الشخصية المعروفة. فتعريفي الشعبوية هو أنها مذهب في السياسة يرى أصحابه أن نخباً منحرفة، فاسدة وطفيلية، تتصدى على الدوام لشعب متجانس وواحد، طاهر أخلاقياً”.
“ليس جوهر السياسة تقسيم المجتمع إلى “نحن” و”هم”
وبالنسبة للمفكرة البلجيكية شانتال موف، يتوجب تطوير شعبوية يسارية من أجل مواجهة الأحزاب اليمينية المتطرفة من جهة وتجذير الديمقراطية من جهة ثانية، وبلغة أخرى، من أجل استعادة السياسة التي تحوّلت إلى ممارسة تكنوقراطية لا تعبر عن مصالح الشعب. لكنها استعادة تمر عبر تفعيل للعواطف وعبر تحديد للخصم المشترك.
وهنا، تكمن – في رأينا – المشكلة الكبرى في تصوّر موف، لأن من يفتح الباب للعواطف لن يستطيع إغلاقه بسهولة ولربما يؤكد، كما عبّر الباحث الألماني يان فيرنر مولر في كتابه “ما الشعبوية؟” المخاوف القائمة. كما أن اعتمادها تقسيم كارل شميت للسياسي بين الصديق والعدو، يطرح أسئلة كثيرة عن مدى ديمقراطية هذه الديمقراطية الراديكالية.
فالديمقراطية كما عبّر أحد أبرز منظريها في القرن العشرين، المفكر الفرنسي كلود لوفور، هي تعبير عن “المكان الفارغ للسلطة”، وهي “عالم اللايقين”، “قلق مؤسساتي” ووظيفة السلطة فيها تكمن في تنظيم صراع الطبقات، وهو ما لا يعني البتة أن تجد للصراع حلاً نهائياً. فلا يمكن البتّة حل الصراع الاجتماعي بشكل نهائي. ويتوجب على السلطة أن تحافظ على المسافة نفسها من مختلف القوى الاجتماعية، وعليها أن تحافظ على هذا الصراع بشكل لا يسمح له بأن يتطوّر إلى حد يهدّد فيه وحدة المجتمع.
لكن الشعبوية، حتى في صيغتها اليسارية، تطلب الانتصار لشعب على شعب ولهوية أو هويات على هوية أخرى. وكما عبّر المفكر العربي عزمي بشارة في محاضرته “الشعبوية وأزمة الديمقراطية”، في معرض نقده لمفهوم كارل شميت عن السياسي، فإن “تقسيم المجتمع إلى “نحن” و”هم”، الصديق والعدو، ليس جوهر السياسة بل حدودها. إنه التعريف التوتاليتاري للسياسة بحدودها، ويتساوق ذلك مع تعريف السيادة من خلال القدرة على إعلان حالة الاستثناء والحق في إزهاق الأرواح البشرية”.
إن كل تفكير يتمحور حول فكرة العدو أو حتى الخصم، ويؤسس له نظرياً، ويفكر من خلال منطق “النحن” و”الهم”، لا يمكنه أن يكون ظهيراً للديمقراطية، إننا سنقف هنا – بلغة دريدا – أمام “ديكتاتورية الأخواتية”، أما الديمقراطية، فليست، وحتى نستعمل مفهوماً لأودو ماركفارد، شيئاً آخر غير “التخلّي عن الراديكالية”.
“يعادي الشعبويون النخبةَ كما يعادون التعدّد بشكل مبدئي”
تنقلنا محاضرة وتفكير عزمي بشارة، كعادته، إلى أرض الواقع، وهي تتحدث “عن محاولات تصدير حكم استبدادي وتعبئته في غلاف أيديولوجي جديد هو “السيادة الوطنية”، على يد كل من روسيا والصين، وخصوصاً روسيا التي ترى أولاً في انتشار الديمقراطية الليبرالية توسيعاً للنفوذ الغربي، وثانياً أن الليبرالية في أزمة داخل الغرب نفسه، وتتحالف مع الحركات اليمينية الشعبوية المعادية للأجانب ولبروكسل، وثالثاً، تسوّق روسيا لفكرة أن الديمقراطية تعني الفوضى في العالم النامي، وهو ما تظهره – برأيها – الأحداث التي تعرفها بعض الدول العربية بعد الثورات”.
“من يريد الحديث عن الشعبوية، وفي الآن نفسه لا يريد الحديث عن الرأسمالية، سينتهي به المطاف غالباً عند سياسة الهوية”
ويقترب بشارة كثيراً من الموقف الذي يعبّر عنه الفيلسوف السياسي الألماني فيليب مانوف في كتابه “الاقتصاد السياسي للشعبوية” (زوركامب، 2018)، حين يعيد ظهور الشعبوية الجديدة لكل من اليسار واليمين في الدول الغربية إلى خلفية تراجع الطبقة الوسطى بسبب السياسات النيوليبرالية. لقد تسبّبت العولمة والتجارة الدولية في ضرر لقطاعات واسعة من الناس، وخصوصاً عبر نقل جزء كبير من صناعاتها إلى دول الأطراف، بحثاً عن العمالة الرخيصة ممّا مهد الطريق لانبعاث الهويات الغاضبة.
وقد عبّر فيليب مانوف عن ذلك أيضاً حين كتب بأن “من يريد الحديث عن الشعبوية، وفي الآن نفسه لا يريد الحديث عن الرأسمالية، سينتهي به المطاف غالباً عند سياسة الهوية”، مؤكداً، ضد القراءة الثقافوية، شأنه في ذلك شأن عزمي بشارة، بأن الشعبوية في السياق الأوروبي تمثل في جوهرها احتجاجاً ضد العولمة، وضد مظهرين أساسيين من تمظهراتها: “التجارة الدولية والهجرة”.
ولعل أبرز ما خرجت به من هذا اللقاء حول الشعبوية والديمقراطية، ومن خلال هذا الحوار بين مفكرين وباحثين غربيين وعرب، هو أن المفكر العربي، ليس فقط أكثر انفتاحاً على الأسئلة الملحة للعصر، بل قد يكون أكثر تعبيراً عنها، بسبب أن أزمات المركز الرأسمالي تطرح نفسها بشكل أكثر حدة في دول الأطراف، في حين يظل المفكر الغربي، في أغلب الأحيان، وحتى على المستوى النظري، رهين سياقه الأوروبي، ومركزيته الغربية، عاجزاً في أغلب الأحيان عن التفكير خارج ذاته.
رشيد بوطيب
حقوق النشر: العربي الجديد 2019




