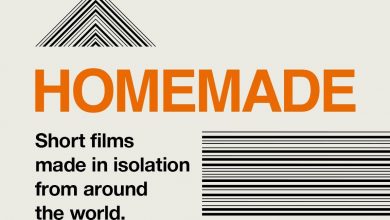“إنها تدور”… الأسئلة الفنية والأخلاقية عن السينما السورية/ علاء رشيدي

منذ بروز موجة الأفلام التسجيلية السورية المستقلة، حملت كل واحدة من هذه التجارب الفيلمية أسئلتها الخاصة، وخصوصاً الأخلاقية والمتعلقة بكيفية تصوير وتحقيق وإخراج هذه الأفلام. قبل التجربة التسجيلية لم يواجه النقد السينمائي هذه الأسئلة سابقاً. يمكن متابعة هذه الأسئلة مجتمعة في مجموعة مقالات الناقد الفني الناشط في الكتابة عن الأفلام السورية منذ العام 2011، راشد عيسى، والتي أصدرها مؤخراً مجتمعة في كتاب بعنوان “إنها تدور”، ضمّ 50 مقالاً عن خمسين فيلماً سينمائياً، منها السوري، الفلسطيني والعالمي، وأبرزها أفلام السينما التسجيلية السورية المستقلة، منذ العام 2011 وحتى اليوم.
بين التسجيلي والتخييلي
السؤال الأبرز الذي يواجه إنتاج السينما السورية المستقلة، هو سؤال المستوى الفني واقتصارها على نوع الفيلم التسجيلي، بينما تركزت الأفلام الرسمية المنتجة من قبل الحكومة السورية على نوع الفيلم التخييلي أو الروائي. لا شك أن صناع الأفلام المستقلة احتاجوا إلى الوثيقة لتثبيت حكايتهم، إثباتها وتأكيدها ورواية حكاياتهم، بينما كرست السينما الرسمية الحكومية حكايتها عبر السينما الروائية. كما أن إنتاج الفيلم التخييلي الروائي يتطلب وجود سيناريو وماكينة صناعية ومالية لم تمتلكها السينما المستقلة. لكن هل هذا يقودنا إلى استنتاجات تتعلق بالأنواع، كما يبين الكاتب في مقاله الخاص بهذه الموضوع: “الفيلم الوثائقي أساسه الوثيقة. بينما يتيح الروائي أو الخيالي إمكانية أكبر للتلاعب والتلفيق”.
هل التلاعب السينمائي هو حقاً أسهل مع السينما التخييلية؟
يمتلك بعض المختصين في مجال التقارير الصحافية رأياً مخالفاً، بل يعتبرون بأن تزوير الوثيقة التسجيلية أقل تكلفة وأكثر سهولة من إنتاج فيلم روائي، وعديد الفيديوهات التي يطلق عليها وصف “مفبركة” تبين سهولة تحقيق ذلك على شبكات الإنترنت. فهل يتعلق الأمر بنوع سينمائي أقرب للحقيقة وهو الوثائقي، وآخر أسهل للتلاعب وهو التخييلي؟ أم إن كل الفنون قابلة للكشف أو التضليل، والأمر منوط برؤية صانع العمل وغاياته؟
إن الأمر لا يتعلق بالأنواع الفيلمية الأقرب للحقيقة وأخرى الأبعد عنها. بل إن الحكاية الروائية أحياناً تبدو أكثر قدرة على أرشفة الحدث والإبقاء على استمراريته في الذاكرة الجمعية، كما نرى مع أفلام مثل “لائحة شندلر، 1993″، “الحياة جميلة، 1997″، “عازف البيانو، 2002″، “حياة الآخرين، 2006)، والذي يروي كل منهم حكاية من حقبة سياسية معينة ويؤرشف لها. وبالتالي، فإن غياب الفيلم التخييلي السوري المستقل يعزى أولاً وبشكل أساسي إلى ضعف الإمكانيات، وإهمال الإنتاج السينمائي السوري المستقل للسينما التخييلية، الروائية والحكائية.
بين المصور والمخرج العلاقة الإبداعية أم الاستغلالية
أول الأسئلة التي أثيرت حول تجارب من السينما التسجيلية السورية هي التعاون بين مصور، غالباً هاوٍ موجود داخل مكان الحدث الواقع، إما تحت الحصار أو تحت الدمار، وبين مخرج محترف. في البداية، ظهرت فكرة الربط بين كلا الطرفين كحلٍّ خلّاق لإنتاج أعمال فنية من أماكن تعيش حالة من العنف والحصار، وتخلو من الصحفيين أو صانعي الأفلام. كان الدافع تطوير مهارات المبتدئين وتحقيق تفاعل مع أصحاب المهنة المختصين. وحقق هذه التعاون أفلاماً سينمائية، لكن إشكاليتين رئيسيتين أثيرتا معها. يذكر الكاتب فيلمي “رسائل من مخيم اليرموك، رشيد مشهراوي”، “ماء الفضة، أسامة محمد”، حيث رأى أن المخرج طغى بحضوره وصبغ الفيلم بفردانيته بأكثر مما يعزز حضور القضية. والإشكالية الأخرى حول أحقية امتلاك الوثيقة الفيلمية والمنتج النهائي، أي الفيلم، بين المصور والمخرج.
كذلك برزت أمام التجربة التسجيلية السورية إشكالية حاضرة باستمرار، وهي عرض لقطات ومشاهد لشخصيات في أفلام تعرض حياتهم للخطر. وتكررت الإشكالية الأمنية بظهور شخصيات في الأفلام يتوجب إخفاؤها أو عدم إظهارها. هذه الإشكالية بإظهار شخصيات في حالة الخطر أو التخفي، انطرحت بقوة في عدد من الأفلام التي نتحفّظ على ذكر عناوينها لما ينطوي عليه الموضوع من حساسية. إلا أن المتابعين للحدث السوري وللإنتاجات الفيلمية السورية يدركون حضور هذه الإشكالية بقوة، والمتعلقة بـمخاطرة بعض صناع الأفلام بالوضع الأمني لشخصياتهم، عبر إظهارها وأحياناً تعريضها للخطر.
تصوير الأفلام على أنقاض المناطق المدمرة
الإشكالية الأخلاقية الأكبر التي تتناولها أكثر من مقالة في الكتاب، تلك المتعلقة بإمكانية التصوير في الأماكن التي تعرضت للدمار والقصف والتهجير، واستعمال أماكن الدمار كأماكن لتصوير الأفلام. برز ذلك جلياً مع تصوير المخرج نجدة أنزور، لأحد أفلامه في مدينة داريا المدمرة، وكذلك تكرر الأمر مع “مطر حمص، جود سعيد” و”جدار الصوت، أحمد غصين”، واللذين صورا مشاهد في مناطق تعرضت للتدمير. يرى الكاتب أن هذه الأفلام استغلّت مواقع الدمار التي خلفتها الحرب على المدن، لتجعل منها لوكيشن تصوير أقل كلفة من بناء استديوهات وتكاليف باهظة لخلق جو الدمار.
وبلغ الأمر درجة الحملة الإعلامية التي أطلقتها وسائل الإعلام النظامية، تطلب فيها الاستفادة من “اللوكيشنات” نتاج الحرب، بدلاً من “بناء استديوهات وصرف تكاليف باهظة لخلق جو الحرب”، ولم تتوقف وسائل الإعلام تلك عند المطالبة بتحويل الدمار إلى “مكان ديكور”، بل تقترح عدداً من السيناريوهات الجاهزة لذلك. حيث الأنفاق “حُفرت بسواعد الرهائن والمخطوفين، الذين عاملتهم كعبيد أو رجال حُكم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة” و”أماكن تعذيب، كان يصلب عليها السوريون ليتلقوا وجبات التعذيب والحقد والكراهية على أجسادهم”.
الرقابة المحلية والدولية
لا جديد في الحديث عن الرقابة التي تفرضها الدولة على الأفلام التي تنتجها المؤسسات التابعة لماكينتها الإنتاجية، أو تلك التي تنتجها المؤسسة العامة للسينما. لكن الجديد التي تحمله مقالات راشد عيسى، منها ما هو غير متضمن بالكتاب، هي موضوع الرقابة التي يفرضها الفكر الثوري على بعض هذه الأفلام. يذكر فيلم “عن الآباء والأبناء، طلال ديركي”، والذي كان من تداعيات عرضه، وبعد أن رشح للأوسكار ” أن قوبل بموجة استنكار واسعة وانتقاد لاذع، بعد أن اعتُبر أنه يصور إدلب على أنها مجرّد معقل للإسلاميين، وبأن الثورة إرهاب، وبأنه يغفل التطرق إلى النظام كسبب في مصيبة السوريين”، ردود الفعل هذه يعتبرها الكاتب كنوع من المحاذير المفروضة على السينما السورية الجديدة كيلا يُجابه فنانوها بالتخوين، ويتابع الكاتب: “خصوصاً أن هناك من وضع شبه قواعد أو وصايا، بأن على مخرجي الأفلام أن يربطوا كل موضوع يتطرقون إليه في أفلامهم بالنظام كسبب رئيس لكل مصائبهم”.
في مقالات أخرى، يكشف لنا الكاتب كيف تخضع السينما السورية المستقلة إلى رقابة بعض الجهات المموِّلة، والتي تطلب التركيز على فكرة الإرهاب. أنها تأمل إدانة طرف دون غيره، أو تبرئة طرف. ويعطي مثالاً فيلم “آخر الرجال في حلب، فراس فياض”، حيث يروي مخرجه أن محكمة ألمانية اعترضت أثناء عرضه لمشروع فيلمه إلى تطرقه لروسيا، وكذلك اعتبرت محكمة تركية نفس الفيلم يدعم الإرهاب. كما رُفض عرضه في لبنان، رغم أن مقر المؤسسة الداعمة للفيلم في بيروت. وفي الجزائر، يتحدث صانع الفيلم عن تبرير منع عرضه: “قالوا بوضوح إنهم لا يستطيعون عرض الفيلم لأنه سيؤدي إلى أزمة دبلوماسية مع سورية”. لم يعرض الفيلم في الكثير من الدول العربية الأردن، مصر، المغرب وغيرها. إنها إذن رقابة المهرجانات الدولية والصالات السينمائية والمؤسسات الحكومية على السينما السورية المستقلة، التي تلقى صعوبات في أماكن عرضها واحتكاكها مع الجمهور.
في تعامل الأفلام مع الرقابة
تطلعنا مقالات الكتاب على نماذج من تعامل الأفلام مع الرقابة، حيث استطاع العديد من صنّاع الأفلام أن يمرروا مقولاتهم النقدية عبر أفلام أنتجتها المؤسسة العامة للسينما نفسها، كما هو الحال مع أفلام “الدجاج، عمر أميرالاي”، “طوفان في بلاد البعث، عمر أميرالاي”، “الرابعة بتوقيت الفردوس، محمد عبد العزيز”. لكن الفيلم الذي يجعل من الرقابة موضوعه الإبداعي هو فيلم “سينما الخصوم، a cinema of discontent”، وهو للمخرج الإيراني المقيم في أميركا، جمشيد أكرمي. لقد جمع هذا الأكاديمي في فيلم واحد توثيق لتطبيقات قوانين الرقابة بمشاهد سينمائية في السينما الإيرانية. ويستضيف الفيلم مخرجين ومنتجين وكتاباً سينمائيين عملوا في إطار هذه السينما، من أمثال جعفر بناهي، أصغر فرهادي، بهمن غوباني، باباك بيامي، كمال تبريزي وسواهم، أولئك الذين أصبحوا شهود الفيلم على هذه الحقبة الإبداعية المعتمة في الرقابة على السينما الإيرانية.
يتحدث الفيلم عن الرقيب السينمائي الإيراني فيما يتعلق بالحجاب، فتصور المرأة مرتدية الحجاب في غرفة نومها، وحتى وهي ممددة على السرير، على مسافة من زوجها، مصفحة بالحجاب. أو تظهر وهي تجفف شعرها بالسيشوار لكن من وراء الحجاب. وهنا يسخر أكرمي في فيلمه، مستخدماً الرسوم المتحركة، حين يصور امرأة تحت الدوش مصرة على ارتداء الحجاب، ثم يسوق الفيلم أمثلة أخرى عن المشاهد الممنوعة، منها الملامسة الجسدية بين الجنسين، فالزوجان لا يتصافحان ولا يلمس أحدهما الآخر، حتى ولو على سبيل الصفع، ينبغي التحايل عليها بالضرب بأشياء وسيطة، لا ملامسة مباشرة بالأيدي في مشاهد الحب. إن مشهد وداع بين زوجين يمكن حلّه بتلصص الكاميرا على أحذيتهما وهما يتراقصان، أما العاشقان اللذان كانا يركضان سعيدين فوق الثلج، فلابد من وجود مسافة بينهما.
بالإضافة إلى ذلك، فإن مجموعة مقالات الكاتب راشد عيسى السينمائية التي يجمعها في كتابه “إنها تدور” هي رحلة نقدية نتعرف خلالها على أبرز الأفلام السورية، الفلسطينية، العربية والعالمية، وخصوصاً تلك التي تحمل في موضوعاتها القضايا الاجتماعية والسياسية، منها “طعم الإسمنت، زياد كلثوم” السوري الذي يعكس حياة العمال السوريين في لبنان، وفيلم “عن الآباء والأبناء، طلال ديركي” الذي يتعرض لحياة الطفولة في ظل الحرب والإرهاب، فيلم “قضية 23، زياد الدويري” الذي يندد بالمجازر المسيحية- الفلسطينية أثناء أحداث الحرب اللبنانية، وفيلم “الرقيب الخالد، زياد كلثوم” الذي ينتصر للكاميرا مقابل انتشار وفرض ثقافة الحرب والسلاح، ومن الأفلام العالمية نذكر “إيكاروس، بريان فوكل” الذي يكشف فضيحة المنشطات في القطاع الرياضي الروسي وفيلم “وداعاً لينين، وولفانغ بيكر” الذي يقدم حكاية حاذقة تروي سقوط النظام الشيوعي في ألمانيا الشرقية، ويرصد بدقة عملية التحول الثقافي حينها.
رصيف 22