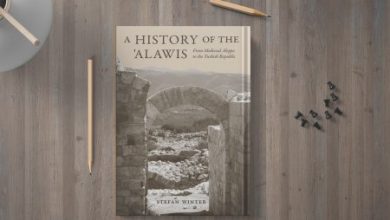ثلاث مدن مشرقية.. سواحل البحر الأبيض المتوسط بين التألق والهاوية/ فيليب مانسيل
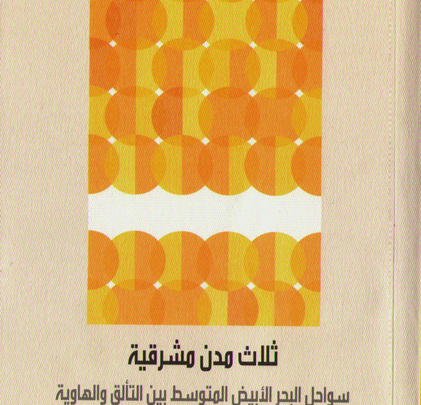
وَهمُ الكوزموبوليتانية في بيروت والإسكندرية وأزمير/ أسامة فاروق
في 30 يناير1863 ألهب جندي مصري حصانه على رصيف ميناء الإسكندرية، فرفس الحصان شخصاً فرنسياً كان يمر في المكان وأوقعه على الأرض. قام الفرنسي وضرب الجندي المصري، فأخذه الجنود المصريون إلى أقرب مركز شرطة. كانت فرنسا وقتها في عهد نابليون الثالث وفي أوج غطرستها، بعد أن خرجت أخيراً مظفرة من حروبها مع روسيا والنمسا. فثارت ثائرة القنصل الفرنسي لأن المصريين تجرأوا ورفعوا أيديهم على مواطن فرنسي، وهدد بأنه إن لم يحصل على ترضية مناسبة فإن الأسطول الفرنسي سيدك الإسكندرية.
وبعد ثلاثة أيام عُرض الجنود (المصريون المتورطون) مكبلين أمام القنصلية الفرنسية في ميدان القناصل ليتفرج عليهم ضباط وبحارة من الأسطول الفرنسي بكامل أبهتهم.. “مكبلا في أغلاله اقتيد الضابط المصري وهو يبكي من حسرة الذل والمهانة، ليقضي عشرين عاماً في السجن”.
هل تصلح حكاية كتلك كإجابة على سؤال لورانس داريل في رباعيته “ماذا نستعيد عندما ننطق كلمة الإسكندرية؟” هل يمكن استعادة تاريخ البؤس والشقاء لأبناء المدينة؟ للأسف لا أحد يحب أن يتذكر هكذا حكايات، رغم أنها وكثير غيرها أكثر عنفا وإذلالا كانت هي الواقع الحقيقي للمدينة، كما يؤكد المؤرخ فيليب مانسيل في أحدث كتبه التي ترجمت للعربية مؤخرا “ثلاث مدن مشرقية”.
يروى الكتاب تاريخ سميرنا (إزمير حالياً) والإسكندرية وبيروت، المدن الواقعة على الشواطئ الشرقية للبحر المتوسط، مفصلا لحظات ضعفها وقوتها، تخبطها وإحباط أهلها، التسلط الأجنبي الذي عزز تقدمها أحياناً، وامتص خيراتها في معظم الأوقات، رحلة الإمبراطورية القديمة التي نمت وتوسعت بعد أن شربت دماء أبناء البلاد الثلاث وارتوت، لكننا نحب أن نتذكر الجانب الآخر، الحالم، الكوزمولوليتاني، حيث تربينا كما يشير مترجم الكتاب مصطفى قاسم على روايات وأعمال سينمائية وتلفزيونية مجدت تلك الحقبة، وأبرزت التعايش والوئام بين أبناء تلك المدن من مختلف الأصول العرقية والدينية “ومن ذا الذي لا تتوق نفسه إلى مدينة متنوعة متآلفة يتعايش فيها المصري والتركي واليوناني والفرنسي والإنكليزي والإيطالي والأرمني في حياة تسودها المحبة والعدالة والتعاون!”.
لكن هل وجدت هذه الحقبة فعلا؟ هل كان المشرق في أي وقت جنة للتعايش بين الأديان والأقوام كما في المخيلة المصرية والسكندرية تحديدا؟ وهل كان المشرق ذلك المجتمع التعددي الجميل المتحاب المرابط الذي ظهر في أفلام الأبيض والأسود المصرية؟ هل كان المشرق هو البقال اليوناني الطيب والتاجر اليهودي المصري الخبيث، والبارمان الإيطالي والنادل الفرنسي اللذين يتحدثان لغة عربية مكسرة؟ يوسع المترجم سؤاله فيقول: هل كان من الممكن في هذا الجو العالمي “الجهادي” إسلامياً و”الصليبي” مسيحياً و”الاستعماري” و”المتعالي حضارياً” أوروبياً، أن يسود تعايش حقيقي قائم على الوئام والتعارف والاحترام بين الأديان والقوميات؟
الإجابة هي “لا” كبيرة بحجم 350 صفحة هي عدد صفحات كتاب مانسيل، فبرغم بعض التفاوت في تاريخ المدن الثلاث، إلا أنهم تشابهوا جميعاً في أن شيئاً من ذلك التعايش لم يحدث، على الأقل بشكله الحالم في الأدبيات، صحيح تجاورت الجماعات المختلفة، لكن من دون أن تتماس أو تتقاطع أو تندمج، كما يشرح المترجم، ووجدت الثقافات المختلفة وأثرت كل منها في الأخرى لكن من دون أن تنتج ثقافة واحدة أو جماعة واحدة مترابطة، ووجدت اللغات المختلفة من دون أن يهتم أحد ناطقيها بأن يتعلم لغة الآخرين، حتى محمد علي نفسه الذي حكم مصر ورسم مستقبلها، بل إن الأهم من هذا كله كما يؤكد الكتاب أن ما ساد بين الجماعات المختلفة كان الاستغلال الاقتصادي والاحتقار القومي والديني، وليس القبول والاحترام.
المواجهة التي أشرنا إليها في البداية مثال واحد لحوادث كثيرة وقعت بين القناصل وبين أهل المدن الثلاث، فالإسكندرية –مثل سميرنا وبيروت- كانت تقع على الخط الفصل بين الإمبراطوريات، فكان القناصل في الإسكندرية، والمدن المشرقية الأخرى، يتصرفون على راحتهم تماما “إذ كانوا فوق كل شيء، وكانت ساعتهم –كما يقال- تضبط الشمس”. يفسر المترجم: كناية عن السيطرة والاستبداد المطلقين، ومن هذا الميراث تجد المصريين اليوم يسخرون ممن يتجبر أو يتغطرس بنعته بـ”جناب القنصل” أو “ابن القنصل” وعلى الرغم من أحدا منهم لا يعرف ما كان القناصل يفعلونه فيما قبل يوليو 1952، “يبدو أن تجبر القناصل وظلمهم بقي كميراث في الوعي المصري: ميراث الأسى”.
لكن بحسب المؤلف المتخصص في تاريخ البلاطات والعائلات الحاكمة، فإن تلك الامتيازات نفسها هي التي جعلت من مدن المشرق تجارب للتعايش بين الأقوام والأديان المختلفة، حتى وصفها المعاصرون بأنها مدن لا نظير لها في أي مكان آخر في العالم إبان ذلك العصر.
فسميرنا كانت واحدة من أكثر المدن تألقاً في الأناضول، ومهد الرياضيات، ويعتقد أنها كانت مسقط رأس هوميروس “ونظراً إلى كونها المدينة الأكبر والأكثر تروماً (بمعنى تبنى الطابع والثقافة الرومانيين) بين مدن آسيا الصغرى، فقد أطلق عليها في عهد الإمبراطورية الرومانية اسم بهجة آسيا وزينة الإمبراطورية”، وكانت المدينة بداية من العام 1600 أكثر حرية وكوزموبوليتانية من منطقتها الداخلية، وكانت قادرة حتى على تحدي أوامر السلطان والقيود الاقتصادية والدينية للإمبراطورية. وبحلول عام 1700 كانت سميرنا عثمانية وأوروبية في الوقت نفسه، حيث كانت تضم ثلاث كنائس كاثوليكية وكنيستين يونانيتين وكنيستين أرمنيتين وثمانية معابد يهودية، وعلى الرغم من حيوية جالياتها المسيحية واليهودية كانت المدينة إسلامية في المقام الأول.
لا يتركنا المؤلف كثيراً مع الشكل الحالم للمدينة التي أطلق عليها “لؤلؤة المشرق” المدينة المبهجة “صنيعة التجار” فيقول إنها كانت في الحقيقة مدينة الزلازل والطاعون والحرائق والمذابح على طول تاريخها، مرجعاً تألقها فقط إلى قدرة سكانها على التكيف، وعدم ملائمة الموانئ المنافسة.
شهدت المدينة كوارث أخرى غير الطاعون، كانت من صنع الإنسان هذه المرة، فتحت سطح المدينة الباسم، كان هناك بركان ينتظر الانفجار، ولم يكن السلام النسبي الذي ساد الجماعات المختلفة حتى 1678 إلا نتيجة لـ”صرامة” القوانين العثمانية “فحتى المسيحيون من الطوائف المختلفة، وكذلك المسلمون واليهود، كانوا في داخلهم يكره بعضهم بعضا كراهية الموت، لكنهم كانوا مجبرين على التظاهر بخلاف ذلك”. انفجر ذلك البركان عدة مرات أعنفها حدث في التاسع من أيلول 1922، معلنا نهاية الحرب اليونانيّة التركيّة، بعد أن دمّرت النيران المتلاحقة الأحياء الأرمينية واليونانيّة بالكامل.
وعلى نحو ما حدث في سميرنا، أخذت الإسكندرية تتحول إلى مدينة يونانية، إذ زاد عدد اليونانيين فيها عنه في أي وقت سابق منذ استسلام المدينة للجيش العربي الفاتح العام 642. في البداية جاء اليونانيون إلى الإسكندرية بأعداد كبيرة كعبيد بعد مذبحة خيوس في العام 1822 وبعد حملة إبراهيم باشا على شبة جزيرة بيلوبونيز في العام 1826 كان من بين هؤلاء على سبيل المثال ميشيل زيزينيا مؤسس حي زيزينيا الشهير، الذي جاء من خيوس عبدا، كما جاء بعض اليونانيون إلى الإسكندرية بكامل إرادتهم أيضا –على نحو ما فعلوا في سميرنا- لتكوين ثرواتهم، فالإسكندرية كانت وقتها جزءاً مهما من حركة الاقتصاد العالمي، “كان ميناؤها يحوي عادة مائتي سفينة على الأقل” وبحلول العام 1839 كانت قيمة تجارة الإسكندرية وحدها تكافئ قيمة تجارة مصر كلها قبل عشر سنوات، وارتفع عدد الشركات الأوروبية التي تأسست في الإسكندرية من ثلاث وعشرين في العام 1822 إلى تسع وستين في العام 1837.
وأصبحت الإسكندرية المدينة الكوزموبوليتناية المشرقية الثالثة بعد القسطنطينية وسميرنا، ومثلهما كانت جمعاً من المتناقضات “حشد مختلط من البشر من كل الألوان والأزياء، منهم المتأنقون والرائعون، وكثيرون منهم بؤساء شبه عراة، فضلا عن الضجيج المتداخل لصيحاتهم ونداءاتهم”.
المشهد نفسه كان يمكن رؤيته على سواحل بيروت، حيث كان التنوع والمرونة جوهر المدينة كما كان في سميرنا والإسكندرية “بالنسبة إلى الآتين من أقصى الشرق كانت بيروت تبدو مدينة أوروبية، وبالنسبة إلى الآتين من أوروبا كانت تبدو عالما جديدا”.
غدا الميناء كما يصفه المؤلف أكثر ازدحاماً، وكان المسافرون يحملهم إلى الشاطئ “أهال شبه عراة” وعلى الشاطئ يجد المسافرون في كل خطوة مشهداً حافلاً بالعجلة والعدو والانطلاق، على أن النمو الاقتصادي الكبير لم يولد وحيداً، بل صاحبته مذابح، تسبب هو نفسه في إطلاق العنان لها “فمع التراجع في قوة العائلات الإقطاعية، أصبح رجال الدين الموارنة أكثر ثقة وتعليماً وموالاة لفرنسا. وفي العام 1841 كتب ريتشارد وود أن الطوائف المختلفة تتميز قبل كل شيء بكراهية شديدة لبعضها البعض”. وفي الأعوام 1842-1845 أدخلت الإصلاحات الإدارية لأول مرة “التمثيل الطائفي” بوصفه مبدأ تأسيسياً في الحياة العامة اللبنانية، لتصبح بيروت حسب تعبير المؤلف آخر مدينة مشرقية، وآخر مدينة لا تسيطر عليها المسيحية أو الإسلام، حيث يسود “التعادل”، لكن الاستقطاب الديني المتزايد يهدد تلك المعادلة على نحو مستمر.
هذا التعدد الكبير كان بمثابة البركان الخامد في المدن الثلاث، ينفجر مرات مخلفاً دماراً وخراباً ومذابح، ثم يهدأ بعض الوقت تستعيد خلاله المدينة بعضا من ألقها وتستعد لما هو قادم.
مؤدى ذلك كله إنه على الرغم من التشابه الكبير بين المدن الثلاث في مشرقيتها، بمعنى خضوعها للحكم العثماني أو الحكم الثنائي العثماني الأوروبي فإن بينها اختلافات جذرية كانت السبب وراء تفرد تواريخها في القرون التي غطاها الكتاب. تجلت هذه الفروق كما يوضح قاسم في معاملة الأهالي في المدن الثلاث، وقبل ذلك في الأحداث الكبرى التي شهدتها هذه المدن، فسميرنا التركية حكماً وشعباً لم يتعرض سكانها الأتراك للاستغلال والإذلال الذي تعرض له أهالي الإسكندرية، الذين تعاملت نخبتها الحاكمة بشقيها الأوروبي والعثماني، وكذلك المكون الأوروبي بين سكانها مع الأهالي المصريين معاملة المستعمِر للمستعمَر، أو السيد للعبد “بلا أدنى مبالغة” بينما حمت الطائفية وأمراؤها وحماتها الأوربيون البيروتيين من هذه المعاملة، وإن حل محلها استغلال واستعباد من نوع آخر من أمراء الطوائف بحق أتباعهم، فضلاً عن ممارسة الاستغلال والعنف بحق الطوائف الأخرى”.
على امتداد صفحات الكتاب يبحث المؤلف عن تلك الحقبة الكوزموبوليتانية فلا يجد منها إلا الاستغلال والاستعباد، والتطرف، فمن أين جاءت تلك الصورة الطوباوية عن التعايش والاندماج، عن الكوزموبوليتانية؟ الإجابة حسب تفسير المترجم جاءت في حالة الإسكندرية تحديداً من العقدين الأخيرين من عمر المشرق، وتحديدا الأعوام 1936-1956 فمع تنامي قوة الدولة المضيفة، بعد إلغاء الامتيازات والمحاكم المختلطة، وبعد أكثر من قرن ونصف القرن من العيش في المدينة، وبعد أكثر من خمسة أجيال ولدوا فيها، بدأ الأوروبيون واليونانيون تحديدا في استخدام اللغة العربية، وكان ذلك بداية كسر الحواجز بين الجاليات التي ظلت منغلقة على نفسها، وبداية لتعامل المصريين بشيء من الندية مع المشرقيين الأجانب، إذ بدا الجميع يقفون أمام قاض واحد ويخضعون لقانون واحد، وبذلك لم يعد المصريون يشعرون بأنهم غرباء.
إلى هذين العقدين تحديداً يرجع شعور الحنين بين المصريين السكندريين إلى الحقبة المشرقية الكوزموبوليتانية وفيهما بتعبير المؤلف “بدأ الكثير من اليونانيين وغيرهم من الأجانب يتحدثون اللغة العربية بطلاقة، بدرجة أفضل كثيراً من قراءاتهم أو كتابتهم لها. وفى المناطق المختلطة، يتذكر السكندريون زيارات جيرانهم أيا كان دينهم، والذهاب معهم إلى المدرسة نفسها، والأكل معهم، والنزول ضيوفا عليهم”.
لكن ورغم ذلك لا يقتنع المترجم في مقدمته بإمكانية وجود ذلك المشرق المتخيل في الروايات، ففي رأيه أن الأجانب حين جاءوا إلى تلك المدن لم يأتوا إليها حباً فيها، ولا رغبة في إثرائها وإعمارها، ولا حباً في التنوع والتعدد، ولا سعياً على معرفة الآخر والتعايش معه، وإنما جاء بهم البحر في المقام الأول بسبب الامتيازات التي أعطتها لهم الدولة العثمانية في أيام قوتها، وأساءوا استخدامها في أيام ضعفها، وهي الامتيازات التي مكنتهم من الثراء السريع على حساب أبناء البلد أنفسهم.
وإلى جانب التفسير السياسي لنوع الحياة الاجتماعية والعلاقات بين الجماعات في مدن المشرق الذي يقوم على بنية السلطة وأجنحتها في مقابل المحكومين، ثمة تفسير آخر “طبقي” يفرض نفسه عبر صفحات الكتاب ويبرزه المترجم أيضاً، فالقسمة في مدن المشرق الثلاث –بلا استثناء هذه المرة- كانت قسمة طبقية، إذ كانت تنقسم إلى طبقة رأسمالية وطبقة معدمة أو إلى أغنياء وفقراء، وشهدت المدن الثلاث تحالفاً طبقياً من أعراق وجنسيات وأديان مختلفة توافق من البداية على استغلال أبناء البلاد وإقصائهم، لذلك كان التعايش غير موجود وإن وجد كان فقط داخل الطبقة الرأسمالية بمكوناتها الدينية والعرقية المختلفة، وكان نادراً أو غائباً تماماً بين الطبقتين “إلا إذا اعتبرنا اتخاذ الخدم من المصريين والمربيات من اليونانيين والسفرجية من الإيطاليين أو غير ذلك من الحرف العرقية التي جمعت الطبقتين في بيوت النخبة، تعايشاً من النوع الذي تحن إليه الروايات السكندرية حول المشرق”.
(*) كتاب “ثلاث مدن مشرقية.. سواحل البحر الأبيض المتوسط بين التألق والهاوية” كتبه المؤرخ فيليب مانسيل، وترجمه د.مصطفى قاسم، وصدر مؤخرا ضمن سلسلة “عالم المعرفة” التي تصدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت.
عالم المعرفة 454 : ثلاث مدن مشرقية سواحل البحر الأبيض المتوسط بين التألق والهاوية ج1 – فيليب مانسيل
عالم المعرفة 455 : ثلاث مدن مشرقية سواحل البحر الأبيض المتوسط بين التألق والهاوية ج2 – فيليب مانسيل
صفحات سورية ليست مسؤولة عن هذا الملف، وليست الجهة التي قامت برفعه، اننا فقط نوفر معلومات لمتصفحي موقعنا حول أفضل الكتب الموجودة على الأنترنت
كتب عربية، روايات عربية، تنزيل كتب، تحميل كتب، تحميل كتب عربية