عن زوبعة فراس السواح -مقالات مختارة-
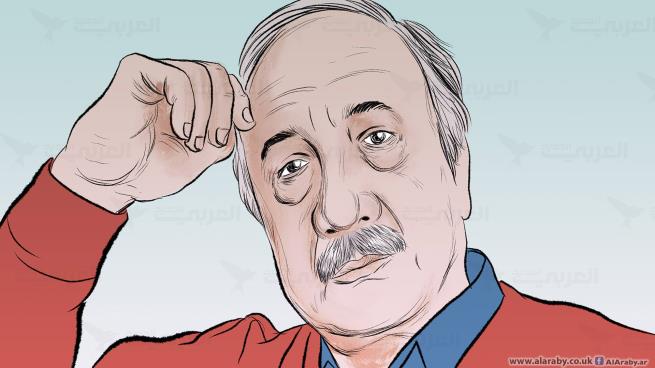
مغامرة فراس السواح/ حسام أبو حامد
لم يكتف الباحث السوري، فراس السواح، بحقه في ممارسة حريته الشخصية في قبول أصدقائه في العالم الافتراضي (فيسبوك) أو رفضهم، وفق معايير يجدها مناسبةً يحتفظ بها لنفسه، بل أعلن عن أحدها في تعميمٍ نشره على صفحته الشخصية بقوله “أنا لا أقبل طلبات صداقة من المحجبات. حجاب الرأس يعني حجاب العقل”، مصدّراً بذلك حكم قيمة استفز عديدين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين واجهوه بسيلٍ من الانتقادات الحادّة، منها ما نسف التاريخ البحثي والفكري للرجل، واتهمه بالجهل، ومنها ما رأى في الرجل “أحد الدواعش العلمانيين”.
في غير مناسبةٍ، اعتبر مفكرون عرب الحجاب عائقا كبيرا بين المرأة ورفع مكانتها، وبالتالي عائقا بين الأمّة وتقدّمها، فأثار قاسم أمين (1863- 1908م) في كتابه “تحرير المرأة” ضجّةً كبرى، رأت فيه إهانة للأمة المصرية، حين قدّم الحجاب قيمةً سطحية، ونساء مصر جاهلاتٍ لا يعتنين بنظافتهن، وتساءل عن مستقبل مصر الذي لن يعدو أن يكون أمّةٌ متخلّفةٌ كسولةٌ بأمهات كهؤلاء. كما ذهب إلى أن العقول والأرواح في الغرب التي بهرت المصريين، واكتشفت قوة البخار والكهرباء، وسعت وراء المعرفة، لا ملذات الحياة، قد تخلت عن الحجاب، حين لم تر فيه فائدة.
ومع أن نساء مصر تدرّبن، في مدارس محمد علي، على الإسعافات الأوّلية، والتمريض، ودرسن في المدارس الابتدائية والثانوية. وبحلول القرن التاسع عشر، أصبحن طبيباتٍ، ومدرساتٍ، وصحفياتٍ، وكاتبات، إلا أن الحجاب أصبح أيضا رمزا لمقاومة الاستعمار، واعتبره مسلمون كثيرون حمايةً لنسائهم ومجتمعاتهم، ودلالةً على إسلام “صحيح”. إذ لم يُجدِ مع هؤلاء للتخلي عن الحجاب، وغيره من رموزٍ اعتبرت حجابا للعقل والتقدّم، لا تحديث من أعلى، ولا علمنة للدولة ومؤسساتها من دون علمنة للمجتمع. العلمانية التي فرضت سياسيا بقيت بالنسبة لمعظم المصريين، وغيرهم من مسلمين، انطلاقا من عصر النهضة (وحتى اليوم) غريبةً وشاذّةً، واستمرت أنماط التديّن المختلفة تلبي حاجة ماسّة للاستمرارية، سيما في مراحل التحول المصحوبة بالاقتلاع، والزعزعة، وقلق الهوية المزمن.
يتفق صاحب هذه السطور مع الرأي أن الحجاب لم يكن عادةً أصليةً وأساسيةً في الإسلام، فلم يأمر القرآن جميع النساء بالحجاب، ولم يصبح عزل النساء في “الحرملك” عادة إلا بعد مُضيّ حوالي ثلاثة قرون على وفاة النبي، عندما قلد المسلمون مسيحيي بيزنطة، وزرادشتيّي فارس الذين ألزموا نساءهم بارتداء الحجاب. مع ذلك، كان الحجاب دلالةً على المكانة
الاجتماعية، ارتدته نساء الطبقات العليا فقط. غدا الحجاب، عبر تنظيراتٍ فقهيةٍ، فريضة دينية، بعد أن كان مسألةً مدنيةً إجرائية، قُصِد منها تمييز الحُرّات من نساء المسلمين في يثرب لحمايتهن من تحرّش المنافقين.
ويخبرنا الجاحظ، في “رسالة القيان”، أمثلة عديدة لاختلاط الرجال والنساء ما قبل الإسلام وبعده، إذ لم يكن بين رجال العرب و”نسائها حجاب، ولا كانوا يرضون مع سقوط الحجاب بنظرة الفَلْتة، ولا لحظة الخلْسة، دون أن يجتمعوا عن الحديث والمسامرة… ويسمّى المولع بذلك من الرجال الزير، المشتقّ من الزيارة، وكل ذلك بأعين الأولياء وحضور الأزواج، لا ينكرون ما ليس بمنكر إذا أمنوا المنكر”، فالأصل في رأي الجاحظ إباحة الاختلاط، والمنكر كاستثناء لا يُبطل الأصل. ولم يُلغِ الحجاب الخاص بزوجات النبي، تكريما للنبي وتمييزا لنسائه، عُرْف العرب في الاختلاط، فبقيت “الشرائف من النساء يقعدن للرجال للحديث، ولم يكن النظر من بعضهم إلى بعض عاراً في الجاهلية، ولا حراماً في الإسلام”، لكن التشدّد به “أمر أفرط فيه المعتدون حد الغيرة.. فصار عندهم كالحق الواجب”.
عاش الجاحظ في القرن الثالث الهجري، قبل أن تعكس مؤلفات الفقه في القرن التاسع هيمنة أولئك “المعتدّين حد الغيرة”، لا سيما كتابي جلال الدين السيوطي “إسبال الكساء على النساء” و”البعث”، الذي يؤكد فيهما على ضرورة إقصاء النساء عن فضاءات الرجال، ستراً لهن وحفاظاً على عفّتهن، بل يحسم موقفه بعد تردّد، ليذهب إلى أن المرأة من المحجوبين عن رؤية الله يوم القيامة، فيكون حجابها في الدنيا وسترها من باب أولى.
في مواجهة الحداثة، اعتنى المتديّنون الإسلاميون، معتدلين ومتشدّدين، عنايةً فائقةً بأدق تفاصيل اللباس والمظهر، وهو ما يفعله هؤلاء اليوم في عصر ما بعد الحداثة، فلا يقتصر لباس المرأة على كونه فريضةً دينيةً، بل تتسع دلالته، ليحوز بعداً وجودياً، ويصبح ركناً أساسياً من أركان التديّن الاجتماعي، فللباس، سواء تعلق بالرجل أو المرأة، سيمياؤه التي ترجع، في رمزيتها، إلى مقاصدَ دينيةً تعبّدية، وإلى حقيقةٍ تقع في صلب الانتماء الحضاري والتميز الثقافي المطلوب.
وفي ظل التطييف السياسي الذي يعصف بالمنطقة، يتحول الحجاب رمزا سياسيا، لا مجرّد رمز ديني، وهويةً يتمسّك بها المقتنع به وغير المقتنع، سواء بسواء. صحيحٌ أنه لا يمكن الانتقاص من حق التعبير السلمي عن الرأي، لكن رأيا في قضية كبرى لا يمكن اختزالُه في تعميم فيسبوكي، أما التعامل مع هذا التعميم بوصفه موقفا علمانيا فهو أدهى وأمرّ، فما هو إلا نسفٌ للعلمانية التي تتسع للمتدينين وغير المتدينين، في دولةٍ يتساوى فيها الطرفان في الحقوق والواجبات، وتتحقّق فيها الحرية وفق مبدئي المساواة والعدالة. وأن يسهم المثقف في خطابه، وبعد صمتٍ طويل، بجرعاتٍ إضافيةٍ من سوء الفهم الشعبي للعلمانية، بوصفها إقصاءً للدين عن المجتمع، فهو نوعٌ من التهوّر المعرفي، كما أن من المعيب أن يتورّط المثقف في خطاب إقصائيٍّ محايثٍ لما يحدث على الأرض.
تناول قضية الحجاب وتحرير العقل بهذا الشكل المبتسر، تعميما على مواقع التواصل الاجتماعي، يُبقيها ضمن دائرة الاستفزاز وردود الفعل الأكثر راديكاليةً. والأجدى دائما، تناولها بالتحليل العلمي الموضوعي، والبحث الجاد والموسّع الذي عوّدنا عليه فراس السواح، بربطها بقضايا التحرّر الاجتماعي بمفهومه العام والشامل الذي يتطلب مسيرةً طويلةً من ثوراتٍ اجتماعيةٍ، سياسيةٍ واقتصادية، خطت المجتمعات العربية المعاصرة على طريقها مغامرتها المتعثّرة الأولى.
يتورّط السواح في مغامرة غير محسوبة، وحسنا فعل حين حذف المنشور من صفحته الشخصية على “فيسبوك”، لعل ذلك يكون إدراكا منه لمحاذير تلك المغامرة، وليس مجرد انحناءٍ مؤقت أمام العاصفة.
العربي الجديد
زوبعة فراس السواح/ سوسن جميل حسن
يعتبر الحجاب قضيةً حاضرةً على ساحة السجالات والنقاشات والخلافات والاختلافات بشكل دائم، وبزخم لا يخلو من التطرّف والعصبية بين مؤيدٍ ومعارض. وقد أثارت هذه القضية المجتمع الإسلامي منذ عقود طويلة، بداية من الفقهاء والمشرعين، ثم المفكرين والباحثين وعلماء الاجتماع ومشايخ الدين، حتى صار قضية إشكالية، وأصبح كل فرد معنيًا إما باتخاذ موقف نقدي منه أو مناصر له ومتمسّك به.
من يتابع السجال الحامي في صفحات التواصل الاجتماعي منذ أيام، بسبب نص كتبه الباحث السوري فراس السواح في صفحته على “فيسبوك”، يعلن فيه أنه لا يقبل طلب صداقةٍ من محجباتٍ، لأن حجاب الرأس يعني حجاب العقل، يمكنه أن يعرف العوز الشديد لـ”أنزيم” الحس النقدي والفكر النقدي في مجتمعاتنا. المأخذ الوحيد الذي يُؤخذ على السواح في نصه هو التعميم، وهو باحثٌ وموضوعيٌّ، ويعرف تمامًا أن التعميم مرفوضٌ في مجالات كهذه. ولكن ربما كتب نصه تحت تأثير حالة انفعالية عالية، حمله رأيًا كان من الأجدر ممن تصدّوا له، وفتحوا جبهاتٍ استخدموا فيها كل أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة، عازمين على نسف فراس السواح، وكل منتجه الثقافي التنويري الذي ساهم، وعلى درجة عالية، في ملامسة وعي الناس، وإثارة الأسئلة بشأن قضايا فكرية وتاريخية ودينية وثقافية، كان الأجدر بهم أن يعتبروا النص فرصةً لنقاش قضية تبقى حاضرة للنقاش، على الرغم مما كتب عنها، وعلى الرغم من كل السجالات التي دارت حولها.
هناك أصول للحجاب في التاريخ، كما تشير كتب عديدة، وكما يرى باحثون كثيرون. وهناك شروط اجتماعية وسياسية وثقافية وتاريخية، حكمت (أو فرضت) على المرأة ارتداء الحجاب، إذ لم يكن شأنًا دينيًا خالصًا في الماضي، بل ارتبط بالحالة السياسية للممالك والشعوب، وبالحالة الاجتماعية، فقد كان، على سبيل المثال، علامة تمايز طبقي لدى الآشوريين، فالنسوة الحرائر كن يرتدين عباءةً تكشف الوجه فقط، عند الخروج، فيما فرض على الإماء السفور، لتمييزهن عن النسوة الحرائر. وفي بعض الحالات، كان تدبيرًا يُمارس على المرأة، أو عرفًا اجتماعيًا في مجتمعاتٍ لا تحظى فيها المرأة بمكانةٍ عليا في المجتمع، وليس لديها حقوق، كما في الصين
والحضارات الآسيوية قديمًا.
أما لماذا تزداد وتيرة السجال بشأن الحجاب في العقود الأخيرة بين مدافعٍ بتطرّف ومناهض أو رافض له بالمجمل، فهذا نتيجة حتمية للصراعات العالمية والإقليمية والمحلية، ونتيجة الاستكبار الذي تمارسه الأنظمة القوية تجاه الشعوب والدول الضعيفة، كذلك نتيجة الاستبداد الذي ابتُليت به الشعوب، خصوصاً في منطقتنا العربية بعد نيْلها الاستقلال من المحتل الأجنبي، وإجهاض مشاريع النهضة التي كانت الهم الأكبر للشعوب الحاصلة على استقلالها، والساعية في طريق تحقيق طموحاتها. وقد كانت قضية المرأة وتحريرها من قيد إرثٍ ثقيلٍ، ديني واجتماعي، يقصيها عن المجال العام، ويسلبها حقوقها، قضيةً محوريةً وتشكل شاغلاً مهما من شواغل المشروع النهضوي، في تلك الفترة التي لا تعتبر بعيدةً جدًا في المنطق الزمني لعمر الشعوب، لم يكن الحجاب شأنًا دينيًا بالمطلق، بل تداخل الديني بالاجتماعي في شيوعه زياً تقليديا للنساء، لكنه كان من حوامل المشروع الطامح بنيل المرأة حقوقها ومساواتها بالرجل، من حيث الاعتراف بها أولاً، كفرد يمتلك حرية الإرادة والقرار.
أما الآن، وبعد تعاظم دور الدين، والإسلام السياسي تحديدًا، خصوصًا في سنوات ما سمي الربيع العربي، وحجم العنف الذي مورس على الشعوب التي وعت ذاتها في لحظةٍ تاريخيةٍ، وانتفضت من أجل كرامتها وحقوقها المنتهكة، فتدخلت في شأنها قوى إقليمية ودولية، أدارت نزاعاتها وصراعاتها فوق أراضينا، فدمرت بلداننا وشرّدت شعوبنا، وازداد الشعور بالقهر والظلم والخذلان. وبعد أن كانت الهزائم المتلاحقة قد تمكّنت من الوجدان العام، مواكبةً لبلوغ الشعور القومي ذروته، ابتداءً من نكبة 1948، مرورًا بنكسة حزيران، تنامى الشعور الديني، وتمكّن أكثر من حياة الناس، وصار الدين ملاذًا لهذه الشعوب المقموعة المخذولة، مسلوبة الإرادة والقرار. ترافق هذا مع تمكين الدين والجماعات والتنظيمات الدينية في ساحات السياسة وتهافتها، لأن تستلم قيادة “الدول والمجتمعات”، بدلاً من أحزابٍ وأنظمةٍ صادرت هذين المجالين، تحت شعارات الديموقراطية والعلمانية والعدل والمساواة والحقوق، في الوقت الذي لم تقدم لشعوبها غير القمع ومصادرة الرأي، وكبت الحريات وتضييق العيش عليها. تنامت الظاهرة الدينية، وتنامى معها التمسّك بالهوية الدينية، بشعائرها وطقوسها ورموزها. وصار الحجاب رمزًا قويًا إشهاريًا دالاً على انتماء اجتماعي سياسي، حتى لو لم تكن كل الشرائح الاجتماعية التي تعتمده، وتتمسّك به فرضا دينيا ورمز انتماء، ترتبط بحركات سياسية، أو تنظيمات ساعية إلى السيطرة على المجال السياسي، لكن تجربة الإسلام السياسي التي أخفقت، والحركات الأصولية التي مارست العنف بأعتى أشكاله، وطرحت أجنداتها الشمولية الإقصائية، جعلتا من الحجاب ظاهرة مرفوضة لدى شرائح عديدة من المجتمع، باعتباره يمثل هويةً جامعة للإسلام السياسي بمختلف أطيافه، والذي لم يقدّم ما يطمئن الشعوب تجاه مستقبلها، ويشكل نكوصًا نحو الماضي، ورجوعًا عن المكاسب التي حققتها في مجال الحريات، ومنها تحرّر المرأة، حتى لو كانت مكاسب لا تقترب من النموذج الذي سعت إلى تحقيقه.
لم يستطع العرب المسلمون هدم جدار الانغلاق، والانفتاح على باقي الثقافات، بل ارتفعت وتيرة شعار “الإسلام هو الحل”، والمناداة بـ “تطبيق الشريعة” التي كانت المرأة أولى ضحاياها
وأكبرها، مع ازدياد وتيرة العنف وانسداد الأفق في وجه الشعوب المنتفضة التي دُفعت باتجاه الحروب البينية والأهلية التي كان للإسلام السياسي دور كبير في تأجيجها، مثلما كان للأنظمة السياسية الأخرى والقوى المتحالفة معها أو الداعمة للفصائل المعارضة دورٌ في تأجيجها.
عودة الحجاب بهذا الزخم، تزامنا مع الحراك السياسي، والزلازل التي تصدّع أركان الدول والشعوب والمجتمعات في المنطقة، وتنامي الحركات الإسلامية، بتدرّجات طيفها بين معتدلة وأصولية عنفية، من المتوقع أن تصبح قضية خلافية بالغة التعقيد والحساسية، في مرحلة إشهار الهويات العقائدية والإيديولوجية التي يجمعها قاسم مشترك متين، هو مصادرة المجال العام، وفرض الأجندة الخاصة ولو بالقوة، وجميعها مارست العنف بأقصى أشكاله، لكن المؤسف أن يكون التهتك المجتمعي والثقافي وصل إلى هذه المرحلة المخيفة، عندما يصدح الجميع بشعارات الحرية وحرية القول والرأي، بينما لا أحد يقبل من الآخر المختلف رأيًا ويطرحه للنقاش، بل الكل يصبح ديّانًا للآخر المختلف، حتى لو كان في تصريح فراس السواح حدٌّ من المبالغة والإساءة، طالما جاء في نطاق التعميم.
وليس هذا القول دفاعا عن السواح، فكاتبة هذه المقالة تخالفه في أن حجاب الرأس يعني بالمطلق حجاب العقل، فهناك عنصر أهم، هو حرية الإرادة والضمير التي تفتقدها شعوبنا العربية بغالبيتها الساحقة. وهذا لا يعني حجاب العقل، فالعبيد، عندما كانت العبودية، باعتبارها ظاهرة لا إنسانية، تشكل جزءًا مهمًا من النشاط البشري، لم يكن العبيد محجبي العقل، بل كانوا مسلوبي الإرادة. وقد أدركوا ذاتهم، وثاروا ضد أوضاعهم، ونالوا حرياتهم، وأبدعوا في كل مجالات النشاط البشري. أقول لو كان تصريح فراس السواح يحمل درجة من الإساءة بتعميمه، فهذا لا يعطي مبرّرًا للآخرين كي يتناولوه بشخصه، ويهتكوا كرامته ومكانته، وينسفوا تاريخه الإبداعي، وإنتاجه الثقافي والفكري الذي لا يمكن إنكاره. كان الأجدر والأكثر إخلاصًا للشعارات التي ينادون بها أن يصبّوا سجالاتهم في مكانها الصحيح. أن يمارسوا دورهم النقدي، ويجادلوا بالحجة والبرهان. هذا لم يحصل، للأسف، وللأسف أكثر أن الهوّة تتسع بيننا وبين إمكانية التأسيس لوعي مغاير، وعي نقدي بالدرجة الأولى، يضع شعوبنا على طريق النهضة الإنسانية الحقيقية، بعد التجارب المريرة والقاسية التي مرّت وتمر بها.
العربي الجديد
الحجاب وفوبيا الإسلام والعلمانية/ عمار ديوب
ما إن رمى الباحث السوري، فراس السواح، جملته الرديئة على “فيسبوك”، أنّه لا يقبل صداقة المحجبات، لأن الحجاب يحجب العقل، حتى اندلعت حوارات “ثاراتٍ” كبيرة بين السوريين، وتخندق الجميع بين الإسلام فوبيا والعلمانية فوبيا. تيار الفوبيات هذا يعد الأفضل، حيث يناقش المسألة من زاوية رؤية فكرية، بينما هناك تيارات إقصائية، ومتطرّفة من الجهتين، ولا تقبل البين بين، حيث الرافضون للحجاب “علمانيّون”، والناظرون إلى ضرورته “إسلاميون”. وكما في كل نقاش سوري، لا بد من الحديث عن الأقليات المتعلمنة “بالسفور”، والأكثرية الدينية المتحصّنة بالحجاب. في سورية، يرمي كثيرون بوجوهنا كل يوم هراءً كثيرا، وهو يعبّر عن رداءةٍ في فهم الواقع والفكر، ويرفض الاحتمالية في الفهم والمواقف، وطبعاً يتم تجاهل الواقع، والسباحة في الأوهام والذاتيات؛ فليس من تاريخٍ ومجتمع ينتمي إليه هذا النقاش! قصدنا هنا: أي نقاشٍ، وفي أيّة قضيةٍ، يجري بسياقٍ تاريخيٍّ محدّد، وربما يكون التعقيد التاريخي الذي نعيشه سبباً في التباساتٍ فكريةٍ كثيرة، وبأغلبية المجالات.
أي نقاشٍ عقلاني يتناول الديني، فهو يقترب من المقدّس، وبالتالي تلتصق به شبهة الشيطنة، وهي مشكلة كبيرة، وتستدعي، كما أصبح سائداً، تنويراً أو إصلاحاً في الدين. لا شك أن المقدّس يجب أن يُنزّه، وأن يُنقد ضمن دراسات عميقة للمقدّس ذاته. الدراسات هذه لا يمكن أن تتمّ، من دون أن يكون للعقل الحرية المطلقة في التفكير والبحث والاجتهاد. ولكن أيضاً، لماذا يطغى الحديث في المقدّس في بعض الأوقات، ويتراجع في أوقات أخرى. القراءة هنا، يُفترض أن تكون حرّة، ومن دون اشتراطات.
دارت في العقود الأخيرة نقاشاتٌ كثيرة بشأن الحجاب، وهل هو فرضٌ دينيٌ أم مسألة شخصية؟ المشكلة هنا أن هذا النقاش لا يهبط من عليائه إلى المجتمع، حيث اعتبر الحجابَ فرضاً دينياً،
وصار التقييم للنساء وللعائلات وفقاً لهذا الاعتبار. الردة الأصولية المتأتية على أثرِ إخفاق التنمية، والتطييف المجتمعي العام، تجيبنا عن قضية الفروض هذه، وهي لعبة الأنظمة أولاً، والإسلاميين ثانياً، وفي ذلك يتم تهميش، ومحاصرة وطرد ونفي وحملات كرهية، كل نتاج التنويريين والعلمانيين، ومهما كانت تصنيفاتهم الأيديولوجية والفكرية، بل والدينية.
لا أهتم بمن يعادي الدين من زاوية الإلحاد، حيث إن القائلين به لا ينتبهون إلى الأساس المجتمعي لكل أشكال الفكر والإيمان وعدمه، والتي تتصاعد أو تخفت وفقاً لهذا الأساس. أي أن قضية الإيمان من عدمه، أو التشدّد من عدمه، أو الميل نحو العلمنة من عدمه، مرتبطة بالنهوض المجتمعي، أو الفشل في التنمية والحداثة. هنا الأصل في النقاش، وليستوي بالأرض وبأنفاس الناس.
لن نستعيد كيفية إخفاق التنمية السورية، ومنذ السبعينيات خصوصا، ومحاربة كل التيارات الحداثية لصالح تطييف المجتمع. وقبالة ذلك، سيطرت أجهزة الأمن على مختلف أوجه الحياة السياسية والثقافية، وكذلك سيطرت مافيات الفساد والنهب على الاقتصاد، وتمَّ الفتك تدريجياً بالقطاع العام، وانهارت البنية الصناعية التي بُدئَ بها في تلك العقود. ومع التسعينيات، بدأت تصدر قوانين تحويل الدولة إلى دولة ليبرالية، وتحت ظل الاستبداد، ولصالح مافيات سلطوية أو تدور بفلكها، ولكن ذلك غَيّرَ من كل بنية الدولة المجتمع، ودفع المجتمع نحو التخلّع والتشظي والتذرّر طبقياً ودينياً وقومياً وطائفياً.
الدولة المحكومة أمنياً، ونظراً لمعرفتها العميقة بالتيارات الحداثية وخطورتها عليها، في طرح برامج ورؤى جديدة لإيقاف الفساد والنهب والاستبداد، ومطالباتها المستمرة ومنذ السبعينيات بالتحوّل الديمقراطي، كما كانت تؤكد المعارضة بكل أشكالها، دفعت المجتمع نحو التطييف كما ذكرنا، وطيّفت مؤسسات الدولة ذاتها بشكل خفي، وأوجدت بذلك وعياً طائفياً، ومظلومياتٍ دينية وطائفية، وبغياب أي حوار مجتمعي أو حريات أوّلية بسبب القمع، وكذلك وبغياب نقاش أزمة الثمانينيات، وما تركته من مشكلاتٍ وكوارث، فإن الواقع ازداد تدهوراً، وتطيّف الوعي بشكل كبير، بينما كانت التيارات المعارضة الحداثية تتحرّك في أطرٍ ضيقة، ومرصودة بشكل دقيق من أجهزة الأمن، وكذلك تراجعت النزعات الحداثية والعلمانية والعلمية في المجتمع.
تطيّف المجتمع السوري بشكلٍ حاد، لكن مشكلاته الاقتصادية والاجتماعية كانت أيضاً ضاغطةً من أجل التغيير الاقتصادي والاجتماعي، أي تنازع الوعي التطييف، وكذلك ضغط الواقع الاقتصادي والاجتماعي، وأن كل فئات المجتمع متضرّرة، والأمر ليس مقتصراً على طائفة من دون الأخرى. على الرغم من ذلك، تنمذج الوعي، فهناك تطابق بين من يَنهب ومن يَحكم، وعكس ذلك، من يُنهب ومن يُحكم عليه، وبالتالي ازداد التطييف.
حساسية التطييف هذه حَوّلت كل حديث ناقد وله علاقة بالدين، ولو كان يخصّ قضايا اجتماعية أو مسائل بسيطة، إلى تصويره وكأنّه هجوم على المقدّس، وازدادت من جرّاء ذلك حملات التكفير أو التلويح بذلك “لدى المسلمين بكل مذاهبهم وطوائفهم وكذلك لدى المسيحيين”. وبالتالي، وُجدت فجوات عميقة في المجتمع بين المؤمنين وغير المؤمنين، وكذلك بين أصحاب الرؤى الفكرية العلمانية والدينية، وحتى الذين يتبنّون رؤيةً عقلانيةً سقطوا بفخ الحملات تلك. وهو ما لوحظ في إطار الصراع السوري بين النظام والثورة، بل وبين تشكيلات المعارضة وقواها، وأيضاً في جمهور الموالاة؛ فليس من رأي آخر.
هناك قضية يستند إليها بعض المثقفين، وتنطلق من أن الأكثرية الدينية لم تحكم، ويجب أن يعود الحكم إليها، وترى أن أي تحوّل ديمقراطي سيقود، بالضرورة، هذه الأكثرية إلى الحكم،
وبالتالي يجب مراعاة حساسية هذه الأكثرية، والابتعاد عن كل نقد لها وللمقدّس، أو حتى تناول أيّة قضية لها علاقة بالديني. ويرى هذا التيار أن كل نقاش ينتقد حياة الأكثرية وقضاياها، ويرفض التقسيم الديني ذاته “أكثرية وأقليات”، يراهُ مصاباً بعُصاب الإسلام فوبيا.
تهمة الإسلام فوبيا، بدأت أخيرا تُستخدم كيفما كان، وطبعاً قبالتها هناك العلمانية فوبيا، حيث يتم تصوير كل نقد، كما ذكرت، وكأنّه تهجم على المقدّس أو الأكثرية، أو عكس ذلك، بما يخص العلمانية والأقليات، وبالتالي تُصم الآذان، وتُغلق العقول، وتَجفُ الأقلام عن أي جديد، وضمن ذلك، يصير التقييم أخلاقياً دينياً “شر خير”، ويسود التكفير، فالقتل.
فشل أهداف الثورة السورية، وتحوّل الواقع إلى حربٍ داخلية وإقليمية، وتطييف الحرب ذاتها، وعدم تغيّر النظام، ورفضه الاعتراف بدوره عن مأساة سورية، أقول كلّها عناصر تدفع نحو التشنج والتعصب والإقصائية والتكفير وكراهية الاتجاه الآخر. إذاً تسيطر على السوريين تيارات الإسلام فوبيا والعلمانية فوبيا. وبالتالي، يقع على المثقفين نقاش القضايا المشتركة وغير المشتركة بين السوريين.
طبعاً ما قاله فراس السواح خاطئ كلية، وهو ليس المدخل المناسب لنقاش ظاهرة الحجاب، وتحوله إلى فرض ديني، ورمز وقيمة أخلاقية، ولكن جملته السيئة لا تهدر قيمة أبحاث الرجل.
العربي الجديد
حجاب العقل!/ عمر قدور
قبل يومين أثار فراس السواح ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي إذ كتب على صفحته في فايسبوك: “تعميم: أنا لا أقبل طلبات صداقة من المحجبات. حجاب الرأس يعني حجاب العقل”. السواح اشتُهر ضمن الحلقة الضيقة للمثقفين في النصف الثاني من السبعينات بكتابه “مغامرة العقل الأولى”، وحينها كان ثمة قحط سوري في الدراسات التي تخص ميثولوجيا المنطقة. ثم شاع اسمه، لدى من يعرفه ومن لا يعرفه، في بداية الثورة بسبب اتخاذه موقفاً مناهضاً لها، إلى أن أتت تدوينته الأخيرة لتذكّر به من جديد.
بعيداً عن ردود الأفعال التي نراها عادة على وسائل التواصل، وتتراوح بين الشتائم والنقد والتهكم، يقودنا ما كتبه السواح إلى قضايا تخص موقع المثقف ونوعية الثقافة التي يتمثلها، ومن ثم إلى ذلك الفهم العامي الذي لا يندر توافره لدى المثقف ومنتقديه. ما كتبه السواح ينقسم بين عبارتين؛ الأولى تتعلق حقاً بحريته الشخصية المطلقة، فمن نافل القول أن من حق أي شخص قبول صداقة الذين يروقون لمزاجه أو لأفكاره. العبارة الثانية فيها مصيبة معرفية كبرى، فالقول أن “حجاب الرأس يعني حجاب العقل” فيه من القطعية مما لا يصدر سوى عن عقل إيماني، وإن أتى هذا الإيمان بزعم العلمانية على النقيض من الإيمان الميتافيزيقي. هكذا يصبح زعم العلمانية ديناً آخر على نقيض من الدين، ويصبح أصحاب الدين العلماني من “الفئة الناجية” على صعيد العقل، ويحق لهم تكفير غيرهم وإن أتى التكفير بلغة مغايرة تقيم تفاضلاً عقلياً لصالح الفئة الناجية.
الأمر لا يتعلق بالسواح تحديداً، فلا يندر أن نرى بين قسم من العلمانويين السوريين تلك النبرة المتعالية على المسلمين تحديداً، وذلك الفهم الذي يستثمر معارف نقد الأديان للنيل من الإسلام تحديداً، لتغيب تلك النغمة لدى تناول مظاهر تخص ديانات أخرى. قد نردّ هذا التشنج إلى واقع سياسي، تبرز فيه الحركات الجهادية والأصولية، وتسعى إلى هندسة المجتمع وفق تصوراتها، إلا أن هذا الفهم لا يعفي أولئك العلمانويين من الحد الأدنى من المعرفة، الحد الذي يقتضي التفريق بين المستوى الإيماني للدين والمستوى الذي يتحول فيه الدين إلى سلطة قهر. في المستوى الأول لا نستطيع الزعم بأن ملايين المسيحيين مثلاً قد أقلعوا عن إيمانهم، وقد أقلعوا عما يراه غيرهم من اللادينيين بمثابة خرافات أو أساطير؛ ما حدث هو التراجع المطلق في سلطة الكنيسة السياسية، أي أن الصراع كان وما يزال الآن في السياسة. وفي السياسة يُفترض بأي نقد، أو أية مواجهة، الاتجاه إلى الخصم الفاعل سياسياً وتحييد أولئك الذين يتشاركون معه على المستوى الإيماني من دون شراكة على المستوى السياسي.
تحمل ذاكرة السوريين حادثة شهيرة في مطلع الثمانينات، عندما نزلت مظليات الأسد إلى الشوارع ونزعن الحجاب عن النساء بالقوة. إذا شئنا الانتباه إلى آثار تلك الحادثة المشينة فسنرى كيف ازدادت نسبة النساء المحجبات بدءاً من ذلك التاريخ، والحجاب الذي كان شأناً شخصياً تحول لدى البعض إلى نوع من هوية مضادة لسلطة الأسد، من دون أن نغفل عن دور الإعلام في صعود الموجة الإسلامية في عموم المنطقة. ما لا ينبغي إغفاله أننا شهدنا في الفترة نفسها زيادة نسبة المحجبات في الفضاء العام، في الجامعات وفي سوق العمل، ويمكن الجزم بأن نسبة التعليم بينهن قد ارتفعت بشكل ملحوظ، بما في ذلك المستويات العليا من التعليم وأحياناً من جامعات عالمية مشهود لها.
فكرة الحجاب التي ترهب البعض تجعله عديم الانتباه “فوق كونه عديم الرحمة” إلى أن جزءاً من ظاهرة ازدياد الحجاب في الفضاء العام يعود إلى تقدم شريحة كانت مقصية عن ذلك الفضاء، ومن الواجب الأخلاقي الدفاع عن وجود تلك الشريحة بدل بقائها حبيسة الجدران حيث يكون “حجاب العقل” الفعلي. الافتراض الآخر الذي يستلزم قليلاً من الرحمة هو القول أن تلك النسوة جميعاً قد وضعن الحجاب جراء ضغوط دينية واجتماعية، وإذا كان من يمارس عليهن تلك الضغوط يمتلك قدراً من التسامح يسمح بتعليمهن وعملهن فسيكون من النازية الفكرية دفعهن إلى ما وراء الجدران كرمى لأشخاص يفضّلون الفضاء العام “معقّماً” من الحجاب؛ ذلك أشبه بإرسال الفقراء إلى المحارق بدعوى القضاء على الفقر.
لئلا نقصر النقاش على الجانب النظري؛ لو افترضنا صدور هذه الإهانة في أي بلد ديموقراطي، بما في ذلك فرنسا التي تُعد الأكثر تشدداً على صعيد العلمانية، فإن صاحبها معرّض للمحاكمة بتهمة التمييز، ولرأينا نساء سافرات قبل المحجبات يرفضن الانتقاص من القدرات العقلية على أساس نوع اللباس. ومع أن القوانين العربية برمّتها قاصرة في معاقبة جرائم التمييز إلا أن هذا القصور في سوريا يتزامن مع تحولها إلى أرض للإفلات التام من العقاب، ومن المؤكد أن جرائم الإبادة المادية تشجع جرائم الإبادة المعنوية بكافة أشكالها. هكذا لا يمكننا عزل زلة فراس السواح عن مناخ عام لا يجوز وصفه بالكراهية وعدم قبول الآخر، لأنه في مرتبة غرائزية أدنى نرى فيها الخطاب الفكري محايثاً ومتمماً لكافة الجرائم.
بالعودة إلى زعم العلمانية الذي يقف وراء إطلاق حكم من نوع “حجاب الرأس يعني حجاب العقل”؛ لا نحتاج فطنة للقول أن عبارات من هذا القبيل تعيد إلى التنظيمات المتطرفة ما تخسره بممارساته مضاعفاً، وكأن أصحابها يهدفون عن وعي إلى تغذية التطرف، وكأنهم موضوعياً شركاء لمن يعتبرونه عدوهم اللدود. من المعتاد أن تستنفر إهانة أية مجموعة بشرية رد الفعل الأكثر راديكالية، سواء كانت المجموعة دينية أو عرقية، وفي حالتنا من المعتاد أن يزداد سوء الفهم الحاصل للمسألة العلمانية، طالما وجد من يتبرع بتصويرها كعدو للدين.
ما يرفضه هؤلاء العلمانويون، أسوة بنظرائهم الإسلاميين، هو مبدأ الحرية الشخصية التي تتضمن الحق في الإيمان والحق في عدم الإيمان والحق في ألا يكون أي شخص في إحدى المنزلتين، وكذلك الأمر بالنسبة للحجاب وكل ما يتعلق بالحرية الشخصية. هذا النزوع إلى الهندسة الاجتماعية، بتعبير ملطّف جداً، ينقض أساس العلمانية التي تتسع للمتدينين وغير المتدينين ما دام كل منهم يقرّ بحرية الآخر، وما دام كل منهم يقبل بدولة على مسافة حقوقية واحدة من الطرفين. مع حجاب العقل الحقيقي الذي يدع الغرائز تنفلت بلا حساب، يحق لنا التذكير بأن المعرفة وحدها لا تصنع ثقافة، وأن الخلط بينهما كان دائماً على حساب الثانية.
المدن
فراس السواح… غوبلز الملول/ بشار جابر
لا شك أن تصريح فراس السواح عن الحجاب، فضيحة الفضائح، ليس كونه معادياً للمرأة أو الدين أو الاتفاق الاجتماعي، بل لأنه يشي بالكثير من طبيعة السواح المعرفية المُهينة والرافضة للحداثة كمنهج للتفكير والبحث المعرفي. الفضيحة في حرب السواح على الحداثة أنها أتت برخص، فالباحث الظواهري، الباحث عن المعنى، بدا فاقداً للتفكر، بالأحرى للوعي بوصفه فكرة وانعكاساً، فلجأ إلى مقولته عن الحجاب (والتي كررها في مقابلة مصورة) كمقولة لا كفكرة، واصفاً الحجاب بـ”الظاهرة المتخلّفة”، والتي يجب وأدها من التاريخ.
وإن كان قوله فكرة، فهو لم يضع حيثيات برهانية أو عملية تجعل ما يتفوه به أمراً قابلاً للإدراك أو الحاجة أو حتى المعنى الذي يُمكن قبوله. فبدا مثقفاً خرافياً، كفردٍ طائش، لا يضع شرطاً ولا وعياً، والأهم أنه صرّح من دون أن يقدم طرحاً أو حواراً، ولم يُبقِ لنا وله سوى عنفه. الجُمل الانبهارية هي أكثر أدوات الفاشية رواجاً. السواح لجأ إلى عنف الفاشية في تسرعها لإنتاج المقولات، التي تقدس النزعات الجماهيرية، والدعاوى الأسطورية المختلقة، ودنيويتها التي تحمل سمةً شريرة انتقامية بهيمية. فالسواح لا يبدو هنا شاعراً يريد اتحافنا، ولا نبياً يُريد امتلاك كهنوت إطلاقي، ولا هو عسكري ليأمرنا، بل هو يحارب الحداثة فقط، بما هي حرية، وعقلانية، وذاتية، كقيمٍ إدراكية بديهية تاريخية لفهم المجتمع البشري.
لا يحاكي الفرد إلا بوصفه بهيماً متخلفاً لأنه مُختلفٌ عنه في إنتاج ما يراه السواح حرية أو تفكراً وعقلاً. فإما أن يخضع الفرد له كتابع لمثقف كهنوتي إطلاقي يكبح أي اتساق فلسفي رتيب، أو تفكير عقلاني فاهم ودلالي لدراسة الفرد قبل نعتهم بالتخلف. وإما يضع الأفراد موضع دراسة تاريخية لزمنهم ومجتمعهم وطبيعة دولتهم ودرجة الحرية المعرفية والعلمية التي وصلوا إليها، والأهم من ذلك ما يقدسونه من رموزٍ كدلالة مؤقتة أو أبدية على هويتهم. إنه العنف حينما يجد إنساناً ناطقاً، ولو كان باحثاً أو علامة، ولو عارض في قوله إنتاجه المعرفي الرصين. فلم يكتب السواح كتابه “نشأة الدين” لإنتاج مقولة كهذه. ذلك الكتاب الذي يضع الإنسان دوماً في دائرة البحث عن مخلّص، للنجاة من قدَره وهجوم الطبيعة عليه والإجابة على أسئلة حياته وحيوات الآخرين وحتى اجتماعهم. لكن العنف يحل على الألسنة من دون استنطاقها ملياً. الأوضح هو وصف شتراوس لزمننا، “زمن العودة إلى الهتلرية”.
أحال السواح الحس البشري إلى الأدوات البهيمية ما قبل الآدمية -أي ما قبل فهم الإنسان كمصنوع حديث ذي غاية ومعنى وتفكر- وهي الأدوات التي تنقل شعورها وحسها إلى عالم القول والإشهار، فلا تدرس سياقاً اجتماعياً هوياتياً بشكل معرفي، ولو كانت ذات باع طويل في معرفة البشر وتاريخ اعتقادهم ورموزهم، لكنها لا تحاكي عقلية الإنسان ووعيه بذاته وقيمه وقدرته على التعلم والتعقل. وتكرار السواح مقولته عن الحجاب و”تخلّف” المحجبات هو صنيعة ذاته وشخصه، في أن لا يُفهم. إنها ضرورته الملحة كمثقف ذاتي، لا يُشاهد التنوير والنهضة كصنيعة اجتماعية سياسية، لكي لا يصارع نظاماً لا يقوى عليه.
https://www.youtube.com/watch?v=fOWgZK7toSk
فهم التاريخ
فالسواح صديق العائلة الحاكمة، لا يبالي في أن يتقاطع معها عنفياً. الباحث الظواهري الحاد، والذي ينفصلُ عن الحدث أثناء فهمه للتاريخ في سلسلة كتبه، بوصفها تحليلاً بريئاً ومقارناً، سارع في قوله الشخصي ليكون حاسماً ومُظهراً لرأيه. جرأته كانت عنيفة، فضرورة المنهج في الكُتب تجعله سياقياً وفلسفياً ورتيباً وزمنياً، ويبدو صلباً كالمرآة في نقل الحدث وفي ترتيب حيثياته. لكن تَمثّل شخصه يجعله عنيفاً، فيتسق مع النظام بسهولة تامة.
حرب السواح على الحداثة واضحة، فما أبهرنا به من عنف قولي له قرين أكثر انغماساً في العنف المُجسد. في الثمانينيات أنزل رفعت الأسد مظلييه فوق دمشق لينزعوا الحجاب عن رؤوس النساء في الطريق، ما جعل حافظ الأسد أكثر ضراوة في حربه على علمانيي البلاد ليُبيض صفحة نظام “البعث”. ولن يكون أجمل لرفعت الأسد من مقولة تُعيد له مصداقية إنجازاته، إلا أن تصدر عن باحث رصين، ليقدس رفعت ما فعله في شوارع دمشق كرمز لفعل حضاري فاشي كهنوتي في آن معاً.
إننا أمام غوبلز ملول، وأكثر إدراكاً وعنفاً، لكن من دون مسدس. فالنظام يرفع المسدس بدلاً منه وقت اللزوم، فلا نعرف كيف يُمكن أن يبدو مثقف بارز مثل السواح موازياً لرفعت الأسد في دلالة العنف والسيادة. نحن، العاديين من قابلي الحجاب كمظهر من مظاهر الحرية الفردية، نقترن بالحرية، فهل يُعقل أن نوازي بين رفعت والسواح؟
يُسهّل السواح المهمة. فرفضه لـ”صداقة” المحجبات في “فايسبوك” هو رفضه للمعرفة، بالأحرى للحداثة حينما تقدم أسئلتها وطروحاتها عن طبيعية حرية الفرد، وقدراته، ودرجة التحقق من الحرية داخل المجتمع، وتسائل الدولة بوصفها دولة حق بدلاً من أن تكون فقط دولة احتكار العنف، بحسب توصيف كوجيف. فاعتبار المحجبة متخلفة، هو مصادرة يستخدمها النظام ومن منطلق طائفي بحت. فهل يراقب السواح الرموز المسيحية على صدور الأفراد، أو يفتح صورهم في “فايسبوك” ليرى العذراء مريم خلف أُسرِهم؟ وهل دقق في أيدي أفراد علويين يُلبسونها خيوطاً خضراء؟
بالطبع لا.. فما تيسر للسواح فعله/قوله هو الحجاب، ليوازي مذهباً سلطوياً عسكرياً عاماً في دلالة المشهد وكثافته. يبدو أن السواح بات يفتك بالظاهر الحيادي، بدلاً من فهمه والانسياب فيه بوصفه معنى أعمق مما تراه عيناه. وهنا تكمن ضحالة عقلانية السواح في الانزياح عن أنسنة الرموز الدينية، في مقابل جعلها متاحاً عنصرياً محدداً. السواح لا يتيح للمحجبات، إن كن عرضة لقيد ما، مفهوم الحرية، كونها فعلاً (للتحرر)، وليست خاصية حجرية تركن في زمنٍ أبدي.
وما يزيد المرء قهراً، هو أن السواح صنع الآن أعداء من أناسٍ يحتاجون إلى قراءته لأهمية ما كتب، وما سيكتب. فقوله الشخصي لا ينفصل عن دوره المعرفي من دون أي شك. عطفاً على ذلك، من المؤسف ألا يكون السواح تلميذاً نجيباً لفلاسفة قرون الحداثة والنهضة، الذين واظبوا على احترام معتقدات العامة. ويُشار إلى أن هيغل كثيراً ما انتقد مثلاً “الإلحاد الكوميدي” عند اليونانيين، بوصفه نوعاً من الاستهزاء الرخيص أو إطلاق المقولات التي تُخيف العامة وتجعلهم بلا آلهة، أو بلا شعورٍ بالمعنى وعرضة لهجمات الطبيعة وشراستها. حتى سيبنوزا، طالب النخبة ألا تحارب رموز العامة وعقائدهم، لأن الإلحاد والتخلي عن العقيدة يُسبب فراغاً أكثر شراً من الإيمان الأعمى والتقليدية البائدة. لقد خلق السواح هوة لنفسه وللمجتمع برمته، فظهر قوله مترنحاً بين عداء للدين، لا قيمة له، وبين انحياز لمذهب النظام الرخيص في الدفاع عن علمنة المظهر الخارجي من دون إقامة وزن لذات الفرد وتفكيره.
المدن




