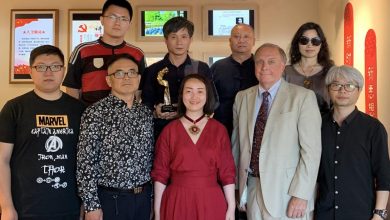عشر قصائد/ سامر أبو هواش
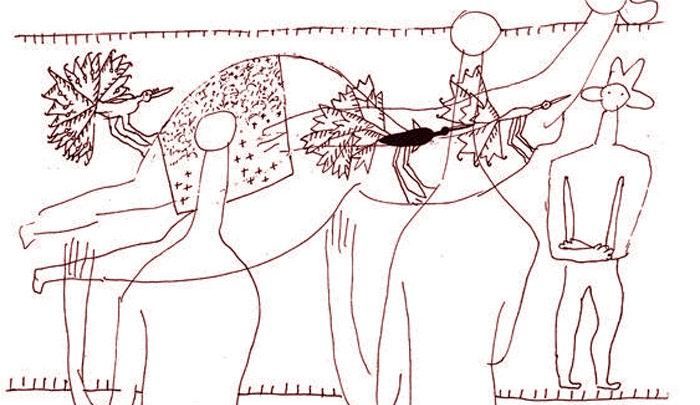
في عالم جديد
كنت وحيداً، قليلاً أو تماماً، وكان العالم يحدث، كالعادة، بعد المقتلة الكبرى، وبتنا جميعاً نعرف أننا نعيش الآن في عالم مختلف، مع النباتات نفسها وقد زادت قليلاً، والحيوانات نفسها وقد نقصت قليلاً، والهواء وقد بات مستحيلاً مثلما لطالما توقعت الحيتان النبيلة وهي في طريقها إلى الانتحار على شواطئ مجهولة.
وصرنا نمشي مثلما يجدر بنا أن نفعل في هذا العالم الجديد، ومن وقت إلى آخر يحالفنا الحظّ ونعثر على كلمات ملونة كالحصى، لكنها ليست كافية لوصف أكبر الأشياء؛ كدسة قتلى أو جبل؛ ولا أصغر الأشياء؛ جثة طفل أو طائر. فلم نعد نأبه لهذه الأمور القديمة، وصرنا نقف تحت الدوش، نركب السيارات، نذهب في عطلات أو تأتي العطلات إلينا، ونجلس في الصباحات المبكرة، عراة تماماً من الكلمات، لكننا لا نقول ذلك، ولا في سرّنا حتى. وصرنا نلتقي عند تقاطعات الليل الكثيرة، بأفواه حافية أدماها الصمت، ونحاول أن نتذكر شكل اللهاث، وما الذي يعنيه حقاً الوصول من هنا إلى صباح آخر لن نسمع فيه سوى أشباح أصواتنا النافقة وهي تحاول أن تتذكر.
مجرد حلم مزعج
العالم يواصل نفسه
مثلما يتوقف قطار في محطة
مثلما يترجل رجل من القطار
مثلما تستوقفه فكرة غامضة فيظنّ أنه نسي شيئاً في القطار، ثم يواصل السير غير عابئ بما قد يكون ضاع منه
مثلما يعاود رجل فتح النافذة لتدخل الأصوات التي ظلت محبوسة طوال الليل في الخارج
مثلما تتوقف المكنسة الكهربائية ثم تنطلق مجدداً بكل قوة كأنها اكتشفت أخيراً الهدف من حياتها
مثلما تقرر امرأة ألا تفكر في حبيبها، فتراه يتضاعف أمامها في الهواء لكنها تظل مصرة على ألا تلفظ اسمه
مثلما يصمت صرّار الليل لبرهة كأنه ممثل يتذكر سطره في مسرحية ثم يعود إلى أول السطر
مثلما يصحو ميت في منتصف الليل أو النهار، ينظر حوله في العتمة الترابية، لا يرى شيئاً، فيعاود إغماض عينيه كأنه كان مجرد حلم مزعج.
أصوات ليليّة غامضة
أتخيّل امرأة مصابة بأرق مزمن، وكالأرنب في “أليس في بلاد العجائب” تتكرّر في رأسها كلمة واحدة “الوقت.. الوقت.. الوقت”، لكنها لا تعرف ذلك، لأنها لا تسمع صوت رأسها، بل صوت المكان. المطر أيضاً لا يفكّر ولا يسمع صوت رأسه. ولا الشوارع. ولا النوافذ. ولا الظلال التي تتحرك باستمرار على شاشة التلفزيون أو خلف الستارة.
لكنّ المرأة المصابة بأرق مزمن تتعب كثيراً من هذه الحال، فتقرّر أن تصبح امرأة أخرى مصابة بأرق مزمن. والمرأة الثانية بدورها تتعب، فتصير امرأة ثالثة، وهكذا دواليك حتى تصبح الغرفة مليئة بالنساء المصابات بأرق مزمن، واللواتي تتكرر في رؤوسهن كلمة واحدة “الوقت.. الوقت.. الوقت..”، لكنهن لا يعرفن ذلك.
شيئاً فشيئاً، يصبح المكان مزدحماً بالنساء المصابات بأرق مزمن و”الوقت” تصبح مطرقة تزداد ضخامة مع الوقت، ويمكن سماع دويها الهائل عندما يسقط أي شيء على الأرض، ولو كوب قهوة فارغ أو ملعقة أو ورقة بيضاء. والجميع في المباني والأحياء المحيطة يسمعون الدويّ ويشعرون بهزّة خفيفة، لكنهم لا يعرفون أن ثمة امرأة مصابة بأرق مزمن تغسل الأطباق في مكان ما وفي رأسها تتكرّر كلمة واحدة طوال الوقت “الوقت.. الوقت.. الوقت”.
شيء يشبه الاصطدام بباب زجاجي
ماذا لو أنني، في هذه اللحظات، كنتُ حزيناً دون أن أعرف؟ ماذا لو كنت حزيناً جداً. ماذا لو كنت، مثلما يقولون، “غارقاً في الحزن”، ولم أنتبه للأمر، تماماً مثلما يرتدي المرء، سهواً، جوربين بلونين مختلفين، أو يمشي وشريط حذائه غير معقود، أو سحّابة بنطاله مفتوحة، أو مع بقعة قهوة بحجم طائر على قميصه.
أحياناً أرى الناس يحملقون بي بطريقة غريبة، أو بطريقة توحي بأنهم يرون شيئاً غريباً، فأسارع إلى تفقد حذائي، بنطالي، قميصي، شعري، أسناني، ابتسامتي.. أهرع إلى أول مرآة وأحدّق طويلاً بوجهي، وغالباً ما أرى الشخص نفسه (مع بعض الفروقات البسيطة)، وأسأله إن كان على ما يرام، ويؤكد لي أنه على ما يرام. وأخرج مجدداً إلى العالم، غير منتبه إلى أن ثمة طائراً أزرق ضخماً يقف على رأسي.
الناجون
في معظم حوادث الطيران، بعد مقتل جميع الركاب والطاقم المكوّن من… إلخ، هناك قصة الراكب المحظوظ الذي تأخر عن موعد الطائرة، والتي تشبه قصة الطفل أو الجرو الذي عثر عليه حياً تحت الأنقاض بعد أسبوع من انهيار المبنى، أو قصة المرأة التي كانت تقف على الرصيف حين ارتطمت شاحنة بعمود إنارة يبعد سنتيمترات منها ولم يمسسها ضرر. هناك أيضاً قصة الشاب والفتاة اللذين يعشقان حضارة المايا واللذين سقطا عن جرف خلال التقاطهما صورة سيلفي لقبلة فرنسية طال انتظارها بينهما وعثر على جثتيهما مهشمتين بعد بضعة أسابيع لكن الكاميرا كانت سليمة تماماً. وهناك وقصة الصديقتين اللتين سافرتا من ألمانيا إلى جبال أطلس وعثر على رأسيهما مقطوعين بعد أيام قليلة. وقصة الشاب الذي نام في غرفة فندق فخم بلندن، بعد اطمئنانه إلى فوز فريقه بمباراة كرة القدم، حين خرج لص من الحمام وهشم رأسه بمطرقة. وهناك قصة الرجل الذي كان يقود سيارته ويدخن بشراهة ويستمع في الراديو إلى قصة الطائرة التي سقطت، أو المبنى الذي انهار، أو الشاب الذي أفاق ذات ليلة في غرفة فندق ولم يجد رأسه… إلخ، حين تلقى اتصالاً هاتفياً من أمه تخبره فيه أن جدّته ما زالت على قيد الحياة، وأنهم سيحاولون إحضارها معهم إلى حفلة الشواء في الحديقة يوم الجمعة المقبل، وأنها تتمنى من كلّ قلبها أن يكون قد تمكن أخيراً من الإقلاع عن التدخين.
أحياناً دائماً
أحياناً أفكر أن الناس جميعاً، في القارات السبع، أو المدن السبع، أو الشوارع السبع.. إلخ، يتشابهون حدّ التطابق في لحظتي الصحو والنوم، بصرف النظر عن بعض فروقات التوقيت، ومستويات الألم، الحب، الشبق، الخوف، الأرق.
مع ذلك، هناك فروقات بسيطة تكاد لا ترى بالعين المجردة. بعضهم يصحو مع مطرقة لا يعرف من أين أتت، ولا يعرف على أيّ رأس سيستخدمها، ومتى؛ ربما الآن.
بعضهم ينام في مكان ورأسه ينام في مكان آخر. معظم هؤلاء يصحو وفي يده خارطة بيضاء تماماً إلا من خط مستقيم يقطع الخارطة إلى نصفين. بعض هؤلاء يصحو أيضاً ومعه مطرقة في موضع الرأس، أو على الأقل فكرة واضحة عن طريقة مفيدة لاستخدام المطرقة.
لن يساعد أحد الوقوف أمام امرأة (لاجئة؟) ممددة على رصيف في شارع “الحمراء” وفي حضنها طفلة تنام بسكينة تامة كأنها لا تعرف شيئاً مما يحدث حولها. لكننا نعرف أن الطفلة تصحو أيضاً في وقت ما، وتظلّ تنظر كلّ الوقت، وترى أمثر مما ينبغي، وهذا في حدّ ذاته مدعاة لنوع غير مصنّف من الرعب؛ رعب لا يخصّ الطفلة ولا المرأة التي تنام الطفلة في حضنها، ولا الرجل الذي يقف الآن ويتأمل المرأة والطفلة، غير متأكد من مشاعره حول الموضوع برمته.
بعضهم يصحو ويجد تلفزيوناً غير مطفأ مكان رأسه. يسمع خليطاً من الأصوات؛ طفل يستطيع تقليد ببغاء؛ امرأة تستطيع تقليد سلّم والصعود على هذا السلم في آن معاً، تصفيق وصرخات إعجاب واستهجان. طائرات حربية تخترق الأجواء، أناشيد حربية، أحدهم يغنّي لصالح عبدالحيّ، مقدمة نشرة أخبار لا تنتهي، إعلان عن بنك مستعد لتبنيك أو أن يصبح الجدّ الحنون لأطفالك الذين لم يولدوا بعد.
أحياناً أفكّر، أن كل ما يحدث بين صرختين، فائض عن الحاجة. هناك من يصحو وينام، وقد نمت له أغصان يابسة بدل الأذرع والأرجل، ولا يعرف ماذا يفعل، سوى أن يتأمل بأن يظهر طائر ما من مكان ما ويحطّ على كل هذه اليباس. وإن كان لا يعرف ماذا يمكن أن يحدث بعد ذلك.
كوابيس صباحية
أصطدم بالباب.
أعرف مكاني.
ماذا لو؟
ماذا لو لم؟
ماذا لو لم يكن؟
ماذا لو لم يكن هذا؟
السقف ينقّط عناكب شفافة كالضوء.
الضوء ليس شفافاً حقاً.
الضوء مخادع.
الستارة مخادعة أيضاً.
خلف الستارة جدار إسمنتي.
خلف الجدار الإسمنتي جدار إسمنتي آخر.
خلف الجدار الإسمنتي الثاني جدار إسمنتي ثالث.
خلف الشارع…
ماذا لو…
على التلفزيون فيلم هندي يلعب المصارعة الحرّة مع فيلم “وسترن”؛ يوسف شاهين يقول: سكوت هنصور.
على إنستغرام مئة ألف رجل وامرأة يمارسون العادة السرية في هذه اللحظات.
في هذه اللحظات، ثمة مراهقة تنتحر في مكان ما.
“لو مضيت في هذه الطريق فسينتهي بك الأمر مفكّراً في أسباب تعاسة كل شخص على الكوكب”، تقول سيريس.
القميص الذي تحمله منذ نصف ساعة (كأنك تنتظر أن تلبسه لشخص آخر)، يلتفت وينظر إليك بعينين حزينتين:
“الشتاء قادم”، يقول لك “الأفضل يا سيدي أن نغادر هذه القلعة”.
صدأ
الصدأ، في حدّ ذاته، وبوصفه مجرد صدأ، ليس موضوعاً مناسباً لقصيدة أو لوحة أو مقطوعة موسيقية، ولا يمكن أن يكون موضوعاً مغرياً لمحادثة بين حبيبين أو صديقين أو حتى غريبين في طائرة. يصعب أو ربما يستحيل أن تجد كتاباً، فيلماً وثائقياً، محاضرة جامعية أو نقاشاً مفتوحاً بين طلبة المدرسة حول الصدأ. لن تجده أيضاً في طابع بريدي ولا على عملة ورقية أو معدنية ولا في بطاقة تذكارية. لكنّ الصدأ موجود دوماً؛ على الكرسيّ المهمل قرب باب المطبخ وقد وضع فوقه أصيص مرتجل من حاوية حليب. في قضبان النافذة التي تعاقبت عليها أياد كثيرة حتى لم تعد تذكر أو تبالي. في الأشياء الكثيرة المرميّة داخل دُرج لم يعد يفتح بسبب الصدأ الذي تراكم بداخله على مرّ السنين. حتى في مغلّفات الرسائل المنسيّة، في شقوق الجدران القديمة، في الملابس البالية التي لا نعرف لماذا ما زلنا نحتفظ بها في الخزانة، وفي الخزانة نفسها، يجد الصدأ دوماً طريقة ليترك لمسته الواضحة. أحياناً، يتسلل الصدأ إلى الأصابع، إلى الأيدي، إلى الشفاه والعيون، وأحياناً يكفي أن تضع أذنك فوق قلب ما، لتسمع الصدأ، وهو يحفر، ببطء شديد، الحرف الأول من اسمه.
نادي الأيدي المتعبة
الساعة على الجدار تحدّق بي طويلاً ثم تتثاءب وتغطّ أخيراً في النوم.
عيناي تذهبان في رحلة إلى غابة وتتزوجان شجرة قديمة ولا ترجعان.
يداي تقولان إنهما ستنضمان إلى نادي الأيدي المتعبة الذي أعلن عن افتتاحه أخيراً في التلفزيون.
قدماي تمارسان هوايتهما المفضلة بتسلق جدران من صنع خيالهما فحسب.
رئتاي ما زالتا تحفران في الكهف نفسه الذي قد يكون بئراً في نهاية المطاف.
قلبي فقاعة ضخمة فوق سطوح مدينة مهجورة.
فمي يلفظ الهواء فحسب.
جندي ميت في عالم آخر
تصحو ذات يوم، مرهقاً سئماً، من نوم لا يشبه النوم، ودون أن تقرّر شيئاً، ودون أن تنظر إلى السماء التي اعتدت النظر إليها كل يوم، ودون أن تتساءل مجدداً عن اسم ذلك الطائر الذي يختبئ منذ شهور في المكان نفسه، ويصدر في هذا التوقيت المريب بالذات، ذلك الصوت الرتيب نفسه الذي يشبه الغناء، لكنه في حقيقة الأمر ليس إلا صوت جندي ميت ينادي من خندق ما على جندي ميت في خندق آخر، ودون أن تقرّر فعل شيء، أو أن تتخذ موقفاً جديداً من أي شيء، تكتفي بالجلوس في مكانك المعتاد، وتدع الزّمن يمرّ، ويمرّ، حتى يختفي تماماً، وتتخيل نفسك جالساً وحيداً على مقعد يغوص في الرمل، على شاطئ بعيد لا يصل إليه أحد، وكل بضع ثوان تقفز سمكة من الماء، تنظر إليك وتهزّ ذيلها في الهواء، ثم تعاود الغوص مجدداً، وتغمرك السعادة حين تفكر أن هذه السمكة، وهذا الشاطئ، وذلك الرجل الجالس على المقعد، كل هذا ربما يكون حقيقياً جداً، وربما يكون مجرد وهم بصري آخر، لكنك لست مضطراً الآن إلى التعامل مع كل هذه التعقيدات الصباحية، فقط تشعل سيجارة أخرى وتسأل زوجتك أو أول شخص تراه عن اليوم والساعة منتظراً سماع صوت ذلك الجندي الميت وهو ينادي أمه أو حبيبته أو ربما جندياً آخر ميتاً في عالم آخر.
شاعر من فلسطين مقيم في أبوظبي
الجديد