“ذكريات غانياتي الحزانى” لماركيز: أرذل العمر أجمله!/ إبراهيم العريس
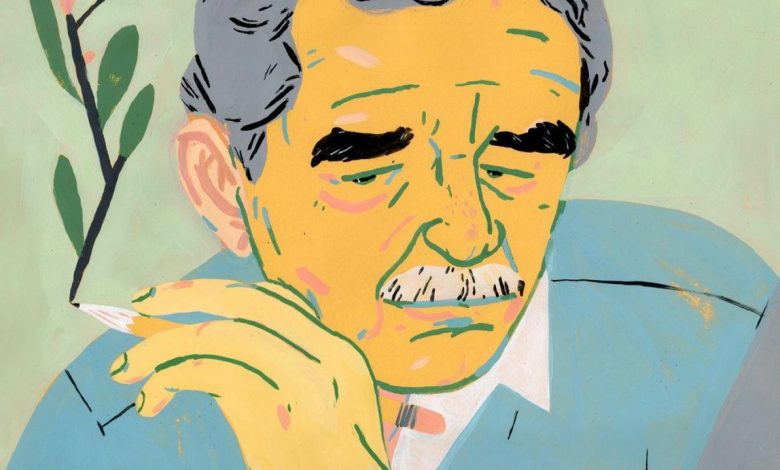
على خطى الياباني العجوز ولكن في منطق آخر
ربما سيكون من الأكثر طرافة هنا، بل حتى من الأكثر فائدة أن نبدأ حكاية هذه الحكاية مما يبدو وكأنه من خارجها. وربما نكون في نهاية الأمر أمام حكايتين لا حكاية واحدة، تأتيان من “خارج الحكاية” التي نتحدث عنها هنا، “ذكريات غانياتي الحزانى”، علما بأن هذا العنوان نفسه يبدو بدوره من خارج الحكاية كما سوف نرى. الحكاية الأولى والأكثر شطارة ودهاء تتعلق بنشر هذه الرواية القصيرة التي كانت من آخر الإبداعات الروائية لغابريال غارسيا ماركيز قبل رحيله لسنوات خلت. فماركيز عندما وضع السطور الأخيرة للرواية وحوّلها للنشر، فوجئ بها تُنشر لدى العديد من دور النشر الأميركية – والإسبانية – مقرصنة. ولما لم يكن قادرا على منع مئات ألوف النسخ المقرصنة من الإنتشار، قام بما لم يكن أحد يتوقعه: في اللحظات الأخيرة غيّر نهاية الرواية كليا إلى حد أن كل الذين قرأوها مقرصنة اضطروا لشراء الرواية من جديد ولم تكن مقرصنة هذه المرة، لأن ماركيز لم يعطهم الوقت لذلك!
أصل ياباني لعمل خاصّ جدا
أما الحكاية الثانية فتعود إلى أبعد من ذلك كثيرا في الزمن: فذات مرة كان هناك كاتب شاب أولع بالأدب الياباني وخاصة بروايات ياسوناري كاواباتا ومنها روايته القصيرة “الحسناوات النائمات”، وهنا كما يحدث عادة أمام كل عمل بديع، رأى الكاتب الشاب أن لا بد له أن “يعيد كتابة” هذا العمل الإستنائي يوما. لكنه ظلّ يؤجل المشروع، ربما ريثما يتقدم في الشهرة ويصبح من الرسوخ بحيث لا يقول أحد أنه “لطش” رواية سلفه الكبير، أو في انتظار أن يتقدم في السن وفي التجربة بحيث يمكن أن يتحول المشروع مشروعا شخصيا مرتبطا به تماما. وهكذا كان على أي حال. ذلك أن الكاتب الشاب الذي نتحدث عنه هو بالتحديد ماركيز والمشروع المعني هو بالتحديد “ذكريات غانياتي الحزانى” الذي بصفحاته القليلة أكد في سنوات ماركيز الأخيرة أن قريحة هذا المبدع لا تنضب، وأنه عرف كيف يطرح من خلال رواية بسيطة وممتعة، سرّ الكتابة والحب وغرابة التقدم في العمر والكيفية التي يمكن بها للمرء أن يتمرد على العجوز الذي فيه وعلى وحدته وكيف يمكنه أن ينظّم تلك الوحدة وأن يقبل ثقل السنين مرميّا فوق كاهله.
وكل هذا عبر موضوع غاية في البساطة إذا أردتم. ويمكن للجملة الإفتتاحية في الرواية أن تلخصه تماما حيث يقول لنا الروي بكل بساطة – بترجمة بديعة إلى العربية قام بها صالح علماني وصدرت بعد حين من صدور الأصل الإسباني عن “دار المدى”: “في السنة التسعين من سنوات حياتي، رغبت في أن أهدي إلى نفسي ليلة حب مجنون، مع مراهقة عذراء” فما الذي فعله؟ تذكّر روسا كاباركاس وهي صاحبة بيت سرّي اعتادت أن تتصل هي بزبائنها الجيّدين عندما يكون في تصرّفها جديد جاهز. وهكذا بدأت الحكاية ولا سيما منذ اللحظة التي قالت له روسا فيها، كما تفعل إمرأة الفندق في رواية كاواباتا حين تقول للعجوز إيغوشي: يتوجب عليك عدم وضع إصبعك في فم المرأة النائمة، ولا محاولة عمل أي شيء مشابه. يطيع عجوز رواية ماركيز تعليمات روسا… ويداوم على الطاعة طوال صفحات الرواية، ليس فقط التزاما منه بما وعد، أو عجزا منه عن فعل ما هو أكثر، بل لسبب آخر غاية في البساطة: لأنه وقع في الحب. وقع في هوى مراهقة الأربعة عشر عاما التي صارت كل حياته وكل همه، والتي بالكاد صار يراها صاحية أو يتجاذب معها أيّ حديث أو يلمسها أو يبثها لواعجه. كل ما في الأمر أنه يجلس طوال الوقت حين يكونان معا، يتأمل في نومها، ويحبها ويحصي أيام عمره الباقية له ناسيا في أحيان كثيرة أن ثمة ثلاثة أرباع القرن تفرق بينهما.
استعراض حياة خاوية
غير أن عجوزنا ينطلق في ساعات تأملاته الطويلة وفتاته راقدة ببراءتها وحسنها ولامبالاتها إلى جانبه، يتذكر حياته الماضية وغرامياته التي كانت كلها مع غانيات يدفع لروسا إيجارهن مكتفيا من الحياة بذلك النصيب. لكنه يخبرنا بالتدريج أن تلك التي أطلق عليها إسما من عنده هو “دلغادينا”، شيء آخر تماما. هي صباه نفسه وبراءته المفقودة وسنينه الضائعة. هي تمسّكه بما بقي له من فُتات العمر. ومن هنا إذ راح يبحث عن حلّ ينهي ذلك الجنون اليوميّ، نهاية سعيدة لم يجد أمامه إلا أن يضم “دلغادينا” إلى حياته بشكل أوثق. ومن هنا نراه في الصفحة الأخيرة من الرواية وبعد أن يُعيّشنا في اندماج معه ومع حبه الكبير العجيب، يصارح روسا بأنه يود شراء البيت كله بما فيه فتاته الحبيبة. وإذ تقترح روسا عليه أن يتشاركا على أن يؤول البيت بما ومن فيه إلى من يبقى على قيد الحياة بعد الآخر، يصارحها بأنه يود أن ترثه “دلغادينا” بعد موته؛ فتضحك قائلة إنها هي الأخرى ستورثها البيت إن عاد إليه. يسألها: “أتظنينها ستوافق؟: فتجيبه “وهي تكاد تموت من الضحك”: “أه ياعالمي الحزين أفهم أنك عجوز ولكنك لست أبله. هذه المخلوقة المسكينة وفيّة في حبها لك”. وهنا يخبرنا العجوز أنه خرج إلى الشارع المشعّ “ولأول مرة تعرفت إلى نفسي في الأفق البعيد لقرني الأول في الحياة. كان بيتي الصامت والمرتب في الساعة السادسة والربع قد بدأ ينعم بألوان فجر سعيد. كانت داميانا – الخادم العجوز – تغني بأعلى صوتها في المطبخ، والقط الذي استعاد حياته حكّ ذيله بكعبي، وواصل المشي معي حتى منضدة كتابتي. وهناك كانت مرتبة أوراقي الذابلة ودواة الحبر وريشة البجعة، في الوقت الذي اندلعت فيه الشمس بين أشجار اللوز في الحديقة، ودخلت سفينة البريد النهرية، المتأخرة أسبوعا بسبب الجفاف، إلى قنال المرفأ وهي تطلق الجؤار. إنها الحياة الواقعية أخيرا، بقلبي الناجي والمحكوم بالموت في حب طيّب، في الاحتضار السعيد لأي يوم بعد بلوغي المئة…”
نحو أكثر النهايات سعادة
ترى هل يمكن أحدا أن يخبرنا عن نهاية رواية، وبالتالي عن نهاية حياة أكثر سعادة من هذه؟ هل يمكن أحدا أن يجرؤ على القول، كما فعل بعض المعلقين، أننا هنا في صدد “رواية إباحية”. في الحقيقة أننا هنا أمام نصّ يحتفل بالحب والحياة وأيضا بالكتابة كمزج للإثنين معاً، كتبها قلم لا يريد أن يذعن أمام العمر، ولا يريد أن يعيش أيّ خريف طالما أن ثمة ربيعا مائلا أمامه؛ ربيعا صامتا حلوا؛ لا يدفعه إلى الإقبال على الحياة بل يتبدى له – وهل يمكن لما يتبدى لكاتب من طينة ماركيز أن يكون شيئا آخر سوى الحقيقة؟ – أنه هو الحياة نفسها.
عندما كتب مركيز هذه الرواية (الأخيرة في مسار إبداعي طويل وعميق لم يوصله إلى جائزة نوبل وغيرها من كبريات الجوائز، وحسب، بل إلى مئات ملايين القراء من الذين دائما ما دُهشوا أمام أعمال له مثل “مئة عام من العزلة” و”الحب في زمن الكوليرا” و”ليس للكولونيل من يكاتبه”، لكي لا نذكر سوى أعماله الأشهر المترجمة إلى عشرات اللغات والمقتبسة في أعمال سينمائية – نادرا ما أعطتها حقها على أي حال-) كان في في السابعة والسبعين من عمره ولم يتبق له للعيش سوى عشر سنوات أخرى كانت كافية له ليكتب مذكراته الرائعة، ويشارك في كتابة سيرته الأكثر روعة. ومن هنا اعتبرت “ذكريات غانياتي الحزانى” فعل إيمان أخير بالحياة كتبه ذاك الذي ولد في آراكاتاكا الكولومبية ومات في المكسيك، واعتبر واحدا من كبار كتّاب القرن العشرين، بل الوريث الطبيعي لسربانتس أحد كبار مؤسسي الفن الروائي في العالم.




