دمشقُ وخصال أشرارها: يوميات مؤدِّب أطفالٍ في القرن الثامن عشر/ محمد تركي الربيعو
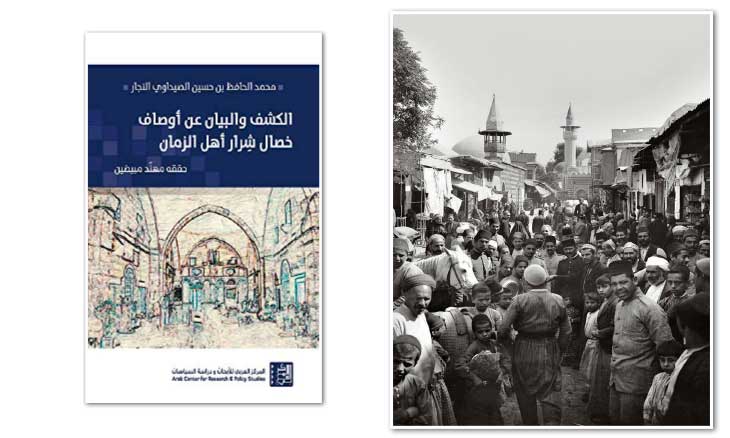
منذ عقدين تقريباً وأكثر، والمؤرّخ الأردني (شاميّ الهوى) مهند مبيضين لا يملُّ ولا يكلُّ عن تعريفنا وإمتاعنا بالجديد على صعيدِ تاريخِ مدينة دمشق في القرن الثامن عشر. فبعد سنواتٍ من البحث في أرشيف المدينة ومكتبتها الظاهرية، كان الرجلُ يخطُّ أولى كتبِه الفريدة عن أهل القلم، الذين عاشوا ودرسوا في المدينةِ خلال تلك الفترة؛ ففي هذا الكتاب، استطاع مبيضين، الذي تعوّد أثناء إعداده له، السيرَ في شوارعِ دمشق والجلوس لساعاتٍ طويلةٍ في مقهى النوفرة، تعريفنا بمناهجِ التدريس في ذلك العصر وأحوال الطلبة والعلماءِ، ومؤلّفاتهم ودواعي تأليفهم.. بيد أنّه، وخلافاً لكثيرين ممن زاروا وكتبوا عن المدينة، قبل أن يرحلوا عنها لمشاريع تأريخية أخرى، بقيت دمشق ورائحةُ شوارعها لا تفارقُ مخيالَ هذا الرجل، حتّى بعد الحرب، ما دفعَه للمزيد من البحثِ في سجّلات المدينة وأحوال أسواقها، كما برز من خلال كتابه عن «ثقافة الترفيه» ولاحقاً في كتابه الآخر «شيخ الكار»، قبل أن يعكفَ على مدى سنة تقريباً في تحقيق مخطوطة «الكشف والبيان عن خصال أوصاف شرار أهل الزمان» التي كتبها أحد مؤدِّبي الأطفال في جامع الدرويشية.
هذه المخطوطةُ الجديدة، التي صدرت عن المركزِ العربي للأبحاث والنشر، تتناولُ في الأساس المجتمعَ من بابِ الأخلاق، وهذا ربما ما يوضّحه عنوانها، بيد أنّها في جانبٍ آخر تنقلُ لنا بعض المشاهدِ عن الحياة الاجتماعية والثقافية وأحوال الأسواق والناس والزواج في تلك الفترة؛ التي كانت تعيشُ فيها دمشق تقلبات عديدة لم تؤثّر في أحوال الناس والولاة وحسب، وإنّما انعكست كذلك على أساليبِ الكتابة من خلال ظهور كتابات العامة (يوميات البديري الحلاق مثلاً) والأهم من ذلك، أنّ هذه التبدّلات كانت تنذر بولادة قيمٍ ومفاهيم اجتماعية وثقافية جديدة. لا يُعرّفُ الكثير عن مؤلّف المخطوطة، محمد الحافظ بن حسين الصيداوي النجار، فالمصادر التي تعودُ إلى القرنِ الثامن عشر لا تأتي على ذكره، وربما يعود ذلك كما يرى مبيضين لمهنته، إذ كان يعملُ مؤدِّباً للأطفال، ولذلك لم تهتم كتب التراجم بإدراجِه ضمن مصافِ الأعيان. توفيّ تقريباً في عام 1758، وبالتالي فقد عاشَ تقريباً في النصفِ الأول من هذا القرن، وهي فترة شهِدت فيها المدينة قلاقلَ سياسية، واقتتالاً مع بدو حوران، كما عرفت اضطرابات ومواجهات عديدة بين مراكزها المحلية قبل أن تقوى شوكةُ آل العظم، وتشهد فترةً من الرخاء الاقتصادي. وفي هذه الأجواء سيكتب الصيداوي رسالتَه؛ كان آنذاك كما ذكرنا يعملُ مؤدّباً في جامع الدرويشية، القريب من أسواق المدينة وأهلها، وقد عُرِف بميوله الصوفية القادرية. سيدفعه هذان العاملان، بالإضافة إلى عاملِ القلاقل التي عرفتها المدينة، لكتابة مخطوطةٍ بمزاجٍ ناقمٍ أو متذمّرٍ بالأحرى على ما آلت إليه الأوضاع، وهذا ما تكشفه مقدمته، إذ يقولُ «إنّ هذا الزمان ما فيه من صاحب في الغالب إلّا لعلةٍ، ولا ملازم إلّا من قلةٍ، ولا رفيق إلّا بدون صداقة وخلة، ولا جار وإلّا يؤذي جاره بيده ولسانه، ولا شريك إلّا فقد الأمان، ولا صغير إلّا وحرم الصيانة».
عاصر الصيداوي ولاة دمشق خلال خمسة عقود، وكان يُظهِر موقفاً سلبياً منهم ومن علاقتهم بالمجتمع عموماً، ولذلك فقد جاءت مخطوطته في بعض جوانبها كما يذكر مبيضين لتنقل عدداً من الحوادث والتواريخ المحلية في سردٍ تاريخيّ وعظيّ يكشفُ مجتمعاً مثقلاً بالفساد والفوضى.
على صعيدِ العسكر مثلاً والعلاقة بالولاة، يكشف لنا الصيداوي عن صفات الجنود الذين قدموا إلى المدينةِ من الخارج، إذ «كانوا يُقبلون على المدينة في صورةٍ منكرة، وسماتٍ منفرة، وقلوبٍ فرعونية، وأخلاقٍ سامرية، وخصالٍ يزيدية، وهيئاتٍ مجوسية تحكّموا بالمسلمين وسفكوا دماء المؤمنين». ورغم أنّ هذه الصفات، كما تبدو من خلال المخطوطة، مقبلة أو نابعة من قصيدة كتبها أحد علماء المدينة في القرن السابع عشر يشكو ما وقع في دمشق من الخطوب العظيمة والدواهي الجسيمة، زمن ورود العساكر السلطانية إلى دمشق المحمية على قصد القشلقة (فترة الشتاء)، في إشارة للحروب بين الصفويين والعثمانيين، إلّا أنّ حديثه اللاحق عن الصراع الذي جرى بين أسعد باشا وفتحي الدفتري، وتأييده وحزنه لما آلت إليه أوضاع الأخير، على يد سعدية قاضون (أسعد باشا كما كان يُوصف في فترته الأولى)، قد تلمّح إلى أنّه يقصدُ جنودَ السلطنة الذين قدموا للمدينة في فترة أسعد باشا، لمواجهة القوات المحلية (اليرلية) المؤيّدة للدفتردار. ولعلّ ما يدعمُ هذا التفسير أنّ الصيداوي لا ينقل لنا أيّ شيءٍ عن صور المقاتلين المحليين، وهو ما قد يعكسُ موقفَ المتصوفة الإيجابي منهم، الذين عادةً ما كانوا يحظون بتأييدِهم وبعلاقاتٍ جيدة معهم داخل المدينة.
أما على الصعيد الاجتماعي، فيبدو الصيداوي، من خلال حديثه عن أحوال الناس والتغيّرات في سلوكياتهم، أنّه ذو شخصية محافظة؛ فعلى صعيدِ المقاهي مثلاً، نراه يبدي تحفظاً حيال مرتادي هذا المكان، الذي يراه مكاناً لمجالسةِ أصحاب اللهو. ومن بين الأشياء التي يشير إليها ناقداً كذلك، شيوع الفسق وبنات الهوى في الأسواق، فيقول «فالحاصل أنّ دمشق فيها من هذا الزمان.. مشي بنات الخطأ في الشوارعِ والأزقّةِ، والتعدّي الظاهر حتّى على أهل الكرامات». يُذكّرنا هذا الموقفُ بموقفِ البديري الحلاق، الذي لم يعكس من خلال حديثه عن تلك الفترة وعن «شلكّات المدينة» واقعَ وانتشار الرذيلة في تلك الفترة، بقدر ما عكسَ موقفَه المحافظ من ظهور النساء في الشوارع، وربما ما يدعمُ هذا الاستنتاج، كما تنبّه لذلك المؤرخُ السوري سامر عكاش، أنّ أهم نصّين عن تلك الفترة، «يوميات ابن كنان» و«يوميات الأب ميخائيل»، لا يشيران مطلقاً إلى تفشّي ظاهرة الفسق وبنات الهوى.
على صعيدِ الأسواق في المدينة، ينقلُ لنا الصيداوي صورةً سلبيةً واحتقاريةً للعاملين في هذه الأماكنِ، إذ يذكرُ أنّ «أهلَ الأسواق وإن كان يوجد فيهم الصالح نادراً، كما هو المشاهدُ والمعاينُ، فإنّهم لا يُعدّون في الغالبِ من جملة الناس بالنسبة إلى أربابِ الكمالات، وذوي الشهامات، لأنّهم لا يصلحون لخطاب ولا يهتدون لجواب، كما أنّ غالبهم يستحلون الغشَ في الميزانِ والمكيالِ، مع ما يحلفون بطلاقهم من نسائهم إن كانوا غشّوا أو بخسوا ميزاناً أو مكيالاً». يكملُ الصيداوي عن صفات أهلِ الأسواق ليقول «إن حانَ وقتُ الصلاةِ تقاعد عنها (ابن السوق) إلى أن يؤدّيها في وقتِ الكراهةِ أو الحرمةِ، أو إخراجها عن وقتها، وربما إهمالها بعضهم بالكلية وحدثته نفسه وسول له شيطانه أنّه معذورٌ في ذلك، لأجل سعيه على نفسه وعياله». ولعل ما يلفتُ النظرَ في هذا الوصف، أنّه يكشفُ لنا عن سلوكيات دينية للعامة، مغايرة ربما للصورة الدرامية أو المتخيلة عن تلك الفترة، فلم يكن الناسُ في تلك الفترة ملتزمين بالشكلِ السلفيّ الذي تحاولُ اليوم بعض الكتاباتِ قوله.
أمّا من الناحيةِ الثقافيةِ، ومن حيث نظرته إلى فعلِ العلماء نجده يكيلُ المدحَ لبعضهم، ممن دافعوا عن المجتمع وتعرّضوا لظلم الولاةِ ومنهم، عين الأعيان وصدر الصدور المرحوم محمد أفندي العمادي، والشيخ محمد العجلوني. أمّا بطله فقد كان آنذاك الشيخُ الصوفيّ عبد الغني النابلسي الذي وقف في وجه الولاةِ الظلمة، ما عرّضه لأذيةٍ كبيرةٍ، وفي هذا يقول: «وكما وقع في ما أدركناه وشاهدناه للمرحوم الشيخ عبد الغني النابلسي صاحب الوقت رحمه الله تعالى، مع ما كان عليه من القدم الثابت في التقوى، والسلوط النافع في السبيل الأقوى، ألجأته أذية الجهلة والفجرة، وأولي الغدر والمكر، بل الضالين والكفرة». ومن الأمور الطريفة التي يأتي على ذكرها، والتي تحمل دلالات ومؤشرات حول أشكال القرابة والزواج آنذاك، ما يتعلّق برؤية الصيداوي للزواج بأكثر من امرأة، إذ يرى بأنّ «أندم من هذا وأشقى وأعلى في مراقي النحوس وأرقى، من تزوّج اثنتين وحصل على بليتين ولزمه شر الليلتين ووقع في الندامة، ولبس ثوب الغرامة، وضاقت معيشته، وكدرت عيشته».. ربما يعكسُ هذا الموقفُ شيئاً من حياة المؤلف الذي عاش وتزوج قبل أن يطلّق، لكن في كلامه أيضاً ما يذكّرنا بالنتائج التي توصّلت إليها الباحثة الأمريكية مارغريت ميري ويذر، في كتابها «القرابة الحقة» الذي بيّنت فيه من خلال دراستها للسجّلات الشرعية في مدينة حلب، أنّ الناسَ والعلماء في القرن الثامن عشر لم يستحسنوا كثيراً فكرةَ الزواجِ بزوجةٍ ثانيةٍ، وربما هذا سببُ استهجان الصيداوي للزواجِ بأكثر من امرأة، وقد يعكس موقفا ومزاجا عاماً في المدينة خلال تلك الفترة.
٭ كاتب من سوريا
القدس العربي




