في كتاب «إنها تدور» لراشد عيسى : سوريا… من «جدار» القمع إلى «كاميرا» التوثيق/ عبدالحفيظ بن جلولي
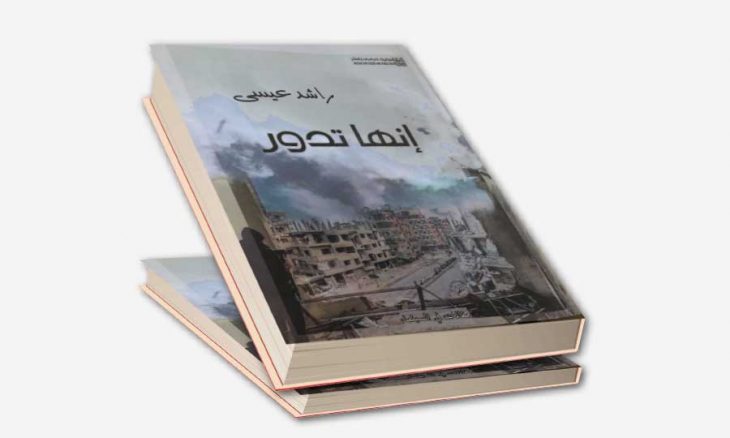
تعود الذاكرة إلى عنصر مفرد يجابه النسيان ويحفزها في الخفاء، ليس خوفا من شيء، لكن لأنها لا تموت. تواجه الذاكرة الواقع بكل تمظهراته السلبية والإيجابية التي لا تشكل بالنسبة لها سوى عناصر الحركة نحو الأهداف ولو تولدت مع كل حركة عثرات جمة وظيفتها الأساس عرقلة المشروع الوجودي المتمثل جوهريا في الحرية، فكل ما يقوم به الإنسان وتترجمه الذاكرة إنما يُقصد به شيء واحد هو إثبات حريته التي لا تباع ولا تشترى، ولا تؤطر بالكلام الخارج عن سياقاته الموضوعية، المعرفة بسقف الكرامة والعدالة الاجتماعية والحرية، ذلك هو ما يوحي به عنوان كتاب راشد عيسى «إنها تدور» وتحته عنوان فرعي «مقالات في السينما».
ليست القراءة في اعتقادي هي المتابعة الحرفية لمضمون المقروء، وصولا إلى قصدية الكاتب المحتملة، بل القراءة هي ترصد ما بين أسطر وصفحات الكتاب، وقوفا عند ما لم يقله، وكان مقصده احتمالا، فالقصد الحقيقي هو قضية يختص بها كاتب الكلمات، لأنه يعيه جيدا، وأول ما يشد انتباه قارئ «إنها تدور» التناص مع المقولة الشهيرة للعالم الإيطالي غاليليو غاليلي، التي أكد بها أنه مع تراجعه أمام الكنيسة عن أن الأرض لا تدور حول الشمس، إلا أن الحقيقة في ما قاله أولا، من أنها تدور حول الشمس، وهو تأكيد من راشد عيسى بهذا التناص اللافت والعميق، بأن كل السوريين مؤمنون بأن السقف الذي يجب أن يظللهم هو «الحرية» ولو أن جزءا منهم والوا النظام ونافقوه في غير ذلك. والوجه الثاني لتأكيد الحضور اليقيني في الإيمان بالحرية وعدالة الثورة السورية هو في «دوران» (الكاميرا) ما يوثق للثورة، التي واجهها النظام بكل عنفه الرسمي المدمر، وجهاز قمعه البوليسي، تأكيد السياقين التاريخي والسوسيولوجي للمعنى في «إنها تدور» يشكل المعبر نحو حركة أداة التوثيق الكونية «السينما» في حفاظها على الذاكرة المواجِهة للنسيان وللظلم الإنساني، حين يوجه للإنسان، فقط لأن هذا الأخير لا يطالب سوى بحقه في شم رائحة الياسمين، على شرفات «دمشق» تحت شمس الحرية الطالعة في مدارات أيلول/سبتمبر.
يؤكد راشد عيسى على أن «الكاميرا تدور في كل بقاع الأرض، لكنها في بلادنا إن دارت ستصطدم بألف جدار». فكرة الجدار العالقة في الوعي العربي، تمثل الفاصل بين المواطن وسقف الحرية المتعالي. تركت الأنظمة العربية وعي العربي لصيقا بالنظر إلى الأرض، ليس تمليا في جمالها، وهي جديرة بذلك، لأنها ترتبط بالحياة، بل لأن النظام يستقر في الأعلى، عرشه لصيق بالسقف، ولهذا لا يريد لأحد أن يزاحمه في ذلك، فهو لا يرى سوى ذاته، ويحشر المواطن «عربي» في مهرجان الحركة المحسوبة والمحددة بتعاليم «جدران العسكر والاحتلال والرقابة بأشكالها كلها» فالجدار مانع للتواصل مع الخارج، إنه استمرار لظل السلطة، والجدار تاريخيا عائق موضوعي للتلاقي، فكل مواطنٍ عربيٍ في وعي أخيه حارسُ أمنٍ معتمد من سلطة خفية، تدرب حسه على الطاعة العمياء لكل ما يصدر عن السقف العروشي، وبهذا يشكل عنصر الجدار المنوال الأشد قساوة وتمثلا لهيمنة الـ Big Brother، وكان التوصيف في محله، حينما استثمر راشد عيسى واعيا أو لاواعيا في الجملة الاستدراكية، التي تفسر معنى الجدار بـ«الاحتلال» لأننا كعرب تلازمنا تاريخيا في وعينا القومي، صورة جدار الميز العنصري، الذي أرسى أساساته العدو الصهيوني، وبذلك يصبح كل ظلم مسلط من سلطة على شعبها هو احتلال.
إن المستوى الرمزي لدلالة المقابلة بين «الكاميرا» (السينما) و«الجدار» يمثل مقابلة بين الخيال والواقع، والخيال الذي آل إلى الواقع بحكم قوة الشيء في حدوثه وفعله، فــ»الكاميرا» باعتبارها تجسيدا للخيال، إذ كل عمل فني هو تمثيل للمتخيل الذي سوف يتم تلقيه بمعايير الذوق، و«الجدار» باعتباره يمثل أحد عناصر الواقع، أو الواقع كله، يشكلان، الكاميرا والجدار، الدعامتين المهمتين لما يمكن أن يُسمى «سينما توثيقية» بمعايير عربية أطلق جذرها الرمزي والموضوعي راشد عيسى، وفق سلطة الخصوصية التي تمنح للعمل فرادته ومعاييره، وهو بذلك، يمنح المفكر العربي والفيلسوف والفنان والأديب ميكانيزمات التفكير في المعضلة العربية، التي أهم ما يكشف عن صعوبتها هو تشكل الفهم حولها، خارج نطاق الرمزيات الفاعلة، فالغيطاني بعد سماعه بهدم «المسافر خانة» في القاهرة، كتب كتابه «استعادة المسافر خانة/ محاولة للبناء من الذاكرة» فالكاميرا بكل ما تملكه من حمولة رمزية وشحنة فنية، تعيد الاعتبار للجانب الروحي في تعاطينا مع أشكال الهدم في شخصيتنا العربية المدمرة، جراء أفانين التعسف والقمع والمنع، التي تتعرض لها من الأنظمة التي لا ترى سوى ذاتها.
تدور الكاميرا، ويسجل فكر راشد عيسى لحظات مأساوية من الراهن السوري تحت حصار النظام الطائفي، ويبدو لي من خلال قراءة الكتاب أنه يحتاج إلى فعالية قرائية، باعتباره وثيقة تاريخية تؤسس لما بعدها، فالعمق الواقعي في كتاب «إنها تدور» يحيل إلى التجربة، باعتبارها حمالة منجز، وخالقة رؤية، وليس هذا كلاما إنشائيا، فباعتقادي أن «التمهيد» وفصل «السينما الوثائقية السورية… الخروج للشارع» يمثلان الأساس النظري لكتابات تهتم بالشأن العربي الأزموي في شقيه الرمزي/الفني والواقعي، ومن ثمة كانت الإشارة إلى الموضوع رؤية في حد ذاتها، تحمل بذور البناء عليها، فبعد أن يذكر بأن دراسة أشارت إلى أن «فيلما وثائقيا واحدا لم ينتج بعد الثورة، من قبل مؤسسات النظام» يخلص إلى «أن الفيلم الوثائقي أساسه الوثيقة، أي الحقيقة التي ستشير، في الحالة السورية، إلى النظام كسبب واضح وراء كل الجرائم الوحشية المرتكبة في البلاد» وراشد عيسى في إلمامه بالأزمة السورية لا يقدم الدليل المادي على جرائمية النظام في قمعه للثورة وحسب، أيضا يشكل الهندسة الرمزية والموضوعية للرؤية القائمة على التوثيقية الفاعلة والمناهضة بذاتها وبحقائقها للظلم والطغيان.
«السينما التوثيقية» هي الحالة التي يتناغم فيها الخيال والواقع، ويتداخل فيها المعنى والمبنى، وينبثق منها الرمز والدلالة، لأنها تكشف عن الواقع بدلالات الخيال (السينما) ليس الخيال الإحالي عن طريق ما يمكن حدوثه، بل الخيال النابع مما يحدث فعلا، فينكشف الغطاء عن الحقيقة بتجلياتها الاستعادية والمستمرة في الوعي ما دامت الصورة تُستوعب بوعي الذاكرة.
ليست الأزمة السورية في ما حدث، سوى تعبير خالص عن عقل السلطة المتوجس من كل حراك من شأنه أن يلفت نظر المواطن إلى سقف الحرية، فــ»الحرف صوت إنما الصوت ليس بمعنى، إنه حرية المعنى» كما يقول عابد عازرية في مقدمة ديوان فايز مقدسي: «سيميا أبجدية الأفعى» التعبير عن الحرية بالحركة هو ما يقلق، لأنه تعيين للوجود بالحركة في الواقع، وهذا ما يشكل عمق رؤية راشد عيسى، حينما يصل إلى التمييز بين «السينما الروائية المنحازة إلى رواية النظام، أو على الأقل تقع في المنطقة الرمادية، ذلك لأن الروائي، الخيالي، يتيح إمكانية أكبر للتلاعب والتلفيق» وهي لعبة النظام لأنه يشتغل في منطقة الخيال التي تناسب رواية السلطة، وزعمها بمواجهة من يتلاعب بمستقبل الوطن، وعليه تكون «السينما الروائية» في وعي الأنظمة وواقعها من أساليب الدعاية والتعبئة الأيديولوجية، فهي تنتج مخيالا موازيا للمخيال الجمالي، القائم على الابتكار والإبداع، فمنطق الاستبداد يخرب ويفسد كل منطق جمالي.
يواجه السينما الروائية بـ«السينما الوثائقية التي ازدهرت في مواجهة النظام. سينما عمادها الوثيقة، الحقيقة». لا تنطلق الرؤية من فراغ الأشياء، بل من المواجهة الواقعية المدمغة بالأثر في المكان وفي النفس، وما أوقعته فوضى النظام بالأشياء وأماكنها وأهاليها، عبَثَ بالنسق الإنساني والعمراني وأحال البنية إلى خراب، فكيف يروح يوثق للخراب، ويرسم بسمة شاحبة على شفاه رافضة أن تتسمى بمسميات مكان اعتقله الديكتاتور، «هذا المكان رماد نادى رماده ولم يعبر خرابه. لم يعد يعرف منتهى بدئه. هذا المكان جرف عشق انجرافه ومفلوتا هوى» بتعبير شعري لفايز مقدسي في «انجراف» القصيدة موثقة: حلب 1970.
يتمكن راشد عيسى ببراعة من التمييز بين فيلمين أحدهما سوري «الليل الطويل» إخراج حاتم علي، يعيد إنتاج التاريخ ولا يتوغل في تفكيكه باعتباره شكلا من أشكال التجاوز، فيؤطر علاميته بإعادة شكل الغرفة إلى فصلها الماضوي بصورة الأب القادم لتوه من المعتقل، بدون أن يضع الصورة في سياقها التغييبي والحضوري، لاستعادة التاريخ بكل تجلياته الذاكراتية، والفيلم الآخر ألماني «وداعا لينين» لولفغانغ بيكر، حيث الأم المتشبثة بالشيوعية، وحركة مشهديتها المنبعثة من غيبوبة، يمنح التاريخ وهو يعارك الحياة بين الغيبوبة والانبعاث، «ذريعة كي نرى أي عالم كنا نعيش» وهي المشهدية التي تكرس التاريخ كتعبير عن حالة روحية عميقة، تستلهم الحياة لحظة وعي بها، في تتالي مساراتها الماضية والراهنة والمستقبلية، وهو ما يرومه راشد عيسى من الوعي بـ«إنها تدور» كحالة من حالات الكاميرا التي تسجل التاريخ ليس قصد السكنى فيه، لكن قصد تغييره بمنطق الذاكرة التي تخزن الرؤية لتحفيز «الفلاش باك» الدافع إلى التجاوز.
٭ كاتب جزائري القدس العربي




