أنا وطريف الخالدي في حي كاديكوي الإسطنبولي/ محمد تركي الربيعو
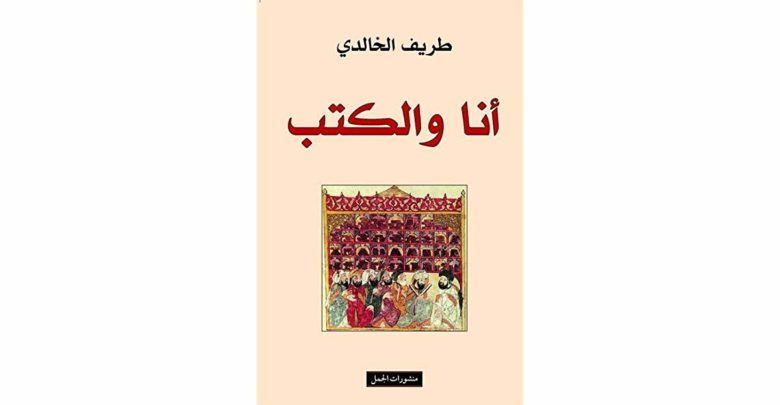
منذ سنوات وعادة المفاضلة قبل العيد بين شراء بعض الألبسة أو الكتب لا تفارقني. لا أدري سبباً لهذه العادة، ربما تكون رواسب لوثة فكرية عن صورة المثقف الملتزم، الذي لا يكل ولا يمل من البحث والمعرفة، أو ربما – وأظن أنه الأدق – يعود إلى ارتباط العيد في ذهني بشراء شيء محبب إلى قلبي؛ جاكيت للتباهي به أمام اصدقائي في حي كانت تسكنه طبقة وسطى دنيا، يشبه مئات الأحياء في بلدان الشرق الأوسط، أو كرة قدم التي لم يكن الحصول عليها في متناول كل أبناء الحي.
إلا أن ولعي بعالم الكتب جاء متأخراً بعض الشي، مقارنة بحياة كثيرين ممن امتهنوا وعملوا في عالم الكتابة والصحافة؛ فقد بدأ في سن الثامنة عشرة، وربما بالصدفة بعد قراءة كتاب تيري ميسان «الخديعة المرعبة»، الذي حاول فيه تكذيب ما حدث في أحداث نيويورك 2001 عبر ربطها بمؤامرة أمريكية. ولا أذكر أن وجود الكتب في كل زوايا منزلنا، كان كفيلاً بدفعي للقراءة؛ كما أن والدي، رغم عمله في حقل الكتابة والبحث، لم يدفعنا أنا وأخواتي في هذا الاتجاه؛ أذكر أن المحاولة القليلة كانت تتمثل في إقناعنا بقراءة أجزاء من «ألف ليلة وليلة»، أو قراءة بعض الروايات للروائي السعودي الراحل غازي القصيبي، وأخص بالذكر رواية «شقة الحرية»؛ مع ذلك لم يرق لي موضوع القراءة كثيراً.
إلا أن هذا البعد عن القراءة لم يعنِ عدم التأثر بالمحيط، إذ كثيراً ما حرص والدي على نقل بعض ما يقرأه من حكم وعبر وأفكار حول مائدة الطعام، وبأسلوب سلس لا يخلو من النكتة؛ ما أفسح لي المجال للتعرف شفوياً على عناوين وأسماء كبيرة في عالمنا الفكري العربي كالعروي والجابري، وعلى طباع بعضهم قبل معرفتهم بسنوات عديدة. ولا أخفي أن هذا أفادني لاحقاً في هضم كثير من الأفكار والكتب بسرعة؛ بيد أنني لم أُدرك سبب هذا الاستيعاب السريع ربما، إلا بعد قراءة كتاب المؤرخ التركي إلبر أورطايلي «العثمانية آخر الامبراطوريات»، الذي يؤكد فيه أن عدم انتشار الكتب في المدن العثمانية في القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، لا يعود لفتاوى أصدرها عدد من العلماء تجاه الطباعة، وإنما لأن الحفظ الشفوي وتفضيل الاستماع إلى كتب التاريخ بلسان أحد القراء كان هو المفضل والأكثر نجاعة، لدى سكان هذه المدن. أدركت بعد هذه القراءة أنني أقرب في صغري الى زمن قرون ما قبل الطباعة، بخصوص عوالم الكتب وطرق معرفتها.
أعود لحديثي عن العيد وشراء الكتب، وأذكر هنا أنني كنت قد عزمت، قبل زيارتي لمكتبة الشبكة العربية للأبحاث والنشر في إسطنبول، على اقتناء كتاب المؤرخ الفلسطيني طريف الخالدي «أنا والكتاب» الصادر حديثاً عن منشورات الجمل. وبالفعل فقد نلت مرادي، بيد أن القلق سرعان ما انتابني حيال موعد قراءة هذا الكتاب، فاليوم التالي يبدأ العيد ولا بد من الاحتفال به، كما كان يؤكد على ذلك والدي رحمه الله؛ الذي كان رغم انشغالاته في عالم الكتابة، لا يكترث كثيراً، بل يضحك أحياناً من نقد بعض الكتاب لعدد من طقوس العيد بوصفها خرافة.
وتراودني هنا ذكرى الفصل الأخير لكتاب رينيه جيرار «المقدس والمدنس» حين أجرى مقارنة بين معنى العيد في فترة ما قبل الحداثة، الذي يقوم على المشاركة بشكل واسع في طقوسه والتزاماته وموائده العامرة (لم أفهم معنى الموائد العامرة ودلالتها، إلا بعد قراءتي لكتاب عبد الله حمودي حول «طقس بلماون» وكيف أن هذا الانتهاك لما هو دارج في الأيام العادية على مستوى الإسراف في الطعام يعد جزءاً من مقدس الانتهاك، الذي يعني انتهاك كل القواعد الدينية في يوم ما خلال السنة، وهو انتهاك مارسته كل الشعوب) وبين الإنسان الحداثي الذي يرى في العيد مناسبة أو فترة لقضائها في أماكن للترفيه بعيداً عن الأهل.
في كل الأحوال، بقي هاجس قدوم العيد يُقلِق حالة النشوة التي عادة ما تنتابني عند شراء كل كتاب. فوجوب قراءته لم تكن من موقف انعزالي تجاه العيد، أو التزام بدور المثقف الساخط؛ وهم كثر في أيامنا المكلومة؛ الذي يبدي في العلن عداءً لخطاب المرح (دعاه آصف بيات بخطاب «جمهورية الاحزان») وإنما لالتزامي بكتابة مادة أسبوعية عن كتاب جديد في جريدة «القدس العربي»؛ التزام بات يكلفني أحياناً عدم الاستمتاع بقراءة بعض الأفكار، والمرور عليها بشكل سريع.
وأمام هذا المأزق الذي عادة ما يعيشه كُتّاب المواد الاسبوعية، قررت اصطحاب الكتاب معي في جولتي لأول أيام العيد برفقة زوجتي وطفلتي المولودة حديثاً إلى حي كاديكوي التركي، الواقع في الجهة الآسيوية من المدينة. ولا أخفي أن ترددنا على هذه الجهة في الآونة الأخيرة لم يعد يتعلق بالمظاهر العتيقة والمقاهي الجميلة والهادئة التي يمتاز بها آخر حصون الكمالية في المدينة؛ بل كونه يتيح فرصة للابتعاد قليلاً عن فضاء حي الفاتح الاسطنبولي، الذي غدا في السنوات الفائتة مركزاً للسوريين أولاً وللعرب ثانياً، لدرجة أن النكت حول رؤية أتراك في هذا الحي باتت دارجة على ألسنة السكان الجدد لهذا الحي (وقد تعكس وعياً وواقعاً بهذا الانغلاق). لذلك اعتقد أن تمضيتي للعيد وازنت من جهة بين الحنين للأسلاف وطقوسهم عبر الاحتفال به ومحاولة المرح، وما وصفه جيرار بـ«الطقس الفرداني للعيد» الذي يُؤدى في غياب الأهل (في حي كاديكوي بدل حي الفاتح).. ربما هي حيرة الارتحال.
تستغرق الرحلة من منزلي إلى كاديكوي قرابة ساعتين (مسافة تماثل فترة الانتقال بين مدن سورية قبل قدوم الحرب) وقد اكسبتنا هذه المسافات عادات أخرى كقراءة الكتب في الطريق؛ وربما قد يفسر سبب اهتمام الأتراك بقراءة الكتب؟ بلا شك أن هناك أسبابا أخرى.
في الطريق، وأثناء التوقف عند أحد مقاهي كاديكوي لإطعام صغيرتي أو لتناول شيء ما، كنت أحاول إنهاء الصفحات الأولى من كتاب الخالدي؛ الذي يتحدث فيه عن بداياته مع القراءة في سن صغيرة، وعلاقته بروايات جرجي زيدان التي التهمها التهاماً من العباسة أخت الرشيد إلى الأمين وفتح الأندلس وصلاح الدين. غير أن هذه القراءة البريئة، إن صح التعبير، سرعان ما ستصطدم بواقع جديد يتعلق بتهجير عائلته من القدس. «لم أعِ الأمر في البدء، لكن هذه المأساة تجلت تدريجياً في نوع من أنواع الهرم الذي أصاب العائلة بأسرها». هذا الهرم، دفع أفراد العائلة إلى النظر للعلم والتعلم بوصفهما غاية وقضية. وهنا سنرى كيف أن أدلجة القراءة والعلم ربما، سرعان ما ستؤثر في خياراته.
ففي أثناء نزوحهم إلى بيروت يذكر كيف أنه بدا متأثراً آنذاك بروايات أرسين لوبين، التي كانت رائجة في المدينة وقصصه حول اللص الجنتلمان، وقصص الكاوبوي الأمريكية. بيد أن هذا الاهتمام سرعان ما أزعج بعض أفراد العائلة، الذين، كما أسلفنا، بدوا أكثر اهتماماً بالكتب والقراءة، التي تخدم ربما قضاياهم أو تحافظ على هويتهم. وهنا لا يجيبنا الخالدي إن كان هذا الموقف المتحفظ من قبل افراد عائلته كان سيكون ذاته لو لم يحدث التهجير؟ وربما قد يفتح باباً للحديث عن دور الأيديولوجيا والأزمات في انتشار بعض الكتب على حساب كتب أخرى، كما يحدث اليوم مثلاً في عالمنا العربي، إذ لا نعثر على أشكال من الكتب التي تُعنى بالتاريخ الثقافي، بينما نجد أن كتب الربيع الدامي ونقد الحداثة والعلمانية هي المزدهرة.
أعود للمؤلف، الذي يخبرنا عن عكوفه على حفظ الشعر العربي، مقابل صفقة عقدها مع أخيه الأكبر؛ ربع ليرة عن كل بيت يحفظه.
أمام المكتبة:
قبل إكمال رحلة الخالدي، أعود إلى رحلتي في حي كاديكوي برفقة كتابه. فأثناء زياراتنا المتكررة للحي، غالباً ما يتاح لي المرور من أمام إحدى المكتبات المتواجدة في أحشائه. وأذكر أن أول ما لفت نظري في هذه المكتبة لافتتها التي صممت على شكل مجموعة كتب مرصوفة إلى جانب بعضها بشكل رأسي. لكن لا أدري لماذا وأنا أنظر إليها هذه المرة، تذكرت لوحات الإعلان التي وضعها قبل أيام حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي المقاتل في سوريا داخل شوارع مدينة القامشلي؛ المدينة التي وُلدت فيها؛ لوحات رسمت عليها أغلفة كتب دوستويفسكي وجورج أورويل وفراس السواح وغيرها من الكتب! بشكل رأسي مشابه للوحة المكتبة.
ربما أنظر للافتة المكتبة باستغراب للمرة الأولى؛ لعلها باتت شبيهة بصورة إعلان حزب شمولي يسيطر بعنف على مناطق لي فيها ذاكرة وأهل، ولا أخفي أن فكرة راودتني في هذه اللحظة حول أن الكتاب بحد ذاته قد يعكس أيضاً صورة من صور الشمولية؛ ألم يساهم ظهور الطباعة وانتشار الكتب في فرض ثقافة معينة وطمس وتهميش ثقافات شفوية عديدة، كما يرى بعض الأنثروبولوجيين؛ لا أعلم؛ ربما هو إسقاط في غير محله. بيد أنني رغم حزني على فقداني لشيء أو لصورة لطالما استمتعت بها، إلا أن ذلك لم ينل من حالة الإغراء تجاه النظر لأغلفة الكتب؛ فعدم إتقاني للتركية غالباً ما يُوجِّه تركيزي إلى أغلفة الكتبففأنا التي =، التي كثيراً ما تعود إلى صور قديمة لإسطنبول أو صور إحدى الشخصيات التركية التي عاشت في القرن العشرين.
بعد تجاوزي للمكتبة، لا أعلم لماذا أبت صور أغلفة الكتب الانزياح عن ذهني لصالح صور أخرى من الحي؛ بقيت ماثلة أمامي وكأنها ترغب في البوح بشي ما؛ وهو ما أدركته لاحقاً حين نظرت إلى صورة غلاف كتاب الخالدي. فالصورة هي عبارة عن منمنمة إسلامية لعالم أو فقيه مع تلامذته في خيمة قد تعود لأمير أو ملك؛ قد يُبرَر وضع هذه الصورة، خاصة أن المؤلف يكشف لنا في هذا الكتاب عن ذاكرة غنية وفريدة حيال علاقته بالتراث وحكمه. وبالتالي قد يكون اختيارها قائماً على تأويل من قبل مصمم الغلاف لفصول من هذا الكتاب، أو ربما لتراث الخالدي في البحث والكتابة، خاصة كتابه العمدة «كتابة التاريخ عند العرب»؛ لكن رغم وجاهة هذه الحجة التي التمستها من بنان أفكاري، إلا أن صورة أغلفة الكتب التركية أجبرتني على التساؤل من جديد عن الأسباب التي لم تجعل مصمم الغلاف يكسيه بلباس أكثر التصاقاً بزمن الكاتب وتجربته مع الكتاب، وأعني هنا فترة القرن العشرين (مثلا صورة لمكتبة في بيروت، التي قضى فيها وما زال عمراً طويلاً في القراءة)، خاصة أن تجربته مع الكتب التي يحدثنا عنها كتابه تعود لبدايات القرن العشرين؛ فهو لا يذكر عن والده ووالدته شيئاً بقدر ما يتذكرهما منهمكين بالقراءة والكتابة. ولذلك فهو ينتمي إلى عالم وزمن للطباعة، وانتشار الكتاب مختلف عن العالم الذي اختبره المرسومون في المنمنة مع الكتاب، خلال القرون الإسلامية الوسطى.
طريف مسافراً إلى أكسفورد
بعد الانتهاء من قصة الغلاف، كان نوم طفلتي الصغيرة، بالإضافة إلى ركوب خط العودة، قد أتاح لي الفرصة للعودة من جديد لذاكرة طريف. إذ ستقرر العائلة في فترة الخمسينيات إرساله إلى مدرسة داخلية في إنكلترا، وقد عنى هذا التنقل آنذاك تعلم اللاتينية واليونانية مقابل نسيان للعربية. «لقد أضحت الإنكليزية جل ما أقرأ ولربما بعض الفرنسية من حين لآخر». بعد ذلك بسنوات أُتيحت له فرصة الانتقال إلى جامعة أكسفورد. وكان منهاج التاريخ في الجامعة ينصب على تاريخ إنكلترا في القرون الوسطى، ومن بين ما بقي حافراً في ذاكرته كتاب «التاريخ الكنسي للشعب الإنكليزي». لاحقاً تسنّت له فرصة قراءة كتب حول الثورة الأمريكية والثورة الفرنسية، وأهمها كتاب جورج روديه «الجمهور في الثورة الفرنسية» الذي أحدث ضجة في تلك الأيام لاستخدامه سجلات البوليس في باريس، في دراسة الجذور الاجتماعية للجماهير.
ومن بين الأمور الطريفة التي يذكرها في سياق ولعه بالكتب في أكسفورد أنه اثناء خوضه للامتحانات النهائية لم يحصل جراء هذا الولع سوى على درجة الشرف الثالثة، وهو ما جعله يرغب بالثأر تجاه جامعته «لم أشعر بأنني استرجعت البعض من صدقيتي في أكسفورد سوى بعد تخرجي بخمس وعشرين سنة، وذاك حين دُعيت إلى إلقاء محاضرة، ونالت إعجاب ألبرت حوراني، وشعرت بأنني قد انتقمت أخيراً من جامعتي».
بعد تخرجه يعود طريف الخالدي إلى بيروت، وهناك تبدأ اهتمامات أخرى تتعلق بالتدريس والعمل الأكاديمي سرعان ما ستوثر على قراءاته وعلى اختياراته للكتب. وفي هذا الفصل نجد أن اهتمام طريف بالكتاب يتحوّل أكثر نحو المواد التي يُدرِّسُها؛ لا يذكر مؤرخنا خلال هذه الفترة أي رواية أثارت إعجابه مثلاً.
ثم سنحت له فرصة إكمال الدكتوراه في شيكاغو، وهنا تعرف على مارشال هودجسون وعلى كتابه «مسعى الإسلام» (البعض يترجمه «مغامرة الإسلام») الذي يراه بوصفه أهم تاريخ لحضارتنا كتبه مؤلف غربي. اختياره كتابة أطروحة عن الفكر التاريخي عند العرب، سرعان ما سيدفع به للبحث في غابة التراث العجيبة. يشير إلى أن ابن رشد كان وما يزال مثال المتنورين العرب في التعقل، غير أنه اكتشف أن نورانية الجاحظ ومؤلفاته تفتح آفاقاً أوسع من آفاق ابن رشد. ويبدو الخالدي في أثناء قراءته لهذا التراث مشغوفاً بكتاب أركيولوجيا المعرفة لميشال فوكو، الذي كما يقول «فهمت منه حوالي عشرة في المئة فقط، لكن تلك النسبة الضئيلة كانت كافية لإحداث تأثير عميق في فهمي لتاريخ الفكر». وفي رؤيته لمهنة المؤرخ بوصفها تتمثل في التنقيب المستمر عن علاقة النص بالمحيط العام أو بالفضاء الثقافي والاجتماعي الذي يحيط به.
ذاكرة منقوصة:
يثني الخالدي في عدة مواضع من كتابه على عمل الاستشراق لإدوارد سعيد، لكنه لا يأتي على ذكر مدى تأثّره بالكتاب، أو المناسبة التي قرأه فيها.
وفي سياق آخر يشير الخالدي إلى أن فترة «السبعينيات والأعوام التي تلتها هي الأعوام التي بدأت فيها اقتناء الكتب من المكتبات المختلفة في بيروت ودمشق». يدفعنا الخالدي من خلال هذه العبارة، وعبر ما تبقى من عناوين وكتب حول التراث أو الحياة اليومية للقرن العشرين، أقول يدفعنا دفعاً لنكن له حالة من الغبطة لا بل الحسد لقدرته على الحصول على كل هذه الكتب، بدون أي متاعب تُذكر.
لا مشاكل بخصوص وصولها، أو تأمين نسخ منها. ربما وجوده في بيروت وفي جامعات غربية قد سهل عليه هذا الأمر، بيد أن غياب أي رواية أو حادثة بخصوص الحصول على كتاب، بدت لي ولقراء كثر رواية منقوصة وغريبة عن ما عهدناه من مشاق في شراء الكتب. ربما كان ذكر حادثة أو حادثتين، وأظن أن ذاكرة الخالدي مليئة بهذه الحكايا، كانت ستغني حياة الكتاب في عالمنا العربي خلال السنوات الماضية. ما زلت أذكر كيف أن كتاب طلال أسد حول «جينالوجيا الدين» كاد أن يكون سبباً في ضياع جواز سفري؛ وربما كانت لحكايتي التراجيدية مع هذا الكتاب أثر كبير في عدم إكمالي له رغم المحاولات العديدة.
ثورة ذاكرة الكتب
وبالعودة إلى كتاب الخالدي ، نجد أن تصنيفه ليس بالأمر الهين؛ فهو ليس كتاباً يقع تحت قبة تاريخ معين (استعير كلمة قبة من تصنيف الخالدي للقبب الفكرية في كتابه «العمدة»)، تارة يعود ليرسم لنا من خلال ذاكرة الكتاب تاريخ التعليم في الجامعة الأمريكية، وتارة يعود ليكشف لنا عن تاريخ بيروت في السبعينيات؛ وتارة لما كانت تقرأه النخب في الستينيات؛ فهو يجمع بين هذا وذاك. ربما هو ضرب جديد من ضروب المعرفة التاريخية يعنى بذاكرتنا مع الكتاب؛ فالخالدي لا يهدف إلى تعريفنا بما قرأه، وإنما يروم إلى دفعنا للبوح، أو الكشف عن رحلتنا مع الكتب، وهو ما دفع كاتب هذه المادة ليتحدث ببعض الإسهاب عن تجربته مع القراءة والكتاب، كجزء من لعبة الخالدي في تثوير هذه الذاكرة داخل عالمنا العربي.
ذاكرة الكتاب الجمعية، وليس ذاكرة طريف الخالدي، هو ما يروم إليه الخالدي من الكتاب، وبذلك يبدو قريباً إلى ملاحظات جاك لوغوف، الذي يكن له احتراماً كبيراً، من أن التاريخ الجديد ينبغي أن يسعى إلى إحداث «ثورة الذاكرة» عبر التخلي عن زمنية تسير بخط مستقيم لمصلحة أزمنة تتعلق بالاقتصاد والديموغرافيا والبيولوحيا والكتاب والموسيقى.
٭ كاتب سوري
القدس العربي




