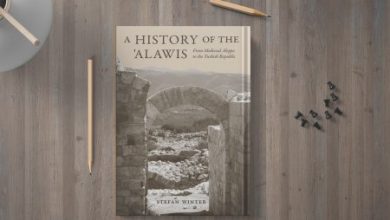تحميل كتاب عزاءات الفلسفة.. كيف قد تساعدنا الفلسفة على أن نعيش حياة أفضل؟

عزاءات الفلسفة.. كيف قد تساعدنا الفلسفة على أن نعيش حياة أفضل؟/ مها فجال
“ما الإنسان؟ إناء يمكن لأدنى اهتزاز أو حركة أن تكسره… جسد ضعيف، وهش، عارٍ، عاجز عن الدفاع عن نفسه في حالته الطبيعية، معتمد على الآخرين، ومعرض لجميع إهانات القدر”
(سينيكا)
ما عادت حياة الغالبية اليومية -عدا مناطق الحروب والصراعات- تتضمن صراعات دموية مع قوى موت وهلاك تطوقنا من كل جانب، ولا عادت تتضمن كذلك عناء عسيرا، وفي بعض الأحيان مميتا، لتوفير الأساسيات اللازمة للبقاء على قيد الحياة. لكن لحقب طويلة، كانت تلك التفاصيل واقعا يوميا بالنسبة للبشر. ففي أزمنة بعيدة، كان على أسلافنا العيش عُزّلا أمام وحوش ضارية تود أن تلتهمهم، وسط طبيعة نزقة لا رادع لهم ولا ملجأ أمام تقلباتها وكوارثها العنيفة.
لحسن الحظ، حالت قرون من التطور على كافة الأصعدة الممكنة بيننا وبين تلك الحياة العسيرة؛ وصارت حياتنا اليوم مختلفة كثيرا عن الحياة التي اضطر أجدادنا أن يعيشوها. وبالرغم من كل تلك التغيرات العظيمة التي اتجهت بحياتنا إلى الأفضل، فإن بعض الأشياء بقيت كما هي دون تغيّر. على رأس تلك الأشياء تأتي الروح الإنسانية. فبالرغم من أن العالم من حولنا ما عاد هو العالم، ظلت أرواحنا على حالها، هشّة وعزلاء أمام الحياة، ينهشها القلق من الداخل أمام أي تهديد أو خطر، وتكسرها مشاعر الإحباط كلّما تغيرت دفة القدر في اتجاه غير ذلك الذي تمنّت، ويرعبها الخوف من المجهول، أو مجرد التفكير في كل الأشياء السيئة التي يمكن لها أن تحدث، والقلق، والإحباط، والخوف من الأخطار والصعاب، أدواء ثلاثة من آلاف الأدواء التي قد تصيب الروح. تلك هي الأدواء، فما الدواء إذن؟
حقق الطب البشري نجاحا مذهلا في شفاء أمراض ظلت لقرون مستعصية، لكنه أمام أدواء الروح يقف عاجزا. في الحقيقة، لم يوجد بعد شيء أثبت كونه دواء ناجعا أمام كل انكسارات أرواحنا. لكن بعض الأشياء تستطيع مساعدتنا في تضميد جراحنا، وتجعلنا أكثر صلابة أمام تهديدات الحياة، وتقلبات القدر، وواحدة من تلك الأشياء هي الفلسفة.
للوهلة الأولى، قد يبدو اللجوء للفلسفة في أوقات المِحَن خيارا غريبا بعض الشيء. فالفلسفة تبقى بالنسبة للكثيرين ذلك العلم المعقد الذي يبحث القائمون عليه عن إجابات للأسئلة الكبيرة المحيطة بالوجود. لكن ذلك ليس صحيحا تماما، فكما بحث الفلاسفة في معضلات الكون، صوّبوا ناظريهم أيضا إلى داخل الروح، وحاولوا البحث عن طرق لمداواتها، والإجابة عن سؤال كيف نعيش حياتنا بأفضل شكل ممكن؟ عن العزاءات التي تستطيع الفلسفة أن تقدمها لنا كتب المؤلف السويسري آلان دي بوتون كتابه “عزاءات الفلسفة”، والذي يعرض فيه كيف من شأن الفلسفة مساعدتنا على الوقوف في صلابة أمام مصاعب الحياة، وتقديم بعض العزاء من أجل أرواحنا المتعبة.
كيف تساعدنا الفلسفة في مواجهة الإحباط؟
من بين كل المشاعر السلبية التي قد تنتابنا على مدار حياتنا، يعد الإحباط أكثرها تواترا. فيكاد لا يمر يوم تقريبا دون أن يحدث شيء نشعر جرّاءه بالإحباط. نذهب للنوم مساء ضابطين المنبه على ساعة معينة علينا أن نستيقظ فيها من أجل موعد مهم في الغد، يأتي الصباح ويرنّ المنبه ولا نستيقظ. أو نستيقظ، ومن ثم نُجهّز أنفسنا للخروج، مسرعين لركوب السيارة، وفور تشغيلها، نجد أن المحرك لا يعمل. أو يعمل المحرك وننطلق، لنجد أن حادثة مرورية جعلت الطريق مزدحما أكثر من المعتاد ما يعني استحالة وصولنا في الموعد. أو يكون الطريق غير مزدحم وننطلق ونصل على الموعد، لنجد رسالة على الجوال ممن كان مفترضا أن نقابله يعتذر فيها عن المجيء بسبب ظرف طارئ، ما يعني أن نهارا بأكمله قد ضاع على لا شيء.
كلنا مررنا بواحد من تلك المواقف التي لا تسير فيها الأمور كما أردنا، حيث تكون لدينا خطة معينة، ولعوامل خارجة عن إرادتنا لا تتحقق، مما يشعرنا بالإحباط. قد تبدو تلك كلها مواقف عادية، مزعجة نعم، لكنها لا تستدعي الكثير من الحنق، لكن الإحباط يتدرج في وطأته من تلك الحوادث المعتادة، لأشياء أخرى أكثر درامية: مثل أن نذاكر لشهور من أجل اجتياز امتحان، لتظهر النتيجة مُعلنة رسوبنا، أو نتقدم لوظيفة أحلامنا، ونُرفض، أو نقابل شخصا ملائما لنا تماما ونقع في حبه، وتحول الظروف بيننا وبين الاقتران به.
على الاختلاف الشاسع بين ما نشعر به من إحباط عندما نستيقظ في وقت مـتأخر، عن ذلك الذي قد نشعر به إن تم رفضنا في وظيفة أحلامنا، يظل السبب الأساسي وراء الشعور بالإحباط واحدا. فكما يقول آلان دي بوتون في كتابه على لسان الفيلسوف اليوناني سينيكا: “البنية الأساسية في القلب من كل إحباط هو تعارض أمانينا مع الواقع”.[1] فمن جهة، توجد أمانينا وخططنا لكل ما نريد له التحقق، ومن جهة أخرى، يوجد الواقع؛ والواقع، كما لا بد أنك تعرف الآن، لا يأخذ ترتيباتك وخططك وتوقعاتك حقا في الحسبان، ولا يفكر فيها كثيرا وهو يتخذ مسارا مختلفا كل الاختلاف عمّا أردت.
فإحباطاتنا تلك كلها تنبع من إيمان ضمني بعالم يسير وفق إرادتنا، و”اقتناع، يكاد يكون هزليا (بغض النظر عن آثاره المأساوية)، أن إحباطا بعينه لم يكن مدونا في عقد الحياة”. وذلك الإيمان بعالم يسير وفق إرادتنا، ينم بدوره عن تصوّر لكون عادل يسير على مجموعة معينة من القواعد لا يحيد عنها، واعتقاد أننا إن لعبنا بنزاهة بحسب تلك القواعد، فسنحصل، كما نظن، على ما نريد. وحسب ذلك الاعتقاد، العمل الشاق والاجتهاد سيؤديان لا محالة إلى النجاح، ومن لا يعمل بجدية لن ينال سوى الفشل، والنزاهة ومعاملة الناس بطيبة ستجعلان الناس يعاملون المرء أيضا بطيبة، أما الأشرار، فلن يجدوا سوى الازدراء. لكننا نكبر لنجد أننا أحيانا نعمل بجد ونفشل، وغيرنا لا يبذلون أي جهد ويحصدون النجاح، ويعامل بعضنا الناس بطيبة فلا يقابلونه سوى بالاستهزاء، وغيره من اللئام ينالون الاحترام.
وفي هذه الحالات “التي يتصرف فيها المرء على نحو صحيح، ولكن تصيبه الكارثة رغم هذا، سيترك المرء مذهولا وعاجزا عن مناغمة الحدث مع نظام العدالة. يبدو العالم عبثيا”. ولمقاومة ذلك “لا بد من تطويع أنفسنا مع اللا اكتمالية المتلازمة مع الوجود، سنقلع عن الإحباط حالما نقلع عن كوننا مفعمين بآمال كبيرة”. فأصل كل إحباط ليس كون العالم مكانا غير عادل، بل إيماننا بعكس ذلك.
فعلى النقيض من الصورة الخيالية التي نمتلكها عن كون منظم يسير وفقا لقواعد بعينها، فالحياة في الحقيقة عشوائية بشكل كبير، وغير متوقعة لأبعد مدى. كرمز لتلك العشوائية، اتخذ الإغريق القدامى إلهة تسمى فورتونا (الحظ)، ويقول عنها دي بوتون: “كانت صورتها منقوشة على الكثير من العملات، حاملة في يد قرن ماعز، ودفة سفينة في الأخرى. كان قرن الماعز رمزا لقدرتها على وهب العطايا، فيما كانت الدفة رمزا لقدرتها الأكثر شرا على تغيير المصائر. كانت قادرة على منح الهبات، والقيام بسرعة رهيبة بتغيير اتجاه الدفة، محافظة على ابتسامتها الهادئة وهي تراقب لحظات اختناقنا حتى الموت بحسكة سمكة، أو اختفائنا في انهيار صخري أو ثلجي. أدخلت تدخلات فورتونا، أكانت لطيفة أم وحشية، عنصرا عشوائيا إلى حيوات البشر”.
وأمام تلك العشوائية، سيكون من السذاجة توقع أن الأشياء ستسير دائما كما نتمنى، أو أن ما نراه عادلا دائما سيحدث. فصحيح أنه في كثير من الأحيان تسير الأمور بسلاسة وكالمعتاد، لكن إياك، كما يحذر دي بوتون على لسان سينيكا، أن ترتكن إلى ذلك، وتظن أنه قاعدة: “ثمة براءة خطيرة في توقع مستقبل يتشكل على أساس الاحتمالات. إذ إن أي حدث يطرأ على الإنسان، بغض النظر عن ندرته أو بعده في الزمن، هو احتمال ينبغي أن نكون مهيئين له. لأن فترات الخير الطويلة التي تسبغها علينا فورتونا تغوينا بالنعاس، يناشدنا سينيكا كي نكرّس وقتا قليلا كل يوم كي نتأمل أفعالها”.
هكذا، سنكون أقل عرضة للإحباط إن أدركنا جيدا أن الحياة، كفورتونا، نزقة، لا تسير وفقا لقاعدة، ولا أحد يمكنه أن يأخذ عليها عهدا على أن تأخذ دائما الوجهة التي توافقه. تسير الحياة أحيانا كما نريد، وننعم بالسعادة والراحة، لكن علينا ألا ننسى أبدا أن الشرور موجود، وأن الحياة قادرة على تغيير دفتها في ثانية. في كل مرة نشعر فيها بالسعادة إذن، علينا الشعور بالامتنان العميق، دون أن نغفل الاحتمالية القائمة دائما أن الأمور قد تتغير إلى ما لا نريد.
صحيح أن إدراكنا بمدى عشوائية الحياة قد يقينا شر الإحباط، لكنه من الناحية الأخرى يجعلنا عرضة لمعاناة نفسية من نوع آخر. فعلى سذاجة إيماننا بكون عادل يسير بنظام محدد، يمنحنا ذلك الإيمان شعورا بالطمأنينة والسلام. أما على الناحية الأخرى، يبث فينا إدراكنا لمدى عشوائية الأمور شعورا بالقلق. فتلك العشوائية كما صرنا نعرف قادرة على إصابة حياتنا في كل لحظة بشتى أنواع الشرور والكوارث، فكيف يا ترى تستطيع الفلسفة مساعدتنا على مواجهة ذلك الشعور بالقلق في القلب من كون غير مأمون الجانب؟
كيف تساعدنا الفلسفة في مواجهة القلق؟
يعرف دي بوتون القلق في كتابه كالآتي: “حالة من الهياج بشأن وضع مربك يتمنى المرء أن تكون نتيجته مفرحة ويخشى أن تكون سيئة. وعادة ما يترك من يعانون منه عاجزين عن الاستمتاع بالنشاطات المبهجة المفترضة، ثقافية كانت أم جنسية أم اجتماعية”. أمام عشوائية الحياة، والمواقف الكثيرة التي نواجهها ولا نعرف أستنتهي إلى ما نريد أم ما نخشى، يبدو الشعور بالقلق إحساسا طبيعيا تماما. لكنه، على الجانب الآخر، لن يساعدنا على حل أي مشاكل. فنحن في حالة القلق لا نكون في مواجهة أمر سيئ حدث على أرض الواقع، بل أمام أشباح ضبابية تتغذى على أسوأ مخاوفنا، نعجز عن عدم التفكير فيها، ولأنها لم تحدث بعد، نعجز أيضا عن مواجهتها.
من ذلك الجانب، قد يكون القلق من حدوث أمر سيئ أحيانا أسوأ من وقوع ذلك الأمر حقا. ففي حالة وقوعه، تكون أمام حدث فعلي تحاول مجابهته، أما وأنت قَلِق من وقوعه، لا تفعل شيئا سوى تمثّله في خيالك وعيشه مئات المرات وأنت عاجز عن فعل أي شيء. قد عبّر سينيكا عن ذلك المعنى بشكل بليغ قائلا: “عدد الأشياء التي تُخيفنا يفوق عدد الأشياء التي تستطيع تحطيمنا، نحن نعاني في الخيال أكثر مما نعاني في الواقع”. [2]
المثير في ذلك حقا، كما لا بد أنك لاحظت، أنه في معظم الوقت ما نخشاه أو يقلقنا لا يحدث. فنحن نملك خيالا قادرا على مفاقمة أصغر الأشياء وتحويلها لتهديدات خطيرة. تقول الكاتبة ماريا بوبوفا عن هذا: “في الثلاثينيات، قام أحد القساوسة بتقسيم القلق إلى خمس فئات من المخاوف، أربع منها خيالية والخامسة “مخاوف ذات أساس حقيقي”، تحتل “ما يقارب 8٪ من المجموع””. لا ننال من أوقات القلق أغلب الوقت إذن سوى معاناة نفسية لا طائل من ورائها، فما الذي ينصحنا به سينيكا حيال ذلك؟ [3]
في أحد خطاباته، كتب سينيكا لصديقه لوسيوس جونيور يوصيه بالآتي: “ما أنصحك به هو ألا تكون تعيسا قبل حلول الأزمة؛ لأنه يمكن للأخطار التي يشحب لونك قبلها كما لو كان تهديدها واقعا ألا تصيبك؛ فهي بالتأكيد لم تأتِ بعد. وبالتالي، فإن بعض الأشياء تعذبنا أكثر مما ينبغي لها أن تعذبنا، وبعضها يعذبنا قبل أن يجب، وبعضها يعذبنا في حين لا يجب أن يعذبنا على الإطلاق. إننا واقعون تحت وطأة عادة المبالغة في الأسى أو تخيله وتوقعه”.
وفي خطاب آخر كتب له يقول: “من المرجح أن تحل علينا بعض الأزمات، ولكنها ليست حقيقة واقعة الآن. فكم مرة حدث ما هو غير متوقع! وكم مر المتوقع دون حدوث! ورغم كونه مقرر الحدوث، فَلِمَ تعاني من أجله سابقا؟ سوف تعاني قريبا بالقدر الكافي عندما يصل. لذلك تطلع في هذا الوقت إلى الأمور الجيدة وما الذي ستحصل عليه من خلال القيام بذلك؟ إنه الوقت بلا شك. سيكون هناك العديد من الأحداث حينها وسوف تؤدي إلى تأجيل الأزمات الوشيكة أو حتى الموجودة حينها أو تنهيها. وقد يفتح الحريق الطريق للفرار أحيانا، وأحيانا يُرفع السيف لحظة وصوله عنق الضحية وينجو الرجال من الموت. وحتى سوء الحظ فإنه متقلب، فقد يأتي وربما لا، وهو حاليا ليس هنا، لذا تطلع إلى أمور أفضل”. [4] قد ننجح في التغلب على القلق باتباع نصيحة سينيكا، لكن سيبقى خوفنا من المجهول ومن كل مصدر محتمل للمعاناة يتحكم في شطر كبير من تفكيرنا وتجربتنا الحياتية، ويجعلنا نحجم عن التجربة، ومن ثم عن العيش. فكيف قد تستطيع الفلسفة مساعدتنا في مواجهة هذا الخوف؟
كيف تساعدنا الفلسفة في مواجهة الخوف من المعاناة؟
“الخوف لا يمنع من الموت، لكنه يمنع من الحياة”
(نجيب محفوظ)[5]
مع الطبيعة المتقلبة للقدر، ومع كون الحياة حافلة بمسببات الألم والتعاسة، قد يبدو التصرف الأمثل هو الإحجام التام عن أيٍّ مما قد يعرضنا للمعاناة، والالتزام بحياة آمنة بعيدة عن كل المخاطر. آمن الفيلسوف آرثر شوبنهاور بذلك كليا، وكتب يقول: “ينبغي لنا توجيه هدفنا لا نحو ما هو بهيج ومستساغ في الحياة، بل نحو تجنب شرورها التي لا تحصى قدر الإمكان. الحصة الأسعد ستكون من نصيب الإنسان الذي أمضى حياته دون ألم كبير، جسدي أو عقلي”. لرأي شوبنهاور وجاهته. فمع كل الفظاعات التي يستطيع القدر أن يبتلينا بها دون أن يكون لنّا أي يد فيها، علينا على الأقل الإحجام عن أيٍّ مما قد يصيبنا من المعاناة مما نستطيع التحكم فيه. أليس كذلك؟
لفترة طويلة نسبيا، آمن الفيلسوف الألماني فريدريش نيتشه إيمانا تاما بما كتبه شوبنهاور، وعاش حياته وفقا لذلك. فقضى سنوات طويلة كناسك زاهد، لا رغبة له في شيء، تجنّبًا للآلام التي يجرها عدم تحقق الرغبات، ولا يسعى لأي متعة، هربا من المعاناة التي يسببها ضياع المُتع. عن ذلك كتب في إحدى الرسائل لأمه يقول: “نعلم أن الحياة تتكوّن من المعاناة، وأننا كلّما جاهدنا أكثر في محاولة الاستمتاع بها، ستزداد عبوديتنا لها، ولذا، ينبغي لنا نبذ متع الحياة والركون إلى التقشف”. لكن فيما تلا من سنوات، مر نيتشه بالعديد من التجارب جعلت رؤيته تلك تنقلب رأسا على عقب.
أدرك نيتشه أن السعادة والألم نصفان من كلٍّ واحد هو الحياة، وأنك لا تستطيع تجنب أحدهما دون حرمان نفسك من الآخر. فالحياة مثلما هي قادرة على إصابتنا بما يؤلمنا، ففيها أيضا الكثير مما يستحق أن يُعاش. صحيح أن الإحجام عنها قد يحميك من الآلام، لكنه أيضا يحرمك من متعها العديدة؛ ومن ثم، فإن كان النكوص عن العيش يساعدك بالفعل على تجنب المعاناة، فإن ما ستعيشه جرّاء ذلك لن يمتّ للسعادة بصلة.
كتب نيتشه عن ذلك يقول: “ماذا لو كانت السعادة والتعاسة مرتبطين معا بحيث لا بد لكل من يرغب في امتلاك إحداهما أن يمتلك أيضا قدرا مماثلا من الأخرى. أمامك الخيار، إما أقل تعاسة ممكنة، وقدرا من الصبر، أو أكبر سعادة ممكنة كثمن لتنامي فرط اللذائذ والمسرّات اللطيفة التي نادرا ما يتم التمتع بها؟ لو قررت المضي في الخيار الأول آملا تقليص وتخفيض مستوى الألم البشري، يتوجب عليك كذلك تقليص وتخفيض مستوى قدرتها على تحقيق السعادة”.
نتيجة لذلك التغير في فكره، لم يعد شوبنهاور مثال نيتشه الأعلى، واتخذ من رجال آخرين أمثالا عليا له. أولئك الرجال، الفيلسوف الفرنسي مونتناي، والأديب الألماني غوته، والأديب الفرنسي ستنادال، كانوا يقفون على طرف النقيض من شوبنهاور، “فبالرغم من جانبهم السوداوي، كانوا يضحكون، ومعظمهم كان يرقص أيضا، كانوا منجذبين إلى “نور الشمس اللطيف والهواء المنعش والنباتات الجنوبية ورائحة البحر والوجبات السريعة من اللحم والفاكهة والبيض””.
وقد كتب أحدهم، مونتناي، عن ارتباط مفهومي السعادة والألم يقول: “لا بد أن نتعلم معاناة كل ما نعجز عن تجنبه، تتكوّن حياتنا، مثل تناغم العالم، من نشازات علاوة على نغمات مضبوطة مختلفة، ناعمة وقاسية، حادة ومنبسطة، هادئة وصاخبة. لو أحب موسيقيّ بعضا منها فقط، ما الذي يمكن له أن يغنيه؟ ينبغي له معرفة كيفية استخدامها جميعها، ومزجها معا. وكذا ينبغي لنا أن نتعامل مع الجيد والسيئ، النابعين من جوهر واحد في حياتنا”.
كلمات مفتاحية: الفلسفة الروح الإنسانية القلق الإحباط الخوف عزاءات الفلسفة مصاعب
المصادر
1
عزاءات الفلسفة، ترجمة يزن الحاج
2
A Stoic’s-Key-to-Peace-of-Mind: Seneca on the Antidote to Anxiety
3
تعاني من القلق إليك وصفة سينيكا الفلسفية لتجاوزه
4
المصدر السابق.
أولاد حارتنا، نجيب محفوظ
ميدان
لتحميل الكتاب من احد الروابط التالية
عزاءات الفلسفة؛ كيف تساعدنا الفلسفة في الحياة
عزاءات الفلسفة؛ كيف تساعدنا الفلسفة في الحياة
عزاءات الفلسفة؛ كيف تساعدنا الفلسفة في الحياة
عزاءات الفلسفة؛ كيف تساعدنا الفلسفة في الحياة
صفحات سورية ليست مسؤولة عن هذا الملف، وليست الجهة التي قامت برفعه، اننا فقط نوفر معلومات لمتصفحي موقعنا حول أفضل الكتب الموجودة على الأنترنت
كتب عربية، روايات عربية، تنزيل كتب، تحميل كتب، تحميل كتب عربية