أربعة نماذج للسينما الأسديّة/ أنس الحوراني
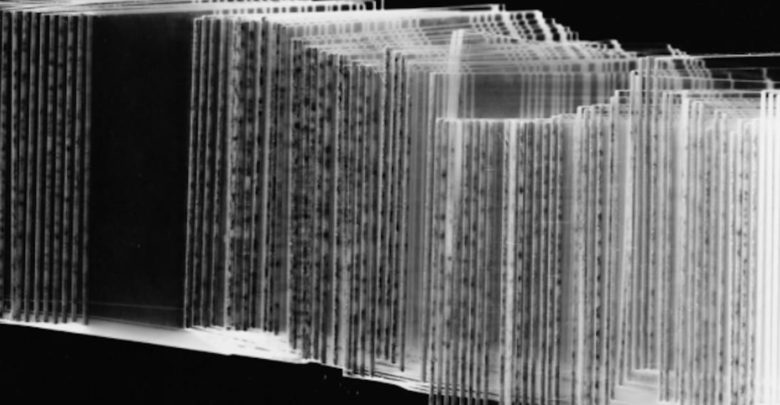
منذ فترة وجيزة، قامت مؤسسة عبد الحميد شومان في الأردن، وبالتعاون مع المؤسسة العامة للسينما في دمشق، بعرض مجموعة من الأفلام السوريّة ضمن فعالية أُطلق عليها اسم «ليالي الفيلم السوري». تنطلق هذه المقالة لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: 1) تحديد مفهوم السينما الأسديّة، وتمييزها عن عموم الإنتاج السينمائي السوري، 2) مراجعة الأفلام التي قامت مؤسسة عبد الحميد شومان بعرضها على مدار أربعة أيام (من الأحد 7/4/2019 إلى الأربعاء 10/4/2019)، لكونها أفلاماً سورية تمثل نماذج حقيقية وإشكالية لما يمكن وصفه بالسينما الأسديّة، وأخيراً 3) مساءلة الظرف والغرض من وراء التطبيع الثقافي الذي بادرت به مؤسسة عبد الحميد شومان مع نظام الأسد عبر تعاونها مع المؤسسة العامة للسينما في دمشق.
مؤسسة عبد الحميد شومان، لمن لا يعرف، هي إحدى أكبر المؤسسات الثقافية في الأردن، تأسست عام 1978 بمبادرة غير ربحية من قبل البنك العربي، عبر تخصيص جزء من أرباحه السنوية لإنشائها. أما برنامج السينما لديها فبدأ عام 1989، وقد قام منذ نشوئه وحتى اليوم بعرض مئات الأفلام والكثير من المهرجانات وأسابيع الأفلام. لكن «ليالي الفيلم السوري» يمثل سابقة مهمة لمؤسسة عبد الحميد شومان، من حيث صفته السوريّة وانتماؤه السياسي الصريح على الأقل. وحسب المنشور الرسمي على موقع المؤسسة، فإن الرئيسة التنفيذية فالنتينا قسيسية «أكدت أن هذه العروض تأتي في سياق مهمة التنوير والتثقيف التي تعمل عليها المؤسسة».
الأفلام الأربعة التي تم عرضها في «ليالي الفيلم السوري» هي التالية: أمينة، من إخراج أيمن زيدان؛ ودمشق… حلب، من إخراج باسل الخطيب؛ ورجل وثلاثة أيام، من إخراج جود سعيد؛ وماورد، من إخراج أحمد إبراهيم أحمد. كلها أفلام أخرجها ومثّل فيها وعمل عليها مناصرون علنيون للنظام الأسدي، وكلها أفلام قدمت سرديّات مختلفة في الشكل ومتشابهة في المحتوى حول سوريا كما يتخيلها هذا النظام، وحول السوريين كما ينبغي أن يكونوا في ظله.
ما هي السينما الأسديّة؟
للسينما السورية تاريخ طويل ومعقد، ولكن مع اندلاع الثورة السورية ربيع عام 2011، أخذت المؤسسة العامة للسينما تدعم بغزارة غير مسبوقة المخرجين والممثلين والعاملين السينمائيين الموالين لنظام الأسد، فافتتحت مراكز ودوراً ثقافية شتّى لتعرض الأفلام التي يتم إنتاجها بالمجان، ويترجَم بعضها إلى مختلف اللغات. الأعمال السينمائية التي بادرت المؤسسة العامة للسينما لدعمها بعد بدء الثورة، تختلف عن تلك التي سبقتها بمجموعة من الخصائص الفنية أو الصفات السردية الفريدة من نوعها. هذه الصفات والخصائص التي سيتم الحديث عنها بشيء من التوسع لاحقاً، هي التي تحملنا على تصنيف هذه الأعمال ضمن ما يمكن تسميته «السينما الأسدية». تاريخ هذا اللون من السينما ضارب في عمق الفنون البصرية السورية، والتي لطالما حاول النظام صهرها لتصبح أدوات للدعاية الأيديولوجية، من سينما ودراما، إلى مسرح وفنون جميلة، إلى آخره؛ ولكنه لم يتبلور حقاً، وفي شكله الحالي، إلا بعد اندلاع الثورة السورية. يرجع ذلك إلى مجموعة من الأسباب المادية والتاريخية المتعددة التي لم تتلاقَ في عهد حافظ الأسد، والتي لا يسعنا التفصيل فيها هنا. ولكن قُصارى القول أن أطياف المعارضة السورية، على اختلافها، تمكّنت إبان اندلاع الثورة من تشكيل شبكات إعلام توثيقي وإبداعي بديل، وقد زاد الانتباه العالميّ والضخّ النافذ على منصات التواصل الاجتماعي من فاعلية هذه الشبكات ومدى وصولها؛ مما دفع النظام إلى إعادة التفكير بأساليب تَعاطيه مع وسائط الإعلام الإبداعية، وإلى الاستثمار بشكل مكثف وهادف فيها، بغية تشكيل سرديّة مرئية مضادة، وموحدة، وموجهة.
ولتعقب الإرهاصات الكثيرة والمتنوعة التي سبقت نشوء السينما الأسديّة، يكفينا هنا إلقاء نظرة سريعة على المضمار البصري الأكثر شهرة في سوريا: الدراما التلفزيونية. وتحديداً، الأعمال الدرامية سياسية الطابع، التي تم إنتاجها إثر استلام بشار الأسد للحُكم. هناك، على سبيل المثال، مسلسلا على طول الأيام وغزلان في غابة الذئاب، اللذان عُرضا في نفس العام – 2006 – تمكنا من تحقيق وظيفتين رئيسيتين لدى عرضهما: 1) إيهام الجمهور بارتفاع سقف الحريات الإبداعية تحت حُكم بشار الأسد، على الرغم من أن كِلا العملين كان، إلى حد غير بعيد، بمثابة تصفية درامية محسوبة ومباركة من قِبل الرقابة (ضد عبد الحليم خدّام في الحالة الأولى، ومحمود الزعبي في الثانية)، و2) تطبيع النظام القائم – على منوال هكذا هي الحياة، والأوجب التعايش معها – وتصوير فساد المسؤولين وجشع رجال المخابرات على أنه نابع من عيوب شخصية وفردية، لا شيئاً يمكن مُحاسبته أو تصحيحه مؤسساتياً. هناك أيضاً مسلسل الولادة من الخاصرة، الذي اتُهم مراراً بتحامله على شباب الثورة، فصوّرهم على أنهم مجموعة من الأفراد الحالمين، الناقمين بشكل شخصي على الفساد والقمع الذي يتعرضون له (من غير الالتفات إلى الأسباب المركبّة والعميقة لاندلاع الثورة السورية، كمأسسة العُنف، وغياب العدالة الاجتماعية والاقتصادية). إن مثالية هؤلاء هي التي تضيّع الثورة، حسب سردية الولادة من الخاصرة. أما رجال الأمن فبعضهم فاسد وقمعي (وهؤلاء أفراد) ولكنهم – بالمجمل – عاملون في جسد يدافع عن الوطن. يضاف إلى ذلك بالطبع مسلسل بقعة ضوء، الذي ساهم إلى حد كبير بتطبيع الموقف التهكمي من أي مطالبة بالإصلاح أو التغيير. فلوحة «حاجز طيّار»، على سبيل المثال، تحكي عن تحول مجموعة من الرجال إلى أرباب منازل خشية الإلحاق الجبري بالجيش، الأمر الذي يصبح على مدار الحلقة شيئاً من النصر للنساء؛ و«انتخابات» تصوّر الفساد المستشري في عمليات الاقتراع الشعبي على أنها مشكلة متجذرة لا في الدولة أو النظام السياسي القائم، وإنما في البيروقراطي المسؤول عن الاقتراع والأفراد المنتخِبين الذين لا يفهمون معنى الديمقراطية؛ أما «طريق السلامة» فتتقفى رحلة زوجين من منطقة إلى أخرى في دمشق، ومرورهما بشتى الحواجز التي تُقيمها مختلف التيارات السياسية، وتلك تُختزل باليسار الجيفاريّ الكاريكاتوري، واليمين الإسلاموي الملتحي، وكأن نظام الأسد هو الجوهر الطبيعي غير المتغيّر فوق كل ذلك. كل هذا غيض من فيض، يطول الحديث فيه ويستحق البحث المتأني حوله، ولكنه مع الأسف لا يتسع في مقالة واحدة.
مع ذلك، لا يجوز الحديث عن جذور السينما الأسديّة كما نقوم بتعريفها من دون المرور على عرّابها الفعلي، نجدت أنزور. فقُبيل إخراجه لأحد أوائل النماذج المتكاملة للسينما الأسديّة – فيلم فانية وتتبدد – قام أنزور بإخراج مسلسلين تناولا ثيمة الإرهاب ومواجهة الأنظمة السياسية له، هما الحور العين وما ملكت أيمانكم. يحكي مسلسل الحور العين عن حادثة انفجار مجمع المحيا السكني في الرياض، ويحاول سرد قصص عائلات المقيمين في المجمّع وسعيهم للعمل لتأمين مستقبلهم ومستقبل عائلاتهم. أما ما ملكت أيمانكم فيرصد قصص ثلاث شابات عربيات، وصراع كل واحدة منهن مع ظاهرتَي الذكورة والتطرف الديني (والتي تصوّر الواحدة منها على أنها صورة مرآتية للأخرى). في كلا العملين، لا تتم مساءلة الجذور التاريخية أو الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية للأعمال الإرهابية أو لظاهرة التطرف الديني، وإنما يتم تقديمها على أنها أيديولوجيا واحدة، طهرانية، أصلها إما الجشع أو الرغبة الجنسية المكبوتة أو هوس الاستئثار بالسلطة. وفي كلا المسلسلين يتم إظهار رجال الأمن بصفة الأفراد الذين لا يستخدمون العنف مع معتقليهم إلا مكرهين. فعندما يتم القبض على شدّاد في مسلسل الحور العين – وشدّاد كان من بين أفراد الجماعة المسلّحة التي باغتتها قوات الأمن السعودية – يتم وضعه تحت الرعاية الصحية، ويتم التحقيق معه بكل سلاسة وحضاريّة (بل ويوصي النقيب خالد رجال الأمن به، ويحثّهم على منعه من أذية نفسه).
ما يميز أعمال نجدت أنزور عن غيرها في السينما السورية – وما يجعله هو بمثابة عرّاب حقيقي للسينما الأسديّة – هو عدم انشغالها بالواقع العربي أو السوري، ورفضها للمماحكة البنّاءة معه. فالمسلسلات الأخرى المذكورة أعلاه – غزلان في غابة الذئاب، والولادة من الخاصرة، وحتى بقعة ضوء، على سبيل المثال لا الحصر – حملت في طيّاتها في الكثير من الأحيان إيماءات نقدية وتقدمية، بل وثورية أيضاً. أما أعمال أنزور فلم تُعنَ يوماً إلا بإنتاج محاكاة للواقع، تنقل من خلالها مجموعة من التصورات والأفكار والرسائل الداعمة للأنظمة العربية. وإذا كانت هذه الآلية تشبه إلى حد بعيد آلية صنع الدعاية السينمائية للدولة، فذلك لأن أعمال أنزور تنتمي بالفعل إلى هذا النوع من السينما.
يمكن تعريف السينما الأسديّة، بشكل مبدئي على الأقل، على أنها مجموع الأعمال البصرية التي تم إنتاجها بُغية تلميع صورة نظام الأسد، وتطبيع وجوده، وإعادة إنتاج خطابه أولاً؛ وقولبة التاريخ السوريّ برمته حسب مخياله الأيديولوجي ثانياً. ومن هنا يمكن القول بأن السينما الأسديّة بدأت فعلاً مع فيلمي الأب لباسل الخطيب، وفانية وتتبدد لنجدت أنزور. فبعد صدورهما عامي 2015 و2016، نرى أجندة عمل المؤسسة العامة للسينما في دمشق قد اكتسبت ملامح أوضح وأدق، ونشهد صعود نجم مجموعة صغيرة من المخرجين: جود سعيد، ويزن نجدت أنزور، وحمادة سليم، وأحمد إبراهيم أحمد، من بين آخرين.
تمثل الأفلام الأربعة التي تم عرضها في «ليالي الفيلم السوري»، تحت إدارة مؤسسة عبد الحميد شومان في الأردن، وبالتعاون مع المؤسسة العامة للسينما في دمشق، نماذج مثالية للسينما الأسديّة، وصار لزاماً الآن إلقاء نظرة متفحصة عليها.
أربعة نماذج للسينما الأسديّة
يحكي أول فيلم تم عرضه، أمينة، عن حياة شخصيته الرئيسية، أمينة، الأرملة حديثاً، والتي تَهَبُ حياتها للعناية بابنها سهيل، العسكري السابق في الجيش العربي السوري، الذي يُصاب في ساحة المعركة فيصبح مشلولاً تماماً إلا من عينيه (في محاكاة ذهنية، تصبح لاحقاً حرفية ومثيرة للخجل، للفيلم الغفرنسي بذلة الغوص والفراشة، الذي تُعرض عدة مشاهد منه في الفيلم نفسه). لسهيل زوجة اسمها سلمى، وابن تتناحر هي وأمينة على الوصاية عليه؛ كما له أخت، اسمها سهيلة، تحب عسكرياً يعمل على إحدى الحواجز اسمه وليد (عسكريو الحواجز، عندما يظهرون في الفيلم، لطيفون، دمثون، يَطلب أحدهم من سائق سيارة فتح صندوقها بكل وداعة). تشعر أمينة، وقد ترملت ولم يعد لها سند ذَكَر غير ابنها المشلول تماماً، بالتهديد، وتخاف على ابنتها من جشع أبو زهير، أحد متصرفي القرية ودائنيها الأخسّاء، ورغبته بها. حبكة الفيلم الرئيسية، إذن، تدور في فلك مألوف وكونيّ: هناك أرملة ترغب بحماية أبنائها وأرضها، وشخص متنفذ يقف في طريقهم نحو تحقيق السعادة. عند حديثه مع الجمهور بعد عرض الفيلم، أكّد أيمن زيدان أن «الفيلم غير اصطفافي» وأنه لا يكترث إلا بالمنطق الإنساني. «أنا أردت أن أحكي قصة أم لديها ولد مصاب، لا أكثر؛ فيلم عن الحرب بدون طلقات ولا فصائل مسلحة.»
عند مشاهدة فيلم سوريّ يحاول سرد قصة كونيّة، تصبح قراءة التفاصيل المكبوتة والمخفية، ومقارنتها بمثيلاتها المكشوفة والمحكية، أسلوباً يمكن التعويل عليه لتحقيق فهم أعمق للفيلم نفسه، ولصانعيه أيضاً. إحدى العُقَد الرئيسية في الفيلم هي وقوع أمينة، بعد وفاة زوجها، بالدَين لأبو زهير، ورفضها لبيع أرضها حتى لو كان ثمنها سيخلّصها منه. للأرض قيمة معنوية بالنسبة إلى أمينة، وتمسّكها بها هو تمسك بالعائلة والتاريخ المشترك. وكم مرة فكّرت أمينة بمغادرة أرضها! في إحدى أكثر مقاطع الفيلم إثارة للاهتمام، والتي تظهر في المنتصف تقريباً، ترى أمينة مجموعة من الناس يركبون قارباً ليتجهوا إلى جزيرة أرواد. في المشهد مطابقة حرفية لمشاهد النازحين السوريين الهاربين من البلاد. ولوهلة ترى أمينة المسافرين الوديعين وقد تماهوا مع المهجرين والنازحين، ثم تكمل مسيرها إلى منزلها بصمت، مؤثرةً البقاء. عندما سُئل أيمن زيدان عن معنى المشهد، أكّد تماهي المهجرين بالمسافرين، وأضاف بأنه قد استعان خلال التصوير بفيديوهات النزوح السوري الموجودة على الإنترنت. هذا الهوس بالبقاء هو أول خصائص السينما الأسديّة.
الخاصية الثانية هي تثمين القيم المحافظة أو «المعتدلة». يمكن وصف فيلم أمينة بالرجعية الأخلاقية، من دون أن يكون في ذلك أي افتراء أو تحامل. عندما ترغب سلمى، زوجة سهيل، بالانفصال عن زوجها لأنه لم يعد يحبها، تنهرها أمينة وتذكّرها بواجبها بالبقاء مع زوجها، ثم تهددها بالتالي: تزوجي إذا كنت ترغبين ذلك، ولكن اتركي حفيدك معي. وعندما توافق سهيلة على عرض أبو زهير بالزواج منها، تحت الوطأة النفسية الشديدة، تزجرها أمها في البداية وتذكّرها بضرورة إكمال دراستها وعدم التفريط بأحلامها، ولكنها بعد لحظة تسألها، «ثم ماذا عن وليد؟» هذا ناهيك عن هوس أمينة بصحة ابنها، فهي لا تتخيله إلا صحيحاً معافى، ولا تحبه إلا بقدر ما تتخيله كما كان في سابق عهده. أمينة الأم هي أم رمزية فحسب، وهي الأم-المثال الذي قولبه حزب البعث على مدار عقود: أمّ قوية، ولكن من دون أن تُخِلّ بتوازن العائلة المثالية، الهرمية، التي يخضع فيها الصغير للكبير، والنساء للرجال. ولأن الرجل الكبير قد مات، والثاني لا يستطيع فرض السيطرة، فقد صار لزاماً على الأم أن تصبح بمثابة الأب، وأن تمارس ذات التسلط الذي كان يمارسه، بتهديد زوجة ابنها تارة، وبالسعي الحثيث لتزويج ابنتها تارة أخرى. إن فيلم أمينة لا يحكي قصة أمينة حقاً – فهي شخصية سطحية بالمعنى التام والفورستري (نسبة إلى إ. م. فورستر) للكلمة، لا تتصف إلا بكونها أماً؛ أماً قلقة، أو غاضبة، أو حزينة – وإنما يحكي قصة علاقة أمينة وابنتها بالرجال المحيطين بهما، وخضوعهما لهم في نهاية المطاف: سهيلة تتزوج، والأم تهب حياتها لأرض الضيعة رثاءً لزوجها وابنها، وبذلك تصبح شهيدة لا للوطن وإنما للرجال الذين ضحَّوا في سبيل هذا الوطن.
وكما يتضح لنا في فيلم أمينة، فإن الخاصية الثالثة والأخيرة للسينما الأسديّة ذات وجه ثنائي، فهي تطبيعُ الواقع المصوّر وتطهيرُه تاريخياً في نفس الآن. ففي هذا الفيلم «غير الاصطفافي»، لا نرى إلا أفراد الجيش العربي السوري، ولا نراهم إلا بصفتهم نبلاء ومُضحّين. (وفي إحدى إجاباته على الجمهور، علّق أيمن زيدان قائلاً، «الفن إعادة إنتاج للواقع، وهذا الفيلم هو إعادة إنتاج للواقع».) من أصاب سهيل وتسبب بشلله التام؟ مسلّحون. من يكون هؤلاء المسلحين؟ لا نعرف. وما هو هدفهم بأي حال؟ تدمير طريقة العيش المتعارف عليها، الرعوية، المليئة بالبطولات والعائلات المثالية المتخيلة. وبِمَ تتصف طريقة الحياة هذه، عدا عن رعويتها وبطولاتها؟ بخلوّها الطبيعي من وجود أي صورة للرئيس. السينما الأسديّة متمثلة في فيلم أمينة تطمس الذاتي والخاص بسوريا الحقيقية، بغية تصوير حكاية عولمية ومستساغة، ولكنها بفعلها ذلك تعيد إنتاج القمع الذي تدّعي عدم اقترافها له. سوريا الأسد في هذا الفيلم هي سوريا متخيلة، لاتاريخية، ولكنها أيضاً سوريا كما يرسم معالمها نظام الأسد، بدءاً من مؤسسة الجيش ووصولاً إلى مؤسسة العائلة، سوريا يقف أبناؤها صفاً واحداً ضد العدو مجهول الهوية وكليّها، ويرفضون مغادرة أراضيهم دفاعاً عنها، وعلى الرغم من كل شيء.
*****
يمكن القول بأن الفيلم الثاني الذي تم عرضه، بعنوان دمشق… حلب، هو أكثر نماذج السينما الأسديّة شهرة حتى الآن، كما أنه أكثرها وضوحاً وشفافية من حيث الانتماء والانشغال الأيديولوجيين. وقد حاز دمشق… حلب على جائزة أفضل فيلم روائي عربي في «مهرجان الإسكندرية لسينما حوض البحر المتوسط» في عام 2018، كما مُنح بطلُه دريد لحام جائزة التمثيل الكبرى عن دوره فيه. لهذه الأسباب مجتمعة يستحق فيلم دمشق… حلب الوقوف المطوّل عنده.
يتناول الفيلم حكاية عيسى عبدالله، وهو رجل مُسنّ وانطوائي ومحافظ، عمل سابقاً مذيعاً لراديو صوت الشعب. يعيش عيسى في دمشق، أما ابنته دنيا فتعيش في حلب التي ترفض مغادرتها، حيث قام مسلحون باختطاف زوجها الذي يعمل عسكرياً لدى الجيش العربي السوري. دنيا لديها ابنان، وهي مع ذلك تؤثر تعريضهما لخطر البقاء في منطقة ملغومة ومهدمة تماماً على الخروج، وتقول إجابةً على استفهام أحد عسكريي النظام الذين حرروا المنطقة – بالتعاون مع الروس، الذين سيأتون عمّا قريب ليمشّطوا المنطقة من الألغام – «لَم أخرج عندما كان المسلحون تحت بيتي؛ والآن تريدني أن أخرج وأنتم هنا؟». بعد وفاة ابنة أخت عيسى في هجوم انتحاري على القصر العدلي، يقرّر المغامرة بكل شيء، والاتجاه إلى حلب لملاقاة ابنته المحاصرة والمعزولة.
هنا يبدأ الفيلم فعلاً: في الرحلة من دمشق إلى حلب، حيث يلتقي عيسى عبدالله بمختلف الشخصيات التي تمثل، على نية المخرج على الأقل، أطياف الشعب السوري، أو صيغة ما عن المجتمع السوري. الفيلم، إذن، تنويعة أخرى – سورية – على سيناريو الفيلم الأميركي رحلة الطريق. في الرحلة يجتمع عيسى بمذيع نسونجي يدعى جلال؛ وزوجين حلبيين يرغبان بإقامة حفل زفافهما في مسقط رأسيهما؛ ورجل يدّعي أنه عنصر مخابرات، رغم أنه يعمل في الحقيقة معلّم أركيلة؛ هناك أيضاً اعتزاز، متطوعة الهلال الأحمر، والمعنية بالأطفال المصابين بالتوحد وبآفة جادوب الصنوبر؛ ورفاه، وهي امرأة في منتصف عمرها، لا تتصف إلا بالرقة والوداعة؛ وابن عشيرة مُسنّ ومُريب المظهر، يتضح فيما بعد أنه مسؤول أمني رفيع المستوى؛ بالإضافة إلى لورا التي تعمل مغنية في إحدى الفرق الموسيقية، وصديقها.
وفي كل حادثة على طريق الرحلة تتضح الدينامية الفكرية للفيلم: فعندما يتم إيقاف عيسى بالخطأ، يدافع ركاب الباص عنه بكل جرأة ويتطاولون على عناصر الأمن، في حين يتعامل أولئك مع الجميع بكل احترام وهدوء. أما سيادة النقيب فيُظهر بعض الامتعاض لكونه مشغولاً بتنفيذ الأوامر فحسب، ولكنه عندما يتعرّف على موقوفه – المذيع المخضرم في المحطة التي كان يستمع إليها طوال الوقت عندما كان طفلاً صغيراً – يقرر تجاوز الإجراءات البيروقراطية وتمريره على مسؤوليته.
وعندما تلجأ أمّ محجبة وابنها إلى الباص، ويتمكن زوجها من إيقاف الباص وتهديد الركاب بالسلاح، يطالب الكثيرون بتسليم المرأة وابنها، مردّدين عبارة «ما دخلنا»، لكن عيسى يرفض فعل ذلك قائلاً: «أصلاً ما ضيعنا غير عبارة ’ما دخلنا‘»، فيقنع ركاب الباص بالتكاتف على الزوج، فيجرّدونه من سلاحه ويركلونه خارج الباص.
أما عندما يتعطل الباص، ويطلب عيسى – الذي أصبح بعد حادثة الزوج المسلّح بمثابة الأب الروحي للركاب – من عنصر المخابرات الكاذب أن يستغل نفوذه وأن يوقف إحدى السيارات لإيصال الزوجين المستعجلين إلى حلب، يقع هذا الأخير في مأزق يكشف هويته الحقيقية. ولماذا قد يدّعي أي شخص أنه عنصر مخابرات في عالم دمشق… حلب؟ «لأنو الكل محسبني عنصر أمن… لهيك قلت يا ولد إذا فيك تساعد العالم، ليش لاء؟». لاحقاً، يقرر عيسى الذهاب برفقة رفاه إلى إحدى الضيَع القريبة ليلتقي بهدى، فيصطدمان في المقبرة المهجورة بأحد أقرباء هدى الصغار في السن والمتأثرين بالإسلامويين الذين غزوا البلاد، فيهددهما ويتهمها بسذاجة مضحكة بـ«ارتكاب الفاحشة». لقاء عيسى بهدى يخلو من أي مغزى درامي، ولا يخلّف وراءه إلا المشهد الأخير منه: عيسى يتحدث مع الولد المسلم الغرّ بأبوية، والولد يعتذر له ويطلب الصفح منه.
وراء التعقيد الدرامي والطول غير الضروري لفيلم دمشق… حلب مجموعة من الأفكار البسيطة:
1) السوريون الذين بقوا على الأراضي السورية هم الوحيدون الذين سيُعيدون إعمار البلاد وإعادتها إلى مجدها السابق. في بداية الفيلم، وإثر التفجير الإرهابي الذي يودي بحياة ابنة أخت عيسى، تتراءى لمخيلة عيسى صورة مثالية: هو وابنته وأحفاده يجلسون في إحدى حدائق دمشق العامة، يتضاحكون مسرورين، وابنة أخت عيسى تَرفُل في ثوب زفافها عن كثب. وفي نهاية الفيلم، بعدما يصل عيسى إلى منزل ابنته المهدم في حلب، ويطلب السماح من العسكري بالمرور خلال الحقل الملغوم، ويتمكن من تجاوزه بنجاح، نرى عيسى وابنته وأحفاده يمشون ويتقافزون فَرِحين في الشوارع الحلبية المرمّمة، وأشعة الشمس تكللهم كهالة. جزاء عيسى وابنته على بقائهما في البلاد هو جنة سوريا المستقبلية.
2) العدو الوحيد للسوريين هو العدو الخارجي (أياً كان ذلك، من مهربين إلى إسلامويين ومسلحين مجهولي الهوية)؛ أما أجهزة الأمن والجيش والشرطة – ولا فرق بين أيّ منها بصرياً – فهي أجهزة رحيمة تحرص على حماية البلاد من هذا العدو الخارجي. أعضاء الجيش كلهم بشر خيّرون في أفضل الأحوال، ومسؤولون ملزمون باتباع الإجراءات البيروقراطية في أسوئها. في خضمّ حِداده، يقرر عيسى زيارة استوديو التسجيل الذي كان يعمل فيه، ويلجأ لمناداة الدول والعواصم العربية على السواء، وكأنما استنجاداً بالعرب من العدو الخارجي الذي أودى بحياة ابنة أخته: «هنا إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق… هنا القاهرة من دمشق. هنا بغداد، هنا الجزائر، هنا صنعاء، هنا القدس، هنا دمشق من دمشق». وفي لقطة أخرى، يقرر العسكري المسؤول عن حماية الحارة التي تسكن فيها دنيا تقديم المساعدة لها من دون مقابل، فيؤمن لها المازوت والخبز بعد أن يطمئن على حالها في اليوم السابق.
3) المجتمع السوريّ المتخيل في دمشق… حلب مجتمع تقدّمي ظاهرياً، ولكنه رجعي تماماً في باطنه: لا تتحدث أي امرأة مع أخرى في الفيلم إلا عن الرجال، وعن علاقتها بالرجال. أما اعتزاز، فلا تفيدها انشغالاتها التطوعية والخيرية، ولكنها تستطيع إيقاف سيارة على الفور عن طريق استغلال مظهرها الخارجي (فهي على حد تعبير عيسى – الذي يمكن اعتباره رمزاً للقيم المحافظة، وتعبيراً عن الروح السورية حسبما يصورها الفيلم – «تكشف صدرها للطبيعة» على الدوام). وفي إحدى لحظات الفكاهة السمجة، تعبّر رفاه لعيسى عن سعادتها بقدوم الربيع، فيجيبها الأخير قائلاً، «ما خرب بيتنا إلا الربيع». هذا ناهيك عن ذكر وداع عيسى لركاب الباص الذين بقوا معه حتى النهاية، فعندما يصل إلى المذيع النسونجي جلال – الذي يقضي معظم الرحلة يضايق النساء من حوله ويحاول التحايل عليهن للتقرب منهن – يصفه بكل جدية بـ«الزميل» و«الرجل الشريف».
هذه هي عناصر الكيتش الأسدي: فكاهة رجعية؛ حنين لسوريا مثالية ومتخيلة توجد في عصر ما قبل الثورة؛ وتطبيع لوجود نظام الأسد، ولسطوته وقانونه.
يجب التنويه إلى أن فيلم دمشق… حلب هو الوحيد من بين الأعمال التي تم عرضها في «ليالي الفيلم السوري» الذي يُظهر صورة بشار الأسد. يحدث ذلك لجزء من الثانية فحسب، عندما يزور عيسى عبدالله فرع الأمن ليستفسر عن اختفاء نسيبه. يُقصد لصورة بشار الأسد في هذا المشهد الثانوي أن تكون لزوماً بيرقراطياً ليس إلا، ولكنها في الحقيقة الشبح المهيمن والآلة المحرّكة لكل واحدة من أُطُره.
*****
إذا كان الفيلم الأخير الذي تم عرضه في «ليالي الفيلم السوري»، ماورد، نموذجاً لإعادة الكتابة الأسديّة للتاريخ السوري، فإن الفيلم الذي سبقه، رجل وثلاثة أيام، هو نموذج لتزييف الحاضر السوري المعاصر.
يروي فيلم رجل وثلاثة أيام قصة مجد، وهو مخرج مسرحي منغمس في الملذات، يتلقى ذات ليلة اتصالاً يُعْلمه أن ابن خالته بيرم قُتل أثناء الخدمة، وأن عليه أن ينقل جثمانه من الشام إلى الضيعة في إدلب. تعترض مجد خلال رحلته مجموعة من العقبات – منعُ سيارة أبي صالح، العنصر الذي يكلفه الرائد بمرافقته، من المرور عبر الحاجز؛ ثم قتلُ القناصة لسائقي عربة الإسعاف التي تتمكن من المرور لاحقاً – مما يحمله على الرجوع، هو والجثة، إلى منزله في دمشق. تفتتح الفيلم مقارنة بين حياة أهل الضيعة التي يأتي منها بيرم – خُضرة تشبه جنة عدن؛ أراض سبخة مثقلة بالماضي؛ رجال جديون ونساء قويات ومستترات، لا يرمشن لسوط المطر على وجوههن – وحياة أهل المدينة التي يعيش فيها مجد – رجال سكارى وآخرون انتحاريون؛ نساء خليعات بلا شخصية، يرتمين في أي أحضان أي رجل قريب منهن (في إحدى أكثر لقطات الفيلم غرابة، نرى امرأتين بلا اسم تلمسان خد جثة بيرم بشيء من الشهوانية). المقارنة واضحة: هكذا فعلت الحرب بأبناء المدينة المدللين والمحميين من آثارها الشنيعة، جعلت منهم ثلة من الأنانيين والمجانين والحشاشين؛ وهكذا فعلت بأبناء القرية الذين ضحوا بأنفسهم وبعائلاتهم كرمى للوطن، فضاعفت من عزيمتهم ورغبتهم بالتكاثر. غني عن القول، بالطبع، أن زوجة بيرم تنجب له ابناً ذكراً في نهاية الفيلم. فتَحتَ كل الهلوسات التي يُغرق الفيلم في تصويرها، ويحاول جاهداً أن يُظهر غرابتها وتشوهها المتعلق بشكل مباشر في الحرب، حكاية دعائية مفادها أن بيرم العسكريّ مات دفاعاً عن الوطن، وأنه سوف يعيش عن طريق إحياء أبناء هذا الوطن، الذين سيبقون على أرضه ويرجعون إلى مسقط رأسهم فيه – وتحديداً: الضَيعة التي لم يصلها تلوث المدينة أو جنونها. يقول مجد في آخر الفيلم: «أنا لم أحضر بيرم إلى الضيعة. بيرم هو الذي جاء بي إليها».
من الجدير بالذكر أن فيلم رجل وثلاثة أيام مُنع من العرض في «مهرجان السينما العربية في باريس» العام الماضي، وتعرض للكثير من النقد المفهوم منذ ذلك الحين. فالفيلم، أولاً وأخيراً، إسقاط سينمائي للجرائم التي لطالما اتُهم الجيش العربي السوري بارتكابها – من قناصة المدنيين إلى اغتصاب النساء على الحواجز – على المسلحين، ومحاولة صريحة لتزييف الحاضر الراهن لسوريا حسب رؤية النظام.
إذا استند هذا التزييف إلى شيء، فقد استند إلى عملية إعادة كتابة شفافة للتاريخ السوري. تصل هذه العملية إلى مداها الكاريكاتوري في فيلم ماورد، الذي يحكي قصة ضَيعة سورية متخيلة يعمل أهلها في صنع الماورد والعطر الشامي. لا شيء في هذه القرية المتخيلة مبني على أي شذرة من شذرات التاريخ الاجتماعي والسياسي الحقيقي لسوريا، فأهلها لا طائفة لهم ولا عقيدة، ولا مسجد يجمعهم ولا كنيسة؛ أما نساؤها فيعملن مع الرجال في الحقول، ويتبادل العشاق من بينهم الورود في وضح النهار، ولا وجود فعلياً لأي عادات مجتمعية مُميِزة تحكم علاقة الأفراد والجماعات. كل ما لدينا هو مادة درامية خام: قرية مليئة بالشخوص الثانوية، يتعاقب على أبنائها أساتذة يرمزون بإبهام إلى شتى الحقب السياسية التي مرّت على سوريا الحديثة: من الشيخ قحطان (الدولة العثمانية)، إلى الأستاذ غالب (الاحتلال الفرنسي)، والأستاذ ثائر (استيلاء حزب البعث على السلطة). ثم ماذا؟… ثم تنظيم الدولة الإسلامية، بالطبع. يبدأ الفيلم – وينتهي – بدخول تنظيم الدولة للقرية، وتحرير الجيش العربي السوري لها. التاريخ في فيلم ماورد قفزات سريعة ورمزية، تؤول إلى المنتهى الأكيد: نصر الجيش العربي السوري، وبقاء نظام الأسد، الحامي الوحيد للدولة السورية.
بإمكاننا السخرية طويلاً من فيلم ماورد. فشخصيته الرئيسية نوارة لا تعدو كونها امرأة سلبية لا حول لها ولا قوة، أما رجاله فليسوا إلا جماعة من المهووسين بالنساء. والمفارقة المضحكة هي أن الشخصية الوحيدة التي يمكن وصفها بالعُمق هي شخصية الزوجة الفرنسية التي تخدع أهل القرية وتسرق قناني عطرها. بإمكاننا، أيضاً، أن نضحك طويلاً على مشهد دخول تنظيم الدولة إلى القرية، حين يقطع أعضاؤها – بحد السيف! – الورود المتناثرة على السهول، فتسيل دماً قاني الحُمرة. ولكن ذلك لن يكون ذا فائدة، ففيلم ماورد، وسائر الأعمال التي تم عرضها في «ليالي الفيلم السوري»، هي على رداءتها التقنية والسردية، وعلى فداحة انتمائها الأيديولوجي، أمثلة على الرؤية الإبداعية لنظام الأسد. ولولا تحريف الماضي السوري حسب المنطق الأسديّ في فيلم ماورد، على سبيل المثال، لما اكتمل مشروع تزييف الحاضر السوري كما تم عرضه في فيلم رجل وثلاثة أيام.
مؤسسة عبد الحميد شومان والتطبيع الثقافي مع نظام الأسد
لماذا، أخيراً، قامت مؤسسة عبد الحميد شومان بعرض أفلام «ليالي الفيلم السوري»، ولِمَن؟
لنكن، بدايةً، واضحين. فالتطبيع الثقافي مع نظام الأسد ليس ظاهرة غريبة أو مفاجئة حقاً على الأردن، بل إنها سبقت حقيقة فتح معبر جابر-نصيب بسنوات عديدة. ولكن العامين الأخيرين شهدا ظهور حشد خطابي يهدف إلى تعميم هذا التطبيع الثقافي والاقتصادي وتسييده؛ ويمكن اعتبار فتح المعبر الحدودي – وهو نقطة تاريخية فاصلة – نتيجة غير مباشرة له. ولا غرو، فبعد مرور بضعة أشهر فقط على فتحه، أعلنت وزارة الخارجية الأردنية تعيين دبلوماسي برتبة مستشار كقائم بالأعمال بالإنابة في السفارة الأردنية لدى دمشق. وقتها، ذكر القائم بالأعمال في السفارة السورية أيمن علوش أن «خطوة تعيين دبلوماسي أردني برتبة مستشار في دمشق ’إيجابية‘» وأن مستوى «العلاقة بين البلدين يتحمل أعلى المستويات في التمثيل في كل المجالات اقتصادياً وتجارياً وسياسياً». وأضاف: «لذلك نأمل أن نرى خطوات أخرى في كل المجالات».
«ليالي الفيلم السوري» هي بالطبع مثال على ذلك، وإن في المجال الثقافي.
*****
عندما رأيت لأول مرة إعلان عرض «ليالي الفيلم السوري» لدى مؤسسة عبد الحميد شومان، وانتبهت إلى تعاونها مع المؤسسة العامة للسينما في دمشق، تملّكني شعور عارم بالتوجس. وخلال أيام العرض الأربعة، تجاوز كمّ الحضور كل توقعاتي، وفاجأني انتماؤهم الديمغرافي (وتلك، في الحقيقة، غلطتي): فالأغلبية الساحقة كانت من العرب الأردنيين والسوريين تحديداً، ولم يكن هناك – على عكس العادة في مثل هذه الفعاليّات – وجود يُذكر للطلاب أو الموظفين الأجانب.
خلال العروض – وخصوصاً خلال عرض دمشق… حلب، الذي خرج الكثيرون منه وهم يذرفون الدموع – كان بإمكان المرء أن يشعر بتعطش الجمهور لصورة سوريا الماضية، المتخيلة كما هي ظاهرة على الشاشة. كان الجمهور حاضراً للضحك على أتفه مزحة، وجاهزاً للتعاطف عند وقوع أدنى هَنَة. وفي فقرة الأسئلة والأجوبة التي تلت كل فيلم، لم يتوجه أحد بكلمة نقد، أو يُشر ولو بالبنان إلى الفيل في الغرفة: نظام الأسد، الموجود في مادة الأفلام والمتستِّر وراء صورها. بل إن أحداً لم يتساءل ولو مرة عن علاقة مؤسسة عبد الحميد شومان بالمؤسسة العامة للسينما في دمشق – عن أصل هذه العلاقة وطبيعتها ومغزاها ومداها على الصعيدين الثقافي والسياسي. وعندما تجرأتُ على طرح السؤال في الليلة الأخيرة – وكانت رانيا حدّاد، عضوة لجنة السينما في مؤسسة عبد الحميد شومان، وعمّار حامد، مدير المهرجانات في المؤسسة العامة للسينما في دمشق، قائمَين على الفقرة وقتها – قوبلتُ بالتهرب الشكّاك من الإجابة («الموقف [أي موقف مؤسسة عبد الحميد شومان] مع البلد وليس مع النظام»؛ «السينما غير سياسية، وهي تعبّر فقط عن سوريا»؛ «نحن مع الشعب وللشعب»). ولكن عندما حيّا أحد الحضور الجيش العربي السوري، وصفّق كل من كان موجوداً في الصالة، لم ينبس أحد من القائمين على العرض بكلمة.
لم يخطر على بالي عندما قررت كتابة هذه المقالة/التغطية حول فعالية «ليالي الفيلم السوري»، أن المطاف سينتهي بي بالتفرقة بين عموم الإنتاج السينمائي السوري، والشيء الذي قررتُ تسميته – مبدئياً – السينما الأسديّة. ولكن في تلك الليلة الأخيرة، تناهى إلى سمعي ما قالته إحدى الحاضرات بالقرب مني: «صرلنا 8 سنين ونحن نشاهد سينماكم. ألم يحن الوقت لنشاهد سينمانا نحن؟». وشعرتُ في الحال بأن سؤالها ينطوي على حقيقة عميقة، مفادها بأنه صار بالفعل يوجد ما يمكن الإشارة إليه، لو أردنا عكس العبارة، بـ«سينماهم هم»، سينما الأسد.
«ليالي الفيلم السوري» كان عرضَ مؤسسة عبد الحميد شومان لهذه السينما بالذات. وذلك أمرٌ لا ينبغي أن يمر مرور الكرام.
موقع الجمهورية




