استشهد عبد الباسط الساروت.. أحد أبطال الثورة السورية -متجدد ومستمر-
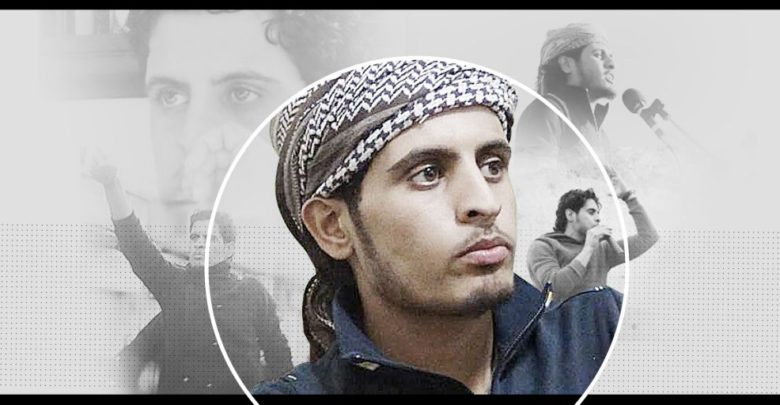
على مَرأى مِن الغيمِ،
ومِن حرّيّةٍ قطَعَ الرصاصُ سؤالَها المَبحوحَ
عن حُضنٍ تَفيءُ إلَيهِ بَعدَ يَديهِ.
آهِ يا يَديهِ الخاويَة،
لا تَحضُني خَصرَ الرياحِ وتَتركيني عاريا،
لا تَحضُني وَجَعَ الترابِ المُنكَسِر
وتُخَلّفي جُرحاً على حوافِ الروح.
يا يَديهِ العاليَة،
أعلى مِن صلاةٍ في فَمٍ مَجروح.
ياسر خنجر
الساروت شهيداً
توفي القيادي في “جيش العزة” عبدالباسط الساروت، الملقّب بـ”حارس الثورة السورية” بعد إصابته بجروح خطيرة خلال المعارك الدائرة بريف حماة الشمالي.
وأصيب الساروت في معركة تل ملح، شمالي حماة، بعد منتصف ليل الخميس/الجمعة، وتمَّ إسعافه على الفور إلى مستشفى ميداني بالقرب من خطوط الاشتباك، ومنه إلى أحد مشافي إدلب، ومن ثم نُقِلَ إلى أحد المشافي التركية، حيث توفي صباح السبت.
مرافق الساروت “خالد أبو علي”، كان قد قال لـ”وكالة ستيب” الإخبارية، إنه قد أصيب بنزيف حاد تمَّ إخضاعه لعملية جراحية فورية لمعالجة تمزّق الأوعية الدموية جرّاء الشظايا، بالإضافة لإصابته بكسور متعددة.
وتعرّض الساروت لإصابة بالبطن أدت الى نزيف تحت البريتوان، بالإضافة لثقوب بالمعدة، وكذلك بإصابة وعائية عظمية بالساعد والساق وتهشّم كبير بهما.
وظهر الساروت في شريطين مصورين عند تواجده على إحدى الجبهات، قبيل تعرضه للإصابة بساعات.
والساروت، من مواليد العام 1992، ابن عائلة نزحت من الجولان، واستقرت في حي البياضة في مدينة حمص. وكان حارس نادي الكرامة السوري، وحارس منتخب شباب سوريا. وأصبح مع بداية الثورة السورية أحد أبرز وجوهها الثورية.
وبرز الساروت كمنشد خلال سنوات الثورة الأولى ولقّب بـ”بلبل الثورة”، وتحولت هتافاته إلى أناشيد مثل “جنة يا وطنا”.
ومع حصار حمص، وانتقال الثورة إلى طورها المسلح، بات الساروت قيادياً في “كتيبة شهداء البياضة”، وبعدها في “فيلق حمص”.
حقد النظام على الساروت كان هائلاً، خاصة بعدما استقبل الساروت الفنانة فدوى سليمان في البياضة المحاصرة، وأنشدا سوية للثورة السورية. “اتحاد الكرة السوري” فصل الساروت ومنعه من لعب الكرة. ورصد النظام مليوني ليرة سورية، للقبض عليه. وحاول النظام السوري اغتياله 3 مرات على الأقل. وقتلت مليشيات النظام جميع أخوة الساروت؛ وليد في الخالدية 2011، ومحمد مطلع العام 2013، وأحمد وعبدالله في كانون الثاني 2014، وكذلك خاله محي الدين.
ويعتبر فيلم “العودة إلى حمص” من أشهر الأفلام التي ركزت على شخصية الساروت، وتحوله كأبرز العناصر التي قادت الحراك السلمي إلى حمله السلاح وقيادة الثورة في مدينته حمص بعد قمع النظام للمظاهرات السلمية. في الفيلم يظهر الساروت وهو يقول: “خسرنا أرواحا، وخسرنا بيوتا، وخسرنا ذكريات، لكن لن نخسر مطلبنا وهو الحرية”.
كما أن الساروت بطل الفيلم الوثائقي “حارس الثورة عبدالباسط الساروت” من إنتاج قناة أورينت.
في نهاية عام 2014 وبعد خروجه مع مقاتلي المعارضة من مدينة حمص إلى ريفها، وفق إتفاق فك الحصار، سرت اشاعات عن مبايعة الساروت “بيعة قتال” لتنظيم “الدولة الإسلامية”. وعلى الرغم من أن التنظيم لم يعلن ذلك الأمر، فقد لاحقت “جبهة النصرة” كتيبة الساروت في ريف حمص، واندلعت بينهما معارك متعددة.
أواخر آب 2015، ظهر الساروت في تسجيل مصور، أكد فيه عدم مبايعته لـ”داعش” ولا أي فصيل أو جبهة، وأن هدفه الأساسي هو إسقاط نظام الأسد فقط.
واضطر الساروت للذهاب إلى تركيا، هرباً من مطاردة “جبهة النصرة” التي كانت ترى في شعبيته خطراً عليها، وحاولت مراراً استقطابه لصفوفها. وبعد عودته من تركيا مثل الساروت أمام “المحكمة الشرعية” التابعة لـ”جيش الفتح” الذي كانت “النصرة” أحد مكوناته. وبعد تثبت براءته، عاد الساروت كقائد ميداني.
في العام 2011، كتب أسامة محمد، في وصف الساروت، حارس المرمى، وهو ينشد للثورة: “حينَ يفتح الساروت ذراعيه على اتساعهما ويَفْرِد كفيّه… تستيقظُ ذاكرةُ الجَسَد… فيتذكر ضربةَ الجزاء”. فهو “حارسُ المرمى… ذكاءٌ وحساسيّة ومرونة وريفلِكس. والسرعة والارتقاء والقراءةُ والتوقيت. وميزات أخرى، أصعَبُها الهدوء الشديد والانقضاضُ الخاطِف… وأهَمُّها اتخاذ القرار… في كل جزء من كل لحظة. لا يطيرُ الحارس لِيَلمسَ الكرة بطرف إصبعه لأنها كرةٌ مطاطيّة… لا أحدَ يَعْرفُ مُخَيّلَتَهُ”.
“حين يبسط الساروت ذراعيه على اتساعهما ويفرد كفيّه يتَذَكَّرُ جَسَدُهُ ضربة الجزاء. هكذا، يقف في المرمى حارس شباب سوريا. وربما… حارس مرمى منتخب شباب الثورة”.
“حين يفرد حارس المرمى ذراعيه وكفيه… يُغْلِقُ الفراغ. ويجعل المهاجمَ أمام خياراتٍ أصعبَ. تلك حركة الأُمَّهاتْ في الذودِ عن أبنائها”.
“لم يكن عبدالباسط يَدري إذ يبسط ذراعيه… أنَّهُ يَحْرِسُ الهوى والهواء… أبوابَ حمص السباعَ وهودَ وعمرو. وإنشاءاتِها وبيّاضَتها ووعْرَها… أحياءها… وأمواتها”.
زمان عبد الباسط
تلتقي في الحِداد على عبد الباسط الساروت ثلاثة أطوار من الفجيعة، قد تظهر سويّة أو بشكل منفرد تبعاً للموقف. من جهة، نجد الحزن المباشر على شاب في السابعة والعشرين من عمره، استشهد خلال معارك صدّ تقدّم النظام في ريف حماة الشمالي بعد ثمان سنوات من الانخراط الكامل في الثورة، حزنٌ تتضاعف معالمه عند من عرفه بشكل شخصي؛ ومن جهة ثانية، نجد، عند جمهور أعرض، حزناً محمولاً على عودة صادمة وحزينة للحظات التأسيسية للثورة السورية وأطوارها الأكثر جماهيرية عامي 2011 و2012، وهي مرحلة صُبغت بصوت الساروت منشداً في مظاهرات أحياء حمص. الكثير من هؤلاء لم يكن لديه أي فكرةٍ عن مآل الساروت بعد حمص، وبعضهم لم يعد قادراً على متابعة الأخبار بشكل عام، لكنّ سنة 2011 مؤسِّسة بالنسبة لهم بقدر ما هي مؤلمة، وبقدر ما هي ضرورية؛ ومن جهة ثالثة، نرى تفجّعاً غاضباً على الحرب التي أُعلنت على الساروت منذ اللحظات الأولى لإعلان استشهاده من قِبل سرديّة أسديّة مهووسة بتحطيم أي معنى وذاكرة وتفكير خارج اتهامات «الإرهاب» المسعورة، حربٌ تعزّزت بحرب إلكترونية منسّقة بإحكام، أدّت إلى حذف كثير من الصور والمنشورات الناعية للساروت على فيسبوك، وحظر كثير من حسابات الذين تمسّكوا بالنشر عن الساروت على الشبكة الاجتماعية. لم تكن هذه الحرب نقاشاً حول رمزية ومعنى الساروت، ولا تفحّصاً لموقف إشكالي له هنا، أو تصريح مُدان بدر عنه هناك، بل كانت حرباً على كلّ سردية أُخرى تخالف رواية النظام عن «إرهاب» و«إجرام» كلّ، كُلّ من قام ضدّه.
أمام هذا الواقع، رأينا أن أفضل ما يُمكن لنا تقديمه، في هذا الفصل المتجدد من حِدادنا المديد، هو أن نحاول تجميع فصول قصّة الساروت بأكمل صورة استطعنا الوصول إليها خلال الأيام الماضية، دون ادّعاء أنها تشمل كلّ الحكاية، بل على العكس، نودّ لو تكون أي نواقص ممكنة فيها دافعاً لكي يروي الآخرون هذه الأجزاء، فتُحفَظَ خارج هشاشة بوستات الفيسبوك المؤقتة، أو أحاديث الشفاهة الزائلة. إن أفضل إنصاف للساروت هو السعي لرواية حكايته وتفحّصها دون تبجيلٍ فائض ولا تحامل غير موضوعي ومع ضمان امتلاكنا نحن، أهل الثورة لها، لنسترجعها ونفككها وننقدها ونُراجعها، ونحميها ونحمي أنفسنا من العداء الإبادي المسكوب عليها وعلينا.
وعدا الجانب الشخصي، المباشر، الخاص بحياة الساروت وخياراته وقراراته -اتفقنا مع كلّها أو بعضها، أو اختلفنا- ففي قصّته ملامح من قصّتنا جميعاً: هذا نحنُ، هذه سيرتنا، وهذه مساحات قلقنا وحيرتنا وتخبّطنا، وهذا حِصارنا، وهذه فجيعتنا. وأيضاً، ما تلقّاه الساروت من هجوم أسديّ مسعور، وصل إلى حد ملاحقة منشورات فيسبوكية لحذفها وحظر أصحابها، هو فصل من فصول الحرب علينا جميعاً -بما في ذلك أولئك الذين لهم آراء سلبية بالساروت، أو مواقف متوجسة من أيقَنة غير نقدية له-، على حاضرنا، وعلى ذاكرتنا وقصّتنا، أي على مستقبلنا.
******
ولد عبد الباسط الساروت عام 1992 في حي البياضة الحمصي، واحدٌ من أحياء العشوائيات الفقيرة الكثيرة التي راحت تنتشر في مدن سوريا الرئيسية وعلى أطرافها، حتى وصل الأمر إلى حد أن نحو نصف سكان مدينتي حلب ودمشق كانوا يعيشون قبيل العام 2011 في أحياء سيئة التنظيم أو عشوائية بالكامل، جعلت من حياتهم اليومية كابوساً متكرراً على مدى أعمارهم.
وقد كان لمدينة حمص نصيبٌ كبيرٌ من سوء الإدارة والفشل الحكومي خلال سنوات حكم الأسد الأب، إذ راح حزام الفقر العشوائي المحيط بها يتضخم منذ أواسط الثمانينات، وصارت الأحياء الصغيرة التي بناها الوافدون الجدد دون تخطيط حكومي تكبر تدريجياً، ومنها حي البياضة إلى الشرق من أحياء المدينة القديمة، الذي بناه أبناء عشائر حمص الشرقية أول الأمر، ثم راح يتوسّع تدريجياً في ظل غياب التنظيم والإهمال الحكومي وسياسات الإفقار التي تزايدت بعد وراثة الأسد الابن للحكم مطلع القرن.
تعرّض حيّ البياضة لإهمال مضاعف في السنوات الأخيرة التي سبقت بداية الثورة، إذ حاول محافظ حمص منع توسّع الحي من خلال وقف منح تراخيص لتركيب ساعات الكهرباء والمياه؛ عن هذا يقول مازن غريبة، ناشط مجتمع مدني من أبناء حمص: «كان يمكنك أن تشاهد أبنية كاملة في حي البياضة يسكنها الناس من دون كهرباء، كانوا يضعون الطعام على الشرفات كي لا يفسد».
في ظروف كهذه عاش الساروت سنوات طفولته وشبابه الأولى، لم يتمكن من متابعة تعليمه، واضطر بدلاً من ذلك للعمل مبكراً في نقل أحجار البناء والحديد، بالتزامن مع انضمامه إلى نادي الكرامة الحمصي، ثم بروزه بعدها كحارس مرمى مميز، حتى تم اختياره ليكون حارس فريق شباب الكرامة، وحارس منتخب سوريا للشباب. ولكن هذا لم يكن كافياً في سوريا كي يعيش المرء حياة كريمة ومضمونة من الناحية الاقتصادية، إذ لم يكن راتب الساروت الشهري من نادي الكرامة يتجاوز الألف وخمسمئة ليرة سورية، أي ما يعادل 30 دولاراً في ذلك الوقت، كما يقول مازن غريبة، الذي يتذكر جيداً أن أبناء البياضة ومن بينهم عبد الباسط، كانوا محركاً رئيسياً للتظاهرات التي بدأت تخرج منذ أواخر آذار/مارس 2011 في أحياء عديدة بالمدينة مثل الخالدية ودير بعلبة والبياضة نفسها.
ربما يكون أول فيديو انتشر على نطاق واسع للساروت هو ذاك الذي تم تصويره في حي البياضة مطلع حزيران/يونيو 2011، يظهر فيه واقفاً على الأكتاف يهتف لمدن سوريا واحدة واحدة مبشراً بامتداد الثورة. وقد كان الخيار وقتها أن يتم تمويه وجه الساروت حماية له من بطش المخابرات السورية، لكن الأمر لم يطل حتى بات الجميع يعرفون أن صاحب الصوت الحنون والقوي في آن معاً هو عبد الباسط، حارس مرمى منتخب سوريا للشباب.
تتالت بعدها الفيديوهات التي يظهر فيها الساروت، دون تمويه وجهه، يهتف بالجموع في شوارع حمص ضد النظام؛ وفي الوقت الذي كان فيه معظم المتظاهرين لا يزالون يتجنبون الكشف عن وجوههم أمام الكاميرات كي لا يصبحوا هدفاً لحملات الاعتقال التي تنفذها أجهزة الأمن، أصبح وجه الساروت وجهاً لكل المتظاهرين، وأصبح صوته تكثيفاً لأصواتهم جميعاً.
«عندما كان المتظاهرون يعرفون أن الساروت سيهتف في أحد المظاهرات، كانوا يذهبون مباشرةً إليها، كانت الأعداد تتضاعف بمجرد وجوده»، هكذا يصف مازن غريبة تأثير عبد الباسط على مظاهرات المدينة. ولا يمكن فصل الشعبية الواسعة التي حاز عليها مبكراً عن كونه واحداً من لاعبي فريق الكرامة الحمصي، مع ما يعنيه ذلك في مدينة تتمتع كرة القدم، وفريق الكرامة على وجه الخصوص، بحضور واسع فيها. وائل عبد الحميد هو واحد من أبناء حمص، وأيضاً من مشجعي فريق الكرامة وجمهوره العريض في المدينة، وهو يقول إن «طريق عبد الباسط الساروت الكروي كان واضحاً، فهو كان أبرز حراس سوريا الشباب، وكان يستعد ليكون حارس فريق الكرامة الأول، وعلى الأرجح حارس المنتخب السوري الأول، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار تاريخ فريق الكرامة، الذي قدّم للكرة السورية عدداً من أبرز حراس المرمى. وقد كانت مشاركة عبد الباسط في الثورة بالنسبة لي كواحد من جمهور النادي أمراً بالغ الأهمية، لأن الانتماء لنادي الكرامة كان جزءاً من تعريفنا لأنفسنا، وكان حضور لاعبين منه في ميادين الثورة أمراً حيوياً بالنسبة لنا».
كذلك لا يمكن فصل شعبية الساروت عن صوته المؤثر والأهازيج والهتافات التي كان يبتكرها، وعن تصديه الشجاع لمهمة الصعود على الأكتاف، التي تعني جعله هدفاً للنظام وأجهزته الأمنية. وبالفعل راحت وسائل إعلام النظام السوري والصفحات الموالية له على فيسبوك تتداول اسم الساروت بوصفه إرهابياً سلفياً، وهو ما دفعه للظهور في فيديو أواسط تموز 2011 ينفي فيه هذه التهم، ويؤكد على رفضه للطائفية وعلى أنه واحد من المتظاهرين السلميين في البلاد، ومنذ تلك اللحظة راح اسمه يتكرس بوصفه واحداً من قادة الثورة في المدينة، ومن أبرز المطلوبين لأجهزة النظام الأمنية فيها.
وجد عبد الباسط الساروت نفسه خريف 2011 في قلب أحياء شبه محاصرة، بدأت تظهر فيها مجموعات مسلحة بشكل متواضع تحت مسمى الجيش الحر، تحمي الأزقة التي تخرج فيها المظاهرات من هجمات النظام الدموية، الذي كان قد بدأ بتقطيع أوصال المدينة ونشر الحواجز العسكرية على الطرقات ومداخل الأحياء. كما وجد نفسه أيضاً في قلب استقطاب طائفي حاد، تنقسم فيه المدينة إلى أحياء ذات غالبية علوية مؤيدة للنظام، وأحياء ذات غالبية سنية مناهضة له، وبالتوازي مع مسار الثورة التي راحت تتسلح رويداً رويداً للدفاع عن نفسها ضد آلة دموية لا ترحم، وترتفع فيها رويداً رويداً شعارات دينية ذات صبغة طائفية، كان هناك مسار من النزاع الطائفي المتصاعد وأعمال القتل والخطف المتبادل.
تكتسب سيرة الساروت واحداً من أبرز وجوه استثنائيتها من تلك الأيام، التي راح يظهر فيها منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 إلى جانب الممثلة السورية الراحلة فدوى سليمان، التي تنحدر من أصول علوية، يهتفان معاً ضد النظام، وهو ما كان رسالة مناهضة للاستقطاب الطائفي، وفي الوقت نفسه بداية لمسار سيصبح فيه الساروت تحت المجهر، في كل أقواله وأفعاله وأناشيده.
في أواخر العام 2011، كان الساروت قد شهد دفن عدد كبير من رفاقه وأبناء حارته البياضة، وفقد أيضاً أول إخوته وأكبرهم، وعدداً من أقربائه وأصدقائه، في أحد الاقتحامات التي نفذها عناصر أمن النظام في الحيّ. ثم كانت الأشهر الأولى من العام 2012 أشهر التحول الحاسم نحو العسكرة، وشهدت مزيجاً من المواجهات المسلحة التي قادت إلى تحرير أحياء عديدة في حمص من قبضة النظام، ومن المظاهرات الحاشدة التي باتت أشبه بكرنفالات ضخمة، يتوسط الساروت كثيراً منها بأغنيات وأناشيد باتت معلماً أساسياً من معالم الثورة، من بينها جنة يا وطنا وحانن للحرية حانن، اللتين اقترنتا باسمه.
تحولت حمص تدريجياً إذن إلى ساحة حرب مفتوحة، وارتكبت ميليشيات تابعة للنظام مذابح قتل طائفي مروعة في عدة أحياء منها، استخدمت فيها السلاح الأبيض في تصفية المدنيين، كما نفذ جيش النظام عشرات الهجمات والاقتحامات على الأحياء المتمردة، مستخدماً الصواريخ والمدفعية والدبابات، ولاحقاً الطائرات، ونجح في السيطرة على عدد منها تباعاً، بما فيها حي البياضة الذي تم تدمير أجزاء واسعة منه وتشريد معظم أهله، بالتزامن مع فرض حصار تدريجي على بقية الأحياء، عبر قطع الطرقات والمنافذ بشكل مباشر أو برصاص القناصة.
كان واضحاً في ربيع 2012 أن النظام يسعى عبر العنف المعمم إلى قتل وتشريد أكبر قدر ممكن من سكان الأحياء الثائرة، وإلى عزل وحصار المناطق التي لا يستطيع السيطرة عليها عسكرياً، وفي وقتٍ ما من تلك الأيام الدامية، وإلى جانب مواصلته الغناء والهتاف في التظاهرات، كان الساروت قد تحوّل إلى حمل السلاح في صفوف مجموعة عسكرية ستحمل اسم كتيبة شهداء البياضة، وشارك في محاولة لاستعادة الحيّ من قبضة النظام، وأصيب فيها برصاصة في قدمه.
في أواسط حزيران/يونيو 2012 كان النظام قد نجح تقريباً في تطويق أحياء المدينة القديمة، التي لم يعد يربطها بالعالم الخارجي سوى طرقات قليلة مرصودة برصاص القناصة، لا تصلح لتأمين كميات معتبرة من الغذاء والدواء والذخيرة، ليبدأ بهذا ما سيعرف لاحقاً بحصار حمص القديمة. كانت المدينة قد فقدت المئات من أبنائها وبناتها في أعمال القمع العنيف والمعارك، وكان عشرات الآلاف من سكان أحياء قلب المدينة قد نزحوا منها إلى مناطق أخرى في حمص وأنحاء سوريا والعالم تحت وطأة القصف، ليبقى في قلب الحصار بضعة آلاف من المدنيين وبضعة مئات من المقاتلين.
حاول عبد الباسط ورفاقه كسر الحصار مراراً دون فائدة، ثم اتخذَ القرار بالخروج من مدينة حمص مع عدد من رفاقه عبر أنفاق وقنوات الصرف الصحي إلى ريفها الشمالي، آملاً بالحصول على مساعدة لمواجهة الحصار الذي كان يزداد إحكاماً. يقول الناشط السياسي خالد أبو صلاح، وهو من أبناء مدينة حمص، إن الساروت «كان يريد تأمين مساعدة عسكرية تؤدي إلى كسر الحصار في أحسن الأحوال، أو تأمين ما يلزم من غذاء وذخيرة لمواجهة الحصار على أقلها، لكن محاولاته تلك لم تسر على ما يرام، لم يحصل على المساعدة اللازمة، ولم يبدُ أن هناك ما يمكن له القيام به من الخارج من أجل كسر الحصار».
في خريف 2012، اتخذ الساروت مع عدد من رفاقه قرارهم بضرورة كسر الحصار بأي وسيلة كانت، أو العودة إلى داخل حمص للمشاركة في مقاومة الحصار على الأقل، في وقت كان النظام قد كشف الأنفاق كلها ونجح في إغلاقها. مضى عبد الباسط مع بضعة عشرات من رفاقه، وخاضوا معركة انتحارية لم يتمكنوا بنتيجتها من كسر الطوق. استشهد عدد من المقاتلين، وفُجع الساروت بفقدان الأخ الثاني له، وأصيب هو نفسه برصاصة في قدمه مجدداً. وقد وثّقَ فيلم العودة إلى حمص لطلال ديركي تلك الأيام، وفي آخره يظهر الساروت ممداً على سرير، وهو يستفيق من أثر المخدر بعد عملية جراحية. وفي تلك المسافة الفاصلة بين الصحو والنوم نتيجة تأثير المخدر، كان يصرخ على نحو فجائعي طالباً من المحيطين به عدم تضييع دماء الشهداء، ومردداً أنه لا يريد شيئاً في الدنيا سوى كسر الحصار: «دبحوني بس افتحوا طريق للعالم».
بعد مرور فصل الشتاء، وبعد أن تعافت قدمه من إصابتها، أعاد الساروت ورفاقه المحاولة، ونجحوا ربيع 2013 في كسر الطوق والعودة إلى قلب الحصار، دون أن ينجحوا في فتح طريق يمكن استخدامه لتنقل الأفراد والغذاء والذخيرة. بعدها راح الحصار يصبح أكثر إحكاماً وقسوة، حتى وصل الحال بالمحاصرين إلى أكل أوراق الشجر ولحم القطط.
لم يتوقف الساروت عن الغناء والقتال معاً في أي وقت، ومن داخل حمص المحاصرة كان هناك فيديوهات عديدة يظهر فيها مغنياً في سهرات مع رفاق السلاح، ربما يكون أشهرها أغنية لاجل عيونك يا حمص. وفي تلك الفترة أيضاً راحت تظهر أكثر فأكثر في أغنياته وأحاديثه عبارات ذات ارتباط بعالم السلفية الجهادية الرمزي، وعبارات ذات أبعاد طائفية بالغة الوضوح، فيما يبدو اقتراباً من عوالم الجهادية التي كانت تشهد صعوداً في عموم البلاد، بعد الخذلان الذي تلا مذبحة السلاح الكيماوي في الغوطة على وجه الخصوص، وانهيار الإطار الوطني للصراع في سوريا.
منذ أواخر 2013، راحت تتردد أحاديث عن عملية تفاوضية تفضي إلى إخراج المقاتلين والمدنيين المحاصرين من حمص عبر اتفاق مع النظام، وقد كان الساروت ورفاقه في كتيبة شهداء البياضة من الأطراف الرافضة لفكرة الخروج، ولكن هذا الرفض لم يكن لفظياً فقط، لكنه تجسّد واضحاً في المعركة المعروفة بمعركة المطاحن أوائل كانون الثاني/ديسمبر من العام 2014، عندما حفر المقاتلون نفقاً باتجاه منطقة المطاحن بهدف كسر الحصار، أو نقل أكياس الطحين على أقل تقدير إلى قلب الأحياء المحاصرة.
انتهت تلك المحاولة الانتحارية بفاجعة كبيرة، فشلت العملية، وفارق أكثر من ستين شاباً من مقاتلي كتيبة شهداء البياضة حياتهم، من بينهم اثنان آخران من أشقاء الساروت، ليكون قد فقد بذلك أربعة من إخوته على يد النظام السوري. هكذا فشلت آخر محاولات كسر الحصار إذن، وترافقت مع أحاديث كثيرة عن خيانات وتخاذل من داخل أحياء حمص المحاصرة، ومن الفصائل المتواجدة في ريف حمص الشمالي، التي كان يُنظر لها على أنها لم تبذل جهداً لكسر الحصار. وقد خرج الساروت في فيديو بعد ذلك، رافضاً توجيه الاتهامات لأحد، وداعياً إلى تجاوز الأخطاء التي لم يحددها، وإلى توحيد الصفوف.
ظهر عبد الباسط بعدها في فيديوهات عديدة يعلن رفضه لفكرة الخروج من حمص، معتبراً أن هذا الأمر ناتجٌ عن تخاذل العالم كله بما فيه الجهات المعارضة التي كانت تفاوض على شروط الخروج. وفي أواسط شباط/فبراير 2014، ظهر في فيديو يهتف فيه في حشد صغير من الناس ضد فكرة التفاوض أو الخروج من حمص أو عقد مصالحة مع النظام، ويصلح هذا الفيديو علامة على التحولات الكبرى التي أصابت الشاب المفجوع بمدينته وإخوته ورفاقه. لا تظهر في الفيديو سوى الرايات السلفية البيضاء والسوداء، ومعها الرهان على قوة السماء وحدها في إنقاذ حمص من مصير السقوط والتهجير، وتأكيدات على أن حمص لا ينبغي أن تسير على طريق مناطق أخرى عقدت اتفاقات هدنة مع النظام مثل برزة والمعضمية قرب دمشق.
في أيار/مايو 2014، بعد أقل من ثلاثة أشهر على ذاك الفيديو، كانت باصات النظام الخضراء تنفذ أول عملية تهجير قسري في سوريا، وتخلي أحياء حمص من المقاتلين والمدنيين الباقين فيها نحو ريف حمص الشمالي. لم يظهر الساروت في أي صورة أو فيديو من الفيديوهات الكثيرة التي صورت المقاتلين والمدنيين أثناء خروجهم، وكان واضحاً أنه وافق في النهاية مرغماً على الخروج، بعد أن وافقت أغلبية المحاصرين عليه إذ لم يعد ثمة بديل عنه سوى الموت جوعاً أو بالرصاص والقذائف.
قبل ساعات من الخروج، كان الساروت قد تحدّثَ في فيديو تم نشره لاحقاً بحزن وانكسار غير معهود في فيديوهات سابقة له، قائلاً إن لديه عتباً على جبهة النصرة وداعش، لأنه كان يعتقد أن لهما أهداف المحاصرين نفسها، موجهاً اللوم إلى قطاعات في التنظيمين على اتهامها لثوار حمص المحاصرين بأنه «حشاشون وكفرة»، مستخدماً عبارات تقول إن حمص ينبغي أن لا تُترك كي يسكنها «العلويون والنصارى والشيعة واللبنانيون والعراقيون».
يقول هذا الفيديو أشياء كثيرة ينبغي الوقوف عندها، أولها أن اتهام النصرة وداعش للساروت ورفاقه بأنهم كفرة يعني أنهم لم يقبلوا الانضمام إلى أي من هذين التنظيمين قبلاً، وأن الساروت لديه هدفٌ مركزي هو إسقاط النظام بالقوة، وهو ما عبّر عنه في هذا الفيديو وغيره بالقول إنه يرفض «التسيّس»، قاصداً رفضه الانضمام إلى أي جهة تحمل أي مشروع سوى قتال النظام. لكن بالمقابل، يبدو واضحاً أن الساروت كان غارقاً في خطاب القوى الإسلامية والسلفية، بما فيه العمل على تحكيم شرع الله في الأرض وفق تعبيره في الفيديو نفسه، وأنه بات يرى في الصراع مع النظام صراعاً دينياً وطائفياً، ينبغي أن يتحالف فيه «المسلمون» جميعاً ويتكاتفوا، بمن فيهم النصرة وداعش، أيضاً على حد قوله في الفيديو نفسه.
تنقّل الساروت خلال وجوده في ريف حمص الشمالي بين عدة مواقع وجبهات منها الدار الكبيرة والرستن وغيرها من بلدات المنطقة، ولأن الريف الشمالي كان محاصراً بدوره، كانت أوضاع الفصائل داخله صعبة للغاية. يقول سامر الحمصي، وهو ناشط إعلامي من منطقة الحولة في ريف حمص الشمالي، للجمهورية: «كان المقاتلون يعانون نقصاً كبيراً في التسليح، لم يكن لديهم سلاح ثقيل كافٍ لمواجهة عدة وعديد النظام، الذي كان يحاصرنا من أغلب الاتجاهات. وقد أدت سيطرة تنظيم داعش على منطقة عقيربات في البادية شرق ريف حمص الشمالي إلى قدرته على إدخال المال وبعض السلاح لعناصره القليلين في المنطقة».
كان عبد الباسط قبيل تلك الفترة قد اشترك في تأسيس فيلق حمص، وهو فصيل رفع علم الثورة، ولم يكن له أي توجهات إيديولوجية كما يقول خالد أبو صلاح، الناشط السياسي من مدينة حمص وصديق الساروت، الذي يضيف أن هدف الساروت وقتها «كان العودة لتحرير مدينة حمص، إلا أن الظروف الصعبة وعدم فاعلية الفصائل في الريف تجاه هذا الهدف، دفعته للعمل هو ومجموعته منفردين، وتنفيذ عمليات خاطفة ضد قوات النظام على تخوم المنطقة للاستيلاء على أسلحة ومواصلة القتال».
في تلك الفترة، يقول أبو صلاح، قام أحد الأشخاص بالتواصل مع الساروت، واعداً إياه بتقديم السلاح مقابل مبايعة تنظيم الدولة، وقد أعلن الساروت أمام هذا الشخص عن استعداده لمبايعة التنظيم، كما أقرّ هو نفسه لاحقاً في أكثر من مناسبة، على أن يكون ذاك من أجل محاربة النظام فقط، وهو ما كان يعرف بـ «بيعة القتال»، المصطلح الذي شاع في أوساط الفصائل السورية، والذي يعني أن البيعة تشمل التعاون في قتال النظام فقط، دون الإنضواء في الجسم التنظيمي والمشروع السياسي.
لم تدم العلاقة بين الطرفين سوى بضعة أسابيع، قام بعدها الساروت بقطع علاقته تماماً مع ذلك الشخص وكل الجهات التي كانت قد أعلنت استعدادها لمبايعة التنظيم في الريف الشمالي، ويضيف أبو صلاح أنه «عندما دخل شرعيون من تنظيم الدولة لاحقاً إلى منطقة الريف الشمالي، وطالبوا الساروت ببيعة التنظيم، رفض ذلك واتخذ موقفاً شديداً تجاههم»، ليقوم بعدها بالإعلان عن استقلال كتيبة شهداء البياضة عن أي تنظيم أو جهة في تسجيل مصور في شهر آب/أغسطس من العام 2015. لاحقاً، وخلال وجود الساروت في اسطنبول بعد خروجه من الريف الشمالي وسوريا، سجّلَ خالد أبو صلاح لقاءً مطولاً معه يشرح فيه ملابسات القصة كاملة، قال فيه إنه تراجع عن فكرة المبايعة عندما تبين له أن مشروع التنظيم هو حكم سكان المنطقة وليس قتال النظام، وعندما شاهد تجاوزات وأخطاء، لم يحددها، يرتكبها أشخاص مقربون من التنظيم أو محسوبون عليه. كما قال في لقاء لاحق مع تلفزيون أورينت مطلع 2018 إنه تراجع عن فكرة مبايعة التنظيم، بعد أن عرف أن الأخير قادم «لقتال الثوار والمسلمين والناس الذين كانوا معي في الحصار».
رغم نفيه مبايعة التنظيم، تعرّض الساروت لمضايقات من الفصائل في المنطقة، وعلى رأسها جبهة النصرة، وقادت تلك المضايقات في النهاية إلى حملة ضد كتيبته راح ضحيتها تسعة من رفاقه في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2015، وانتهت بأن غادر الساروت ريف حمص الشمالي، ثم غادر سوريا كلها إلى تركيا أوائل العام 2016.
في تركيا تنقل الساروت بين غازي عنتاب واسطنبول، وشارك هناك في مظاهرات مناصرة لمدينة حلب التي كان النظام قد حاصر أحياءها الشرقية وباشر اقتحامها وتهجير أهلها أواخر 2016. يقول خالد أبو صلاح إن عبد الباسط لم يكن يريد البقاء في تركيا، إلا أن تهديدات جبهة النصرة باعتقاله منعته من العودة، متابعاً أنه «بعد سقوط حلب بيد النظام بدأت التظاهرات تعود للشمال، وقمنا عبد الباسط وأنا بالدخول إلى سوريا والمشاركة فيها. ورغم أنني قمتُ بالعديد من الوساطات بمساهمة شخصيات حمصية معروفة لدى الفصائل، إلا أن أحرار الشام وجبهة النصرة كانوا مصرين على اعتقاله». وبالفعل، بعد بضعة أشهر من عودته إلى سوريا، قامت دورية تابعة لهيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) باعتقاله، وحبسه في السجن الانفرادي لمدة 37 يوماً، ليتم إطلاق سراحه بعدها نتيجة وساطات أهلية بحسب أبو صلاح.
بعد خروجه من معتقلات النصرة، قرر عبد الباسط الذهاب مع عدد من رفاق مجموعته الأولى، كتيبة شهداء البياضة، إلى ريف حماة الشمالي، وذلك لإقامة مقرات على الجبهات، التي كانت أقرب مكان إلى حمص يمكنه الوصول إليه. وقد شارك باسط ورفاقه في معارك عديدة هناك إلى جانب مختلف الفصائل، ولكن بشكل مستقلّ، إلى أن انضموا في الأيام الأخيرة من العام 2017 إلى جيش العزة، أحد فصائل الجيش الحر العاملة في ريف حماة الشمالي. يقول أبو صلاح للجمهورية: «كان عبد الباسط يقول إن هذا فصيلٌ لا يملك أمنيات وسجوناً (…) نحنا ما منحكم المدنيين، نحنا مندافع عنهم».
يبدو اختيار الساروت لجيش العزة استمراراً لمجمل مسيرته التي كان أبرز معالمها هو التركيز على هدف إسقاط النظام السوري، ويُعرَف فصيل جيش العزة بأنه رفض المشاركة في أي قتال ضد فصائل أخرى مناهضة للنظام، بما فيها تنظيم الدولة وجبهة النصرة، وبأنه لم يعمل على السيطرة على السكان وحكمهم بنفسه في مناطق انتشاره في أي وقت، وبأن لديه ميولاً وخطاباً إسلامياً واضحاً، لكنه بقي ملتزماً علم وتسمية الجيش الحر حتى اللحظة، وأخيراً بأنه كان من الفصائل التي أعلنت مراراً رفضها لتفاهمات أستانا وسوتشي الروسية التركية، وإن كان قد التزم بها ضمنياً.
بقي الغناء والهتاف حاضراً في حياة الساروت دوماً، يظهر حيناً منشداً شعراً حماسياً على رفاق السلاح في الجبهات، وحيناً آخر مغنياً أو هاتفاً في جموع المتظاهرين في معرة النعمان وغيرها، وحتى لحظات حياته الأخيرة، لم يكفّ يوماً عن القيام بكل ما يمكنه القيام به في سبيل مواجهة النظام.
خلال المعارك الأخيرة التي دارت في ريف حماة الشمالي والغربي، كان الساروت مشاركاً على الجبهات مع جيش العزة، وقد ظهر في فيديو يتحدث فيه عن تقدم فصائل المعارضة في منطقة تل مَلَح. يقول خالد أبو صلاح إنه «بعد تحرير المنطقة الممتدة بين تل مَلَح والجبيّن، وصل خبر للساروت وهو على الجبهة عن إصابة مجموعة نتيجة قصف في الخطوط الخلفية، فقرر الذهاب بسيارته لإسعافهم. عند تشغيل السيارة تعرض المكان لقذيفة، إلا أن أحداً لم يُصَب بإذى، لكن في المرة الثانية عندما تحركت السيارة أصيبت بقذيفة مجدداً، وأصيبَ الساروت بجراح في البطن والساق والذراع، أُسعف على إثرها إلى نقطة طبية في خان شيخون».
بعدها أراد المسعفون أن ينقلوه إلى مستشفى الدانا في ريف إدلب الشمالي، لكنه تعرّض لنزيف حاد أجبر المسعفين على التوقف في معرة مصرين لنقل الدم له، ومن ثم نقله مجدداً إلى الدانا. يقول أبو صلاح إنه تمت السيطرة على الإصابة في مستشفى الدانا، ومال وضعه للاستقرار، عندها تم نقله يوم الخميس السادس من حزيران/ يونيو عن طريق معبر باب الهوى إلى مشفى في الريحانية ومن ثم أنطاكيا في تركيا، لكن وضعه عاد للتدهور بعد ذلك، ويعزو أبو صلاح هذا إلى نقله المتكرر ونزفه الشديد للدماء.
صبيحة يوم السبت الثامن من حزيران 2019، استشهد عبد الباسط الساروت متأثراً بجراحه، ليختم بموته حياة قصيرة وملحمية عامرة بالتحولات والمعارك والدماء، ويُنقَل جثمانه بعدها إلى داخل سوريا ليدفن في مدينة الدانا بريف إدلب. وقد حملت أكتاف المشيعين جسد الساروت الشهيد، بعد أن اعتادت أن تحمل جسده الحيّ ليقود هتافات المتظاهرين وأغانيهم؛ وبدل أن يهتفوا معه كما جرت العادة، هتفوا له وهو يُدفن بعيداً عن حمص التي قضى سنواته الأخيرة مقاتلاً في سبيل فك الحصار عنها، ثم العودة إليها بعد التهجير.
*****
رغم ما يظهر في سيرة الساروت من اندفاع شديد واستعداد دائم لاقتحام الموت دون تردد، إلا أن السيرة نفسها تقول أيضاً إن سنوات حياته الأخيرة لم تكن انجراراً أهوجاً نحو الموت، بل كان ذلك كله مبنياً على قرار واعٍ بخوض التحديّ حتى النهاية؛ كانت ثورته مواجهةً، لا مجرد انفجار طارئ، وبهذا المعنى فإن الساروت قد امتلك مصيره، وسار في الدروب التي سلكها بناءً على مزيج من التفكير والانفعال، ودليلُ ذلك الأشهر الطويلة التي قضاها مصاباً مثلاً في ريف حمص الشمالي، ليعود بعدها إلى تكرار الأمر نفسه الذي كان قد أدى إلى إصابته.
القصد من هذا القول هو الإشارة إلى أن كثيراً من الدفاع عن الساروت وسيرته، جاء مستنداً إلى «بساطته»، وإلى القول إن الظروف قادته مجبراً لا مختاراً إلى كل الدروب التي سلكها. وفي هذا القول اتجاهٌ إلى نزع الأهلية عنه، على نحو لا تُصادِق عليه أقوال الرجل وأفعاله وحكايته. لم يكن الساروت بسيطاً، إذا كان المقصود بالبساطة هنا أنه لم يكن يدرك معنى وأبعاد ما يقوم به أو ما يقوله، وليس صحيحاً أنه لم يختر طريقه بإرادته، لأنه مهما كانت الظروف الموضوعية بالغة القسوة والقهر، يبقى أن الإرادة تتفاعل معها وتختار طريقها في المساحات المتاحة، قلّـت أم كثرت. الظروف التي عاشها الساروت لم تكن ظروفه وحده، لكن مصيره وطريقه لم يكن مصير وطريق جميع من عاشوا معه الظروف نفسها.
لكن الصحيح أيضاً أن الساروت لم يكن يملك العدة الفكرية والنظرية الكافية التي تساعده على التعبير عن كل أفكاره، أو على التفكير المنهجي في ظروفه واتخاذ قراراته على أساس ذلك، فحتى عند اقترابه من الخطاب السلفي بقيت نواة كلامه متمحورة حول أفكار «النخوة» و«الشرف» و«الدفاع عن النفس والعرض والدم». ويظهر نقص العدّة الفكرية أيضاً في تكراره عبارة «رفض التسيّس»، أو عبارات من قبيل «نحنا ما حدا قادر يسيّسنا». تشير مجمل سيرة الشهيد وأقواله إلى أن ما كان يقصده هو رفض الخيارات التفاوضية مع النظام، ورفض الانضواء في أي مشروع للحكم وإدارة حياة الناس قبل إسقاط النظام، لكنَّ في قلب موقفه هذا سياسة واضحة، تذهب في نهاية المطاف إلى أن تكون عكس «رفض التسيّس»، عندما تظهر على شكل استعداد للتماهي مع أي جهة تناصب النظام العداء، مهما كان مشروعها السياسي فاقع الوضوح مثل داعش والنصرة. «التسيّس» عند الساروت كان اعتبار كلّ ما عدا الهدف الوحيد، تحطيم النظام الأسدي، إنما هو «دروب ملتوية»، في جذرية أحاديّة الوجهة، أمامها معركة واحدة واضحة التعريف ومستقيمة الطريق، وعدو واحد مُعرّف بالكامل وبشكل نهائي، وكل ما تبقّى هو «إلهاء» مرفوض، في طريقة تفكير تشبه تنظيرات غالبية الحركات الراديكالية المعاصرة بمختلف تلويناتها، رأت أمامها أميركا أو إسرائيل أو الرأسمالية العالمية أو «الطاغوت».
هل يعني هذا الكلام تبريراً أو تسويغاً أو مغمغة لخطاب ومظاهر ومواقف اتخذها عبد الباسط الساروت أو تبنّاها، ويرفضها كثيرون من أهل الثورة السورية -وكتّاب هذه الأسطر بينهم-، من خطاب مهادن أو إيجابي تجاه داعش وجبهة النصرة في مرحلةٍ ما، ومن تعبيرات منفعلة طائفياً؟ قطعاً لا. كما أنه لا يعني تجريماً لمن يرى أن هذه أمورٌ لا يمكن تخطّيها، أو لمن يرى أن شرح الساروت لملابساتها في تصريحات لاحقة ليس كافياً. هذه «مشكلتنا» نحن معه، ويا ليتنا كنا أحراراً من الإجرام الأسدي، وكان باسط على قيد الحياة بيننا، كي نتشاجر معه عليها يوماً ما، فإما تراجعٌ واعتذار، وإما فراق. حُرمنا، وحُرم باسط من هذا أيضاً.
إنصافاً أمام التاريخ والبلد، وأمام الموت والدمار والألم، ينبغي رفض التركيز على هذه المراحل منزوعةً من ظرفها والأجواء المحيطه به، ورفض تكرارها بشكل محموم بوصفها كلَّ حكاية الساروت، وحتى كلَّ حكاية الثورة السورية حسب تصوير الأسد واعتذارييه. هل مشكلة الأسديين، أو جريدة الأخبار، أو الإعلام البوتيني، أو مدبري الحملة الإلكترونية لمسح المحتوى الإيجابي بحقّ الساروت من على فيسبوك، أن الساروت قد قال هذا التصريح المتشدد في لحظة ما، أو رفع تلك الراية، أو شتم تلك الشتيمة الطائفية؟ قطعاً لا. مشكلتهم معه أنه قام ضد بشار الأسد، وهي نفسها مشكلتهم معنا جميعاً، سلميين وقتاليين، طائفيين ووطنيين ديمقراطيين، وهذه مشكلتهم مع الثورة السورية ككل، بكل ما فيها، وبكل من معها.
يبدو استشهاد الساروت اليوم وكأنه قد فتح نافذةً لنا جميعاً على ذاكرتنا عن 2011، عن أنفسنا وتصوراتنا في تلك اللحظة التي غيرتنا جميعاً، تلك اللحظة التي شعرنا فيها أننا نمتلك قرار تحديد مصيرنا، ونمتلك أصواتنا العالية والمبحوحة. ومن أجل هذا بالضبط، لأن الساروت هو رمز تلك اللحظات، يحاول الأسديون وحُماتهم أن يحرمونا منه ومنها. وقد كانت حملة النظام وحلفائه لمحو سيرة الساروت والكتابات عنه، علامة على ذعرهم من سيرة الثورة كلها، وعلى إدراكهم العميق لأهمية خوض معركة الحكاية، ولا نملك أمام هذا سوى أن نواصل إصرارنا على خوض هذه المعركة، والوقوف على توثيق تفاصيلها بكل ما يسعنا من حبّ وإنصاف، دفاعاً عن ذاكرتنا، عنا، عن 2011، وعن الثورة السورية ضد النظام الأسدي، وعن سوريا.
موقع الجمهورية
الصراع على رمزية عبد الباسط الساروت/ بكر صدقي
لم يكن مصرع عبد الباسط المأساوي مفاجئاً لأحد. فهذه هي الخاتمة المنطقية التي مضى إليها بتبصر وعناد منذ بداية الثورة. لم يكن بحاجة إلى أوهام إيديولوجية أو تحليلات سياسية أو توقعات مستقبلية ليدرك أن حربه غير المتكافئة مع الوحوش لا بد أن تنتهي بالاستشهاد الذي تمناه.
فقد كانت خيارات أخرى كثيرة أمامه، أبسطها الخروج من سوريا الميئوس منها، كما فعل كثيرون منا، وكانت مساهماته المكشوفة في الثورة كفيلة بأن تفتح له أبواباً لحياة مريحة في المنافي. لكنه لم يفعل. كانت لديه مهمة، وضعها بنفسه لنفسه، هي العمل، بكل ما يتاح له من وسائل، على محاربة النظام الساقط. وهي مهمة مستحيلة في الشروط التي وجد الساروت نفسه فيها، فكان الموت أمامه، بانتظاره في أي لحظة.
سيرة الساروت ملحمية بذاتها، وليست بحاجة إلى نسج أي أساطير مختلقة لتخليدها في رمز. هي سيرة الشاب المفعم بالعنفوان، البسيط، النقي، غير المفتقر إلى لحظات ضعف بشري، ولا إلى أخطاء بشرية، يعرف ما يريد، بلا تعقيدات أو لف ودوران، يعيش الشروط الفظيعة التي يجد نفسه فيها بصبر وثبات، لا يؤجر بندقيته لجهة كما فعل كثيرون، ولا تراوده أوهام عن حل سياسي يعرف أن الوحش القابع في دمشق لا يمكن أن يجنح نحوه، وبخاصة أن «الحل السياسي» المزعوم تتولى إدارة اللعب به دولة المحتل الروسي.
كذلك هي سيرة شاب مفجوع بمقتل أفراد أسرته وتدمير مدينته وحيه على يد وحش دمشق، ولم تحطمه المآسي، فمضى بثبات نحو ما يؤمن به: الموت البطولي.
على رغم اجتماع كل هذه العناصر المهمة بذاتها لصنع رمز وطني، يبقى الأهم هو هذا الإجماع الذي حظي به، حياً وميتاً، وخاصة بعد استشهاده. إجماع قلت سوابقه، يذكرنا برمز آخر صنعه مصرعه، هو الشهيد مشعل تمو الذي اغتالته يد الغدر في خريف 2011، عشية سفره إلى الخارج. يمكننا القول، من هذا المنظور، إن مشعلاً نجا من الاحتراق السياسي الذي سبقه إليه كثير من المعارضين. صحيح أننا لا يمكن أن نعرف شيئاً عن المصير المحتمل لمشعل، لو أنه نجح في الهروب وواصل نشاطه المعارض من خارج الحدود، لكن سوابق الآخرين تضعنا أمام أحد احتمالين: فإما الغوص في السياسة في أطر المعارضة التي رأينا مصائرها المؤسفة، أو النأي بالنفس عن أوساخ السياسة، ليصبح محكوماً بالشلل والنسيان. الاختيار بين المصيرين متاح لكل شخص، وهو يتحدد بأخلاقيات الشخص أكثر مما بفهمه للسياسة والعمل السياسي.
نجا مشعل، إذن، من هذا المصير، وإن كان الثمن حياته بالذات. باستشهاده تحول مشعل إلى رمز للثورة السورية، فرفعت صوره في مظاهرات معظم المدن السورية، وشهد تشييعه سيلاً بشرياً جارفاً على رغم ضآلة حجم الحركة السياسية التي أسسها وقادها. ربما كان تياره هو الأصغر حجماً بين القوى السياسية الكردية، في حين بات مشعل، بعد استشهاده، بحجم سوريا.
تكرر ذلك، للمرة الثانية، في لحظة استشهاد عبد الباسط، فاستطاع أن يجمع السوريين من مختلف ألوان الطيف الوطني لسوريا ما بعد الأسد. يمكن إيراد الكثير من نقاط الاختلاف بين الشهيدين الرمزين، لكن الفارق الأهم يكمن في السياق التاريخي لاستشهاد كل منهما. فقد استشهد مشعل في زمن صعود الثورة، في حين استشهد عبد الباسط في زمن انحسارها. ولهذا الفارق معنى: ففي لحظة مشعل لم يكن السوريون بحاجة ماسة إلى رمز يمثل ثورتهم، لكن الاغتيال الخسيس الذي تعرض له، إضافة إلى الخيارات السياسية للرجل، خلقت من حوله إجماعاً وطنياً كبيراً. أما اليوم، بعد الحصيلة المهولة لاغتيال سوريا المديد، وفي زمن «المصالحات»، والاستسلام، وحالات العودة إلى حضن النظام، وتواطؤ المجتمع الدولي ضد تطلعاتهم في الحرية والعدالة والكرامة، وضياع البوصلة السياسية لدى أطر المعارضة، فقد بات السوريون بحاجة ماسة إلى رمز يلخص سيرة ثورتهم وتطلعاتها ومصيرها، فكان عبد الباسط خير من يمثل هذا الرمز.
اللافت في أمر استشهاد الساروت أن «سوريي» الضفة الأخرى، أعني سوريي الأسد المكشوفين والمموهين، قد اهتموا أيضاً بهذا الحدث، وإن بصورة سلبية بالطبع، أكثر من اهتمامهم بأي حدث مشابه. هناك تجنيد أو تطوع واسع النطاق لكسر أي رمزية محتملة قد تصنع حول الشهيد. لقد وصل الأمر حد حملات تبليغ مكثفة لحذف بوستات فيسبوكية تتحدث بصورة إيجابية عن الساروت، بوستات عادية لا تنطوي على أي إيحاءات تدعو للكراهية أو التحريض على العنف أو غيرها من المضامين التي تستوجب الحذف. وبدلاً من التجاهل الذي هو السلوك المعقول والمفهوم، لجأت «الموالاة» إذا صحت هذه التسمية، إلى الحرب النشطة ضد رمزية الساروت، فهوجم من أعلنوا مواقف إيجابية من الشهيد، بأكثر مما هوجم هو نفسه.
لقد تحول عبد الباسط إلى رمز، بهذا الإجماع الكبير الذي حظي به. وقد يمكن تفسير هذا الإجماع لدى السوريين الذين اشتهروا بعمق خلافاتهم، بحاجتهم إلى الرمز، في هذا الظرف من شعور طاغ بالخسارة، مقابل شعور الطرف الآخر بأنه «منتصر». فوجدت هذه الحاجة ضالتها في الشاب الذي أحببناه جميعاً بأغنياته الثورية وقيادته للمظاهرات السلمية في حمص ومسيرته المأسوية بعد الخروج منها.
الصراع على رمزية الساروت هو، في حقيقته، صراع رمزي على سوريا ومصيرها.
كاتب سوري
القدس العربي
عبد الباسط الساروت : سيرة ثورة مغدورة/ زياد ماجد
قد يكون عبد الباسط الساروت الرجل الأكثر تجسيداً لمسار الثورة السورية في بهائها وارتجاليّتها وفي هنّاتها وتعرّجاتها، وصولاً الى نهاياتها التراجيدية.
فحارس مرمى نادي الكرامة الحمصي ومنتخب سوريا للشباب، المولود العام 1992 في حي البياضة الذي تقطنه غالبية من الوافدين الى حمص من ريفها، ويعيش فيه كما في بابا عمرو “بدوٌ” كانوا يوماً رحّلاً قبل أن يستقرّوا في ثالث مدن سوريا حجماً، اقتحم الثورة السورية بشعبيّته وبصوته ذي البحّة الشجيّة، ليقود المظاهرات ويحلّق كنسر فوق أكتاف محبّيه ممّن كانوا يصفّقون ويهتفون لصدّه الكرات، فصاروا يهتفون له ومعه من أجل الحرّية والعدالة وإسقاط النظام. عاش سلميّة الثورة في الساحات وقاد الجموع وشكّل لفترة ثنائياً أخّاذاً مع الفنانة الراحلة فدوى سليمان، العلوية المنبت والعلمانية المسلك، بما عناه الأمر يومها من رمزية أُريدَ لها كما لبعض الأهازيج والكتابات على الجدران مكافحة الطائفية والدفاع عن الوحدة الوطنية المُتخيّلة. وينبغي القول هنا، المُتخيّلة بصدق وإخلاص أو ربما باشتهاء وخشية اكتشاف فقدانٍ فظيع.
“بدّو العالم كلّها تبقى عبيد عندو… نحنا منّا عبيد إلا لربّ العالمين”.
بهذه الجملة اختصر الساروت بداية ثورته على بشار الأسد في الفيلم الوثائقي “وعر” الذي صُوّر في أشهر الثورة الأولى، أيام تحوّل حمص الى ما يشبه عاصمتها لجهة الحراك السلمي والمظاهرات اليومية والصحافة المواطنية وبداية المواجهات المسلّحة بين حُماة المتظاهرين وشبيحة النظام. وعطف على الجملة تكراراً عباراتٍ عن الكرامة والحرّية و”الموت ولا المذلّة”.
عبّر الساروت بعفويّته الأخّاذة حينها عن مزيج من تديّن شعبي يرفض الاستكانة للجور ويُؤثر الشهادة على الذلّ، وعن التزام بقيم “حداثية” تدور حول الحرّية وكرامة الفرد. ولعل في هذه الخلطة تحديداً ما مثّل معنى الانتفاضة الشعبية في سوريا وقتذاك، وتدفّق الجموع الى الطرقات والساحات رغم الرصاص والاعتقال والتعذيب والإعدامات الميدانية وذاكرة الخوف. فتجاوُر التكبير مع نداءات الحرّية وحّد رجالاً ونساءً من خلفيّات وأجيال مختلفة – ولَو أن جّلها من بيئات شعبية، حملت طوق حماية ميتافيزيقي يُعين على مواجهة القتل القائم أو المُحتمل، وتوقَ تحرّر مستقبلي من ثقل استبداد عمره في سوريا أكبر من أعمار معظم المتظاهرين والمعتصمين.
مع تحوّله الى واحد من رموز الثورة ومُنشدي اعتصامات الخالدية وغيرها من أحياء حمص “المحرّرة” ليلاً، انتشرت لعبد الباسط الساروت أغانٍ أو ترانيم لا تشبه الأناشيد الثورية الكلاسيكية، ولَو أنها تؤدّي وظائف الأخيرة التعبوية والدُعائية والتحريضية. فالساروت إذ غنّى في المظاهرات أو في الغرف المغلقة “يا وطنّا ويا غالي” بصوته المبحوح وبحزنه العميق سرد مسيرةً من القيامات الشعبية المتتالية و”القبضنة” أو “الجدعنة” في مواجهة النيران والسكاكين والدوس على الرؤوس، من درعا الى حمص، مُعرّجاً على زوايا الخريطة السورية التي لم يكن كثرٌ من السوريّين أنفسهم يعرفون أسماء العديد من قراها ودساكرها الثائرة. فَعل ذلك ببساطة وتلقائية تحوّلت مع أدائه “جنّة جنّة” الى تعبير عن تمسّك بالوطن المنشود ولَو كان “ناراً” من جهة، وعن ندامةٍ على عدم الانتفاض أو “الفزعة” لمدينة حماه بعد العام 1982 من جهة ثانية (“يا حماه سامحينا، والله حقّك علينا…”). والندامة هنا تعني الكثير. فالثورة السورية في العام 2011، كما معظم الثورات العربية، بدت في بعض جوانبها بحثاً عن زمن ضائع. زمن نهبته أنظمة الحكم، وسرقت أعمار من عاشه وأورثت لمن لم يكن قد وُلد فيه بعدُ، مثل الساروت، حالاً من الموات السياسي والمهانة المُعمّمة على المجتمع بأسرِه. وطلب الثأر لحماه بهذا المعنى بعد طلب السماح منها بدا سعياً لثأرٍ لجيلين على الأقل وثورةً على تاريخ مفصلي أو تأسيسي في سياق بناء الاستبداد وجدران خوفه في سوريا الأسد، دفعت ثمنه تلك المدينة المصلوبة لتكون عِبرةً لسواها.
ثم جاء حصار الأحياء الثائرة في حمص، بعد انتقال قسم كبير من متظاهريها السلميّين الى حمل السلاح دفاعاً عن أرواحهم وعن ذويهم إثر تصعيد النظام لقمعه وزجّه بالدبابات في مواجهة المعتصمين وقصفه لتجمّعاتهم وارتكابه المجازر المتنقّلة ضدّهم. وخسر الساروت في الحصار والقتل والاغتيال، رغم نجاته الشخصية منه مرّتين، أصدقاءه الواحد تلو الآخر. ثم خسر عمّه وخسر على مراحل أشقّاءه الأربعة، وانتقل الشاب العشريني من الغناء في الساحات الى القتال والغناء داخل بيوت شاحبة مع مقاتلين يستريحون أو عابري سبيل متضامنين أو صحافيين يغطّون ثورة مدينتهم. ولعلّ ترنيمته (الأشبه بالحِداء) “صامدين يا وطنّا صامدين رغم ظلم الظالمين” عبّرت عن سمات مرحلة حمص الجديدة التي عايشها، المخنوقة بالقصف والمعزولة عن العالم، الدافع يُتمها شبّانها الى ثنائيات عزيمة ويأس والى مواقع بحث عن التضامن ومقاومة الخوف، في المساجد أو في الكتائب المسلّحة أو في ما تبقى من شبكات إنترنت وخطوط هاتف تؤمّن تعلّقاً بالحياة خارج عتمة الحصار، أو بالأحرى فيها جميعها.
في تلك المرحلة، أسّس الساروت “كتيبة شهداء البياضة”، التي روى فيلم “العودة الى حمص” بعض يوميّاتها داخل الحصار وفي مواجهته. على أن مآل الكتيبة كان مأساوياً. إذ سقط معظم مقاتليها خلال معركة لفكّ الحصار عن بعض أحياء المدينة، التي سقطت بدورها بعد أشهر في أيدي النظام وحلفائه.
خرج الساروت من حمص العدّية في العام 2014. ترك خلفه حطاماً وآمالاً وأرواحاً وقبورا. تاه لفترة، وظهرت له تصريحات طائفية وصوَر مع رايات سوداء وتسجيلات بمصطلحات جهادية. وتحدّث البعض عن مبايعته خلافة البغدادي بعد تقرّب وجيز من جبهة النصرة. ثم اختفى الرجل وندُر الحديث عنه فيما خلا أنباءً عن محاولة اعتقاله من قِبل النصرة، الى أن عاد في ذكرى اندلاع الثورة في آذار 2018 ليظهر مُنشداً من جديد، يهتف ويغنّي بين جموع في بلدات ومدن إدلبية ترفع أعلام الثورة مع ما عناه أمر رفعها هذا من تحدٍّ في ظلّ الصراع القائم بين “خَضارها” ورايات السواد النازعة الى تمزيقه وحظره.
وإذا كان الوقت قد مرّ مكثّفاً في حيّز جغرافي ضيّق في سيرة الساروت الحمصية، فإنه بدا مفكّكاً بعد خروجه، تشبه محطّاته ما يُحيط بها من تقطّع أوصالٍ ورتابة انتظارٍ حيناً، وموت وتيه وتهجير جديد أحياناً أُخرى. والأرجح أن الساروت أراد عند انضمامه الأخير الى جيش العزة قائداً لفصيل اتّخذ من حمص مسمّى له العودةَ الى سيرته الأولى، والرباط في مواقع ريف حماه الشمالي، في أقرب نقطة خارج احتلال النظام وروسيا وإيران لمدينته ولأحلامه الممزّقة. هناك قاتل وقُتِل من صار بعمر السابعة والعشرين. واكتملت بمصرِعه سيرةٌ تراجيدية تعرّجت مسالكها وتعدّدت رمزيّاتها وظلّت شجاعته وصلابة موقفه من نظام أصابه بخسائر شخصية بمقدار المُصاب العام أبزر ملامحها.
هكذا يمكن تأريخ نواحي عدةّ في مسار الثورة السورية من خلال قراءة سيرة الساروت وما فيها من عفوية ورومانسية وشهامة وهشاشة وفقدان وغضب وتطرّف وبسالة وحصار، حملها جميعها صوتٌ شجيّ ومُحيّا بهيّ وقامة منتصبة تذكّر بذود صاحبها عن مرمى في رياضة عشقها يوماً وجعلت منه بطلاً لجمهوره الحمصي، قبل أن تنقله الثورة لترفعه على راحات جمهور توسّع وتبدّل ونسي بعضه الساروت، الى أن أعاد استشهاده تذكير الجميع بنبرته وبالأثر الذي تركه في كلّ من صادفه يوماً في ملعب أو ساحة أو جبهة أو يوتيوبٍ أو سكايبٍ أو هاتف نقّال.
لروحه السلام…
درج
ياقوت عبد الباسط الساروت/ صبحي حديدي
في آذار (مارس) 2011، حين كتب أطفال درعا «إجاك الدور يا دكتور» على ألواح مدارسهم وعلى جدران المدينة، كان عبد الباسط ممدوح الساروت (1992 ــ 2019) لا يحمل من أثقال سوريا المعاصرة، مزرعة الاستبداد والفساد والمافيات والتمييز المناطقي والطائفي، سوى 19 سنة: لا «يفهم في السياسة» كما ردّد مراراً، وليد أسرة جولانية فقيرة هاجرت إلى تخوم حمص في أعقاب تسليم الجولان على يد كبير مجرمي الحرب، الأسد الأب؛ لم يكمل تعليمه «لأسباب معيشية ذات صلة بفقر العائلة»، كما يوضح؛ حارس مرمى نادي «الكرامة» الحمصي، ومنتخب شباب سوريا لكرة القدم؛ المنشد المغنّي بغريزة شعرٍ يتدفق في داخله مثل جداول ربيع، وإحساس عارم بالنغم الشعبي وإلحاح الإيقاع الحارّ.
أطفال درعا، وذلك الحنين العميق الجارف إلى الكرامة الإنسانية والعدل الاجتماعي والحرّية والخبز، وربما النشيد الطلق المتحرّر من نير المستبدّ، كانت أوّل بواعث مجيء الفتى إلى الانتفاضة؛ أو إلى الثورة كما يحلو له أن يسمّيها، محقاً بالطبع لأنها بدأت هكذا في يقينه، وهكذا تواصلت خلال ثماني محطات ونيف من تجربته الشخصية في خضمها العاصف. وكان ذلك الخضمّ أشدّ عتوّاً، في استثارة الآمال وتكبيد الآلام وفي الانتصارات مثل الانكسارات، من أن يتحمّل قلبَه الطفل ولسانَه الهاتف وتكوينَه الوطني والحمصي والبدوي والجولاني الأصيل، المتجذر مثل سنديانة. ولقد خرج إلى ساحات حمص يذكّر طالبي الحرّية بأنّ هذا الوطن «جنّة» حتى في ناره، وهو «الحبيّب» و»أبو التراب الطيّب»؛ فلم تعد الأغنية تردّ السامعين إلى أصولها عند كريم العراقي وماجد المهندس، بل تجردّت من أيّ مستوى في الاستنساخ لأنها باتت سورية بامتياز: ابنة هذا الوطن/ الجنّة الذي ينتفض، وترنيمة هذا الفتى السوري الثائر الذي يُلهب حناجر الجموع، ويُشعل جذوة في الحماس والتعبئة والاستبشار لم يكن لها نظير في مواقع الانتفاضة الأخرى، حتى عند ذلك الحموي الصادح الساخر الذي اشتهر بلقب «القاشوش».
محطة تالية في هذه الوظيفة الثورية، الخاصة والمدهشة وذات الفعالية العالية، التي انتدبها الساروت لنفسه، وارتضتها له الحشود في أربع رياح سوريا، وليس في حمص وحدها؛ كانت ظهوره خلال التظاهرات والاعتصامات برفقة فدوى سليمان (1970 ــ 2017)، الأمر الذي جعل هذا الثنائي يتخذ تلقائياً، ولأسباب وجيهة، سلسلة دلالات عالية التأثير في الوجدان الجَمْعي: أنّ شريكته امرأة، أوّلاً؛ وأنها فنانة ممثلة، خريجة المعهد المسرحي، ثانياً؛ وهي، ثالثاً، ولدت لأسرة من الطائفة العلوية. وليس أنّ اجتماع الساروت وسليمان كان محاولة، بارعة وصادقة، في تمرين الشارع الشعبي على تطبيق شعار «الشعب السوري واحد»، في مناطقه وإثنياته وأديانه وطوائفه، فحسب؛ بل كانت، أيضاً، رسالة جبارة ضدّ الأجنّة الجهادية المتطرفة التي أخذت تتوالد رويداً رويداً، بتشجيع منهجي وتسهيلات من النظام.
محطة تالية، حاسمة في حياة الساروت، كانت اللجوء إلى السلاح بوصفه المآل الوحيد المتبقي، ليس في مواجهة الحصار الهمجي الذي فرضه النظام والميليشيات المذهبية على حمص وأهلها، وانتزاع كيس الطحين، وفتح ممرّات عبور المدنيين، فقط؛ بل كان الوسيلة الأوحد للدفاع عن النفس، وعدم فتح الصدر عارياً أمام القذيفة الفاشية. ومثلما كان التسلّح أداة فُرضت على شارع الانتفاضة الشعبي، جرّاء وحشية النظام وصعود الجهاديين، ولم يكن البتة خياراً إرادياً؛ كذلك فإنّ بندقية الساروت كانت قد ارتفعت على كتفيه بحكم الحاجة في حدودها الدنيا، القصوى والأقرب إلى الضرورة وخيار الدرجة صفر. وليست هذه السطور المقام المناسب للسجال حول هذه المحطة في مسيرة الساروت، ولا هي ملائمة لمساءلة أو تبرير اضطراره، خلال طور قصير للغاية، إلى مخاطبة «داعش» في «بيعة قتال» لا «بيعة طاعة»؛ إذْ يكفي التذكير بأنّ شرعيي التنظيم الإرهابي ذاته رفضوا قبول الساروت في صفوفهم، وأنه طُورد من جهاديي «النصرة» واعتُقل، وكاد أن يلقى حتفه على أيدي الظلاميين من مشارب مختلفة.
ورغم أنّ الساروت فقد أباه وأربعة من أخوته بنيران نظام الأسد وميليشيات إيران المذهبية، وأنه في نهاية المطاف سقط شهيداً في ميدان قتال مشرّف لا تديره أطراف الجهاد المتشدد؛ فإنّ نموذجه في الاستشهاد لا يشبه سواه لاعتبارات شتى، وإنْ كان يستكمل النماذج كافة، ويُغنيها. ولعلّ أبرز ما انطوت عليه خصوصية الساروت أنه لم يكن نسخة مطابقة من غياث مطر أو باسل شحادة، إذا وضع المرء جانباً شهداء عسكريين على غرار «أبو فرات» وعبد القادر الصالح؛ بل كان أمثولة القياس الأعلى في التعبير عن ولادات تلك المطحنة الجهنمية، التي خلطت معادلات القوّة والضعف، والصواب والخطل، والنزاهة والارتزاق، والمعارضة الصادقة النظيفة وتلك الكاذبة الملوّثة… حصيلة انتفاضة نبيلة امتلكت كلّ الحقّ وكلّ الشرعية وكلّ الأداء الملحمي، وتكاتفت قوى إقليمية ودولية عظمى لوأدها في المهد، ثمّ اغتيالها على النحو الأشدّ بربرية حين ترعرعت قليلاً ولاح أنها توشك على مقاربة المستحيل.
القدس العربي
والشهيد الساروت اختار لقب «أبو جعفر» تيمناً، أغلب الظنّ، بابن عمّ النبيّ محمد والصحابي شهيد غزوة مؤتة الذي لُقّب بـ»جعفر الطيّار» لأنه، حسب الرسول، «يطير في الجنّة بجناحين من ياقوت». وليس كثيراً على فتى الانتفاضة السورية، أحد الأجمل والأبهى في لوائح شهدائها، أنّ له من ياقوت الذاكرة السورية النصيب الأسخى والأرقى والأجدر.
عن الساروت الذي أنار الطريق ومضى/ ماجد كيالي
أثار مقتل عبد الباسط الساروت، في ريف حماه، في معركة مع النظام والميليشيات المتحالفة معه، جدالات كثيرة في وسائل التواصل الاجتماعي، على رغم أنه حظي بإجماع وباحتفاء بين السوريين لم يسبق أن حظي به أحد قبله، منذ بداية الثورة، إلا أن ذلك لم يسلم من وجهات نظر حاولت أن تطرح رأياً آخر، أو مختلفاً، في شأنه.
وتتمحور الانتقادات أو التساؤلات المعترضة أو المتحفظة على ظاهرة الساروت، حول تحول الشاب نحو العمل مع بعض الفصائل الإسلامية العسكرية، وعمله في فترة معينة مع جماعة تنضوي في إطار “داعش”، على رغم أنه ظل مطلوباً فيها وفي جبهة النصرة، وعلى رغم أنه لم يعرف عنه تدين ينم عن تشدد أو تطرف لا في مواقفه ولا في سلوكياته.
ثمة هنا ثلاثة تحفظات على وجهات النظر تلك، التي تبدو متسرعة، أو تستسهل تقديم تساؤلات نمطية جاهزة، ضد العسكرة وضد الأسلمة، من دون أن تلاحظ تعقيدات الصراع السوري، والمداخلات الخارجية التي تثقله، أو التي تفرض مساراتها أو أجندتها عليه، وهي على أهميتها ومشروعيتها، حمّلت الشاب الراحل أكثر مما يحتمل. لذا وفي مناقشة وجهات النظر تلك، يمكن طرح الملاحظات الآتية:
أولاً، لم تكن التحولات التي ذهب إليها الساروت ذات مصدر فكري أو أيديولوجي، إذ لم يكن حزبياً ولا مثقفاً (وهذا ليس مأخذاً عليه)، إذ إنه لم ينل حقه من التعليم مثل كثر من السوريين المهمشين في الأرياف والأطراف، لذا من الخطأ، ومن الظلم له، اعتبار انخراطه مع هذا الفصيل أو ذاك، نتاجاً لتحول سياسي أو أيديولوجي عنده، مع أن ذلك تم لفترة قصيرة، وعلى رغم أنه حصل بحكم الأمر الواقع، نتيجة سيطرة فصائل معينة في المنطقة التي أصر على البقاء فيها داخل سوريا، بدل مغادرتها، في ما اعتبره ضرورة للبقاء في الأرض، في حين خرج أمثالنا منها.
ويحضرني هنا حديث سابق مع رزان زيتونة، بعدما تعرض مكان إقامتها لتهديد علني في الغوطة (من جيش “الإسلام”)، فدعوتها إلى المغادرة حفاظاً على سلامتها، فكان جوابها العنيد والنبيل: “إذا غادرت، وغادر كل من مثلنا، من سيبقى إذاً في البلد؟”. عموماً، الساروت نفسه تبرأ من تلك الفترة القصيرة في تصريحات علنية، من دون أن ننسى أن ثمة كثراً مثل الساروت يعيشون في تلك المناطق، من المعارضة، أو الناس العاديين، وهم في ذلك يعانون من هيمنة تلك الفصائل، ولا يمكن صبغهم بطابعها، بل ويتمردون ضدها، لو استطاعوا إلى ذلك سبيلاً.
ثانياً، لا أعتقد أن العسكرة والأسلمة (وهذه غير الإسلام)، تعبران عن تطور وتحول داخلي في ثورة الشعب السوري، إذ إنهما أُدخلتا إليها، في طابعها الأعم والسائد، من الخارج، واحتلتا مشهد الثورة السورية بفعل مداخلات من أطراف خارجية، وبواقع ارتهان بعض من شخصيات المعارضة لأطراف خارجية. طبعاً، لا ينفي ذلك وجود نزعة للعمل المسلح للرد على بطش النظام ولرفض إقحامه الجيش في قمع الشعب، كما تبدت في ظاهرة “الجيش الحر”، وظاهرة الدفاع عن أحياء وقرى ضد الشبيحة وأجهزة الأمن، لكن تلك الظواهر العفوية والطبيعية، لم تتطور إلى حد فرض ذاتها، أو لم يسمح لها بالتطور التدريجي. لذا فإن الفصائل المسلحة التي طغت على الثورة السورية، وفرضت مساراتها العسكرية اللاحقة عليها، نشأت بفعل دعم خارجي، تقصّد استبعاد ظاهرة “الجيش الحر” تحديداً، وتصعيد فصائل ذات طابع أيديولوجي معين. وبالمثل، أيضاً، لا يمكن نفي نزعة “الأسلمة”، لكنها وهي التي اقترنت بالعسكرة، ينطبق عليها الأمر ذاته، مع علمنا أن ظاهرة السلفية الجهادية، التي تحكمت بمشهد الثورة السورية، غريبة عن التدين الشعبي السوري، المعتدل والمرن، بل إنها غريبة عن الإسلام السياسي السوري، بغض النظر عن رأينا به. وكما شهدنا فإن السلفية الجهادية في سوريا نمت فجأة، وصعدت بشكل سريع، حتى على حساب جماعة “الإخوان المسلمين”، التي تعاملت ببرغماتية انتهازية مع هذا الأمر، تحت لافتة “أخوة المنهج”، ما أضر بثورة السوريين، وبإجماعاتهم الوطنية. كما أضر بها، وبصدقيتها، علماً أن النواة الصعبة للسلفية الجهادية السورية في أغلبيتها من غير السوريين. وأختم بالتذكير بتفصيل بسيط، مفاده أن “داعش” و”النصرة” ومن يشبههما، غير محسوبين على الثورة السورية، ولا يحسبون أنفسهم عليها، بل إن معظم قتالهم، استهدف جماعات “الجيش الحر” والفصائل الأخرى، أكثر مما استهدف النظام.
ثالثاً، في شأن هكذا نقاش يجدر التمييز بين تحولات ناجمة عن حراكات داخلية في الثورة السورية، سياسية وايديولوجية وتنظيمية وعسكرية وتفاوضية، وبين تدخلات خارجية ممنهجة، من أطراف متباينة، استطاعت بقوة ثقلها ونفوذها فرض مسارات وخطابات معينة على ثورة السوريين، وأخذها بعيداً من مقاصدها الحقيقية. وتعني الأخيرة إسقاط النظام، وتحقيق توق السوريين إلى الحرية والكرامة والمواطنة والديموقراطية، لا سيما بحكم افتقاد هذه الثورة كياناً سياسياً جمعياً، وافتقادها طبقة سياسية تدير صراعها ضد النظام. هذا مع علمنا أن القوى الخارجية هي التي أضحت، منذ سنوات، تتحكم بالصراع السوري، أي بالطرفين المعنيين، النظام والمعارضة.
رابعاً، الفكرة الأساسية هنا في ما يخص الساروت، أن ما حصل معه حصل مع غيره، في الغوطة ودرعا والقلمون وأرياف حلب وإدلب وحماه، بخاصة أن النظام استطاع تدمير الطابع المديني للثورة، بتدمير بيئاتها الحاضنة، وتشريد سكانها. لذا الأجدى في تحديد رأينا من ظاهرة ما، بسلبياتها أو ايجابياتها، الأخذ في الاعتبار تعقيدات الواقع، والمداخلات التي تحكمه، إذ لا توجد ثورات كاملة، أو نظيفة، أو بحسب قالب معين، فالثورات بمثابة انفجارات عفوية، لا تمكن هندستها، ولا التحكم بمساراتها، فكيف إذا كانت ثورة مستحيلة ويتيمة وبالغة التعقيد وباهظة الثمن، كالثورة السورية؟
أهمية الساروت تكمن في أنه يشبه شعبه وأنه إنسان عادي، صنع أسطورته بعيداً من أي ادعاءات حزبية أو أيديولوجية أو وجاهية، وصنع ملحمته ببقائه في أرضه ثم في استشهاده، عن عمر 27 سنة، بعد استشهاد والده وثلاثة من إخوته. الساروت حارس مرمى منتخب شباب سوريا، الذي بزغ نجمه في بداية الثورة عن عمر 19 سنة، سيبقى في ذاكرة ناسه وقلوبهم، وسيبقى نجماً في السماء، ينير طريق الحرية للسوريين.
درج
من البوعزيزي إلى الساروت/ محمد أحمد بنّيس
بين إضرام الشاب التونسي، محمد البوعزيزي، النار في جسده احتجاجا على مصادرة بلدية سيدي بوزيد عربة الفواكه التي كانت مصدر رزقه، ومقتلِ عبد الباسط الساروت، قبل أيام، في مواجهات مع قوات الجيش السوري في ريف حماة، تسعة أعوام جرت فيها مياه كثيرة تحت جسور السياسة العربية، واشتبكت فيها الأحلام والانتكاسات بشكل غيّر ملامح المنطقة.
وإذا كانت الشُعلة التي أضرمها البوعزيزي، بجسده، قد أضاءت مساحة من الطريق أمام التونسيين لإنجاز ثورتهم المعلومة، قبل أن تنتقل شرارتها إلى محيطها العربي، فإن مقتل الساروت لا يختزل فقط ما آلت إليه الثورة السورية المغدورة، بقدر ما يحيل، كذلك، على مساحةٍ موازيةٍ أخرى، تبدو فيها معظم الثورات العربية في حاجةٍ لإعادة النظر في سيروراتها واستراتيجياتها، بعد أن تكالبت عليها الثورات المضادة، وحرّفت مساراتها نحو الحرية والديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
ليس مقتل منشد الثورة السورية مجرّد خبر عابر في يوميات المأساة السورية بكل تفاصيلها المؤلمة، إنه العنوان الأكثر دلالةً على الإفلاس الأخلاقي والسياسي للنظام السوري الذي لم يكتف باستباحة دماء شعبه وتهجيره، ودكِّ مدنه وقراه، وتدمير اقتصاده، وتغذية الأحقاد الطائفية والمذهبية فيه، وتحويل البلاد إلى حلبة مفتوحة للتقاطبات الإقليمية والدولية، بل أسهم في إحداث حالة من الانسداد السياسي والاجتماعي والنفسي غير المسبوقة. وهو في ذلك يختزل المأزق البنيوي للنخب العربية الحاكمة، وعجزَها عن الاهتداء إلى حلولٍ وسطى تجنّب بلدانها وشعوبها الدمار والخراب والفوضى. ولم يكن عبثا أن يسوِّق هذا النظام، منذ بداية الأحداث في 2011، شعاره ”الأسد أو نحرق البلد” الذي يعكس ثقافةً سياسيةً تنبني على السطوة والخوف والخضوع.
بدأ الربيع العربي مع الشرارة التي أطلقها البوعزيزي في وسط تونس، ثم سرعان ما انتقل إلى ميادين القاهرة وبنغازي وصنعاء والمنامة ودرعا وغيرها. وفي الوقت الذي بدت فيه الطريق سالكة أمام شعوب المنطقة لانتزاع حقوقها المشروعة في إنهاء الاستبداد والفساد وإقامة أنظمة ديمقراطية منتخبة، سيعرف هذا الربيع منعرجاتٍ دراماتيكية، خرجت بمعظم ثوراته عن طورها السلمي، ودفعت بها في اتجاه الاحتراب الأهلي والفوضى. وتحولت ساحات القتال في سورية وليبيا واليمن إلى مختبراتٍ مفتوحةٍ لتجريب وصفات القوى الإقليمية والدولية في تفكيك البنى المجتمعية، وضرب السلم الأهلي والاجتماعي، وإنهاك القوى المدنية والديمقراطية واستنزافها، ودعم التنظيمات والجماعات الجهادية والمتطرّفة، ودفع هذه الشعوب إلى حافّة اليأس والإحباط.
بهذا المعنى، يصبح الساروت عنوانا صارخا لهذا المسار المأساوي الذي قطعته الثورات العربية طوال الأعوام التسعة الفائتة، وإن كان ذلك، بطبيعة الحال، أكثر دلالةً وتعبيرا في الحالة السورية. وهو المسار الذي بدأ بمسيراتٍ ومظاهراتٍ سلمية حاشدة تطالب بالحرية والكرامة والديمقراطية، قبل أن تدخل قوى الثورة المضادة في الإقليم على الخط، لتنعرجَ بهذه الثورات بعيدا عن أهدافها التي كانت تتطلع إلى تحقيقها، مُفسحةً المجال أمام التطرّف الأصولي الأعمى، ليُعمِل فيها إجهاضا وإفسادا، ويَحُول دون تحولها إلى مشاريع جادّة للتحول الديمقراطي. وقد كان الحصاد مأساويا، سيما في غياب تنظيمات حزبية ومدنية قادرة على تدبير تداعيات هذه اللحظة التاريخية المفصلية. ومرة أخرى كان ذلك أفدح في الحالة السورية بسبب عجز المعارضة، بمختلف توجهاتها الفكرية والسياسية، عن النزول إلى الأرض والالتحام بيوميات الثورة ودينامياتها، وتخفيف معاناة السوريين، واحتضانِ عبد الباسط الساروت وأمثاله من شباب سورية الذين تقطعت بهم سبلُ الثورة، ووجدوا أنفسهم وحيدين بلا خيارات سياسية وميدانية، غير الالتحاق بالتنظيمات والجماعات المسلحة المختلفة.
يرمز سقوط الساروت، أو بالأحرى استشهاده، إلى سقوط نظام الأسد والمعارضةِ والجماعات المسلحة والقوى الإقليمية والدولية التي خطفت من الشعب السوري ثورته، وأحالتها إلى مقتلة مفتوحة. وقد يكون في تزامن موته مع وصول الحراك الشعبي في السودان والجزائر إلى ذروته ما يوحي بأن نجاح الموجة الثانية للربيع العربي رهينٌ بمدى قدرتها على الاستفادة من أخطاء الموجة الأولى التي فجر شرارتها محمد البوعزيزي قبل تسعة أعوام.
العربي الجديد
عبد الباسط الساروت.. فارس من هذا الزمن/ محمد حجيري
حارس الثورة وبلبلها
قليلة الأسماء التي تشارك في الثورات او الاحتجاجات وتبقى على “مثاليتها” أو أيقونتها، فمسار الأحداث والوقائع، كثيراً ما يقلب صور الأشخاص وتموضعهم ويبدل في نظرة إلناس اليهم، أو يجعلهم الزمن في غياهب النسيان، أو يدخلهم في بوابة “الخلود” ووهمه.
وفي الثورة السورية، بقى الطفل حمزة الخطيب أيقونة، وكذلك المغني ابراهيم القاشوش، والسينمائي باسل شحادة، والمغيبة رزان زيتونة ورفاقها، والأب باولو، والناشطين الإعلاميَين رائد الفارس وحمود جنيد في كفرنبل، والآن عبد الباسط الساروت، وهو الشخصية المحبوبة والمثيرة للجدل التي صنفت في خانة “البطل الشعبي”… يعرّف شوقي ضيف، البطولة، بأنها في اللغة الغلبة على الأقران، وهي غلبة يرتفع بها البطل عمن حوله من الناس العاديين ارتفاعاً يملأ نفوسهم له إجلالاً وإكباراً، وهذا التعبير أخذ حيزاً في التعليقات على مقتل الساروت في ساحة المواجهة مع نظام الاسد.
يقول مالك الداغستاني وهو من المقربين من الساروت: “لم يكن تحوّل الساروت إلى بطلٍ شعبيٍّ أو أسطورةٍ من نتاجات المخيلة الشعبية التي تضفي على أبطالها صفاتٍ خارقةً فوق بشريةٍ غير موجودةٍ فيهم أصلاً. لم يقسر اسم الساروت المخيلةَ الشعبية السورية على ابتكار الحكايا المتخيلة عنه. لكنه، وببساطةٍ غير متوقعةٍ من شابٍّ في عمره، قدَّم من صفاته وسلوكه للأسطورة كلّ عناصرها لتتكامل بصفتها أسطورة. ظهر الساروت بوجهه المكشوف حين كانت الأكثرية تخفي هوياتها. تواجد في كلّ الأماكن الخطرة التي لم يتخيل أحدٌ يومها ظهوره فيها. غنّى في بابا عمرو حين كان الحيّ محاصراً. دخل إلى حمص المحاصرة حين كان الآخرون يفكرون ويبحثون عن طريقةٍ لمغادرتها. وفي حصار المدينة أكل كغيره أوراق الشجر والزيتون المرّ. وعندما غادرها راح يعمل وأصدقاءه بقطاف الزيتون كي يؤمّنوا كفاف يومهم. وكان، في كلّ لحظةٍ في الثورة وحتى اليوم، يجاور الموت ولا يهابه. بل، وفي الكثير من المواقف، كان يتجرّأ عليه ويتحارَشُه بشجاعةٍ غير مألوفة”.
ويقول الشاعر إسلام أبو شكير “يمثل الساروت نموذجاً خاصّاً قد يكون الأصدق بين جميع النماذج التي عرفتها الثورة السورية.. نموذج الشابّ البسيط الذي انخرط في الثورة بدافع من إحساسه الفطري والطبيعي بحقه في ان يعيش بكرامة، وحسب.. لا يملك رؤية، ولا نظرية.. لا يعمل وفق حسابات الساسة والمؤدلجين واصحاب المشاريع.. يصبح جزءاً منهم أحياناً، ولكن لأن الخيارات امامه معدومة، ثم إنها جريمة هؤلاء لا جريمته هو.. الساروت هو نفسه البطل الشعبي الذي فتن ارواحنا عبر التاريخ بشبابه وفتوته ونبله وغيريته، والأهم بمنبته الذي ينتمي إليه معظمنا”.
البطولة الشعبية نجدها جلية في سيرة الساروت، بل هو يمتلك اكثر من بطولة واحدة، ولد العام 1992 من عائلة هاجرت من الجولان واستقرت في حي البياضة بمدينة حمص، كان يُعد ثاني أفضل حارس مرمى في قارة آسيا، وحارس المرمى الأساسي في منتخب سوريا للشباب وحارس نادي الكرامة. كان طريقه ممهدًا ليكون حارس المنتخب الأول والاحتراف في نادي أوروبي، لكنه قرر التخلي عن مجد الكرة في مقابل الوقوف في مواجهة جيش الاسد دفاعاً عن مدينته وحيّه، وعدا عن كونه رياضيا محترفاً، أعاد اكتشاف موهبة اخرى لديه خلال مشاركته في التظاهرات والاحتجاجات الاسبوعية وهي الهتاف تأليف الأغاني وغنائها. ويمكن لمس هذه الموهبة عن الاستماع لأنشودة “جنة جنة جنة يا وطنّا” بصوته، فلقب بـ”بلبل الثورة ومنشدها” عدا عن لقبه حارس الثورة. حين برز اسمه وأصبح السوريون وغير السوريين يرددون هتافاته وأناشيده، وقبل أن يعلنه النظام السوري كمطلوب ومطارد، سارع الاتحاد الرياضي العام في سورية إلى فصله ومنعه من اللعب مدى الحياة، وكان تعليقه الساخر على ذلك: “ضحينا بحياتنا والناس تموت وهم يسألون عن الاتحاد الرياضي… هل يضمنون أنفسهم واتحادهم الرياضي؟”.
وفي مطلع تموز (يوليو) 2011، اتهم النظام الساروت بإنشاء إمارة سلفية في حمص بدعم من خليجيين. لم يستطع الساروت في البداية أن يلتقي بوسائل إعلامية ليوضح الأمر ويدافع عن نفسه، فأصدر بياناً في فيديو نشره في موقع “شام” في “فايسبوك” نفى فيه هذا الإتهام. في 14 ديسمبر/ كانون الأول 2011 تعرض لمحاولة اغتيال نجا منها بأعجوبة وأصيب في ساقه بطلقات عديدة، وظهر في تسجيل وهو يعاود الذهاب إلى المظاهرة وساقه لم تتعاف بعد. وعلى أنغام فيروز في فيلم وثائقي لقناة “أورينت”، تهتف الجموع “سلامات عبد الباسط سلامات” وهو محمول مرة أخرى على الأكتاف لقيادة المظاهرة، والأرجح أن النظام الأسدي كان يخاف المنشدين أكثر من الرصاص، فهو اقتلع حنجرة ابراهيم القاشوش، ولم يتردد في رصد مكافأة مقدارها مليوني ليرة سورية لمن يساعد في القبض على الساروت، وحاول اغتياله اكثر من مرة… وبالتوازي مع محاولات النظام لجم صوت الساروت المدوي، كان النظام يبيد المواطنين بدءاً من مجزرة الخالدية في فبراير/ شباط 2012 والتي أسفرت عن أكثر من 300 قتيل وحملة بابا عمرو وغيرها. كان لا بد حمل السلاح للمواجهة والدفاع عن النفس، مع التذكير بأن النظام الأسدي، كان هدفه منذ البداية عسكرة الثورة ولاحقاً أسلمتها.
لم يكن الساروت قبل الثورة السورية جندياً أو مقاتلاً، لكن الواقع يغير مسار الامور، يجعل عاشق كرة القدم من حملة البندقية، فالشاب الذي كان حارس مرمى سرعان ما أسس كتيبة “شهداء البياضة” مع إخوانه من الحي نفسه لحماية المدينة. وخلال المواجهات قتل ثلاثة من أخواله، وأربعة من إخوته: وليد الذي قتل في الخالدية العام 2011، محمد الذي قتل أوائل العام 2013، وأحمد وعبدالله اللذان قتلا في 9 كانون الثاني 2014 في حادثة المطاحن. فقد حاول الساروت مع كتيبته فك حصار حمص من الداخل وعبروا إلى منطقة المطاحن التي كانت تسيطر عليها قوات النظام ليجلبوا الطحين للمحاصرين، وقتل أكثر من 40 فرداً منهم، من بينهم إخوته.
هكذا بدأ الساروت يقاتل بالكلمة والرصاص والمعنى، يوم خروجه من حمص المحاصرة في الثامن من أيار (مايو) 2014 قال الساروت: “إذا بقينا نتبع الأتباع والأنصار والكتائب والأسماء والمسميات والجبهة والدولة مطولين كتير”. وبعد خروجه مع بقية المقاتلين من مدينة حمص إلى ريفها، وفق اتفاق فك الحصار الذي وقع بين المقاتلين والنظام السوري، تواردت أنباء عن بيعته لـ”داعش”، وقد نشر فيديو على مواقع التوصل الإجتماعي قال فيه: “نحن كتيبة شهداء البياضة لا ننتمي لأي فصيل ولا ننتمي لأي مجلس ولا ننتمي للإئتلاف ولا ننتمي لأي تنظيم ولا ننتمي لأحد. هدف هذا التشكيل مقاتلة النظام حتى آخر قطرة دم”. وصعد نجمه وبات موضع اهتمام التعليقات وحتى المخرجين، صور المخرج طلال ديركي فليما عنه بعنوان “العودة إلى حمص” عالج تطور الأزمة التي بدأت باحتجاجات سلمية مناهضة للنظام منتصف شهر مارس/ آذار 2011، التي تحولت بعد أشهر إلى نزاع دامٍ أودى بحياة مئات الآلاف من المواطنين. استعمل المخرج الأسلوب الروائي ليوثق قصة الساروت الرياضي الثوري الذي تخلى عن الحراك السلمي وحمل السلاح، كالآلاف غيره ضد الجيش السوري. (كما يعرض الفيلم شخصية أخرى وهو الطالب الجامعي الساخر أسامة الهبالي).
ولم يكن الساروت هدفاً للنظام فحسب، في الثالث من تشرين الثاني 2015، هاجمت “جبهة النصرة” مجموعة من عناصر الساروت بهدف اعتقالهم، فرفضوا تسليم أنفسهم واندلعت على أثر ذلك اشتباكات تطورت إلى هجوم الجبهة وفصائل أخرى على مقرات “كتيبة شهداء البياضة” ومقتل وأسر عدد من أفرادها. واستطاع الساروت الهرب إلى أرياف حمص والنجاة مع من تبقى حياً من أفراد كتيبته. في العام 2016 شارك الساروت في تظاهرات انطلقت في محافظة إدلب السورية، وطالب بتوحيد فصائل المعارضة السورية المسلحة، وكان من المنددين بتهجير النظام السوري للمدنيين من مدينة حلب. في العام 2017 اعتقلت “هيئة تحرير الشام” الساروت ثم اخلت سبيله، على خلفية قضايا تتعلق باقتتال سابق. العام 2018 ظهر الساروت، في تسجيل مصور، خلال معارك المعارضة جنوبي إدلب. وسرعان ما انضم فصيله إلى فصيل “جيش العزة”. وكان أصيب في يده وتعرض لمحاولة اغتيال في شباط الماضي اثناء تواجده في معرة النعمان. بمعنى آخر كان الساروت على علاقة تراجيدية مع الموت، بين اكثر من اصابة، وأكثر من محاولة اغتيال، واكثر من حصار، ومن عائلة أبيدت، ومن مدينة ازيلت معظم معالمها، ومن مجتمع هجر بغالبيته.
وبعد كرة القدم والهتاف والأناشيد والحصارات ومحاولات الاغتيال، قتل بلبل الثورة في معارك شمال سوريا. كتب عدي الزعبي “حتى نارك جنة”، لطالما ردد عبد الباسط هذه الجملة، حتى ارتبطت به، كأن البلد بأكملها جحيم الآخرة، جحيم لم يتركه الشاب النجم الأيقونة، بعدما تركه ملايين السوريين، بحثاً عن حياة آمنة”. وكتب مالك الداغستاني أيضاً “فرِح باسط(عبد الباسط الساروت) بصدور أغنيته الجديدة، وطلب من صديقه فراس الرحيم كاتب الكلمات كتابة قصيدة جديدة. اليوم أخبرني فراس أنه أنهى فعلاً كتابة القصيدة، واليوم أخبرتنا السماء أن الساروت قد مضى إليها.(…) حين اتفقنا على تسجيل الأغنية. رفض أن يغادر الجبهة وتم تسجيلها بواسطة الموبايل في الخندق”.
باختصار، تظاهر الساروت وأنشد وقاتل وأصيب وكان آخر المغادرين من حمص، لم يلجأ للسكن في الفنادق، ولم يختر الهجرة الى أوروبا، ولم يصبح مليونيراً، برغم المصاب الذي حل بإخوته وعائلته، بقي في ساحات القتال منشدا وحاملاً البندقية في آن معاً، وهذا مشهد نادر..
المدن
مات الساروت.. يلعن روحك يا حافظ/ يوسف بزي
سيبقى فيلم “العودة إلى حمص” لـ(طلال ديركي) مرجعاً تاريخياً، ووثيقة فنية بصرية عن الثورة السورية، في حمص تحديداً.
كرس ديركي فيلمه لملاحقة الشخصية الثورية عبد الباسط الساروت، حارس مرمى نادي الكرامة ومنتخب سوريا للشباب، الذي سيحمل لقبيّ “حارس الثورة السورية” و”منشد الثورة”. وعلى امتداد ساعة ونصف نشاهد الساروت متولياً ابتكار الهتافات والأهازيج والردّيات في التظاهرات الليلية بالساحات الداخلية لأحياء حمص. وفي النهار، نراه منهمكاً في أعمال الإغاثة، وتنظيم الأنشطة المدنية السلمية، وإدارة عمليات الإعلام وبث الصور والفيديوات الميدانية، بل وأيضاً في ملاعبة الأطفال الذين باتوا يطاردونه بشغف أينما رأوه، في حركة لا تهدأ حتى الفجر.. إلى أن نرى الساروت وقد بات وجهه حاملاً علامات ندرة النوم والإنهاك البدني.
لاعب كرة القدم هذا، لصيق الحياة الشعبية في حمص وربيبها، هو صوتها العفوي ولهجتها. وهو لا يجهد ولا يكترث لـ”تبرير” الثورة، كما لو أنها بديهة لا معنى للسؤال فيها. وبالبداهة نفسها انتخبته حمص عفوياً وتلقائياً صورة لها وحنجرتها ورأس تظاهراتها وتجمعاتها. وعلى النحو نفسه كانت كلماته وشعاراته تأتي عفو الخاطر والسليقة وكأنها في الوقت نفسه طالعة من دواخل ومخيلة وأفئدة السكان، أهلاً وشباناً وشابات جميعهم، وتخاطب فيهم وتقول ما يعتمل دخيلتهم وأفكارهم.
هناك مشهد في “العودة إلى حمص” نرى الساروت يجتاز الجموع من مؤخرة التظاهرة إلى مقدمتها عالياً عن الجمهور بكامل قامته المستقيمة، كما لو أنه مرفوع في الهواء سحراً ومعجزة، طالما أنه لا يعتلي الأكتاف ولا تحمله الأيدي. وهو ما أن يمسك الميكروفون حتى يصيبه تحول فيزيولوجي ينقلب فيه جسده النحيل إلى “قامة” طويلة ممتلئة بالعزم، فيما صوته الشجي والمبحوح يكتسب قوة اللوعة والشجن القديم الذي لا بد أنه طالع من عتق المدينة ووجدانها. يكتسب الساروت لحظة قيادته للتظاهرة تحولاً كوريغرافياً لجسمه، كأن تمتد يده في الهواء وتلوح أبعد من مداها الحقيقي. الإيقاع الذي يحرك به أجسام الآلاف الذي تجمهروا في حلقات القفز والرقص الدائري، استجابة لكل “ردّية” يطلقها، خصوصاً عندما تتحول عبارة “يلعن روحك يا حافظ” إلى أغنية مرحة وراقصة.
“اسمع اسمع يا قناص.. هيدي الرقبة وهيدا الراس” هو أول شعار ابتكره، حسب قوله في الفيلم. ثم إنه راح يؤلف مع كل حدث يومي موّالاً، كما لو أنه بهذه الطريقة “يدون” للذاكرة الشفهية الحقائق اليومية والوقائع والأحداث، تدويناً حياً وشعبياً غير قابل للمحو ولا للنسيان، تماماً كما كانت الملاحم الشعبية تؤَّلف وتشاع.
في واحدة من ردياته، تنقلب الحماسة إلى شجن حزين ومكسور، وإلى قهر فاجع: “مالو بشار يقتل شعبه عشان كرسي؟ حرام عليك، حرام عليك”. وحين يرددها الجمهور بنبرة أليمة، نشعر بالفظاعة التي تهددهم، كما لو أيقنوا أن “قتل الشعب” سيتعاظم إلى إبادة.
عندما راح يصرخ مع أهل حمص “برهان غليون مانك سمعان؟ الشعب بدو حظر طيران”، بات الساروت بنظر السوريين يعبّر عن مطالبهم السياسية المباشرة، كاتباً بيانهم اليومي، مسطراً المواقف والأهداف والتحولات المتسارعة ميدانياً وسياسياً وإعلامياً، متقدماً على هيئات “المعارضة” في الخارج وهادياً لها. وهذه هي لحظة التحول عند الساروت، بوصفه بات قائد الثورة في حمص. في العام 2011، كان عبد الباسط الساروت يبلغ سن 19 عاماً فقط.
في أواخر العام الأول للثورة، سيتحول النشطاء السلميين وشبان التظاهرات، مع وصول الدبابات والألوية العسكرية وبداية القصف المدفعي العشوائي، واقتحامات الفرق الخاصة للأحياء، وتولي أجهزة المخابرات عمليات الاعتقال فالتعذيب والموت والإعدامات الميدانية.. سيتحولون إلى مجموعات دفاع محلية، في الوقت الذي وضع النظام اسم الساروت على رأس لائحة المطلوبين وقام بقتل أخيه الأكبر، وليد، وعدد من أفراد أسرته وتدمير منزل العائلة، وبدء عزل أحياء الخالدية وباب عمرو والبياضة ومحاصرة باقي الأحياء. لقد فرض النظامُ الحربَ: إما الاستسلام ودفن الثورة كلياً وإما القتال والتمرد.
هنا، سيرتقي الساروت إلى مرتبة أعلى من قائد التظاهرات ومنشدها الأبرع. سنراه مقاتلاً بالغ الشجاعة والتهور والإقدام. ما سيمنح اسمه بعداً أسطورياً إضافياً. صار “بطلاً” واقعياً وفي الفيلم أيضاً. هذا لا يحدث في العالم الحقيقي إلا نادراً: أن البطل لا يمثل. والبطولة فائقة واقعياً إلى درجة أنها “سينمائية”. وستوثق كاميرا طلال ديركي على نحو صادم ومدهش هذه الشجاعة الاستثنائية لعبد الباسط، الذي أصيب مرات عدة، ليعود إلى القتال مجدداً، حتى قبل أن تبرأ جروحه.
لقد بدا واضحاً أن مصير حمص أضحى من مصير الساروت. ولأن المدينة في مطلع العام 2012 حملت لقب “عاصمة الثورة”، ستكتسب حياة الساروت وأفعاله قوة رمزية ملهمة وبالغة الخطورة، خصوصاً مع “التدخل” المتعدد الجهات، المانح مالاً ومساعدات وسلاحاً للمجموعات الثورية. زمن العفوية انتهى وفق متطلبات الحرب، المتسربة إليها الفوضى الميدانية والتخبط السياسي، مقابل آلة النظام العسكرية التي تنتهج أقصى درجات الوحشية، خصوصاً بتعمد قنص الأطفال وخطف النساء والاعتداء عليهن، وتشديد الحصار الغذائي وحملة التدمير العنيف.
سقوط حمص وخروج الساروت منها، كان علامة على المنعطف الذي أخذته الحرب والثورة: منعطف الحرب الشاملة وحملة الإبادة والتهجير. استعاد النظام نموذج “حماة 1982” ليعممه على سوريا كلها. ونجاة الساروت كانت انتصاراً معنوياً. بل إن خروجه الأول وعودته في المعركة الأخيرة، قبل الخروج النهائي، أوحى أن “انتصار” النظام مستحيل، وإن أكد أن مآلات الثورة صارت أكثر سوداوية وتشاؤماً.
الشجاعة المطلقة والانغماس بالتضحية وسخاء الافتداء الذي ميّز مئات الآلاف من السوريين في ثورتهم، بل هذا العناد حتى الموت في المواجهة، سيضفي على الأحداث السورية طابعاً تراجيدياً مروعاً، طابع النكبة التاريخية. وكأن ما أصاب الثورة، إنما يزيد العالم وحشة وقسوة.
انتقل الساروت من براءة اللعب وبهجة الملاعب إلى رومانسية التظاهرات والهتافات، ومن كرنفالية الساحات وحلقاتها الراقصة إلى حماسة الإغاثة والتصوير والتواصل الإعلامي.. ومنها إلى شجاعة التمرد المسلح وفروسية الدفاع عن الناس المظلومين، وصولاً إلى الانخراط المحترف بالحرب والتحول الصعب نحو يأس التطرف في مسار القسوة وفائض الموت وشراسة العدو، ثم الانتباه والتراجع عن بؤس الخيار التكفيري، والعودة مرة أخرى إلى حضن المعارضة المسلحة..
طوال ثماني سنوات، سيبقى الساروت مقاتلاً مندفعا، بخيار البقاء في سوريا وفي الجبهات الأمامية. خيار “إما النصر أو الموت”. أما نحن الذين لا نحبذ نفي الضعف الإنساني ولا نصدق روايات الأبطال الخارقين، فإننا نعجز عن إنكار تحقق “البطولة” بمعناها الملحمي والروائي والسينمائي مع هذا الشاب الحمصي وروحه التي تحرس الحلم السوري.
بموته لا بد من ترداد أعمق آهة سورية: يلعن روحك يا حافظ.
تلفزيون سوريا
الساروت وهجاء المثقفين/ دلال البزري
رثاء عبد الباسط الساروت عَبَرته نعرةٌ تنال من الثقافة والمثقفين. من مقارنته السلبية الضدية بـ”المثَقَفَتية”، إلى تِرداد صفاته الحميدة، من نوع “بساطته”، “عفويته الأخّاذة”، انعدام علاقته بالعلم والثقافة. ثم مع قليلٍ من التمويه، رفعه عالياً بصفته “صانعاً للقيم”، من دون الحاجة إلى “معرفةٍ واسعة”، أو “علم كبير” أو “تعليم”، أو لـ”النظريات الفلسفية والعلمية والأخلاقية”. ومكْمن حريته الأساسي أنه لم يكن “مثلنا” (أي مثل أمثال المثقف الراثي)، إنما كان “حرّاً من صراع الأفكار العقيمة”، و”نظريات الكتب”. طبعاً لم يكن الحزن على الشهيد ينطوي كله على عباراتٍ أو جملٍ من ذاك القبيل. ولكن أيضا لم تخل مقالاتٌ وبوستات شبكية عديدة من هذه النعرة. نعرة وجدت سبيلها إلى الذيوع بصراحة، أو بأقل منها.
وإذا ما قارنتَ بين رثاء الساروت ورثاء سوري آخر معروف، يتبيّن لكَ الفرق. الفيلسوف الطيب تيزيني، الحمصي، أيضا، مثل الساروت، رحلَ قبله بأقل من شهر .. كيف كان عزاؤهما؟ سَيْلا جارفاً من الحزن على الساروت، ورفعه بسرعة قياسية إلى مرتبة الأيقونة. سبقه شحوب توديع تيزيني، والاختلاف على نصيبه من الحزن على رحيله؛ بل رافقته رسالة صديقه وزميله يوم وفاته، والتي لا تشبه الرثاء، إنما هي إلى الهجاء أقرب، حيث كتبَ: “لم أُعجب بأية صفة من صفاته (أي تيزيني)، ولم أرض عن أي سلوكٍ من سلوكاته، ولم أستحسن أياً من مؤلفاته”. وذلك بعد مقدمة يؤكّد فيها أنه يعرفه منذ العام 1970، وانه زامَله وعرفه في حياته العامة والخاصة وقرأ جلّ ما كتبه.. إلخ.
المهم في الموضوع أن العزاءين، الأول والثاني، يوحيان إليك أن ثمّة مناخا معاديا للمثقفين، لم تصنعه دوائر قرار، ولا ساهمت به أقلامٌ “مأجورة”، ولا انخرط في ثنياته أفراد “غير مثقفين”. بالعكس، كلام الاثنين صدر عن مثقفين، معروفين وغير معروفين. ولكنهم أفرادٌ يتعاطون بالثقافة أو يهتمون بها، على درجات متفاوِتة ومتقارِبة في آن.
خلف هذا التمييز، هل يقف طول عمر تيزيني (85 سنة)، وصغر عمر الساروت (27سنة)، حين رحيلهما؟ إذ نأسف على الشباب، ونستكثر على طويلي العمر سنواتهم، والذين ماتوا ميتة ربهم، في فراش المرض الأخير، لا على الجبهات؟ فيكون الحزن عليهم تصنيفياً، عازلاً هذا، ومنصِّبا ذاك؟ أم أن الموضوع هو أن الساروت حمل السلاح، وتيزيني لم يحمله؟ والاثنان بقيا في “الداخل”، واحد يواجه بالسلاح، والثاني يعجز عنه؟ لكبر عمره أو لخياراته الأخرى؟
أحدهم أخذَ على تيزيني “بقاءه في الداخل”، ولهذا لن يحزن عليه. على أساس أن الباقين في الداخل كلهم موالون للنظام. ولا قيمة من بينهم إلا لمن يحمل السلاح بوجهه. وقد تكون هذه الفكرة مسنودة بشعوبيةٍ متثاقِلَة، أساسها طَبقي، ترى في الساروت ابن العشوائيات، وفي تيزيني ابن الصالونات؟
حب السلاح وكراهية الثقافة. لا يمكن إنكار أن الذين تحمّسوا بشدة لرثاء الساروت هم من الصف الذي يؤيد حمل السلاح ضد النظام. وفي هذه الحالة، السؤال الساذج هو: إذا كنتم، كمثقفين، تكرهون المثقفين، وتمدحون الساروت كل هذا المديح لأنه، من بين أسباب أخرى لكراهيتكم هذه، حمله السلاح ضد النظام بعدما اضطر إلى ذلك، واستمراره به حتى الموت.. فلماذا لا تلتحقون بالميدان، وتتجاوبون مع الأيقونة التي رفعتم إلى مصافّ القديسين، وتحملون بدوركم السلاح انسجاما مع أنفسكم، ومع ما تقولون وتكتبون؟ هذا ليس تحدّيا، إنما دعوة إلى الانسجام مع النفس، وإلا فسوف يترسّخ في الأذهان تقسيم العمل في الثورة السورية؛ من جهة، بين الذي يحمل السلاح، وهو غير مثقفٍ، شعبي، فقير، ولكنه محبوبٌ من المثقفين. ومن جهة أخرى، بين هذا وبين الذي لا يحمل السلاح، ولكنه يمتدح حامليه، ويساهم بتحويلهم إلى أيقوناتٍ، ويكون عادة من المثقفين الذين أتيحت لهم فرص التفكير والكتابة؟
يمكن تفهّم سياقات وظروف كثيرة حالت دون التماهي العملي مع الساروت، والمشي على خطاه. ولكن يبقى سؤال، تطرحه تلك المرثيات: لماذا يكره المثقفون المثقفين؟ وهنا أقصد مثقفي المعارضة لنظام بشار. لأنهم هم الغالبون. إذ تكاد لا تجد مثقفين موالين لهذا النظام.
لماذا إذن؟ هل هي من طبائع المثقفين، شديدة الفردية والنرجسية، أنهم لا يروْن غير أنفسهم؟ غير مستعدّين للاعتراف بأي مثقفٍ آخر؟ دائماً يتكلمون عن المثقفين، غالباً كأنهم “مزعومون”. يرذلونهم بلا هوادة. أو يتجاهلونهم. الفيلسوف الذي هجا تيزيني، يوم رحيله، لم يكن يعبِّر عن انعدام لياقته الإنسانية وحسب. إنما عن سلوكٍ متجذِّر وسط المثقفين. كراهية بعضهم بعضا، أو تجاهل بعضهم بعضا في أفضل حالات الدماثة والتهذيب.
حسناً. ربما لا يكون المثقف على هذه الدرجة من النرجسية، خصوصاً إذا لم يكن “نجما”، ومشهوراً. إنما كراهيته المثقفين والثقافة قد تكون عائدة إلى هامشية المثقف نفسه، فكل أكاليل الغار على جبينه لا تقدّم ولا تؤخِّر بشيء في مسار الحدث، أو التغيير. وهذه نقيصةٌ ملموسة، يتحسَّر عليها المثقف، ويدور حولها، بصيغ موارِبة أحيانا. و”يتذكّر” الزمن “الجميل”، أو “العصر الذهبي”؛ ويجترّ أوهام الأدوار التي لعبها المثقف في الأزمنة الغابرة. مع أنه، مع تدقيقٍ قليل، تجد أن هذا “الدور” للمثقف كان مجرّد واجهة ووجاهة؛ تلاعب به السياسيون، الثوريون خصوصاً، فأعطوا للمثقف الحظوة والطلّة البهية وامتيازاتٍ.. إلخ، في مقابل تنظير المثقف لسلطتهم، المعارِضة. أي كانوا مثل “وعاظ السلاطين” الذين كتب عنهم العراقي علي الوردي. مع فرق أنهم، في حالتنا، كانوا مدنيين، لا شيوخا ولا مفْتين، وسلاطينهم مرفوعين على عروش المعارضة.
الدور، الوظيفة، إلى ما هنالك من وصفٍ للأفعال التي تنتظر المثقف. يدور حولها كاتباً منظِّراً مستشهداً، ولكنه لا يدخل في صلبها. لماذا؟ لأن أفكاره ليست مجرَّبة في التغيير، لأنه لا تُتاح له سياقاتٌ ممكنة للتغيير الذي تنشده كتاباته. بل: هل هذه الكتابات منذورةٌ للتغيير؟ أم إن هدف الكتابة تبدَّل، بدوره، أو تعدَّل؟ المثقفون يكرهون المثقفين، لأنهم، في الحقيقة، لا يتأملون من كتاباتهم إلا الحساب والمحاسبة، فوق أنها، أي الكتابة، تبْخل عليهم بكل شيء، ما عدا نعمة “الاعتراف” العزيزة التي لا تهبط إلا على المحظوظين من بينهم، فمن أين لهم ساعتئذ أن لا يكرهوا أنفسهم، ولا يكرهوا بعضهم؟
العربي الجديد
سيرة الساروت.. سيرة الثورة/ خضر الآغا
أن تقترن سيرة ثورة بسيرة شخص فذلك لا يكون إلا عندما يريد التاريخ أن يبالغ بإضفاء تراجيديا من نوع خاص على تلك الثورة كما على ذلك الشخص معًا. في تاريخ الأحداث الكبرى الثورية والتحررية يظهر شخص ما، أو يتم تصنيعه، ليبدو قائدًا للحدث ومحركًا له، لكن ذلك بدا، غالبًا، على أنه نوع من صناعة سجل أو توسيع سجل يقرر أو يحفظ أثر الفرد في التاريخ.
الأشخاص المحفوظون في ذلك السجل هم قادة، ومثقفون، وأصحاب مشاريع، ونبويون، وأصحاب كاريزما، ومتفوقون… وما من وسيلة للتحقق من صحة هذه الإضفاءات السحرية على أولئك الأشخاص، إذ إن الشعوب، خاصة في أوقات الشدة، تحتاج للعودة إلى ذلك السجل وتصديقه والإعجاب به. هكذا تبدو مسيرة الأحداث الكبرى الانعطافية في التاريخ، لكنها في هذه الحالة هي مجرد أحداث انعطافية تاريخية قد تكون عظيمة ودفعت الشعوب لأجلها أثمانًا باهظة، لكنها -على نحو ما- خالية من التراجيديا. التراجيديا تنطوي على انعطافات حادة، أحيانًا تبدو مؤلمة وأحيانًا مفرحة، وعلى هزائم وخيبات أمل وبكاء ونشيج وإصرار وتراجع وفقدان أمل وبدء جديد وهكذا… في دوامة ثقيلة الوطء لا يعيشها سوى الناس الذين لم يعد لديهم سوى مواجهة الموت والإبادة بكافة السبل والأشكال، الناس الذين لم يعد أمامهم سوى طريق واحدة هي الدفاع حتى النهاية عن أمهاتهم وآبائهم وأطفالهم وزوجاتهم وحبيباتهم وجيرانهم وأصدقائهم، فإما أن يدافعوا أو يموتوا جميعًا. التراجيديا تتكثف عندما يعرف هؤلاء الناس أنهم سيموتون هم ومن يدافعون عنهم على نحو شبه مؤكد، أو مؤكد! ولكن لا خيار آخر. إلى هذه التراجيديا العاصفة ينتمي عبد الباسط الساروت.
مع مجموعة صغيرة من الرجال خرج يوسف العظمة ليدافع عن سوريا بمواجهة الجبروت الفرنسي وأبهة السلاح والجيش والتنظيم، وكان عارفًا أنه سيُقتل، لكنه كان عارفًا، أيضًا، أنه يؤسس لقيمة كبرى لدى السوريين، وأنه يُعلي من شأن الكرامة السورية. وقد قتل العظمة وترك كرامة السوريين محفوظة وعالية.
وبعد ذلك بزمن طويل اعتدى الأسد على كرامة السوريين، وبعد ذلك بزمن طويل أيضًا ثار السوريون لأجل كرامتهم لتبدأ ملحمة تراجيدية تعد واحدة من أقسى، إن لم تكن أقسى التراجيديات التي عرفها الناس في عصرهم الحديث. وظهر عبد الباسط الساروت ابن الـ 19 عامًا كأحد شخوص هذه الملحمة التي ستبدو في زمن ما وكأنها مكتوبة في زمن هوميروس والأزمان الملحمية.
سيرة الثورة وسيرة الساروت هي سيرة الإرغام. فحين لم يكن للسوريين خيار آخر لاسترجاع حقوقهم، واسترداد كرامتهم التي أهدرها نظام الأسد الهمجي، وحين تسكّرت كافة الأبواب والطرق والنوافذ والمسالك أمامهم لجؤوا إلى العلاج الأخير: الكيّ. الثورة هي الكيّ الذي يتم اللجوء إليه كآخر العلاجات. وعندما رأى الساروت أن النظام يواجه السوريين بالقتل تخلى عن طموحه في أن يكون رياضيًا متفوقًا كحارس لنادي الكرامة بحمص وحارس لمنتخب الشباب السوري، وانضم لثورة الكرامة: قائدًا للمظاهرات في حمص، ومحركًا لها، ومغنيها. قال إنه خرج مع الناس بداية لأجل درعا كنوع من “الشهامة والنخوة”. وأصيب مرارًا إصابات قاتلة، لكنه نجا كشخوص الملاحم. وعندما حوصرت مدن سورية كثيرة، وتدمرت مدن أخرى، ولجأ الناس للسلاح إرغاميًا في البدء، حمل الساروت السلاح وأسس كتيبة “شهداء البياضة” التي أكد أنها لا تنتمي لأي تنظيم ولا لجسم عسكري أو سياسي، وكان هدفه فك الحصار عن حمص، وإدخال الطحين لأهلها المحاصرين الجائعين. وفي الوقت ذاته فعلت الثورة الشيء نفسه: حملت السلاح للدفاع عن الناس وفك الحصار عن المدن: خطان متوازيان ومتلاقيان ومتشابكان ومتوحدان بالوقت ذاته. بعد سنة ونصف السنة من حصار حمص خرج 62 مقاتلًا لفك الحصار ومهاجمة مبنى المطاحن لإحضار الطحين إلى 800 عائلة محاصرة و3000 نسمة، إلا أن النظام استطاع كشف العملية وتدمير النفق الذي تسلل منه المقاتلون واستشهدوا جميعهم في تلك المعركة الإنسانية التي سميت “معركة الطحين”. وفي غمرة سيطرة النظام على المناطق التي خرجت عن سيطرته أُبعد الساروت إلى الريف الشمالي لحمص. وانطلاقًا من هنا سيبدأ خط آخر في هذه التراجيديا الحزينة لكنها شاهقة الإرادة. مسيرة يأس وتغلٌّب عليه/ يأس وتغلُّب عليه بلا هوادة.
بعد الخروج من حمص نوى الساروت الالتحاق بداعش لأنها كما قال: “دولة” وإنها “تقاتل”، ربما يقصد أنها منظمة وتقاتل باتفاق وخطط مركزية. ثم أكّد أنه لم يكن يعرف هذا التنظيم بشكل جيد نتيجة لحصاره الطويل في حمص، لكنه عندما عرف أنها “تقتل الناس ومن كان معه في الحصار ويأكل معه الحشيش” كف عن الالتحاق بها. وكنوع من القتل الرمزي له، أشاع مؤيدو داعش أنه التحق بها، وأشاع بعض مؤيدي الثورة أنه التحق بها، على الرغم من أن داعش لم تعلن ذلك رسميًا، ولا هو أعلن ذلك، وعلى الرغم من نفيه مرارًا التحاقه بالتنظيم الإرهابي عبر العديد من الفيديوهات والمقابلات التلفزيونية إلا أن هذه التهمة لم تزل تلاحقه حتى بعد استشهاده.
لقد قاتل الثائر السوري ومنشد الثورة مع العديد من الفصائل التي تحسب على الإسلاميين وبعضها يحسب كفصيل جهادية، لكنه قال مرة في حوار تلفزيوني: “إذا كانت الثورة هي فصائل وفساد وتنفيذ برامج دول واقتتال فصائل بين بعضها البعض فأنا أغسل يدي من هذه الثورة، لكن هذه الثورة هي ثورة شعب”، وأنه سيقاتل النظام أينما وجد. وهنا نستذكر قول غابرييل غارسيا ماركيز: “إن لحظة من الظلام لا تعني أن الناس قد أصيبوا بالعمى”. الروائي الياس خوري هو من ذكّر مرة بهذا القول لماركيز عندما شرح تفهمه لواحد من مآلات الساروت وقد تخلى عنه الجميع. وبالفعل تواجه الشعوب الإبادة بكافة الوسائل المتاحة.
بعد سنة وشهرين على مغادرته سوريا والإقامة في تركيا عاد الساروت لميادين القتال مثلما يحدث في التراجيديات، واستشهد خلال دفاعه عن مدينة حماه، استشهد بريف حماه خلال حملة الإبادة التي يشنها نظام البراميل مدعومًا بمشاركة الفاشية الروسية على إدلب وريف حماه، استشهد بعد أن مر بكل ما مرت به الثورة، بحيث يمكن لتاريخه الشخصي أن يكون تاريخًا للثورة. ليس بمعنى أن يحل محل الثورة ويحل محل الناس، إنما بمعنى البعد التراجيدي المعقد الذي غلف مسيرته، وهو ذاته البعد التراجيدي الذي غلف مسيرة الثورة، وبمعنى أنه لو تحدثنا عن مسيرته الثورية فإننا نكتشف بالوقت ذاته مسيرة الثورة.
ثمة بعد رمزي آخر في استشهاده وهو الحزن العميم الذي سيطر على معارضي النظام بتوجهاتهم الفكرية والإيديولوجية والسياسية المختلفة، ما يشير إلى أن ثمة ما يجمع التناقضات والتوجهات والأمزجة على الرغم من حالة العصاب التي تسيطر على المشهد العام في سوريا.
الزمن الملحمي يعود في انبثاقات قاسية كاختبار صفيق من التاريخ على إمكانية حلوله في الأزمنة والأمكنة جميعها.
عبد الباسط الساروت.. أيقونة الأيقونات السورية/ مصطفى ديب
باستشهاده يوم أمس، متأثّرًا بجراحه التي أُصيب بها على جبهات ريف مدينة حماة الشمالي، سدّد الشهيد عبد الباسط الساروت، حارس الثورة وصوتها الأبقى، دينه للمدينة التي لطالما خاطبها طالبًا منها، نيابةً عن كلّ السوريين الأحرار، مسامحته عمّا حلّ بها على يد الأسد الأب في الثمانينيات. “يا حماة سامحينا، والله حقك علينا، انت مننا ولينا، وبالجبّار أملنا”. قال حين غنّى أشهر أغانيه “جنّة جنّة جنّة، جنّة يا وطنّا، يا وطن يا حبيب، يا بو تراب الطيّب، حتّى نارك جنّة”.
باستشهاده رسّخ كذلك في مسامعنا صوته وهو يقول: “كبار صغار منعرف انه، يلي بيقتل شعبه خاين”. ولا نستطيع التعامل مع استشهاده إلّا بما قالته والدته: “استشهاد عبد الباسط قوّة الكم يمّة، الله بياخذ العزيزين حتّى يشدّ هممكم”.
عبد الباسط الساروت، لو تتبّعناه، سنكتشف سريعًا أنّه حكايتنا كسوريين. وكذلك، حكاية الثورة السورية كاملةً، بكلّ تفاصيلها وتقلّباتها، منذ بداياتها وحتّى هذه اللحظة التي ترفض فيها أن تلفظ أنفاسها الأخيرة، وتُراهن على معادلةٍ بسيطةٍ وواضحة، كان الراحل من أشدّ المؤمنين بها، كما جلّ السوريين الثائرين. معادلة تقول بأنّ لا حل للثورة إلّا النصر، وإن لم يكن النصر، فلتكن شهادة، المهم أنّ العودة إلى الوراء مستحيلة، وغير واردة أصلًا في حسابات الأحرار.
إنّه كذلك، وببساطةٍ شديدة، قصّة الثورة المروية شفويًا، وشبيهها بكلّ مراحلها. قصّتها يوم بدأت عفويةً وسلمية، يوم وقف وسط الأحرار يغنّي للحريّة وحدها، مُقدِّمًا وجهًا مدنيًّا بحتًا للثورة، لا يُمكن أن يُغادر ذاكرة السوريين. إنّه قصّتها يوم دفعها عنف ووحشية النظام إلى الانتقال من السلمية إلى العسكرة، فغادر الساحات والميادين دون أن يُغادرها، أي الثورة، وحمل السلاح لأنّ الحرية أسمى من أن يتراجع عن المطالبة بها لأنّ النظام يهدّده وكلّ الثائرين بالموت والتجويع والحصار، والنتيجة أنّ لا القصف ولا همجية العصابة الحاكمة استطاعت أن تجعل حارس الثورة يستنكف عمّا بدأه.
يروي الساروت قصّة الثورة يوم خُذلت وتُركت وحيدةً، ولا تزال. يوم صار تقاسم الغنائم والتسابق نحو الحصًة الأكبر أهم من إجبار النظام على وقف تدميره الممنهج لأحياء حمص القديمة، وتهجير ما تبقّى من أهلّها بعد حصارٍ مرير لم يُثني العزائم، وإن خرج في النهاية مخذولًا ومكسورًا من المدينة التي أحب، بعد أن دافع عنها، وغنّى لها، وغيّر وجهها للأبد. وهو أيضًا قصّتها حين ضاق أفقها، وحين بدأ بعض المؤمنين ينفضّون عنها، وحين اجتمع العالم ضدّها لا معها، وحين حاول البعض حرف مسارها، فزرع في جسدها داء الأيديولوجية والتكفير. حينها، لم يعد متاحًا للسوريين إمكانية أن يختاروا ما يريدون، فاختار الساروت، بفعل الخيبات المتراكمة، والخذلان المستمر للثورة، وتحت ضربات النظام وحلفائه المدمّرة والهمجية، ومدفوعًا باليأس، الانتصار للأيديولوجية.
حكاية مبايعة عبد الباسط الساروت لتنظيم داعش كانت مؤقّتة وقصيرة، وكذلك ميله نحو التشدّد. كان الأمر برمّته نتيجة لا قناعة مسبقة، أو انتماءً خالصًا، أو إعجابًا بفكر التنظيم الإرهابي كما نظام الأسد. مبايعته جاءت نتيجة الخذلان والغدر، وردّة فعلٍ لا أكثر على ما حلّ بالثورة آنذاك، دون أن ننسى أن العصابة الحاكمة بوحشيتها وبراميلها وصواريخها الكيماوية لم تترك حينها للسوريين خياراتٍ كثيرة. ولكنّ الساروت الذي اتّهم بالتشدّد آنذاك، سرعان ما انتبه لوحشية التنظيم، وتراجع عن خياره عائدًا مرّةً أخرى إلى الفصائل التي تُقاتل لأجل اسقاط النظام، لا لغاياتٍ أيديولوجية. مؤكّدًا أنّ الأخيرة تقود إلى طرقٍ كثيرة لا تؤدّي جميعها إلى الهدف الأصل، أي الحرية التي ظلّ طوال ثماني سنواتٍ يحنّ إليها.
كان لعودة الساروت هذه ومواقفه الجريئة من الفصائل الإسلامية ثمنًا سيدفعه حين يُبعد عن الشمال المحرّر نحو تركيا، هربًا من محاكمها، أي الفصائل، خصوصًا جبهة النصرة. وخلافه مع الأخيرة وغيرها كان قائمًا على إدراكه بأنّها ترتهن لأوامر المموّلين في قرار تجميد الجبهات أو فتحها، بينما كان يصرّ على قتال النظام وحلفائه حتّى اللحظات الأخيرة، مدفوعًا بالعاطفة والغيرة على الثورة، فهو من المقاتلين الذين تأخذهم العاطفة دائمًا، كما قال في أحد حواراته.
غير أن هذه العاطفة لم تأخذه يومًا بعيدًا عن الهدف الأساس؛ الحريّة وإسقاط النظام. ولم تدخله كذلك بازارات الدول الإقليمية والتحالفات التي فكّكت الثورة، ولم تدفعه للمراهنة على أي أحدٍ لتحقيق النصر، مكتفيًا برهانه على سلاحه وقدرته على القتال دائمًا، ومتّخذًا من شعاراتٍ كـ”يا الله ما إلنا غيرك يا الله”، و”الموت ولا المذلّة”، و”ع الجنة رايحين شهداء بالملايين” عناوين أبدية لمسيرته. ورغم معاناته على يد النظام كما الفصائل المتشدّدة التي استقطبته يومًا كما الكثير من السوريين، والمضايقات التي تعرّض لها، ومحاولات الاغتيال المستمرّة، ظلّ الساروت وفيًا لجمهور الثورة ولنفسه أوّلًا، مصممًّا أن يظلّ قريبًا منهم، وأن يرفض أي مكاسب مادية ممكنة، وأي شهرة محتملة توفّرها له الاصطفافات هنا أو هناك.
كان عبد الباسط الساروت طوال ثماني سنوات ثوريًا عظيمًا، ومقاتلًا مندفعًا، لا يقبل أن تبرد جبهة وتُجمّد أخرى. مشهد توجّهه نحو جبهة القتال في ريف حماة الشمالي على دراجته النارية كان دليلًا ثابتًا على شغفه بمقارعة النظام حتّى اللحظات الأخيرة من حياته. وظهوره قبل ساعاتٍ من إصابته فرحًا بتحرير قرية تل ملح دليلًا أيضًا على أنّه لا يدافع عن ريف حماة لأن هذه المنطقة ضمّته وعائلته وكلّ الأحرار المهجّرين، وإنّما دفاعًا عن الثورة، هو الذي ظلّ مؤمنًا حتّى النهاية بأنّ أي بقعةٍ محرّرة، وإن كانت قرية صغيرة، تكفي لتكون دليلًا على أنّ الثورة لا تزال مستمرّة، وأن العمل الثوري، عسكريًا ومدنيًا، لا يزال ممكنًا.
باختصارٍ شديد، أن نذكر عبد الباسط الساروت يعني أن نستعيد الصورة الأجمل للثورة، صورة المظاهرات الأولى، حيث الرجال والنساء جنبًا إلى جنب، وحيث الساروت إلى جانب الراحلة فدوى سليمان يهتفان للحرية وإسقاط النظام. هذا المشهد وحده ينفي عنه أي تهمة بالتشدد، كما ينفيها عن الثورة أيضًا. هذا المشهد هو ما سنذكره حين يمرّ اسم عبد الباسط الساروت، أو حين تُلفظ عبارة “ثورة”، ولا نبالغ إن قلنا أنّ الساروت هو الثورة، وأنّ الثورة هي الساروت. ولا نستطيع أن نودّعه إلّا بما علمّنا إياه طيلة سنواتٍ: “شهيدنا لا ما مات، زغردلّو يا البنات”.
الترا صوت
ابن كلّ الأمهات السوريّات وأحلامنا.. وداعاً يا الساروت/ صهيب أيوب
يحرقني صوت أمي. تقول عبر الهاتف كأن الفقيد الذي تحدّثني عنه يشبه ابناً لها، شخصاً عزيزاً تعرفه، تعرف خطوط يده وجلده الأسمر وتنهيدات صوته. كأنها ألبسته يوماً حذاءً وسارت معه جنباً إلى جنب إلى مدرسته، كأنها وقفت بجانبه حين كان يفوز في مباريات كرة القدم، وهتفت باسمه عالياً: “عبد الباسط يا حلو!”. أمي عرفته من دون أن تشاركه كل هذا، عرفته كأمٍّ وكامرأةٍ حمصيّة وكمتابعةٍ لمجريات ما يحدث لوطنها الجريح في بدايات ثورته، من الشاشات ومكبّرات الصوت الصادحة عبر يوتيوب، عرفته من ثورتها: الثورة التي ذهبت إلى مكانٍ آخر. حتى لو ارتضى عبد الباسط، هذا الشاب الأسمر صاحب الصوت الشجي أن يتعاطف ويتواطأ مع راياتها السوداء يوماً، ويعدّل لاحقاً، هاتفاً من جديدٍ لثورته ضدّ الظلم، كأن الظلم وحده يشدُّ عصبه ووتره إلى القتال حتى النفس الأخير.
ابن كل السوريات
أمي لا تعرفه حقّاً، كأمهاتٍ سوريّاتٍ أخريات أحببنه وأحسسن اليوم بفقدٍ شديد، هذا الفقد كما وصلني عبر سماعة الهاتف، نديّ وصادق عبر صوتها المحزون. تخبرني عن حزنها الذي سيكبر كشجرةٍ في حديقة خساراتها، هي التي تجاوزت السبعين عاماً، ولن تر، ربما مرّة أخرى، مدينتها حمص. المدينة التي كانت سوقنا ومرتع صيفنا ومتعتنا ومنبت ثورتنا. أمّي الحمصيّة التي خسرت اليوم كما خسر كلُّ أولاد ثورتنا الأم سورية، صوتهم: عبد الباسط الساروت.
تخبرني عنه كأنه أقرب لها من يدي أنا الذي صرت بعيداً. يحرقني صوتها وهي تقول إنه استشهد. وكلمة شهيد بالنسبة لديبة أمي، كلمة تفوق معناها الديني والروحاني والدلالي. هي كلمة تعني خسارةً أكبر منها ومن حبِّها لثورة أهلها وثورتنا الأم، سورية. أمي المنحدرة من حمص، ومن قلعة الحصن، وابنة طرابلس التي عاشت فيها حياتها وتزوّجت فيها وأنجبتنا، لم تمت حمص يوماً في قلبها، ولم تبعدها رحلات الأهل عن حمصها العديّة. كانت رغماً عنها تعود إلى أصوات أهلها ولهجتهم الحمصيّة، من خلال عبد الباسط الساروت، وسيلتها يوماً إلى الحنين والذكريات، بعد أن أحزنها سقوط حمص بيد الديكتاتور. أمي التي تروي لي بصوتٍ شديد الحزن، كم كان صوت هذا الشاب الصادح يجعلها تحلم بمدينة عائلتها وشقيقتها وأحياء لا تزل راسخة في ذاكرتها.
صوت الحرية
كان صوت عبد الباسط الحرّ، يعبر إلينا نحن أولاد طرابلس، أولاد الأمهات السوريّات، خافقاً، يجعلنا نؤمن أن الحريّة التي ينادي بها ناسُنا في حمص، هي حريتنا أيضاً، حريتنا من نظام قتلنا وقاتلنا، نظام عبث بمدينتنا طرابلس، وترك ذئابه يوماً تنهش شبابها. هذا النظام الذي سيطارده صوت الساروت كلّ يوم وإلى أبد الآبدين: ثورة يا وطنا. حين كانت هذه الثورة ولا تزل ثورتنا، من كلِّ أطياف سورية وحين كان الساروت برفقة فدوى سليمان، يقفان معاً: سنّي وعلوية، كي يقولا للأسد أن هذه الثورة أكبر من “تطييف” بذرتها كما أشاع شبّيحته. حتى لو انجرّ يوماً هذا الشاب إلى تيّارات متطرّفة، هو الذي كافح وسيكافح بصوته وبارودته النظامَ الذي قتل أشقاءه ودمّر بيته وسرق منه أحلامه كلها. باعثاً رقّةً تنقصنا اليوم في عالمٍ متوحّشٍ، رقّة تشبه أوتاره التي وزّعها علينا وعلى إيماننا بالحرية، وإيماننا بالخروج من النفق.
جنة، جنة، جنة
يستشهد الساروت حتى لو أراد البعض ألّا يمنحه هذه الصفة، فهي بالنسبة لأمهاتٍ سوريّاتٍ شهادة، كما شهداء كثر قُتلوا أثناء التعذيب أو الهرس أو تحت القذائف وخلف نيران الأخوة والأعداء، وتحت الطيران أو تنشّقوا الكيماوي. الساروت يُقتل ويستشهد لفكرةٍ هي أكبر منه، عرفها وأحسّها حين خرج يوم آذار 2011، صادحاً: “جنّة، جنّة، جنّة، يا وطنا جنّة، يا وطن يا طيب، والله يا وطنا، حتى نارك جنّة”. وبالفعل كانت نار هذا البلد والمحرقة السوريّة جنّة له، أراد أن يختم حياته فيها وبجبهاتها جمعاء. قاتل مع الجميع ضدّ الأسد، حتى أنه قاتل مع الداعشيين وناصرهم مرّة، ثم خلعهم وناصر آخرين.
عايش الساروت كلّ تحوّلات هذه الثورة وتراجيديّتها، وكل مآسيها وخضّاتها وأحزانها وخرابها. حاول حتى الرمق الأخير أن يُقاتل ضدّ عدوّه الأوّل: نظام القتل والأبديّة، منذ حافظ الأب إلى بشار الابن، وآلتهم المجرمة. حاول منذ أن خرج متظاهراً عادياً إلى أن أصبح منشد الثورة ومغنّيها، وقائد حراكها باللحم الحيّ، ضد رصاص الشبّيحة في حمص، ثم مقاتلاً على جبهاتٍ عدّة، تاركاً لكلِّ التحوّلات أن تجذبه وتجاذبه، محاكياً كلّ الصدمات واللغويات العصبيّة منها والطائفيّة وغيرها، حاملاً كلّ الجراح في أوقاتها العصيبة والمدمّرة، في لحظات فَقْدٍ وخساراتٍ وهزائم وانتصارات صغيرة. سار في دروب عدّة حتى لو لم نكن يوماً نؤيّده بها، لأنه آمن أنه يريد أن يحارب وجهاً واحداً لمأساة سوريا: نظامها. أراد أن يُسقط هذا النظام، منذ أن صدح “يسقط يسقط النظام”، إلى حين حمل سلاحه في كتيبته التي قادها إلى حين وصوله إلى ريف حماه الشمالي، حيث أصيب وحيث مات وعينه على الحرية.
هذه ليست قصّةً حزينةً نهايتها نهاية بطل شجاع. أنها قصّة جمعيّة لمآلات مأساةٍ كبرى تُدعى سورية، مأساة جمعيّة لأحوال سوريين هتفوا ضدّ نظام القتل والوحشية والدمار. وهم يأملون بكرامةٍ وعزّة.
الساروت حياً.. لسه الأغاني ممكنة*/ عبدالرزاق دياب
من قال إن الساروت مات؟؟..الأغاني لا تموت، وبعيداً عن فجائعية هذا الخبر على المؤمنين بعدالة قضية السوريين وثورتهم وبآن واحد خذلانهم ومظلوميته، واقتداء بكل قصص الثورة في التاريخ فإن ما فعله الساروت وأمثاله هو سجل خالد يجب أن يورث لأجيال لا أن ندفنه بالدموع.
منذ الفجر وأنا أفجر ماذا أفعل..ماذا يمكن أن يفعل عاجز مثلي ليس لديه سوى كلمات الرثاء والدموع، وقرأت ما كتبه الجميع، وصبرت لأول مرة على الكتابة، وعلى قسوة المشهد دون صوت عبد الباسط، ومن دون أغنياته الجديدة، ومن دون أن يمر حلمه ذات يوم إلى قلبه المدفون في حي البياضة في مدينته حمص.
مرّ شريط الشهداء القديسين وهم كثر، والذين لا نعرفهم كمثل عبد الباسط، أولئك المجهولين الذين لم نسمع بهم، ولم تكتب عنه البوستات وتسجل لهم التقارير، وماتوا بصمت الكبار، ومرت صور كثيرة للمغيبين والممعتقلين والمعذبين، والمهجرين والمهددين اليوم تحت الزيتون وفي كل الأرض الشقيقة والغريبة.
استمعت إلى تقارير عن عبد الباسط..شاهدت أفلاما تسجيلية عن رحلة العودة الفاشلة إلى حمص مع رفاقه، ودغدغت روحي لهجته البدوية الصارمة البسيطة، ومر في خاطري كل البسطاء الذين يشبهون عبد الباسط ولم يكن لهم حظ الظهور مثله، وهؤلاء كانوا هناك في الجنوب وفي جديدة الفضل وخان الشيح وجنوب دمشق وحمص وريف دمشق وقرى الأرياف الثائرة في حماة وحلب ودير الزور..مر كل هؤلاء ببساطتهم وقاماتهم.
خطر لي أن أكتب حد السخط الكبير، وقلت في نفسي أيموت عبد الباسط ويبقى حياً وبيننا كل هذا القيح ممن يدّعون الثورة، وسوف يفعلونها، ويتصدرون مشهد النواح والرثاء، سيقفز هؤلاء اليوم إلى الشاشات ويعرضون صورهم مع الشهيد، ويدّعون علاقتهم الوطيدة به، وأن له مثله ماضٍ من البطولة، وستتصدر عبارات (شهيداً جميلاً) (مات الساروت) العالم الأزرق الافتراضي، ومن ثم ستذوي رويداً رويداً حماستهم إلى النسيان.
هو لا يشبه أحدا، ويشبه الجميع في موته وحياته، ويكفيه أنه لم يتورط مع لابسي البذلات الرسيمة ونياشين الثورة في مالهم وولاءاتهم، ومثل النخلة الطريدة التي أحبت أن تموت واقفة في أرضها، وأن تحاول ما استطاعت غرس جذورها في جوار البيت البسيط في البياضة..حاول الساروت أن يصل إلى أقرب مكان لمسقط رأسه بعيداً عن البحار الغريبة في المنافي.
وهو مثلنا بشر يصيب ويتعثر، يندم ويصيح، ولكننا نهمس فقط ونثرثر، ونناضل في الصفوف الخلفية هذه امكانياتنا وشجاعتنا، ولأن صوته أعلى كان أقرب إلى الوطن، وأكثر حنيناً، وشجاعة.
سنترك خلفنا بالتأكيد مواقفنا وهي أضعف الإيمان في العمل، وسيترك الساروت خلفه كل هذه الحياة التي يرددها الصغار والكبار، وكل هذا النشيج من الحنين، وكل النشيد الآسر من القوة وواقعية المقاتل.
الساروت حياً..أيتها البلاد التي تنجب المغنين وتحفظ الأغنيات…ولسه الأغاني ممكنة.
جيفارا سوريا مات…/ عدنان عبدالرزاق*
هامش 1: ليس أكبر وأصدق من عبد الباسط الساروت بالثورة السورية، ليعلن الحداد عليه وتنكس الأعلام ثلاثاً، فبخسارته اليوم، فقدت الثورة أهم بوصلاتها وباتت دونما بلبل وحارس.
هامش 2: ربما بمحاولتي تكريس ربط الساروت بجيفارا، صح وخطأ بآن.
أما الخطأ أو ما قد يراه البعض كذلك، أننا مهووسون بصور القادة العالميين، ولا نسعى لتسويق أبطالنا بمعزل عن “التبعية” فلربما للساروت أكثر مما كان لـ”تشي” الصديق.
وأما الصح، أو ما رأيته وارتأيته، فربط الساروت بمناضل عالمي، تزيد من انتشار قصته وبالتالي عدالة قضية ومطالب السوريين، إذ لا أرى شبيهاً للثورة، أكثر من عبد الباسط، بما في ذلك تقلباتها التي فرضتها الظروف الذاتية الداخلية والموضوعية الإقيمية والدولية، كما لم أر سورياً مؤمناً بالثورة ومتصالحاً مع نفسه تجاه الثورة ويقينية انتصارها، كما الساروت.
هامش3: فقدت أم عبد الباسط الساروت عام 2011 ابنها وليد شهيداً، وفي عام 2012 استشهد زوجها ممدوح. لتتابع هذه الأسرة زف قرابين للثورة عام 2013 حينما استشهد الابن محمد وتبعه عام 2014 عبد الله شهيداً، وصبيحة اجتياح حلب من نظام الأسد والمييلشيات الطائفية، مات الابن بسام قهراً إثر جلطة دماغية…لتقدم خنساء سوريا”أم وليد” اليوم، أيقونة الثورة السورية عبد الباسط، شهيداً.
هامش رقم 4: بعلمي واطلاعي، لو شاء عبد الباسط الضوء وسعى لحلمه الفردي عبر المحافل والمؤتمرات وعواصم العالم، لكان ربما من أوائل السوريين مالاً وشهرة، بيد أنه، ورغم فجيعة الأسرة وخوف الأم من فقدان خامس أولادها بعد زوجها وإخوتها وحفيدها، آثر الساورت متابعة الثورة بساحة المعركة، كما يليق بمناضل يسعى لقضية سامية ويحقق ولو عبر دمه، الحرية والكرامة للسوريين.
أول من أمس، تلقيت نبأ إصابة عبد الباسط على جبهات القتال بريف حماة، اتصلت بأكثر المقربين له، للتأكد والاطمئنان “المناضل خالد أبو صلاح” تواصل خالد وتواصلت بدوري، ليؤكد لنا الأصدقاء، أن الساروت بخير وإصابته ليست خطيرة، وإن من شيء لفعله، فهو نقله من مشفى أنطاكيا، وهو ما تم أمس إلى مشفى خاص بالريحانية، ليأتي الخبر الفجيعة فجر اليوم باستشهاد عبد الباسط، فكسانا اليتم وفطر قلوبنا فرط الحزن والوجع.
يدايّ ترتجفان، رغم أن الموت حق وكانت الشهادة مطلب عبد الباسط وحلمه مذ قال لأمه “يا يما أنا طالع أخلع ثوب العار” وصولاً إلى “يا يما ثوب جديد، زفيني جيتك شهيد” وما بينهما من أغان باتت شعارات الثورة ونشيدها الوطني، كجنة جنة جنة..سوريا يا وطنّا، وآخر أغانيه قبل أيام”سوريا جانا رمضان، وبعد رمضان العيد. .تاسع سنة ياغالية بينا المرار يزيد”.
فلماذا يا ترى كل هذا الحزن الذي كاد أن يفقدني يقين نصر الثورة وشعوري بموتها مع الساروت؟!
ببساطة، لأن ثورة السوريين، هي تماما كما عبد الباسط، بصدقها وعفويتها وبساطتها، قبل أن تتلوّث ويحاول السراق خيانتها.
ولأن السوريين حينما خرجوا بطلب العدالة والكرامة والحرية، كانوا كما الساروت حرفياً، طبيعيون حماسيون صادقون، لا تحكمهم نظريات ولا توجههم دول وأموال وأجندات.
ولأن الساروت، كما من سبقه للمجد والشهادة، أمثال “أبو فرات وحجي مارع وهرموش”، هم من كرسوا صورة البطل الشعبي والثائر المناضل بذاكرة السوريين، بل وكانوا اكسير البقاء على خط الثورة والاستمرار حتى الحرية، وزاد إلى جانب الشهيدات فدوى سليمان ومي سكاف، أن ألهب الشارع بغنائه وأهازيجه وعباراته البسيطة.
فببساطة، هؤلاء هم السوريون دونما تكلف وتجمّل وروتوش، وهم كانوا الأمل بلجم السراق وتصويب مسيرة ومسار الثورة.
وربما الأهم، لأن الساروت خير من عكس الثورة بتردداتها وارتداداتها، ونقل بصدق مراحلها التي عاشها بحسه العفوي الصادق، حتى بما عابه عليه كثيرون وقتما حمل السلاح إلى جانب أصحاب اللحى المستوردة، ربما ليقينه بأن الديكتاوريات لا تسقط بالمؤتمرات ولا عبر طاولات الخنوع والتنازل.
بكّرت برحيلك أبا جعفر، وإن ختمت نضالك بما حلمت، شهيداً مقبلاً واقفاً تحول دونما تدنيس الأرض وسرقة الأحلام…رحلت يا ابن سوريا ولم تزل بالحلق غصة الحنين للحرية” حانن للحرية حانن، يا شعب ببيتو مش آمن، كبار صغار بنعرف إنو…إللي بيقتل شعبو خاين”.
نهاية القول: أمي وأم السوريين جميعهم، أنت ومن تبقى من أهلك شرف لنا وأمانة بأعناقنا.
أم الوليد الساروت، فقدت خمسة من أولادها وثلاثة من إخوتها وحفيدها، فهل لم تزل بعد اليوم “تماضر بنت عمرو السلمية” خنساء العرب.. يا لهذا الوجع الذي يأكلنا
الساروت.. مسار ثورة/ حسام كنفاني
كل من ناصر الثورة السورية، منذ بدايتها، يعرف عبد الباسط الساروت. له معه حكايات عبر المقاطع المصوّرة التي كانت تخرج من المناطق الثائرة، والأناشيد التي كان يطلقها لتحفيز المتظاهرين السلميين، ولا سيما في حمص. راقبه من بعيد، وهو يتنقل بين أحياء بابا عمرو المحاصرة، لكنه كان يشعر دائماً بأنه قريب، وبأنه صوتٌ يعبّر عن الحلم الذي راود كثيرين، ليس السوريين فحسب، بل كل من تغنّى بالحرية والديمقراطية وزوال الاستبداد. لهؤلاء كان عبد الباسط الساروت رمزاً، خفت في أحيان قليلة، وتوارى عن صدارة المشهد بفعل التحوّلات التي شهدتها مسيرته في الثورة، وهي تحوّلات تشبه، إلى حد كبير، مسار الثورة السورية نفسها، وصعودها وهبوطها، من المدنية إلى العسكرة ونشوء فصائل الجيش الحر، مروراً بالتطرّف وبروز السلفية الجهادية، ووصولاً أخيراً إلى عودة العمل العسكري المعارض بشكل أساس للنظام.
ولكن يحسب للساروت أنه لم يدخل، مثل كثيرين غيره من الناشطين السياسيين والثوريين، في بازارات الدول والمنصّات والائتلافات والتحالفات التي شرذمت الثورة السورية أكثر مما خدمتها، وأدخلتها في متاهات إقليمية ودولية. حتى خروجه من سورية كان قليلاً، ربما مرة أو اثنتين، زار خلالهما إسطنبول، ليعود بعد ذلك إلى بلده. كان مقتنعاً أن عمله على الأرض في سورية، وليس في أي مكان لجوء آخر، على الرغم من الفرص التي أتيحت له، بحسب ما يخبر أصدقاء كثيرون له. آمن بالدور الذي عليه لعبه، لم تغرر به النجومية التي كسبها في بداية الثورة، وتحوّله إلى أيقونة يمكن أن يحتذي بها الناشطون. بل هو ضرب بكل ذلك عرض الحائط، حين قرّر التحوّل إلى التطرّف والانضمام إلى “جبهة النصرة” والاقتراب من مبايعة “داعش”. في تلك اللحظة، كان الساروت يمثل واحدة من اللحظات المحورية في الثورة السورية، والتي اختصرت في الشعار الشهير “ما إلنا غيرك يا الله”، في مواجهة التجاهل الدولي العام للمحرقة السورية، وانضمام فاعلين دوليين وإقليميين لمد يد العون لنظام بشار الأسد في قتل شعبه على مرأى العالم ومسمعه. كانت ترجمة الشعار في ظهور هذه المجموعات المتطرّفة، والتي لم تكن بعيدة أيضاً عن الدعم الإقليمي، واستقطبت شبانا سوريين عديدين، والساروت كان منهم. ومع ذلك، بقيت سيرته حاضرة باعتباره “حارس الثورة ومنشدها”، حتى في مرحلة انفكاكه عن هذه الصفة. لم يرد أي من مناصري الثورة التي قامت على فكرة الحرية والعدالة أن يرى الساروت في هذا المكان، أو يقتنع بأنه انتقل إلى ضفةٍ مغايرةٍ لما كان ينادي به، تماماً مثلما يرفض هؤلاء الاقتناع بأن “داعش” وجبهة النصرة وغيرها من الحركات المتطرفة جزءٌ من الثورة السورية، بل هي مجرد انعكاس لتحولاتٍ مضت إليها الثورة، ولا بد أن تعود عنها. وهذا ما حصل مع الساروت، حين عاد إلى ساحة العمل الثوري، عسكرياً ومدنياً في إدلب وريف حماة، مبتعداً عن التحوّل الفكري الذي أصاب سيرته، محاولاً خط سطور أخيرة مشرفة من حياته القصيرة (27 عاماً)، والتي سجل خلالها الكثير.
لهذا، ولارتباط سيرة الرجل ومساره بثورة آمن كثيرون، ولا يزالون، بعدالتها، جاء وقع مقتله قاسياً ومؤلماً. كل من ناصر الثورة السورية، من بدايتها، شعر أنه فقد عزيزاً أو شخصاً يعرفه حق المعرفة، أو هكذا تخيّل، وهو يرى أن مساحة الحلم ضاقت، وخسرت واحداً من رموزها. أو ربما أسقط، في لا وعيه، نهاية الساروت على الثورة نفسها. هو حزنٌ مضاعف، أبعد من الساروت نفسه. حزنٌ لا بد أن تواجهه قناعةٌ أنه ما زال للحلم بقية، وأن النهايات الحقيقية لم تكتب بعد.
العربي الجديد
الساروت: خطورة الرمز/ ساطع نور الدين
لى مرتبة الاسطورة، لأنه يختزل سيرة شعب مسكين، وحكاية ثورة مجهضة.عديم التجربة في السياسة، محدود الخبرة في الامن، قليل الحيلة في تجنب الهاوية. يعيش على شفير الموت، حاول المرة تلو المرة أن يموت، لعلّه يلتحق بأفراد الأسرة التي أُبيدت بالكامل..وفي الطريق الى حتفه، كان الحداء سلاحه الأقوى، الذي يستخدمه ضد القاتل، لكنه يخفف به عن وجعه الخاص ويسعى الى تقاسمه مع الجمهور.
في وداع عبد الباسط الساروت، تقترب فصول التراجيديا السورية من خاتمتها الحزينة. وتتحول مأساة الفرد الى رمز لبؤس الجماعة. في تشييعه الى مثواه الاخير، تتوارى الشخصيات والتنظيمات والهيئات التي أحتلت مساحة السنوات الثماني الماضية، بما فيها إسم التنظيم الذي ينتمي اليه الراحل، والذي لا يعرف حتى الكثيرون من السوريين عنه سوى القليل. هو يحمل صفة “جيش”، لكنه ليس جراراً ولم يكن حاوياً لذلك الشاب الذي فاجأ المتظاهرين في جميع الساحات، وأدهش المقاتلين على مختلف الجبهات، ولا يمكن أن يندرج في أي إيديولوجيا أو في أي هوية سياسية. الحارس، المغني، المنشد، البطل الشعبي، بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.
إنتهى وقت المفاجأة. آن الأوان للاستفسار عما إذا كان الشعب الذي حفزه الساروت، قد تعرض للابادة بالفعل، وعما إذا كانت الثورة التي تقطعت بها السبل، قد خابت بشكل كامل؟ أم أن الجنازة هي صرخة جديدة في وادي الذئاب التي تمزق لحم سوريا، يمكن ان تؤسس لما هو جديد، مختلف، متقدم عما جرت تجربته في ثماني سنوات عجاف، طويت صفحتها الآن برحيل الساروت، الذي كان مثله مثل غالبية السوريين بلا تجربة وبلا خبرة وبلا حيلة.
تحويل الشهيد الى رمز ليس وعداً كافياً. في سوريا الكثير من الرموز والقليل من المكونات التي تسد الفراغ الهائل، والفوضى العارمة، والفردية الشديدة. وهو حال المعارضة على إختلاف تشكيلاتها، التي لا يزال يقدر عددها بالمئات، ولا تجمعها سوى فوعة الدم أو نصرة الدين، وليس بينها كلام في السياسة ولا حتى بينها وبين المشتتين في مختلف أنحاء العالم، الذين لم ولن يتوصلوا في المستقبل المنظور الى ما يتخطى الالتقاء في مناسبات الهجاء والرثاء والبكاء والحنين. حرب التحرير الشعبية التي لطالما لوحوا بها في وجه المحتلين الروس والايرانيين، ما زالت أسيرة فرضية التدخل الخارجي المعرقل، والدعم الخارجي المعطل، وما زالت رهينة نظرية “حروب الاخرين” على أرض سوريا التي سبق أن روجها اللبنانيون لكي يعفوا أنفسهم من مسؤوليات الحرب، وإنهائها.
ليس لذلك الجمهور الذي أنشده وحفّزه وبكاه الساروت عنوان. هي نتيجة طبيعية للحملة العسكرية الروسية والايرانية الضارية، التي تحرق الارض السورية ومن عليها. لكن هل من أمر يجري تحت تلك الارض، في الملاجىء والمخابىء، في العراء؟ هل من عمل مشترك يتم في الشتات، ويقيم بين أهله رباطاً إنسانياً أو إجتماعياً على الاقل، قبل ان يكون سياسياً. صار مضجراً لوم الممولين والداعمين في تخريب الثورة وأسلمتها وتسليحها. يفترض ان تصبح تلك الملامة من الماضي، وإلا وجب السؤال عن المصالحات التي نقلت السلاح من كتف الى كتف، وأثارت الشك في عمق الالتزام بالثورة، وفي صحة التوق الى التغيير.
تقاتل فصائل المعارضة السورية في الشمال بمهارة وكفاءة عالية، إفتقد إليها أهل الوسط والجنوب والوسط والشرق. لكنه اليوم قتال إنتحاري. لم يعد لدى تلك الفصائل مكان تذهب إليه، ولم يعد لها مدى سياسي سوري يضع المعركة في سياقها الصحيح، يستثمرها، يستفيد منها بأي شكل من الاشكال.. على الاقل لينقض الفرضية الشائعة عن أن عصبية النظام وحوافز جمهوره المتنوع الانتماءات الطائفية، ما زالت أقوى من أن عصبية المعارضة وحوافز جمهورها الذي كان يعتقد أنه الغالبية الساحقة من السوريين.
مات رمز جديد للثورة السورية. قد يكون الاخير.
المدن
الساروت… نشيد الوضوح/ ياسر أبو شقرة
ليس أصدق من خبر الموت سوى رؤية مجلس العزاء، حين ينقلب الخبر يقيناً، ويتشارك الجميع حزنهم فيكبر، هذا ما حدث صبيحة اليوم حين غدت جدران “فايسبوك” وبقية مواقع التواصل خيمة عزاء في رمز الثورة السورية الأكثر شعبية، فعادت أغاني عبد الباسط الساروت في يوم رحيله، لتذكر الجميع بالوطن الجنة، وبحلم الشهادة، وآمال كل مواطن عربي في التحرر منذ مطلع 2011.
لعل الأغنية ذات الأصل العراقي “جنة يا وطنا” من أبرز ما غناه الساروت، بعدما غيّر مفرداتها وحمل أسماء مدن سورية عبر كلماته إلى قلب كل سوري. قبلها، كانت هذه المدن عبارة عن غياهب في عقول سكان المدن الكبرى كدمشق وحلب، الأمر الذي عمد إليه النظام عبر عقود، بتحطيمه لهويات المدن السورية الأخرى، وتهميشه لدورها في البناء الكبير الذي صار يسمى سوريا الأسد، وهو اسم عنيف فاقد لكل ما يؤلفه مع قلوب السوريين، بعدما انتُزعت بلادهم وحيواتهم ودُمغت باسم الأسد، ومع هذه الأغنية باتت حمص مدينة جديدة في وعي الجميع، حرة، كريمة، تنتصر لأخواتها الأخريات الجميلات، ولم تعد الرقة والقامشلي مدناً سورية أقرب إلى العراق في وعي السوريين، بل باتت مدنهم التي يفخرون بها، ويشتاقون لزيارتها حتى لو لم يكونوا قد عرفوها من قبل. في تلك السنة، جزم الكثير من السوريين أنهم لو استُفتوا على نشيد وطني جديد للبلاد، لكانت أغنية الساروت ستفوز من دون منازع، خصوصاً أن حماة الديار هم من هدم الديار وسفك دم سكانها.
في كل منعطف أخذته الثورة السورية، وفي كل حالة توهان خلقتها السياسات الدولية، لو تتبعت الساروت، ستسمع صوت أكثر الناس المتضررين من العصابة الحاكمة، الأبسط، البعيد من الكلام المنمق والدبلوماسي، الحالم الممتلئ حباً. فعلى عتبة الموت، إما أن يكون الوطن جنة، أو هو اجتياز العتبة أطهاراً، والفوز بجنة تنتظر من مات في سبيل كرامته. هذه المعادلة البسيطة التي يؤمن بها جل الشعب السوري، النصر أو الشهادة، المعادلة سهلة النطق، والتي لا يصمد أمامها سوى الأبطال الحقيقيين، وخلال الإصرار على أي منهما تبدأ الأسئلة الكبرى بالظهور، من نحن؟ لم نبذل كل هذا؟ وفي سبيل مَن؟ ولمواجهة ازدحام الأسئلة ليس هناك أبسط من جواب يتألف من عشر كلمات، تجدهم في أغنية الساروت “حلم الشهادة”:
فاقد هويتي يابا، ألقاها فين؟
ولمستا بثورة يابا، ضد الظالمين.
بأكثر الصيغ المنطوقة ركاكة، وتعباً، يجمع الساروت أكثر من ثلاث لهجات ليكمل سطرين في أغنيته، لكن ما حمله السطران من معنى يلخص حياة السوريين منذ استلام حافظ الأسد للسلطة في البلاد، من دون تنظير وكما يحبّ السوريون، كلام من القلب، ويصل إلى القلب قبل أن يعمل التفكير عمله فيه، ليس هنالك ما يؤلم أكثر من ضياع الهوية، وليس أجمل من ثورة تعيدها لك، فتشعر أنها خُلقت من جديد، خلقت في زمان ومكان تلاحقك فيه كل أشكال الموت فقط لأنك حلمت بما هو أجمل من قاتلك.
ومع طول مدة الصراع وازدياد همجيته، ودخول معظم دول الكوكب كضباع تتسابق على وجبتها، شتت الآراء، وضغط العجز ليخبر عن لا جدوى الأمل، فضاعت البوصلات وتفرقت وبقي الساروت على جبهته، مختفياً عن الإعلام، يدرك الفجوة بين من يسمعه في بيته، ومن يعمل معه على خطوط النار. وكأن الساروت أدرك أن ظهوره الإعلامي سيفضح حجم الكارثة على الجبهات، ويزيد الشرخ مزقا إضافية، حيث المليشيات المتقاتلة باتت أقذر من بعضها البعض على اختلاف الانتماء، والولاء، وحجم التمويل، والتوجه فرأيناه يعود من تركيا بعدما دخلها هرباً من محاكم نصبها له آلهة الأرض، الفصائل الإسلامية. وليس خلافها مع الساروت سوى أنه يفضح ارتهانهم لأوامر الممول في تجميد الجبهات وفتحها تبعاً لمصالحهم، بينما يستمر الساروت في رغبته الدائمة والمستمرة بقتال النظام وحلفائه.
وفي الموجة الجديدة من الربيع العربي، كما أسماها الإعلام، وأثناء اختفاء الساروت عن المشهد، وتشتت السوريين في أصقاع الأرض، وترددهم في دعم الجزائر والسودان، بسبب ما اكتسبته نفوسهم من عُقد بعد الانكسارات المتوالية، وخوفهم على مصير مشابه للأخوة في البلدين، ظهر صوت الساروت مع طلوع العيد الذي غادرنا فيه، ليشد على أيدي الجزائريين والسودانيين ويخبرهم أننا معهم، وأننا هنا منذ أعوام ومازلنا نقاوم، فيعيد الأمل لكل السوريين، وأخوتهم العرب.
جتنا الجزاير ثايرة.. بها الحراير سايرة
الخرطوم صاحت حاضرة.. ونقوم إيد بإيد.
إعجاب الساروت بحرائر الجزائر، رغم أن لثورتهم وجوهاً عديدة كان يستطيع الغناء لها، كان خير نفي لكل ما اعتراه من تهم بالتشدد، ألصقها به بعض العلمانيين، ليجتمعوا على كراهية الرجل مع “جبهة النصرة”، في أول مرة يجتمعون على شيء. لكن يوم يموت الساروت سيدرك السوريون جميعاً، في الداخل والشتات، في المناطق التي يسيطر عليها النظام، والخارجة عن سيطرته، علمانيين وإسلاميين، أنه ما من وجه أنظف للبلاد، من شاب بذل كل ما يستطيع، وتحدى كل المنعطفات، وتحمّل الكثير من التهم لأنه كان مضطراً لأخذ القرارات على الأرض، إلا أنه كان وسيبقى عبد الباسط الرمز، وستبقى أغاني الثائر الواضح، أعلى من أي إنتاج موسيقي يحاول أن يحاكي واقع السوريين، ويلخص ما مروا به.
المدن
عن الإصرار والخذلان وانعدام الخيارات.. الساروت متجسّداً بها/ عبدالله الموسى
من الصور المحفورة بالذاكرة جثة الشهيد أمام مقر الكتيبة في حلب، زميل الدراسة والنضال وجلسات القنص كهواة حرب لا باع لنا فيها، تمالكت نفسي ألا أبكي أمام باقي المقاتلين، لكن شهقات صديقي فوق رأس “أبو يزيد الدرعاوي” فجرت عينيّ بسيول الدمع المنهمرة بحرقة قلب.
قائد اللواء والكتيبة والذي يعرف “أبو يزيد” قبلي بأربع سنوات كان كالصخرة، واقفاً بصمت أعلى من كل صرخاتي أنا وصديقي. بعد أكثر من 100 حالة مشابهة لوداع رفاق السلاح، وثبات أبو صالح أمام صرخات أمهات الشهداء، سألته مرة كيف لك أن تتمالك نفسك؟
قال لي الموضوع ببساطة إننا كلنا سنموت إذا بقينا على هذا الدرب، ومَن يستشهد باكراً يفوز أكثر، يبتعد عن الأخطاء والفتن وما تجره عليه من كلام الناس يلوكونه بألسنهم ويقذفونه عند أول زلّة.
وهكذا مضت الأيام تحت وابل البراميل المتفجرة و20 صنفاً من الصواريخ التي فتكت بنا ومَن معنا من المدنيين، حتى ملّ منا الموت وسئم هذا الروتين. نفس القتيل والضحية والمكان والزمان والوجوه الشاحبة المحمولة على أكتاف قلة قليلة ممن بقى.
استشهد الساروت اليوم بعد أن تنبّأ بموته قبل ست سنوات.. ستٌ من الإصرار والضياع والشتات، ليدفن غداً في إدلب وحماة التي هتف لهما من عاصمة ثورتنا حمص العدية.
يُجسّد الساروت الثائر السوري بمجمل الصورة بعيداً عن التفاصيل، بعبثيته التي هزّت عرش الأسد، وإصراره على المواجهة، وخذلانه من القريب والغريب، من أصحاب البيانات.
“بدنا نفتح طريق للعائلات يا بو محمد” والساروت مستلقٍ على سرير مشفى ميداني في حمص المحاصرة.. لا أعلم إلى متى ستبقى هذه الجملة تتردد في رأسي مزاحمة آلاف الصور والأصوات. الساروت الذي فقد 60 من كتيبته لم يجزع لذلك بقدر ما كان مقهوراً لأن المعركة فشلت. ومَن للعائلات من بعدك يا حارسهم؟ “جرح الأخوة وجرح الوطن مين يشفيه”؟
يجسّد الساروت حرفياً حكاية الثورة. مثالاً مثالياً عن الثائر السوري، ابن البلد وصاحب العاطفة الجياشة، ابن الثورة التي سبقه في سبيل نجاحها أربعة من إخوته، وعشرات الرفاق والأقرباء.
الساروت الزاهد أطرب مسامعنا بأناشيد الثورة الهدارة، ومن هنا جاءت قدسيته، ابن ثورة 2011 وابن حمص العدية وابن المظاهرة الأولى وحارس المنتخب ولسان الثوار.
“يا مَن خذلت الخاي”، قالها الساروت بوضوح لمن يريد أن يسمع، خاصة وأن الخذلان بدأ من حمص فعلياً، لكنه لم ينته بها ويبدو أنه لن ينتهي في هذا العالم القذر. ومع ذلك رفض الساروت أن يكون ضحية تتقاذفها بيانات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وبعد مجازر الحصار في حمص القديمة وبابا عمرو قرر الساروت حمل السلاح.
قد يظن البعض أن التحول من أقصى السلمية إلى السلاح هو فقدان للهوية، إلا أن هذا التحول خاضه عشرات الآلاف من المتظاهرين، مؤمنين جميعاً بعدم كفاية المظاهرات مع هذا النظام. كان التحول للسلاح أول اختبار للساروت أمام انعدام الخيارات، في وقت كان الثوار مضطرين أن يختاروا بين سيئ وأسوأ، كان الساروت يفقد هذه الرفاهية أمام الحصار وكارثية المجازر ذبحاً بالسكاكين من قبل الجيران الطائفيين.
وبعد أن بات عدد الرصاص في جعب الساروت ورفاقه أقل من عدد جند العدو المتربصين، كان الاختبار الثاني للساروت أمام انعدام آخر للخيارات. وهُجّر أبناء حمص إلى ريفها الشمالي الذي يبدو أن الساروت لم يكن مرتاحاً فيه لتكون إدلب محطته الأخيرة بعد إجازة قصيرة في تركيا. بعد أن واجه فقداناً ثالثاً للخيارات كي يصل إلى إدلب.
كُتب على الساروت أن يفقد الخيارات حتى عندما أصرّ على القتال في إدلب، إدلب التي تغيرت ملامحها كثيراً خلال السنوات الخمس الأولى واستقر بها الحال كما هي الآن. ولقي في “العزة” مستقراً مناسباً لحمل البندقية مع من تبقّى من كتيبته.
حافظ الساروت إلى جانب البندقية على الغناء، أملاً بموطن كالجنة، لا تهزّه دموع والدته إن أتاها بـ “ثوب جديد”. مقاتلاً شرساً فداء “لأجل عيون حمص” وسوريا.
وهكذا قصّ الساروت الحكاية بنهاية متوقعة جداً، فـ “هيجذ تموت الزلم”، لتكون سوريا الثورة بعيداً عن الأسد و”حرام عليه”.
“خنساء سورية” والدة عبد الباسط الساروت تودّع فلذة كبدها/ جلال بكور
بقُبلات فوق وجنتيه ترافقت مع الدعاء “الله يجعل دربك أخضر يا ابني… حبيبي يا أمي… مأواك الجنة يا أمي”، ودّعت أمّ وليد، والدة عبد الباسط الساروت، فلذة كبدها، في مستشفى مدينة الريحانية، قبل نقل جثمانه إلى شمال سورية.
عبد الباسط الساروت، الملقب بـ”منشد وحارس الثورة السورية”، لم يكن أول فقيد لها، بل هو الخامس في الثورة السورية من أبنائها، كما فقدت خمسة من إخوتها وزوجها واثنين من أحفادها، من جراء المعارك وقصف النظام السوري.
أبناء “خنساء سورية” الذين فقدتهم هم وليد وأحمد ومحمد وعبد الله وبسام، وأخيراً عبد الباسط، رثتهم وبكتهم أمّ وليد واحداً تلو الآخر، كما رثت زوجها وإخوتها وأحفادها.
وشُيع جثمان عبد الباسط اليوم في الريحانية، وسط حشد كبير من السوريين، على أن يدفن في مقبرة الدانا قرب شقيقه عبد الله، بحسب ما تداوله الناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
مصادر مقربة من عائلة الساروت أكدت لـ”العربي الجديد” أن أم وليد لم تطلب من أبنائها يوماً الجلوس أو الهرب من مواجهة النظام، بل كانت تحثّهم دائماً على مواصلة الثورة والصمود في وجهه، مصرّة دائما على عبارة “لله ما أخذ ولله ما أعطى”، عند فقدها فلذات كبدها.
فقدت أم وليد ابنها البكر وليد في قصف طاوله مع عدد من المقاتلين في مدينة حمص نهاية عام 2011. كما فقدت ولدها محمد في نهاية عام 2012، وولديها عبد الله وأحمد في نهاية عام 2014، جراء المعارك والقصف على مدينة حمص القديمة. في حين فقدت بسام في العام الماضي، جراء إصابته بنوبة قلبية وعدم التمكن من إسعافه نتيجة الظروف القاهرة في الشمال السوري.
وخسرت أم وليد زوجها أيضاً في عام 2012 وحفيديها، جراء استهدافهم بالنيران ورصاص القناصة من قبل حواجز النظام السوري في مدينة حمص، الملقبة بـ”عاصمة الثورة”.
ويؤكد مقربون من عائلة الساروت أن ما أصاب أم وليد جعلها جديرة بحمل لقب “خنساء الساروت”، و”خنساء سورية”، وحالها كحال الكثيرات من النسوة السوريات اللاتي فقدن فلذات أكبادهن.
قتل بمعارك ريف حماة.. مسيرة “منشد الثورة السورية” من الملاعب لجبهات القتال
عندما انطلقت الثورة السورية في 2011 ترك عبد الباسط الساروت ملاعب كرة القدم وانضم إلى المظاهرات المناهضة للنظام، وحين جوبهت الاحتجاجات بالقوة حمل السلاح وخاض معارك كثيرة كان آخرها بريف حماة، حيث قُتل منشد الثورة السورية وحارسها كما يصفه ناشطون.
وأعلنت مواقع سورية معارضة قبل يومين إصابة الساروت (27 عاما) بجروح خلال معارك مع قوات النظام السوري في قرية تل ملح بريف حماة الشمالي، ولم يرشح حينها ما ينبئ بأن إصابته تهدد حياته.
لكن فصيل جيش العزة أصدر اليوم السبت بيانا نعى فيه القيادي الميداني الشاب في صفوفه، وأكد الناطق باسم الفصيل النقيب مصطفى معراتي أن الساروت أصيب في فخذه وبطنه ويده وتوفي في مستشفى بتركيا.
وكان الساروت “أبو جعفر” قائد “لواء حمص العدية” في جيش العزة الذي انضم إليه أواخر عام 2017 مع مئات آخرين من المقاتلين المهجّرين من حمص.
وقبل ساعات من الإعلان عن إصابته في قرية تل ملح، ظهر القيادي الميداني الراحل في جبهات القتال بريف حماة الشمالي، وهو يؤكد في تسجيل مصور على الاستمرار في مواجهة النظام السوري حتى “تحرير سوريا”.
وكان خبر وفاة “بلبل الثورة” صادما لكثيرين من مؤيدي الثورة السورية الذين رثوه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعبارات حزينة، تشهد بوفائه للقضية التي من أجلها خرج السوريون للميادين والشوارع قبل أكثر من ثماني سنوات.
رمز ثوري
ورثى قائد جيش العزة جميل الصالح في حسابه على تويتر عبد الباسط الساروت، وأرفق رثاءه بفيديو قديم للساروت ينشد فيه “راجعين يا حمص.. راجعين يا الغوطة”.
كما وصف جيش العزة -في بيان- القيادي الراحل بأنه رمز من رموز الثورة السورية، وتعهد بالاستمرار على نهجه.
وكتب المعارض السوري أحمد أبا زيد في حسابه على تويتر “عبد الباسط الساروت شهيدا.. حارس الحرية وأيقونة حمص ومنشد الساحات والصوت الذي لا ينسى في ذاكرة الثورة السورية شهيدا”.
ورثاه أيضا القيادي بالائتلاف الوطني السوري هادي البحرة حيث كتب عنه في تغريدة بتويتر “الشاب عبد الباسط الساروت سيبقى حيا.. اختار وعقد العزم واستشهد على أمل أن يتحقق حلم السوريين”.
من جهته كتب الإعلامي أحمد موفق زيدان في حسابه بتطبيق تلغرام “صوتك سيبقى يدوي في الأجيال الراهنة والمقبلة.. وستظل دماؤك شعلة حرية حتى تطهير الوطن..”.
أما الناشط هادي العبد الله فكتب في صفحته بموقع فيسبوك أنه “لا كلام ولا مفردات تعطي البطل حقه… لطالما تمنى الشهادة على أرض سورية”.
منشد الثورة
وكان الساروت حارس مرمى منتخب سوريا للشباب ونادي الكرامة بحمص، لكنه سرعان ما التحق بالمظاهرات المناهضة للنظام في مارس/آذار 2011.
ولأن هذا الشاب -الذي كان حينها دون العشرين- من سكان حي البياضة في حمص، فقد انضم إلى المظاهرات الحاشدة التي كانت تخرج في ساحات المدينة، وخاصة منها ساحة الساعة.
وخلال تلك المظاهرات، برز عبد الباسط كمنشد يردد الهتافات الثورية تحفيزا للمتظاهرين الذين كانوا ينادون بإسقاط النظام.
وكان من بين تلك الأناشيد “جنة جنة والله يا وطنا”، ثم كان من أناشيده بعد التهجير نحو الشمال السوري “راجعين على حمص.. راجعين على الغوطة”.
وفي 2014، روى فيلم “عودة إلى حمص” للمخرج السوري طلال ديركي -والذي نال جائزة في مهرجان ساندانس الأميركي للسينما المستقلة- حكاية شابين من حمص، أحدهما الساروت.
كما تضمن ألبوم غنائي جمع أناشيد راجت خلال المظاهرات المناهضة للأسد في بدايات الثورة، أغنية “جنة” بصوت الناشط الراحل. وطُبعت صورته على طوابع بريدية رمزية صممها ناشطون معارضون في 2012 لتوثيق الاحتجاجات.
ولم تقتصر مشاركة الساروت في المظاهرات على مدينة حمص، بل شارك وأنشد خلال مظاهرات خرجت في مدن بالشمال السوري كمدينة إدلب، ضد هجمات قوات النظام السوري على مدينة حلب ثم على محافظة إدلب نفسها.
ضريبة كبيرة
دفع الساروت ضريبة كبيرة لمشاركته في الاحتجاجات ثم في المعارك ضد قوات النظام السوري.
فقد قتل خمسة من إخوته برصاص النظام، حيث قتل الأول بحي الخالدية في 2011، والثاني في 2013، ثم قتل اثنان معا في 2014 في أواخر الحصار على حي الخالدية بحمص، في حين قتل أخوه الخامس في إدلب متأثرا بإصابات سابقة.
ووفق ناشطين، فإن والده قتل أيضا جراء القصف، في حين أن والدته فقدت بدورها خمسة من أشقائها.
وفي مقابلة أجراها معه ناشطون، روى الساروت مسيرته منذ اندلاع الثورة، ومن التفاصيل التي ذكرها أن قوات النظام قتلت اثنين من أشقائه وأخا له من الرضاعة خلال عملية دهم لمنزلهم بحمص، وكان النظام السوري قد عده منذ الأيام الأولى ضمن من يصفهم بالخونة، ورصد مكافأة لمن يبلغ عنه.
ومما رواه الساروت في المقابلة نفسها أنه بات مهددا بالاغتيال في أي لحظة، لذلك حمل السلاح دفاعا عن نفسه.
وبعد قمع النظام الدامي لمظاهرات مدينة حمص، تشكلت كتائب مسلحة تابعة للمعارضة بينها “كتيبة شهداء البياضة”.
وبعد مقاومة استمرت نحو سنتين ونصف السنة تعرض خلالها مئات المقاتلين وعائلاتهم للتجويع، تم في 2014 إجلاء المعارضة المسلحة نحو ريف حمص الشمالي، قبل أن يُهجّر لاحقا إلى الشمال السوري.
وكان الساروت ممن هُجّروا نحو الريف الشمالي، وهناك اشتبك مع جبهة النصرة التي اتهمته بموالاة تنظيم الدولة الإسلامية، وهي تهمة نفاها الرجل في حينه، ثم انتقل إلى تركيا وظل فيها أكثر من سنة ليعود مجددا إلى سوريا وينخرط في جبهات القتال ضد النظام بالشمال السوري.
التعلق بالثورة
وفي واحدة من عدة مقابلات أجريت معه، قال الساروت إن قلبه تعلق بالثورة لأنها ثورة عزة وكرامة على حد وصفه، مضيفا أن التضحيات ومنها التهجير المستمر من منطقة إلى أخرى هي ثمن قليل للحرية.
كما قال إن الثورة ستعود من جديد، كما انطلقت من درعا، حتى لو سيطر النظام على ما تبقى من مناطق للمعارضة.
واشتهر الساروت بأنه ليس ممن يحبون المديح، فقال في مقابلة منشورة بمواقع التواصل الاجتماعي “يقولون عني إني حارس الثورة ولكن الثورة لها حراس.. ويقولون عني منشد الثورة وللثورة منشدون”.
وأضاف معبرا عن تواضعه “أنا شخص من هذه الثورة ولا أحب التمجيد وضد تمجيد أي قائد وإنما التمجيد للشهيد والجريح والأسير”، مؤكدا أن الثورة لم تكن طائفية بل قامت ضد الطغيان.
الثورة السورية تودع حارسها ومنشدها… وفاة عبد الباسط الساروت أبرز ثوار حمص
توفي صباح اليوم السبت، القيادي في جيش العزة التابع للجيش السوري “عبد الباسط الساروت” والملقب بـ”حارس الثورة السورية وبلبلها”، بعد تعرضه لإصابات بليغة قبل يومين خلال محاولته إسعاف بعض عناصر المعارضة بعد تعرضهم لهجوم في منطقة “تل ملح” في ريف حماة الشمالي وسط سوريا.
مصادر خاصة، قالت لـ “القدس العربي”: الساروت أصيب بقذيفة هاون خلال عملية الإنقاذ، ولم تكن إصابته بالطفيفة، بل تعرض لنزيف داخلي شديد في البطن، بالإضافة إلى جروح في الساق والذراع، واستمر النزيف لوقت طويل حتى تمكنت فرق الإنقاذ من إيصاله إلى المشفى.
المتحدث الرسمي باسم جيش العزة، النقيب مصطفى معراتي، تحدث عن نقل الساروت إلى داخل الأراضي التركية لتلقي العلاج، ولكنه تعرض لنزيف داخلي شديد قبل ذلك في البطن، علاوة عن تفتت العظم في الساق، وكسر في اليد.
وينحدرُ عبد الباسط من عائلة هاجرت من الجولان واستقرّت في حي البياضة في حمص والتي وُلد فيها في الأول من كانون الثاني/يناير عام 1992.
وقال المتحدث لـ “القدس العربي”: انضم عبد الباسط الساروت إلى جيش العزة برتبة قائد “لواء حمص العادية”، قبل ثلاثة أعوام تقريباً، أي منذ خروجه من حمص، واستمر ذلك حتى وفاته صباح اليوم السبت، مشيراً إلى أنهم سيقومون بنقل جثمانه إلى الداخل السوري حتى يدفن هناك.
الساروت، الذي كان حارس منتخب سوريا للشباب قبل الثورة السورية، عُرف عنه في الفترة الأخيرة مشاركته في العديد من المعارك، إلى جانب مشاركته بمظاهرات سلمية وغيرها من النشاطات، وكان قد فقد أربعة من أخوته وكذلك والده خلال الأعوام السابقة، ففي عام 2011 توفي شقيقه “وليد”، وفي عام 2012 قتل والده “ممدوح”، وفي العام التالي قتل شقيقه “محمد”، وآخر من توفي من أخوته كان “عبد الله”، وذلك في عام 2014، وجميعهم قتلهم النظام السوري.
كما تفاعل مئات آلاف السوريين مع خبر رحيل الساروت، ونعته مئات الحسابات الشخصية والعامة على مواقع التواصل الاجتماعي، واشتملت كلمات مودعيه ومحبيه على المديح له ولتاريخه النضالي ضد النظام السوري، ووفاء العهد حتى الاستشهاد.
ويقول القيادي في الجيش الحر “مصطفى سيجري” لـ “القدس العربي”: “هنا الصمت يغلب، وتعجز الكلمات عن الوصف في حضرة الأبطال، الساروت رمزاً ثورياً وطنياً، الساروت ثورة شعب وحارسها الأمين، قدم كل ما يملك من أجلها، خسارتنا اليوم عظيمة ولا تقدر بثمن، ترجل الفارس ورحل البطل تاركا خلفه ثقل الأمانة وواجب الاستمرار في التضحية والعطاء من أجل سورية التي أحبها وأحببته، سيبقى الساروت حيا في وجدان الشعب السوري وخالدا في ذاكرة الأحرار، وقد حفر إسمه بماء الذهب إلى جانب الرموز السورية الوطنية على مر التاريخ”.
وإثر اندلاع حركة الاحتجاجات في سوريا، قاد الساروت تظاهرات في مدينته حمص (وسط)، التي يعدها ناشطون “عاصمة الثورة” ضد الرئيس بشار الأسد.
ومع تحول التظاهرات إلى نزاع مسلح، حمل الساروت السلاح وقاتل قوات النظام في حمص قبل أن يغادرها في العام 2014 إثر اتفاق إجلاء مع قوات النظام بعد حصار استمر عامين للفصائل المعارضة في البلدة القديمة.
وفي العام 2014، روى فيلم “عودة إلى حمص” للمخرج السوري طلال ديركي، والذي نال جائزة في مهرجان ساندانس الأمريكي للسينما المستقلة، حكاية شابين من حمص أحدهما الساروت.
كما تضمن ألبوم غنائي جمع أناشيد راجت خلال التظاهرات في العام 2012، أغنية “جنه” بصوت الساروت. وطُبعت صورته على طوابع بريدية صممها ناشطون معارضون في العام 2012 لتوثيق حركة الاحتجاجات ضد النظام.
ونعى ناشطون معارضون وقيادون على صفحات التواصل الاجتماعي الساروت. وكتب الباحث والمعارض أحمد أبازيد على حسابه على تويتر “عبد الباسط الساروت شهيداً حارس الحرية وأيقونة حمص ومنشد الساحات والصوت الذي لا ينسى في ذاكرة الثورة السورية شهيداً”.
وقال المعارض في الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة هادي البحرة على تويتر “الشاب عبد الباسط الساروت، سيبقى حياً، اختار وعقد العزم، واستشهد على أمل أن يتحقق حلم السوريين”.
وكان النظام السوري قد رصد مبلغ مليوني ليرة (35 ألف دولار) للقبض عليه، حيث إنه مطلوب لعدة فروع أمنية وقد حاول النظام السوري اغتياله ثلاث مرات على الأقل. في حين قتل النظام خاله محي الدين الساروت.
القدس العربي
الساروت ووالدته وأغنياته/ معن البياري
يستثير فيديو صورة والدة شهيد سورية، عبد الباسط الساروت، تقبّله وتودّعه إلى الجنة، زوبعة من اللواعج التي تتْعب اللغة في البحث عن مفرداتٍ تعبّر عنها. واللاعج في المعاجم حُرقة القلب من الحب. وسيرة هذا الشاب الذي غادر الحياة عن 27 عاما مثقلةٌ بما يجعل حبّه ليس شعورا عاطفيا فحسب، وإنما حاجة يتسلح بها كل فردٍ منا، لتُسعفنا في مناوأة كل تعاسةٍ في العالم، في كل العالم. .. تنطق صورة الجثمان المسجّى، وحواليْه جمعٌ من رفاق عبد الباسط ومن الشباب السوري النظيف، يحيطون بالأم المكلومة، بحزمةٍ من المعاني، تجعل التخلص من نظام الأسد في سورية ضرورةً من أجل حفاظ الجنس البشري على اسمِه هذا جنسا بشريا. تتملّى في الصورة، وفي بالك أن عبد الباسط الساروت هو ابنٌ خامس لهذه المرأة، يرتقي إلى الأعالي بفعل جرائم هذا النظام الذي تقصّد مرّات قتل هذا الثائر النبيل، صدّاح الثورة السورية وبلبلها عن حق، حاول مرّات وأخفق، أعلن عن آلاف الدولارات لمن يرشدُه إليه. تُحدّق في الصورة، وفي بالك أن ثلاثة من إخوة المرأة، أخوال أولادها، قضوا أيضا برصاص نظام القتل نفسه، وكذا اثنان من أحفادها، وزوجُها أيضا. أي خنساءَ إذن، تلك التي شابه بعضُنا هذه الأم، الزوجة، الأخت، الجدّة، بها. المخيّلات الفقيرة جعلتها كالخنساء، فيما مخيلةٌ رحبةٌ كانت سترى هذه المرأة التي كانت تقول “لله ما أعطى ولله ما أخذ” جبروتا لا مثالَ له، أرضا لا تجفّ، وإن ينعف منها الدم كثيرا، وإن يسّاقط الدمع فيها كثيرا.
ربما يصيب نجاحا من يكتب، بحذاقةٍ ونباهةٍ ضروريتين، عن عبد الباسط الساروت من مدخل التعليق السياسي على لحظةٍ مستجدة، بالغة الصعوبة، تعبر إليها سورية وثورة شعبها وخرائط مستقبلها، ولكن الحمولات الوجدانية والعاطفية الباهظة في هذا الحدث المجلّل بأرطالٍ من الأحاسيس المرّة لا تجعل كتابةً من هذا اللون ميسورة، سيما أن صور تشييع الساروت، والأهازيج التي هتفها المحتشدون في وداعه، والموكب المهيب الذي نقله إلى مدفنه، لا تترك لأي كلامٍ في السياسة موضعا جدّيا. ببساطةٍ، لأن حارس مرمى منتخب شباب سورية لكرة القدم سابقا، ومغنّي ثورة السوريين، وشهيدها الشجاع، الفارس، يغادر الدنيا بطلا شعبيا، أمثولةً استثنائية، لا يمنّ عليه أحد عندما يخلع عليه صفته أيقونة. ثمّة بساطةٌ شاسعةٌ في انتقاله من لاعب كرة قدم إلى ثائرٍ بالأغنية والتظاهر وبالبارودة. قال إنه لم يكن يهتم بالسياسة، ثم صيّرته جرائم النظام ضد السوريين، في مدينته حمص وغيرها، يصبح من الثائرين، الساخطين الناقمين الغاضبين، الساعين إلى تحرير سورية من الحاكمين القاتلين فيها. هذه هي القصة فحسب. ثم في سبع سنوات، صار الساروت يغنّي، ويتظاهر، ويقاتل.. ثم يُقتل.
كأن صوت عبد الباسط الساروت احتاج إلى شيءٍ من اللكنة البدوية، والبحّة العراقية، ليلهج بأغنياته القصيرة، المشحونة بحب البلد، بسورية جنّةً، بالوطن “الحْبيّب”. كتب زملاؤه كلمات أغنياته، ولحّنوها، تبدو غير سوريةٍ تماما، ففيها تلك الرّنتان، البدوية والعراقية، وقد لا يكون زعمي هذا دقيقا تماما، الأهم أنها تضرب الخسيس المطلوب رحيلُه بالهجاء الذي يليق به، وتحتفي بحمص، وبالنصر والشهادة، وذلك كله بقاموسٍ متقشّف، ومفرداتٍ لا تتقصد الشعرية، ولا الإيحاء، فما تنطق به عن السلاح وحمْله “لأجل عيونك يا حمص” هو المُراد منها. ولمّا جاءت آخر أغنيات الساروت (إنتاج تلفزيون سوريا، 2019) على ثورتي الجزائريين والسودانيين، وتمنّت لمصر خلاصا من الطاغية فيها، فذلك يستقيم مع الجوهريّ في كفاح هذا البطل الشعبي، الحمصي الجولاني المنبت، استهداف الظلم، والهجس بالعدالة.
باسل شحادة، وغياث مطر، وإبراهيم القاشوش، وزران زيتونة، وسميرة الخليل، ورائد الفارس، وحميد الجنيد، وفدوى سليمان، ومي سكاف، وباسل الصفدي، وعمار جربوع، ونيراز سعيد، وعبد الباسط الساروت.. أسماءٌ لشجعان سوريين وسوريات وفلسطينيين، فنانين ومبدعين، ثوارٍ ومناضلين، أقمارٍ دلّ ضياؤها الباقي على أن الأمل في انتصار سورية على نظام الفتك والقتل غزير، وهذه وداعيات عبد الباسط، وقبلات والدته على جبينه، وأغنياتُه، تنعش هذا الأمل الذي لا يغيب.
العربي الجديد
حناجر ثائرة: عبد الباسط الساروت ورفاقه/ عبد الله البشير
حتى لحظة إصابته الخميس الماضي في ريف حماة السورية، ثمّ رحيله يوم السبت، بقي عبد الباسط الساروت، مقاتلاً ومؤمناً بانتصار الثورة السورية ومبادئها على قمع وإجرام نظام بشار الأسد، وحلفائه من الإيرانيين والروس واللبنانيين. بسلاحه وبحنجرته، اشتهر الساروت، فكان منشد الثورة، وصاحب أبرز الأناشيد التي رافقت سنوات الانتفاضة السورية منذ العام 2011. ولعل أشهر ما غنّاه كانت “جنة جنة جنة”، التي غيّر كلماتها لتناسب الوضع السوري.
الساروت الملقب بـ”بلبل الثورة وحارسها” وفق التسمية التي أطلقها عليه رفاقه، كان من الرموز التي جمعت أحرار سورية، وصدحت حناجرها بالهتافات ضد النظام، والأهازيج المطالبة بالحرية. لكن الساروت لم يكن وحده في ساحات الهتاف، وإن كان الأكثر شهرة بسبب شجاعته الكبيرة. بل إن الثورة منذ لحظاتها الأولى، عرفت عدداً من المنشدين، الذين أطلق عليهم لقب “القاشوش”، تيمناً بإبراهيم القاشوش، ابن مدينة حماة، الذي اشتهر بقيادته للتظاهرات السلمية هناك، فلم يحمل السلاح، لكن كلماته كانت كافية لتزعج نظام الأسد. مصير القاشوش لا يزال حتى اليوم غامضاً، فبينما انتشرت روايات في سنوات الثورة الأولى عن قتله واقتلاع حنجرته، قالت أخبار أخرى إنه لاجئ في إحدى الدول الأوروبية وقد توارى عن الأنظار حفاظاً على حياته.
حاول النظام طيلة هذه السنوات قمع المنشدين وأصحاب الهتافات في الشوارع، لكن وحشيّته فشلت أمام كثيرين، بينهم سيفو العكر أحد أبرز الأصوات التي صدحت ضد النظام في الغوطة الشرقية.
وقضى العكر ابن مدينة سقبا (1991) في ريف دمشق، بحادث سير في على طريق مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي في مايو/أيار 2018، وكان يلقب بـ”قاشوش الغوطة”. وعرف عنه نشاطه الإعلامي وعمله الدؤوب على مساعدة أهالي مدينته، ليغادر معهم خلال تهجيرهم للشمال السوري، حيث قضى.
أيضاً اشتهر في الغوطة الشرقية المنشد موفق النعال ابن مدينة دوما (1962) الذي لقب بـ”أبو عماد المنشد”. وهو واحد من الأصوات المميزة التي قادت التظاهرات. لكن تعرض المنشد للاعتقال على يد عناصر هيئة تحرير الشام في 9 يناير/كانون الثاني 2018 ، لتفرج عنه الهيئة بعد ضغوط شعبية ومدنية. ولا يزال المنشد مقيماً في الشمال السوري.
ومن بين الأصوات التي حاول نظام الأسد تغييبها أيضاً طارق الأسود ابن مدينة حمص (1989) المعروف بـ”بلبل حي الملعب”. وقد اشتهر بشخصيته اللطيفة والمحببة بين الناس. وطارق وجد مكاناً لنفسه على الأكتاف ليقود التظاهرات بصوت ثابت، ويثير حماسة من حوله، متنقلاً بين أحياء الملعب وبابا عمرو، والإنشاءات، والحميدية، لينتهي به الأمر أسيراً لدى النظام.
اعتقال الأسود لأربعة أيام في زنازين نظام الأسد، كانت كفيلة بتشويه جسده، وزرع الندوب فيه. وبقيت هذه الجراح أشهراً على جسده، لكنها لم تثنه عن العودة والالتحاق بتظاهرات الحرية في مدينته، وأثناء مشاركته في أحد التحركات الشعبية يوم الجمعة 24 فبراير/شباط 2012، أصيب بجروح بالغة مع صديقه أنس طرشة، ليفارقا الحياة سريعاً.
يُذكر في هذا السياق الناشط غياث مطر ابن مدينة داريا في ريف دمشق، الذي ثابر على قيادة المظاهرات فيها، مؤكداً على سلمية الثورة السورية عند انطلاقها. مطر الذي ولد في 8 أكتوبر/تشرين الأول 1986 في مدينة داريا، تميز بأخلاقه العالية، وصوته العذب. في الثورة لُقب بـ”غاندي الصغير”، لكن سلمية غياث لم تشفع له، فلاحقته قوات النظام لتعتقله في 6 سبتمبر/أيلول 2011. انتفضت مدينة داريا مطالبة بالإفراج عنه، لكن غياث قضى تحت التعذيب في معتقلات الأسد. وقد سلم جثمانه إلى أهله، وكانت تكسوه الحروق والجروح، كما شق عنصار النظام بطنه قبيل تسليم جثته.
ومن غياث إلى سميح شقير “الحنجرة الثائرة”، التي حملت هموم الناس منذ ما يزيد عن 30 عاماً. آمن بتحرير الإنسان قبل الوقوف بوجه الطاغية. الفنان أعلن موقفه المناهض للنظام صراحة منذ اليوم الأول لاندلاع الثورة، ليهدي أغنيته “يا حيف” لأطفال درعا مع انطلاقة الثورة عام 2011. وسميح شقير فنان سوري، ومغنٍّ، ومؤلف موسيقي، وشاعر من مواليد الجولان السوري المحتل، وعاش حياته قبل المنفى الفرنسي في قرية القرّيا (محافظة السويداء)، وبدأ بتقديم أغانيه على المسارح عام 1982، ويقيم حاليا في العاصمة الفرنسية باريس.
كل هؤلاء المنشدين والفنانين شقوا بحناجرهم الشجاعة طريقاً لحرية السوريين، ليصبحوا كما الساروت رموزاً لا يغيّب الموت ذكراها.
العربي الجديد
أمير العراء/ روجيه عوطة
كان عبدالباسط الساروت ساحراً، ومرد هذا السحر، الذي يتصف به المحاربون، أنه، ومنذ العام ٢٠١١، منذ وقوع الثورة التي اسقطت كل شيء، أقام في العراء، ومع الوقت، علم كيف يحوله إلى مكانه، ويغدو أميره. في آخر طلة له مع رفاقه من حماه، أبدى ذلك السحر مكتملاً بوجه بهي، ثم عاد وأبداه من جديد في آخر أنشودة له، التي طبعتها نبرته، نبرة العزم بعد الفقد، ليكون قصدها الإمداد به لكل الأحرار في السودان، وفي الجزائر، وأينما كان. فمن سمات المحاربين أيضاً، أنه، وفي صراعه من أجل الحرية، يشعر بصراع امثاله، الذين يصنعون تواريخهم، وبهذا الشعور، يوآزرهم فيه.
جاء الساروت إلى العراء من العراء، برياضته، بجسده، بحركته، وانطلق في خوضه، مرة بصوته، ومرة بسلاحه، وبصوته وسلاحه في كل المرات. وضع الساروت كل وجوده في خدمة هذا الخوض، أي في اقباله على وجود مختلف، لا محل فيه لنظام بشار الأسد، لنظام المجزرة، فالثورة، في أساسها، هي وضع الوجود على المحك من أجل معاودة خلقه. الساروت مضى في هذا المذهب حتى عقبه، وهو، على حال كثرة من الثوار السوريين، تعداه، وانتقل إلى جانبه الآخر، حيث يلتقي بهم، وحيث يستقبلونه: حمزة الخطيب يمسكه بيده، ابو فرات يشد على كتفه، مي سكاف تبتسم له، وباسل شحادة يصوره، وغياث مطر يقدم له وردته، والحجي مارع يطلق الرصاص احتفالاً به… الجميع هنا يرحب به بين شعبه الثوري، بين هذا الشعب المقبل.
اذا كانت “كل ثورة تثوّر مفهوم الثورة” على قول فيلسوف، فمحاربوها هم وحدهم المنوطين بهذا التثوير، وتجربة الساروت دليل طويل على ذلك. إذ إن الثورة بالانطلاق منها هي الحياة بنفسها، هي الحياة، التي لا يتوقف اليوم طردها، فترجع عبرها، ليتخللها اندفاع، وتخبط، وشكيمة، وانجراح، وتعثر، وسقوط، ومواظبة، وهمة، وصراخ، وتنظيم، وحماسة، ورفض، ومستحيل، لتجيء عارية من أي ضبط، من أي تمثيل مسبق عنها، من أي نمذجة، من أي فرض عليها، ليصنعها محاربوها بالتوازي مع عيشها. بهذا المعنى، ثورة الساروت، وعندما لا تلتزم بأمر التشكل في خطاب أو في وجهة أو في لغة أو في منظر، تكون عين السياسة. “قبل الوجود، هناك السياسة”، يقول فيلسوف آخر، وثورة الساروت، لأنها وضع لهذا الوجود على المحك لخلق غيره، لا يمكن أن لا تكون سياسية، لا يمكن أن تكون سوى مثلما كانت.
لم ينزل أمير العراء روحه عن كفه، رفعها عليه وحيداً مع شعبه الذي قتله نظام بشار حافظ الأسد، ونفاه العالم “القذر والمتوحش” (رزان)، والغبي. بقي محارباً في تلك الأرض التي خرجت على الأبد، في تلك الأرض، التي تعرف عليها من خلال القتال، والتي احبها بفعله. فهو، وعلى تصريح منه، كلما حارب في مدينة وقرية وحي وشارع، يصير متمسكا أكثر فأكثر بكل هذه المطارح. المحاربون، وبقتالهم، لا يصنعون التاريخ سوى لأنهم يصنعون الجغرافيا، لأنهم يرسمون خرائط للأرض، لا من أجل اعتقالها، بل، وعلى العكس تماما، من أجل الدفاع عنها وتحريرها. صناعة وجود، وصناعة جغرافيا، وصناعة تاريخ، هذه هي حياة المحاربين، وهذه هي الثورة الساروتية.
ولكن، هل يموت محارب لنظام الأبد؟ طبعاً لا، وهنا، الجواب ليس ضربا من الإنشاء، لكنه، يستند إلى كون ثورة ذلك المحارب لا تزول بالمطلق، وهذا، لأنها تحضر في كل حدث من قبيلها، وعندها، ثمة من سيخوضها على نحوه، ثمة محاربون سيولدون على هذا النحو. فعبد الباسط الساروت لا يموت بل إنه يعبر، وكما كان محاربا في الأرض، كذلك، سيكون في الغياب.
المدن
استُشهد لكنه لم يُهزم/ باسل العودات
ربما كان قليلَ خبرة في السياسة والعسكرة، لكنّه كان خبيرًا في إبقاء جذوة الثورة متقدة، وخبيرًا في حب الحرية والأرض والإنسان، ولم يكن يحمل أيديولوجيا راسخة أو محددة، ولا أيديولوجيا منفعية أو مصطنعة، بل كانت أيديولوجيا همّها تحقيق المعاني التي تحملها فكرة الثورة، ولم يضع أمام عينيه الحصول على مكاسب شخصية، وآثر البقاء في أرضٍ تستعر، حيث يعيث النظام السوري وحلفاؤه قتلًا وتدميرًا، ولم يكن يكترث بأن يكون ضحيتهم التالية، وتابع ما بدأه قبل ثماني سنوات، فغنّى ونظم الأشعار، وبثَّ التفاؤل بأن ليل الاستبداد زائل لا محالة، وأن شمس الحرية ستشرق في سورية قريبًا.
استُشهد عبد الباسط الساروت، الذي يُعدّ من الرموز القليلة الباقية لتلك الأيام الجميلة للثورة، أيام التظاهر السلمي والغناء والقصائد، أيام الحلم بالتغيير السياسي الممكن والقريب، وأيام توزيع الورود على جلّادي النظام مقابل رصاصهم.
استُشهد الساروت، لكنه لم يُهزم، وسيبقى في ذاكرة السوريين ومذكراتهم وأدبيات ثورتهم، ولن يُنسى، وسيظل شوكة في حلق الجلاد، حيًا وميتًا، وسيبقى مُلهمًا وصاحب تجربة تُحاكي تجربة الثورة السورية، بكل ألقها ونكساتها وتغيراتها وتبدلاتها وحمولاتها واحتمالاتها وطرقها الشائكة، كما تُحاكي تجربة شعب مسكين حلم بالحرية والكرامة والشمس التي لا تغيب، فأُبيد.
استُشهد الساروت، لكن الفكرة التي ضحى من أجلها لن تموت، سقطت الراية من يده، ولا بد من أن هناك من سيحملها، فالحق دائمًا يجد وراءه مُطالبًا، والحرية دائمًا لديها من يرنو إليها ويُقاتل من أجلها، والسنبلة التي تسقط تُنبِت بعد حولٍ الكثير من السنابل.
لم يسعَ المنتفضون السوريون قبل ثماني سنوات لحمل السلاح؛ بل حملوا الكثير من الورود ووزعوها، ولم يكن همّهم العسكرة، بل رفضوها وأدانوها، ولم يخرجوا في الشوارع بالملايين كل يوم جمعة من أجل القتل والتدمير؛ بل من أجل بناء وطن حر كريم ديمقراطي تعددي تداولي لكل السوريين، لكن العنف المنفلت للنظام وشراسة حلفائه، وقلّة الخبرة السياسية للمعارضة وفشلها، كل هذا دفعهم عنوة إلى مسارات جانبية، لم يكونوا يريدونها، أثّرت في مسيرة ثورتهم وهشّمتها.
هذا تمامًا ما واجهه الساروت، لكنّه من النادرين الذين أصرّوا على البقاء متصالحين مع فكرة ثورتهم، فلم ينحرف عنها، سار في دروب وعرة صعبة ومتشعبة، وكان هدفه دائمًا إبقاء الثورة متألقة، وهذا ما حققه، وستضمنه من بعده حركة التاريخ الإنساني.
ترجّل البطل.. وبقي الحلم/ عبد الناصر كحلوس
“إنها لمأثرة عظيمة أن تكون سيرة حياة شخص واحد هي ذاتها سيرة ثورة شعب بأكمله، سيرة الساروت هي ذاتها سيرة الثورة…. اليوم لم يمت عبد الباسط الساروت، بل مات حلم كبير من أحلامنا“.
بهذه الكلمات الصادقة، ودّع احد الكتاب السوريين من عشاق الحرية، الشهيدَ عبد الباسط الساروت بلبل الثورة وبطلها، بعد أن ترجّل ذاك الفارس عن جواده بمسيرة كفاح ونضال، كتلك التي نقرأ عنها في الروايات والأساطير.
رحل الساروت حارس منتخب شباب سورية، وابن حمص العدية، ومنشد الثورة وبلبلها، مسطرًا سيرة بطولة قل نظيرها إلا في الثورة السورية.
اختار عبد الباسط الساروت الذي لم يكمل عقده الثالث، الانضمام إلى صفوف الثورة منذ شرارتها الأولى، وتميز بصوته وأغانيه في تظاهرات حمص ومسائياتها التي انتشرت في عموم سورية، وأصبح صوته رمزًا للتظاهرات والاعتصامات والوقفات من أجل الثورة، في سورية وخارجها، رددها وحفظها الكبار والصغار.
آمن بالثورة وصدق بها ومعها وفيها، وكان نموذجًا للثائر الحر الحقيقي… لم يبع أو يشتري أو يقبض… لم يغادر الأرض… آمن بأن الكفاح على الأرض بكل الطرق هو الطريق الوحيد للتحرير… لم يكن إيمانه بالثورة وحلمه بالنصر نابعًا من قراءات أو فلسفات أو تنظيرات، إنما كان نابعًا من فطرته وإنسانيته وإحساسه بالظلم والاضطهاد.
وهو ما ردده، مرارًا وتكرارًا، أن هدفه إسقاط نظام الأسد وكل من يسانده، وأن تحرير الوطن من عصابة الأسد والمحتلين يمر عبر فوهة البنادق من رجال صادقين مخلصين.
أصيب عدة مرات إصابات بالغة، ولم يستكن، وعاد لساحات الكفاح وعلى كافة الجبهات في سورية. ودّع إخوته الأربعة شهداء على مذبح الحرية فداءًا للثورة، ونجا من عدة محاولات اغتيال، كل ذلك لم يثنه عن حلمه وهدفه، حتى ما أثير عن انضمامه إلى تنظيم الدولة، بعد حصار حمص والظروف التي عاشها -كما رواها بلسانه- ثم الانكفاء عنها مع الاستمرار في القتال والنضال ضد الأسد وزبانيته، لا يعدو أن يكون شكلًا منطقيًا وطبيعيًا لإنسان عفوي فطري، عاش الثورة بكل تلاوينها، ورفض كل مغريات الخارج والسياسة والساسة والمؤتمرات والعيش الرغيد، وبقي متمسكًا بالأرض (يا وطن يا حبيّب.. يا بو تراب الطيّب.. حتى نارك جنة).
كما أنشد وردد مؤمنًا أن الثورة ستنتصر بالكفاح والنضال والالتحام بالناس ووجعها، وهو المسار الحقيقي والنموذجي لثائر سوري.
اشتبك مع (جبهة النصرة) وحوصر ورفض تسليم نفسه وكتيبته، وصدر أمر باعتقاله، فاضطر إلى الذهاب إلى تركيا مؤقتًا والعودة في وقتٍ لاحق، ثمّ ما لبث أن عُيّن قائدًا ميدانيًا فِي (جيش العزة) المُتمركزِ في الشمال السوري، ليتابع مسيرته البطولية في الكفاح والنضال، حتى آخر طلقة في جعبته.
قلائل هم الأشخاص الذين حازوا إجماع السوريين، سواء بحياتهم أو مماتهم، كعبد الباسط الساروت الذي شكل رحيله وجعًا مضافًا للسوريين ولرموز الثورة.
رحل الساروت الذي طالما ردد: يا حماة سامحينا.. والله حقك علينا…. رحل على تراب حماة، تاركًا إرثًا كبيرًا من القصص والملاحم والبطولات في تاريخ ثورتنا السورية.
رحل الفارس، وبقي الحلم…
وداعًا عبد
عندما لعِبَ “الساروت” مع الموت وأتقن الشهادة/ سعيد غزّول
قبل سنوات تنبّأ “الساروت” بموتهِ، كان ذلك أواخر العام 2014، أي بعد خروجه مِن مسقطِ رأسه وعاصمة الثورة السورية (حمص)، التي قضى فيها سنوات ثورته الأولى مِن قيادة المظاهرات والغناء فيها، إلى قيادة العمل المسلّح، وذلك بعد استخدام “نظام الأسد” كافة آلات القتل لـ قمع الثورة.
كان التنبّؤ بموتهِ حينها، عبر صورة نشرها أصدقاؤه على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهره (شهيداً) مسجّى على الأرض يلتحفه الكفن، قبل أن يخرج في مقطعٍ مصوّر يعتذر عن تلك الصورة المنتشرة على مواقع – لا يملك فيها أي حسابٍ شخصي -، موضّحاً أنها كانت “مزحة” ضمن سهرة أصدقاء وتفاجأ بنشرها.
اعتذر “الساروت” بشدّة عن تلك الصورة التي نُشرت – دون علمه -، كي لا يفهم الناس مِن اعتذاره “أن الساروت ذو شأنٍ كبير” – ولكنه كان كذلك حقّاً -، وأكّد أن اعتذاره جاء تبياناً للناس فقط، بأن هناك صفحات تسيء للفصائل والمقاتلين والثّوار والثورة باسم “عبد الباسط”، وهو الذي لا يملك أي حساب في تلك المواقع.
حينها، طالب “الساروت” ابن حي البياضة الحمصي، بأن يحزن الناس على شهداء الثورة السورية دون الحزن على “عبد الباسط”، لأن “عبد الباسط صنعه الناس وأولئك الشهداء”، وأن كثيرين ممن رحلوا أفضل من عبد الباسط مشدّداً على أن “الثورة لن تقف على الساروت وغيره”.
لعب دور الموت مِراراً ولم يهبه أبداً، كان صديق دربه في كل معاركه التي خاضها طوال ثماني سنوات ضد”نظام الأسد”
“عبد الباسط” الذي عرفته الثورة وهو ابن 19 ربيعاً، لعب مع الموت مِراراً ولم يهبه أبداً، كان صديق دربه في كل معاركه التي خاضها طوال ثماني سنوات ضد “نظام الأسد”، تعرّض خلالها لـ عشرات الإصابات، ونجا مِن لعبة الموت دائماً، عقب كل شائعة تؤكّد نبأ استشهاده، الذي أتقنه أخيراً وبات حقيقة لا يمكن نفيها أبداً وإن أرادت الثورة.
نعم لقد فُجعت الثورة السورية وتأكّد النبأ الحقيقي باستشهاد “الساروت”، ظهر أمس السبت، بعد سنوات مِن الكفاح والقتال والتظاهر والخذلان والخسارات والانتصارات والتهجير والشتات عاشها وعايشها الفتى، الذي قضى متأثراً بإصابةٍ بالغة تعرّض لها في معاركه مع “نظام الأسد” وحلفائه بريف حماة.
انتشرت الصورة الحقيقية التي ملأت جدران مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الأخبار، لـ تزف نبأ استشهاد حارس الثورة السورية وبلبلها، ولكني كـ كثيرين مِن السوريين بتنا نقلّب صفحات تلك المواقع أملا بأن يخرج “الساروت” مجدّداً لـ يعتذر عن الخبر ويؤكّد مرة أخرى، أنه على قيد الحياة وسيقاتل “نظام الأسد” حتى آخر قطرة دم، ولكن الأمر أصبح حقيقة فعلاً، وفقدت الثورة أحد أبرز رموزها، وبالطريقة التي أرادها وأقسم عليها، حتى آخر قطرة دم.
وأظهرت الصورة، الفتى الأسمر النحيل الذي لم يخلُ موضع شبرٍ من جسدهِ إلّا وفيه أثر رصاصة معركة أو شظية قصف، لقد فارق “الساروت” حياته شهيداً في المعارك لا على فراشهِ، وحُمِل على أكتافِ آلافِ السوريين إلى مثواه الأخير، تاركاً خلفه أمّه (الخنساء) التي فقدته مع أبيه وخمسةٍ مِن إخوته، فلا نامت أعين الجبناء.
ما لم يعلمه ابن عاصمة الثورة قبل رحيله المفجع، أن الثائرين السوريين أجمعوا على حب الفتى الأكثر شعبية في الثورة، وأن استشهاده أدمى قلوبهم ونكأ جراح مَن سبقوه مِن رموز، وأن مواقع التواصل الاجتماعي التي لم يملك فيها حساباً، باتت كلّ جدرانها خيمة عزاء له، عبرها يبكون فقدانهِ، ويتداولون أناشيده، لـ تذكير بعضهم البعض بالوطن الذي كان جنة الساروت، وبأحلام الشهادة التي أرادها فداء له.
لم يعلم أنَّ سيرته تعدّت حدود الثورة السورية وثورات الربيع العربي، وباتت كل بقاع الأرض تعرفهُ وتتناقل – بحزن – نبأ استشهاده
لم يرَ “الساروت” بعينه تلك الجموع الغفيرة التي قدِمت مِن كل حدبٍ وصوب لـ تشييع جثمانه، لم يعلم أنَّ سيرته تعدّت حدود الثورة السورية وثورات الربيع العربي، وباتت كل بقاع الأرض تعرفهُ وتتناقل – بحزن – نبأ استشهاده، ولكنه يعلم جيداً أن صوته وأهازيجه وأناشيده وعباراته ستبقى مخلّدة في ذاكرة السوريين.
“الساروت” الذي ظلّ كـ غيره مِن الثائرين في حمص، مقاوماً لكل آلات القتل الفتّاكة التي استخدمها “نظام الأسد”، بقي يحارب مع بندقيته بـ صوته، لـ حين دخلت أحياء حمص الثائرة في حصار خانق، فقد “الساروت” مِن أجل فكّه، أبيه وأربعة مِن أشقائه وثلاثة مِن أخواله، واضطر حينها إلى حنثِ قسمه ألماً بأن لا يخرج مِن حمص، كما ردّد في إحدى أناشيده (ما أطلع منك يا حمص لو هالروح تروح)، ولكن أخرجه القهر على ضحايا الحصار والجوع، وعدم قدرته على فكِ الحصار عنهم وفتح طريق لهم – اذبحوني وافتحوا طريق للعالم -، لـ يحقّق الشهادة في حماة، التي سبق وطلب منها السماح “يا حماة سامحينا، والله حقك علينا”، وافياً بحقّها عليه، دون أن يدري بأن له حق في كل بقعةٍ سورية.
عاش “الساروت” الكثير مِن قسوة الفقدان خلال سنين الثورة، فقدَ أباه، إخوته،أحبته، أصدقاءه، مقاتليه، وهو الذي دخل عهد المواجهة المسلّحة “مضطراً”، دفاعاً عن ثورته التي صدحت بالحرية، ومن ثم الدفاع عن مدينته، التي استباحها “نظام الأسد” كاملةً، وأمطرتها طائراته بالصواريخ والبراميل المتفجرة ، وارتكبت فيها عشرات المجازر.
لم يتخاذل – وقد تعرّض للخذلان مِن القريب والبعيد -، لم يغادر – وقد غادر الكثيرون -، لم يتنازل – وقد تنازل الكثير -، لم يفقد إيمانه ولو مقدار ذرّة بثورته، انكسر مِراراً ولكنه وفي كل مرة ينتفض كالعنقاء مِن قلب الرماد، سيبقى صمود هذا الشاب درساً لِمن أراد النهوض مجدّداً مِن بين الجراح والمآسي، فقد رحل وكانت آخر وصاياه (سوريا ظلّي واقفة).
نعم لقد استشهد الفتى، الذي انتقل مِن ملاعب كرة القدم، لـ يصبح أيقونة المظاهرات والاعتصامات السلمية في ساحات حمص وسوريا، ناقلاً آلام الثائرين عبر خطابات وأغان صدح بها بصوته العذب، استشهد الحارس الأمين الذي بذل كل ما يستطيع، وتحدّى كل المنعطفات والانكسارات، وتحمّل الكثير مِن التهم والتخوين، ولكنه بقي قلب الثورة النابض وصوتها الذي ما زال يحاكي واقع ثورة السوريين.
تلفزيون سوريا
الساروت.. موت ثائر/ رغدة حسن
في لحظة وصول خبر استشهاده، وقفنا جميعًا لنستدرك حقيقة وجودنا. جاء الخبر كالصاعقة، شطرنا ووضعنا أمام مرآته. لم نختبر مشاعرنا، كما فعلت بنا تلك اللحظة المعجزة. جمعنا موته، ووحّدنا في لحظة استثنائية، وكأنه يوقظ فينا ما نام وخبا من جذوة أحلامنا وانسانيتنا.
كنا نهرب من أخبار الموت القادم من جهته، ونُغرِق أرواحنا في ماء المنفى.
كنا ندور على رحى التأقلم، وقراءة الواقع الجديد، حين كان وحيدًا لا جدار يستند إليه.
نزور معالم البلاد الجديدة، ونرطن بلغات لا تشبهنا، ونستمع إلى موسيقى شعوب غريبة، حين كانت حنجرته تغني للثورة.
ابن الثورة الحر، المجبول بعشق تفاصيلها.
كم خانوك.. وكم باعوك!
لكن موتك أيها المجنح، وحّد القلوب المتنافرة، ابتلع موتك مخالبنا وأنيابنا التي كنا نشهرها عند أي اختلاف، وعدت بنا إلى نقاء الزمن الأول.
موتك المعجزة غسل أرواحنا، وصفاء ضحكتك التي صارت شراعًا، أخذتنا جميعنا إلى سوريا.
فقدنا ذاكرة الكراهية، واجتمعنا على طبق الحزن الواحد.
كيف امتلكت الجرأة ايها الأسمر الصغير، لتصفعنا جميعا دفعة واحدة، وتوقظ فينا صورة البلاد؟ من أين لك تلك الشجاعة النادرة، لتذهب وحيدًا إلى الموت وتتركنا بلا حارس لأحلامنا؟ كيف انتقلت من طفل يلهو بالكرة، إلى عملاق يفرد جناحين من نور ليحتضن وجع شعب بأكمله؟
لا أعتقد بأن هناك من ادعى الحزن على رحيلك، نزل الدمع صافيًا وحقيقيًا، لأننا اكتشفنا في تلك اللحظة كم كنت تشبه بلادنا البسيطة، الصامدة، اليتيمة، المسروقة.
تستحق هذا الرحيل المهيب، وتستحق أن نبكيك ونبكي البلاد فيك.
الترا صوت
نحن في مرآة الساروت/ عمر قدور
رحل مَن أصبح رمزاً وأُطلق عليه لقب “حارس الثورة” قبل سنوات، رحيله لم يجعل منه ذلك الرمز، بل مسيرته خلال الثورة، المسيرة التي تعادل ثلث عمره. قيل الكثير عن سيرته، وكانت حاضرة في أفلام جابت المهرجانات الدولية، بينما بقي يستأنفها في سوريا على طريقته، ووفق ما تتيحه ظروف المعركة التي لم يحد عنها. اختلف السوريون فور استشهاده، بين أغلبية ساحقة بكته وأقلية راحت تنال مما نُسب إليه من مبايعة داعش، وهي مبايعة لم تتجسد في ساحات القتال ولا في مسار أيديولوجي، وأغلب الظن أنها عبّرت عن نزقِ لحظةٍ قبل أن يتراجع عنها، من دون أن ننسى أولئك “الغانديين” الذين يجرحهم الترحم على أي مقاتل ضد الأسد.
رحيل الساروت، الذي اختار لنفسه واختارت له الظروف منذ انطلاق الثورة مساراً تراجيدياً، هو بمثابة مرآة تعكس حالنا، تعكس فشلنا وهزائمنا. البكاء عليه فيه الكثير من وجع الخسارة، وليس فيه الحد الأدنى من مشاعر الغضب والوعد باستئناف ما كان يمثله الرمز المفقود، لا لأن السوريين جميعاً أقلعوا عن الإنشاء والخطابة، وإنما من فرط الإحساس بالانكسار واليأس. الساروت كان بطلاً، بينما من تبقوا لا يرون في أنفسهم مشروع سيرة مشابه من حيث الروح القتالية وإن اختلفت الأساليب والمسارات، ولا يرى كثر منهم أن استئناف السيرة ممكن حقاً.
خرج الساروت مرغماً من سوريا لأكثر من سنة بقليل، ليعود إليها مقاتلاً مرة أخرى. في حين خرج قادة فصائل عسكرية محملين بالثروات، ليفتتحوا بأموالها مشاريع تجارية في تركيا، أو ليعرضوا خبراتهم كمرتزقة. الأهم أن الشباب السوري الذي خرج لم يعد، وهناك يأس من عودته يوماً، وهذا الشباب لم يكن يريد الانخراط في المعركة التي منحها الساروت حياته، حتى إذا كان مؤيداً لخوضها، وحتى إذا كان يتفجع اليوم على بطولته!
من دون مطالبة بتضحيات إضافية فوق التي شهدناها، لا نستطيع إنكار خروج نسبة عالية من الشباب الذي كان سباقاً إلى الثورة في وقت مبكر من عمرها. وحشية الأسد وقواته ومخابراته تفسر لنا هذا الخروج الاضطراري، ويريد البعض الآخر رمي المسؤولية على الإسلاميين الذين صارت لهم يد طولى في طور العسكرة ما أدى بهم إلى الاعتزال أو الاعتكاف. في أوقات مؤثرة كان من المحتمل أن تصنع فرقاً، غرق من هم في جهة الثورة في جدالات عقيمة حول التحولات الاضطرارية، وغابت أسئلة من نوع: لماذا ينبغي أن تكون العسكرة إسلامية؟ أو “طائفية بنظر البعض”، فلا ينخرط فيها منتقدو الإسلاميين؟ ولماذا تكون على شاكلة النموذج الليبي، ولا تكون متكيّفة مع واقع ما سُمّي “ثورة يتيمة” محرومة من وسائل فعالة للدفاع عن النفس؟
بالتأكيد كان ثمة خارج متواطئ، وكان له تأثير مطابق لتأثيره في هذا النوع من العسكرة، لكن هذا لا يعفي مجمل السوريين الذين لم يقترحوا ولم ينخرطوا في سبل أقل كلفة وأقل ارتهاناً للدعم. بالتأكيد أيضاً كانت هناك رغبة دولية وربما إقليمية في تحويل سوريا إلى ساحة لتصفية صراعات خارجية، لكن كان واقع الثورة نفسه أضعف من أن يفرض نفسه شريكاً ولاعباً يُحسب له حساب ضمن لوحة الصراع الكبرى.
ليست المسألة في السلمية أو في العسكرة أو في أي نهج آخر، هذه الاختلافات التي تظهر أو تُختلق طوال الوقت لم تأتِ بها أية قوة خارجية، هي بالضبط عدم قدرة السوريين على الانتظام وعلى العمل معاً. لم يعمل السوريين معاً على الصعيد السياسي، ولا كانت الفصائل تنسق معاركها على الأرض إلا أن عندما يجمعها الحصار وتفرض عليه الضرورة خوض المعركة معاً، وحتى تحت الحصار قامت فصائل بمقاتلة فصائل أخرى بدل قتال قوات الأسد، ولم يكن القتال البيني دائماً بسبب اختلاف أجندات الداعمين وإنما كان في العديد من الأحيان ضمن منطق إمارات الحرب.
لعل وضع السوريين في المنافي “مع استثناء المنافي العربية البائسة” يشرح الأمر، فنحن ليس لدينا في أي بلد قوة سورية منظمة، رغم ما تتيحه الأنظمة الديموقراطية من سهولة انتظام وتجمع. تجمعات التضامن الضئيلة العدد هنا وهناك عندما تكون هناك مأساة في الداخل ربما تعكس حال سوريي المنافي، إلا أن الوضع يستحق شرحاً أوفى. نستطيع العثور في فرنسا مثلاً على عدد من الجمعيات السورية المرخصة تجاوز المائة على الأقل، وهذه الجمعيات التي يُفترض بها الاشتراك في قضية واحدة غير قادرة على التنسيق فيما بينها، وبالطبع غير قادرة على إنشاء كيان يمثّلها جميعاً أمام الحكومة والمجتمع الفرنسيين. هنا، وفي تجارب أخرى في بلدان شبيهة، ليس هناك ما يمنع انتظام السوريين بشكل فعّال سوى عجزهم وفشلهم، وبسبب العجز والفشل على تشكيل قوة مؤثرة تم تفويت فرص ضرورية مهما بلغت ضآلتها.
حتى إذا تجاوزنا كل بلد على حدة، يتيح الشتات الأوروبي إمكانية الانتظام بسهولة للمقيمين فيه، وتتيح وسائل التواصل الحديثة إمكانية أخرى لتجاوز عوائق الجغرافيا. في هذه المساحة الشاسعة قد نعثر على جزر صغيرة معزولة لبعض المجموعات، إلا أن أياً منها لا يشكّل نواة لمشروع أعم، ولا يطمح إلى ذلك لقناعته باستحالة الوصول إلى مشروع جامع. لقد كان الوضع مبرراً في المرحلة الأولى بصدمة اللجوء، وبالحاجة إلى وقت لاستيعاب المجتمع الجديد، ليعود انكشاف عجز السوريين عن العمل معاً ولو لمرة واحدة ومن أجل هدف يُفترض أنه يجمعهم. ربما لاحقاً ستنتظم أجيال جديدة من سوريي الشتات، الأجيال التي نشأت أصلاً على ثقافة المجتمعات الجديدة، أما من جاؤوا محملين بالهزائم والعجز فلا يبدو أنهم قادرون على فعل ما لم يفعلوه حتى الآن.
صحيح أننا كسوريين تعرضنا لأبشع مقتلة في هذا القرن، وتعرضنا لأقسى عمليات التحطيم الاجتماعي والنفسي. ذلك لا ينفي امتثال شريحة واسعة منا لمصيرها، وصولاً إلى الامتثال الجماعي لفكرة عدم امتلاك السوريين لمصيرهم. لا يُحسب على المصادفة أن النجاحات التي حدثت هنا أو هناك كانت فردية بمعظمها، وإن خدمت الهدف العام، ولعل النجاحات الفردية مع الفشل الجماعي يشيران إلى بؤس ما نحن فيه.
لقد اختزل الساروت ما عجزنا عن فعله، بما يتعدى العجز الفردي إلى الفشل الجماعي. من جانبه مشى بقناعاته حتى النهاية، أما نحن فكنا بحاجة إلى أبطال مثله، بقدر ما نشعر بالفخر بهم نقنع بعدم قدرتنا على مجاراتهم. يستحق الساروت الحزن الكبير الذي حظي به، الرهان الأصعب يبدأ كما اعتدنا بعد انقضاء صدمة الحزن.
المدن
الساروت الذي لا يشبهنا/ ماهر مسعود
ليست مهمة تلك القيم التي نتعلمها، بقدر أهمية تلك التي نصنعها، تلك التي ننتجها عبر فعلنا في الحياة. كثيرون هم من يعيشون حياتهم على قيم صنعها غيرهم، قلائل هم من يصنعون القيم عبر التاريخ.
ليس مهماً إن كان الساروت علمانياً أو متديناً، ريفياً أو بدوياً أو مدنياً، عبقرياً أو بسيطاً لا يعرف القراءة والكتابة، لأن الساروت كان صانع قيم، وصُنّاع القيم لا يموتون.
لم يصنع القيم عبر خبرته ومعرفته الواسعة، أو علمه وتعلّمه وتعليمه الكبير، فقد كان في عُمر التاسعة عشرة عندما قامت الثورة، طفلاً يلاعب الحياة ويحرس مرماها، يسائلها غاضباً ولا يعرف الأجوبة، يقتحمها ولا يصدق قسوتها. كان وقتها طفلاً يغني في مسارح التظاهرات من دون أن يعلم أنها ستنقلب إلى تراجيديا ملحمية دامية، وأنه سيكون بطلها المأساوي أو أنه سيموت مثل أبطال المآسي في الأساطير الإغريقية.
لم يصنع قيماً للفكر والتفكير، فالأطفال لا يصنعون قيماً بعقولهم، بل بوجودهم ذاته، لا يصنعون المعنى بنظرياتهم الفلسفية والعلمية والأخلاقية، بل يخلقون المعنى بحضورهم، بألعابهم، بضحكاتهم وغنائهم، بأوهامهم وبالحياة النابضة في أجسادهم.
إيمانه بالثورة لم يكن متعالياً أو مثالياً أو معقداً أو محكوماً بحسابات الربح والخسارة والمجد وكل المفاهيم المركبة. كان إيماناً بديهياً بسيطاً كشربة ماء، واضحاً كأفق مفتوح، قاسياً كشعور القهر، صادقاً كضحكة الأطفال.
لم يكن الساروت مثلنا، كان حراً من الأيديولوجيا التي حاصرته فخرج منها بلا تنظير ولا اعتذار، حراً من صراع الأفكار العقيمة التي نخشى تصنيفاتها فنلبس قناع الحكمة. ترك وجهه مكشوفاً ومفتوحاً لرياح الثورة، طحنته عواصفها وتناقضاتها وتقلباتها، غنّى للحرية عندما كان للغناء معنى وللصوت صدى في أرواح السوريين وفي العالم، عندما كانت حمص عاصمة الأمل وأجمل مدن العالم في تظاهراتها. كانت حنجرة الساروت سلاحه الأول، والغناء للثورة معركته المفضلة.
تحول الساروت إلى حمل السلاح بعدما دُهست الأغنيات بالدبابات، تحوّل إلى حمل السلاح ببساطة ثورية، من دون أن يهمه مصدر السلاح أو مصير السلاح، فالبوصلة واضحة في روحه، ضد الظلم، ضد القهر والعبودية. أما طريق الحرية المسالم، فقد جرفته جنازير النظام في بابا عمرو، في البياضة، في الخالدية التي غنى في أزقتها وساحتها مع الراحلة العظيمة فدوى سليمان، في باب السباع الذي قتل فيه أجمل الشهداء، باسل شحادة.
في حمص، قاتل الساروت حتى النفس الأخير، خسر أخوته الأربعة ووالده، ودّع الكثير من أصدقائه، بكى حرقة ليوصل الطحين إلى المحاصرين، قاتل مع شباب البياضة بروح آتية من الأساطير في حرب لا شيء عادلاً فيها.
عندما سيطر الإسلاميون على وجه سوريا المحترق، تحوّل إلى الجهاد ببساطة ثائر، من دون أن يسأل عن مصير الجهاد وأيديولوجيا الجهاد، فالبوصلة بقيت واضحة في صدره، لا عودة للوراء، حتى لو كانت خسارة العالم، كل العالم، هي الثمن.
لم تكن بوصلة الساروت هي الله، ولا الجهاد، ولا السلاح، ولا الأغنيات، كانت بوصلته حرية الشعب السوري، حريته هو بعدما صار روحاً جماعية. شعوره بأحقية الدفاع عن الظلم والقهر والعدالة المسحوقة، كان مثل الحقيقة الثابتة أمام عبثية دولاب الزمن، كل الأفكار والأيديولوجيات والمعاني الكبرى كانت تحت قدميه، أدوات غير مفهومة لما هو مفهوم لديه بالحدس، طرق معقدة لطريقه الواضح. لم تثبت تحولاته إلا أنه كالحياة، تتغير وتمضي، تعلو وتهبط، تجري وتتدفق ولا يعنيها سوى هدف واحد، هو خلق المعنى لمن يحيا.
كثيرون رحلوا، كثيرون هاجروا، كثيرون هُجِّروا، كثيرون غادروا ثورة لم تعد تشبههم، كثيرون اختاروا طرقاً أخرى للثورة، كثيرون عادوا لمملكة الصمت والهزيمة، كثيرون فضّلوا الأمان على الحرية، كثيرون تابوا، كثيرون نسوا، كثيرون ماتوا قهراً.. إلا الساروت، لم تتغير بوصلته، لم يمت قهراً، لم يرحل إلا ليعود، لم يمت عجزاً، لم يمت صمتاً… مات واقفاً، مات فاتحاً صدره للعدم، مات غير معنيٍّ بالعدم، فالموت حرية أيضاً، ولطالما ارتبطت الحرية في سوريا بالعدم.
مات بسيطاً كرائحة الخبز، غريباً كإله في الأساطير القديمة، قريباً كخرافة مقدسة أو حكاية من حكايا الجدات. مات من دون أن يسأل ما معنى المعجزات، فقد كان يعيشها، من دون أن تعنيه معاني البطولات، فقد كان يجسّدها، مات مثل موت الله عند نيتشه، عندما لم يعد للأمل قيمة ولا معنى.
تجسّد حكاية الساروت كل ما نهرب منه، نحن الناجون الأحياء، الخوف من الموت والبكاء على الموتى، الخوف من الإرهاب والوسم بالإرهاب، الخوف من القتل والقتال والمقتلة، الخوف من الفشل، من انعدام المعنى، من مواجهة انعدام المعنى.. الخوف من قسوة الحرية ولا أمانها في سوريا، سوريا أرضنا، أرضنا المقبرة.
تجسد حكاية الساروت حكاية الثورة السورية، الثورة التي رقصت وتمايلت على ألحان الأمل في البدايات، الثورة التي نزفت أجمل أبنائها في العراء من دون أن يضمّدها أحد، الثورة التي أثارت رائحة دمائها كل ضباع الأرض لتنهش في لحمها الطري، الثورة التي لبست ثوب الجهاد عندما تُركت عارية أمام عين التاريخ الوقحة، والقادمين من أصقاع التاريخ، الثورة الباقية رغم أنف التاريخ وضداً من ميوله الفاشية، ميوله التي يحركها اليوم أتفه طقم رئاسي وسياسي حاكم في التاريخ المعاصر من مشارق الأرض إلى مغاربها.
المجد والسلام لروح سوريا، المجد للساروت.
المدن
حمص تنتظر حارس صوتها/ الياس خوري
حين احتفلنا بعبد الباسط الساروت وهو يصدح أغانيه الحمصية ويحرس ميادين الثورة بصوته، رأينا فيه صورة لاعب كرة القدم وهو يصدّ الكرة عن مرماه. يقف، ينحني، يركض، يقفز، ويغني.
الفتى الحمصي الجميل أخذنا إلى المدينة التي تحتضن نهر العاصي، وهناك رأينا حلماً.
وكانت الثورة.
الشعب الذي كُبّل بسلاسل الخوف انتصب كالرمح معلناً ثورته من أجل الحرية والكرامة، في مشرق عربي أذلّه الضباط واللصوص والطائفيون والخونة.
وهناك في ليالي الخالدية في حمص، كان الفتى الجميل يصرخ بالحرية، حارس منتخب سوريا للشباب في كرة القدم، تحوّل إلى حارس الحلم. الفتى الجميل الذي تشرق الحرية في بحة صوته صار تجسيداً لثورة مغدورة. كل الطغاة اجتمعوا في حلف دموي ضدّ الساروت وغياث مطر وحمزة الخطيب وباسل شحادة. كلهم شعروا بالخوف من يد طفل تكتب على الحائط وصوت فتى يغنّي وكاميرا تصوّر ووردة يحملها ثائر. الجيوش التي لم تقاتل عدواً إلا لتنهزم وجدت في شعب سوريا فرصتها كي تقتل. هناك فرق بين القتال والقتل، هؤلاء الذين قتلوا الشعب بشكل منهجي وحولوا سوريا إلى ساحة يتبارى فيها المجرمون، هؤلاء لم يقاتلوا إلّا ليقتلوا.
من زمن البدايات بقي الساروت شاهداً أخيراً على فيض الجنون الذي جعل من سوريا أرضاً لحروب الديكتاتورية والأصوليات ضد الشعب السوري، وكان على الفتى الذي أُجبر على مغادرة حمص أن يعبر في مفترقات الالتباس التي قادته إلى حيث لم يكن، ثم أعادته ليموت في مكانه الطبيعي، مقاتلاً حراً، وشهيداً يدافع عن حقه في الحياة.
سيرة الساروت تلخص حكاية السوريات والسوريين مع الحلم والفشل، مع اليأس وما بعد اليأس، فالفتى الحمصي رسم مسار التخبّط والحلم بحدسه الشعبي وارتباطه بالأرض السورية التي لم يغادرها، فسقى شجرة الحرية اليابسة دماً، ودفن صوته في التراب الذي صار جنّة الحالمين الوحيدة.
ولعل في موت الساروت في هذه اللحظة الدموية التي يعيشها ربيع السودان المدمّى ما يكشف هاوية الموت التي قادت العسكريتاريا وظلها الأصولي بلاد العرب إليها.
هناك في السودان امّحى الالتباس الذي غطّى سوريا بضباب صراع وحوش الاستبداد العربي بعضهم مع بعض.
في السودان انكشفت اللعبة كلها على حقيقتها، أنظمة العار الخليجية المتحالفة مع إسرائيل تجد نفسها في حلف واحد مع العسكريتاريا وعصابات الشبيحة وفلول الأصوليين. نظام القتلة والجنجويد الذي بناه عمر البشير بدماء السودانيات والسودانيين حليف للأصوليين وعميل للخليج المتأمرك المتصهين ويحميه الفيتو الروسي-الصيني في مجلس الأمن.
أخيراً ظهرت اللعبة على حقيقتها.
بعد أن فقدت العسكريتاريا العربية مبرر تسلطها، ارتمت في أحضان إمارات الكاز، وتحولت إلى صَدَفة جوفاء، تحكم بالعنف المطلق، لا هدف لها سوى البقاء في السلطة، حتى ولو كان ثمن السلطة إهدار كرامتها.
الدم الذي سال في العاصي يسيل اليوم في النيل، كما أن صرخة الحرية في الجزائر تعرف أنها قد تواجه في أية لحظة هوس الطغمة العسكرية بالسلطة المطلقة.
الآن يا عبد الباسط ترى في مرآة موتك ما حاول الجميع حجبه عن عينيك وعيوننا. أرادوا تأبيد الاستبداد باسمائه المختلفة. واليوم في السودان نكتشف أن للاستبداد اسماً واحداً هو العسكريتاريا، وأن جميع أسمائه الأخرى مستعارة، وليست سوى معبر للدول الإقليمية وغير الإقليمية كي تستبيح أرضنا.
الآن نفهم سرّ تعاطف العسكر المستبد في مصر مع نظام بشار، وسرّ استعجال الإمارات فتح سفارتها في دمشق.
كلهم يا عبد الباسط اجتمعوا من أجل قتلك وإخراس صوتك. هل تصدّق أن من خطف رزان زيتونة وسميرة الخليل كان يريد إسقاط النظام؟
لم يكن هؤلاء السفلة سوى صدى للمافيا العسكرية التي أرادتهم أداة لمزيد من توحيش المجتمع.
الوحش الذي رفع شعار «الأسد أو لا أحد»، هذا الوحش أفرغ سوريا من نصف شعبها، ويتابع المهمة كي لا يبقى في سوريا سوى العبيد.
وهذا ما يقوم به اليوم القتلة في المجلس العسكري السوداني، يسقون النيلين الأزرق والأبيض دماً، كي يعاد السودان إلى حظيرة الانحطاط العربية، محولين ميادين الخرطوم إلى ميدان الساعة في حمص.
أسفي على حمص لأنها لا تستطيع أن تقدّم الوداع اللائق ببطل تراجيدي اسمه عبد الباسط الساروت.
اخترتَ طريقك وذهبتَ إلى موتك كما يليق بأبطال الملاحم.
أما حمص العدية، حمص التي اقتحم شبابها السماء في بابا عمرو، حمص الساحرة حتى بعد تدمير أغلب معالمها، هذه المدينة التي لا تستطيع استقبال جثمانك، صارت اليوم مدينتك أنت.
لقد كتبت يا عبد الباسط الساروت اسمك على حجارتها السوداء، وعلقت صوتك على حيطانها، ورسمت وجهك على ترابها.
وحمص ستبقى في انتظار حارس صوتها ومغني ثورتها وزينة شبابها وشهيدها المضرّج بالحلم المغدور.
وغداً عندما تنقشع هذه العتمة التي صنعها الاستبداد، غداً ستستعيدك حمص كي تستعيد اسمها من جديد، وكي يعود العاصي إلى مسيرته عاصياً على قانون الجغرافيا صاعداً إلى الأعلى كي يصبّ في بحر الحرية.
القدس العربي
عبد الباسط الساروت… تحية لـ “الخيار الأصعب”/ سامر مختار
في السنوات الخمس التي سبقت انطلاقة الثورة السورية ازداد شغفي بسماع الموسيقى إلى درجة أنني عمِلتُ في متجر لبيع الأسطوانات الموسيقية في شارع “القيميرية” بدمشق القديمة، لا أبيع سوى أنواع معينة من الموسيقى: موسيقى الكلاسيك، البلوز، الجاز، وأنواع محددة ونخبوية نوعاً ما من الموسيقى والأغاني الشرقية: ألبومات فيروز، أغاني مارسيل خليفة، سعاد ماسي، عازفا العود العراقيان منير بشير ونصير شمة، الموسيقي التونسي ظافر يوسف، وقبلهم موسيقيين يعيشون بالمهجر كالموسيقي السوري عابد عازاريه، وبالأخير مسرحيات الرحابنة وزياد.
علاقتي مع الأغنية السياسية أو الثورية في ذلك الوقت لم تكن مرتبطة لا بالحاضر الذي أعيشه، ولا حتى بسوريا، بل كانت مرتبطة حصراً بفلسطين كأغاني مارسيل خليفة وفرقة العاشقين الفلسطينية، والمغنية الفلسطينية ريم البنا.
مع انطلاقة الثورة السورية مطلع عام 2011 كنت على موعد مع الأغنية الثورية السورية، وفجرّت أغنية “يا حيف” لسميح شقير وعيي، ووعي الكثيرين من الشباب السوري، على أهمية الأغنية المرتبطة بالأرض والناس والثورة، والأهم من ذلك كانت الأغنية مرتبطة بما قام الشعب السوري بثورةٍ من أجله: حلم التغيير ووضع حد للظلم وإنهاء حكم الاستبداد والإعلاء من شأن كرامة الإنسان.
أي كانت هذه الأغنية تغيّر، ولأول مرة، علاقتي بفكرة الأغنية والموسيقى بشكل عام، ولم يعد سماع الموسيقي مسبباً للاسترخاء والتأمل أو للنقد الساخر والملتوي وغير المباشر، بل تعبير مباشر عن ضمائر الثوار والمتظاهرين، بل وعن وحدتهم أيضاً، وقد سلمتني أغنية شقير إلى أناشيد إبراهيم القاشوش وأغاني عبد الباسط الساروت.
خطرٌ على الطاغية
في ذلك الوقت المبكر من عمر الثورة (يوليو/ تموز 2011) أكثر ما فاجئني هو ردّ فعل النظام الوحشي على أناشيد إبراهيم القاشوش الشاب السوري من مدينة حماة، الذي كان يؤلف شعارات ضد النظام السوري وينشدها أمام جموع المتظاهرين؛ إذ قام باعتقاله وقتله تحت التعذيب، بعد أن اقتلع حنجرته، وفي ذلك دلالة.
في ذلك الحين أدرك السوريون أهمية ما يفعلونه وخطورته في آن، وكان بإمكان الأغاني والأناشيد الثورية أن تساهم في ملحمتهم بحكم تأثيرها الكبير على وعي الناس وتحريك الشارع.
وبالتزامن مع ذلك بدأنا نسمع عن حارس مرمى منتخب الكرامة للشباب عبد الباسط الساروت، الذي يبلغ من العمر 19 عاماً، ويقود مظاهرات حاشدة في مدينة حمص، ويؤلف الشعارات والمواويل والأغاني الثورية وينشدها في المظاهرات.
كانت المشاعر والأحاسيس المرتبطة بتلك اللحظة الثورية المتوهجة تتراوح كالبندول بين الصعود والهبوط، بين الحماس والخفوت، وكل ذلك على إيقاع عنوانه “صوت عبد الباسط الساروت” الذي أعادت أغنياته وأناشيده وهتافاته هوية ثقافية شعبية اعتقدنا أننا فقدناها.
في تلك اللحظة الثورية كنا بأمس الحاجة لهذا الصوت، في لحظة الموت، الاعتقال، القتل بالرصاص السريع، التعذيب داخل الأقبية والسجون والمسالخ الأسدية، لحظة الخوف، فقدان الأمل، اليأس، لم يكن يحرك الجموع معارض سياسي يظهر على قناة العربية أو الجزيرة، بل كان عبد الباسط الساروت وأمثاله هم من يشحذ الهمم ويبقي معنويات الناس عالية.
شحنة الإرادة في صوت عبد الباسط الساروت كانت بحد ذاتها ثورة؛ من أغنية “جنة جنة جنة .. جنة يا وطننا” إلى أغنية “حانن للحرية حانن” إلى “حرام عليك” كان صوته القادم من ساحات الغضب إلى السماعة الصغيرة التي أضعها في أذني وأسمعه في السر بمثابة السند والأمل وعدم الاستسلام للإحباط.
كنت دائماً أتأمل هذه المفارقة: اعتدتُ على سماع الموسيقى الكلاسيكية والأغاني “المرموقة فنياً” والآن يهتز وجداني بصوت شابٍ يهتف من قلب المظاهرات ويرتجل الإيقاعات التي تخلو من أي أدوات موسيقية، ولا شيء جميل بصوته، سوى تلك البحة القادمة من أعماق جسده وروحه فتتسلل إلى روحك لتحدث نوعاً من الصدمات الكهربائية بجسدك، وتجعلك بحالة انتعاش وتحفز دائمين.
تراجيديا الثورة ومنشدوها
بعد 2012، سنة الشتات في دمشق، التي انقطعتُ فيها عن متابعة الأخبار؛ لانقطاع الإنترنت عن البيوت التي تنقلتُ فيها، وخروجي من دمشق، عدت لمتابعة ما فاتني من أخبار وأحداث، لأكتشف أن الساروت بات قائد لكتيبة “شهداء البياضة” في حمص.
كانت توقعاتي في ذلك الوقت عن مصير الساروت منحصرة في أنه سيهرب مع عائلته خارج سوريا بعد أن عرض النظام 2 مليون ليرة سوري لمن يأتي برأسه، وبعد محاولة اغتيال نجا منها بأعجوبة. وبعد أن بدأ النظام بإبادة حمص وباقي المدن السورية بشتى أنواع الأسلحة الثقيلة.
بنيت توقعاتي الخاطئة على أن الساروت بات نجماً ثورياً وبإمكانه أن يلجأ إلى بلد أوروبي ويكمل حياته ويخطط لمستقبله، إما بدخول نادي كرة قدم احترافي، أو تعلم الموسيقى والغناء، ولم أتخيل له مستقبلاً غير ذلك، ربما لأنني شعرت أنه ليس بهذا الشاب المتدين أو المؤدلج، وليس بالشاب الذي يُظهر أي خبرة أو وعي سياسي منظم.
بالتزامن مع المشهد التراجيدي الذي دخلت فيه الثورة السورية والتحولات العنيفة التي عمّقها تكاثر الفصائل المسلحة والجماعات الدينية المتطرفة كجبهة النصرة ومن بعدها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وجيش الإسلام (واعتداله المزعوم)، كانت حياة الساروت شديدة الالتصاق بهذه التراجيديا الجمعية ومعبرة عنها. قُتل والده وأربعة من أخوته أثناء قصف طائرات النظام لمدينة حمص.
تضافرت تحولات الساروت مع تحولات الثورة؛ فتارة يتقرب من جماعات دينية متشددة، وتارة يبتعد عنها، لكن قربه لم يكن مدعوماً بإيديولوجية دينية حركية أو نظرية، بقدر ما كان خياراً فرضته عليه قوى الأمر الواقع.
في 31 / 8/ 2015 ظهر الساروت في فيديو تسجيلي، أعلن فيها عدم مبايعته لـ”داعش” وقال إنه لا ينتمي، هو والفصيل الذي يقاتل معه، لأحد، وأن هدفه فقط مقاتله النظام السوري والدفاع عن أرض سوريا.
شكل الساروت نموذجاً مختلفاً عن “السائد الثوري”؛ لم تغرّه نجوميته ولا موقعه في الثورة، وكان دائم التعفف من الألقاب التي يطلقها الثوار عليه؛ وفي فيلم وثائقي قصير، أعده موقع “زمان الوصل” بتاريخ 21/1/2019 يظهر فيه الساروت بكامل حماسه وهو يقول “أنا ما عندي لقب. هم يقولون حارس الثورة. الثورة لها حراس. هم يقولون منشد الثورة. الثورة لها منشدون. أنا اسمي عبد الباسط الساروت. شخص من هذه الثورة. شو ما يقول الناس. أنا أحترم الناس. ولا أحب التمجيد. ضد التمجيد. التمجيد للجريح والشهيد والأسير فقط.”
حبه لأرضه وإخلاصه في الدفاع عنها بالكلمة والغناء وقيادة المظاهرات، أو بخياره لحمل السلاح والدفاع عن مدينة حمص في أحلك اللحظات، في وقتٍ كان فيه التواجد تحت القصف أشبه بالانتحار، يدلل على أنه ليس هناك سوى الدوافع النبيلة ما تحركه.
ومثل الناشط الحقوقي رائد فارس، والمصور الصحفي خالد عيسى، والقائد العسكري للواء التوحيد عبد القادر صالح (حجي مارع) وغيرهم من الشخصيات التي كانت رمزاً للنضال والشجاعة والنبل والإخلاص، رحل الساروت في ميدان القتال مؤخراً.
رحل الساروت تاركاً المرء في حيرةٍ من أمره وهو يفكر في خيارات من اختاروا أن يبقوا مقاتلين على الأرض السورية رغم معرفتهم بأنهم قد يقتلون في أي لحظة، ورغم وجود خيار الانسحاب والهروب، والخلاص “الفردي” ورغم معرفتهم بأنهم قد يغوصون في تعقيدات الصراع السوري التي رسم ملامحها نظام باطش من جهة وتنظيمات عسكرية إسلامية متطرفة ليس هدفها مقاتلة النظام بل أن تحتل مكانه السلطوي من جهة أخرى.
يفكر المرء كيف أن هؤلاء قد ذهبوا للخيار الأصعب، بلا أي رفاهية للتفكير بالخلاص الفردي، والتضحية بكل شيء، بما في ذلك حياتهم نفسها، من أجل خلاص جمعي طال انتظاره.
رمان
عبد الباسط السّروت وقصّة ثورة لن تموت/ د. فتحي الشوك
انتقل إلى جوار ربّه يوم السّبت 8 يونيو 2019 الشّهيد بإذن الله عبد الباسط السّاروت منشد الثّورة السّورية، حارسها وأيقونتها متأثّرا بجروح أصيب بها في معارك ضدّ قوّات النّظام بريف حماة شمالي سوريا، لينضمّ إلى قافلة شهداء الحرّية ولتتحقّق أمنيّة كان لا يخفيها بل ويتغنّى بها بصوته الشّجي، تحوّل أبو جعفر إلى إيقونة لثورة شعب يتطلّع إلى الحياة الحرّة الكريمة بل صار شبه أسطورة توثّق أدقّ تفاصيلها منذ انطلاقتها قبل تسع سنوات، فكيف أمكن لشاب في مثل سنّه أن يفعل ذلك؟
السّاروت والثّورة المغدورة
انطلقت الثّورة السّورية سنة 2011 ضمن موجة الرّبيع العربيّ الأوّل لتشهد سوريا جملة من الاحتجاجات الشّعبية العفوية والسّلمية المطالبة بالحرّية والكرامة والانعتاق ووضع حدّ لما تشهده البلاد من قمع وانتهاكات لحقوق الإنسان وفساد ودكتاتورية، جوبهت المطالب المشروعة بعنف شديد وقمع لا يوصف ليكشّر النّظام عن وحشيّة دمويّة لا مثيل لها ويجرّ الثّورة إلى المربّع الّذي يحبّذه ويستدعي إليه كلّ طغاة العالم محوّلا سوريا إلى محرقة وساحة صراعات طائفية، إقليمية ودولية. قمع النّظام السّوري الفاشي الشّوفيني المجرم شعبه بالحديد والنّار ومارس كلّ صنوف الاضطهاد والتعذيب والتقتيل، من إلقاء للبراميل المتفجّرة واستعمال للأسلحة الكيماوية ولم يكتف بذلك بل وتكرّم على المهوّسين بالإجرام باستدعائهم ليشاركوه ساديّته المرضيّة.
كان السّاروت حاضرا في الثّورة في كلّ لحظاتها، شاهدا على لحظة ميلادها ومرافقا لها في انعطافاتها وتحوّلاتها، ومعبّرا بصوته وبصفحة وجهه عن القليل من ابتساماتها والكثير من حزنها وانكساراتها وهنّاتها
سقط مئات الآلاف من الضّحايا وشرّد الملايين بين نازح في الدّاخل ولاجئ في الخارج وسط صمت دولي مخز يرتقي إلى درجة التّواطئ والتّآمر لتتواصل المأساة والمعاناة لشعب ذنبه الوحيد أنّه تطلّع إلى حياة حرّة وكريمة. تعرّضت الثّورة السّورية إلى الغدر والخيانات والطّعنات ودفع بها دفعا إلى سوء المآلات لتصبح مثالا يلوّح به في وجه من كلّ من يفكّر في سلوك نهج الثوّرات. نظام طائفي متوحّش لم يتردّد في لحظة ارتعاشه إلى طلب نصرة كلّ متوحّش بل واختلاق من فاقه توحّشا، كلّ ذلك لأجل أن يستمرّ ويبقى ولو على جماجم ضحاياه ولو احترق كلّ البلد.
كانت بداية عبد الباسط السّاروت مع الثّورة مع أوّل بداياتها ليكون صوتها الجميل المدويّ في ساحاتها، في البياضة والخالدية حينما كان يكاتف الفنّانة الرّائعة فدوى سليمان في السّاحات ويقود المسيرات المطالبة بالحرّية والكرامة لتجابه بالقمع والبارود والنّار والخيانات وتجرّ مكرهة إلى مربّع العنف القاتل المدمّر للكيانات. كان السّاروت حاضرا منذ البداية ليكون الحرف والكلمة والشّعر واللّحن والصّوت الجميل الصّادق الصّادح ليجابه بصوت المدافع والبراميل المتفجّرة وقمع فاق التصوّرات. السّاروت شاب ولد ذات يناير 1992، كان حارس مرمى لفريق الكرامة ولمنتخب بلاده للشّباب، كان من الممكن أن ينهج طريق غالبية زملائه ليمثّل فريق منتخبه الأوّل وربّما ليجد مكانا له كمحترف في أحد الفرق الأجنبية لينعم بالدّولارات وبذخ الحياة، لكنّه اختار الطّريق الصّعب وخيّر أن يحرس ويدافع عن كرامة مهدورة في ميادين الواقع والجدّ، اختار أن يقاوم وأن يحتضن الأرض الّتي أنجبته كشجرة زيتون عصيّة على الاقتلاع، نبت من عمق الأرض وحمل تضاريسها وصار معبّرا لآهات المعذّبين فوقها.
كان السّاروت حاضرا في الثّورة في كلّ لحظاتها، شاهدا على لحظة ميلادها ومرافقا لها في انعطافاتها وتحوّلاتها، ومعبّرا بصوته وبصفحة وجهه عن القليل من ابتساماتها والكثير من حزنها وانكساراتها وهنّاتها. كان في بدايته كبلبل يشدو للحرّية والحياة والحبّ ليجبر إلى أن يتحوّل إلى نسر يدافع عن وجوده ووجود من كان يطربهم ويلهبهم حماسة وشوقا إلى حياة أفضل. كان حارسا لفريق الكرامة ولمنتخب شباب بلده الواحد ليتحوّل إلى حارس لكرامة شعب يتطلّع لأن يعيشها في البلد الواحد.
السّاروت الأسطورة
تواجد السّاروت، خلال تسع سنوات من ثورة مغدورة تهافت عليها ضباع العالم بأسره لأجل وأدها، في كلّ الميادين والأماكن، في البياضة والخالدية، في بابا عمر حينما كان محاصرا وفي حمص حينما شارك المحاصَرين أكل أوراق الشّجر والزّيتون المرّ، شارك بصوت حنجرته الّتي صارت علامة مميّزة للثّورة وبصوت بندقيّته ليواجه الموت طلبا للحياة، قاتل قوّات النّظام وميليشياته في حمص ليهجّر إلى الشّمال في 2014 ويلتحق بجيش العزّة، تعرّض إلى الكثير من محاولات الاغتيال كانت آخرها في 28 يناير 2018 ليصاب يوم الخميس 6 يونيو 2019 في يده وقدمه وأمعائه مع نزيف حادّ ساعات بعد احتفاله بدخول بلدة تل ملح، تمّ نقله للعلاج في تركيا حيث فارق الحياة هناك، رحمه الله وتقبّله عنده من الشّهداء.
كان يجابه الموت، بل ويتجرّأ عليه، يخوض معاركه مقبلا غير مدبر بشجاعة قلّ نظيرها ليتحوّل إلى إيقونة كاملة الأوصاف بل وأسطورة متكاملة الأركان، صفات وسلوك من شابّ في مثل عمره نقلته إلى خانة الأبطال الخوارق في مخيّلة وقلوب محبّيه. كان السّاروت ممثّلا أمينا للثّورة وصوتا صادقا معبّرا عنها بعيدا عن مصادح سماسرة نزل الخمسة نجوم، كان كتابا مفتوحا يمكن قراءة ما تمّ فيها من مؤامرات طالتها من الدّاخل والخارج وما دفعت إليه من تحوّلات لم يتخيّلها أشدّ المتشائمين، الساّروت هو الرّجل الأقرب تجسيدا للثّورة السّورية في نقائها وعفويتها قبل أن تدنّسها الأيادي الآثمة.
بأوّل أغنية “جنّة جنّة جنّة ا نت يا وطنّا” إلى آخر ما شدا به وهو في ساحات الوغى “سوريا ضلّي واقفة” وهو يغنّي لسوريا الحرّة الواحدة إلى كلماته الأخيرة وهو يوصي الثّوار: “يا شباب لا تضيعوا دم الشهداء، بجاه الله لا تضيعوا دم الشهداء”، كان السّاروت الحارس الأمين والبلبل الفريد والنّسر الكاسر وطائر الفينيق المنتفض من تحت الرّماد، كان اكسيرا لثورة تأبى الموت ومثالا للقائد والقدوة ومن يستمع لأمّه الحاجة حسنة، وهي الّتي فقدت زوجها وستّة من سبع أبنائها وحفيدين وخمسة من إخوتها لتستحقّ عن جدارة لقب خنساء العصر، كيف ترثيه وتوجّه رسالة لرفاقه محفّزة إيّاهم على الاستمرار في المقاومة والنّضال، ومن يشاهد جنازته كيف جمعت ما تفرّق ونفخت من جديد في ثورة أرادوا دفنها يتأكّد من أنّ ثورة الشّعب السّوري مآلها أن تنتصر في النّهاية وتحقّق أهدافها على قول شاعرنا التّونسي الفذّ ابو القاسم الشّابي: “إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر ولا بد لليل أن ينجلي ولابد للقيد أن ينكسر”.
الذكاء الاصطناعي والغباء السياسي/ سلام الكواكبي
إلى جانب تعقب حيواتنا وتحولاتنا وتنقلاتنا، تقوم المواقع الأساسية في الشبكة العنكبوتية كغوغل والفيسبوك، بطرح إعلانات موجهة لكل منا تتعلق بميوله الشرائية أو القرائية او السماعية أو …إلخ. وهي تتعقبه في تنفسّه لتعرف أهواءه وتقترح بالتالي عليه ما يناسبها من الفقرات الإعلانية التي كثيراً ما تفاجئنا بدقتها. إلى جانب الإعلانات، تُتحفُنا مواقع التواصل الاجتماعي أيضاً بإعادة نشر أخبار قديمة نسبياً أو كثيراً ومرتبطة بحدثٍ جديد. فيعمل الذكاء الاصطناعي عمله ويربط الأحداث ببعضها وينتخب في ذاكرته ما يراه مناسباً ويقترح أن يذكرنا بواقعة مرتبطة بهذا الحدث أو بعناصره في ماضٍ من الزمن. وتحمل هذه التجربة عديدا من المفاجآت وتذكرنا أيضا بالكثير من المنسيات. إلا أننا، كأفراد، نقوم أحيانا بنبش ماضينا الإلكتروني وإخراج ما نعتقد بأنه مرتبط بحدث جديد ونستعرض من خلاله مقدرتنا السابقة لعصرها في توقع وفي تحسس الآتي من الأحداث.
في يوم استشهاد عبد الباسط الساروت، الرمز الثوري السوري، ظهر على شاشة حاسوبي مقالٌ لتجمع سينمائيين ارتأوا أن يحتفظوا بأسمائهم مبهمة رغم معرفة كل من يتابعهم ويعجب بأعمالهم بها. ومن العنوان توقعت الأسوأ، ولم أنتبه إلى التاريخ، فظننت للوهلة الأولى بأنه منشورٌ في اليوم نفسه. ماذا يقول العنوان؟ بكل بساطة، يقول عنوان المقال المنشور في صحيفة الليبراسيون الفرنسية واسعة الانتشار: “فليسقط أبطال الثورة السورية”. وعلى عادة الباحث الذي لا يستند فقط إلى عنوان ربما يحمل تحريضا ليقول عكسه في النص، وعلى الرغم من صدمتي المبدئية بالعنوان، إلا أنني لم أحكم على النص إلا بعد أن قرأته ثلاث مرات. القراءة المتتالية ليست دليلاً على صعوبة النص وعمق مفاهيمه، بل ترتبط هذه القراءة المتكررة بالدهشة التي تحاول أن لا تصدق ذاتها.
فالنص المستعاد عمداً من أصحابه يوم استشهاد الساروت، والذي سبق نشره سنة 2015 عشية خروج الساروت من حمص ووقوعه لفترة وجيزة في أحضان متطرفين إسلاميين، وهو الشيء الذي كتبت فيه صفحات طويلة شارحة أسبابه المرتبطة بمآلات الحراك السوري بمجمله، النص هذا يدور حول الشهيد نفسه. إن تعمّد إعادة نشره، رغم افتراض علم أصحابه المثقفين بتطورات الأسباب التي دفعتهم بغيرتهم التقدمية إلى التنديد بالساروت حينها، يعني بأنهم متمسكون بموقفهم ضيق الأفق الذي دفعهم الى كتابة مقالهم منذ سنوات أربع. كما يدل على أنهم انفصلوا عن تطورات الحدث الساروتي منذ ذاك التاريخ.
من الجمل البافلوفية في النص، نتوقف مثلا عند عبارة يمكن لمن ينطق بها أن يدعى إلى برامج عديدة في التلفزيون المصري مثلاً والتي تندد بمطالبات ديمقراطية لمن يعتبر دهماء الإعلام المصري بأن أفكارهم لا تمت للديمقراطية بصلة. يقول النص: “هل يمكن أن نستمر بالإيمان بوجود ثورة في سوريا ما دام أبطالها ـ والقصد هنا الساروت ـ ينتمون إلى أفكار من يعادي الديمقراطية؟”. ومن ثم يستعرض المقال مسار الساروت، متهكماً أساساً، ومن باب الغيرة الفنية أو عداوة الكار، على فيلم “العودة إلى حمص” لطلال ديركي الذي صوّر ـ ودائماً حسب المقال ـ الساروت كبطل وحتى كمسيح يمشي على الماء في مشهد يظهره وهو يمشي على أكتاف الجموع الملتفة حوله. ولا يقتصر الأمر على الاستخفاف بالفيلم الوثائقي الذي حصد جوائز عالمية عدة، إلا أنه أيضاً يُضيف بهارات مطلوبة لكل وسائل الإعلام البافلوفية عربيا وأوروبيا، ويفتح الباب على مصراعيه لأصحاب هذا التجمع السينمائي “المجهول” لكي تتم استضافتهم في برامج تنتمي إلى عالم اليمين المتطرف أوروبيا أو إلى عالم اليسار المتخشب عربياً، فيتعرض لدور قناة الجزيرة في إطلاق صفات البطولة على الساروت.
إن تحدثت عن الراديكالية الإسلامية خالطاً شعبان برمضان ومتجاهلاً المسارات والوقائع، كما وإن زينت حديثك بالتهكم على دور قناة الجزيرة، فثق حتماً بأن أبواب الشهرة الغربية ستفتح لك. هذا ما اقتنع به أصحاب المقال عند نشره للمرة الثانية في يوم الاستشهاد. ومن باب حسن الظن، فإن نشره للمرة الأولى سنة 2015 كان ردة فعل على حدث بعينه ودون أي خلفية معرفية أو رؤية مستقبلية. ولكن إعادة نشره ممن يعرف أو أنه يدّعي معرفة تطورات المشهد السوري، فهو بالتأكيد ليس فعلاً بريئاً، رغم أنه يظل في حيّز حرية التعبير عن الرأي ويحق لمنتقديه الذين لطالما أعجبتهم “نهفات” هذا التجمع السينمائية المسمى بـ “أبو نضارة” أن يوجّهوا له النقد وعلى أشده.
من المؤسف حتماً أن يُدعى كلٌ إلى الانهماك في عمله والتموضع في حقل اختصاصه، إذ إن المثقف الجامع هو نموذج اليوم. بالمقابل، يبدو أن مستوى الجهل أو التجاهل لدى بعض المثقفين بكافة تفاصيل المشهد تدفع لدعوتهم الى الاهتمام بالاختصاص. فلن أخوض أنا مثلاً في تفكيك عمل سينمائي وتحليل جوانبه الفنية، وربما أكتفي بإبداء إعجابي أو عدمه، وهكذا يكون لي رأي. وبالتالي، فعلى “أبو نضارة” الاكتفاء بإمتاعنا بشرائطه السينمائية المتميّزة حتماً وترك السياسة والخوض في تحليلاتها إلى أهلها أو له إن رغب، على أن يُعبّر عنها على قهوة ناصية الشارع. وإلا فسيحل الغباء السياسي محل الذكاء الاصطناعي في المشهد الثقافي السوري على الأقل.
تلفزيون سوريا
في وداع الساروت/ إيمان محمد
يصعب جداً، بل يكاد يكون مستحيلاً أن تعود بمشاعرك إلى بدايات الثورة، فتحياها كما هي، بقوتها، بعنفوانها، بصدقها، بشعبيتها، بطهرها ونقائها. ذاك شعورٌ لم أصدق أن بالإمكان استعادته بعد الغربلة والخذلان والضفادع والتقلبات الكبيرة التي حدثت داخل الثورة، مما أفقد الناس الثقة بمتابعتها، وأفقدهم الثقة في أنفسهم فتراجعوا عنها.
لا أحد يعرف كيف تتغير الأمور، ولأي سبب تنقلب الموازين، شهيدٌ واحد، شاب صادق واحد صنع الفرق وعاد بنا إلى زمن المجد، وقد أعادني مشهد تشييع الساروت إلى 2011 إذ كان الجميع على قلب واحد، وحيث تجلت روح الثورة ونبضها، وحيث كان للشهداء والدم المُراق في سبيل إحقاق الحق قيمة، وحيث كان الناس يغارون على قطرة الدم، ويتألمون لرحيل المخلصين.
هل كان الساروت يعلم أن شهادته التي حلم بها منذ البدايات، وتخيلها في صور شتى، ولاحقها عبر سنوات الثورة الطويلة وأحداثها العصيبة فلم يظفر بها، هل كان يعلم أنها أتته اليوم في الوقت المناسب، بعد أن بهت وجه الثورة، وخُذلت كما لم تخذل ثورة من قبل هل كان يدري أنها ستنعشها وتحييها، وأن تشييعه سيكون بعظمة أهدافها، وبعظمة شعب آمن بها إلى هذا الحد؟
رغم كل الأحداث العاصفة والمؤثرة التي مرّت بنا في الثورة، يصعب كثيراً نسيان مظاهرة واحدة من مظاهرات السّاروت، لا يمكنني إحصاء عدد المظاهرات التي كانت تخرج من مساجد مدينتي حمص كل جمعة، لكن المظاهرة الجامعة كانت مظاهرات الساروت، يأتي إليها شباب الثورة من كل أنحاء حمص، بل ومن مدنٍ أخرى، ليشهدوا هتاف الساروت، ويشاركوا خلفه حتى تبحّ أصواتهم، ولا يغادروا إلا وقد تجددت دماء الثورة في عروقهم، فكانوا يعبرون عن تلك المشاعر بطرق مختلفة، ويتناقلون كلماته ويحاكون أسلوبه بالهتاف، ولا يستطيعون مواكبته في التفاعل مع الكلمة.
أذكر في المظاهرة الأولى التي شهدتها معه أنه طالب الجميع أن يرفعوا أيديهم لأعلى، لأعلى أكثر وكأنها تعانق السماء، لم أفهم المراد حتى بدأ يخاطبنا بأننا سنؤدي قسم الثورة، وكعادتي لم أجازف بالقسم حتى أعرف على ماذا أقسم، ولما عرفت كنت أحزن عندما تخلو المظاهرات من القسم، ففيها تجديد العهد، ودعوة للاستمرار مهما كان الثمن، كان الساروت دائماً يحب أن يختتم مظاهراته بسورة النّصر، وكأنه يرسل رسالة مغزاها ضرورة السعي فهناك نصرٌ وفتح مبين لابد سيأتي ولابد أن نصرّ على قدومه.
مع بداية حمل السلاح لم يتردد الساروت في القتال لأجل الحق والكرامة، حوصر وصبر، وكانت المعنويات العالية تصل للعالم عبر إصراره وكلماته، رحل عنه رفاقه كتيبة شهداء البياضة، فلم ييأس ولم يستسلم رغم الانكسار وهول الفاجعة، وبعد التهجير تقلب في مسارات عدة كان يبدو جلياً منها أنه يفتش عن من يعينه على المقاومة، ثم أدرك بعدها كيف يتجه إلى الصواب ويعود للهدف الصحيح، أخذ موقعه في النهاية كأسد مغوار، ووقف على الجبهات بشجاعة، ودَّعنا قبل ليلة كعادة الأبطال بالقوة والعزيمة والإخلاص، أصيب ثم غادرنا بشموخ، ولن يغادر الذاكرة، لن يغادر اسمه الثورة مهما حاولوا طمسها أو تجاهله، مثل الساروت لا يمكن نسيانه أو تجاهله أبداً.
لن يفرح الشامتون برحيل الساروت أبداً، فالإنعاش في الثورة واقع، تواكبه أحداث مهمة على جبهات ريف حماة وريف إدلب، رفاق الساروت من خيرة شباب الثورة يقفون ليدافعوا عن أرضهم ببسالة، تتزاحم المعاني ما بين فرح وتأثر وتأمل لما يحدث، من حقنا أن نشعر بشيء من الفرح حتى في اللحظات الفاجعة التي يتركها رحيل أبطالنا، فطالما هناك من يضحي ويثابر سيستمر الأمل. هنيئاً للساروت تحقيق حلمه، لقد حقق ما هو أكثر من حلمه، لقد ترك نجمة في السماء تضيء لتخبر عنه، كلما فكر النسيان بالعودة سيطارده صوت الساروت وهو ينشد للوطن من بعيد.. جنة جنة
تلفزيون سوريا
البطل الشعبي/ ميخائيل سعد
في سنوات الجمر، أي في بداية الثمانينيات، جاء أحد المسنين الحلبيين الميسورين لزيارة ابنه في بيروت، ولما كنت أعرف الابن، الذي لم يكن يستطيع الذهاب إلى سورية لأنه مطلوب أمنيًا “لتعاطفه” مع الحزب الشيوعي (رياض الترك)، فقد أُتيحت لي الفرصة للجلوس مع العجوز أكثر من مرة، في مقاهي “الروشة”، حيث يدخن أركيلته، ويتحدث هامسًا، ناظرًا إلى اليمن واليسار، عمّا كان يجري في سورية، وما كان يصل إلى مسامعه من قصص وأخبار عن القتال بين سلطة حافظ الأسد والطليعة المقاتلة، وكانت حلب ساحة رئيسية من ساحات القتال تلك. في إحدى المرات، أثناء حديثه، استقام ظهره ولمعت عيناه، وهو يروي كيف أن المخابرات كانت تلاحق أحد المطلوبين من “الطليعة”، وحاصرته في زقاق شعبي ضيق، وعندما اقتربت دورية الأمن منه، التفت باحثًا عن منفذٍ، فلم يجد أمامه إلا فرن الحيّ فدخله، ولما لم يكن هناك مكان للهرب من رجال الأمن إلا “بيت النار” ألقى نفسه فيه، ووقف رجال الأمن ينظرون مندهشين وشامتين بهذا الإرهابي المعادي للنظام “التقدمي”، وهو يحترق.
كان الرجل المسن، الذي لم يكن معجبًا بالطليعة المقاتلة، يتابع بحماس رواية تفاصيل القصة التي وصلته عن هذا البطل الذي فضل الموت حرقًا على الاستسلام والاعتراف بأسماء أصدقائه المجاهدين، قائلا حرفيًا: “لقد شخ على عنتر” في شجاعته. كان يعرف أنه لن يستطيع المقاومة، وأنه في النهاية سيقول كل ما يعرفه عن التنظيم، لذلك فضّل الموت على الذل والخيانة.
رويتُ هذه القصة عشرات المرات، ووجدت نفسي معجبًا بهذه الشخصية الأسطورية في سلوكها، على الرغم من انتمائها الديني والأيديولوجي، فقد استطاع، بتضحيته بنفسه، العبور فوق الأيديولوجيات والأديان، ليقدم لنا نموذجًا عن البطل الشعبي الذي يضحي بحياته من أجل الجماعة وقيمها الإيجابية، سواء كانت هذه الجماعة سياسية أو دينية أو قومية، مستعيدين عبره سيرة الأبطال الشعبيين الذين نعرفهم على ألسنة “الحكواتية”.
كان أغلب من رويت لهم موقفي الإيجابي من ذلك البطل، يخافون أو يلومونني لأنه مسلم، بل مسلم متعصب، ويستغربون تعاطفي معه. كان رأيي -وما يزال- أن هذا النموذج من البشر لا ينطبق عليه التوصيف الديني، على الرغم من أهمية الدين في حياتنا، لأنه عابر للأديان والطوائف، إنه شوق الشعب للتحرر من العبودية والخنوع، ورغبته في امتلاك مصيره. هذا هو بعض المعنى الذي جعلني أدافع عن ذلك البطل وتضحيته بنفسه، ولم يكن يعنيني إلى أي دين ينتمي.
عبد الباسط الساروت هو نموذج معاصر لذلك البطل، بل إنه فاقه في التضحية، فالأول لم يكن أمامه إلا الفرن وناره، ولكن الساروت كان يمتلك خيارات متعددة إلا أنه أختار الاستمرار في ثورته ودفع ثمن ذلك روحه، مع إدراكه أنه سيصل إلى هذه النتيجة، وهذا ما يجعله متفوقًا، فالسنوات علمته أن نظام الأسد لن يغفر لأي سوري ثار ضده، وقد عرف ذلك من تجارب من سبقه من أبطال الثورة السورية، مثل الشهيد يوسف الجادر “أبو فرات”، والشهيد باسل شحادة، والشهيد عبد القادر الصالح، المعروف بـ “حجي مارع”، والشهيد المقدم حسين الهرموش، وعشرات بل مئات الشهداء الآخرين. إن أمثال هؤلاء هم من جعلوا الثورة تستمر، لأنهم لم يكونوا يبحثون عن مكاسب مادية أو معنوية، وإنما كانوا يبحثون عن الحرية، لهم ولشعبهم، التي حرمهم منها نظام الأسدين.
في قادم الأيام، سيروي السوريون لأولادهم وأحفادهم سيرةَ البطل السوري عبد الباسط الساروت ورفاقه، من المهد الى اللحد، كي يكون منارتهم عندما تشتد الظلمات ويريدون العودة إلى منازلهم. وستنتظر أرواح رواد المقاهي السورية عودةَ البطل الشعبي عبد الباسط إلى الحكاية، في كل مرة يتوقف فيها الحكواتي عن الحكي.
البطل الشعبي والمثقف الزائف/ فيصل الزعبي
كل الذين لديهم كلام غير مسؤول، عن بطل شعبي مثل الساروت والقاشوش وغيرهما الكثير، كانوا يخرجون من فيلم (قلب شجاع) لـ ميل جيبسون، وهم يشعرون بقيمة الكرامة، ويمنحهم الفيلم النصر الجواني للحياة، وربما علقوا في بيوتهم صورة البطل السينمائي وليس البطل الواقعي الذي جسده ممثل الفيلم…!
ألم يقاتل بطل (قلب شجاع) بكل ما يملك من سلاح حاد من أجل الكرامة، من أجل قيمة تخص الروح الشعبية، وتخص القيمة الوطنية، على الرغم من أن جيش أعدائه لم يستبيحوا الحياة بهذه القسوة التي استخدمتها أنظمة مستبدة، كالنظام السوري، ولم تتم إبادة شعب، وتهجيره كما حصل في المقتلة السورية التراجيدية الشنعاء؟ ثمّ ألم يكن لدى بطل (قلب شجاع) مقاتلون شعبيون قساة، ألم تدر مذابح حقيقية بين الرجال، وكانت النساء والأطفال في مأمن بشكل ما!؟
ربما الأدب والفن الحديث لم يتناول مفهوم وتجسيد البطل الشعبي، الفوضوي، الذي يدافع عن أرضه وعرضه وكرامته التي هدرت.
عليك أن تقرأ جيدًا -أيها المثقف الزائف- كيف يقاتل البطل الشعبي، وكيف يفني كل ما لديه، كالساموراي أو المقاتل الياباني الذي كان يرمى بنفسه وطائرته في حلق الأسطول الأميركي.
لا يمكن للمواقف الأيدولوجية أن تكون عائقًا، كما يحصل الآن في المجزرة السورية، فهي لا تميز بين البطل الشعبوي، والمقاتل المأجور.
ألم يتبنَّ المثقف خرافة الزير سالم وتجسيدها كقيمة شعبية، ومن رحم مفهوم البطل الشعبي “لا تصالح” أليست فكرة انتقام؟
المثقف العربي الزائف يريد أن يكون البطل الشعبي على الورق فقط، كما هو نضاله الإنشائي التاريخي، الذي صاغه كبيانات ومواقف في أمسيات ضيقة، فقط للتطهير، بينما يبني الأعداء منشآتهم على أرضه المحتلة.
ألم يؤدِ جزار ليبيا الجنرال غريستياني التحية لجثمان عمر المختار، وهو قاتله؟ لمذا فعل ذلك القاتل الإيطالي؟ ليس بسبب عدالة في رأسه، بل هو فهم تاريخي للبطل الشعبي، وقيمته، كما عرف كيف يؤبّد نفسه بإيجابية مع ضحيته، فلو أنه قتله من دون هذه التحية؛ لنسيه التاريخ وأبقى عمر المختار وحيدًا ببطولته.. حتى المثقف الزائف البائس لا يعرف هذه المعادلة الأخلاقية، أو رديفها الانتهازي.
لست بصدد تعريف المثقف الزائف بهذه المقالة، فلقد كتب عنه، بأسماء مهذبة، جورج لوكاش وكثيرون غيره، وتحت عناوين مختلفة، مثل المثقف العضوي ودوره الثقافي والتاريخي في التغيير. ولست بصدد تعريف البطل الشعبي الممتد والمتجسد في كل فنون وثقافات المجتمعات.
لم يكن البطل الشعبي يومًا مصلحًا ولا صاحبًا لأفلاطون، وهو ليس مثقفًا في الأساس! إنه مناضل ومقاتل عفوي مملوء بالأخطاء، لكن له في الأدب والفن، قيمة جمالية عليا، يرصدها المثقف غير الزائف، بفخار وعزة. حتى إن الرسامين والكتاب والسينمائيين وغيرهم من المبدعين، اقترحوا في إبداعاتهم أبطالًا شعبيين، غير واقعيين، من أجل هذه القيمة العليا للبطل الشعبي الواقعي.
الساروت: بطل شعبي بامتياز، قُتل في معاركه الحياتية، وهو ينشد حينًا ويقاتل حينًا آخر. لم يكن قائدًا فذًا، بل كان موجِعًا بحنجرته، وشجاعته، وصدقه؛ لذلك أطلق أعداؤه على قتله عبارة (الصيد الثمين)، لأنهم يدركون أنه بطل شعبي، وهذا النوع من الأبطال، يصمد زمنيًا، فهو مخيف وخطر، لذلك لا بد من الخلاص منه كشخص، وكقيمة، تدخل الوجدان الشعبي، الوجدان الذي لا يموت.
ما الذي يفعله المثقف الزائف؟ إنه يقود تزوير القيمة، وكما هم (مؤرخو) الأباطرة والمستبدين، يؤرخون بتزويرٍ منقطع النظير، فلا بد من جيش يوازيهم من المثقفين الزائفين الأنذال، كي يبددوا القيمة الأخلاقية والإنسانية لمفهومات كثيرة، منها البطل الشعبي، وقيمة الموت من أجل الحرية والكرامة.
البطل الشعبي ليس لديه برامج سياسية براغماتية، ولا يعرف -إذا انتصر- ما الذي سيحدث بعد ذلك. يعرف الدفاع عن شعبه فقط، بلا طلبات ولا مواقع ولا مال ولا مناصب.. لا يعرف أنه سوف يكون رمزًا، ولا يدري متى تنتهي الحرب ولا كيف بدأت.
البطل الشعبي كما هو عروة بن الورد في الوجدان، لكن المثقف الزائف المعاصر، انتقائي حقير، يشبه المثقف النازي والصهيوني.. يحمل عقلًا انتقاميًا وضيعًا، وآه يا سورية كم قاتلٍ لديك ومقتول، وكم من السكاكين على نحرك! والأيام القاسية لم تأتي بعد، وإنه لشرخ عميق وعظيم.
جيرون
بسبب وثائقي الساروت.. “فايسبوك” يحذف “زمان الوصل TV”
أعلن مؤسس ورئيس تحرير صحيفة “زمان الوصل” الالكترونية السورية، فتحي بيوض، أنّ موقع “فايسبوك” حذف صفحة “زمان الوصل TV” التابعة للصحيفة، بسبب نشرها فيلماً وثائقياً حول المعارض الراحل عبد الباسط الساروت.
ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان عشرات السورييناختفاء منشوراتهم من “فايسبوك”، التي كانوا قد رثوا فيها الساروت، بحجة “مخالفة قوانين النشر” و”الإساءة لمعايير المجتمع” في المنصة الاجتماعية، فيما قال آخرون إنّ الأمر يعود لحملة تبليغات تقوم بها حسابات موالية للنظام ضد المعارضين. كما حذفت إدارة “فايسبوك” مجموعة “منتدى السوريين في فرنسا”، والتي تتضمن أكثر من 55 ألف عضو، “نتيجة التبليغات الكثيرة، بعد السماح بمشاركة العديد من المنشورات، المتضامنة والمتعاطفة مع قصة ومواقف عبد الباسط الساروت”.
وكان من بين الذين طاولتهم حملة الحذف الكاتب والمعتقل السابق، ياسين الحاج صالح، الذي حذف الموقع أكثر من منشور له كان قد رثى وتحدث فيه عن الساروت، وذلك ضمن ما وصفها الحاج صالح بـ” حملة اعتقال منسقة لبوستات ومقالات ساروتية”. وقال في منشور عبر حسابه في “فايسبوك”: “الأسدية الإلكترونية شغالة باعتقال وقتل الكلمات ما دام ما قادرة على اعتقال وقتل أصحابها”، معلناً عن أن الحملة طاولت أيضاً الكاتب والباحث اللبناني، زياد ماجد، حيث تم حذف كلامه وتجميد العمل بحسابه.
حملة الحذف التي قام بها “فايسبوك” دفعت بنشطاء إلى إطلاق عريضة الكترونية تحت عنوان “اطلبوا من فايسبوك الالتزام بحرية التعبير وعدم حذف الكتابات عن عبد الباسط الساروت”.
وطالب الموقعون على العريضة إدارة “فايسبوك” الالتزام بالحرية التي تكفلها شرعة حقوق الإنسان العالمية، وذلك بإعادة كلّ الكتابات المحذوفة وإعادة تفعيل الحسابات المجمّدة، والتوقف بشكلٍ نهائي عن مثل هذه الممارسات التي تُذكّر السوريين بالديكتاتورية التي قاموا لمواجهتها بحثاً عن حريتهم وكرامتهم.
وأضاف الموقعون: “إذا كان من المعيب الوقوع في مثل هذا الخطأ بسبب الاعتماد على (الآلات) التي لاتميز معاني الحرية والعدالة، وتحترم مشاعر الشعوب المطالبة بها، فإننا “نطالب إدارة فايسبوك بأن تتحمل مسؤوليتها الأخلاقية، وتنسجم مع مبادئ تأسيس الموقع، وتقوم بحل المشكلة عن طريق عاملين لديها يستطيعون التمييز بين ماهو مسيءٌ حقاً للناس ويُخالف شروط استخدام الموقع، وبين مواد تُعبّر عن رأي الشعوب الباحثة عن حقوقها الإنسانية التي تكفلها كل القوانين والشرائع”.
لا مكان للساروت في قواميسكم/ عمار ديوب
كحارسٍ محترفٍ لها، آمن بالثورة في بلاده سورية. أغواه جمالها وجمالياتها، فحازت على قلبه، وأصبحت رئتيه اللتين يتنفس بهما. عشقها بوجدِ الولهان، وغنّى لها، وخَطبَ بأهلها. لم يترك مناسبةً إلّا وكان في مقدمة نشاطاتها، واحتفالاتها. لم يكن قبلها (العام 2011) يتقن الصلاة؛ الألم والحصار والجوع والاعتقال والموت تستدعي الله والأنبياء، حينها تعلّمَ بعض أصول الدين وصلى لرب العباد، ليجد للبلاد خلاصاً من الأهوال التي بدأت معالمها بالظهور. لم تكن نصرةُ الدين هدفه، ولن تكون، فلهذه الغاية أصحابها وأهلها وتجّارها ومجانينها؛ كان يبتغي مؤازرة مدينة درعا، والإفراج عن المعتقلين، والاعتراف بالحريات، وإيقاف الفساد وكل أشكال التطييف. رَغِبَ ابن الثامنة عشرة بإصلاحٍ يُجنب البلاد المآسي التي صارت إليها، ولكنّ هذا الإصلاح لم يأتِ. بعدها تكثف القتل الهمجي، والذي كان سبباً في الانتقال من الإصلاح إلى الإسقاط.
أحبَّ عبد الباسط الساروت سورية “جنّة جنّة جنّة”، ليس لنفسه أو لطائفته، بل أحبّها من أجل كل السوريين؛ فهو ابن حمص، حيث التعدديّة بكل أشكالها، مسيحيين وعلويين وسنّة، بدوا ومدنيين، عربا وتركمان وشركسيين، سفورا ومحجبين، شيوعيين وبعثيين وإخوانا… وفي الثورة تَشاركَ تأييده لها، وانخراطاً فيها، مع باسل شحادة وفدوى سليمان، وآخرين كثر، ومن كل الانتماءات. قوبل حبّه ذاك بمزيدٍ من القمع والقتل والمجازر والدمار والحصار والتطييف وتقسيم حمص على أساسٍ طائفي!
رفض النظام الاعتراف به وبالثورة، وغرقت أغلبية قيادات المعارضات بالفساد، وبترتيب
علاقاتٍ تصبح عبرها أداةً للدول، وتنفذ سياساتها وتَحمِلها على طبقٍ من ذهب إلى السلطة. ليس الساروت سياسياً، ولم تمدّ له يدُ المساعدة؛ حُوصر وجاع وأكل أوراق الشجر، ونحف. ولكنه لم يُصالح، ورفض كل عروض الإغراء، وأصبح من المطلوبين للنظام وبكل السبل، قتلاً أو أسراً، وخُصص لمن يقتله مال، وداهنه بتسويةٍ تُعطيه امتيازاتٍ كُبرى؛ لم يقبل الحارس، ولم يداعبه حلم العودة إلى الطاعة وأيّة طاعة أخرى.
حوصر عبد الباسط الساروت في حمص، وحاول الصمود بكل السبل. ويقول الموالي والمعارض إن الأحياء التي أصبح يحكمها مع آخرين لم تتعرض للسرقة والنهب والتعفيش؛ إطلاقا ومطلقاً، فقط أخذوا الطعام والوقود، أي ما يقيهم من الموت جوعا أو برداً. هذا يوضح الأخلاق التي يستند إليها الرجل، والحلم الذي يسعى إليه، فهو لم يكن إلّا ثوريّاً، وفعل كل ما يستطيع للوصول إلى غايته. قُتل أهلُه، وأصيب أكثر من مرّة وقُتل رفاقه. وحينما غادروا مدينته، خرجوا بأسلحتهم الفردية، ومن لم يمت من أهلٍ ظلّوا مع أولادهم المقاتلين. وبعزيمة العودة إلى حمص؛ لم يغادر ذلك الحلم، وظلَّ يجول في فؤاده، وكأنّه حبيبته السرية، ولكنها المعلنة أيضاً، فتطابق في وجدانه السر والعلن، ومات وهو يسعى إلى هدفه. كان في وسع الساروت استثمار أنه رياضي، ومغنٍّ، ولديه حقيقة وأسطورة الحصار والصمود، واستشهاد كثيرين من عائلته؛ أبى إلّا العودة إلى ميادين القتال. من هنا، يمكن أن نفهم أسطورته، والحب الذي كان له قبل الاستشهاد وبعده.
حاولتُ تقصّي حكاية الجهادية، والأقوال التي نسبته تارةً إلى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتارةً إلى جبهة النصرة، وتبيّن أنّه لم ينضوِ يوماً تحت أيّ من رايتيهما، بل ولوحق وحوصر منهما، واضطر بسبب ذلك للهرب إلى تركيا، ثم عاد إلى وطنه؛ فهو لم يجد مبرّراً للبقاء في الخارج. وحالما عاد حاكمته جبهة النصرة، ثم أسقطت الاتهامات ضده؛ هذه هي القصة أيها المنافقون. حينما اقترب من “داعش”، لم ينضوِ فيها، وتمَّ ذلك لأن كل سبل المساعدة أغلقت في وجهه ولأسباب أخرى. وحالما تبيّن له أن “داعش” فصيل لقتل الثوار، ابتعد عنه، وكذلك فعل مع جبهة النصرة. نعم، لم يقبل الرجل تلويث دمه وسيرة الثورة، وعاد إلى القتال، وبأسوأ الشروط.
الساروت هذا أيقونة. نعم، فهو يمتلك كل أسباب الحياة، ويرفضها من أجل الانتصار لقضيته،
ويعلم أن ذلك قد يُفقده الحياة؛ ذلك الفناء الذي سبقه إليه أهله ورفاقه، وما خانهم، وما صالح وما صار سلفيّاً أو جهاديّاً؛ إمّا أن تفهم الأمر كذلك، أو أنت تبتغي الصيد القذر، وليس العكر فقط. تتحدّد قيمة الإنسان في أفعاله. والفعل يجمع القول والعمل. لم يبتدع الرجل أمراً ليس فيه، وأسطورته شكلتها أفعاله، وتمايزه عن سواه ومعهم، والسؤال: ألا تستحق الجلجلة السورية أنبياء وملائكة وأيقونات؟ المقاييس التي تمجّده كإلهٍ ليست صحيحة، والتي تشيطنه ليست صحيحة، والتي تُخرجه من جنة قواميس الثورات المتخيلة أيضاً ليست صحيحة. الحقيقة أنّه ابن مدينة حمص العديّة، خاض كل معاركها، ورَهنَ حياته للقضية التي وجدها مُحقة، وهو بذلك انسجم مع ذاته ومع الشعب، كما قال هو، والتزم بذلك.
إن كان من مدانٍ، بكل مالآت سورية، فهو النظام أولاً، والمعارضة بكل تنويعاتها ثانياً، والدول الخارجية ثالثاً، وبالتأكيد التنظيمات الجهادية، والتي ليست أكثر من أدواتٍ سياسيةٍ لصالح الدول، ويقودها جهاديون منفصلون عن العصر، ويبتغون إعادة الزمن إلى لخلف، وهذا غير ممكن. أمثال الساروت كانوا مجانين بالمعنى الثوري فقط؛ سعوا من أجل الثورة واستشهدوا من أجلها؛ هو ورفاقه، وكثيرون لا يعرفونه، ولا يعرفهم، وفي كل المدن السورية.
لنتأمل المشهد: لو أن النظام اعترف بسلميّة الثورة في الأشهر الأولى وأفرج عن الحريات والديمقراطية، وحاسب الفاسدين؛ هل كان سيحصل في سورية ما حدث؟ هل كان الجيش سينشقّ، وتُدمر البلدات والمدن، ويُقتل نحو مليون سوري، ويُهجر ملايين آخرون، ويصبح السوريون لاجئين بالملايين! هنا أس كل الحكايا، ولهذا يصبح نقد سيرورة الساروت معدومة الموضوع، وكلاما خارج السياق، والأنكى أن الأمر كلّه كذبٌ بكذب.
لم تُقنع الساروت إلا أهداف الثورة الشعبية كما ملايين السوريين، ولم يسعَ إلّا من أجل تحقيق أهدافها. ومن هنا تشارك مع فدوى سليمان وباسل شحادة وغيرهما. ومن هنا مناشدته كل أهالي سورية، ومهما كانت مذاهبهم، للانخراط بالثورة التي كان حارساً لها، وأبى إلّا أن يستشهد من أجل حلمه بانتصارها يوماً ما. وفي سياق ذلك، حارب النظام وقاتل الجهاديين، وظل ينسج أسطورته، ويتمايز. وبالتالي من الخطأ تشبيهه بسواه، إنّه يُشبه ذاته فقط. وفي هذا، يتمايز عن أيقونات الثورة، فلكلٍّ منها تمايزها، وفي تمايزاتها تتكامل العزائم وتتأسطر وتشدّ.
العربي الجديد
بين الساروت والطاغوت/ أحمد عمر
تبيّن لي، بعد أمّة وشعبين؛ شعب منفيٌ في الخارج وشعب منفي في الداخل، أو شعب تشعب شعوباً وقبائل متحاربة، أنني لست الوحيد الذي ذكّرته جنازة الساروت بجنازة الرائد الركن المهندس المظلي، صاحب أطول لقب معروف في سوريا الحديثة، وأوجه الشبه بين حارس الكرامة وسارقها قليلة وهي؛ أنهما شابان من عمر متقارب، ورياضيّان، وكان لهما عند الموت المبكر جنازة كبيرة ورثاء، وهذه بعض الفروق بين الناسوت والبهموت:
أول الفروق أن ابن الشعب، وليُّ المرمى، عبد الباسط ولد وفي فمه طعم اللبن وقضى في المعركة، وتحت أخمصه الحشر، ومرماه الوطن ، وأن ابن الرئيس الملك، الملك الرئيس، ولي العهد، صاحب اللقب الذهبي، ولد وفي فمه ملعقة ذهب، وقضى في حادث سير، ومرماه القصر، والفرق كبير.
وقد غُمَّ سبب موت باسل، وعدل اسمه فصار مصدراً؛ الباسل، في الصحف السورية، عُتّم تماماً، لأن شرف الموت في حادث سير أدنى من شرف الموت في المعركة، كنا نعلم السبب لكننا لم نسأل، تواطأنا على الصمت، وطُوّب شهيداً ثم سيداً للشهداء في حادث سير، وقد تلي عليه قرآن كثير، ولم يكن مألوفاً أن يتلى القرآن علناً في قلعة العلمانية، لكنها هيبة الموت ورهبته . وأطلق عليه لقب الشهيد، والشهادة وصف جاء به الإسلام لم يكن معروفاً في الجاهلية، وكانت كل الاصطلاحات الإسلامية قد بدلت في أدبيات البعث، فالجهاد صار مقاومة ونضالاً وكفاحاً وأحياناً سعره أبخس: ممانعة، وحلّ نداء الرفيق حل محل نداء الأخ، وبقيت الشهادة لأن العقول البعثية – أمخاخها وأظواظها- عجزت عن ابتداع وصف مشابه للشهيد من المعاجم، ومثلها الأحزاب اليسارية، فأوصاف مثل الراحل والفقيد لا تجيزها أو تقوم مقامها، وإن اجتهدت في تعقيم الاستشهاد من المعاني الأخروية، كالاقتصاد في ذكر الجنة، أو تجنبها أحياناً، خوفاً من منافسة جنة الدنيا الحلوة الخضرة النضرة وتجارتها، واستعارت عبارات مثل “السلام لروحه” من أديان أخرى، لتحاشي قراءة الفاتحة التي حلّ محلها دقيقة الصمت، وقد شاع مؤخراً دأب إيقاد الشموع، وتلك بدعة مبتدعة!
ومن الفروق أنّ عبد الباسط الحديدي قضى نحبه وهو يرفع سلاحه دفاعاً عن أهله ودياره، فكأنه عمر المختار السوري، وأن صاحب اللقب الطويل الذهبي مات في سيارة محصنة بوسائل الأمان هي الأغلى في سوريا كأنها برج مشيد، لكنها لم تحرسه من الموت، ومن الفروق أن أحد الناشطين تذكّر طرد أريل شارون من المسجد الأقصى عندما طرد نصر الحريري من جنازة الساروت، وهي مقارنة ظالمة، وفهمها اللوم، والحريري سنّي، وتذكر كثيرون مي سكاف زميلة المظاهرات السلمية، وهي ليست سنيّة، أو هي هجناء، فهو بهذا غدا رمزاً وطنياً. وكان النظام مغتاظاً أشد الغيظ من “دويتو” الأناشيد مع الراحلة فدوى سليمان، وسكت إسلاميون على مضض على اجتماعهما في النشيد والنشيج!
ومن الفروق أن عبد الباسط استشهد حقاً، وقد أُخرج من دياره بغير حق، وهو يرى الشهادة رأي العين، وأن صاحب الظل الطويل مات في سباق مع العرش، وتضمر أخبارٌ سبب موته، وهو السرعة وحرق المراحل حتى حرقوا البلد كلها حرقاً للمراحل. اُغفل سبب موت باسل. العقول التي أشرفت على إخراج مسرحية “الشهادة” طمست سبب الموت، لأنه سبب أقل شرفاً من الموت في الخندق كما ذكرنا، وقيل إنه كان ذاهباً لدورة رئاسية في ألمانيا، ليرث العرش الجمهوري، يتدرب فيها على حكمنا، وعلى حبسنا نصف قرن آخر، في بلاد الغرب الديمقراطية. وذكر لي عالم نازح أن الطائرة التي كان سيسافر بها، كانت مليئة بسبائك الذهب والتحف، وأخبار صحافية مسربة من أوروبا فضحت وقائع تزويجه من سيدة لاستحصال بقية حسابه البنكي في أوروبا، حسب الحيل القانونية التي تجيزها أوروبا، فخسر نصفها. وذكرت صحف أن ثروته كانت ثلاثة عشر ملياراً، وكانت الميزانية الوطنية السنوية ثلاثة مليارات لعشرين مليون فم سوري لا يفتح حتى عند طبيب الأسنان، والأسنان هي الأعمار.
ومن الفروق أن الساروت مات فقيراً، ليس له قبر، ألا قبر له بعد هذا التعب؟ مثواه وجدان شعبه، مات في المنفى، وهو عاشر عشرة مبشرين بالجنة، من شهداء أهل بيته، وكل شهيد مثواه الجنة، وإن الذين رثوه أو مدحوه أو بكوه لم يكن بهم طمع لجواز سفر أو كيس أسمنت أو رخصة سيارة أو مطعم.
ومن الفروق أننا بُكّينا المهندس المظلي وصاحب الظل الثقيل كرهاً، ودموع البصل غير دموع القلب، وعشنا أربعين يوماً مجبرين على الحزن، وكنا سعداء بموت الذي حبس الفارس عدنان قصار لأنه سبقه في سباق الفروسية، والذي حبس سائساً لأن جواده أصيب بالإسهال، كما سرّب لنا قريب للسائس.
بموت باسل توقفت الحياة في سوريا، فلا بيع ولا شراء، ولا أعراس ولا أفراح، وسكتت الإذاعة وخرست الدراما أربعين يوماً، وعشنا أربعين يوماً في البرزخ بين الحياة والموت، وباستشهاد الساروت عادت الحياة إلى الشعب السوري فهو عرس. الشهيد إنسان يتبرع بالدم لشعب كامل، كنا مصابين ولا نزال بفقر دم، ويفرِق الفقه بين شهيد الدنيا وشهيد الآخرة، وتفرّق علوم الدنيا بين شهيد السلطة وشهيد الكرامة. كان الملوك الفراعنة يصطحبون معهم في موتهم حاشيتهم، فيقتلونها حتى يصحبوا أرواحهم معهم إلى العالم السفلي، وقد قُتلنا قتلاً رمزياً أربعين يوماً، بل أربعين سنة في العالم السفلي.
ومن الفروق أن النشيد العراقي “جنّة جنّة” تحول إلى نشيد وطني جديد أو مثله، ولم يكن حي البياضة الأبيض الذي أتى منه الساروت جنّة، بل كان حياً عشوائياً، العروق الخضراء فيه قليلة، ويكاد يكون جحيماً، لكن جهنم بالعزّ أطيب منزل.
إن الذين كتبوا في رثاء الباسل الذي سُميتْ بإسمه نصف آثار سوريا ودوائرها الحكومية، وسميت بإسمه مساجد، ومطاعم، ونجتْ الملاهي من إسمه، كتبوها إما رياء أو نفاقاً أو إجباراً، أما نحن فكتبنا مراثينا حباً، فنحن عندما نرثيه نرثي الحرية ونرثي الوطن. وفرق كبير بين مراثي العبيد ومراثي الأحرار.
ومن فروق الرياضة، أن الفارسي الذهبي كان ينتزع الجائزة الذهبية بأفراسه الثمينة، في الوطن السوري، فلم يكن الفارس الذهبي يجرؤ على المنافسة خارج الوطن، وتروى قصص عن “سنيدة” كانوا يخيفون أفراس المنافسين الضيوف، وخرج لنا متحدث غير رسمي يسوغ استنكاف الفارسي الذهبي عن مباريات خارج الوطن لأن الأغرَّ وبقية خيوله الأصيلة تعتكر مزاجاً في السفر، وكان الفرسان العرب يأتون على خيولهم براً وبحراً وجواً، والفروسية من الأفراس، ومنها جاء وصف الفروسية والفراسة، نصفها للفارس ونصفها للفرس، وأن حارس المرمى فارس كامل ، نقتبس هذا التعريف لحارس المرمى من كتاب “كرة القدم في الشمس والظل”: هو البواب والشهيد. ومن الفوارق أن الساروت استشهد وهو يريد فتح طريق للعالم، وأن قتيلهم أغلق الطرق حياً وميت
المدن
في البحث عن سوريا اليوم/ عمر قدور
حدثان لا يوجد رابط مباشر بينهما أثارا خلافات من الطبيعة ذاتها بين السوريين مؤخراً، الأول وفاة المفكر طيب تيزيني قبل أقل من شهر، ثم استشهاد عبدالباسط الساروت. في الحالتين برزت أصوات من هنا أو هناك للنيل من الرجلين، وللتحريض على عدم الترحم عليهما، وكانت حاضرة تلك الأصوات التي ترحمت على تيزيني واعتبرت الساروت إرهابياً، مثلما حضرت الأصوات التي فعلت العكس.
ليست المسألة في حق كل منا في تقييم الشخصيات العامة سلباً أو إيجاباً، فالسوريون الآن غير مترفين على النحو الذي يسمح لهم بممارسة عمليات نقدية معمقة ومعرفية، وهم لا يفعلون ذلك حتى الآن. الأمر برمته هو أولاً وآخراً في السياسة، والخلاف سياسي ضمن ظرف عام يتراوح بين المقتلة والإبادة الجماعية وبين غموض مستقبل سوريا ككل. والخلاف ليس على هذه الشخصيات أو غيرها، هو يتحين مناسبة ليشهره أصحابه، كنوع من التأكيد على افتراق السوريين، والتأكيد على استحالة ردم الهوة بينهم.
بالطبع الحديث هنا ليس عن الهوة بين أنصار النظام ومن هم في الطرف المقابل؛ إنه عن أفرقاء تتراوح نظراتهم إلى أنفسهم بين من يريدون التغيير ضمن ضوابط يضعونها هم، وبين أنصار للثورة بلا تحفظ، أو مع بعض التحفظات. إلا أن الرغبة في التغيير، التي يُفترض بها أن تجمع هؤلاء، تتكشف في كل مناسبة عن أن العداء البيني من قبل البعض يفوق العداء المزعوم للأسد، ومن المستغرب أن تبادل النكايات لا يتوقف، بمعنى أن القطيعة بينهم لا تحدث على النحو الذي حدث بين شبيحة الأسد وأنصار الثورة. كأننا طوال الوقت أمام رابطة تحمل من الشد بقدر ما تحمل من النفور والكراهية، وكأن أطراف هذه الرابطة غير قادرين على فصمها، رغم كونه القرار الأكثر عقلانية من أجل التخلص مما تمثله من إعاقة ذهنية وحركية.
لن يصعب علينا ملاحظة الوظيفة التي تؤديها تلك الرابطة للمتخالفين الذين تضمهم، وهي وظيفة سياسية بقدر ما هي نفسية يمكن فهمها وفق علم نفس الجموع. مثلاً سيجد ذلك الداعية السلمي سلواه في فشل العسكرة والتهجم على مؤيديها، وهذا بالتأكيد أسهل من بذل جهد لا فقط من أجل العمل على ثورته السلمية الناصعة، وإنما أسهل أيضاً من العمل على أي بناء نظري وواقعي للثورة التي يريدها أو يشتهيها. قد يجد مؤيدون للعسكرة سلواهم بتسلط الإسلاميين عليها، وبتسلط الخارج على الصراع، ولوم الإسلاميين أسهل من التساؤل عن ديناميكيتهم وعدم القدرة على مجاراتهم. الإسلاميون بالطبع لا يقصّرون من ناحيتهم في لوم الباقين، وهذا أسهل من التوقف عند إخفاقاتهم الكثيرة السياسية والعسكرية، وأسهل من الاعتراف بأنهم أيضاً ليسوا كتلة واحدة، بل كتل متحاربة وإن اجتمعت نظرياً على كره من هم خارجهم. لا أسهل على الكردي من رمي كل المصائب التي ألمت بالأكراد على الثورة، بحيث أصبح قمع البعث والأسدية مجرد جنحة صغيرة بالمقارنة، مثلما لن يكون أسهل على العربي من اتهام الأكراد بخذلان الثورة وبكونهم من الأسباب الرئيسية في إفشالها، فلا الكردي مستعد لنقد تجربة الميليشيات الكردية ولا العربي مستعد للاعتراف بأخطاء ميليشيات عربية وللتمييز بين الميليشيات الكردية كسلطة أمر واقع والأكراد كمجموعة موجودة قبل تلك الميليشيات وستبقى بعد انقضاء دورها.
لا أمل بجمع هؤلاء المتخالفين، ربما هذا أول ما ينبغي الانطلاق منه، لأن العقلانية تقضي بعدم إنكار الواقع. العقلانية نفسها تقول أن إمكانية أي اجتماع سوري تنطلق أولاً من المتشابهين والمتفقين، هذا إذا كانت متوفرة. التشابه المقصود لا يعني نفي التمايز أو الاختلاف، وإنما يعني الاتفاق مسبقاً على الرحابة الفكرية والنفسية التي لا تعيق الاجتماع على قاعدة التباين. لماذا استحضار وفاة تيزيني واستشهاد الساروت في هذا السياق؟
إذا كان الاستهلال قد ذهب إلى أولئك الذين نالوا من الشخصيتين في مناسبة رحيلهما، تحت دوافع أيديولوجية وذرائع شتى، فما تجب ملاحظته وجود شريحة امتلكت الرحابة كي تثمّن ما هو وطني في سيرة الراحلين، وأفراد هذه الشريحة غير متطابقين فكرياً، ولا ينطلقون من موقع أيديولوجي واحد، ولا الموقف الإنساني هو وحده الدافع بل هناك ما يمكن اعتباره بحق موقفاً وطنياً وإنسانياً في الوقت نفسه.
كي لا نبقى في إطار التعميم، ضمن هذه الشريحة هناك علمانيون وهناك إسلاميون ومسيحيون، هناك عرب وهناك أكراد وتركمان وغيرهم، لتشمل أيضاً من لا يرى نفسه مصنَّفاً ضمن خانة قومية أو مذهبية أو أيديولوجية. بشيء من الأمل “أو بكثير منه”، قد يكون هؤلاء، فضلاً عن سوريين في الداخل منعهم القمع من التعبير على نحو مشابه، هم ما تبقى من سوريا اليوم، وربما يكونون أفضل من يستطيع النهوض بمشروع سوري يستأنف روح الثورة في إطارها الوطني والإنساني.
ما سبق لا يعني إقصاء آخرين، بل يستقيم الافتراض بدايةً أن الذين يمتلكون رحابة فكرية ونفسية قادرون على استيعاب المختلفين الغائبين. العبرة هي أولاً في القدرة على الانتظام ضمن مشروع وطني يقطع مع أخطاء المرحلة السابقة، وثانياً في القدرة على الاستمرار والمواظبة بالروحية ذاتها. من ثم فإن مصداقية أي مشروع تُكتسب عبر العمل والجهد، وهي التي تفرض على سوريين آخرين الارتقاء بخطاباتهم وجهودهم، وهي أيضاً التي تفرض نفسها على الخارج من أصدقاء وخصوم.
إذا استخدمنا المجاز، لا يجوز لحركة تغيير “مهما كان الاسم الذي نطلقه عليها” أن تتحول إلى بحيرة، ثم إلى مستنقع من الأسئلة والأجوبة المكرورة. وما لم تتم القطيعة مع ذلك العقم الفكري، الذي لا يكون تزامنه مع العجز مصادفة، سيكون من الصعب إعادة ذلك التيار إلى جريانه. إذا كانت الثورة هي قطيعة مع الماضي فإن فشلها، مع الرغبة في استئنافها، غير ممكنين إلا بالقطيعة مع أسباب الفشل الأول، وإذا اقترنت التجربة الأولى بأحلام جمع معظم السوريين فلعل واحداً من الدروس المستفادة أن جمع المتخالفين مستحيل قبل اجتماع المتشابهين.
المدن
حين يغدر الثوار بالثورة/ حسن النيفي
أصدرت جامعة حلب الحرة، الكائنة في مدينة اعزاز المتاخمة للحدود التركية، بتاريخ ( 11 – 6 – 2019 ) قراراً يقضي بفصل أحد كوادرها التدريسية، وهو الدكتور (محمد صابر العمر) المدرس في كلية التربية، وأرجعت جامعة حلب الحرة قرار الفصل إلى ( معلومات واردة إلى رئاسة الجامعة من بعض الطلاب، بقيام الدكتور محمد صابر العمر ….. بالإساءة إلى رمز من رموز الثورة السورية، عبد الباسط ساروت،تقبله الله). كما تضمن القرار إحالة الدكتور محمد إلى مجلس تأديب في الجامعة.
وعلى إثر صدور القرار المذكور، شاع مقطع صوتي نُسب إلى السيد محمد صابر العمر، وتداولته وسائل التواصل الاجتماعي، ينفي فيه نفياً مطلقاً علْمه بما حدث، كما ينفي صحة ما نُسب إليه من اتهام، ويعزو قرار فصله من الجامعة إلى أسباب كيدية أو خلافات شخصية مع بعض الأفراد.
قبل الانحياز إلى هذا الموقف أو ذاك، وقبل اللجوء إلى أي استنطاق لمجريات الحادثة وحيثياتها، يمكن التأكيد – ووفقاً لنص قرار الجامعة – أن إدارة الجامعة قد اتخذت قرار الفصل، بناء على ( ورود أنباء من بعض الطلاب)، وليس بناء على كلام مباشر ومسموع من الشخص المتهم، ثم إنها – إدارة الجامعة – قد أصدرت القرار قبل الاستفسار من المتهم ، واستيضاح ما إذا كان كلام ( بعض الطلاب) صحيحاً أم لا، بل صدر القرار بناء على الاستماع إلى طرف واحد، دون سماع الآخر، وهذه أول ثغرة قانونية أساسية، يمكن لها تقويض أركان الحكم الذي أصدرته الجامعة، علماً أن أكثر من عضو في الهيئة التدريسية، ومن زملاء الدكتور ( المُتهم)، قد أكدوا لوسائل الإعلام، أنهم حاولوا التأكد من صحة ما نُسب لزميلهم من خلال الحديث والتحرّي مع بقية الطلاب، فوجدوا أن لا صحة للاتهام ، ما يعني أن قرار الفصل كان جائراً بل باطلاً.
لستُ معنيّاً بالمعاينة القانونية لهذه الحادثة، ولستُ قاضياً ولا محامياً ولا صلة لي بعلم القانون، كما أنني لا أعرف السيد محمد صابر العمر، ولم أره في ما مضى مطلقاً، ولكن – يُخيّل إلي – أننا أمام حادثة تتجاوز في ماهيتها، وفحواها القيمي، التخوم الشخصية لحياة الناس، وتمتد لتطال المفاهيم والنواظم التي يدافع عنها السوريون، بل جميع أحرار العالم ، المدافعين عن كرامة الكائن البشري، وتحريم الظلم والامتهان، ذلك أن التهمة التي وُجهت للأستاذ الجامعي، هي ذات صلة وثيقة بالشأن السوري العام، وتتلخص بالإساءة الكلامية إلى الشهيد عبد الباسط ساروت، والشهيد الساروت إنما استمدّ هذه الحصانة التي يدافع عنها قرار الجامعة، من كونه رمزاً وطنياً للثوار السوريين، وليس من صفته الشخصية كمواطن سوري فقط، وهذا ما يجعلنا نميل إلى القول: إن القيمة الاعتبارية والرمزية للساروت إنما تستمدّ فحواها الجوهري من خلال امتثاله وتجسيده لقيم الثورة وتطلعات السوريين نحو الحرية والعدالة، وأعتقد أن الإجماع الشعبي الدافق نحو شخصية عبد الباسط، ما كان ليكون لولا بقاء الساروت – رحمه الله – مخلصاً لثوابت ثورة السوريين، بل الوجه الأكثر نقاء ونصاعة لانتفاضة الشعب السوري.
الحكم الذي أصدرته جامعة حلب الحرة بحق الدكتور محمد صابر العمر ، وبالإخراج الذي تم تداوله حتى الآن، تتناقض مضامينه وأهدافه تناقضاً مطلقاً مع القيم والثوابت التي نادى بها الساروت، واستشهد من أجلها، إذ إن اتهام المواطنين دون التحقق من الوقائع، وقذفهم بتهم الخيانة دون الاستناد إلى وقائع دامغة، يتطابق إلى حدّ بعيد مع ما كانت تلجأ إليه محاكم الأسد الميدانية والاستثنائية الأمنية حين كانت توجّه لمعارضي النظام الأسدي وخصومه إتهامات عائمة غائمة، ليست الغاية منها سوى النيل من الخصم، من مثل: ( إضعاف الشعور القومي – النيل من هيبة الدولة – إيقاع الوهن في نفسية الأمة إلخ)، بل إن قرار جامعة حلب الحرة يذكرنا بما قامت به الجهات الأمنية لنظام الأسد في أعقاب موت باسل الأسد شتاء 1994 ، حين قامت بحملة اعتقالات، طالت العشرات، وربما المئات من السوريين، وذلك تحت ذرائع مختلفة، فهي تارة بذريعة الشماتة بموت باسل الأسد، وتارة أخرى بذريعة عدم إظهار علائم الحزن، وما إلى ذلك من اتهامات، تفصح جميعها عن استمرار السلطة الأسدية في اختزال الوطنية السورية بأشخاص الحاكمين، وبالتالي تأليه الشخص، ليس بما يحمل من قيم تمثل السوريين، بل بما يحمله في شخصه.
لا شك أن المقارنة بين الحادثتين ليست منطقية، من جهة التناقض التام بين الثائر الشهيد عبد الباسط ساروت، وباسل الأسد الذي لم يكن سوى ( مشروع دكتاتور) آنذاك، إلّا أن المراد هو إبراز وجه التماثل في السلوك بين الجهات الأمنية الأسدية، والإجراء الذي اتخذته إدارة جامعة حلب الحرة.
إن الإخلاص للقيم التي تحملها وتجسّدها الرموز الوطنية، إنما يكون بالإخلاص والامتثال للتجسيدات الفعلية لهذه القيم، وليس للأشخاص بذواتهم، والدفاع الحقيقي عن المرحوم الساروت ينبغي أن يتجسّد بالدفاع عن حقوق الناس والحفاظ على كرامتهم بعيداً عن انتماءاتهم العرقية أو الدينية أو الإثنية، وكذلك بالانصياع للقانون والامتثال لقيم العدالة، وليس بالانقياد للدوافع الشخصية أو النزعات الثأرية، أو الاتهامات التي تفتقر إلى الأدلة والوقائع.
لقد جسّد استشهاد المرحوم عبد الباسط ساروت حالة من الإجماع الشعبي، تُبرِز بوضوح ناصع مدى تجذّر ثوابت وقيم الثورة في نفوس السوريين، بل أضحت هذه الحالة باعثاً على الامل لدى ثوار سورية نحو العودة إلى إحياء روح الثورة كما حملها الساروت وقبله أبو فرات وغياث مطر وعبد القادر صالح ورزان زيتونة ومي سكاف وفدوى سليمان والكثيرين غيرهم ممن لا يتسع المجال لذكر أسمائهم.
إن الدفاع عن هذه الرموز الوطنية والحرص على نصاعتها، إنما يتمثل بالدفاع عن القيم والثوابت التي استشهدوا من أجلها، أمّا التمجيد بهؤلاء الرموز من خلال تجريدهم من إرثهم القيمي الذي ناضلوا من أجله، فما هو إلّا سعي نحو التأليه المجاني الذي لا يتسق مع الحالة الإنسانية السوية للبشر، وبالتالي هو غدرٌ – بوعي أو بدون وعي – لجوهر ما نادت به الثورة السورية.
تلفزيون سوريا
بين الخطيب والساروت ثورة شعب/ محمد نور حمدان
بدأت الحكاية من أطفال درعا عندما كتبوا على الجدران مطالبين بإسقاط النظام ثم اشتعلت هذه الثورة عندما تسربت صور لذلك الطفل حمزة الخطيب الذي استشهد على يد جلاديه من النظام وآثار التعذيب الوحشي على كل جزء من أجزاء جسده فأصبح أيقونة للثورة التي امتدت روحها في نفوس الشباب الفطريين الذين اندفعوا رافضين للظلم والاستبداد دون أدلجة أو تحزب في معظم المدن السورية كان جسد حمزة الخطيب ملهما لكثير من الشباب للتحرك ضد الظلم والاستبداد الذي قام به النظام المجرم ولأن النظام لا يعرف إلا لغة الحديد والنار والبطش والاعتقال والتعذيب ولغ أكثر وأكثر في دماء الشباب الطاهرة البريئة التي خرجت سلمية ظناً منه أنه قادر على إخمادها بهذه اللغة ولم يدرك هذا النظام أن العنف لا يولد إلا العنف وأن الفعل لا بد فيه من ردات الفعل ثم تتابعت قوافل الشهداء لشباب وهم في مقتبل العمل يخرجون في المظاهرات السلمية مطالبين بالحرية وبدلا من أن يعودوا إلى منازلهم كانت تختطفهم طلقة قناص أو يد مجرمة أثيمة والأسماء أكثر من أن تعد وتحصى في كل مدينة سورية بل في كل في منطقة سورية تروي لنا حكاية شاب اعتقل أو استشهد أو حرة اغتصبت في المعتقلات وكان ذنبه الوحيد أنه نادى بإسقاط النظام ونادى بالحرية والكرامة .
هذه هي البداية ثم تسلحت الثورة للدفاع عن الأرض والأهل والعرض وبعد أن تحررت معظم أجزاء سورية قام النظام بلعبته الخبيثة واعتقد النظام أنه بتسليح الثورة سيصرف أنظار العالم عنها وسيبعد تعاطفهم معها وصور أن القضية في سوريا هي قضية حرب أهلية بين نظام وعصابات مسلحة خرجت عن الشرعية وقد استطاع النظام خلال السنوات الماضية صرف أنظار العالم عن قضية الشعب الثائر وحاول النظام أن يعيد شرعيته أمام المجتمع الدولي من خلال الترويج بأنه يحارب مجموعات إرهابية في سورية ثم عمل على تدويل القضية من خلال إبعاد الشعب السوري عن التفكير بالقضية وأن الموضوع أصبح دوليا ولا علاقة للشعب به فالشعب أصبح بين مهجر لاجئ يبحث عن حياة آمنة وخائف يترقب الموت في كل لحظة ويتمنى أن تعود سوريا كما كانت قبل عام 2011.
وبينما النظام ينفذ هذه اللعبة الخبيثة على حساب الشعب السوري المسكين الذي أصبح شعبا منقسما متفرقا ضائعا في بلاد اللجوء والمهجر والخيام جاء استشهاد الساروت
إن استشهاد الساروت أعاد بنا الذاكرة إلى تلك الأيام التي كانت تخرج فيه الجموع من الشباب تحت علم الثورة السورية هتافها واحد هدفها واحد وهو إسقاط النظام.
الساروت ذلك الشاب الذي رفض قمع النظام وظلمه وإجرامه وخرج مع الجموع الثائرة ليقودها بأغانيه وصوته العذب الذي دخلت بيت كل سوري.
جاء استشهاد الساروت ليذكر المجتمع الدولي أن ثورتنا ثورة خرجت ضد ظالم متجبر خرب البلاد وقتل العباد وليست حربا أهلية كما يصورها النظام.
جاء استشهاد الساروت ليذكر الشباب السوري والأجيال التي نشأت في ظل الثورة ولم تدرك بداياتها ماذا تعني الثورة ولماذا خرجت الشباب عام 2011 وواجهت الرصاص الحي بالهتافات السلمية.
إن أي ثورة في العالم لا تعيش بالشعارات والدعاوى الرنانة وإنما الثورة تحتاج تضحيات جسام وتتطلب بذل الدماء حتى تنتصر وهذه هي الثورة السورية بعد طول الطريق والسنوات التي مرت والتآمر الدولي على هذا الشعب المسكين تعود إلى الواجهة من جديد لتذكر العالم في الرسالة السامية والقيم التي قامت لأجلها الثورة ولتعلن أنها لن تموت حتى تحقق أهدافها في زوال النظام المجرم وأجهزته القمعية ومؤسساته الأمنية
وحتى تعيش الثورة وتستمر فهي بحاجة لأيقونات وقدوات صادقة تكون رمزا للأجيال القادمة وملهمة لها بالتحرك تلك الأجيال التي عاشت في بلاد الاغتراب والمخيمات وولدت في ظل الثورة والخراب الذي نشره النظام المجرم في جميع أجزاء سوريا.
إن الساروت يمثل كل شاب سوري أراد أن يعيش بكرامة وأراد أن يحيا في دولة عادلة بعيدة عن الظلم والطغيان فقدم روحه ودمه رخيصة من أجل بناء دولة العدل والحرية والكرامة كالكثير من الشباب الذين قدموا أرواحهم في بدايات الثورة وما زالوا يقدمونها في معركة الحرية والعدالة والكرامة
ستبقى ذكرى الساروت خالدة في وجدان وضمير كل شاب سوري عاش من أجل بناء دولة العدل والحرية والقضاء على نظام الطغيان والظلم والفساد
إن قصة الساروت هي قصة كل شاب سوري عاش من أجل أمته واستشهد من أجل أهله وبلده ففي كل بيت سوري عندنا قصة شبيهة بقصة الساروت والخطيب
من خلال الساروت والشباب الذين استشهدوا قي الثورة سنعلم الشباب والأجيال القادمة ماذا تعني الثورة وماذا تعني التضحية وماذا تعني الشهادة في سبيل الله.
تلفزيون سوريا
ماذا بعد الساروت: موت أم حياة؟/ محمد محمود
عادة ما يكون استشهاد الثوّار أو المعارضين، أو حتى المواطنين، دافعًا لإحياء الأوطان بعد موتها، وقد تجلى ذلك في الشهيد خالد سعيد أيقونة الثورة المصرية، ومن قبله البوعزيزي الذي قتلته نيران الظلم قبل أن تقتله نيران الحقيقة، يعيد التاريخ نفسه اليوم ليكتب فصلًا جديدًا مضيئًا عنوانه عبد الباسط الساروت.
يقول كارل ماركس: التاريخ يعيد نفسه مرتين، الأولى على شكل مأساة والثانية على شكل مهزلة. وهو ما نأمل ألا نراه يحدث في ملحمة الساروت. خاض عبد الباسط معركة الثورة بكل أطيافها وألوانها، انتشلته الثورة من حراسة المرمى إلى حراستها، قاد المتظاهرين في الميادين، ألهبت أغانيه حماسهم الوقّاد، حمل السلاح ليذود عن وطنه، قاتل ثم رحل، ثم عاد فقُتل.
كما تعلم، استشهد الساروت على أيدي جنود بشار الأسد، استشهد بعدما أزعجهم وقضّ مضاجعهم، ربما بموته سينامون مرتاحي البال، لكن الثوار لن يعرفوا النوم، وهو ما يدفعنا للتساؤل: هل سيغيّر رحيل الساروت من واقع الثورة السورية الأليم أم أن الوضع سيبقى على ما هو عليه؟!
إذا نظرنا إلى مشهد الثورة السورية سنجده مبعثر الأوراق، اختلف الثوار فيما بينهم فتعدّدت انتماءاتهم وتحطمت أحلامهم فوق صخرة العدو، فالعدو عدوان، تمرّ دمشق على الصراط، فتجد عن يمينها نار بشار وعلى يسارها نار داعش، بينما يساعدها على العبور ثائرون قد جعلوا الوطن غايتهم، ولكن الوطن ليس دائمًا بمستجيب.
من المؤكد أن استشهاد الساروت قد أزاح الغمامة عن أعين الذين يخافون مصير سوريا تحت قذائف الدبابات وأسلحة الكيماوي، وهي التي كانت تغرق في رائحة الورود التي طالما تغنى بها الشعراء، الآن تكتشف الثورة أن العدو قد يودي بحياة ملاكها الحارس، فهل سيدرك الثوّار خطورة ما ينتظرهم؟!
ليست دعوة للمزايدة وإنما للتفكير، فعادة ما تولد الخلافات صغيرة ثم تكبر، وهو ما عانته سوريا بين ثائريها، فهل سيتعلمون الدرس أم سيقعون في ذات الأخطاء؟ هل يكون عظم المصاب دافعًا للتوحد في مواجهة العدو أم لمزيد من الهزيمة؟ لا تموت الثورة برحيل مقاتليها لكنها تموت عندما تصل إلى المنتصف فلا تكمل الطريق، فأنصاف الثورات مقابر للثوار، واليوم نحن أمام سؤال: هل ستتم الثورة هلالها بدرًا كاملًا؟
هذا ما نتركه للثوّار وللأيام ليجيبونا عنه، ستدور رحى الزمن مرة أخرى، لكنها حتمًا لن تجود بساروت آخر، على روحه السلام، وعلى واقعنا -إن لم ينصر ثورته- السلام.
الترا صوت
الساروت في رحم الضمير الشعبي/ غطفان غنوم
لو كان الساروت نقيًّا كالماء في قعر المحيطات، لما أفادنا وأفاده ذلك في نظر خصومه من أعداء الحرية والمذعنين للاستبداد، وبشيء من التأمل والروية يمكن لأي عاقل التنبؤ بسلوك هؤلاء فيما لو لم يجدوا ما يمكن لهم أن يستندوا له في المحاججة والمخاصمة، فمثال الطفل الشهيد حمزة الخطيب ذي الثلاثة عشر عامًا لا يزال ماثلًا في ذاكرة كل سوري، ونتذكر مليًّا كيف أنكر رأس النظام السوري في مقابلة تلفزيونية سماعه بما حدث لحمزة من تنكيل وتعذيب، بل أنكر معرفته بالطفل أصلًا، ثم تضاربت الأقوال والروايات بعد أن عم الغضب الشارع السوري وندّد العالم بجريمة التمثيل بجثة الطفل البريء، فبات حمزة على لسان مؤيدي النظام السوري إرهابيًا مسلحًا يريد قتل جنود الجيش السوري، ثم تحوّل إلى طفل مغرر به ساقه المندسون مع أصحابه كأكباش فداء في معركتهم التخريبية، ولاحقًا استقروا على رواية مخزية مفادها أن الفتى الذي لم يبلغ بعد سن الرجولة، كان يقصد اغتصاب النسوة في مساكن الحرس، وأنه قتل نتيجة الاشتباكات.
لكن وعلى الرغم من استقبال رئيس النظام السوري لوالد الطفل لاحقًا وتقديم التعزية له، لم يشفع ذلك للثورة ولا للثوار ولا لحمزة نفسه في نظر محبي النظام، وهذا أمر اعتدنا عليه كسوريين اختبروا بطش نظامهم منذ قرون، فالرواية الرسمية تصدر عادة للخارج وللرأي العام، نمطية الطابع، متماشية مع الرغبة الغربية خاصة، والدولية عمومًا، بحيث توحي للعالم أن النظام نظام عقلاني، علماني التوجه. أما على صعيد آخر فالرواية الشعبية شيء آخر، يجب أن تحمل في طياتها طابعًا عنيفًا وقاسيًا ومخيفًا لكل مواطن تسول له نفسه بالتعبير عن رفضه لأي مظهر من مظاهر الاستبداد.
يعتمد النظام في تسويق كلتا الروايتين على عامل الزمن، فهو يعي تمامًا بأن الزمن كفيل بنسف أية وجهة نظر تغطي حدثًا جللًا إذا لم تدعم تلك النظرة بتأييد شعبي وعالمي وببراهين ثابتة، له في ذلك تجربة قديمة في الثمانينيات من القرن المنصرم بعد مجازر حماة الشهيرة.
في السياق العام لحياة الساروت الذي تحول إلى سردية تصلح أن تكون سردية الثورة بحق، بكل تضاريسها، وجد النظام ضالته المنشودة في خلفية الساروت العقائدية، كي يطلق ذبابه الإلكتروني ووحوشه حملة عنيفة لتحطيم رمزية البطل الشعبي الذي استطاع بخفة الروح الاستقرار في رحم الضمير الشعبي.
يجب ألا ينسى الجميع بأن “داعش” التي نفى الساروت لاحقًا باعتراف مسجل ومصور انتسابه لها، كانت تتحرك على مرأى ومسمع النظام السوري نفسه وبتسهيلات منه، متقافزة بين المحافظات السورية بسهولة، وبأن الطيران الحربي السوري والروسي الذي دكّ مدنًا سورية كاملة لم يحدث وأن ضرب ولا لمرة واحدة رتلًا واحدًا من أرتال التويوتا التي كانت تسرح وتمرح على الأوتوسترادات السورية في الداخل. لكن النظام يدرك بأن اتهمامه بالتواطؤ مع داعش سيخضع للتجاذبات ولعبة التجاذبات هي المستنقع الذي يعرف التحرك به تمامًا، ألم يقل في يوم ما وزير الخارجية وليد المعلم في تصريح له عن آلية النظام في التعاطي مع المحققين الدوليين بالمجازر التي ارتكبها نظامه: سنغرقهم بالتفاصيل!
وهذه الآلية أثبتت جدواها خلال السنوات الماضية، فهي تتيح لهم اكتساب الوقت الكافي لتشتيت صفوف الثورة، ولتبديد أي إجماع قد يحدث شعبيًا حول أية مستجدات، ولاحقًا لإخفاء مكامن الضعف.
تحضرني الآن حادثة جرت معي حين كنت طالبًا في كلية الإخراج السينمائية في جمهورية موالدافيا الشعبية التي استقلت عن الاتحاد السوفييتي السابق، بعد أحداث أيلول/سبتمبر بشهور، وما ترتب عليها من تداعيات خطيرة، أسفرت فيما أسفرت عن تعامل قاس مع الجاليات المسلمة في بعض الدول الأوروبية، فبينما كنت واقفًا بانتظار دوري أمام مكتب لتصريف النقود، اخترق الطابور مواطن يتحدث الروسية، ودفع بجلافة مقصودة شابًا أسمر تبدو عليه ملامح عربية واضحة قائلًا: ارجع لورا يا بن لادن!
انتابتني الحمية فتقدمت ثم قلت له: وأنا أيضًا بن لادن.
هل أجدني يومًا ما مضطرًا لتبرير كلمتي تلك فيما لو كانت محفوظة ومتداولة وأتاحت لي الظروف في سياق ما أن أبرز شعبيًّا؟
ما أريد قوله إن التعسف هو المحرك الأول للعنف، وأن التطرف هو المحرك الثاني، وأمام تعسف وتطرف كالذي شهده شخص فقد كل إخوته وكثيرًا من أهله ثم غنى للحرية ورددنا أغانيه، ينبغي لنا التأمل طويلًا، وعدم الغرق في التفاصيل، علها تكون ولادة جديدة من رحم هذا الضمير الشعبي الذي بثت به الحياة برحيل الساروت.
هنالك من يكتب عن الأبطال جيدًا، وهنالك من يصنع أفلاًما عن الأبطال وهنالك من يتقمص شخصياتهم ليمثل أدوارًا ناجحة، ولكن البطولة في جوهرها ليست متاحة للجميع!
الأبطال فقط من يصنعون البطولة.
الترا صوت
كيف نحكم على عبد الباسط الساروت؟/ فراس حمية
لو كنت في سوريا منذ عام 2011 وحتى الآن، في منطقة سيطرة نظام الأسد في سوريا، لكنت ربما أعلنت الولاء للنظام، ولو كنت في منطقة تقع تحت سيطرة داعش لأعلنت الولاء لداعش، ولو كنت في منطقة تخضع لجبهة النصرة لأعلنت الولاء للجبهة، ولو كنت في منطقة يسيطر عليها الجيش الحر لكنت أعلنت الولاء لهم.
ولو كنت في أي منطقة تخضع عسكريًا لحكم أي طرف من الأطراف المتحاربة في سوريا منذ بدءالحرب السورية، لكنت أعلنت الولاء للطرف الأقوى المسيطر على الأرض. هل كان بالإمكان فعل غير ذلك؟ هل كان بالإمكان لأي شخص أن يعارض القوى العسكرية وأن يقاوم فرديًا دون الرجوع إلى الطرف المسيطر؟
أما الاحتمال الثاني فهو الخروج من كامل الأراضي السورية والتغريد خارج السرب ومعارضة النظام والنصرة وداعش والجيش الحر إذا لزم الأمر، لكن حينها سوف يكون موقفي هامشيًا، إذ في النهاية تتحكم موازين القوى على الأرض، بما لا يعطي للفرد الثائر سوى خيارات محددة عليه أن يختيار من بينها.
لا يمكن للثائر أن يقوم بتفصيل فصيل ثوري حسب قياسه ومزاجه، فاللائحة لقوى الثورة الفاعلة أو للقوى المناوئة للثورة، تضم خليط من التناقضات والسلبيات والإيجابيات والخير والشر.
إذًا، على الثائر الاختيار، وفي اختياره يكمن نضاله ضمن الجماعة، فالحياد هو اختيار لا ثوري، إذ إنه خيار غير فاعل في مجريات الأحداث الثورية، ويعتبر بمثابة انسلاخ كليّ عما يجري في سوريا. الحياد ينهي رؤية الثائر للحياة المتخيلة التي يريدها وييضي على الأحلام الثورية لنظام الحكم المتخيل الذي يسعى الثائر لتشييده والعيش في كنفه.
فالثائر محكوم بالانتماء إلى فكر ونظرية، كما أنه محكوم بالانتماء إلى جماعة وسط دوي الرصاص ولهيب المعركة. فالحركة الثورية قلما يمكنها أن تؤتي ثمارها من خارج حدود الوطن، لأنها إما ستكون مرتهنة وإما مقاومة نظرية لا تستطيع التغيير الجذري كما في الحالة السورية، حيث يفرض الواقع العسكري شروطه على ما عداه.
ولا يجب أن ننسى أن محاكمة الثائر ضمن ثورة جذرية مسلحة متحولة إلى حرب أهلية، لا يستقيم مع الوضع الحاصل في سوريا، وذلك لأن الثائر يساوي صفرًا إن كانت ثورته منفردة ومن خارج الوطن، لأن القوى المتصارعة لا تقيم وزنًا للأفراد.
وكما يقول برتولت بريشت: “في أي صراع بين المؤسسة والفرد، مهما كان الفرد قويًا ومهما كانت المؤسسة ضعيفة، في النهاية ستنتصر المؤسسة”. فالساروت أو غير الساروت، لن يكون له أي فاعلية بمعزل عن الأحداث وبمعزل عن اتخاذ جانب ما من المتعاركين في الحرب السورية.
فالساروت اكتسب أيقنته من نضاله ومن موقعه الثوري، أي من خلال اختياره وقراره، ما ترتب عليه مسؤوليات والتزامات تجاه الثورة. الساروت هو الساروت، لأنه اختار الفعل والعمل ولم ينأ بنفسه، ولم يكن هناك خيارات متاحة غير الموجودة والمعروفة على الأرض بعدما تخلى العالم كله عن الثورة السورية. كان ثائرًا في معركة تائهة، وجد ضالته في التنقل بين فصيل وآخر إذ لا إمكانية لغير ذلك.
ويكتب ماهر أبو شقرا في تعليقه على مقتل الساروت والمحاكمات الأخلاقية التي طالته، قائلًا: “عفوية الثورات الشعبية ورومنسيتها شرط من شروطها. ولا يمكننا أن نطلب من الثوار أن يكونوا كالصراصير، ينغمسون في قذارة الواقع دون التلوث به. ولا أن يموت أهلهم وينكل بهم دون أن يتخذ الثوار مواقف متطرفة أو رجعية أو حاقدة. لا يمكن اشتراط العقلانية في الثورات. لو كان الواقع محتملًا، لو كان ثمة مكان بعد للعقلانية، لما اشتعلت الثورة”.
والواضح لي أن الرومانسية لم تكن من شخصية الساروت، أرى أنه كان أكثر واقعية من غيره. الظاهر أن الرومانسية إنما أتت من مؤيدي الثورة السورية، هؤلاء الذين يريدون الثورة طاهرة ونبيلة وخالية من كل دنس وبمعايير أخلاقية وإنسانية سامية.
هؤلاء هم الحالمون الذي يريدون للثورة أن تبقى فتية كما عهدوها في الأشهر الأولى، وكانوا يأملون لو أن نظام الأسد سقط بفعل ضغط المظاهرات السلمية، ويخشون الإقرار بأن الثورة لجأت إلى العنف الثوري المسلح، وبأن الثوار بشر يخطئون أحيانًا.
وقع مؤيدو الثورة في حيرة بين مناصرة الساروت أو مناصرة مفجري السارين بشعوبهم. لوهلة يبدو أنها قضية إشكالية، لكن الساروت نحّى الإشكاليات جانبًا متقدمًا على مؤيدي الثورة.
هؤلاء من ينكرون الواقع ولا قدرة لهم على مواجهة حجج الآخرين، ذلك أنهم يفتقرون إلى صفة مهمة كان يجب اكتسابها خلال مسار الثورة وفهمها وهي: “الوقاحة”. الوقاحة في عدم مهادنة الطاغية، وعدم الوقوف على الحياد، الوقاحة في اتخاذ الموقف الصريح، الوقاحة في رؤية الواقع القاسي كما هو، والاصطفاف مع كل من يمكن الاصطفاف معه لمحاربة النظام. الوقاحة لمعرفة أن الثورات ليست دائمًا نظيفة. الوقاحة في الدفاع عن الثورات وعن نجاحاتها وإخفاقاتها وأخطاءها ودنسها وشرفها. وأعتقد أن عبد الباسط الساروت وعى ذلك حين أدرك هامشية دوره منفردًا على الأرض السورية.
في الجهة المقابلة، أبدى مؤيدو نظام الأسد وقاحة في مواقفهم والدفاع عنها، فنادرًا ما نجد شخصًا من مؤيدي محور الممانعة خجولًا من أفعال هذا الفريق. هؤلاء يعيدون صياغة وتركيب المعايير الأخلاقية وفق أجندتهم، لأنهم يملكون من الوقاحة ما لا يملكه مؤيدو الثورة، وهذا ما أصاب مؤيدو الثورة في المنفى بضربات قاتلة بفعل التناقضات الحاصلة بينهم، واختلافهم المستمرة حول قضايا عديدة تصل أحيانًا حدود التراجع والخجل عن أفعال الثورة ومجرياتها.
إذًا، فالسؤال الذي يجب طرحه والتساؤل حوله، ليس حول كيفية أيقنة الساروت وجعله رمزًا للثورة في سوريا، بل السؤال الذي يجب طرحه هو: لو كان أي منا بدل الساروت، ما الذي كان سيفعله؟ ما الموقف الذي كان سيتخذه على ضوء المجريات على الأرض في سوريا؟ التنظير سهل، لكن الواقع مغاير تمامًا لمواقفنا التي نلتهي بإطلاقها عبر السوشيال ميديا وفي حياتنا اليومية الآمنة؛ فالحرب تفرض واقعها. والعمل الثوري يختلف كليًا فيما لو كان من داخل سوريا أو من خارجها.
الترا صوت
شيء من سوسيولوجيا الضمير الجمعي السوري (الساروت نموذجًا)/ طلال المصطفى
عندما فكرتُ في الكتابة عن الشهيد عبد الباسط الساروت، كشخصية جمعية سورية تتمثل الضمير الجمعي السوري وتمثله في الوقت نفسه، عادت ذاكرتي إلى عام 1994، أيام كنتُ طالب دراسات عليا في قسم علم الاجتماع في جامعة دمشق، وبالتحديد إلى يوم مقتل باسل الأسد الابن الأكبر للدكتاتور حافظ الأسد، في 21 كانون الثاني/ يناير 1994، في حادث سير على طريق مطار دمشق، فبعد أيام من مقتله، دخل الدكتور محمد صفوح الأخرس إلى القاعة التعليمية، وعلامات الحزن واضحة على وجهه، وبدأ الحديثَ عن شخصية باسل الأسد وعن التعبير الشعبي السوري عن حزنه لفقدانه، وكأنه لا يعرف أن ذلك التعبير كان بفعل أجهزة المخابرات السورية، ثم وجّه طلبًا صريحًا لمن يرغب منا -طلاب السنة الأولى ماستر- بكتابة رسالة ماستر عن شخصية باسل الأسد، كشخصية شابة جامعة للسوريين من منظور سوسيولوجي؛ ولكنه تفاجأ حين لم يبدِ أحد منا رغبة في ذلك، واستغرب حين لازم الصمت الجميع، ثم أكد لنا أنه سيشرف شخصيًا، بوصفه مستشارًا للدكتاتور الأسد، على تلك الرسالة، وأن كل شيء جاهز من مراجع وتقنيات، وما هي إلا أشهر قليلة ويحصل الطالب على الماستر، وأيضًا صمت الطلاب كافة، استمر في الحديث رافعًا نبرة صوته عاليًا ومفعّلًا لغة جسده، وبدأ يشير بيديه من قاعة كلية الآداب في المزة إلى الغرب، حيث قصر الدكتاتور، مؤكدًا أن من يقبل بالكتابة عن باسل الأسد سوف يصبح ذا شأن كبير في سورية، وبالتحديد في قصر الدكتاتور، واستمر الصمت يلازمنا، فما كان منه إلا أن خرج غاضبًا من القاعة يشتمنا ويشتم الجامعة التي سمحت لنا بالتسجيل في الدراسات العليا. بينما كانت السعادة واضحة وفاضحة على وجوهنا، حيث اكتشف كل واحد منا شخصية الآخر، ومواقفه التي لم نكن نجرؤ على البوح بها لبعضنا البعض، بسبب الهواجس الأمنية التي زرعها النظام بين الطلبة.
نعم، بعد خمسة وعشرين عامًا، وبعد أن أصبحتُ أستاذًا في قسم علم الاجتماع، تعود بي الذاكرة إلى موضوع الرمز والضمير الجمعي السوري، لأكتب عن الشخصية الجمعية الحقيقية التي عبّرت عن الضمير الجمعي السوري من منظور سوسيولوجي، عن الشهيد عبد الباسط الساروت.
أما مفهوم الضمير الجمعي سوسيولوجيا، فيمكن تحديده بتماثل أفراد المجتمع في بعض المعتقدات والرموز والعواطف العامة المشتركة بين معظم أفراد المجتمع، حيث يكتسب هذا الضمير واقعًا ملموسًا ومستمرًا في ثقافة أفراد المجتمع. من خلال التمثلات الاجتماعية والجماعية لشيء معين، التي تعطي صفة القداسة الدنيوية على الأشياء، وتفرضها كنسق من الطقوس على أفرادها، وهنا يُعدّ الضمير الجمعي الفاعل الوحيد في صياغة التمثلات الجمعية، كما هي ممارسة اجتماعية من طرف المجتمع كناظم لها.
حدد تشارلز كولي “الضمير الجمعي” بالعلاقات الحميمية التي تؤدي إلى ذوبان الفرد في الكل المشترك، مما يجعل ذات الفرد على الأقل، لأسباب عدة، جزءًا من حياة الجماعة، ويتم التعبير عن هذا التوحد بـ (النحن) التي تنطوي على التعاطف والانتماء المتبادل، حيث يعيش الفرد هنا في شعور الكل، ويجد الهدف الأساس لإرادته في هذا الشعور.
استنادًا إلى هذا المفهوم، نجد أمامنا الساروت، صاحب الشخصية الكاريزمية الشابة في مجال كرة القدم، حيث هو حارس نادي الكرامة ومنتخب سورية للشباب، والرياضة ميدان خصب لإظهار الذات والتمتع بالشهرة على المستوى المحلي والعالمي. فحين انطلقت الثورة السورية عام 2011 في حمص، ولم يكن عمره يتجاوز تسعة عشر عامًا، تخلى عن طموحاته الكروية التي كان يمكن أن تجعله شخصية عالمية، في مجال الأندية الرياضية العالمية وكسب الشهرة والمال، وأزاح كل هذه الطموحات الذاتية، بل إنه عدّها طموحات زائفة، أمام التحاقه بأهل حيه الشعبي في البياضة في حمص، وبالمتظاهرين، وقيادة التجمعات والتظاهرات بشعاراته الوطنية الجامعة للسوريين وأغانيه الشعبية السورية التي تعبّر عن وجع السوريين كافة.
أدرك الساروت، بوعيه العفوي الشعبي، منذ الأيام الأولى للثورة، أن عليه الاختيار بين الالتزام بالضمير الجمعي السوري، وبين الاحتفاظ بطموحاته الكروية وإظهار ذاته الشخصية ونجوميته الرياضية التي يحلم بها كل شاب بمقتبل العمر، فكان خياره الانتماء إلى الضمير الجمعي السوري بنوعيه التقليدي الآلي، والعضوي المعاصر، وقد تحدث عالم الاجتماع الفرنسي عن الضمير الجمعي الآلي السائد في المجتمعات التقليدية أي ما قبل مجتمعات الحداثة، ولمسنا ذلك في تمثله للقيم الريفية البدوية للشخصية العربية، في شهامته وشجاعته وعنفوانه في الاحتجاجات والتظاهرات في مدينة حمص، وكذلك الأمر في تدينه الشعبي المتسامح مع الآخر، الرافض للظلم والعدوان، والرافض للمذهبية والطائفية والتطرف، وهذا ما لمسناه في أغانيه الشعبية وعباراته الدينية التي تنم عن إيمان عميق بالحق، وقد عبّر عن ضمير السوري للجيل السابق، عندما غنى لمدينة حماة، وطلب منها السماح لعدم وقوف السوري إلى جانبها، عندما تعرضت للإبادة الوحشية من قبل الأسد الأب عام 1982، وعبّر عن الضمير الجمعي العضوي الذي تحدث عنه دوركايم في المجتمعات المعاصرة، من خلال القانون ومنظمات المجتمع المدني، فكان صوته عاليًا يطالب بالحرية والكرامة والعدالة لسورية، وهي مفاهيم تعبّر عن الضمير الجمعي المعاصر للسوري. وهي تدل في الوقت نفسه على رفضه التمثلات الجمعية التي تتعارض مع ثورة الحرية والكرامة، التمثلات التي عمل على إنتاجها نظام الاستبداد الأسدي طوال خمسين عامًا، بل عمل على تكوين تمثلات اجتماعية سورية جديدة ذات طابع احتجاجي تجاه أوضاع لم تعد مقبولة اجتماعيًا، أي لم تعد تستجيب لأهداف الثورة السورية، ويمكن ملامسة ذلك في مسيرته الثورية النضالية، خلال سنوات الثورة الثمانية الأخيرة ضد الاستبداد الأسدي.
هكذا كان الساروت يعبّر عن الضمير الجمعي السوري، في التظاهرات والغناء من أجل الحرية والكرامة، ملتزمًا بهويته الإسلامية من دون أن يمارس المذهبية والطائفية تجاه الآخرين، وملتزمًا بهويته السورية الجامعة لكل السوريين، فغنى لكل المدن السورية، وأحبّها مثل حبّه مدينته حمص، وعندما اضطرت الثورة إلى حمل السلاح في وجه ميليشيات الأسد، حمل السلاح وبوصلة سلاحه كانت باتجاه المعتدين على الشعب السوري فقط، رافضًا الاقتتال الداخلي، حتى في استشهاده كان شهيد الضمير الجمعي السوري، نال الشهادة في ريف حماة وإدلب وليس في حمص، وشارك السوريون كافة في جنازته، وتكفينا قراءة سريعة لما تضمنته وسائل التواصل الاجتماعي في الحديث عنه، حيث نعاه وبكاه السوريون من المدن والبلدات السورية كافة، السياسي، المثقف، الفنان، الأستاذ والطالب، الإنسان العادي، المتدين، غير المتدين، أصحاب الأيديولوجيات الفكرية والسياسية المتنوعة، الأطفال والشباب، الرجال والنساء… الخ، في سورية وخارجها. وهكذا بعد أن عبّر الشهيد الساروت في سلوكه الثوري اليومي عن الضمير الجمعي السوري، انتقل ليصبح الشخصية الجمعية السورية، كناية عن الضمير الجمعي السوري، وقد تجلت في مقاومته للاستبداد الأسدي وللاحتلال الروسي والإيراني، في عنفوانه وشموخه قبل استشهاده بساعات قليلة، من خلال قسمه على المقاومة والتشبث بالأرض السورية، سورية الحرية والكرامة.
لقد حدد عالم الاجتماع الفرنسي دوركايم أخلاقية الفعل الإنساني بقوله: “إن الشخص لا يسلك سلوكًا أخلاقيًا، إلا حين يستهدف غايات تسمو على الغايات الشخصية، وحين يتفانى من أجل ما هو أرفع منه ومن كل الأفراد، وبالتالي لن نجد كائنًا معنويًا يسمو على الأفراد كافة”، ويمكن ملاحظة ذلك في سورية الحرية والكرامة، التي استُشهد الساروت من أجلها. إنه الفعل الإنساني الأخلاقي بامتياز.
أخيرًا، كما رفضت مع زملائي أن نكتب عن القتلة والمجرمين في سورية، عندما كنّا طلابًا، نؤكد أننا -كأساتذة- سنطلب من طلابنا في سورية الجديدة أن يكتبوا الأبحاث والأطاريح العلمية عن الثورة السورية ورموزها المعبّرين عن الضمير الجمعي السوري.
جيرون




