الجيش السوري: في أصل الشحاطة/ المؤجِّلون الأحرار
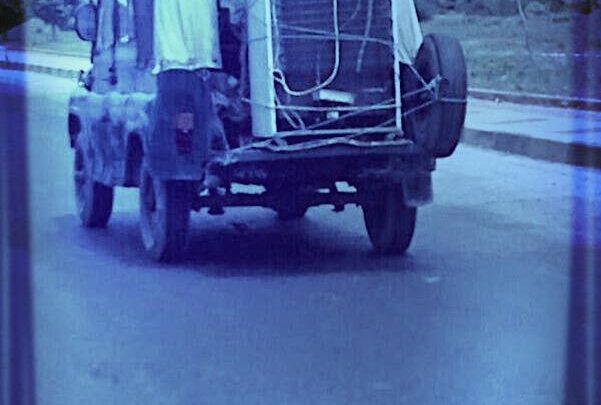
نحن مجموعة من الشبان السوريين، أسعفنا الحظ بأن كانت خدمتنا الإلزامية مؤجلة لأسباب دراسية عند قيام الثورة السورية، فنجونا من موت محقق، أو من أشياء أخرى قد تكون أسوأ من الموت. واليوم، اجتمعنا في عيد الجيش السوري، كي نشكر قيادته الحكيمة على إتاحتها فرصة تأجيل الخدمة بغرض الدراسة، وكي نوجه لها تحيةً على طريقتنا، تحيةً لرمزيتها التي اقترنت قبل الثورة بالرثاثة والهزائم واللصوصية، واقترنت بعدها بالتجويع والمذابح والنهب المعمم.
*****
تقول الأسطورة إن تسمية جيش أبو شحاطة تعود إلى الرتب التي يضعها الملازمون الطلاب في الكلية الحربية عند تخرجهم، فتلك الرتب التي تشبه فعلاً نعل الحذاء، أو نعل الشحاطة كما اتفق السوريون، صارت شعار هذا الجيش الذي كان رائداً على المستوى العربي في مجال الانقلاب على الديموقراطية الناشئة في بلاد كانت قد استقلت عن الاستعمار حديثاً. لقد كان هذا الجيش وكراً للدسائس والانقلابات منذ الاستقلال، وراح يقع تحت هيمنة الضباط البعثيين منذ انقلاب عام 1963، ويصبح أداتهم الضاربة في عملية الاستئثار بالسلطة، حتى أتى حافظ الأسد وقضى على هيبته وسطوته لصالح الأجهزة الأمنية. هذا الجيش، الذي كان مصطفى طلاس وزير دفاعه لأكثر من ثلاثين عاماً، يشبه كثيراً بدلة طلاس العسكرية «المبهبطة» المثقلة بالنياشين المضحكة، وقد كان، كما طلاس أيضاً، الأداة المطواعة طوال خمسين عاماً لتنفيذ حكم الإعدام بالسوريين أفراداً وجماعات. في هذا النص سنحاول أن نرصد جوانب من سيرة هذا الجيش في عيد تأسيسه، وجوانب من سيرة «الشحاطة» أيضاً، إذا أمكن القول.
ولكن ما الذي يعنيه السوريون حقاً عندما يقولون إن فلان يخدم في جيش أبو شحاطة، أو إن فلان ضابطٌ في جيش أبو شحاطة؟ المقصود هنا هو فِرق الجيش النظامي العادية، أي أن ما يخرج عن وصف أبو شحاطة هو الأجهزة الأمنية بأنواعها، وفِرق وقطاعات الجيش ذات الطبيعة الأمنية أو التدريب الخاص، مثل القوات الخاصة والفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد والحرس الجمهوري، كما يخرج الضباط الكبار عن وصف أبو شحاطة غالباً، مثل قادة الفرق ونوابهم أو مدراء الإدارات المهمة في الجيش مثل إدارة الحرب الكيميائية مثلاً؛ أما سوى ذلك، فكلّه أبو شحاطة، تقريباً.
جيش أبو شحاطة مؤلفٌ إذن من الجنود والضباط قليلي السلطة والهيبة، الذين تنحصر سطوتهم داخل قطعات الجيش فقط، والذين لم يكونوا يثيرون ذعر المدنيين في أيام السلم، بل يقعون مع المدنيين ضحية الذعر الذي تثيره الأجهزة الأمنية وبقية قطاعات الجيش غير الشحاطية. وغالباً ما يكون هؤلاء متواضعي التدريب والتسليح، ومواردهم المالية محدودة، لكن سيرة البلاد خلال خمسين عاماً أو يزيد، تقول إن تشكيلاتهم جاهزةٌ في كل وقت لتنفيذ كل المهمات التي تطلبها الأجهزة الأمنية، بما فيها أشد المهمات انحطاطاً ووحشية، على ما يُظهر مثال الوجود السوري في لبنان، ومثال مذبحة حماة، ومجريات سنوات الثورة السورية.
ويحتاج تحديد المراحل التي مرّ فيها الجيش السوري حتى وصل إلى هذا الدرك إلى بحث تاريخي معمق، لكن المؤكد أن هذا التحول مرّ بمراحل رئيسية، أبرزها مرحلة الستينات التي تم فيها تسريح مئات الضباط وصف الضباط تعسفياً بسبب الشك في مدى ولائهم لحزب البعث، ثم جاءت المرحلة الأسدية التي تم فيها فرز العناصر والضباط الأكثر ولاءً وتجميعهم في أجهزة وقطعات متنوعة، لا تُعرف تراتبيةٌ أو هيكليةٌ واضحة لها، لكنها تتنافس في ما بينها على السلطة ومصادر الثروة، وميدانُ تنافسها الأبرز هو مدى الولاء للقيادة.
ولأن من تقاليد الأسدية الراسخة خلق الأشباح وترك كل شيء غامضاً صعباً على الفهم، فإن وصف أبو شحاطة يبقى رغم كل ما سبق عابراً لكل قطعات الجيش وكل الأجهزة الأمنية، إذ يحصل أن يتمتع ضابطٌ في جيش أبو شحاطة بسطوة مخيفة بسبب علاقاته الشخصية أو العائلية مع ضباط نافذين في جهاز أمني ما، ويحصل أن يكون عنصر أو ضابط في جهاز أمني مخيف مثل المخابرات الجوية أبو شحاطياً، إذا كان المقصود بهذه العبارة قلّة الهيبة وضعف السطوة. لا شيء يمكن أن يكون مفهوماً أو متوقعاً بالحد الأدنى في عوالم السلطة الأسدية، والرتبة التي يحملها ضابطٌ قد لا تعني شيئاً في أوقات كثيرة؛ قد يرتعد ضابط برتبة عميد في الجيش أمام مساعد في فرع الأمن العسكري.
شعبة التجنيد
شعبة التجنيد هي القاسم المشترك الأكبر بين ذكور سوريا، أو ربما المضاعف المشترك الأصغر… ما علينا؛ على كل شباب سوريا أن يذهبوا إلى شعبة التجنيد التي يتبعون لها ما أن يتموا سن الثامنة عشرة، وذلك لاستخراج دفتر بغيض يُسمّى دفتر الجيش، يتم تدوين سيرتهم العسكرية فيه؛ من ليس لديهم أخوة ذكور عليهم أن يأتوا بوثيقة تثبت ذلك، ثم أن يكرروا الأمر كل سنة حتى تتجاوز أمهاتهم سن الخمسين؛ المرضى عليهم أن يأتوا بوثائق تثبت أمراضهم كي تتم إحالتهم إلى اللجان الطبية العسكرية لبيان ما إذا كانت أمراضهم تلك تستدعي الإعفاء من خدمة العلم، أو تحويلها إلى خدمة ثابتة إدارية لا تدريبات قتالية فيها؛ أما الباقون فعليهم أن يأتوا بوثائق دراسية كي يتم تأجيل خدمتهم، أو أن يستعدوا للالتحاق بالخدمة الإلزامية في موعد السحب القادم.
ومواعيد السحب هي مواقيت ثابتة في السنة، يتم إلحاق المجندين إلزامياً فيها بقطعات الجيش، وغالباً ما يكون في كل سنة موعدان للسحب، أحدهما يكون مخصصاً لغير المتعلمين، والآخر مخصصاً للمتعلمين الحاصلين على شهادة التعليم الأساسي وما فوق، وهو ما يُطلق عليه اسم “سحب المثقفين”. وليس ثمة قواعد معلنة للفرز، الذي يفترض أن يكون عشوائياً، باستثناء ما تفرضه مستويات التعليم والإعداد المهني المتنوعة، من قبيل أن الجامعيين الذين درسوا في كليات تزيد مدتها عن أربع سنوات سيكونون ضباطاً حتماً. لكن هناك قواعد أخرى غير معلنة وغير مضبوطة تماماً، ذلك أن التوازنات والحسابات الطائفية تدخل بوضوح في هذا الأمر، إذ يكثر أن يتم فرز المجندين العلويين إلى الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة، وبدرجة أقل إلى القوات الخاصة، ثم بدرجة أقل وأقل إلى بقية قطعات الجيش. غالباً، سيكون فرز الشبان العلويين من عمر الثامنة عشرة، الذين تبدو عليهم ملامح القوة الجسدية، إلى الحرس الجمهوري.
لكن هل يعني هذا أن هؤلاء ليسوا أبو شحاطة؟ ليس بالضرورة، فالغالب أن جميع من يؤدون الخدمة الإلزامية مشمولون بتصنيف أبو شحاطة بغض النظر عن مكان وجودهم، أما من يُحتمل أنهم سينجون من وضعية أبو شحاطة، فهم من يطلق عليهم اسم المتطوعين، أي من اختاروا الحياة العسكرية مهنةً لهم، الذين ينضمون إلى قطاعات الجيش والأجهزة الأمنية عندما تعلن عن حاجتها لمتطوعين، ويتم توزيع المقبولين منهم وفقاً لتعليمهم وقدراتهم البدنية ومنابتهم الطائفية والمناطقية والطبقية، ووفقاً للواسطة والدعم الذي يحصلون عليه من محاسيب أو أقارب أو أصدقاء.
طاحونة الحرس
يبدو الاسم أعلاه شاعرياً إلى حد بعيد، لكنه في الواقع اسمٌ لسجن رهيب في قلب دمشق، ملاصق لبناء الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، قرب الدوار المعروف بدوار الجمارك في البرامكة، كان تابعاً للحرس الجمهوري، ومخصصاً لسجن عناصر الحرس الجمهوري الذين يرتكبون مخالفات للنظام العسكري، ذلك حتى بداية الثورة على الأقل، ولا نعرف إذا كان هناك تغيرات قد طرأت على مهمته تلك بعدها.
في بداية الخدمة الإلزامية، هناك ما يعرف بدورات الأغرار، التي تشغل الأشهر الأولى من الخدمة، ويتم تدريب المجندين خلالها بدنياً وعسكرياً. وأقسى دورات الأغرار على الإطلاق، هي تلك التي يخوضها المجندون في الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة والقوات الخاصة. والغالب أن نزلاء طاحونة الحرس يكونون من المجندين الذين لا يصمدون في دورات الأغرار تلك، فيتملّصون من التدريب أو يهربون من الخدمة.
يروي أحد أصدقائنا بعض الوقائع التي قادته إلى ذلك السجن الرهيب عام 2002، يقول إنه لظروف اقتصادية وعائلية لم يتمكن من متابعة دراسته بعد الشهادة الثانوية، لكنه لم يكن يريد الذهاب إلى الخدمة الإلزامية، فحاول التخفي طويلاً في قريته في ريف جبلة، إلى أن تم إلقاء القبض عليه من قبل الشرطة العسكرية. ولأنه كان ضخم الجثة قوي البنية، ومن ريف جبلة، تم فرزه إلى الحرس الجمهوري. كانت دورة الأغرار التي خاضها في معسكر قرب جديدة عرطوز بريف دمشق، ولأنه كان عنيد الطباع ومشاكساً، تعرض لعقوبات قاسية من بينها عقوبة كان يطلق عليها الضابط المسؤول اسم «كيف تشرق الشمس في عرطوز»، ومضمون العقوبة أن يقف المجند الليلَ كله عارياً في برد كانون القارس، حتى تطلع الشمس.
بعد أن شاهد صاحبنا شروق الشمس في عرطوز، أُصيب بنزلة صدرية كادت تودي بحياته، ورفض الضابط إعطاءه إجازة طبية، فهرب إلى قريته وقضى فيها شهرين فاراً، إلى أن تم إلقاء القبض عليه مجدداً أثناء نزوله إلى مدينة جبلة. تم تحويله إلى طاحونة الحرس شهراً كاملاً، قضى معظمه في زنزانة انفرادية مظلمة، وعاد بعدها لمتابعة خدمته كسيرَ النفس، ووحشاً مستعداً للقتل في الوقت نفسه؛ يقول: «في أحد الأيام كانت مياه الأمطار تتسرب إلى الزنزانة حتى بلغ ارتفاعها شبراً، كنتُ أشعر أنني سأموت من البرد والرطوبة، وبعد قليل قام أحد الحراس بإدخال الطعام لي، كان صحناً من الحساء، تم وضعه على صفحة الماء ودفعه باتجاهي، بحيث طفا نحوي على وجه الماء القذر الذي اختلط بالحساء».
لا نستفيض في تفصيل هذه الواقعة بسبب مأساويتها فقط، فهي على مأساويتها تبدو نزهة بالمقارنة مع سجون ومعتقلات النظام اليوم، لكن هذه الحادثة تشرح الكثير عن جيش أبو شحاطة وكيفية عمله، وتشرح كيف أن وجود المرء في الحرس الجمهوري قد يجعله مخيفاً في عيون المدنيين والمجندين في أماكن أخرى أقلّ شأناً، لكنه لا يعفيه من أن يكون أبو شحاطياً، والأهم، أن طاحونة الحرس مثالٌ صغيرٌ على كيفية قيام النظام بطحن الجيش، وكيفية استخدام الجيش لطحن المجتمع، وكيفية تحويل البلاد كلها إلى طاحونة تدور لتهرس أعمار وكرامات وآمال أبنائها.
ثمة قصة أخرى تستحق أن تُروى هنا، هي قصة سمعناها من أبو هيثم، الذي كان حلّاقاً في حارة من حارات سوريا، ذلك قبل الثورة وقبل أن يهدم النظام تلك الحارة. كان أبو هيثم يروى لنا، نحن زبائنه، وقائع دورة الأغرار التي خضع لها، والتي استمرت ستة أشهر. يقول إنه تمّ فرزه إلى القوات الخاصة، واضطر لخوض «كل دورات الجيش السوري التدريبية». وتلك الدورات هي بمجملها عبارةٌ عن تدريبات وحشية للمجندين الجدد ضمن الخدمة الإلزامية، لنزع الإنسانية منهم، مثل دورة الصاعقة ودورة التعايش مع الطبيعة، ودورات أخرى كنا نسمع بها عندما كنا فتياناً، فتتقاسم مع الأفرع الأمنية مهمة بثّ الرعب في نفوسنا، إذ كانت تبدو نوعاً من التعذيب المستمر.
في ختام دورة القوات الخاصة، جرى إنزال أبي هيثم وزملائه من طائرة مروحية داخل حلقة واسعة تم إشعال النار في أطرافها، يقف في وسطها أكثر من مساعد أول بالكرابيج، التي تنهال على كل من يصل إلى الأرض. تستمر حلقة التعذيب تلك لساعات، والعساكر يتكدسون فوق بعضهم بعضاً ويتلقون كرابيج المساعدين، كنا نضحك وهو يروي القصة كأنها طرفة مضحكة، إلا أنه في إحدى المرات صمت عندما انتهى من روايته، واقترب من البكاء.
عرفنا عندها أنها ليست واحدة من «سوالف» الحلّاقين كما كنا نعتقد، كان ذاك الشاب يتحدث عن تجربته في أكل لحوم الحيوانات الحية كالأفاعي والأرانب خلال تعذيبه في دورة «التعايش مع الطبيعة»، يروي تلك الوقائع بالتفصيل، بعيون مفتوحة ضيقة الحدقات مثل عيون المصابين بالذهان.
تلك الحكاية هي تلخيصٌ بليغٌ لهذا المزيج الغريب من الرثاثة والوحشية عند جيش الأسد، فهو بلا قيمة في بلدٍ تحكمه الأجهزة الأمنية، إلا أنه في الوقت ذاته مصنعٌ للتوحش، كان اسمه يعني بالنسبة لشباب سوريا الخضوع للتعذيب طوال سنتين من أعمارهم، من دون سبب واضح؛ في الحقيقة كان هناك سبب، كان ذلك الوسيلة الأنسب لتعليم الشباب السوريين معنى أن تعيش في «سوريا الأسد».
كانت الإهانات والمعاملة المذلة التي يتعرض لها المجندون في دورات الأغرار تحمل اسماً معروفاً، «كسر النفسية»، وهو اسمٌ يشير بوضوح إلى أنها ممنهجة ومخططة وواضحة الهدف، الذي هو تحطيم كل شعور بالاعتزاز والاعتداد بالنفس عند ذكور سوريا المنكوبين بجيشهم. ويقتضي الحديث عن «كسر النفسية» عودة ضرورية إلى «سحب المثقفين»، إذ تتحدث المرويات الشفهية السورية عن إذلال متعمد للمتعلمين، على وجه الخصوص حملة الشهادات العلمية العليا والأطباء، الذين تقول المرويات إنه كان يتم تخصيص أكثر الضباط كرهاً للمتعلمين للإشراف على تدريبهم، الذي يأتي مشفوعاً بكمية من الإهانات غير المبررة، ومنها النزول في «الجاموقة». والجاموقة هي حفرة ممتلئة بالمياه الآسنة القذرة والفضلات، سبق أن نزل فيها بدون سبب واضح أغلب عناصر الجيش السوري خلال فترات تدريبهم، كعقوبة على أشياء لا حصر لها. وتصلح الجاموقة شعاراً للجيش السوري ربما أكثر من الشحاطة، إذ أنالجيش الذي تمت «جومقته» بشكل حثيث طوال سنوات، كان يتدرب في الواقع على «جومقة» البلاد كلها.
ومن أبرز علائم كراهية مؤسسة الجيش لـ«المثقفين»، أن كلمة «أستاذ» تُعتبر إهانة بالغة في الجيش، وكثيراً ما تمت معاقبة مجندين حديثي الدخول إلى الخدمة العسكرية بالنزول في الجاموقة، لأنهم أخطأوا فاستخدموا كلمة أستاذ عند حديثهم مع أحد قادتهم. كلمة «أستاذ» تعني في الحياة العسكرية السورية «حمار»، ولا تُستخدم مطلقاً إلا بقصد الإهانة.
التعفيش بوصفه عقيدة قتالية
نستطيع أن نتابع منشورات إدارة التوجيه السياسي في الجيش كي نعرف عقيدته القتالية النظرية، أما العقيدة القتالية العملية فهي الدفاع عن نظام الأسد، وأشياء أخرى متنوعة يصعب حصرها، من بينها التعفيش على ما تشرح سنوات الثورة السورية وسنوات العيث فساداً في لبنان.
وإذا كان التعفيش كما نعرفه هو الاستيلاء على ممتلكات المدنيين في المناطق التي يدخلها الجيش، إلا أن للتعفيش وجوهاً وجذوراً أخرى، لا تقتصر على نهب الممتلكات في زمن الحرب. التعفيش عقيدة راسخة في الجيش السوري، بمعنى أن الحياة العسكرية فيه تقوم على الاستيلاء على كل ما يستطيع المرء الاستيلاء عليه، بصرف النظر عن أي قانون أو مبدأ. وليس المقصود هنا هو الفساد فقط، بمعنى استيلاء الضباط على مخصصات الجند من الأطعمة وعلى مخصصات الآليات من المحروقات، وغير ذلك، بل أيضاً بمعنى أن هذا الاستيلاء يصبح منطقاً يومياً، وهو ما تتضمنه العبارة السورية الشهيرة: «عسكري… دبّر راسك»، بمعنى أن للعسكري أن يؤمن احتياجاته بأي طريقة ممكنة، بل إن عليه أن يفعل ذلك كي ينجو بنفسه.
في نهاية الخدمة الإلزامية، على المجند أن يسلّم كل شيء استلمه أصولاً، بما في ذلك البطانيات وفرش النوم والألبسة العسكرية، وإذا كان هناك ما هو مفقود أو تالف، فيجب دفع غرامة عنه، تبلغ أضعاف أضعاف سعره الحقيقي في السوق. «عسكري… دبّر راسك» تعني هنا بالضبط أن تسرق أغراض زملائك كي تسلّمها بدل أغراضك التالفة أو المفقودة، أو أن تدفع رشوة لموظفي الاستلام كي يتغاضوا عنك، وهذا سلوك عادي يمكن أن يقوم به أي عسكري.
هذا مثال بسيطٌ فقط، ذلك أن ما يتم تدريب الجنود عليه بعد «كسر نفسيتهم»، هو عقيدة الاستباحة؛ كل شيءٌ مباحٌ باستثناء عدم الولاء للقيادة، وكلُّ شيء هنا تعني حرفياً كلَّ شيء. وفي قلب التعفيش كعقيدة قتالية للجيش العربي السوري، يحضر «التفييش»، المصطلح الذي يعني في العلوم العسكرية الأسدية أن يؤدي المجند معظم خدمته الإلزامية في بيته، مقابل مبالغ مالية متفاوتة يدفعها كرشوة.
يدفع العسكري «المفيَّش» ما يشبه معاشاً شهرياً للضابط المسؤول عنه، مقابل أن يأتي يوماً واحداً في الشهر إلى القطعة العسكرية التي يخدم فيها، أو أن لا يأتي أبداً. يعرف جميع السوريين بوجود هذا الأمر، ولا يحتج عليه العسكريون الذين لا تسعفهم علاقاتهم وأوضاعهم الاقتصادية بتفييش أنفسهم، بل يتقبلونه بوصفه من طبائع الأشياء، أو بوصفه تفاوتاً طبيعياً بين البشر، لا معنى للاحتجاج عليه. ولأن دوام الحال من المحال، يحصل أن يدفع بعض المفيشين ثمن تفييشهم غالياً، عندما تغضب القيادة على الضابط الذي فيّشهم، فيشملهم الانتقام المريع الذي يأتي غالباً بصيغة «مكافحة الفساد».
كسر النفسية، وعقيدة الاستباحة، ومعهما معاشات متواضعة للعسكريين «المحترفين»، ومعاشات مثيرة للسخرية للعسكريين في الخدمة الإلزامية، بالكاد تتجاوز ما يعادل 15 دولاراً في الشهر؛ تتضافر كل هذه العوامل لتخلق ما يشبه مؤسسة رسمية لتنظيم عمل مجموعات من اللصوص وقطاع الطرق، أول ضحاياها هم أعضاؤها الذين يرفضون أن يصيروا لصوصاً، أولئك النبلاء الذين يقضون خدمتهم الإلزامية كلها، أو يقضون عمرهم كله في الجيش، دون أن تموت ضمائرهم، ودون أن يتبلد الإحساس بالشرف والكرامة لديهم، فيبذلون جهداً هائلاً لاجتياز خدمتهم الإلزامية بأقل الخسائر النفسية والضميرية الممكنة، أو يعيشون حياتهم الوظيفية العسكرية في مفاصل ومواقع هامشية، لا يفعلون شيئاً فيها سوى انتظار سن التقاعد الذي سيحمل الخلاص لهم من كل هذا الخراب العميم.
وبالعودة إلى «كسر النفسية»، ثمة معلومة يعرفها «علماء النفس» في إدارة التوجيه السياسي في الجيش العربي السوري، وهي أن كسر النفسية يكون أجدى كل ما كان الإنسان أصغر سناً، ولعل هذا ما دعاهم إلى ابتكار معسكرات التدريب الجامعي، ذلك أن بقاء المرء حتى سن الخامسة والعشرين بدون كسر نفسية عسكري، يفتح الباب على احتمال نجاته تماماً من سياسات كسر النفسية المتوافرة بسخاء في الحياة المدنية أيضاً، الأمر الذي قد يشكل خطراً على استقرار الدولة وسلامة التراب الوطني.
معسكرات التدريب الجامعي
يقع مقر مكتب التدريب الجامعي التابع للجيش في شارع الضباب في حي كفرسوسة الدمشقي، وشارع الضباب المشهور هذا هو الشارع الذي يضم عدة فروع أمنية اشتهرت بكونها الأكثر إجراماً قبل الثورة وبعدها، مثل فرعي المنطقة و215 التابعين للأمن العسكري. إلا أن مكتب التدريب الجامعي يمكن أن يكون الاستثناء الوحيد في هذا الشارع المخيف، إذ لا يشعر المرء عند دخول باب البناء بأي رهبة من جنود الحراسة، الذين لا يسألون بدورهم عن أي شيء. عند دخول البناء، قد تدخل غرفة عميد أو مقدّم بالخطأ، لن يعاتبك أحد، فالأمر أشبه بمراجعة دائرة نفوس من الطراز القديم، وعند الانتهاء من أوراقك التي تثبت خضوعك لمعسكرات التدريب الجامعي المطلوبة، ستنتابك الحيرة من هذا المكان وموقعه في شارع الضباب ذاك.
في الحقيقة، إذا كان جيش النظام هو جيش أبو شحاطة، فإن ضباط التدريب الجامعي هم أبو شحاطة «حاف»، لأن إدارة التدريب الجامعي هي المكان الذي يتم تجميد الضباط فيه، ليصبحوا عملياً من دون مستقبل أو أمل بالترفيع، ما يعني أن سطوتهم وهيبتهم بالحدود الدنيا. إلا أن هذا لا يعني أن الأيام التي سنقضيها في المعسكر الجامعي ستكون نزهةً، فتلك الأيام أُعدّت أصلاً لتكون «بروفا» على الأيام السوداء التي تنتظر الطلاب في الخدمة الإلزامية بعد تخرجهم.
تبدأ حفلة الدخول إلى المعسكر بحلاقة شعر الطلاب الذين وصلوا المعسكر بشعر أو لحية طويلة، إلا أن يوم الالتحاق يكون عادياً بالمجمل، إلى أن تأتي الساعة الخامسة والنصف صباحاً من اليوم التالي، حيث ستسمع الضابط المناوب يقول بشكل متكرر: «اغسل وجهك… إحلق ذقنك… وانضمّ للصف الصباحي». والصف الصباحي هو الطوابير المنتظمة التي ينبغي الوقوف فيها من أجل التفقد وتدريبات النظام المنضمّ، ويبعد عن الخيام التي ينام فيها الطلاب مشياً حوالي خمس عشرة دقيقة، بينما سيكون لديهم عشر دقائق فقط للالتحاق به. خلال ذهابنا إليه، كنا نعيد كلام الضابط بسخرية، «احلق ذقنك… اغسل وجهك»؛ نعم، يمكن أن نسخر من الضباط دون خوف، لكن هذا لا ينبغي أن يُفهم على أنه دعوة مفتوحة للسخرية؛ في الحقيقة لا يمكنك السخرية من كل شيء هناك، إذ تم اعتقال طالبين في صباح أحد أيام التدريب الجامعي لأنهما رفضا ترديد شعار حزب البعث.
في معسكر الضمير للتدريب الجامعي، كان يمكن للطلاب أن يموتوا بقرصات العقارب المنتشرة هناك، بينما كان معسكر الديماس الأقرب إلى دمشق أفضل نوعاً ما، إلا أنك في الحالتين يمكن أن تموت من الملل خلال الدروس المكررة التي تشرح علوماً عسكرية قديمة للغاية، تتخللها قصص الضباط المملة عن عجائب الحياة في الجيش، أو قصص أسطورية عن عبقرية القائد الخالد في حرب تشرين، أو قصص عن نظام الترفيعات في الجيش، الذي قاد هؤلاء الضباط إلى التجمّد عند رتبة مقدّم، التي سيتقاعد معظمهم فيها.
كان هؤلاء الضباط أشبه بموظفي دائرة النفوس القديمة التي ذكرناها سابقاً، كل شيء ممل حولهم، إلا أن ذلك لا يعني أنهم لا يملكون سلطة علينا، نحن طلاب الجامعة المجبرون على حضور هذا المعسكر باعتباره أحد المواد المرسبّة. وعدا عن هذه الأجواء المملة، فإن خلاصة هذه المعسكرات هي كسر رأس طالب الجامعة بشكل مبكر، وتعليمه قواعد الحياة الأساسية في بلاد يحكمها الأسد، وعلى وجه الخصوص تقديس القائد الأسد وتحقير كل ما عداه بما في ذلك أنفسهم، ذلك حتى عندما كان النظام متيقناً من نفوذه التام على البلاد قبل الثورة، فأصغر كلمة تعني تحويل الطالب فوراً إلى الأمن السياسي الذي يتبع له فرع خاص بالطلاب.
كانت معسكرات التدريب الجامعي أكثر قسوة وطولاً وجديّة في الثمانينات والتسعينات، وراح عددها يتناقص وأيامها تقلّ وقسوتها تتراجع بعد وصول الأسد الصغير إلى السلطة، حتى باتت أضحوكة مثيرة للسخرية، مع احتفاظها بدورها الفعال في الإعداد العقائدي لحياة «عسكري… دبر راسك»، وللقبول بفكرة النزول في الجاموقة. سيتمّ لاحقاً إلغاء هذه المعسكرات وتحويلها إلى دوامٍ إداري إضافي للطلاب في كلياتهم، يخضعون فيه للتدريب العسكري، ليكون هذا فرصةً لتعرّضهم للإهانات العلنية أمام الجميع، ولا نعرف إذا كان هذا أفضل لهم فعلاً.
عن إخوتنا الذين في الجيش
لم تكن الحياة العسكرية في سوريا بؤساً كاملاً شاملاً على كل حال، إذ لا شك أن أغلب الذين أدّوا الخدمة الإلزامية قد تعرّفوا إلى بعضٍ من أقرب أصدقاء عمرهم فيها، ولا شك أنَّ فيها لحظات كثيرة من المرح والمغامرة المسلية، خاصة لحظات اقتراب التسريح من الخدمة، ولحظات التسريح نفسها، التي يصفها كثيرون كما لو أنها لحظات الولادة الثانية لهم. لكن كل هذا قد انتهى مع اختيار النظام للحرب الشاملة استراتيجية وحيدة للتعامل مع الاحتجاجات الشعبية، وتحوّل الجيش إلى ثقب أسود يبتلع أعمار شباب سوريا، كما ابتلع «الأخد عسكر» العثماني أعمار أجدادهم قبل قرن من الزمن.
وقد شاعت في الأشهر الأولى التي أعقبت تسلّح الثورة ثم عسكرتها عبارةٌ تقول: «من هو العسكري في الجيش، أليس أخي وأخاك؟»، وكانت تُستخدم في الرد على دعاة عسكرة الثورة والمتحمسين لها، للقول إن قتلى الجيش هم أهلنا، وإنه لا ينبغي توجيه السلاح إلى صدورهم.
في الواقع، إن هذه العبارة على بساطتها بالغة التعقيد، فهي تبدو صحيحة وخاطئة في الوقت نفسه، ويأتي تعقيدها من حقيقة أن الجيش السوري ليس مؤسسة وطنية بأي حال، لكنه في الوقت نفسه يضمّ خليطاً من كل أبناء البلاد، وكان كل ذَكَر سوريٍّ معرضاً لأن يكون عنصراً فيه عند قيام الثورة، وبعد قيامها اتسعت الدائرة لتشمل كل من يمكن أن يتم استدعاؤهم للخدمة الاحتياطية. وفي الواقع، ليس الجيش هو من اتخذ قرار الحرب ضد الثائرين على نظام الحكم، ليس جيش أبو شحاطة على الأقلّ، فجيش أبو شحاطة لا يملك من أمره شيئاً، وهو أداة في يد الأجهزة الأمنية التي تعمل في خدمة العائلة الحاكمة ومحاسيبها.
وليس صحيحاً القول إن جميع جنود وضباط الجيش كان لديهم خيار ترك القتال والانشقاق، هذا غير صحيح قطعاً، فهناك الآلاف ممن ليس لديهم هذا الخيار، إلا إذا كان الاختيار بين الموت الفوري أو الموت المؤجل اختياراً فعلاً. لقد فارق الآلاف من عناصر جيش الأسد حياتهم في حرب لم يقرروها ولا ناقة لهم فيها ولا جمل، ولا معنى للتلطي خلف افتراضات وأقوال أخرى، ولهذا فإن لنا إخوة في الجيش دون شك، لكن إخوتنا هؤلاء يشكلون مفاصل متناهية الصغر، في آلة جهنمية تدمر البلاد من أقصاها إلى أقصاها، وتقتل السوريين سحقاً تحت ركام بيوتهم.
تقتضي الأمانة القول إذن إن في صفوف الجيش كثيرين ليسوا إلا ضحايا في الواقع، على وجه الخصوص من أولئك الذين سيقوا رغم أنوفهم إلى الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية، ويقتضي الإنصاف أن نتمنى الرحمة لأرواح من قتلوا منهم والخلاص لمن لا يزالون على قيد الحياة؛ لكن مؤسسة الجيش السوري كانت طوال تاريخ البلاد مفرخة للمؤامرات والانقلابات والمذابح الدموية، ومنبعاً للرثاثة والهزائم واللصوصية، ثم انتهت لأن تكون خادماً مطيعاً عند الأسد وأجهزته الأمنية، وبعدها جيشاً ممزقاً انشق عنه آلاف الضباط والجنود، وتحوَّلَ الباقون فيه إلى قطعات تقاتل تحت إمرة الروس والإيرانيين ووكلائهم المحليين، وترتكب المذابح المتتالية بحق السوريين من شرق البلاد إلى غربها، وبمختلف صنوف الأسلحة التي يسمح بها العالم، التي لم ينقص منها سوى الأسلحة الذرية.
واليوم، في الأول من آب الذي يصادف عيد الجيش السوري، وإذ يحاول الروس استعادة بعض من هيبة هذا الجيش، لا يسعنا إلا أن نقول لهم إن مهمتكم تلك ستفشل حتماً، ذلك أن شيئاً في الدنيا لن ينفع في القيام بهذه المهمة، لا الانتصارات العسكرية التافهة على أبناء البلد فقط، والتي ما كانت لتحدث لولا الإرادة الدولية، ولا مشاريع إعادة الهيكلة وإحداث مزيد من الفيالق والفِرق. لقد ضاعت آخر بقايا هيبة الجيش السوري منذ عاد عناصره من لبنان في إجازاتهم محملين بالمسروقات، وبات بالنسبة لقطاعات واسعة من السوريين جيشاً معادياً منذ رفع شعارات «الأسد أو نحرق البلد» و«الجوع أو الركوع»، وبانتظار أن يتم تفكيك هذا الجيش عن آخره، فليس أمامنا إلا أن نسميه جيش الهزائم والعار والمذبحة.
موقع الجمهورية




