المدينة العربية والحداثة: من التقليد إلى التحديث/ عاطف عطيّه
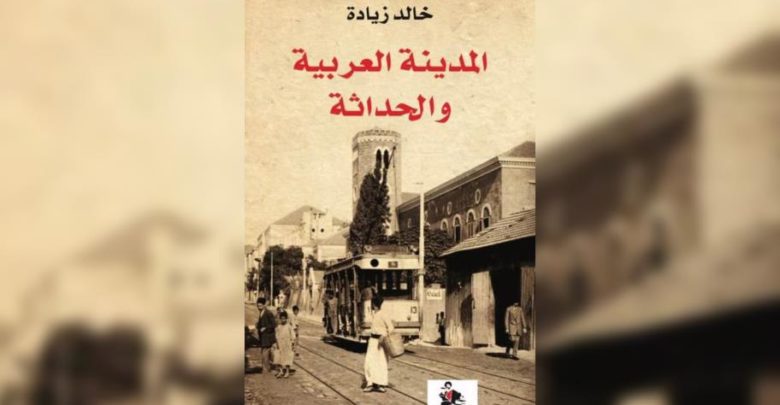
يقدم لنا خالد زيادة في كتابه “المدينة العربية والحداثة” بحثاً مستفيضاً حول المدينة العربية والمسلمة، مصطلحاً وتعريفاً ونشأة وميزات. وهو بذلك يؤصل الأسس المبنية عليها المدينة العربية والمسلمة ليعطيها النمط المختص بها، وما يميزها عن المدينة الغربية التي كانت المعيار الذي اتخذه المؤرخون الغربيون في نظرتهم إلى المدينة العربية والمسلمة ليبرهنوا على أنها لم تصل إلى ما وصل إليه الغرب في بنائهم لمدنهم، وهي بالتالي لا وجهة لها، ولا هوية، ولا تنظيم يحددها ويحدد مزاياها، وكأنها العماء المطلق.
يبني زيادة في مستهل بحثه ما يحدد المدينة المسلمة، على الصعد اللغوية والتاريخية والفقهية، وإن كان جلّ ما وصل إليه هؤلاء هو الوصف الذي يقدمه رحالة أو زائر عبّر عن دهشته مما شاهده من روعة البناء وضخامته، ووسع المساحة التي تحتلها المدينة، وصولاً إلى ما هو أعمق في النظر إليها، إن كان على مستوى فطرة الإنسان على الاجتماع، وطلب الكمال، من خلال استجلاب كل ما يمكن أن يوصل إلى ذلك، بإجادة الصنائع والفنون وتنوّعها، وهو ما لا يتحصل إلا في المدينة؛ أو من خلال النظر الفلسفي للمدينة التي لا تعمُر إلا بالتعاون والعدالة، لتصل إلى ما يمكن ان يجعلها مدينة فاضلة. أما من الناحية الفقهية التي جاءت هنا أكثر واقعية في نظرتها إلى المدينة، فقد حدّدتها بشروط واضحة لتتسمى بهذا الاسم، منها طلب السكون والاستقرار، وحفظ الأموال، وصون العائلة، والحصول على الحاجات على اختلافها، وإتاحة العمل من أجل التكسب. أما ما يمكن أن يقدّمه القيمون على شؤون المدينة فهو ما يحقق مطالبهم الدينية والدنيوية، في ما يؤدي إلى الاستقرار وسعة العيش. أما نظرة ابن خلدون إلى المدينة، فهي أنها ذلك التجمع الكبير الذي يأخذه الحاكم مقراً له، فيزيد ذلك من عمرانها، ويؤهلها لتكون المدينة التي تجمع كل المواصفات التي تؤمّن الاستقرار والرفاه لساكنيها، ومنشأ الصنائع والفنون، ومركز التبادل التجاري، وموئل الفقه والأدب، ومجال اختطاط الشوارع والحارات، والتميز في الأبنية والقصور الدالّة على السعة في العيش والغنى.
كل هذه المواصفات لم تكن أكثر من تحديد ميزة المدينة عن غيرها من التجمعات الريفية، باعتبارها إلتقاء فطرة الناس ومصالحهم في الاجتماع، مع ما يعطيه من أسباب الحياة التي تنتقل بالاستمرار الملازم للعيش من الضروري إلى الكمالي، حتى يصير الكمالي ضرورياً ليحلّ مكانه كمالي أرقى.. وهكذا.
المدينة الإسلامية والعربية
من المهم في هذا الكلام الذي يعطي للمدينة العربية ميزاتها المخصوصة المختلفة عن المدينة الغربية، ما يقوله زيادة في هذا الصدد. إذ هؤلاء لم يلحظوا في كتاباتهم، حتى الفقهية منها، أن المدينة التي يقصدون هي مدينة إسلامية أو اجتماع اسلامي، أو مدينة مسلمة. توصيف المدينة أو تعريفها، أو إبراز مقوماتها ما هي حسب هؤلاء، وحتى الفقيه الماوردي منهم، إلا مدينةٌ إنسانية عليها أن تؤمّن لساكنيها الظروف المناسبة للحياة، ويأتي الدين والممارسة الدينية وأماكنها، بعد ذلك، باعتبارها تحصيلَ حاصل. يقول ذلك خالد زيادة، ليصل إلى أن مصطلح المدينة الاسلامية ما هو إلا من صنع المستشرقين، ليقوموا، من بعد، بالمقارنة بين هذه المدينة الثابتة في مواصفاتها، حسب تقديرهم، والمدينةِ الغربية، النموذج والمعيار. ويخلص زيادة إلى القول في هذه المسألة أن الفارق أساسي بين نظرة المستشرق غارديه ونظرة الفقيه الماوردي. فالأخير تحدث عن شروط اكتمال المدينة، بينما الأول تكلم على مجال مديني واحد متكرّر لا يحول ولا يزول.
من البديهي أن يكون لكل مدينة مهما كانت هويتها، ظروفُها الخاصة التي استدعت تأسيسها وتنظيمها حسب الموقع المورفولوجي وتوفّر المياه، وقربِها أو بُعدها عن مدن أخرى أو تجمعات سكنية. كما من البديهي أن تنظّم وفق تطلعات ساكنيها وعلاقاتهم فيما بينهم، وبالبيئة التي تشكل مساحة مدينتهم. من هنا جاء التنظيم وشكلُ الحكم وعناصره مبنيةً على هذه الظروف، وأدّت إلى مسيرة مدينية هنا، تختلف عن مسيرة مدينية هناك، أو هنالك، بصرف النظر عن هوية الحاكم، أو نوعية الوجهاء والأعيان، أو الانتماء الديني لهؤلاء أو لعامة الناس، وحتى لكيفية النظر إلى المدينة، إما باعتبارها عالماً قائماً بذاته، أو تابعة لعالم أوسع وأكثر أهمية، وأبرز حكماً وغنى. هنا جاءت ملاحظة مستشرق مغاير عندما تساءل: المشكلة هي في “فهم أي نوع من النظام كان ينظم حياة السكان” (لابيدوس، زيادة ص34). وهنا يركز زيادة، باستحضاره ما ذكره لابيدوس، بأن نشأة المدينة المسلمة أو العربية كان يقوم على تعاون بين الفئات المتقدمة فيها، إن كانوا من العسكر، أو العلماء، أو الأعيان، وعادة ما يكون العسكر هم الذين يتسلمون زمام الأمور في الحكم، بالتعاون إما مع الأعيان أو العلماء من خلال نفوذهم أولاً، ومن خلال صلتهم المباشرة مع عامة الناس، من أجل إضفاء المزيد من الاستقرار والسكينة اللتين تريحان أهل السلطة.
في هذه المناسبة، رأيت من الأنسب إبراز نمط الحكم المملوكي، في القاهرة على الخصوص، كمثال، إذ أمسك المماليك بالسلطة السياسية والحكم، وأقصوا ما يمكن أن ينافسهم فيهما، من العرب على الخصوص، من خلال إطلاق أيديهم في كل ما له علاقة بالدين والشريعة، إن كان في تسلم وإدارة الأوقاف أو المعاهد الدينية، أو في إطلاق يد المذاهب الأربعة في التشريع. والخلاصة إطلاق أيدي العرب في كل ما له علاقة في شؤون المجتمع، وترك الأمور السياسية وشؤون الحكم إلى أهلها، وهم هنا المماليك غير العرب بالطبع.
هنا أيضاً، يستنتج زيادة ملاحظة في غاية الأهمية مستخلصة مما قاله لابيدوس في هذا الصدد، وهي “أن المماليك لم يحكموا سوى مناطق ناطقة بالعربية، في مصر وبر الشام. وفي تلك المرحلة نما شعور مبكّر لدى العلماء بالعروبة التي أصبحت منذ ذلك الوقت هوية المدن، مثل القاهرة ودمشق وحلب، والدليل على وحدتها”، (ص39). وهذا ما افتقده العرب إبان الحكم
العثماني الذي جعل أمور الدين والدنيا في حوزته، وما كان على العرب إلى أن يسيروا في ركابه، وإن شعر العلماء العرب بفقد منزلتهم ومشاركتهم شؤون الحكم أو أن يكونوا صلة الوصل بين السلطة والعامة. لذلك وعى العلماء العرب موقعهم في التنظيم العثماني، فعملوا على التمسك بعروبة المدينة، في أي مكان من بلاد العرب. ويستخرج زيادة، هنا أيضاً، ملاحظة لامعة تقول “بأن عروبة القرن التاسع عشر لم تأت من فراغ وإنما بُنيت على هذا التراث الذي جمعه العلماء (العرب) في العصر المملوكي (غير العربي)” (ص43).
المدينة العثمانية
إذا كانت المدينة المملوكية قائمة على التنسيق بين السلطة الحاكمة والعلماء، جاءت المدينة العثمانية لتستبدل العلماء بالطوائف الحرفية؛ وهي ملاحظة قدمها مستشرقان توجها أيضاً وجهة مخالفة للمستشرقين النمطيين. وقررا، حسب عرض زيادة، هذه المقولة المهمة: “إذا كان الدين هو البنيان الاسلامي، فإن الطوائف كانت الأحجار التي بني منها”. مشايخ الحرف كانوا صلة الوصل بين العامة والحكام. والمدينة حارات مضبوطة من هؤلاء، ومجموعها يشكل المدينة العثمانية، عربية كانت أو غيرها ضمن السلطنة، أو حتى ربما في بلاد البلقان.
في علاقة الحكم العثماني مع المدينة، كان الدين هو الوسيلة لإضفاء الشرعية السياسية، عندما يكون السلطان في حاجة ماسة إليه باعتباره آلية الطاعة. في هذا المجال حوّل السلطان العثماني محمد الفاتح مدينة القسطنطينية التي أسماها اسطنبول، مدينة معولمة في مقاييس ذلك الزمان، إذ جعلها مدينة مفتوحة لكل الناس على اختلاف أديانهم وإثنياتهم، مع كل التسهيلات اللازمة لسكناهم وتأمين مستلزمات العمل والعيش. فتحولت المدينة بذلك، وبسرعة قصوى، من عاصمة كبرى للدولة البيزنطية، إلى عاصمة عليها أن تكون أكبر للسلطنة العثمانية. ومن أجل هذا الانفتاح، كان عليه أن يضفي الشرعية على مدينة مسلمة ليتم تنظيمها على هذا الأساس. ولأن الضرورة تقضي بإعمارها بالسرعة الممكنة، كان عليه أن يفعل ذلك، وما على الخليفة، الموروث من عهد المماليك، إلا أن يضفي الشرعية على هذا القرار، بإصدار الفتوى اللازمة، وعند إصدارها، انتفت الحاجة إليه فأُهمل.
هنا يمكن القول إن المدينة هي التي تنتج ظروفها وعلاقاتها ومميزاتها، وإن اشتركت جميعها في الانتماء إلى الإسلام أو إلى أي دين آخر. ومن المفارقة، في هذا المجال، على ما يقول زيادة، أن على شيخ الاسلام الذي ورث موقع الخليفة، أن يكون في خدمة السلطة السياسية، ولكن في الوقت نفسه، لا يمكن لخليفة أن يحل مكان خليفة، لأي سبب كان، إلا إذا صدرت الفتوى الشرعية بذلك من شيخ الاسلام نفسه. وإصدار الفتوى شأن ديني يبقى في خدمة السياسة، ولأن السلطان الجديد، مهما كانت الوسيلة التي توسّلها للحصول على أعلى منصب في الدولة، فلا بد إلا أن يكون في موقع القوة لاستصدار مثل هذه الفتوى، ولا بد لشيخ الاسلام إلا أن يجاريه في ذلك.
يقدم لنا خالد زيادة تفصيلاً مهماً عن مسرى الحياة في أهم المدن العثمانية والعربية، من اسطنبول وأزمير وسالونيكي إلى حلب والاسكندرية وبيروت والقاهرة وبغداد وغيرها. وكان لكل من هذه المدن مسرى حياة خاص بها تحت إدارة ولاة السلطنة، مع كل ما يمكن أن تستوعبه من تغيرات، إن كان على الصعيد الديموغرافي الديني أو الإثني، برعاية سياسة
الانفتاح على الملل والنحل لدى الدولة، بالاضافة إلى العمل على تحديث هذه المدن بما تجود به ذهنية الولاة التي لم تكن بعيدة عن رياح التغيير القادمة من أوروبا، وخصوصاً منذ بداية القرن التاسع عشر في مصر أولاً، ومن ثم في بقية المدن، من بيروت إلى حلب ودمشق والاسكندرية وبغداد، وغيرها..
حظيت القاهرة وبيروت بتفصيل أكثر من بقية المدن العثمانية منذ دخول عناصر التحديث إلى القاهرة إبان الحملة الفرنسية على مصر، واحتلال القاهرة؛ وهي العناصر التي حولت المدينة إلى غير ما كانت عليه، بموجب السياسة الإنمائية الفرنسية المختلفة كل الاختلاف عن طريقة اختطاط المدينة وتنظيمها والاهتمام بنظافتها وتوسيع شوارعها. وهذا ما أثار إعجاب المصريين، وخوفهم في الوقت نفسه؛ وهذا هو بطبيعة الحال شعور الأهالي دائماً تجاه المحتلين الغرباء والمستعمرين الجدد.
جاءت التنظيمات العثمانية قبل منتصف القرن التاسع عشر وبعد نصفه لتغير الدولة سياستها وخصوصاً تجاه الطوائف غير المسلمة، وكان ذلك بمثابة الاستجابة لما يريده الغرب من سياسة السلطنة، دون الأخذ بالاعتبار ما يشكّل ذهنية المسلمين الإيمانية بأن لا أديان أو طوائف تضاهي الاسلام والمسلمين في عقر دارهم. كان ذلك سبباً للتململ، أولاً مما حصل عليه المسيحيون واليهود من امتيازات ومن تقدم ساهمت في إشعال الفتنة بين المسلمين وغيرهم من المسيحيين واليهود في أكثر من مدينة في السلطنة، على ما يلحظه زيادة في أكثر من مكان من الكتاب. إلا أن ذلك لم يقتصر على التقدم الإداري فقط، بل طال أيضاً بنية المدينة ونمط حياة الناس وكيفية ممارستهم لحياتهم اليومية.
إن أهم ما يظهر من نمط الحكم العثماني بروز سلطة الولاة في دولة تحكم مساحة مترامية الأطراف، حيث من الصعب تنظيمها وحكمها بنظام مركزي. فكان الولاة، على ما يقول زيادة، على قدر قوة سلطتهم، يتحكمون بالولايات ويستمدون سلطتهم من السلطان مباشرة الذي أطلق أيديهم في ما يرونه مناسباً، على أن تجمع الضرائب على اختلافها على مسؤوليته، أو عن طريق الالتزام. وكان هؤلاء قد برزوا نتيجة قيامهم بهذا الدور الذي يتوارثه الأبناء عن الآباء، كما حصل في بلاد الشام من دمشق إلى جبل لبنان وعكا وبيروت وصيدا وحلب ودمشق وبغداد، وفي شمالي أفريقيا، القاهرة على الخصوص في عهد عائلة على بك الكبير وأسرته التي توصلت إلى الاستقلال التام عن السلطنة العثمانية. وقد ترافق ذلك مع تغيرات جغرافية اقتصادية أفقدت السلطنة موارد ضخمة لم تجد ما يمكن أن يحلّ محلها للابقاء على سيرورة انتاجية ريعية – استهلاكية متوازنة.
كان من أبرز مظاهر انحطاط السلطنة العثمانية، حسب زيادة، هو تسلط الانكشارية على مفاصل الدولة والمجتمع، وما رافق ذلك من ضعف مركزي ساهم في انفصال ولايات أو استقلالها. وقد ازداد ضغط هؤلاء مع ضعف السلطة المركزية، ومع تراجع في حال قوتها إلى الدرجة التي تقضي على هؤلاء. وفي حال الفشل، يصل الأمر إلى اغتيال السلطان.
ليس من الغريب أن نصل حتى في عصرنا الحاضر، إلى ما يتماثل مع ذلك من حيث سيطرة العسكر على مجمل البلدان العربية، إما مباشرة أو بالواسطة. وما التغيير في هذه الأحوال إلا انقلاب العسكر على بعضهم بعضاً في أحداث لا تنتهي، أو في تداول للسلطة بالقسر دون إراقة دماء؛ ويبقى المجتمع في مكان آخر لا يصل إليه إلا النزر اليسير من التغيير، هذا إذا حصل فعلاً.
هذه الوقائع التي شهدتها الولايات العربية، على ما يقول زيادة، يمكنها أن تكون مادة تحليلٍ لسيرورة السلطة العسكرية التي تبوأها المماليك، فحوّلت “الولايات إلى دول في زمن السيطرة الأوروبية، ثم في أثناء بروز حركات التحرر من الاستعمار”، (ص113-114). فكانت بذلك السلطة العسكرية المتمثلة بالانكشارية متماثلة مع الادارة العثمانية المستحدثة التي قضت على سلطة العلماء العرب، فتبلورت عندها فكرة العروبة، كما تبلور الاحساس بأهمية العسكر في بناء الدولة العربية المستحدثة بعد المواجهة مع العثمانيين، أولاً؛ ومن ثم مع البريطانيين والفرنسيين، قبل وبعد نيل الاستقلال.
إرتباط التحديث العثماني بالقضاء على الانكشارية، ملاحظة مهمة قدمها خالد زيادة في مجال العلاقة بين الدولة وأجهزتها. ذلك أن أهم ما حظيت به السلطنة العثمانية كسلطة، هو امتلاكها زمام الأمور بعد القضاء على الانكشارية، ومن ثم توجيه إدارة الدولة إلى ما هو مستحدث في شؤون الحكم وتنظيم الجيش، والانتقال من حكم الفرد وإرادته السلطانية إلى حكم المؤسسة المنبثقة من مفهوم الدولة الحديثة. وهكذا انتقلت وحدة الاهتمام، على ما يقول زيادة، من المدينة إلى الوطن، ومن سياسة الفرد إلى سياسة منبثقة من المجتمع بكل أطيافه، وهو ما تفصح عنه الدولة الحديثة. ولذلك، “فإن السياسة قلّصت من شأن المدن وفكّت من عزلتها لمصلحة مفهوم الوطن الذي يتجاوز الانتماءات الجزئية والفئوية”، (ص130). والسياسة بهذا المعنى مؤشر مهم من مؤشرات الدولة الحديثة.
الاستحداث والتحديث والحداثة
في تحليله لمسألة التحديث المرتبط مباشرة بالتدخل الأوروبي في السلطنة العثمانية، بدءاً بعصر التنظيمات، يبين خالد زيادة أن التأثير المباشر ظهر أولاً في مصر مع الفرنسيين، قبل ذلك بأقل من نصف قرن بقليل، ومن ثم مع محمد علي الذي أخذ من فرنسا على الخصوص المعيار في كيفية بناء الدولة، وتنظيم العسكر، والعمل على الدخول في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وعليه، كان المصدر الأساسي للتحول الذي حصل في مصر مدوناً في تاريخ الجبرتي، الشاهد العيان الذي يصف ما كان يحصل في شتى المجالات مع الإفصاح عن المشاعر العفوية والصادقة المختلطة من الاعجاب والرهبة والخوف من نمط حياة غريب عن نمط حياة معيش، يمكن أن يوصل إلى ما يشبه الانفصام. وكانت النتيجة، بجهود الفرنسيين ومحمد علي، من بعد، أن ظهرت قاهرة جديدة ومنظمة وعامرة إلى جانب قاهرة قديمة يتآكلها الزمن وتسير نحو الاندثار. إلا أن التجديد المديني لم يبق لوحده دليلاً على العمران والتوسع، بل دخل عليه ما هو معاكس، يعرف بالمدن العشوائية التي نبتت كالفطر في الوقت الذي تخلت الدولة عن الاهتمام بالتخطط والتعمير.
على المنوال نفسه، ينسج زيادة ما حصل في حلب وبيروت من تحولات ظهرت بالتدخل المباشر من قبل الفرنسيين، وخصوصاً بعد نهاية الحرب العالمية الأولى وبداية الانتداب، وإن كان حصل من قبل ما قام به إبراهيم باشا مما يشي بالتحديث في المشرق تأثراً بوالده في مصر. وما يمكن قوله هنا، هو أن بيروت تحولت إلى مدينة كوزموبوليتية في فترة قياسية، كان لا بد من إلحاق مقاطعات جبلية مجاورة لها لتكون بيروت عاصمة لها، وتجهيز مرفأ يكون بديلاً عن المرافئ الموجودة من طرابلس إلى حيفا.
يميز خالدة زيادة عن حق بين الاستحداث والتحديث والحداثة. ذلك أن الاستحداث هو التغير على نمط معلوم إن كان في العمارة أو في اللباس أو أدوات الطبخ ومفروشات المنزل. أما الحداثة فهي اكتساب بالاختيار أو القسر “تشريعات وإجراءات صادرة عن رؤية ونظام مغايرين لما درجت عليه المدن طوال قرون من الزمن”(ص166). وهو ما حدث في القاهرة من خلال تفكيك بنية المدينة التقليدية بنزع استقلالية الحارات وإزالة البوابات، واعتبارها وحدة إدارية يديرها أبناؤها، بالإضافة إلى الهندسة العقلانية للمدينة، والمنشآت الضرورية، وهو ما لم تعرفه القاهرة من قبل. وإذا كان من أولى مواصفات الحداثة القطع مع الماضي والتوجه إلى بناء الحاضر والمستقبل، ظهر الميل إلى هدم المدن القديمة لاستبدالها بما هو حديث.
إلا أن ما هو أدهى وأكثر أثراً، كان إهمال المدن القديمة لتقضي على نفسها بنفسها، إذا لم تطلها معاول الهدم. هذا ما حصل في بيروت والقاهرة، وما حصل ويحصل في بقية المدن، وإن كانت حاراتها التقليدية لا تزال قائمة. في هذه الحال، على ما يؤكد زيادة، أصبحت المدن القديمة مركزاً لسكنى القادمين من الأرياف، بعد أن تخلى عنها ساكنوها بانتقالهم إلى شوارع المدينة الجديدة، وأمكنتها الفسيحة المطلة على كل ما هو جديد. ووجد الريفيون في المدينة ما هو أفضل في غياب السياسات التنموية الريفية لدى كل البلدان العربية، فكان ذلك مناسبة
لإدخال قيم الريف وعاداته وتقاليده إلى المدينة، فانتقلت بعد التكيف معها إلى ريف قادم من الخارج بدل إدخال النمط المديني في ذهنية أبناء الريف. وتفشّت بذلك ظاهرة ترييف المدن، والتنويع في هذا الترييف إلى الدرجة التي أضاعت فيها المدينة هويتها. وصغرت مساحتها مقابل التوسع العمراني المفتوح على الاتجاهات كلها، وخرج منها ما يمكن أن يشكل إمدادات للثورة، أو إعلان التمرد والعصيان.
يربط خالد زيادة نشوء الأحزاب السياسية بالدولة الحديثة. ذلك أنها تفصح، لحداثتها، عن حرية الممارسة السياسية. فنشأت الأحزاب بإيديولوجياتها المتنوعة لتعمل على تنفيذ ما تؤمن به على صعيد الدولة والمجتمع لتنقلهما إلى التحديث إذا لم يكن إلى الحداثة. إلا أن الانشغال بالإيديولوجيا لوحدها لا يكفي ولا يوصل إلى غاية الحزب في الانتقال من التقليد إلى الحداثة، وخاصة في ممارسة الحياة السياسية التي تحلق فوق الهموم والمشكلات اليومية للناس. وهذا ما دعا المهتمين بالإيديولوجيات إلى التغيير في مسارات العمل والانشغال بما يهم الناس ويلامس تطلعاتهم، فكانت بدايات النظر في التركيز على حق العيش في المدينة، على ما يقول زيادة، باعتبارها تمثل الجماعات الكبرى، ومسرح الفعل السياسي. وهذا ما يفرض تأمين المتطلبات الحياتية كافة للمنتمين إليها، وهو ما يمكن أن يكوّن التوجه الجديد للفكر المؤدلج الذي عليه أن يتعاطى بشؤون الناس في حياتهم اليومية. ومن المدينة تصل نتائج هذا الفعل وتداعياته إلى الريف قريباً كان أو بعيداً، وإن كان الحق فيه يختلف عن الحق في العيش في المدينة، ومن هذا الحق تنمية الريف وفعل ما يمكن لإبقاء الريف عامراً، وليخفّ ضغط النزوح، ولتنحسر مساحات العشوائيات.
يخلص خالد زيادة إلى تلخيص مراحل التحديث التي مرت بها البلدان العربية والمسلمة العثمانية ويحددها بثلاث؛ الأولى، مع بداية التنظيمات بإظهار أهمية الادارة وتنظيم الجيش وتحديث التعليم في المركز كما في الولايات، بالاضافة إلى تحول ظاهر في التقاليد والعادات ونمط العيش والسكن وغيرها؛ الثانية، مرحلة الاستعمار المباشر في أوقاته المتفاوتة. والمرحلة الثالثة، النزوع نحو الاستقلال والحصول عليه، وإن بأوقات متفاوتة أيضاً. فانتقلت بذلك العواصم العربية والمدن الكبرى إلى مرحلة الهجنة المختلطة بين التقليد والتحديث.
أما تخطيط المدن وتعيين عناصرها الأساسية فقد انتقلت من تخطيطها ووظيفتها من أصالة تستجيب لحاجات الناس وقادتهم، إلى الانغماس في تقليد وفي محاكاة التنظيم الغربي للمدينة في ساحاتها وشوارعها ونمط بناء مساكنها دون الاهتمام بما يفصح عما يشكل ثقافتنا العمرانية وتطويرها. والنظر في هذه المسألة شأن آخر.
ما قدمه خالد زيادة في كتاب المدينة العربية والحداثة يفتّح أبصارنا على هذا النمط من البحث لنفهم كيفية تشكل المدينة العربية، إن كان في موقعها أو في الوظائف التي عليها أن تقوم بها، مع التأكيد على أن نمط بنائها وتنظيمها ونظرتها إلى الإنسان تختلف في شكل واضح عن أنماط بناء ووظائف المدينة الغربية. كما أن التغيرات التي تصيبها تصيب أي مدينة أخرى في العالم، لأن مسألتي التطور والتغير سنّة طبيعية في الحياة، بالاضافة إلى ما يفعله الإنسان من خلال علاقته مع الطبيعة ومع الإنسان، ما يعجّل في التطور والتغيير، إن كان عن طريق الإنجازات الداخلية أو التثاقف أو التأثير الذي يفرضه الغالب على المغلوب حسب التعبير الخلدوني.
شكراً للدكتور خالد زيادة على هذا الإنجاز، ومن حقنا أن نطالبه بالمزيد.
* عاطف عطيّه: أستاذ علم الاجتماع، مدير سابق لمعهد العلوم الاجتماعية – الفرع الثالث- الجامعة اللبنانية.
عنوان الكتاب: المدينة العربية والحداثة المؤلف: خالد زيادة
ضفة ثالثة




