الهوية لم تعد أزمة الأقليات فقط، كل المجتمعات تتساءل: من نحن؟
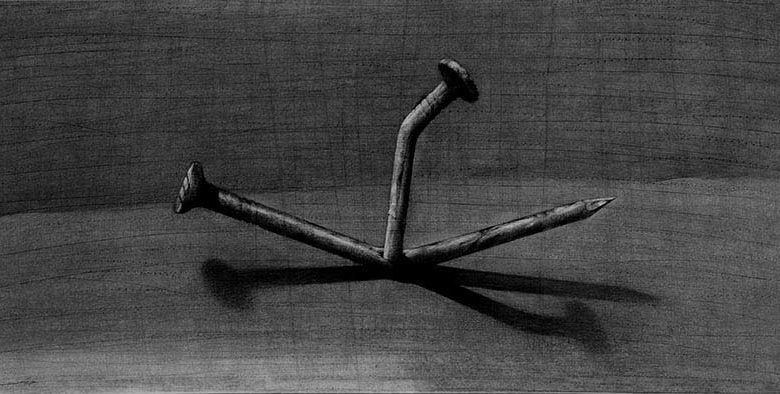
المتابع لما يجري من أحداث وصراعات وأزمات داخلية في مختلف أنحاء العالم، قد يجد خيطا رفيعا يجمع بينها، وإن تباعدت في المظاهر والأسباب وعمق التفاصيل؛ يتعلق هذا الخيط بأزمة الهوية. في بوتقة هذه الأزمة تصب مختلف التطورات التي يشهدها العالم من صراعات في بعض دول المنطقة العربية، أو انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، أو عن ترؤس دونالد ترامب للولايات المتحدة، أو صعود تيارات اليمين المتطرف، موجة معاداة الآخر التي تضرب اليوم بقوة ألمانيا، إلى طموح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبناء أوروبا معاصرة قادرة على تولي دفاعها والتغلب على أزماتها وتطرح نفسها في العالم على قدم المساواة مع واشنطن وبكين، وحتى حملة “مي تو” ضد التحرش الجنسي.
عادة ما يحيل الحديث عن القلق المجتمعي المرتبط بالهوية إلى الأقليات والإثنيات، لكن في السنوات الأخيرة توسع الحديث عن أزمة البحث عن هوية لتشمل نطاقا أوسع من أقلية تشعر بالغبن في مجتمعها مقابل سيطرة أغلبية “مختلفة”. اليوم، توسعت النظريات التي تتحدث عن أزمة الهوية وترصد نزوعا نحو الانغلاق و”القبيلة”، في مفهومها المضاد للعولمة، التي كلما توسعت زاد معها الإحساس بالاغتراب الذي تحول إلى رفض للآخر ومعاداة الأجانب ورغبة في السيطرة على الحدود، بمعناها الواسع، جغرافيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا. تغذى هذا الإحساس من مخلفات الأزمات الاقتصادية وما ولدته من بطالة وغلاء ومشكلات اجتماعية ثم تضاعف هذا الإحساس في ظل أزمات الهجرة واللجوء، حتى بات هذا الشعور القلق يشكل التوجهات السياسية، كما يشير إلى ذلك الفيلسوف والمفكر الأميركي فرانسيس فوكوياما، بقوله إن السياسة اليوم تتحكم فيها مسائل الهوية أكثر مما تتحكم فيها المشاغل الاقتصادية أو الأيديولوجية.
بحث عن الهوية
الشباب الذين انتفضوا في 2011 في بلدان الربيع العربي، وجرت وراءهم بقية المجتمع، كانوا يبحثون عن هوية تعرّفهم، ارتبطت هذه الهوية بالأساس بالعمل والكرامة؛ أوروبا حائرة اليوم بين التطبيق “الديمقراطي” لشعارات حقوق الإنسان التي كوّنت هويتها لسنوات طويلة وبين ضغوط هذا التطبيق التي دفعت نحو صعود اليمين المتطرف ورغبة كبرى في العودة إلى الهوية “القبيلة” بمفهومها المرتبط بالمجتمع المنغلق؛ الأميركيون الذين بكوا بحرقة على فقدان السيناتور جون ماكين، كانوا يبكون الشخص والفكرة التي جسدها باعتباره أحد آخر وجوه الحقبة الأميركية “الراقية”، وهو السياسي المضاد لكل ما تمثله ثقافة الرئيس الحالي دونالد ترامب، أكثر من يعارض سياسات الحدود المفتوحة واتفاقيات التجارة الحرة.
قبل أيام أعلنت الشرطة الألمانية عن تعرض شاب سوري (20 عاما) لضرب مبرح في متنزه بمدينة فيسمار شمالي البلاد على أيدي ثلاثة جناة بدافع معاداة الأجانب، وتم طرحه أرضا، وقام أحد المهاجمين بضرب الشاب بسلسلة حديدية. وبعد ذلك لاذ الجناة بالفرار. وهذا الحادث هو واحد من سلسلة حوادث مشابهة تعيش على وقعها ألمانيا حيث انتشرت مطاردة الأجانب والهتافات النازية وأعمال العنف، ضمن وضع يقول عنه الصحافي الألماني اليهودي ميشيل فريدمان “هذه ليست سوى قمة جبل الجليد لحركة متطرفة ذات قاعدة كبيرة”.
الثقافة الألمانية، باتجاهاتها التي تناصر التسامح والتنوع، هي “قذرة وملوثة” بشكل خاص، في نظر هانس توماس تيلشنايدر العضو في حزب البديل لألمانيا، صاحب التوجهات اليمينية المتشددة. ويقول تيلشنايدر في تصريح لصحيفة فاينانشيل تايمز، يجب على الألمان أن يعودوا إلى التراث الثقافي المعروف. ويضيف “يجب أن نقدم إنتاجا جديدا لمسرحياتنا، لكنها يجب أن تكون مسرحياتنا، ولا بد لها أن تتناول الأمور التي تهمنا: من نحن الألمان؟ ومن أين نأتي؟ وإلى أن نحن ذاهبون؟”.
وجاء حديث تيلشنايدر تعقيبا على حملة ضد مسرحية (تاريخ العنف)، للمخرج ثوماس أوسترماير، وهي مقتبسة من رواية متعمقة حول العرق والطبقة الاجتماعية والعنف كتبها الكاتب الفرنسي الشاب المشهور إدوارد لوي. وينعكس البحث عن الهوية، في حديث تيلشنايدر، من خلال قوله إن المؤلفات الكلاسيكية هي التي تستطيع تقديم أجوبة على تلك الأسئلة، وكمثال على ذلك ذكر أسماء ثلاثة أعمال عظيمة من روائع الأدب الألماني، وهي مسرحية “فاوست” (1808) من تأليف جوته، وثلاثية “فالنشتاين” (1799) من تأليف شيلر، ومسرحية “معركة غابة التيوتوبورج” (1808) من تأليف هاينريش فون كلايست، التي تستند إلى اللقاء الملحمي بين الرومان والقبائل الألمانية في السنة التاسعة للميلاد، وكان يُنظر إليها من قبل معاصري كلايست على أنها نداء قوي لحمل السلاح ضد فرنسا.
سلط الضوء على هذه التعقيدات الهوياتية، الفيلسوف والمفكر الأميركي فرانسيس فوكوياما، في أحدث دراساته عن النزعة القبلية الجديدة وأزمة الهوية، مشيرا إلى أن كل التطورات التي تشهدها المجتمعات العالمية ترتبط بشكل أو بآخر بالتحولات الاقتصادية والتكنولوجية للعولمة، لكنها أيضا متجذرة في ظاهرة صعود سياسة الهوية.
الهوية تصنع السياسات
يفسر صاحب نظرية نهاية التاريخ قراءته بقوله إن السياسة خلال القرن الماضي كانت في معظمها تحددها المسائل الاقتصادية، حيث كانت السياسة من جهة اليسار متركزة على العمال والنقابات العمالية وبرامج الرفاه الاجتماعي وسياسات إعادة التوزيع.
وفي المقابل كان اليمين مهتما بشكل أساسي بتخفيض حجم الحكومة وتعزيز القطاع الخاص. بيد أن السياسة اليوم تتحكم فيها مسائل الهوية أكثر مما تتحكم فيها المشاغل الاقتصادية أو الأيديولوجية. الآن لا يركز اليسار في الكثير من الديمقراطيات على خلق مساواة اقتصادية عريضة بقدر ما يركز على خدمة مصالح تشكيلة عريضة من المجموعات المهمشة مثل الأقليات الإثنية والمهاجرين واللاجئين والنساء والمثليين. في الأثناء أعاد اليمين تحديد مهمته الأساسية لتصبح حماية الهوية الوطنية التقليدية التي كثيرا ما ترتبط بشكل صريح بالعرق والإثنية والدين.
يقلب هذا التحول تقليدا طويلا (يرجع على الأقل إلى زمن كارل ماركس) يتمثل في اعتبار الصراعات السياسية انعكاسا للصراعات الاقتصادية، لكن على الرغم من أهمية المصلحة المادية الخاصة فإن البشر تحركهم أشياء أخرى أيضا، وهي قوى تقدم تفسيرا أفضل لليوم الراهن. في كل أنحاء العالم حشد الزعماء السياسيون أتباعهم حول فكرة أن كرامتهم أهينت ويجب استردادها.
وبالطبع في البلدان ذات النظام الاستبدادي، هذه الإغراءات أمر معتاد إذ تكلم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن “مأساة” انهيار الاتحاد السوفييتي وانتقد الولايات المتحدة وأوروبا لاستغلالهما ضعف روسيا أثناء فترة التسعينات لتوسيع حلف الناتو. كما يلمح الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى “قرن الإهانة” لبلده، وهي فترة هيمنة أجنبية بدأت في سنة 1839.
فرانسيس فوكوياما: الحل ليس التخلي عن فكرة الهوية التي تقع في قلب الطريقة التي يفكر بها الناس في أنفسهم والمجتمعات المحيطة بهم، بل تحديد الهويات الأوسع والأكثر اندماجية
لكن الاستياء الناتج عن خدش الكرامة أصبح قوة جبارة في البلدان الديمقراطية أيضا. لقد برزت حركة ‘أرواح السود مهمة’ من سلسلة من حوادث شهيرة قامت فيها الشرطة بقتل أميركيين من أصول أفريقية وأجبرت بقية العالم على أن يهتموا بضحايا وحشية الشرطة.
وفي الجامعات وفي المكاتب في مختلف أنحاء الولايات المتحدة عبرت النساء عن غضبهن مما يبدو أنه وباء تحرش واعتداء جنسيين واستنتجن بأن زملائهن من الرجال لم يعتبرهن بكل بساطة مساويات لهم. وأصبحت حقوق المتحولين جنسيا قضية شهيرة بعد أن كانوا من قبل غير معترف بهم أهدافا مميزة للتمييز. والكثير ممن صوتوا لترامب تاقوا إلى زمن أجمل في الماضي لاعتقادهم بأن مكانهم في مجتمعهم الخاص كان أكثر أمانا.
مرة بعد أخرى غدت المجموعات تعتقد بأن هوياتها (سواء الوطنية أو الدينية أو الإثنية أو الجنسية أو المتعلقة بالنوع الاجتماعي أو غيرها) لا تلقى الاعتراف الكافي. ولم تعد سياسة الهوية ظاهرة صغيرة تظهر فقط في الحدود النادرة للجامعة أو توفر خلفية للمناوشات ذات الرهانات المحدودة في “الحروب الثقافية” التي تدعمها وسائل الإعلام. وبدلا من ذلك أصبحت سياسة الهوية مفهوما رئيسيا يفسر جزءا كبيرا مما يحصل في الشؤون العالمية.
وهذا يترك الديمقراطيات الليبرالية الحديثة في مواجهة تحد مهم حيث أنتجت العولمة تغييرا اقتصاديا واجتماعيا سريعا وجعلت هذه المجتمعات أكثر تنوعا بكثير، مما خلق مطالب بالاعتراف من قبل مجموعات كانت سابقا لا تُرى بالنسبة إلى المجتمع السائد. أدت هذه المطالب إلى ردة فعل عنيفة وسط المجموعات الأخرى التي تشعر بأنها بصدد فقدان منزلتها ولديها شعور بالانزياح.
وهكذا تتعرض المجتمعات الديمقراطية إلى الانقسام إلى قطاعات تعتمد على هويات أضيق فأضيق، وهو ما بوسعه أن يهدد إمكانية التفاوض والعمل المشترك من قبل المجتمع ككل. وهذه طريق لا تؤدي إلا إلى انهيار الدولة والفشل في نهاية المطاف. وما لم تستطع هذه الديمقراطيات الليبرالية إيجاد طريقها ثانية نحو فهم كوني للكرامة الإنسانية فسيكون مصيرها (ومصير العالم) الصراع المستمر.
يؤكد فوكوياما أن المجتمعات تحتاج حماية المجموعات المهمشة والمقصية، لكنها تحتاج أيضا تحقيق أهداف مشتركة عبر التفاوض والإجماع. والتحول في أجندات كل من اليسار واليمين نحو حماية هويات المجموعات الضيقة يهدد في النهاية هذا المسار.
والحل، حسب نظريته، ليس التخلي عن فكرة الهوية التي تقع في قلب الطريقة التي يفكر بها الناس المعاصرون في أنفسهم والمجتمعات المحيطة بهم، بل هو تحديد الهويات الأوسع والأكثر اندماجية التي تأخذ في الاعتبار التنوع الحالي للمجتمعات الديمقراطية الليبرالية.
مستقبل موحد أكثر
المجتمعات البشرية لا يمكنها الإفلات من الهوية أو سياسة الهوية. إن الهوية حسب تعبير الفيلسوف شارلز تايلر هي “فكرة أخلاقية قوية”، والحل وفق فرانسيس فوكوياما يمكن أن يكون عبر توظيف الخيال. ويوضح بقوله ذلك إن أحسن طريقة للتعبير عن مخاوف المستقبل عادة ما تكون عبر الخيال، وبخاصة الخيال العلمي الذي يحاول تخيل العوالم المستقبلية على أساس أنواع جديدة من التكنولوجيا.
في النصف الأول من القرن الماضي ارتكزت الكثير من هذه المخاوف المتطلعة إلى المستقبل حول أنظمة بيروقراطية كبيرة، مستبدة ومركزية قضت على الفردانية والخصوصية، وأوضح مثال على ذلك رواية 1984 لجورج أورويل، لكن طبيعة مدن الواقع المرير الخيالية بدأت تتغير في العقود اللاحقة من القرن الماضي، وتكلم فصيل معين معبرا عن المخاوف التي أثارتها سياسة الهوية، حيث أن ما يسمى مؤلفي سايبربانك مثل ويليام غيبسون ونيل ستيفنسون وبروس ستيرلينغ رأوا مستقبلا لا تهيمن عليه أنظمة دكتاتورية مركزية بل تفككا اجتماعيا خارجا عن السيطرة سهلته الإنترنت.
رواية انهيار الثلج للكاتب ستيفنسون التي نشرت في سنة 1992 قدمت واقعا افتراضيا من صنع الكمبيوترات يمكن للأفراد فيها تبني صورا رمزية وتغيير هوياتهم حسب الطلب.
وفي الرواية، انقسمت الولايات المتحدة إلى تقسيمات حضرية فرعية تخدم الهويات الضيقة، مثل جنوب أفريقيا الجديدة (للعنصريين) وهونغ كونغ العظمى للسيد لي (للمهاجرين الصينيين).
هناك حاجة إلى جوازات السفر والتأشيرات للسفر من حي لآخر، وتمت خصخصة سي آي إيه، وأصبحت حاملة الطائرات ‘يو إس إس إنتربرايز” موطنا عائما للاجئين. وانحسرت سلطة الحكومة الفيدرالية لتضم فقط الأرض التي توجد فيها البناءات الفيدرالية.
عالمنا الحالي يتحرك في الآن نفسه في اتجاه مدينتين متقابلتين للمركزية المفرطة والتشتت اللانهائي. الصين على سبيل المثال بصدد بناء نظام دكتاتوري ضخم تقوم فيه الحكومة بجمع معلومات شخصية خصوصية للعمليات اليومية لكل مواطن. وفي المقابل تشهد أجزاء أخرى من العالم انهيار المؤسسات المركزية وظهور الدول الفاشلة وتعاظم الاستقطاب وتنامي نقص الإجماع على الغايات المشتركة. لقد سهل الإعلام الاجتماعي والإنترنت بروز المجتمعات المتحفظة التي لا تعزلها الحواجز المادية بل الهويات المشتركة.
الشيء الجيد في ما يخص الخيال الذي يتحدث عن الواقع المرير هو أنه تقريبا لا يتحقق أبدا، وتخيل كيفية بروز الاتجاهات الحالية بطريقة أكثر مبالغة من أي وقت آخر بمثابة تحذير مفيد حيث أصبحت رواية 1984 مثالا قويا لمستقبل كلياني أراد الناس تجنبه، كما ساعد الكتاب على تلقيح المجتمعات ضد النظام الاستبدادي. وبالمثل يمكن للناس اليوم تخيل بلدانهم أماكن أجمل تدعم المزيد من التنوع لكنها أيضا تتبنى رؤية لكيفية خدمة التنوع للغايات المشتركة وتدعم الديمقراطيات الليبرالية بدلا من تقويضها.
ويخلص فوكوياما مؤكدا أن الناس لن يتوقفوا عن التفكير في أنفسهم ومجتمعاتهم في ما يتعلق بالهوية. بيد أن هويات الناس ليست ثابتة ولا تمنح بالمولد بالضرورة. ويمكن للهوية أن تستخدم للتقسيم، ولكن أيضا للتوحيد. وذلك في النهاية هو العلاج للسياسة الشعبوية الحالية.
العرب




